الأصحاح الحادي والعشرون
اقتصر متّى على ذكر بعض الحوادث في أريحا، فلم يذكر زيارة المسيح بيت زكا، ولم يذكر مثل عشرة الأَمْناء. وضرب المسيح هذا المثل إما في المدينة وإما في الطريق وهو صاعد إلى أورشليم (لوقا ١٩: ١ - ٢٨).
١ «وَلَمَّا قَرُبُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَجَاءُوا إِلَى بَيْتِ فَاجِي عِنْدَ جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ، حِينَئِذٍ أَرْسَلَ يَسُوعُ تِلْمِيذَيْنِ».
زكريا ١٤: ٤ ومرقس ١١: ١ الخ ولوقا ١٩: ٢٩
وَلَمَّا قَرُبُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ صعود المسيح إلى أورشليم الذي ذُكر في بداءة هذا الأصحاح حدث يوم الأحد العاشر من نيسان، وهو بدء الأسبوع الأخير من حياته على الأرض. والأرجح أنه ترك أريحا نهار الجمعة الثامن من نيسان، ووصل إلى بيت عنيا مساءً عند بدء السبت اليهودي كما يظهر من قول يوحنا «ثُمَّ قَبْلَ الْفِصْحِ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ أَتَى يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا» (يوحنا ١٢: ١).
بَيْتِ فَاجِي معناه في اليوناني «بيت التين» وهي قرية صغيرة شرق أورشليم على السفح الشرقي من جبل الزيتون، قرب بيت عنيا وعلى الطريق بينها وبين أورشليم. وليس من اليسير تعيين موقعها تماماً اليوم. واستنتج أكثر المفسرين أنها كانت بين بيت عنيا وأورشليم، لأن متّى ذكر وصول المسيح إليها بعدما خرج قاصداً أورشليم. وظنها بعضهم شرق بيت عنيا بناءً على تقديم مرقس ولوقا إياها على بيت عنيا في ذهاب يسوع من أريحا إلى أورشليم. ففهموا من قول متّى أن بيت عنيا كانت متنحِّية عن الطريق السلطانية بين أريحا وأورشليم وبيت فاجي، وأن المسيح في قدومه من أريحا وصل أولاً إلى بيت فاجي، ثم مال عن الطريق إلى بيت عنيا، ثم عاد إليها في سفره إلى أورشليم يوم الأحد.
جَبَلِ ٱلزَّيْتُون ويقع شرق أورشليم، ويفصل بينهما وادي قدرون (يوحنا ١٨: ١). ويرتفع ٢٥٥٦ قدماً فوق سطح البحر، ولا يزيد عن الهيكل سوى ٣٠٠ قدماً، لأن الهيكل كان على جبل المُريا (٢أخبار ٣: ١). وهو على بعد نحو ميل أو ثلث ساعة من المدينة. وحسبت تلك المسافة عند اليهود سفر سبت (أعمال ١: ١٢) وهو ألفا خطوة. ويقع على سفحه الغربي بستان جثسيماني (قارن لوقا ٢٢: ٣٩ مع مرقس ١٤: ٣٢) وعلى سفحه الشرقي بيت فاجي وبيت عنيا.
٢ «قَائِلاً لَهُمَا: اِذْهَبَا إِلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمَامَكُمَا، فَلِلْوَقْتِ تَجِدَانِ أَتَاناً مَرْبُوطَةً وَجَحْشاً مَعَهَا، فَحُلاَّهُمَا وَأْتِيَانِي بِهِمَا».
ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمَامَكُمَا الأرجح أنها بيت فاجي التي لم يكونوا قد وصلوا إليها حينئذٍ وهي المذكورة في العدد الأول.
أَتَاناً... وَجَحْشا اقتصر مرقس ولوقا على ذكر الجحش فقط. وزادا على قول متّى أنه لم يجلس على ذلك الجحش أحدٌ قبل المسيح. وندر ركوب الخيل في الأسفار العادية يومئذٍ في اليهودية لقلتها واستخدامها في الحرب خاصة. واعتاد ملوك بني إسرائيل وأشرافهم ركوب الحمير (قضاة ١٠: ٤، ١٢ و١صموئيل ٢٥: ٢٠) فركوب الحمار لا يدل على الفقر ودناءة المقام فقد ركبه الملوك وقت السلام.
٣ «وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدٌ شَيْئاً فَقُولاَ: ٱلرَّبُّ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِمَا. فَلِلْوَقْتِ يُرْسِلُهُمَا».
وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدٌ أي اعترضكما، ويظهر من ذلك أن أصحاب الأتان والجحش كانوا من معارف يسوع وعارفي معجزاته، لأنه اشتهر كثيراً بإقامة لعازر في بيت عنيا. فكان قول الرسولين إن الرب محتاج إليهما كافٍ لأن يقنع أصحابهما بتسليمهما إلى الرسولين. ولا يخلو ذلك من علم سابق ونبوة، لأن المسيح عرف الحوادث وأنبأ بها قبل أن تحدث.
٤، ٥ «٤ فَكَانَ هٰذَا كُلُّهُ لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِٱلنَّبِيِّ: ٥ قُولُوا لابْنَةِ صِهْيَوْنَ: هُوَذَا مَلِكُكِ يَأْتِيكِ وَدِيعاً، رَاكِباً عَلَى أَتَانٍ وَجَحْشٍ ٱبْنِ أَتَانٍ».
إشعياء ٦٢: ١١ وزكريا ٩: ٩ ويوحنا ١٢: ١٤، ١٥
الحادث المذكور إتمام للنبوة، والمسيح قصد إتمامها بما فعله (انظر متّى ١: ٢٢) ونطق زكريا بهذه النبوة منذ ٥٥٠ (زكريا ٩: ٩) ونسبها اليهود في كل عصر إلى المسيح المنتظر، ومقدمتها على ما ذكرها متّى من نبوة إشعياء (إشعياء ٦٢: ١١). ولم يفهم التلاميذ يومئذٍ أن ركوب المسيح على جحشٍ كان إتماماً لنبوة زكريا (يوحنا ١٢: ١٦). أمر المسيح تلاميذه قبل هذا الوقت أن لا يُظهروا للناس أنه المسيح ملك اليهود، من أجل ذلك تجنب كل احتفال. ولكن حان الوقت لأن يرفع الحجاب عن دعواه وأن يدخل أورشليم باحتفال، ليُظهر للناس أنه المسيح ملك اليهود الروحي.
لابْنَةِ صِهْيَوْن هذا اسم من أسماء أورشليم (إشعياء ١: ٨). لأن جبل صهيون هو أحد الجبال التي بُنيت عليها أورشليم وهو جنوب تلك الجبال وأعلاها.
مَلِكُكِ يَأْتِيكِ وَدِيعا تنبأ النبي بأن المسيح يأتي ملكاً مُدعياً حق التسلط على هذا العالم، ولكنه لا يأتي بمركبات وخيل كمحارب من الملوك الأرضيين، بل يأتي بما يليق برئيس السلام. ولا يأتي بعظمة وافتخار بل بالوداعة. وسيرة المسيح كلها وفق هذه النبوة.
أَتَانٍ وَجَحْشٍ ٱبْنِ أَتَان وفي الأصل «عَلَى حِمَارٍ وَعَلَى جَحْشٍ ابْنِ أَتَانٍ» (زكريا ٩: ٩) فالعطف على ذلك هو للتفسير، فيكون المعنى كقول العامة «حمار ابن حمار» أو لعل متّى قصد الأتان وابنها، وأن التلميذين أتيا بهما وأعداهما للركوب. ولا دليل إلا على أنه ركب أحدهما.
٦ «فَذَهَبَ ٱلتِّلْمِيذَانِ وَفَعَلاَ كَمَا أَمَرَهُمَا يَسُوعُ».
مرقس ١١: ٤
ذكر مرقس ولوقا أن أصحاب الأتان والجحش اعترضوا الرسولين في أول الأمر، فأجاباهم بالجواب الذي أمرهم به المسيح.
٧ «وَأَتَيَا بِٱلأَتَانِ وَٱلْجَحْشِ، وَوَضَعَا عَلَيْهِمَا ثِيَابَهُمَا فَجَلَسَ عَلَيْهِمَا».
٢ملوك ٩: ١٣
وَضَعَا عَلَيْهِمَا ثِيَابَهُمَا القصد بالثياب هنا الخارجية كالرداء والعباءة، ووضعاها احتراماً للراكب كما صنع أصحاب ياهو له (٢ملوك ٩: ١٣). ووضعا الثياب على الدابتين لعدم معرفتهما أيهما يختار أن يركبه.
جَلَسَ عَلَيْهِمَا أي على أحدهما وهو الجحش كما ذكر مرقس ولوقا. وقال «عليهما» بحذف المضاف الذي هو أحد، لمناسبة تكرارهما بضمير الاثنين.
٨ «وَٱلْجَمْعُ ٱلأَكْثَرُ فَرَشُوا ثِيَابَهُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ. وَآخَرُونَ قَطَعُوا أَغْصَاناً مِنَ ٱلشَّجَرِ وَفَرَشُوهَا فِي ٱلطَّرِيقِ».
لاويين ٢٣: ٤٠ ويوحنا ١٢: ١٣
ٱلْجَمْعُ ٱلأَكْثَرُ بعض هذا الجمع أتى مع يسوع من أريحا، والبعض رافقه من بيت عنيا، والبعض أتوا من أورشليم ليستقبلوه، وسار بعضهم أمامه وبعضهم وراءه، وكان بينهم بعض الفريسيين الذين لم يفرحوا مع الجمع (لوقا ١٩: ٣٩).
فَرَشُوا ثِيَابَهُمْ... وأَغْصَان مِنَ ٱلشَّجَرِ احتراماً له كما اعتادوا أن يصنعوا للعائدين من الحرب منتصرين، وللملك الراجع إلى بلاده بعد غيبته عنها. وزاد يوحنا على ذلك أن الذين استقبلوه من أورشليم أتوا بسعف النخل (يوحنا ١٢: ١٢، ١٣) وفرشوه في الطريق إظهاراً لزيادة فرحهم بالانتصار والسلام (رؤيا ٧: ٩).
٩ «َٱلْجُمُوعُ ٱلَّذِينَ تَقَدَّمُوا وَٱلَّذِينَ تَبِعُوا كَانُوا يَصْرُخُونَ: أُوصَنَّا لابْنِ دَاوُدَ! مُبَارَكٌ ٱلآتِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ! أُوصَنَّا فِي ٱلأَعَالِي!».
مزمور ١١٨: ٢٥، ٢٦ ومتّى ٢٣: ٢٩
أُوصَنَّا كلمة سريانية مركبة معنى أولها (أُوْصَ) خلص، ومعنى آخرها (نا) أرجو، وهي منقولة من مزمور ١١٨: ٢٥. وكان استعمالها أصلاً للدعاء، ثم اصطلح الشعب على استعمالها في هتاف السرور. وأكثر ما كانوا يستعملونها لذلك في عيد المظال وهم يرنمون مزمور ١١٨ كله.
لابْنِ دَاوُدَ هذا إقرار الجمع بأن يسوع هو المسيح ملك اليهود. وقبل المسيح هذا الاحترام بالمعنى الذي قصدوه.
مُبَارَكٌ ٱلآتِي وهذا منقول من مزمور ١١٨: ٢٦ ويراد به التمجيد والترحيب. وقصد الجمع بذلك إكرام المسيح وحده لا الزوار الآتين معه إلى العيد، فهو وحده المخلص الذي أتى ليخلص شعبه من خطاياهم.
بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ أي المتسربل بسلطان الرب، والذي وكل الرب إليه إعلان مشيئته.
أُوصَنَّا فِي ٱلأَعَالِي إن كان قصدهم بذلك التمجيد، فيكون المعنى: ليتمجد المسيح تمجيداً يبلغ السماء ارتفاعاً! وإن كان قصدهم الدعاء، فيكون المعنى: خلِّص من علو السماء. ولا بد من أن هتافات الجمع كانت متنوعة، فذكر متّى بعضها ومرقس ولوقا غيره. فسأل الفريسيون من ذلك الجمع يسوع أن ينتهر الصارخين فأبى (لوقا ١٩: ٣٩). ولما رأى المدينة افتكر في الدينونة الآتية عليها وبكى، ولم يلتفت إلى ما كان له من الاحتفال والتمجيد أسفاً على المصائب المقبلة على تلك المدينة (لوقا ١٩: ٤١).
١٠ «وَلَمَّا دَخَلَ أُورُشَلِيمَ ٱرْتَجَّتِ ٱلْمَدِينَةُ كُلُّهَا قَائِلَةً: مَنْ هٰذَا؟».
ٱرْتَجَّتِ ارتجت عند دخوله إليها كما اضطربت عند ميلاده (متّى ٢: ٣) وذلك شأن كل حادث عظيم لانتشار خبره سريعاً بها. ولا عجب من أن ترتج من اجتماع تلك الجماعات الكثيرة وهتافهم واحتفالهم بالمسيح.
مَنْ هٰذَا؟ هذا سؤال من رأوا تلك الجماعات وسمعوا هتافها من بعيد، ولم يروا من تحتفل به. أو سؤال من نظروه ولم يعرفوا من هو لأنهم غرباء، فإن المدينة كانت حينئذ غاصة بالغرباء بمناسبة عيد الفصح. وسؤالهم هو تعجب واستفهام، ومعناه: أي الناس هذا حتى يرحب به كل هذا الجمع العظيم ويناديه بابن داود ويمجده معتقداً أنه المسيح؟ وهذا كان تأثير الحادثة في العامة، وأما تأثيرها في الفريسيين فذكره لوقا ويوحنا (لوقا ١٩: ٣٩، ٤٠ ويوحنا ١٢: ١٩).
١١ «فَقَالَتِ ٱلْجُمُوعُ: هٰذَا يَسُوعُ ٱلنَّبِيُّ ٱلَّذِي مِنْ نَاصِرَةِ ٱلْجَلِيلِ».
هذا جواب الجموع للسائلين. وليس فيه من الاحترام ما يوازي الاحترام الذي في هتاف أصدقاء المسيح، لكن فيه تصريحاً باسمه الشائع بين الناس، وهو أسهل على إدراك الغرباء فكأنهم قالوا «نبي الناصرة المشهور».
١٢ «وَدَخَلَ يَسُوعُ إِلَى هَيْكَلِ ٱللّٰهِ وَأَخْرَجَ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِي ٱلْهَيْكَلِ، وَقَلَبَ مَوَائِدَ ٱلصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيَّ بَاعَةِ ٱلْحَمَامِ».
تثنية ١٤: ٢٤، ٢٥، ٢٦ ومرقس ١١: ١١، ١٥ ولوقا ١٩: ٤٥ الخ ويوحنا ٢: ١٣ الخ
لم يهتم متّى بأن يذكر حوادث كل يوم من الأسبوع الأخير على ترتيب وقوعها، ولكن مرقس اهتم كثيراً بذلك. ففي بشارته أن المسيح في أول يوم من دخوله أورشليم «دخل الهيكل ونظر حوله إلى كل شيء» و «إِذْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ أَمْسَى، خَرَجَ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا» (مرقس ١١: ١١).
دَخَلَ يَسُوعُ هذا من حوادث يوم الاثنين. وأتى من بيت عنيا إلى أورشليم صباحاً، وفي أثناء مسيره حدث بعض ما كان من أمر التينة (مرقس ١١: ١٢ - ١٤).
إِلَى هَيْكَلِ ٱللّٰه بُني الهيكل على جبل المُريا، ووسعوا قمة الجبل بأن أقاموا جدراناً عالية في سفحه في وادي يهوشافاط، وملأوا الفراغ بين القمة والجدران بالتراب والحجارة. وبنى سليمان الهيكل الأول سنة ١٠٠٥ قبل الميلاد، واستغرق بناؤه سبع سنين، ثم هدمه نبوخذ نصر سنة ٥٨٤ قبل الميلاد (٢أخبار ٣٦: ٦، ٧). وبنى زربابل الهيكل الثاني مكان الأول بعد سبعين سنة من هدمه. فكان دون الهيكل الأول في الزينة والبهاء، ولم يكن فيه تابوت العهد إذ فُقد هذا في السبي، ولم تظهر فيه سحابة المجد. ومع ذلك فإنه فاق الأول مجداً لدخول المسيح إليه (حج ٢: ٣، ٩). ودنس ملوك الأمم الذين استولوا على أورشليم هذا الهيكل مراراً، وخربوا جانباً منه. وأخذ هيرودس الكبير يرممه ويصلحه ليستميل إليه قلوب اليهود. وبدأ ذلك من سنة ١٨ من حكمه وذلك عام ٢٠ ق م. واشتغل بترميمه نحو عشرة آلاف من مهرة البنائين، وظل خلفاء هيرودس يصلحونه ويبدلون ويغيرون حتى صح قول اليهود للمسيح أنه «بُني في ٤٦ سنة». واتخذوا الحجارة من الرخام الأبيض، وكان منظره من أبهج مناظر أبنية الأرض لتغشيته بكثير من صفائح الفضة والذهب، علاوة على حسن تلك الحجارة. وكانت فسحة الهيكل مربعة عرض كل من جدرانها أربع مئة ذراع.
وكان في ذلك الهيكل أربع دور:
الأولى: دار الأمم، وفي الجانب الشرقي منها باب الهيكل الجميل (أعمال ٣: ٢، ١٠) ويحيط بها أروقة، وعلى جوانبها غرف لسكن اللاويين. وفي أحد تلك الجوانب مجمع أو مدرسة لعلماء اليهود. وفي تلك المدرسة جلس يسوع وهو ابن ١٢ سنة وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم (لوقا ٢: ٤٦). وفي تلك الأروقة خاطب الشعب، وفيها اجتمع التلاميذ كل يوم بعد صعوده (أعمال ٢: ٤٦). واشتهر أحد هذه الأروقة أكثر من غيرها بنسبته إلى سليمان (أعمال ٣: ١١) وكان علو هذا الرواق ٧٠٠ قدم. فجرب الشيطان المسيح بأن يطرح نفسه من سطحه إلى أسفل. وكان في تلك الدار موائد للصيارفة وباعة الحمام وأمثالهم. وسُميت دار الأمم لأنه لم يكن لغير اليهود أن يجاوزوها إلى الداخل. ولم يكن في هيكل سليمان دار للأمم، فلم يكن فيه سوى دار للكهنة والدار العظيمة (٢أخبار ٤: ٩).
الثانية: دار النساء، ونُسبت إليهنَّ لا لأنها مختصة بهن، بل لأنه لم يجز لهن أن يتعدَّينها إلى داخل، فكن يأتين إليها ليقدمن القرابين. وهي أعلى من الدار الأولى، فكانوا يصعدون إليها بتسع درجات. وفصلوا بين الدارين بجدار من حجر علوه ذراع، وأقاموا قرب الدرجات أعمدةً من رخام كتبوا عليها باليونانية واللاتينية إنذارات للأمم، خلاصتها أن من جاوزها منهم إلى الداخل يُقتل (أفسس ٢: ١٣، ١٤). واتُّهم بولس أنه أدخل يونانيين إلى الهيكل ودنس ذلك الموضع المقدس (أعمال ٢١: ٢٨). وكان اليهود يمارسون العبادة العادية في تلك الدار (لوقا ١٨: ١٠ - ١٤) و(أعمال ٢١: ٢٦ - ٣٠) وكان في جوانبها ثلاثة عشر صندوقاً يضع العابدون فيها عطاياهم (مرقس ١٢: ٤١).
الثالثة: دار إسرائيل، أي دار ذكور العبرانيين، وكانت الدار العظيمة في هيكل سليمان تشتمل على هذه الأقسام الثلاثة (٢أخبار ٤: ٩) وهي أعلى من دار النساء، وكانوا يصعدون إليها من تلك بخمس عشرة درجة، وفصلوا بينهما بجدار ارتفاعه ذراع فيه ثلاثة أبواب.
الرابعة: دار الكهنة، شرق دار إسرائيل وفيها مذبح المحرقة والمرحضة. وغرب هذه الدار كان الهيكل الحقيقي وهو أعلى منها، وكانوا يصعدون إليه باثنتي عشرة درجة. وكان أمامه رواق يتجه إلى الشرق علوه ١٩٠ قدماً، وفي مدخله عمودان: اسم أحدهما ياكين، والثاني بوعز. وقُسم إلى قسمين: الأول القدس، وطوله ٦٠ قدماً وعرضه ٣٠ قدماً، وفيه المنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه ومذبح البخور. والثاني قدس الأقداس، وهو مربع طول كل جانب منه ٣٠ قدماً. وكان حجاب نفيس يفصل بينه وبين القدس (متّى ٢٧: ٥١).
وقد هُدم هذا الهيكل في حصار تيطس لأورشليم بعد الميلاد بسبعين سنة كما تنبأ المسيح (متّى ٢٤: ٢) واجتهد الإمبراطور يوليان أن يبنيه سنة ٣٦٣م، ولم ينجح.
وَأَخْرَجَ كان الذين أخرجهم في دار الأمم. وهذه هي المرة الثانية التي يفعل فيها الأمر نفسه (يوحنا ٢: ١٤، ١٥). وكانوا يتاجرون هناك في حيوانات الذبيحة وكل ما يحتاج إليه العابد للتقدمات من ملح وبخور وزيت وخمر وأمثال ذلك، تسهيلاً لمطالب العبادة. ويحتمل أنهم كانوا يبيعون ما ليس ضرورياً للقرابين، والأرجح أنه كان لرؤساء الكهنة نصيب كبير من ربح تلك التجارة.
مَوَائِدَ أوجبوا أن تكون النقود التي تُدفع في خدمة الهيكل يهودية (خروج ٣٠: ١٣). وكان زوار الهيكل يأتون من ممالك مختلفة بعملات البلاد التي يقيمون فيها، فاحتاجوا إلى الصيارفة ليبدلوها لهم بنقود يهودية. ولا ريب أن في ذلك ربحاً لرؤساء الكهنة يحصلون عليه من الصيارفة. فلما قلَبَ يسوع موائدهم اضطروا أن ينقلوها إلى أماكن أخرى خارج الهيكل.
بَاعَةِ ٱلْحَمَامِ كان الفقراء الذين لا يستطيعون أن يشتروا الغنم والبقر يشترون الحمام للذبيحة (لاويين ٥: ٧ و١٢: ٦ - ٨ و١٤: ٢٢). والظاهر أن المسيح لم يلقَ مقاومةً من أحد على ما فعله من طرد الباعة والصيارفة. ولعل ما فعله لا تستطيعه فرقة من الجنود. والذي حمل المسيح على ذلك العمل كان (١) شدة غيرته لله ولبيته. (٢) أنه أراد أن يعلن للشعب أنه هو المسيح، مصلح ما فسد في الدين إتماماً لنبوة ملاخي (مل ٣: ١، ٢). (٣) رمز إلى ما سيفعله في مجيئه الثاني وإلى فعله الروحي في تنقيته كنيسته وقلب كل مؤمن به، لأن كلاً منهما هيكله. ونذكر ثلاثة أسباب لعدم مقاومتهم إياه: (١) هيئته الخارقة الطبيعة، فإنها أوقعت الرعب في قلوبهم فلم يستطيعوا أن يقاوموه. (٢) مرافقته الجموع الكثيرة له والذين كانوا مستعدين أن يساعدوه على كل شيء. (٣) تبكيت ضمائرهم لهم على أنهم مذنبون بتجارتهم. والشاهد على ذلك أن يسوع أصاب بطردهم.
١٣ «وَقَالَ لَـهُمْ: مَكْتُوبٌ: بَيْتِي بَيْتَ ٱلصَّلاَةِ يُدْعَى. وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةَ لُصُوصٍ».
إشعياء ٥٦: ٧ وإرميا ٧: ١١ ومرقس ١١: ١٧
هذه النبوة من أقوال إشعياء (إشعياء ٥٦: ٧).
بَيْتِي دعا اللهُ الهيكلَ بيته لأنه بُني لعبادته، وتخصص له، وأُجريت فيه مراسيم الدين والعبادة.
بَيْتَ ٱلصَّلاَةِ أُضيف البيت إلى الصلاة دون غيرها من مراسيم الدين لأنها الجزء الأعظم من مراسيم العبادة، ولأن الناس اعتادوا أن يعبِّروا بها عن كل ما بقي من تلك الأمور كالتسبيح وتقديم الذبائح والقرابين وقراءة كلمة الله وشرحها وتفسيرها.
مَغَارَةَ لُصُوصٍ وبخ الله اليهود في زمان إرميا النبي على تدنيسهم بيته بالعبادة الوثنية بهذه العبارة عينها (إرميا ٧: ١١). وكان صراخ الباعة والمشترين وأصوات البهائم ورعاتها في الهيكل تليق بمغارة لصوص يقتسمون فيها المسروقات بالخصام لا ببيت أبيه المقدس. فكأنه قال لهم: دنستم بيتي بتجارتكم حتى صار مثل مغارة اللصوص المتدنسة بفظائعهم.
وجعلوا الهيكل مغارة لصوص لأنهم سلبوا الله حقه إذ اتخذوا المعبد الإلهي سوقاً للكسب المادي. وسلبوا قاصدي العبادة الروحيين الفرصة التي اغتنموها ليرفعوا قلوبهم إلى الله بالصلاة في مقدسه المعين لها. وسلبوا الغرباء أموالهم بأن خدعوهم وغشوهم ببيع مواد التقدمة وصرف النقود.
والمرجح أن المسيح بقي كل هذا النهار (وهو نهار الاثنين) في الهيكل يمنع الناس من تدنيسه حتى قيل «إنه لَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَجْتَازُ الْهَيْكَلَ بِمَتَاعٍ» (مرقس ١١: ١٦) وشغل المسيح الوقت بتعليم الناس، وصنع المعجزات. وكان رؤساء الكهنة وحراس الهيكل في كل تلك المدة ينظرون إليه بالغيظ، ويتآمرون على قتله لأنهم عجزوا عن إيقاع الأذى به وقتها (يوحنا ١٢: ١٩ ومرقس ١١: ١٨).
١٤ «وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ عُمْيٌ وَعُرْجٌ فِي ٱلْهَيْكَلِ فَشَفَاهُمْ».
إشعياء ٣٥: ٥، ٦
عُمْيٌ وَعُرْجٌ كان هؤلاء مجتمعين على جوانب الطرق إلى الهيكل ومداخله، ليطلبوا صدقة من العابدين الداخلين إليه، فتركوا طلب الصدقات ودخلوا دار الهيكل فشفاهم يسوع. ودنس الكهنة بيت الصلاة بأن جعلوه سوق تجارة، أما يسوع فقدسه بأن جعله بيت رحمة. وأظهر بطرده الباعة غيرته لقداسة بيت الله، وأظهر بمعجزاته قوته ورحمته وجوده. فكان صنعه تلك المعجزات جواباً لسؤال الذين سألوا في اليوم السابق «من هذا» (انظر ع ١٠). وصنع المسيح معجزات في أورشليم قبل ذلك ولكن لم يصنعها في الهيكل.
١٥ «فَلَمَّا رَأَى رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةُ ٱلْعَجَائِبَ ٱلَّتِي صَنَعَ، وَٱلأَوْلاَدَ يَصْرُخُونَ فِي ٱلْهَيْكَلِ وَيَقُولُونَ: أُوصَنَّا لابْنِ دَاوُدَ»؟».
اغتاظ رؤساء الكهنة من تأثير أعمال المسيح وتعاليمه في نفوس الشعب، وخافوا من خسارة سلطتهم عليهم، ورأوا في نجاحه موانع من تنفيذ قصدهم قتله (يوحنا ١١: ٥٣، ٥٧) وفهموا جيداً أن قصد يسوع من أعماله هو إثبات كونه المسيح، مُصلح الدين اليهودي الذي أنبأ به إشعياء وملاخي (إشعياء ٤: ٤ ومل ٣: ٣ و٤: ١).
ٱلْعَجَائِبَ في معجزات شفاء المرضى، وطرد الباعة من الهيكل. فتلك زادتهم كراهيةً له بدل أن تقنعهم بصحة دعواه.
ٱلأَوْلاَدَ يَصْرُخُونَ فِي ٱلْهَيْكَلِ أخذ الأولاد يكررون ما هتفت به الجموع عند دخول المسيح أورشليم والهيكل. ودلَّ هذا على احترام الشعب له. ويحتمل أن الأولاد رأوا آيات المسيح وسبحوه لأجلها.
١٦ «وَقَالُوا لَهُ: أَتَسْمَعُ مَا يَقُولُ هٰؤُلاَءِ؟ فَقَالَ لَـهُمْ يَسُوعُ: نَعَمْ! أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ: مِنْ أَفْوَاهِ ٱلأَطْفَالِ وَٱلرُّضَّعِ هَيَّأْتَ تَسْبِيحاً؟».
مزمور ٨: ٢
أَتَسْمَعُ أشاروا بذلك إلى أنه لا يليق أن تسمع أصوات الأولاد في الهيكل، وأنه لا خدمة لهم في العبادة لصغرهم. وقصدوا بذلك توبيخ المسيح على أنه سمح بتقديمهم التسبيح له في ذلك المكان. وقولهم «هؤلاء» يعني قصدهم أنه لا يدعوه «ابن داود» إلا الأولاد الصغار.
أَمَا قَرَأْتُمْ في هذا السؤال شيءٌ من التوبيخ لرؤساء الكهنة والتعريض بغفلتهم عن كتاب الله، لأنهم لو عرفوا كلام الله حق المعرفة ما عثروا في تسبيح الأولاد في الهيكل إكراماً له. والكلام الذي اقتبسه هنا هو في مزمور ١٨: ٢ من الترجمة السبعينية، ومعناه أن الله يفرح بتسبيح الأولاد له إن كان نتيجة تأملهم في خليقته أو في إرساله المسيح فادياً ومخلصاً. فبيَّن بهذا حُسن تقديم ذلك التسبيح ولياقته في هيكله، وقال إن التسبيح له هو تسبيح لله. ولنا من ذلك أن الله يفرح الآن بصلاة الأولاد وتسبيحهم في البيوت وفي مدارس الأحد وفي الكنائس.
١٧ «ثُمَّ تَرَكَهُمْ وَخَرَجَ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا وَبَاتَ هُنَاكَ».
مرقس ١١: ١١ ويوحنا ١١: ١٨
تَرَكَهُمْ أي رؤساء الكهنة.
إِلَى بَيْتِ عَنْيَا وبات هناك إما في بيت لعازر (يوحنا ١١: ١) أو في بيت سمعان الأبرص (مرقس ١٤: ٣). وكانت تلك القرية على سفح جبل الزيتون الشرقي، واشتهرت بأنها وطن لعازر وأختيه مريم ومرثا. وهي تبعد مسيرة نحو ثلاثة أرباع الساعة من أورشليم (يوحنا ١١: ١٨).
١٨ «وَفِي ٱلصُّبْحِ إِذْ كَانَ رَاجِعاً إِلَى ٱلْمَدِينَةِ جَاعَ».
مرقس ١١: ١٢ الخ
كثيراً ما ذكر متّى الحوادث بدون التفات إلى ترتيب وقوعها. وأما مرقس فرتب الحوادث حسب أزمنتها وذكرها تفصيلاً. فنتعلم من بشارة مرقس ما لا نتعلمه من بشارة متّى، وهو أن المسيح لعن التينة في صباح يوم الاثنين عند ذهابه إلى المدينة لكي يطهر الهيكل، وأن التلاميذ شاهدوا أنها يبست في صباح الغد أي يوم الثلاثاء. ومتّى ذكر لعنة التينة ويبسها معاً بغضّ النظر عن أن بينهما يوماً، فذكرها بين حوادث يوم الثلاثاء أي بعد تطهيره الهيكل بيوم.
فِي ٱلصُّبْحِ أي صباح الاثنين على ما قال مرقس ١١: ١٢، ١٥.
جَاع أظهر يسوع ناسوته بجوعه، وأظهر لاهوته بتيبيس الشجرة بكلامه. أظهر شدة غيرته في التعليم في الهيكل بأن ذهب إليه من بيت عنيا قبل أن يتناول طعاماً.
١٩ «فَنَظَرَ شَجَرَةَ تِينٍ عَلَى ٱلطَّرِيقِ، وَجَاءَ إِلَيْهَا فَلَمْ يَجِدْ فِيهَا شَيْئاً إِلاَّ وَرَقاً فَقَطْ. فَقَالَ لَهَا: لاَ يَكُنْ مِنْكِ ثَمَرٌ بَعْدُ إِلَى ٱلأَبَدِ. فَيَبِسَتِ ٱلتِّينَةُ فِي ٱلْحَال».
عَلَى ٱلطَّرِيقِ كانت تلك الشجرة مباحة لأبناء السبيل.
جَاءَ إِلَيْهَا لا يلزم الفهم من ذلك أن المسيح لم يعرف أنها غير مثمرة، فقصد أن يعلم التلاميذ مثالاً أخلاقياً بواسطة تلك الشجرة، ففعل كما يفعل غيره من الناس في مثل تلك الأحوال، فوجدها كثيرة الأوراق، فاتخذ ذلك دليلاً على أن عليها شيئاً من باكورة التين. لأنه من المعلوم أن التين في فلسطين يثمر مع الأوراق، ويُنضج أحياناً بعض الثمر قبل غيره بأيام ليست قليلة.
وجاء في مرقس أنه لم يكن وقت التين أي وقت نضجه العام. وقال ذلك بياناً لقوله إن المسيح «جاء لعله يجد فيها شيئاً» أي بعضاً من باكورة التين. وإذ لم يكن وقت التين كان يقتضي أن لا يكون زمان الورق، فوجود الورق قبل حينه في تلك التينة يعني أنها مثمرة قبل الأوان.
وَرَقاً فَقَطْ أي لم يجد شيئاً من الثمر الفج، ولا من الثمر الناضج، ولا إشارة على أنها ستثمر.
وتلك الشجرة الكثيرة الورق الخالية من الثمر المبكر والمتأخر رمزٌ: (١) إلى المنافق لأنه يدَّعي زيادة التقوى ولا يعمل شيئاً من أعمالها لمجد الله ولخير الناس. (٢) إلى الأمة اليهودية التي ادَّعت أنها الأمة المنفردة بالقداسة على الأرض، لأن لها الشريعة والهيكل والشعائر الدينية من الصوم والأعياد والذبائح الصباحية والمسائية، ومع ذلك فهي خلت من الإيمان والمحبة والقداسة والتواضع والاستعداد لقبول المسيح وطاعة أوامره. فافتخرت بكونها شعب الله الخاص ورفضت ابنه الذي أرسله. (٣) إلى كل إنسان أو كنيسة أو أمة تدَّعي القداسة ولم تأت بأثمار تليق بالتوبة والإيمان (انظر أيضاً مثل شجرة التين في لوقا ١٣: ٦ - ٩).
لاَ يَكُنْ مِنْكِ ثَمَرٌ خاطب الشجرة كأنها تدرك وكأنها أذنبت. وقصد بذلك إفادة البشر. فلا نظن أن المسيح فعل هذا غضباً، بل هو قصد أن يعلّم البشر بمثال منظور كما علمهم كثيراً قبل ذلك بأمثلة مسموعة. ولا فرق بين الرؤيا وهذا المثال، إلا في أن الرؤيا تكون أثناء النوم، وهذا كان في اليقظة. والمسيح لعن الشجرة لا لأنها بلا ثمر، بل لأنها لكثرة أوراقها كأنها ادَّعت الإثمار كذباً. وكان دعاء المسيح على تلك الشجرة نبوَّة بمستقبل الأمة اليهودية، فشتاتها في كل البلاد (مثل أغصان من تلك التينة) هو إنذار للناس في كل عصر بوقوع دينونة الله عليهم إن لم يأتوا بثمار القداسة، لأنهم كأغصان الكرم التي ينزعها الكرام ويحرقها (يوحنا ١٥: ٢، ٦) ومثل «أَشْجَارٌ خَرِيفِيَّةٌ بِلاَ ثَمَرٍ مَيِّتَةٌ مُضَاعَفًا، مُقْتَلَعَةٌ» (يهوذا ١٢). وهو إنذار لكل الكنائس غير المثمرة ككنيسة أفسس (رؤيا ٢: ٥).
فَيَبِسَتِ فِي ٱلْحَال نفهم من ذلك أن التينة أخذت تيبس من تلك الساعة. ويُحتمل أن التلاميذ شاهدوا حينئذ الأوراق تذبل. على أن التلاميذ لما رجعوا مساءً إلى بيت عنيا لم يلاحظوا ما أصابها من التغيير، ولكنهم رأوا ذلك في الغد (أي يوم الثلاثاء) وهم راجعون إلى أورشليم (مرقس ١١: ٢٠). فسرعة يبس الشجرة إشارة إلى خراب أورشليم وعقاب الأمة اليهودية.
ويتضح لنا من هذا ثلاثة أمور: (١) معجزة إظهار قوة المسيح وهو تيبيس الشجرة بكلمة. (٢) مثل لبيان عقاب المنافقين. (٣) النبوة بخراب أورشليم.
صنع المسيح آيات كثيرة أظهر بها الرحمة. وهذه هي الآية الوحيدة التي أظهر بها العقاب فعلّم بها أنه يُجري العدل والقضاء كما يمنح الرحمة. وقد علّم مثال الدينونة بألطف الطرق، بأن ضرب تلك الشجرة، وهي جسم بلا شعور، ومبذولة لكل عابر سبيل فلم يتلف مالاً خاصاً. وتلك الشجرة عقيمة لا نفع منها للعامة فلم يتلف مالاً عاماً.
٢٠ «فَلَمَّا رَأَى ٱلتَّلاَمِيذُ ذٰلِكَ تَعَجَّبُوا قَائِلِينَ: كَيْفَ يَبِسَتِ ٱلتِّينَةُ فِي ٱلْحَالِ!».
مرقس ١١: ٢٠
لَمَّا رَأَى ٱلتَّلاَمِيذُ كان ذلك في يوم الثلاثاء. وما سبق في ع ١٨، ١٩ كان في يوم الاثنين، فجمع متّى حوادث اليومين وقصها جملة.
تَعَجَّبُوا من سرعة تأثير فعل المسيح في التينة. كانت خضراء فأصبحت يابسة كأنها ماتت منذ سنين، وذلك بكلمة فقط. والذي نطق بكلمات التعجب هو بطرس، فكان نائباً عن سائر الرسل كعادته (مرقس ١١: ٢١).
٢١ «فَأَجَابَ يَسُوعُ: ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ كَانَ لَكُمْ إِيمَانٌ وَلاَ تَشُكُّونَ، فَلاَ تَفْعَلُونَ أَمْرَ ٱلتِّينَةِ فَقَطْ، بَلْ إِنْ قُلْتُمْ أَيْضاً لِهٰذَا ٱلْجَبَلِ: ٱنْتَقِلْ وَٱنْطَرِحْ فِي ٱلْبَحْرِ فَيَكُون»
متّى ١٧: ٢٠ ولوقا ١٧: ٦ و١كورنثوس ١٣: ٢ ويعقوب ١: ٦
لم يذكر المسيح شيئاً مما قصد بلعنه الشجرة، وترك ذلك لتأمل التلاميذ. وبيَّن لهم قوة الإيمان بتأثير كلامه في التينة. والإيمان المقصود هنا هو الإيمان الضروري لعمل المعجزات. وقد شاهد التلاميذ قوة المسيح بتلك المعجزة، فأكد لهم أنهم يستطيعون أعظم منها إن آمنوا به وقرنوا إيمانهم بالصلاة.
لِهٰذَا ٱلْجَبَلِ: ٱنْتَقِل الخ هذا الكلام جارٍ مجرى المثل، يراد به المستحيل على القوة البشرية، وذلك مثل ما جاء في قول بولس للكورنثيين (١كورنثوس ١٣: ٢) راجع شرح متّى ١٧: ٢٠. وأراد بالجبل هنا جبل الزيتون وبالجبل في ص ١٧ جبل الشيخ. إن نقل الجبال سهل على الله كإبراء المريض، ومع ذلك لم ينقل جبلاً لأنه ليس من مواضيع صلاة الإيمان. على أن إزالة الأمة اليهودية، والمملكة الرومانية وديانتها الوثنية من أمام الإنجيل، أعظم برهان على قوة الله ونعمته. إنها أعظم من نقل جبل حرمون وجبل الزيتون معاً وطرحهما في البحر. وهذا تم فعلاً. وأكد المسيح أنهم يتغلبون على كل الموانع في سبيل تأسيس الكنيسة.
ومعلوم أن قوة الله غير محدودة، وأن الرسل يستطيعون أن ينالوا على قدر إيمانهم. فإذا كان لهم إيمان لا يعجزون عن صنع شيء من العجائب مهما كان عظيماً، إن كان ضرورياً لنجاح الإنجيل.
٢٢ «وَكُلُّ مَا تَطْلُبُونَهُ فِي ٱلصَّلاَةِ مُؤْمِنِينَ تَنَالُونَهُ».
متّى ٧: ٧ ومرقس ١١: ٢٤ ولوقا ١١: ٩ ويعقوب ٥: ١٦ و١يوحنا ٣: ٢٢ و٥: ١٤
علم المسيح تلاميذه في هذا العدد ما يمكنهم أن يحصلوا به على مساعدة تلك القوة غير المتناهية، وهو الصلاة والإيمان معاً لا أحدهما دون الآخر. ولم يقصد المسيح بهذا القول غير تلاميذه الاثني عشر، ولم يعدهم إلا في نشرهم إنجيله ومقاومة أعدائه. فمن الضروري أن ذلك الوعد مقيد بشرط أنهم لا يطلبون إلى الله شيئاً لا يليق أن يمنحهم إياه.
كُلُّ مَا أي كل ما هو ضروري لإجراء أعمالهم الرسولية وموافق لإرادة الله.
٢٣ «وَلَمَّا جَاءَ إِلَى ٱلْهَيْكَلِ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَشُيُوخُ ٱلشَّعْبِ وَهُوَ يُعَلِّمُ، قَائِلِينَ: بِأَيِّ سُلْطَانٍ تَفْعَلُ هٰذَا، وَمَنْ أَعْطَاكَ هٰذَا ٱلسُّلْطَانَ؟».
مرقس ١١: ٢٧ ولوقا ٢٠: ١ وخروج ٢: ١٤ وأعمال ٤: ٧ و٧: ٢٧
أتى يسوع في ذلك اليوم (يوم الثلاثاء) إلى الهيكل وبدأ يعلم الشعب كما فعل في يوم الاثنين. وكان مكان تعليمه موافقاً لاجتماع الشعب، وذلك إما دار الأمم أو دار إسرائيل الداخلية. وكان ذلك اليوم آخر يوم من أيام تعليمه العلني على الأرض، وهو من أهم أيام حياته.
رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَشُيُوخُ ٱلشَّعْبِ اجتمعوا سابقاً وتآمروا في اتخاذ أحسن الوسائل ليصطادوه أو يجدوا علة يشتكون بها عليه إلى المجلس اليهودي الكبير، أو إلى الوالي الروماني (لوقا ١٩: ٤٧، ٤٨). ويظهر من النتيجة أنهم اتفقوا في تلك المؤامرة على أن يرسلوا إليه أناساً من فرق اليهود المختلفة، يسألونه أسئلة مخادعة ليوقعوه بها. وكان أول تلك المسائل قولهم:
بِأَيِّ سُلْطَان سأله رؤساء اليهود الدينيين وحراس الهيكل هذا السؤال، وكان لهم حق شرعي في مراقبة الأعمال التي تجري في الهيكل. فأتى يسوع المدينة راكباً باحتفال الجموع الهاتفين بقولهم «أُوصنا» ودخل الهيكل وادَّعى أن له حقاً أن ينظم ويصلح الأمور فيه، مع أنه لم يكن من الكهنة الذين هم بنو لاوي، وليس له سلطان على ذلك من الحبر الأعظم ولا من الوالي الروماني.
تَفْعَلُ هٰذَا أي طرد من يبيع ويشتري في الهيكل، ومنع كل من يمر بمتاع وتعليمه فيه. فأقام لهم برهاناً كافياً على أنه نبي مرسل من الله بالمعجزات التي صنعها أمام عيونهم. فأظهروا أنهم لم يقتنعوا بذلك البرهان، وطالبوا بغيره. ولم يفعلوا ذلك بإخلاص بل بمكر ليجدوا عليه ما يمكنهم من الشكوى عليه بأنه يجدف. فحاولوا أن يحصلوا على الجواب الذي حصل عليه قيافا بعد ذلك بسؤال صريح، وهو قوله إنه ابن الله (متّى ٢٦: ٦٣، ٦٤).
٢٤ - ٢٦ «٢٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ: وَأَنَا أَيْضاً أَسْأَلُكُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ قُلْتُمْ لِي عَنْهَا أَقُولُ لَكُمْ أَنَا أَيْضاً بِأَيِّ سُلْطَانٍ أَفْعَلُ هٰذَا: ٢٥ مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا، مِنْ أَيْنَ كَانَتْ؟ مِنَ ٱلسَّمَاءِ أَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ؟ فَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ قَائِلِينَ: إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ، يَقُولُ لَنَا: فَلِمَاذَا لَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ؟ ٢٦ وَإِنْ قُلْنَا: مِنَ ٱلنَّاسِ، نَخَافُ مِنَ ٱلشَّعْبِ، لأَنَّ يُوحَنَّا عِنْدَ ٱلْجَمِيعِ مِثْلُ نَبِيّ».
متّى ١٤: ٥ ومرقس ٦: ٢٠ ولوقا ٢٠: ٦
أجابهم يسوع بحكمة فلم يمنحهم فرصة للشكوى. ولم يرد بسؤاله أن يتخلص من الإجابة، إنما سألهم لأن جواب سؤالهم ضمن جواب سؤاله.
مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا القصد بمعمودية يوحنا كل خدمته، أي تعليمه الذي كانت المعمودية إشارة إليه وختماً له.
مِنَ ٱلسَّمَاءِ أي من الله. فإن أجابوا بالحق أن معمودية يوحنا من السماء، أي أنه نبي، ففي ذلك جواب لسؤالهم، لأن يوحنا شهد أن ليسوع سلطان المسيح التام (يوحنا ١: ٢٧، ٢٩، ٣٤ و٣: ١٣).
فَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ الأرجح أنهم فكروا في ما بينهم. ولم يكن تفكيرهم ليجاوبوه بما اعتقدوه حقاً، بل ليجهزوا جواباً وفق أهوائهم. فرأوا أنهم إن قالوا إن يوحنا نبي يدينون أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا بتعليمه وبشهادته ليسوع أنه المسيح. وإن قالوا إنه ليس نبياً حكموا أنه كاذب، فيهيج عليهم الشعب ويرجمونهم، لأنهم يعتبرون يوحنا نبياً عظيماً صادقاً (لوقا ٢٠: ٦ ويوحنا ٧: ٢٧).
٢٧ «فَأَجَابُوا يَسُوعَ: لاَ نَعْلَمُ. فَقَالَ لَـهُمْ هُوَ أَيْضاً: وَلاَ أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيِّ سُلْطَانٍ أَفْعَلُ هٰذَ».
إشعياء ٢٩: ١٠ - ١٢ وكولوسي ١: ١٩، ٢٨
لم يبق لهم سبيل للتخلص إلا بأن يدَّعوا الجهل، فاعترفوا أنهم لا يستطيعون أن يحكموا في أمر يوحنا المعمدان، وثبت أنهم غير أكفاء لأن يحكموا في دعوى المسيح.
لاَ نَعْلَمُ والصحيح أنهم لم يريدوا أن يظهروا اعتقادهم، فقد اعتقدوا أن معمودية يوحنا من الناس. وعلم المسيح رياءهم ولم يجبهم إلا بالسؤال الذي أفحمهم. ولا شك أنهم خجلوا كثيراً لأنهم اضطروا أن يعترفوا بالجهل بعد أن أرسلوا من أورشليم إلى يوحنا لجنة من الكهنة واللاويين للنظر في دعواه (يوحنا ١: ١٩).
وَلاَ أَنَا أَقُولُ لأني سكنت الرياح وأمواج البحر بأمري، ومشيت على الماء كما على اليابسة، وأشبعت ألوفاً من الناس من بضعة أرغفة، وشفيت كل أنواع الأمراض بكلمتي أو لمس يدي، وأخرجت الشياطين، وأقمت الموتى. وهذه براهين قاطعة على أن لي سلطاناً إلهياً به فعلت كل ما فعلت، ومع كل هذا لم تؤمنوا. فما فائدة الكلام!
فنرى من ذلك أن الحق واحد لا يتجزأ. ولا يصح أن يقبل الإنسان جزءاً منه ويترك باقيه. لقد رفضوا دعوى يسوع وامتنعوا عن قبول دعوى المعمدان! ويورد بعض الناس المسائل الدينية متظاهرين أنهم يطلبون الفائدة وهم يبطنون الكفر.
٢٨ «مَاذَا تَظُنُّونَ؟ كَانَ لإِنْسَانٍ ٱبْنَانِ، فَجَاءَ إِلَى ٱلأَوَّلِ وَقَالَ: يَا ٱبْنِي، ٱذْهَبِ ٱلْيَوْمَ ٱعْمَلْ فِي كَرْمِي».
أورد المسيح للكتبة والفريسيين ثلاثة أمثال بيَّن لهم في الأول خطيتهم، وفي الثاني عقابهم، وفي الثالث عاقبة كفرهم وعصيانهم لأمتهم ومدينتهم.
مَاذَا تَظُنُّونَ؟ سأل الكتبة هذا السؤال ليدينوا أنفسهم بجوابهم له، كما دان داود نفسه بجوابه لناثان. فلم يكتفِ بدفعهم عنه عندما تحاملوا عليه، بل حمل عليهم بما سيأتي من الأمثال، ليبيِّن إثمهم لعدم إيمانهم به.
ٱبْنَان أراد بالاثنين قسمي الناس الذين بلغتهم تعاليمه. فأحدهما أشرار لم يدَّعوا أنهم يطيعون الله، وتعدوا الشريعة علانية بلا حياء، كالعشارين والزناة. والقسم الثاني هم الذين حاولوا أن يبرروا أنفسهم بأعمال الناموس، كالكتبة والفريسيين، فامتنعوا عن الشر ظاهراً وافتخروا بتقواهم. ويبدو للمشاهد أن القسم الثاني أفضل من القسم الأول، لأن البر الذي في الناموس خير من عدم البر. وهذا المثل عن صاحب كرم يعتني بكرمه هو وعائلته. والقصد برب الكرم الله، وبالكرم العالم (متّى ١٣: ٣٨). وبالابنين ما ذكرناه، وبدعوة أبيهما إلى العمل دعوة الله للناس إلى العمل معه (١كورنثوس ٣: ٩).
ٱلأَوَّلِ أراد به العشارين والزناة.
ٱعْمَلْ فِي كَرْمِي ذلك ما يحق لصاحب الكرم أن يأمر ابنه به، وفيه إشارة إلى أن لله حقاً أن يأمر الناس بخدمته. وأعظم ما يأمر الله به قبول ابنه (يوحنا ٦: ٢٩). والذي أمر به رب الكرم ابنه شفاهاً يأمرنا به الله بكتابه، وبروحه، مخاطباً ضمائرنا.
٢٩ «فَأَجَابَ: مَا أُرِيدُ. وَلٰكِنَّهُ نَدِمَ أَخِيراً وَمَضَى».
مَا أُرِيدُ هذا دليل على العصيان والاستخفاف والجسارة، لأنه لم يكلف نفسه عناء تقديم عذر. وما قاله هذا الابن هو قول لسان حال العشارين والزناة.
نَدِمَ أَخِيراً وَمَضَى أي ذهب إلى الكرم وعمل فيه بالرضى والأمانة كما أمره أبوه. وهكذا فعل العشارون والزناة بالتوبة والطاعة عند تبشير يوحنا المعمدان، كما شهد المسيح لهم في ع ٣٢ فاعتمدوا منه (لوقا ٧: ٢٩). وأتى كثيرون منهم إلى المسيح (لوقا ١٥: ١) فاتضع الذين كانوا عصاة وأطاعوا بنعمة الله والإصغاء إلى ضمائرهم. وظهر من هذا العدد قيمة الندامة. فإذا ندم أو تاب شر الخطاة قبله الله. وظهر منه أيضاً برهان التوبة الحقيقية، وهو العمل لا الكلام ولا الدموع.
٣٠ «وَجَاءَ إِلَى ٱلثَّانِي وَقَالَ كَذٰلِكَ. فَأَجَابَ: هَا أَنَا يَا سَيِّدُ. وَلَمْ يَمْضِ».
متّى ٢٣: ٣ وتيطس ١: ١٦
لم يرد بتقديم ذكر أحد الابنين على الآخر أن الدعوة وُجِّهت لأحدهما قبل الآخر، إنما أراد أن الاثنين دُعيا دعوة واحدة.
هَا أَنَا هذا جواب الابن الثاني، وهو جواب رياء لا جواب إخلاص، لأنه لم يقصد العمل وأجاب بما ذكر ستراً لما قصده من العصيان. ودليل ذلك أن المسيح ذكر أنه قال «ها أنا، ولم يمضِ» فلم يقل إنه ندم على قوله كما قال الأول. وفي ذلك إشارة إلى ما فعله الكتبة والفريسيون، فإنهم ادعوا شديد الغيرة لشريعة الله، وتظاهروا بالاستعداد التام للطاعة الكاملة لأوامره، ولكنهم عصوها بدليل قول المسيح عنهم «يَقْتَرِبُ إِلَيَّ هذَا الشَّعْبُ بِفَمِهِ، وَيُكْرِمُني بِشَفَتَيْهِ، وَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُبْتَعِدٌ عَنِّي بَعِيدًا» وقوله «حَسَبَ أَعْمَالِهِمْ لاَ تَعْمَلُوا، لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ وَلاَ يَفْعَلُونَ» (متّى ١٥: ٨ و٢٣: ٢) فقد اقتصروا على حفظ طقوس الشريعة وأعرضوا عن فضائلها، وقاوموا الله في تأسيس ملكوته الإنجيلي، وعزموا على قتل ابنه.
وَلَمْ يَمْضِ الله لا يقبل الإقرار بالطاعة والتقوى إذا لم يقترن بالعمل. وهذا مثال لما فعله الفريسيون بادعائهم التقوى ادعاء الابن الثاني بقوله «ها أنا». وعدم مضيه مثالٌ لما فعلوه يوم دعاهم الله أولاً إلى التوبة بلسان يوحنا المعمدان، وثانياً بلسان يسوع المسيح.
٣١ «فَأَيُّ ٱلاثْنَيْنِ عَمِلَ إِرَادَةَ ٱلأَبِ؟ قَالُوا لَهُ: ٱلأَوَّلُ. قَالَ لَـهُمْ يَسُوعُ: ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلزَّوَانِيَ يَسْبِقُونَكُمْ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللّٰهِ».
لوقا ٧: ٢٩، ٥٠
إِرَادَةَ ٱلأَبِ هي الطاعة لأمره بالذهاب إلى كرمه والعمل فيه. وأراد بها حفظ كل شريعة الآب السماوي المعلنة في كتابه والاجتهاد في سبيل ملكوته.
قَالُوا لَهُ: ٱلأَوَّل أجابوا بالصواب، ولم يشعروا بأنهم دانوا أنفسهم بتلك الإجابة لأنهم لم يفهموا قصد المسيح بالمثل. ولا عجب من أنهم لم يشعروا بذلك، لأن الذين يرفعون لله صلوات شكر أنهم أفضل من باقي الناس لا يشعرون بأنهم يشبهون الابن الذي قال «ها أنا يا سيد» ولم يمضِ. فالأول هو الذي أطاع دون الثاني. كان الأول رديء القول جيد العمل. وكان الثاني جيد القول رديء العمل.
قَالَ لَـهُمْ يَسُوعُ أوضح المسيح للفريسيين ما لم يفهموه من ذلك المثل، وما قصده بالابنين.
يَسْبِقُونَكُمْ إلى دخول الملكوت السماوي. أي أن رجاء دخول العشارين والزناة ذلك الملكوت أقوى من رجاء دخول الفريسيين إليه، لأن كبرياء الفريسيين واتكالهم على البر الذاتي جعلاهم يبقون خارج ذلك الملكوت غير مبالين بالملجأ الذي أعده الله للنجاة من غضبه الآتي على العالم الساقط في هاوية الخطية. وأما العشارون فشعروا بإثمهم، وأن لا شيء لهم من البر الذاتي، فبادروا إلى الهروب من ذلك الغضب إلى ملجأ بر المسيح الكامل وفدائه (متّى ٩: ٩ ولوقا ٧: ٢٩ و٣٧ - ٥٠ و١٥: ١، ٢ و١٩: ٢، ٩، ١٠).
٣٢ «لأَنَّ يُوحَنَّا جَاءَكُمْ فِي طَرِيقِ ٱلْحَقِّ فَلَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ، وَأَمَّا ٱلْعَشَّارُونَ وَٱلزَّوَانِي فَآمَنُوا بِهِ. وَأَنْتُمْ إِذْ رَأَيْتُمْ لَمْ تَنْدَمُوا أَخِيراً لِتُؤْمِنُوا بِه».
متّى ٣: ١ الخ و٢بطرس ٢: ٢، ٢١ ولوقا ٣: ١٢، ١٣
طَرِيقِ ٱلْحَقّ أي الطريق الحقيقية لنوال البر، وهي التوبة والإيمان بالمسيح الذي شهد له يوحنا أنه «الطريق والحق والحياة» (يوحنا ١٤: ٦)
فَآمَنُوا بِه أي بتعليم وجوب التوبة، وبشهادته أن يسوع هو المسيح.
وَأَنْتُمْ إِذْ رَأَيْتُمْ في هذا تلميح إلى أنه كان يجب على الفريسيين أن يرغبوا في التوبة اقتداءً بالعشارين.
لَمْ تَنْدَمُوا أشار المسيح بذلك إلى أن الله يرفض بر الفريسيين الذي افتخروا به، وأنهم محتاجون إلى التوبة كالعشارين. ولا يلزم أن يفهم من هذا العدد أن كل العشارين تابوا، ولا أنه لم يتب أحد من الفريسيين. إنما القصد أن الذين آمنوا كانوا ممن قبلوا الرسالة، من أمثال متّى وزكا من العشارين، ونيقوديموس ويوسف الرامي ثم بولس من الفريسيين.
ولم يعلّم المسيح بهذا المثل أن رجاء خلاص الشرير والمنافق المشهور برذائله أقوى من رجاء خلاص الذي سيرته الظاهرة حسنة. إنما أراد أن يوضح أن الأمل في خلاص أثيم إذا تاب وترك كل خطاياه هو أقوى من الأمل بنجاة الذي يتظاهر بالفضيلة دون أن يترك خطاياه القلبية من الكبرياء على البر الذاتي.
٣٣ «اِسْمَعُوا مَثَلاً آخَرَ: كَانَ إِنْسَانٌ رَبُّ بَيْتٍ غَرَسَ كَرْماً، وَأَحَاطَهُ بِسِيَاجٍ، وَحَفَرَ فِيهِ مَعْصَرَةً، وَبَنَى بُرْجاً، وَسَلَّمَهُ إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَرَ».
مزمور ٨٠: ٨ - ١١ ونشيد الأنشاد ٨: ١١ وإشعياء ٥: ١ الخ وإرميا ٢: ٢١ ومرقس ١٢: ١ الخ ولوقا ٢٠: ٩ الخ، متّى ٢٥: ١٤، ١٥
اِسْمَعُوا مَثَلاً آخَرَ في هذا تلميح إلى أن الفريسيين أرادوا الانصراف عن المسيح، فلم يسمح لهم بذلك قبل أن يسمعهم كلام التوبيخ والإنذار. وأبان لهم في هذا المثل العقاب الذي سيجلبونه على أنفسهم بعصيانهم.
إِنْسَانٌ رَبُّ بَيْتٍ رمز برب البيت إلى الله.
غَرَسَ كَرْماً القصد بالكرم ملكوت الله على الأرض، أي كنيسته التي سلمها أولاً إلى شعب العبرانيين وسماها كرمة (مزمور ٨٠: ٨ وإشعياء ٣: ١ وحزقيال ١٥: ٢) وقوله «غرس كرماً» يدل على أن الله مؤسس الكنيسة، علاوة على أنه ربها. فدعا أولاً إبراهيم من بين النهرين وبدأ تأسيس الكنيسة في عائلته. ثم أتى بنسله من مصر وأسكنه أرض كنعان وفرض لهم رموزاً امتازوا بها عن سائر الأمم كما يمتاز الكرم بسياجه عن غيره من الأراضي، وحماهُ بعنايته (إشعياء ٢٦: ١ و٢٧: ٣ وزكريا ٢: ٥) وفعل ذلك كله ليجعله شعباً مقدساً مثمراً في كل عمل صالح.
أَحَاطَ... وَحَفَرَ ... وَبَنَى أي فعل كل ما يُنتظر من أصحاب الكروم. وزاد على ذلك ليكن ذلك الكرم مخصباً محفوظاً. وفي ذلك إشارة إلى أن الله لم يترك شيئاً مما يقتضيه صلاح الكرم الروحي أي كنيسته اليهودية حتى صح قوله «ماذا يُصنع أيضاً لكرمي وأنا لم أصنعه له» (إشعياء ٥: ٤). وأشار بولس إلى هذه الوسائط بقوله «الَّذِينَ هُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ، وَلَـهُمُ التَّبَنِّي وَالْمَجْدُ وَالْعُهُودُ وَالاشْتِرَاعُ وَالْعِبَادَةُ وَالْمَوَاعِيدُ» (رومية ٩: ٤).
سَلَّمَهُ إِلَى كَرَّامِينَ من عادة أرباب الحقول والكروم أن يسلموها إلى فعلة بشرط أن يؤدوا لأصحابها جزءاً من الثمر. وعلى هذا سلم الله ملكوته أولاً إلى الأمة العبرانية. فكانوا بالنسبة إليه كالفعلة إلى رب الكرم. وكانوا علاوة على ذلك قد عاهدوا الله على أن يكونوا شعبه (خروج ١٩: ٣ - ٨) فكان عصيانهم خيانة ونكثاً بالوعود.
وَسَافَرَ رَمز بحضور رب الكرم وسفره إلى إظهار وجود الله واحتجابه. فلما كان بنو إسرائيل في البرية، ولا سيما يوم كانوا أمام سيناء، أظهر الله لهم حضوره بأمور كثيرة، فكلمهم بصوت مسموع، وسار أمامهم أربعين سنة بعمود السحاب والنار، وأعطاهم المن من السماء كل تلك المدة، وكان يعاقبهم على عصيانهم وتذمرهم في وقته. فيصحُّ أن يُقال إنه كان حاضراً بينهم في كل تلك المدة. ولكن بعد إقامتهم بأرض كنعان ارتفعت عنهم تلك العلامات الظاهرة امتحاناً لهم، ليرى: هل يطيعون هم أوامره أم لا. وعلى هذا يسوغ أن يقال إنه احتجب عنهم. فكلما أمهل الله الخاطئ في هذه الأرض يصح أن يقال إنه بعُد عنه (٢بطرس ٣: ٣، ٤).
٣٤ «وَلَمَّا قَرُبَ وَقْتُ ٱلأَثْمَارِ أَرْسَلَ عَبِيدَهُ إِلَى ٱلْكَرَّامِينَ لِيَأْخُذَ أَثْمَارَهُ».
وَقْتُ ٱلأَثْمَارِ لجني أثمار الكرم الحقيقي وقت معين في كل سنة، ولله كل الحق أن يسأل شعبه ثمار الشكر والطاعة والعبادة والمحبة في كل حين (لوقا ١٣: ٧ ويوحنا ١٥: ٢، ٥، ٨) ويحتمل أن يراد بوقت الأثمار المدة التي تقضَّت على بني إسرائيل بعد إقامتهم بأرض كنعان وانتصارهم على أعدائهم، لأنه كان لهم حينئذ فرصة للتأمل في إتمام الله مواعيده لآبائهم، وإجرائه معجزاته لأجلهم منذ إخراجهم من مصر، ولإظهار ما استفادوه من تعليمه وتأديبه.
عَبِيدَهُ أشار بذلك إلى الأنبياء الذين دعوا الناس إلى الله وحده، ونهوهم عن الآلهة الباطلة. ولم يُرد بأولئك العبيد الأنبياء الذين أرسلهم في وقت واحد، بل الذين أرسلهم في أزمنة مختلفة منذ كان اليهود أُمة.
لِيَأْخُذَ أَثْمَارَهُ لم يسأل الله الناس أكثر مما يحق له أن يطلبه، فيطلب ثمار البر على قدر ما يعطيهم من وسائط النعمة وفرص التوبة والبركات الروحية، وذلك مثل قوله «أَرْسَلْتُ إِلَيْكُمْ كُلَّ عَبِيدِي الأَنْبِيَاءِ مُبَكِّرًا وَمُرْسِلاً قَائِلاً: لاَ تَفْعَلُوا أَمْرَ هذَا الرِّجْسِ الَّذِي أَبْغَضْتُهُ» (إرميا ٤٤: ٤).
٣٥، ٣٦ «٣٥ فَأَخَذَ ٱلْكَرَّامُونَ عَبِيدَهُ وَجَلَدُوا بَعْضاً وَقَتَلُوا بَعْضاً وَرَجَمُوا بَعْضاً. ٣٦ ثُمَّ أَرْسَلَ أَيْضاً عَبِيداً آخَرِينَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلأَوَّلِينَ، فَفَعَلُوا بِهِمْ كَذٰلِكَ».
٢أخبار ٢٤: ٢٠، ١ ونحميا ٢٩: ٢٦ ومتّى ٥: ١٢ و٢٣: ٣٤ الخ وأعمال ٧: ٥٢ و١تسالونيكي ٢: ١٥ وعبرانيين ١١: ٣٦، ٣٧
أشار بذلك إلى معاملة الشعب العبري أنبياء الله (١صموئيل ٢٢: ١٥ و١ملوك ٩: ١٠ و٢٢: ٢٤، ٢٧ و٢أخبار ٢٤: ١٩ - ٢١ و٣٦: ١٦ ونحميا ٩: ٢٦ وإرميا ٣٧: ١٥، ١٦ ولوقا ١٣: ٢٤ وعبرانيين ١١: ٣٧ ورؤيا ١٦: ٦ و١٨: ٢٤).
٣٧ «فَأَخِيراً أَرْسَلَ إِلَيْهِمُ ٱبْنَهُ قَائِلاً: يَهَابُونَ ٱبْنِي».
أَرْسَلَ إِلَيْهِمُ ٱبْنَهُ الأمر الجوهري في هذا المثل توضيح ما بلغه الكرامون من الشر، وهو أنهم أهانوا ابنه علاوة على إهانتهم عبيده المرسلين الأولين. إرسال رب الكرم ابنه كان نهاية الوسائط، إذ رأى أنه لا نفع من إرسال عبيد آخرين. كذلك الله إذ لم يجد نفعاً في إرسال أنبياء آخرين، لأن اليهود اضطهدوا الأنبياء الأولين وقتلوهم، أرسل ابنه الحبيب الذي كان عليهم أن يقبلوه بإكرام كما يقبلون الآب (يوحنا ٣: ١٦، ١٧ و٥: ٢٣ ورومية ٨: ٣، ٣٢ وغلاطية ٤: ٤ و١يوحنا ٤: ٩، ١٤). وإرسال الله ابنه ليموت عن الناس دليل على أنه «لاَ يَشَاءُ أَنْ يَهْلِكَ أُنَاسٌ، بَلْ أَنْ يُقْبِلَ الْجَمِيعُ إِلَى التَّوْبَةِ» (٢بطرس ٣: ٩).
يَهَابُونَ ٱبْنِي أي يستحون ويخافون أن يعاملوه كما عاملوا العبيد، فيسمعون له ويطيعونه كما يليق بشرفه ومقامه. فالمسيح أثبت في ذلك أفضليته على كل الأنبياء في كل عصر. لكنه أثبتها بطريق لم يستطع بها الفريسيون أن يثبتوا عليه التجديف بدعواه أنه ابن الله كما كانت غاية مراقبتهم له. ومشابهة الجسديات للروحيات ناقصة، لأن رب الكرم في المثل جهل مقاصد الكرامين الشريرة حين أرسل ابنه إليهم، ظناً منه أنهم سيكفون بذلك عن عصيانهم. وأما الله فعلم منذ الأزل كيف يعامل الناس ابنه، ولكنه أرسله لكيلا يبقى لهم عذر.
٣٨ «وَأَمَّا ٱلْكَرَّامُونَ فَلَمَّا رَأَوْا ٱلابْنَ قَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ: هٰذَا هُوَ ٱلْوَارِثُ. هَلُمُّوا نَقْتُلْهُ وَنَأْخُذْ مِيرَاثَهُ».
مزمور ٢: ٨ وعبرانيين ١: ٢ ومزمور ٢: ٢ ومتّى ٢٦: ٣ و٢٧: ١ ويوحنا ١١: ٥٣ وأعمال ٤: ٢٧
تآمر الكرامون بالشر على الابن عندما رأوه خلافاً لما توقعه رب الكرم منهم. وفعلوا ذلك إما لأنهم لم يخافوا رجوع رب الكرم، أو لأنهم أغمضوا عيونهم عن النظر في عاقبة شرهم. كذلك تآمر اليهود على قتل المسيح ورفضوا أنه مسيحهم وملكهم، فعرَّضوا أنفسهم لعواقب أفعالهم الهائلة. لقد تشاور اليهود على قتل المسيح وفق هذا المثل (يوحنا ١١: ٤٧ - ٥٣). ومثله تآمر إخوة يوسف عليه وهو قادم إليهم (تكوين ٣٧: ١٩) فظنوا أنهم يبطلون مقاصد الله في ترؤّس يوسف عليهم، فخابوا. وكذلك خاب اليهود بظنهم أن يبطلوا مقاصد الله المتعلقة بابنه يسوع المسيح (أعمال ٣: ١٨ و٤: ٢٧، ٢٨).
هٰذَا هُوَ ٱلْوَارِث علم الكرامون أن الابن هو الوارث الحقيقي. لكن اليهود لم يعرفوا أن يسوع هو المسيح، ولو أن هذا ممكناً لهم لو أنهم نظروا بقلوب وعقول منفتحة إلى المعجزات التي صنعها أمامهم. ولكنهم أغمضوا عيونهم عمداً وقسّوا قلوبهم لكيلا يقتنعوا بما يناقض أهواءهم ويعاكس أغراضهم. لذلك كانوا بلا عذر. أما كون المسيح وارثاً فواضح من أن الله «جعله وارثاً لكل شيء» (عبرانيين ١: ٢).
نَقْتُلْهُ وَنَأْخُذْ مِيرَاثَهُ رأى الفريسيون أن لا طريق لحفظ سلطانهم على الشعب إلا بقتل المسيح، لأن دعواه تبطل دعواهم (يوحنا ١١: ٤٨ و١٢: ١٩).
٣٩ «فَأَخَذُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكَرْمِ وَقَتَلُوه».
متّى ٢٦: ٥ الخ ومرقس ١٤: ٤٦ الخ ولوقا ٢٢: ٥٤ الخ ويوحنا ١٨: ١٢ الخ وأعمال ٢: ٢٣
قصة معاملة الكرامين ابن رب الكرم نبوَّة بما علم المسيح أنهم قصدوا أن يفعلوه به، وقد فعلوه بعد ثلاثة أيام من ذلك. وأظهر بتلك القصة للفريسيين أنه عالم بمقصدهم السري.
خَارِجَ ٱلْكَرْمِ ظن البعض ذلك إشارة إلى تسليم يسوع إلى الأمم ليصلبوه (يوحنا ١٨: ٢٨) وإلى أنه يصلب خارج أورشليم (لوقا ٢٣: ٢٣ ويوحنا ١٩: ١٧ وعبرانيين ١٣: ١٢، ١٣). ولم يتحقق أن المسيح قصد بذلك سوى رفض اليهود إياه وقتلهم له.
٤٠ «فَمَتَى جَاءَ صَاحِبُ ٱلْكَرْمِ، مَاذَا يَفْعَلُ بِأُولَئِكَ ٱلْكَرَّامِينَ؟».
ذكر هنا رجوع رب الكرم كأنه أمر لا ريب فيه، وأنه يحاكم الكرامين الأشرار. وفي ذلك إشارة إلى رجوع المسيح عند خراب أورشليم. وغايته من سؤاله عما يفعله رب الكرم عند مجيئه أن يدينوا أنفسهم بجوابهم، ويسلموا بأن الدينونة التي ستقع عليهم هي مما يقتضيه العدل.
٤١ «قَالُوا لَهُ: أُولَئِكَ ٱلأَرْدِيَاءُ يُهْلِكُهُمْ هَلاَكاً رَدِيّاً، وَيُسَلِّمُ ٱلْكَرْمَ إِلَى كَرَّامِينَ آخَرِينَ يُعْطُونَهُ ٱلأَثْمَارَ فِي أَوْقَاتِهَا».
لوقا ٢٠: ١٦ ولوقا ٢١: ٢٤ وعبرانيين ٢: ٣ وأعمال ١٣: ٤٦ و١٥: ٧ و١٨: ٦ و٢٨: ٢٨ ورومية ٩: ١٠ و١٥: ٩، ١٠، ١٦، ١٨
قَالُوا أي الكتبة والفريسيون، وربما وافقهم على ذلك غيرهم من الحاضرين. ولعلهم لم يشعروا حينئذٍ بأن المسيح ضرب هذا المثل عليهم، أو أنهم شعروا وتجاهلوا خجلاً من الجمع.
يُهْلِكُهُمْ حكموا بمقتضى اختبارهم فعل الناس في مثل تلك الأحوال، وبموجب العدل وذلك بعد ما أخذ منهم الكرم وسلمه إلى آخرين. والقول الذي نسبه متّى هنا إلى الفريسيين نسبه مرقس ولوقا إلى المسيح. فنستنتج من أقوال الثلاثة أن المسيح سأل الكتبة والفريسيين أولاً فأجابوه بذلك، فكرر جوابه تصديقاً لقولهم إشارة إلى معنى آخر يستلزمه المعنى الأصلي.
كَرَّامِينَ آخَرِينَ أشار بذلك إلى دعوة الأمم (رومية ١١: ١١ - ٢٥).
يُعْطُونَهُ ٱلأَثْمَارَ لا يلزم من ذلك أن يطيع كل الأمم ويقدمون لله أثمار البر. فالقصد به أن الله ينزع وسائط النعمة ممن لا يستعملونها كما ينبغي، ويعطيها لغيرهم. فإن كان هؤلاء أمناء بقيت تلك الوسائط لهم.
ويشير هذا المثل إلى رفض اليهود خاصة. وفيه بيان معاملة الله لكل من يستحقون وسائط النعمة ويعصونه. وجواب الكتبة والفريسيين هنا نبوة بمستقبلهم. والله لا يسكت عن سلب حقوقه من أثمار كرمه الروحي، فإذا لم يكن الذين سُلم إليهم أمناء سلَّمه إلى غيرهم من أصحاب الأمانة.
٤٢ «قَالَ لَـهُمْ يَسُوعُ: أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ فِي ٱلْكُتُبِ: ٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبَنَّاؤُونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ. مِنْ قِبَلِ ٱلرَّبِّ كَانَ هٰذَا وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيُنِنَا».
مزمور ١١٨: ٢٢، ٢٣ وإشعياء ٢٨: ١٦ ومرقس ١٢: ١٠، ١١ ولوقا ٢٠: ١٧ وأعمال ٤: ١١ وأفسس ٢: ٢٠ و١بطرس ٢: ٦، ٧
أتى المسيح هنا ببرهان من كتبهم، وهو أن الله أنبأ منذ القدم بنفس الأمر الذي قصده المسيح في هذا المثل.
فِي ٱلْكُتُبِ أي أسفار العهد القديم (رومية ١: ٢) وما ذكره المسيح في هذا العدد اقتبسه من مزمور ١١٨: ٢٢ وهو المزمور الذي أخذ منه الشعب قولهم «أُوصنا» ونادوا به يوم دخوله المدينة باحتفال.
ٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ الكلام هنا عن حجر في الجبل، اختاره رئيس البنائين رأساً للزاوية ووضع عليه علامة ذلك. لكن البنائين حسبوه غير موافق وتركوه مكانه. والقصد بالبناء هنا كنيسة الله. وبرئيس البنائين الله وبالحجر الذي اختاره رئيساً للزاوية الرب يسوع المسيح الذي عيَّنه الله منذ الأزل ليكون أساساً لبيته الروحي أي كنيسته (إشعياء ٢٨: ١٦) والبناؤون هم الأمة اليهودية، ولا سيما يهود ذلك العصر الذين أبوا أن يقبلوا يسوع مسيحاً (أعمال ٤: ١١ و١بطرس ٢: ٧). وسبب رفضهم يسوع أنه كان من عائلة بائسة، وكان متواضعاً محتقراً من الناس (إشعياء ٥٣: ٢، ٣) وليس له جاه عالمي، ولم يقصد إنشاء مملكة عالمية. ونسبة هذه النبوة إلى يسوع خاصة لا تمنع نسبتها أولاً إلى داود ثم إلى زربابل (زكريا ٣: ٩ و٤: ٦ - ١٠) لأن كلاً منهما كان رمزاً إلى المسيح.
رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ تمت مقاصد الله وصار المسيح أساس الكنيسة بالرغم من كل مقاومات اليهود (أفسس ٢: ١٩ - ٢٢).
هٰذَا أي جعل يسوع المسيح أساساً للكنيسة.
عَجِيب أي هذا الأمر حيَّر كل من نظر فيه، لأنه خلاف ما توقعه أكثر أفراد الأمة العبرية. فلو لم يكن من حكمة الله التي لم تُدرَك ومقاصده الأزلية، ما أمكن أن يحدث. ولا شك أن كل حوادث عمل الفداء هي غاية في العجب. وهل أعجب من أن الله يرسل ابنه الوحيد فادياً، وأن الكلمة الأزلي صار جسداً واتضع في كل حياته على الأرض، ورفضته الأمة المختارة وقتلته! وهل أعجب من إقامة الله إياه من الموت، ومن أنه بنى عليه كنيسته المجموعة من اليهود ومن كل أمم الأرض وجعلها دائمة إلى الأبد! فهذه الأمور كلها لا تزال عجيبة عند الناس في الأرض، والملائكة والقديسين في السماء.
٤٣ «لِذٰلِكَ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَلَكُوتَ ٱللّٰهِ يُنْزَعُ مِنْكُمْ وَيُعْطَى لأُمَّةٍ تَعْمَلُ أَثْمَارَهُ».
متّى ٨: ١١، ١٢
أوضح المسيح في هذا العدد مقصده من ذلك المثل، ففسّر الكرم بملكوت الله. وعبَّر متّى في بشارته عن الكنيسة بملكوت الله أربع مرات وبملكوت السماء عشرين مرة.
يُنْزَعُ مِنْكُمْ الخطاب لليهود، والقصد أنه ينزع منهم كل وسائط النعمة والبركات المختصة بشعب الله الخاص، كاستئمانهم على أقوال الله، وإرثهم للمواعيد.
وَيُعْطَى لأُمَّةٍ أي أن الأمم تُعطى وسائط النعمة التي أهملها اليهود (أعمال ١٣: ٤٦ - ٤٨ و١٥: ١٤ و٢٨: ٢٨ ورؤيا ٥: ٩، ١٠) وتحققت هذه النبوة من جهة الأمم في بيت كرنيليوس (أعمال ١٠) وبإيمان ملايين منهم بالمسيح من ذلك الوقت إلى الآن، وتمَّت أيضاً من جهة اليهود بخراب مدينتهم وتشتتهم في العالم، وبأن قليلين منهم آمنوا بالمسيح ونالوا فوائد خلاصه.
٤٤ «وَمَنْ سَقَطَ عَلَى هٰذَا ٱلْحَجَرِ يَتَرَضَّضُ، وَمَنْ سَقَطَ هُوَ عَلَيْهِ يَسْحَقُهُ».
إشعياء ٨: ١٤، ١٥ وزكريا ١٢: ٣ ولوقا ٢٠: ٨ ورؤيا ٩: ٣٣ و١بطرس ٢: ٨ وإشعياء ٦٠: ١٢ ودانيال ٢: ٤٤
في هذا العدد إشارة إلى قوله «يَكُونُ مَقْدِسًا وَحَجَرَ صَدْمَةٍ وَصَخْرَةَ عَثْرَةٍ لِبَيْتَيْ إِسْرَائِيلَ، وَفَخًّا وَشَرَكًا لِسُكَّانِ أُورُشَلِيمَ. فَيَعْثُرُ بِهَا كَثِيرُونَ وَيَسْقُطُونَ، فَيَنْكَسِرُونَن» (إشعياء ٨: ١٤، ١٥). وذلك يُظهر عواقب رفض الإيمان بالمسيح في هذا العالم فادياً وفي العالم الآتي دياناً.
مَنْ سَقَط أشار بذلك من عثروا بالمسيح لاتضاعه (إشعياء ٨: ١٤ و٥٣: ٢ ولوقا ٢: ٣٤ ويوحنا ٤: ٤٤) وأكثر الذين سمعوه حينئذ كانوا في تلك الحال. وهي حال إثم وخطر، لكنها ليست حال يأس، لأنه يمكن للذي وقع فيها أن ينجو منها بالتوبة.
سَقَطَ هُوَ عَلَيْهِ أي الحجر وكل ما بُني عليه. أو المسيح وكل قوة ملكوته معاً. ولعل ذلك مما قيل في دا ٢: ٣٤، ٣٥، ٤٥ ووقت سقوطه يوم الدين.
يَسْحَقُه القصد بالمسحوق هنا من وجب عليه الهلاك ويئس من الخلاص، فلا يسقط هذا الحجر للدينونة إلا على من سقط على ذلك الحجر أولاً.
٤٥، ٤٦ «٤٥ وَلَمَّا سَمِعَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ أَمْثَالَهُ عَرَفُوا أَنَّهُ تَكَلَّمَ عَلَيْهِمْ. ٤٦ وَإِذْ كَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يُمْسِكُوهُ خَافُوا مِنَ ٱلْجُمُوعِ، لأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ نَبِيٍّ».
ع ١١ ولوقا ٧: ١٦ ويوحنا ٧: ٤٠
شعر هؤلاء أخيراً بأن المسيح قصدهم في المثل. فلو لم يخافوا الشعب لبلغوا مقاصدهم منه علانية. فاضطروا أن يحاولوا قتله بمكر وخيانة. وفي قوله «تكلم عليهم» ربما يقصد تكلم عنهم بما هو الحكم عليهم بالتوبيخ الذي يستحقونه، إذ عرف مسبقاً أنهم يزمعون قتله مكراً وخبثاً.
الأصحاح الثاني والعشرون
١ «وَجَعَلَ يَسُوعُ يُكَلِّمُهُمْ أَيْضاً بِأَمْثَالٍ قَائِلاً».
لوقا ١٤: ١٦ ورؤيا ١٩: ٧، ٩
تابع المسيح تعليمه بأمثال، فضرب مثلاً في هذا الأصحاح يشبه في بعض أموره المثل الذي ذكر في لوقا ١٤: ١٥ - ٢٤. وهما مثلان مختلفان، لأن ذاك ضُرِب في بيرية في بيت فريسي وهذا في أورشليم في الهيكل. وقصد المسيح في ذاك دعوة الناس إليه. وقصده في هذا دينونتهم على رفضه. وهدف هذا المثل كهدف مثل الكرم، أي إظهار شر اليهود في رفض المسيح، وعقابهم على ذلك. والفرق بين المثلين أن الله في الأول طلب ثمار البر، وفي الثاني عرض البركات على الناس. في الأول خاطب اليهود كأُمة، وفي الثاني خاطبهم كأفراد. وفي الأول رمز إلى المسيح بأنه ابن رب الكرم، وفي الثاني بملك ابن ملك.
٢ «يُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمَاوَاتِ إِنْسَاناً مَلِكاً صَنَعَ عُرْساً لابْنِهِ».
مَلَكُوتُ ٱلسَّمَاوَات أي بركات الإنجيل التي بشر بها المسيح.
يُشْبِهُ إِنْسَاناً أي أحوال إنسان وأعماله. وتقوم تلك المشابهة بالاستعداد، والدعوات، وقبول كل المدعوين الدعوة أو رفضها، وفرح كل من قابليها.
عُرْساً كثيراً ما يشبِّه الكتاب المقدس بركات العهد الجديد بعرس (إشعياء ١٥: ٦ و٦١: ١٠ و٦٢: ٥ وهوشع ٢: ١٩ ومتّى ٩: ١٥ ويوحنا ٣: ٢٩ وأفسس ٥: ٢٢ و٢كورنثوس ١١: ٢). ووجه الشبه بين وليمة العرس والإنجيل: الابتهاج وجمع الأصدقاء. ويحق للإنجيل أن يشبه عرساً لأن فيه مسرات، فهو بشارة غفران وسلام ورجاء ومصالحة مع الله ورفقته، وبكل بركات العهد الجديد، ومواعيد السماء، وتعزية الروح القدس. ولأن فيه إظهار محبة المسيح لكنيسته ومحبة الكنيسة للمسيح، ومسرة كل منهما بالآخر، واتحادهما الدائم. وخلاصة ذلك أن بركات الإنجيل تشبه وليمة، ولزيادة ما فيه من المسرة يشبه وليمة عرس، ولما فيه من الشرف والعظمة يشبه وليمة عرس ملك، كوليمة أحشويرش التي «أَظْهَرَ غِنَى مَجْدِ مُلْكِهِ وَوَقَارَ جَلاَلِ عَظَمَتِهِ» (أستير ١: ٤) لأن العريس هو المسيح والعروس هي كنيسته. ومدة التبشير في الإنجيل زمان الخطبة.
ويقول سفر الرؤيا إن اقتران المسيح بالكنيسة لا يكون إلا بعد مجيئه الثاني (رؤيا ١٩: ٧). فيصح أن نحسب الوليمة المذكورة هنا وليمة خطبة المسيح للكنيسة على الأرض، ووليمة الاقتران في السماء (أفسس ٥: ٢٧). وقد عبَّر الكتاب عن الوليمتين بالعرس.
ومعروفٌ أن الأمور الدنيوية تعجز عن إيضاح الأمور الروحية، ولذلك ضاق المثل هنا ببيان القصد، لأن أعضاء الكنيسة الحقيقيين فيه هم المدعوون الذين قبلوا الدعوة ولبسوا ثياب العرس، وكلهم يشكِّلون العروس فيها.
٣ «وَأَرْسَلَ عَبِيدَهُ لِيَدْعُوا ٱلْمَدْعُوِّينَ إِلَى ٱلْعُرْسِ، فَلَمْ يُرِيدُوا أَنْ يَأْتُوا».
لا تزال العادة في الشرق حتى اليوم أن يحمل بعض ذوي العروس بطاقة دعوة يذهبون بها إلى بيوت الأصدقاء والجيران يدعونهم إلى العرس قائلين «عقبال عند الجميع».
عَبِيدَه ظن البعض أن العبيد هم جماعة الأنبياء (متّى ٢١: ٣٦) وهم الذين دعوا الأمة اليهودية لتقبل مراحم الله وبركاته. وظنهم آخرون خدام الإنجيل في أيام المسيح قبل صلبه كيوحنا المعمدان والاثني عشر رسولاً والتلاميذ السبعين، فهؤلاء كلهم نادوا «قَدْ كَمَلَ الزَّمَانُ وَاقْتَرَبَ مَلَكُوتُ الله» (مرقس ١: ١٥) وهو المرجَّح. فهي دعوة ثانية، تكرر دعوة الأنبياء الأقدمين جرياً على العادة الباقية إلى هذا اليوم في الولائم، وهي أن المدعو يُدعى ثانية في ساعة الوليمة (أستير ٥: ٨). فيتضح من ذلك أن دعوة المسيح ليست جديدة، بل هي تكميل للدعوة الأولى. فمنذ بدأ أن يكون اليهود أمة قام نبيٌ بعد نبي ليخبر الأمة بإتيان ملكها ومنقذها، ويحثها على الاستعداد لقبوله.
وهذا المثل بُني على عادة الملوك الأرضيين في ولائمهم، فلم يكن يليق بشرف الملك أن يرسل ابنه ليدعو الناس. ولكن ابن الله ملك السموات والأرض تنازل أن يدعو العالم قائلاً: تعالوا، لأن كل شيء مُعدٌّ.
ٱلْمَدْعُوِّينَ هم البشر، وأولهم الأمة اليهودية.
فَلَمْ يُرِيدُوا من الغريب أن المدعوين في المثل يرفضون مثل هذه الدعوة الشريفة المبهجة. والعقل لا يسلم بذلك الرفض إلا بأن أولئك المدعوين كانوا يكرهون تسلط ذلك الملك، وغير راضين أن يظهروا الصداقة له أو أن يقبلوا دعوته لهم بحضور وليمته. فرفضوا الدعوة ليعلنوا بغضهم له وعصيانهم عليه. ويشبه هذا انفعالات أكثر اليهود ضد ملكوت المسيح الروحي، فكان ما أظهروه للمسيح من أعمالهم كما لو قالوا «لا نريد أن هذا يملك علينا» فعدم محبة المسيح ومُلكه سبب رفض دعوته للخلاص.
٤ «فَأَرْسَلَ أَيْضاً عَبِيداً آخَرِينَ قَائِلاً: قُولُوا لِلْمَدْعُوِّينَ: هُوَذَا غَدَائِي أَعْدَدْتُهُ. ثِيرَانِي وَمُسَمَّنَاتِي قَدْ ذُبِحَتْ، وَكُلُّ شَيْءٍ مُعَدٌّ. تَعَالَوْا إِلَى ٱلْعُرْسِ».
أمثال ٩: ٢
عَبِيداً آخَرِين الأرجح أن هؤلاء هم الرسل وغيرهم من المبشرين الذين نادوا بالإنجيل بعد صلب المسيح وصعوده، مبتدئين بذلك منذ يوم الخمسين، كاستفانوس وبرنابا وبولس وأمثالهم ممن نادوا بيسوع والقيامة. لكن يحتمل أنه أراد بإرسال العبيد الآخرين تكرير الدعوة إظهاراً لطول أناته ورغبته في خلاصهم.
قُولُوا لِلْمَدْعُوِّين أشار بذلك إلى أن دعوة الإنجيل عامة شاملة لكل البشر، كقوله «مَنْ يُرِدْ فَلْيَأْخُذْ مَاءَ حَيَاةٍ مَجَّانًا» (رؤيا ٢٢: ١٧).
ثِيرَانِي وَمُسَمَّنَاتِي كناية عن البركات الروحية من السلام والمسرة بالمسيح. فهو مثل قوله بفم النبي «يَصْنَعُ رَبُّ الْجُنُودِ لِجَمِيعِ الشُّعُوبِ فِي هذَا الْجَبَلِ وَلِيمَةَ سَمَائِنَ، وَلِيمَةَ خَمْرٍ عَلَى دَرْدِيّ، سَمَائِنَ مُمِخَّةٍ، دَرْدِيّ مُصَفًّى» (إشعياء ٢٥: ٦).
ويذكر البشير لوقا ٢٤: ٢٢ - ٢٤ هذا المثل ذاته ويضيف إليه أنه لا يزال يوجد مكان. وهذا إشارة إلى أن المدعوين ليسوا يهوداً فقط، بل تعم الدعوة الأمم، ويُفسح لهم المجال لقبول الإنجيل.
كُلُّ شَيْءٍ مُعَدٌّ أي أن الآب مستعد أن يقبل الخاطئ، والابن أن يشفع فيه، والروح القدس أن يقدسه، وأن في الإنجيل كل ما تحتاج النفس إليه. وابتدأ الاستعداد للوليمة الإنجيلية زمن الناموس في رسومه وذبائحه وأعياده «ظل الخيرات العتيدة» وأشار المسيح إلى ما في هذه الوليمة من شبع للنفس (يوحنا ٦: ٥١ - ٥٩). وفي خطاب بطرس يوم الخمسين تمام الإيضاح بقوله «كل شيء معد» (أعمال ٢) (انظر أيضاً أعمال ٣: ١٩ - ٢٦ و٤: ١٢).
٥، ٦ «٥ وَلٰكِنَّهُمْ تَهَاوَنُوا وَمَضَوْا، وَاحِدٌ إِلَى حَقْلِهِ، وَآخَرُ إِلَى تِجَارَتِهِ، ٦ وَٱلْبَاقُونَ أَمْسَكُوا عَبِيدَهُ وَشَتَمُوهُمْ وَقَتَلُوهُمْ».
رومية ٢: ٤ وعبرانيين ٢: ٣
في هذين العددين بيان معاملة الناس للإنجيل مما فعله اليهود إلى ما يعمله أكثر الناس إلى هذا اليوم. وينقسم أهل العالم إلى قسمين: (١) الذين لا يبالون بالأمور الروحية، وينهمكون بالأمور الدنيوية غير المحرمة، فإثمهم بأنهم اكتفوا بها ولم يلتفتوا إلى الروحيات، وهم المقصودون بالذين «تهانوا ومضوا الخ». وأمثال هؤلاء الذين دعاهم حزقيا الملك إلى عيد الفصح في أورشليم (٢أخبار ٣٠: ١٠) ومنهم ديماس الذي ترك بولس «إِذْ أَحَبَّ الْعَالَمَ الْحَاضِرَ َ» (٢تيموثاوس ٤: ١٠) وأكثر الناس من هذا القسم. و(٢) الذين يقاومون الإنجيل فعلاً لأنه يقاوم كبرياءهم وبرهم الذاتي وأرباحهم وتعصبهم، وهم المشار إليهم بالذين رفضوا دعوة الملك أولاً ثم أعلنوا عداوتهم بعصيانهم جهاراً وقتلوا عبيده. وذُكر من أمثال هؤلاء في سفر الأعمال أعمال ٤: ٣ و٥: ١٨، ٤٠ و٧: ٥٨ و٨: ٣ و١٢: ٣ و١٤: ٥، ١٩ و١٧: ٥ و٢١: ٣٠ وفي ١كورنثوس ٤: ٣ وفي ١تسالونيكي ٢: ٢، ١٤ - ١٦. وكان استفانوس ويعقوب من أول جيش الشهداء الذين شُتِموا وقُتِلوا.
٧، ٨ «٧ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْمَلِكُ غَضِبَ، وَأَرْسَلَ جُنُودَهُ وَأَهْلَكَ أُولَئِكَ ٱلْقَاتِلِينَ وَأَحْرَقَ مَدِينَتَهُمْ. ٨ ثُمَّ قَالَ لِعَبِيدِهِ: أَمَّا ٱلْعُرْسُ فَمُسْتَعَدٌّ، وَأَمَّا ٱلْمَدْعُوُّونَ فَلَمْ يَكُونُوا مُسْتَحِقِّين».
دانيال ٩: ٢٦ ولوقا ١٨: ٢٧ ومتّى ١٠: ١١، ١٣ وأعمال ١٢: ٤٦
أشار هنا إلى خراب أورشليم
جُنُودَهُ القصد بهؤلاء عساكر الرومان، فكل جيوش الأرض جنود الله، بمعنى أنهم يجرون مقاصده عمداً أو اتفاقاً أو على الرغم من أنفسهم. فإنه سمى الأشوريين «قضيب غضبه» (إشعياء ١٠: ٥، ٦). وسمى نبوخذنصر ملك بابل «عبده» (إرميا ٢٥: ٩) مع أن الله عاقب نبوخذنصر على ما فعله (إرميا ٥١: ١١). ولعل القصد بجنود الله ملائكته الذين يجرون عقابه غير منظورين (١أخبار ٢١: ١٥، ١٦ و٢أخبار ٣٢: ٢١).
مَدِينَتَهُمْ كانت أورشليم أولاً مدينة الملك العظيم أي الله، لكنها صارت بعد ما رفض اليهود ابنه «مدينتهم» (لوقا ١٣: ٣٤، ٣٥) وما قيل هنا مثل ما قيل في متّى ٢١: ٤١ وخربت تلك المدينة بعد ٤٠ سنة من هذا الكلام.
فَلَمْ يَكُونُوا مُسْتَحِقِّين هم أثبتوا على أنفسهم أنهم غير مستحقين لأنهم لم يقبلوا الدعوة، وصار الباقون مستحقين لأنهم قبلوها (أعمال ١٣: ٤٦). فكلا الفريقين لا يستحق الجلوس إلى مائدة الملك.
انتهى هنا الجزء الأول من هذا المثل وهو المتعلق باليهود. وباقي المثل مختص بتاريخ الكنيسة المسيحية من خراب أورشليم إلى اليوم. وقوله «العرس مستعد» أي أنه مهيأ، ويمكن قبول جميع الداخلين إليه.
٩ «فَٱذْهَبُوا إِلَى مَفَارِقِ ٱلطُّرُقِ، وَكُلُّ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ فَٱدْعُوهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ».
مَفَارِقِ ٱلطُّرُقِ أرسله إلى تلك المفارق لكثرة الناس فيها عادة، وذلك إشارة إلى تبشير الأمم بالإنجيل بعدما رفضه اليهود. ومن ذلك الوقت دُعي كل أمم الأرض إلى الوليمة الإنجيلية (أعمال ٢١: ٢١، ٢٢) وامتثالاً لقوله «ااذْهَبُوا إِلَى مَفَارِقِ الطُّرُقِ» ذهب فيلبس إلى السامرة وبشر هنالك. وبشر بطرس كرنيليوس الروماني ورفقاءه وعمدوهم. ونادى بولس لأهل أثينا بأن «اللهُ الآنَ يَأْمُرُ جَمِيعَ النَّاسِ فِي كُلِّ مَكَانٍ أَنْ يَتُوبُواِ» (أعمال ١٧: ٣٠).
١٠ «فَخَرَجَ أُولَئِكَ ٱلْعَبِيدُ إِلَى ٱلطُّرُقِ، وَجَمَعُوا كُلَّ ٱلَّذِينَ وَجَدُوهُمْ أَشْرَاراً وَصَالِحِينَ. فَٱمْتَلأَ ٱلْعُرْسُ مِنَ ٱلْمُتَّكِئِينَ».
متّى ١٣: ٣٨، ٤٧
في هذا العدد وصف المجموعين بالدعوة التي ذُكرت في العدد السابق، وجُمعوا بدون امتياز بين الشريف والدنيء والغني والفقير والعالم والجاهل.
أَشْرَاراً وَصَالِحِينَ لعل الأشرار هنا الذين رذائلهم ظاهرة للناس كالمرأة الخاطئة التي غسلت قدمي المسيح بدموعها. والصالحين هم الأفاضل ظاهراً كنثنائيل وكرنيليوس. فقبل الأشرار ليكونوا صالحين، وقبلها الصالحون في عيون الناس ليكونوا صالحين في عيني الله.. ولعل القصد بذلك أن الدعوة الإنجيلية عامة تشمل كل أصناف الناس بغض النظر عن أحوالهم السابقة. فالشرط الوحيد هو الإيمان بأن يسوع هو المسيح. أو لعله بيان إمكان أن يكون في الكنيسة مراؤون مع المؤمنين الحقيقيين، كما مرَّ في شرح مثال الشبكة (متّى ١٣: ٤٧، ٤٨). وهذا لا يمنعه ما احتمله الكلام من المعاني السابقة. وقد يكون الشرير في نظر الناس صالحاً، لكنه في نظر الله العكس بالعكس.
فَٱمْتَلأَ ٱلْعُرْسُ لم يبطل رفض اليهود للمسيح مقاصد الله من إظهار كثرة رحمته وبهاء مجده.
١١ «فَلَمَّا دَخَلَ ٱلْمَلِكُ لِيَنْظُرَ ٱلْمُتَّكِئِينَ، رَأَى هُنَاكَ إِنْسَاناً لَمْ يَكُنْ لاَبِساً لِبَاسَ ٱلْعُرْسِ».
رومية ٣: ٤٢ و١٣: ١٤ و٢كورنثوس ٥: ٣ وأفسس ٤: ٢٤ وكولوسي ٣: ١٠، ١٢ ورؤيا ٣: ٣ و١٦: ١٥ و١٩: ٨
بقية هذا المثل مختصة بالذين قبلوا الدعوة ظاهراً، ومقارنتهم بالذين قبلوها حقيقة.
دَخَلَ ٱلْمَلِكُ لِيَنْظُرَ ميَّز الملك نفسه لا الخدم بين المستحق وغيره من المتكئين. وهذا إشارة إلى أن الله وحده يعرف قلوب الناس، فيميز بين المخلصين والمرائين. ولا شك أن الوقت المعين للفحص العظيم هو نهاية العالم كما مر في مثل الزوان (متّى ١٣: ٣٩). وأما الآن فيسير المسيح بين المنائر الذهبية (رؤيا ١٢: ١، ٢) ويميز أعمال كل من يدَّعي أنه مسيحي. وهذا هو الفحص المشار إليه في هذا المثل.
إِنْسَاناً هو الوحيد الذي وُجد غير أهل لأن يكون من المتكئين الكثيرين. ولكن لا يلزم من ذلك تعيين عدد المرائين بالنسبة إلى عدد المخلصين في الكنيسة. وإن كان لوحدته معنى، فهي تشير إلى تدقيق فحص الملك حتى لا يغفل عن واحد بين كثيرين. وذكر المرائي بين المخلصين يدل على أن القصد بتلك الوليمة هي الكنيسة على الأرض، لأنه لا يمكن لأحدٍ من المرائين أن يحضر وليمة السماء لأنه «يَعْلَمُ ٱلرَّبُّ ٱلَّذِينَ هُمْ لَهُ» (٢تيموثاوس ٢: ١٩).
لِبَاسَ ٱلْعُرْسِ تتضمن الدعوة إلى العرس أن يأتي المدعو لابساً الأثواب اللائقة بالعرس. وكان عند الملوك الأقدمين والأغنياء جزء كبير في خزائن ثروتهم ملبوسات نفيسة (متّى ٦: ١٩ ويشوع ٧: ٢١ وقضاة ١٤: ١٢ و٢ملوك ٥: ٥ وأيوب ٢٧: ١٦ ويعقوب ٥: ٢)، فجاء في التاريخ أنه كان للوكولوس أحد أغنياء الرومان خمسة آلاف رداء. وأن خمسين فارساً انكسرت بهم السفينة فنجوا بالسباحة وأتوا إلى غلياس، أحد سكان جزيرة صقلية فألبسهم مما في خزانته من الثياب اللباس الكامل. وكان من عادة الملوك والأعيان أن يهبوا لأصدقائهم الثياب الفاخرة علامة مسرتهم بهم، وكان الملوك والخلفاء يقدمون خلعاً، وكان من لا يقبل تلك الهبة يُعد من محتقري واهبها (تكوين ٤١: ٤٢ و٤٥: ٢٢ و٢ملوك ٥: ١٥ وأستير ٦: ٨ ودانيال ٥: ٧).
والأرجح أن الملك المذكور في المثل وهب لباس العرس لكل المدعوين، كما وهب ياهو ملك إسرائيل لعبدة البعل (١صموئيل ١٨: ٤ و٢ملوك ١٠: ٢٢) ولولا ذلك لم يسكت الذي ليس عليه لباس العرس عن الاعتذار عندما سأله الملك «كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟» فقد كان حضوره بملابسه العادية إهانة متعمَّدةً للملك. ولم يفسر المسيح قصده بلباس العرس، لكن كلامه يدل على أنه شيءٌ من الاستعداد لا بد منه في حضور وليمة عرس الحمَل السماوية، وأنه لا بد من أن يكون قبل حضور الوليمة. ومما نعلمه من آيات أُخرى في الكتاب المقدس هو أن برَّنا الذاتي خرقة نجسة (إشعياء ٦٤: ٦) وأن الله أعد لنا ثياباً بيضاً (رؤيا ٣: ٥ و٦: ١١ و٧: ٩) وهي «الْقَدَاسَةَ الَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ الرَّبَّ» (عبرانيين ١٢: ١٤ ورؤيا ١٩: ٨ ورومية ١٣: ١٤ ولوقا ١٥: ٢٢ وإشعياء ٦١: ١٠ وغلاطية ٣: ٢٧) قداسة من «غَسَّلُوا ثِيَابَهُمْ وَبَيَّضُوهَا فِي دَمِ ٱلْحَمَلِ» (رؤيا ٧: ١٤) وهي «بر الله» (رومية ١: ١٧) وذلك البر بالمسيح (رومية ١٠: ٤ وغلاطية ٣: ٢٧ و٢كورنثوس ٥: ٢١) ونحصل عليه بالإيمان به (في ٣: ٩) وهو «هبة أو عطية مجانية» (رومية ٣: ٢٤) وهو «بر ينشئُ فينا براً» (رومية ٨: ٤).
ورأى بعضهم أن القصد بلباس العرس بر المسيح، وآخر أنه تقدس الروح القدس. وكلاهما صحيح، لأن الأمرين متلازمان. والخلاصة أن القصد بالإنسان الذي عليه لباس العرس هو الذي يتكل على بره الذاتي للخلاص محتقراً البر الذي أعده الله.
١٢ «فَقَالَ لَهُ: يَا صَاحِبُ، كَيْفَ دَخَلْتَ إِلَى هُنَا وَلَيْسَ عَلَيْكَ لِبَاسُ ٱلْعُرْسِ؟ فَسَكَتَ».
يَا صَاحِبُ هذه الكلمة هنا كلمة لطف موجهة من شخص أعلى إلى أدنى.
كَيْفَ دَخَلْتَ الخ سؤال الملك وسكوت المسئول يدلان على أن الملك أعد لباساً لكل مدعو، فلم يكن لذلك الإنسان عذر. فإهماله لباس العرس إهانة للملك، فندم حتى لم يستطع أن ينطق بكلمة. وفي هذا العدد وما بعده إشارة إلى ما يحدث يوم الدين، فكل خاطئ لا يقبل في حياته بر المسيح يسأله الله في اليوم الأخير «كَيْفَ دَخَلْتَ إِلَى هُنَا وَلَيْسَ عَلَيْكَ لِبَاسُ ٱلْعُرْسِ؟» ويكون يومئذٍ محكوماً عليه من ضميره، فيقف بلا عذر أمام منبر الله مع أنه ربما جلس مدة حياته الأرضية على مائدة الرب بين المخلصين، ولم يعرف أحد منهم أنه مراءٍ. ولكن حين يأتي المسيح للدينونة يُعرف حالاً ويعاقب.
إن يسوع يدعونا لنأتي إليه بما نحن عليه بلا انتظار أن نكون أكثر أهلية لقبوله. ولكن إن أتينا إليه بقلوبنا، فلن نبقى على ما نحن عليه، لأنه سيغيِّرنا.
١٣ «حِينَئِذٍ قَالَ ٱلْمَلِكُ لِلْخُدَّامِ: ٱرْبُطُوا رِجْلَيْهِ وَيَدَيْهِ، وَخُذُوهُ وَٱطْرَحُوهُ فِي ٱلظُّلْمَةِ ٱلْخَارِجِيَّةِ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَاءُ وَصَرِيرُ ٱلأَسْنَانِ».
متّى ٨: ١٢
لِلْخُدَّامِ هم غير العبيد الذين دعوا الناس إلى الوليمة. فالعبيد هم المبشرون بالإنجيل، والخدام هم الملائكة (متّى ١٣: ٤١، ٤٩).
خُذُوهُ يُفصَل المراؤون على الأرض عن المخلّصين في اليوم الأخير إلى الأبد، ويُمنعون من السماء (متّى ١٣: ٤٨ و٢تسالونيكي ١: ٩).
ٱلظُّلْمَةِ ٱلْخَارِجِيَّة في داخل قصر الملك نور وشبع وفرح، وفي الخارج ظلمة وجوع وحزن. والقصد بالظلمة الخارجية شقاء النفس واليأس، نتيجة منع الأثيم من حضرة الله.
ٱلْبُكَاءُ وَصَرِيرُ ٱلأَسْنَانِ (انظر متّى ٨: ١٢) وهذا دليل على تشديد قصاص الملك لذلك الإنسان على إهانته إياه، وإهانته العريس والعروس والمتكئين أيضاً. وفي ذلك بيان لعاقبة المرائين في الظلمة الجهنمية.
١٤ «لأَنَّ كَثِيرِينَ يُدْعَوْنَ وَقَلِيلِينَ يُنْتَخَبُون».
متّى ٢٠: ١٦
(انظر شرح متّى ٢٠: ١٦). كثيرون يُدعون ببشرى الإنجيل، وهم ثلاث فرق: بعضهم يستخفون بها ويفضلون العالم عليها. وبعضهم يبغضون الحق ويقاومونه. وآخرون يعترفون بالحق ظاهراً ولا يقبلونه في قلوبهم. وقليلون يقبلون الدعوة لخلاص نفوسهم ويثبتون بذلك صحة اختيارهم.
وأمثال القسمين جماعة البالغين العبرانيين الذين خرجوا من مصر، والاثنين اللذين دخلا أرض كنعان (١كورنثوس ١٠: ١ - ١٠ ويهوذا ٥). وجيش جدعون فإنه دُعي إلى الحرب وكان ٣٢ ألفاً، فانتخب منه ٣٠٠ فقط ليكونوا أنصاراً لجدعون وشركاء نصره (قضاة ٧) ودُعي كل اليهود وانتُخب قليلون منهم للحياة لأن أكثرهم فضَّل خطاياه على المخلّص. ودُعي الأمم للخلاص أيضاً (إشعياء ٤٥: ٢٢) فبشروا بالإنجيل أمة بعد أخرى، وإلى الآن لم يقبله إلا القليلون منهم فاثبتوا أنهم انتُخبوا. وهذه الآية خلاصة المثل كله لا خلاصة الجزء الأخير منه. فليس القصد بها أن أكثر أعضاء الكنيسة غير منتخبين وأنهم مراؤون. فالقصد بالمدعوين هنا كل الناس الذين رفض أكثرهم نعمة الله (متّى ٧: ١٣، ١٤).
١٥ «حِينَئِذٍ ذَهَبَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَتَشَاوَرُوا لِكَيْ يَصْطَادُوهُ بِكَلِمَةٍ».
مرقس ١٢: ١٣ الخ ولوقا ٢٠: ٢٠ الخ
قال لوقا «فَرَاقَبُوهُ وَأَرْسَلُوا جَوَاسِيسَ يَتَرَاءَوْنَ أَنَّهُمْ أَبْرَارٌ لِكَيْ يُمْسِكُوهُ بِكَلِمَةٍ، حَتَّى يُسَلِّمُوهُ إِلَى حُكْمِ الْوَالِي» (لوقا ٢٠: ٢٠). وكان الفريسيون قبل ذلك يسألون المسيح كما اتفق لكل منهم. ولكنهم اتحدوا وتشاوروا بعد ذلك واختاروا مسائل معينة اتفقوا عليها، ظنوا أنه لا بد أن يقع ولو في جواب واحدة منها، ليجدوا علّة يشتكون بها عليه إلى بيلاطس الوالي كمهيج الناس على الحكومة. واختاروا أن يسألوه بواسطة أناس يتظاهرون بأنهم يبتغون الاستفادة منه.
ولو وجدوا علة ليشكوا يسوع إلى الوالي في هذا الشأن لكان تقديمهم إياها من أفظع أعمال الرياء، لأنهم كانوا يبغضون تسلط الرومان، ورغبوا في مسيح سياسي يقودهم إلى طرح نير الاستعمار الروماني. ومن أول أسباب رفضهم أن يسوع هو المسيح هو عدم موافقته إياهم على ذلك. فطلبوا أن يجدوا عليه ذنباً هم مرتكبوه في قلوبهم. وكانت غايتهم مما أعدوه من المسائل له أن يلجئوه إلى جواب يجعل الشعب يكرهه، فيقوم عليه أو يكرهه الوالي فيعاقبه.
يَصْطَادُوهُ اصطياد الطيور يتم بشرك أو فخ. ورغب الفريسيون اصطياد المسيح فيعرضونه لغضب الشعب أو غضب الوالي. وتوقعوا ذلك بثلاث مسائل (١) سياسية دينية. (٢) أخلاقية تتعلق بالطلاق. (٣) علمية تتعلق بتفسير كتبهم الدينية. فالأولى قدمها الفريسيون والهيرودسيون، والثانية قدمها الصدوقيون، والثالثة قدمها أحد الكتبة. فغلبهم المسيح كلهم وأرجعهم خائبين.
١٦ «فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ تَلاَمِيذَهُمْ مَعَ ٱلْهِيرُودُسِيِّينَ قَائِلِينَ: يَا مُعَلِّمُ، نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَتُعَلِّمُ طَرِيقَ ٱللّٰهِ بِٱلْحَقِّ، وَلاَ تُبَالِي بِأَحَدٍ، لأَنَّكَ لاَ تَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ ٱلنَّاسِ».
لوقا ٢٣: ٧
تَلاَمِيذَهُمْ أي الذين هم يعلمونهم، وقد أرسلوهم إخفاءً لما أضمروه له.
ٱلْهِيرُودُسِيِّينَ هم فرقة سياسية من اليهود غايتها الانتصار للعائلة الهيرودسية. والمظنون أنهم كانوا يبتغون أن أحد تلك العائلة يملك في أورشليم بدل الوالي الروماني، كما كان في أيام هيرودس الكبير. وتظاهروا بفرط المحبة للرومان والرغبة في طاعتهم بغية الحصول على غايتهم. وكان بين هؤلاء والفريسيين عداوة شديدة. ومع ذلك اتفقوا على الإضرار بالمسيح، فادَّعوا أنهم اختلفوا في مسألة، رفعوا الأمر إليه ليحكم بينهم.
تُعَلِّمُ... بِٱلْحَقِّ هذا مدح باللسان يخالف ما في القلب. وغايتهم من هذا التملق أن يسر المسيح بهم ويجيبهم بلا حذر. وكثيراً ما قاد التملق الناس إلى الهلاك، وهو أشد خطراً من التهديد (مزمور ٥٥: ٢١). فعلينا أن نحذر المملقين.
وَلاَ تُبَالِي بِأَحَدٍ أي أنك لا تخشى أن تتكلم بالحق، وأنك مستقل الأفكار فحكمك بلا هوى.
إِلَى وُجُوهِ أي لا تنطق بشيء خلاف اعتقادك إرضاءً للسامعين. فقولهم هذا حق، وإن كان قصدهم الخداع، فلم يخطر على بالهم أن المسيح يعلم أفكارهم مع أنه «لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا أَنْ يَشْهَدَ أَحَدٌ عَنِ الإِنْسَانِ، لأَنَّهُ عَلِمَ مَا كَانَ فِي الإِنْسَانِ» (يوحنا ٢: ٢٥).
١٧ «فَقُلْ لَنَا مَاذَا تَظُنُّ؟ أَيَجُوزُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ أَمْ لاَ؟».
قيصر اسم لكل إمبراطور من الرومان كفرعون لقب كل ملوك مصر. وكان الإمبراطور يومئذٍ طيباريوس الذي اشتهر بالقساوة والدناءة (ملك سنة ١٤ - ٣٧م). وكان اليهود يؤدون الجزية للرومان بالنسبة إلى أموالهم حسب إقرارهم بأقدارها (لوقا ٢: ١). وتأديتهم الجزية دليل على تسليمهم بسلطة الأجانب عليهم، وعلامة على عبوديتهم. وكان تأديتهم الجزية للرومان من أكره الأمور عندهم ولا سيما عند الفريسيين، واعتقدوا أن تأديتها لا تجوز في شريعة موسى. ففيها ما نصه: «مِنْ وَسَطِ إِخْوَتِكَ تَجْعَلُ عَلَيْكَ مَلِكًا. لاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ عَلَيْكَ رَجُلاً أَجْنَبِيًّا لَيْسَ هُوَ أَخَاكَ» (تثنية ١٧: ٦٥). وقامت فتن كثيرة في اليهودية لأخذ الرومان تلك الجزية من أهلها (أعمال ٥: ٣٧) فلو سئل الفريسيون هذا السؤال لأجابوا «لا». ولو سئل الهيرودسيون لأجابوا «نعم» إرضاءً للرومان. فلو قال المسيح «يجوز» لشكا عليه الفريسيون إلى الشعب وأثبتوا أنه خائن لأمته، فيستحيل أن يكون مسيحهم المتوقع أنه يرفع نير الرومان عنهم، فيمكنهم أن يقضوا عليه بلا معارض من الشعب. ولو قال «لا يجوز» لشكاه الهيرودسيون إلى بيلاطس الوالي بحُجَّة أنه عاصٍ يهيج الفتن على قيصر، كما كذب بعضهم بعد ذلك «وَابْتَدَأُوا يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ قَائِلِينَ: إِنَّنَا وَجَدْنَا هذَا يُفْسِدُ الأُمَّةَ، وَيَمْنَعُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ» (لوقا ٢٣: ٢).
١٨ «فَعَلِمَ يَسُوعُ خُبْثَهُمْ وَقَالَ: لِمَاذَا تُجَرِّبُونَنِي يَا مُرَاؤُونَ؟».
أظهر المسيح بهذا الجواب أنه يعلم ما في القلوب، وذلك علم مختص بالله. ودعاهم «مرائين» بدون نظر إلى وجوههم، وصدق بذلك، لأنهم كانوا كذلك. فإنهم تظاهروا بأنهم يرغبون في معرفة الحق وغايتهم أن يصطادوه بكلمة.
١٩ «أَرُونِي مُعَامَلَةَ ٱلْجِزْيَةِ. فَقَدَّمُوا لَهُ دِينَاراً».
متّى ٢٠: ٢
كشف المسيح رياءهم، وأجابهم على سؤالهم إجابةً لا تعرِّضه لمساءلة الفريقين القائمين عليه. كما علَّمهم علاوة على ذلك تعليماً مفيداً، وأظهر سمو الحكمة السماوية والعلم الإلهي.
مُعَامَلَةَ ٱلْجِزْيَةِ أي صنف النقود الذي تؤدونه جزية.
قَدَّمُوا لَهُ دِينَاراً الدينار نقد روماني من الفضة (والجزية التي كانت تؤدى للهيكل شاقل أو نصف شاقل وهو نقد يهودي). وكان وجود ذلك الدينار في أيديهم جواباً لسؤالهم. فإنهم باستعمالهم له أظهروا خضوعهم لقيصر، لأنه «إذا راجت نقود ملك في بلاد، اعترف سكانها بأن ذلك الملك ملكهم». فباستعمال الفريسيين نقود الرومان أقروا بسلطان قيصر عليهم، وبيَّنوا أنهم أجازوا تأدية الجزية له.
٢٠ «فَقَالَ لَـهُمْ: لِمَنْ هٰذِهِ ٱلصُّورَةُ وَٱلْكِتَابَةُ؟».
كان مرسوماً على الدينار صورة رأس قيصر ومكتوباً حوله اسم قيصر وبعض ألقابه الشريفة.
٢١ «قَالُوا لَهُ: لِقَيْصَرَ. فَقَالَ لَـهُمْ: أَعْطُوا إِذاً مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلّٰهِ لِلّٰه».
متّى ١٧: ٢٥ ورومية ١٣: ٧ و١بطرس ٢: ١٣، ١٧
لم يترك المسيح في جابه باباً للشكوى ضده للشعب أو للحاكم الروماني، فقد حكموا قبل أن يسألوه بجواز تأدية الجزية، بدليل ما في أيديهم من عُملة قيصر، وهو إقرار بأنه ملكهم. وبذلك أجاب على مسالة أهم من مسألتهم، حيرت أفكارهم، وهي أنه هل تأدية الجزية لملك أجنبي خيانة لله أو لا؟ فظهر من كلام المسيح أنها ليست خيانة. فالقيام بالواجبات السياسية لا يلزم منه ضرورة مخالفة القيام بالواجبات لله.
أَعْطُوا إِذاً مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ قوله «ما لقيصر» صدَّق على كل الواجبات السياسية، كتأدية الجزية بناءً على أن نقودها من قيصر، وأنها ترد إليه بأمره، وأن الطاعة واجبة لقيصر ولكل من يعينهم في مناصب. والكتاب المقدس يوجب الطاعة للحكومة السياسية والشريعة البشرية ضمن حدودها (رومية ١٣: ١ - ٧ و١كورنثوس ٧: ٢١ - ٢٤ وأفسس ٦: ٥ - ٨ وكولوسي ٣: ٢٢ - ٢٥ و١بطرس ٢: ١٣ - ١٧). وأفضل رعايا الملوك هم المسيحيون بالحق. والجزء الأول من جواب المسيح هو قوله «أعطوا إذاً ما لقيصر» وُجِّه للفريسيين الذين رفضوا في قلوبهم سلطان قيصر عليهم.
وَمَا لِلّٰهِ لِلّٰه هذا الجزء الثاني من جواب المسيح ووجَّهه إلى الهيرودسيين الذين رغبوا في الخضوع لقيصر فكانوا في خطر أن يهملوا واجباتهم لله.. لقد كان المشتكون مختلفين في الرأي في ما بينهم، وإنما اجتمعوا معاً مؤقتاً للإيقاع به واصطياده بكلمة.
ويصدق قوله «ما لله لله» على كل الواجبات الدينية. فنفس الإنسان على صورة الله (تكوين ١: ٢٧) فيجب أن تُعطى النفس له، أي أن نقدم قلوبنا وأموالنا وخدمة أيدينا له بروح الإيمان والمحبة والطاعة. فعلينا أن نطيع حكام الأرض لأن الله أمر بذلك.
وخلاصة الجواب أنه يجب إعطاء الدينار لقيصر وإعطاء النفس لله. ويجب أن يكون كل إنسان أميناً للحاكم الأرضي وأميناً للحاكم السماوي. ولا يلزم بالضرورة أن تتناقض مطالب الحاكمَيْن. فإن تناقضا وجب أن يطاع الله أكثر من الناس (أعمال ٥: ٢٩).
٢٢ «فَلَمَّا سَمِعُوا تَعَجَّبُوا وَتَرَكُوهُ وَمَضَوْا».
تَعَجَّبُوا لأنه استوفى جواب الفريقين، ولم يتمكن أحدهما من توجيه الشكوى ضده، بعد أن كانوا يظنون أنه لا يمكنه أن ينجو من الفخ الذي أخفوه له. فتحيروا من وفرة حكمته، ثم تركوه وانصرفوا في خجل مفحمين.
٢٣ «فِي ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ جَاءَ إِلَيْهِ صَدُّوقِيُّونَ، ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَيْسَ قِيَامَةٌ، فَسَأَلُوهُ».
مرقس ١٢: ١٨ الخ ولوقا ٢٠: ٢٧ الخ وأعمال ٢٣: ٨
صَدُّوقِيُّون ذكروا قبلاً (راجع متّى ٣: ٧) وكان أكثر رؤساء الكهنة من هذه الفرقة (أعمال ٥: ١٧).
لَيْسَ قِيَامَةٌ أنكروا قيامة الجسد لأنهم أنكروا خلود النفس (أعمال ٢٣: ٨). فإن تلاشت النفس عند الموت لم يبق باب لحياة الجسد. فملاشاة النفوس منافٍ لقيامة الأجساد. فوجه المسيح جوابه إلى الضلالة الأصلية في اعتقادهم، وبرهن من الكتب المقدسة أن موتى هذا العالم لا يزالون أحياء في عالم آخر. فخلود النفس وقيامة الجسد وثواب الأبرار وعقاب الأشرار عقائد ترتبط معاً. فمن أثبت أحدها أثبت الكل.
ومثل اعتقاد الصدوقيين في ذلك كان اعتقاد الفلاسفة الأبيقوريين الذين خاطبهم بولس في أثينا (أعمال ١٧: ١٨).
٢٤ «يَا مُعَلِّمُ، قَالَ مُوسَى: إِنْ مَاتَ أَحَدٌ وَلَيْسَ لَهُ أَوْلاَدٌ يَتَزَوَّجْ أَخُوهُ بِٱمْرَأَتِهِ وَيُقِمْ نَسْلاً لأَخِيهِ».
تثنية ٢٥: ٥
قَالَ مُوسَى سنَّ موسى هذه الشريعة دفعاً لانقراض العائلة، ولحفظ اسم الإنسان ونسبته بين أمته إن مات بلا نسل (تثنية ٢٥: ٥، ٦)
يُقِمْ نَسْلاً لأَخِيهِ كان إذا مات أحد بلا نسل تزوج أخوه أرملته، وسمَّي أول ولد منها باسم الميت، واعتُبر ذلك الولد وارثه وابنه. ومثال ذلك في راعوث ص ٤.
٢٥ - ٢٨ «٢٥ فَكَانَ عِنْدَنَا سَبْعَةُ إِخْوَةٍ، وَتَزَوَّجَ ٱلأَوَّلُ وَمَاتَ. وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسْلٌ تَرَكَ ٱمْرَأَتَهُ لأَخِيهِ. ٢٦ وَكَذٰلِكَ ٱلثَّانِي وَٱلثَّالِثُ إِلَى ٱلسَّبْعَةِ. ٢٧ وَآخِرَ ٱلْكُلِّ مَاتَتِ ٱلْمَرْأَةُ أَيْضاً. ٢٨ فَفِي ٱلْقِيَامَةِ لِمَنْ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ تَكُونُ زَوْجَةً؟ فَإِنَّهَا كَانَتْ لِلْجَمِيعِ!؟».
ذكروا للمسيح حادثة من الممكنات البعيدة الوقوع، ظنها الصدوقيون اعتراضاً منافياً لإمكان القيامة. فإنهم فرضوا كأمر لا بد منه أن الموتى إن قاموا بقوا على ما كانوا عليه في هذا العالم، فيكون المتزوجون هنا متزوجين هناك. ولم يقدروا أن يتصوروا كيف تكون امرأة واحدة زوجة لسبعة في وقت واحد! فأنكروا القيامة لأنهم حسبوها مستحيلة.
لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسْلٌ ذكروا ذلك لئلا يجيبهم المسيح بأنها تكون زوجة لمن ولدت له.
٢٩ «فَأَجَابَ يَسُوعُ: تَضِلُّونَ إِذْ لاَ تَعْرِفُونَ ٱلْكُتُبَ وَلاَ قُوَّةَ ٱللّٰهِ».
يوحنا ٢: ٩
نسب المسيح ضلالهم إلى سببين: (١) جهلهم بما حوته كتبهم الدينية التي اعترفوا أنها إلهية، و(٢) تحديدهم قوة الله، كأنه غير قادر أن يجمع أجزاء الأجساد بعد موتها ورجوعها إلى التراب، وكأنه يعجز أن ينظمها ثانية ويحييها. لقد نسوا أن تجديد بنية الموجود أسهل من إيجاده من لا شيء، فسلَّموا بالخلْق وأنكروا القيامة. فعدم المعرفة بالكتاب المقدس، وعدم الإيمان بقوة الله هما سبب ضلالات كثيرة.
٣٠ «لأَنَّهُمْ فِي ٱلْقِيَامَةِ لاَ يُزَوِّجُونَ وَلاَ يَتَزَوَّجُونَ، بَلْ يَكُونُونَ كَمَلاَئِكَةِ ٱللّٰهِ فِي ٱلسَّمَاءِ».
١يوحنا ٣: ٢
لأَنَّهُمْ فِي ٱلْقِيَامَةِ أي الناس بعد القيامة
لاَ يُزَوِّجُونَ أي لا يعطون بناتهم زوجات لأبناء غيرهم، ولا يأخذون بنات غيرهم زوجات لأبنائهم.
وَلاَ يَتَزَوَّجُونَ أي لا يأخذون بنات غيرهم زوجات لأنفسهم. وقول المسيح في هذا العدد جواب مفحم لاعتراض الصدوقيين، وخلاصته أن العلاقة بين الزوج والزوجة مختصة بهذه الدنيا فلا تكون في السماء، فلا موت في السماء (رؤيا ٢١: ٤) ولا حاجة إلى الولادة (لوقا ٣٠: ٣٥، ٣٦). فلو سُئل الفريسيون سؤال الصدوقيين وهو «لمن تكون المرأة من السبعة؟» لأجابوا «هي للأول» ولكن المسيح قال إنها ليست لأحد منهم.
كَمَلاَئِكَةِ صرّح المسيح بوجود ملائكة، الأمر الذي أنكره الصدوقيون، وقال إن المؤمنين يكونون بعد القيامة كالملائكة في بعض الأمور. فلا تناقض في ذلك لكونهم ذوي أجساد. وهم يشبهون الملائكة في الخلود، وعدم الزواج، وأنهم ليسوا عرضة لنوع من الجوع أو العطش أو الوجع أو النوم أو الشهوات الجسدية، وأن أجسادهم الروحية لا تقبل الفساد. كما أنه لا يلزم أن نفهم من هذا القول إن الذين لا يتزوجونهم أقدس وأفضل من الذين يتزوجون.
ونفي المسيح الزواج في السماء لا يعني أن الذين عرف بعضهم بعضاً على الأرض لا يعرفون بعضهم في السماء، ولا يعني أن الأصدقاء هنا لا يكونون أصدقاء هناك، ولا أن المتزوجين هنا ينسون هذا هناك. إنما قال إن الجسد الروحاني يخلو من شهوات الجسد الحيواني، لأنه «يُزْرَعُ جِسْمًا حَيَوَانِيًّا وَيُقَامُ جِسْمًا رُوحَانِيًّا» (١كورنثوس ١٥: ٤٤) ويلزم من تشبيه المسيح الصالحين بالملائكة أنهم يقومون كاملين في القداسة والسعادة.
٣١، ٣٢ «٣١ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ قِيَامَةِ ٱلأَمْوَاتِ، أَفَمَا قَرَأْتُمْ مَا قِيلَ لَكُمْ مِنْ قِبَلِ ٱللّٰهِ: ٣٢ أَنَا إِلٰهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلٰهُ إِسْحَاقَ وَإِلٰهُ يَعْقُوبَ. لَيْسَ ٱللّٰهُ إِلٰهَ أَمْوَاتٍ بَلْ إِلٰهُ أَحْيَاءٍ؟».
خروج ٣: ٦، ١٦ ومرقس ١٢: ٢٦ ولوقا ٢٠: ٣٧ وأعمال ٧: ٣٣ وعبرانيين ١١: ١٦
برهن المسيح في هذين العددين بما في كتب موسى (خروج ٣: ٦، ١٥) أن الذين ماتوا في هذا العالم أحياء في عالم آخر، ولذلك يستطيعون أن يرجعوا إلى الأجساد ويقومون. واقتصر على إيراد البرهان من كتب موسى، لأن الصدوقيين اعتبروها كلام الله بنوع خاص. ولو أن في العهد القديم براهين أخرى (منها أيوب ١٩: ٢٥، ٢٦ ومزمور ١٦: ١٠، ١١ وإشعياء ٢٦: ١٩ وحزقيال ٣٧ ودانيال ١٢: ٢).
وقول الله لموسى كان من العليقة الملتهبة في حوريب، بعد موت إبراهيم بـ ٣٢٩ سنة، وبعد موت اسحق بـ ٢٢٤ سنة، وبعد موت يعقوب بـ ١٩٨ سنة. وأكد في ذلك القول إنه لم يزل إلهاً لهم. ولو أنهم تلاشوا ما صحَّ أن يقول هذا، فإن الله ليس إله عدم. فإذاً كانت نفوس أولئك الآباء حية عند الله، لأنه قال ذلك مع أن أجسادهم كانت في القبور طيلة تلك المدة.
وزاد لوقا على ما قاله متّى «لَيْسَ هُوَ إِلهَ أَمْوَاتٍ بَلْ إِلهُ أَحْيَاءٍ، لأَنَّ الْجَمِيعَ عِنْدَهُ أَحْيَاءٌ» (لوقا ٢٠: ٣٨) وأورد المسيح تلك الآية للصدوقيين لما فيها من البرهان على خلود النفس، لأنهم أنكروه. وأما الله فخاطب بها موسى لما فيها من برهان أنه لا يزال يذكر العهد الذي قطعه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأن يجعل نسلهم شعبه الخاص.
أَنَا إِلٰهُ إِبْرَاهِيمَ... ويَعْقُوب أي إني إلههم الآن كما كنت إلههم وهم على الأرض. فلم يقل كنت إلههم بل «أنا إلههم» أي أنه يديم حياتهم، وهو مصدر سعادتهم وحافظ عهده لهم.
لَيْسَ ٱللّٰهُ إِلٰهَ أَمْوَاتٍ أي أنه ليس إله مجرد أسماء أولئك الآباء، بل هو إله أشخاصهم. وهو ليس إله مجرد تراب ورماد، بل إله أرواح حية.
بَلْ إِلٰهُ أَحْيَاء الموتى عند أهل الأرض هم أحياء عند الله. وهذا يخالف اعتقاد القائلين إن أرواح الموتى في سبات تبقى إلى القيامة. اكتفى في رده على الصدوقيين بإيراد ما يُثبت خلود النفس، لأن إنكارهم القيامة نتج عن إنكارهم ذلك الخلود.
٣٣ «فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْجُمُوعُ بُهِتُوا مِنْ تَعْلِيمِهِ».
متّى ٧: ٢٨
ٱلْجُمُوعُ هم المحيطون به سوى الصدوقيين، وكان أكثرهم من الفريسيين. وكان الصدوقيون قليلين بين اليهود بالنسبة إلى الفريسيين. لكن أكثر الكهنة كانوا صدوقيين.
بُهِتُوا لم تدهشهم عقيدة القيامة بل برهنة المسيح على صحتها بآية لم يخطر على بالهم أنها دليل على القيامة. وبُهتوا من قدرته على إبطال سفسطة الصدوقيين وتعليمه حقائق روحية عظيمة، لأن الجموع كانوا قد اعتادوا أن يسمعوا في الهيكل الجدال بين الصدوقيين والفريسيين في أمور سطحية.
٣٤ «أَمَّا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا أَنَّهُ أَبْكَمَ ٱلصَّدُّوقِيِّينَ ٱجْتَمَعُوا مَعاً».
مرقس ١٢: ٢٨ الخ
أَبْكَمَ ٱلصَّدُّوقِيِّينَ توقع الصدوقيون أن يبكموا يسوع باعتراضاتهم، فرأوا النتيجة أن يسوع أبكمهم بأجوبته المملوءة حكمة، وبأدلته القاطعة. ولكن مع أنهم أُبكموا لم يقتنعوا.
ٱجْتَمَعُوا أي الفريسيون، وكانت غاية اجتماعهم أن يجهزوا له فخاً جديداً. فسرورهم بأن المسيح غلب الصدوقيين لم تكسبه رضاهم.
٣٥ «وَسَأَلَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ نَامُوسِيٌّ، لِيُجَرِّبَهُ».
لوقا ١٠: ٢٥
نَامُوسِيٌّ كان الناموسيون فرقة من الكتبة، وهم فريسيون (مرقس ١٢: ٢٨). ولعلهم تخصصوا في دراسة ناموس موسى، ولو أن باقي الكتبة كانوا يدرسون الكتاب كله من ناموس وأنبياء.
لِيُجَرِّبَهُ يظهر مما ذكره مرقس أن الفريسيين اتخذوا هذا الناموسي آلة لمقاصدهم الشريرة على المسيح، وأنه لم يشاركهم في تلك المقاصد. ويظهر من ذلك أيضاً أن جواب المسيح أثر فيه تأثيراً كثيراً وأقنعه بجودة تعليمه (مرقس ١٢: ٣٢ - ٣٤). والتجربة التي قصدها الفريسيون هي أن يجاوب المسيح بما يقلل احترام السامعين إياه، إن جاء جوابه خلاف اعتقادهم أو أن يكون ضعيفاً يثير السخرية.
٣٦ «يَا مُعَلِّمُ، أَيَّةُ وَصِيَّةٍ هِيَ ٱلْعُظْمَى فِي ٱلنَّامُوس؟».
كان هذا من أهم المسائل عند الفريسيين، وانقسموا على الإجابة أحزاباً، فقال بعضهم إن أعظم الوصايا هي وصية الختان، وقال البعض إنها وصية الغسل والتطهيرات، وقال آخرون إنها الوصية المتعلقة بأهداب الثياب (عد ١٥: ٣٨). وقال غيرهم إن رابع الوصايا العشر هي الأهم.
٣٧ «فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: تُحِبُّ ٱلرَّبَّ إِلٰهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ».
تثنية ٦: ٥ و١٠: ١٢ و٣٠: ٦ ولوقا ١٠: ٢٧
إِلٰهَكَ أي الإله الواحد خالقك وحافظك. فنسبته إليك توجب عليك أن تحبه، وتبين تلك العلاقة أنه يستحق تلك المحبة. وفي قوله «إلهك» إشارة إلى أن الله واحد حق، وهو «إلهك» بسبب ما بينكما من عهد كان في جبل سيناء من أنه يكون إلهاً لبني إسرائيل وأن يكون بنو إسرائيل شعباً له. والله بالنسبة للمسيحي إلهُ مصالحةٍ بدم ابنه. وهذا يزيد على ما كان لليهودي.
ولعل قصد المسيح بذكر القلب والنفس والفكر أن يجمع كل قوى الإنسان على محبة الله، فتُوقف كلها لخدمته.
قَلْبِكَ يراد بالقلب في الكتاب المقدس مصدر عواطف الإنسان أو انفعالاته. ويلزم من قوله «تحب الرب من كل قلبك» أنه لا يكفي بمجرد العبادة الظاهرة والطاعة الخارجية، لكنه يطلب المحبة القلبية، وأن تفوق محبتنا له محبتنا لغيره، وأن نكون مستعدين أن نترك كل شيء لأجله (أمثال ٢٣: ٢٦ وإرميا ٣: ١٤).
نَفْسِكَ النفس مصدر حياة الإنسان، فمحبة الله من كل النفس تؤثر في كل طبيعة الإنسان حتى ضميره ومشيئته. فتقتضي أنه إن عاش الإنسان يعيش للرب، وإن مات يموت به (يوحنا ١٤: ١٥، ٢٣ و١كورنثوس ٥: ١٤ وفي ١: ٢١ و١يوحنا ٢ و٤: ١٦).
فِكْرِكَ القصد بالفكر هنا قوى الإنسان العقلية، فمحبة الله من كل الفكر تقتضي أن تدخل في دروسنا ومباحثنا وأعمالنا الجسدية، وأن نكون مستعدين لأن نتعلم منه كل شيء، وأن نفضل تعاليم كتابه الصريحة على كل أحكام عقولنا (مزمور ١١٩: ١٥، ٩٧ وأمثال ١٢: ٥ و٢كورنثوس ١٠: ٥). فيجب أن تكون محبتنا لله (١) خالصة (٢) قوية (٣) سامية على كل محبة. واقتبس المسيح هذه الآية من التثنية تثنية ٦: ٤، ٥. وبذلك علَّم أن الشريعة كلها تكمل بأمر واحد هو المحبة. وهي تحملنا على تكميل كل واجباتنا لله والناس طوعاً واختياراً. وهي أفضل ما يمكن الإنسان أن يقدمه. ويجب تقديمها لأفضل الكائنات.
ونتعلم أن الله لا يكتفي باعتقادنا بوجوده ووحدته، واعترافنا بحق سلطانه، وحفظنا يوم عبادته، وتقديمنا القرابين والذبائح. فجوهر ما يرضيه منا المحبة القلبية، وعليها تُبنى طاعتنا المقبولة له، لا على خوفنا من العقاب أو طمعنا في الثواب.
٣٨ «هٰذِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلأُولَى وَٱلْعُظْمَى».
ٱلأُولَى أي المقدمة على كل ما سواها في أهميتها وشمولها ودوامها.
ٱلْعُظْمَى هي العظمى لأن الذي يحفظها يحفظ سائر الوصايا الإلهية. والله هو الأول والأعظم فيستحق أن تكون محبتنا له «الأولى والعظمى». وهذا جواب شافٍ كافٍ على سؤال الناموسي.
٣٩ «َٱلثَّانِيَةُ مِثْلُهَا: تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ».
لاويين ١٩: ٢٨ ومتّى ١٩: ١٩ ومرقس ٢٢: ٣١ ولوقا ١٠: ٢٧ ورومية ١٣: ٩ وغلاطية ٥: ١٤ ويعقوب ٢: ٨
والثانية: لم يسألهُ الناموسي عن الوصية الثانية، لكن يسوع انتهز الفرصة ليعلمه الشريعة كلها.
مثلها: في أن مصدر الوصيتين واحد وهو الله، وأن أساسهما واحد وهو المحبة. والثانية لا تقوم بدون الأولى، لأنه لا يمكن أن نحب أخانا حق المحبة إلا إن أحببنا الله أولاً (١يوحنا ٤: ٢٠، ٢١). وهي مثل الأولى في الإخلاص والمنفعة للعالم.
كَنَفْسِكَ هذا مقتبس من سفر اللاويين (لاويين ١٩: ١٨) ولم يأمرنا الكتاب المقدس أن نحب أنفسنا لأن هذا أمر مسلَّمٌ به. ويظهر من هذا العدد أن محبة النفس ليس إثماً لأن المسيح جعلها قياس محبتنا للقريب، ولكنها تكون إثماً إذا قادتنا إلى إهمال واجباتنا لله وللناس.
٤٠ «بِهَاتَيْنِ ٱلْوَصِيَّتَيْنِ يَتَعَلَّقُ ٱلنَّامُوسُ كُلُّهُ وَٱلأَنْبِيَاءُ».
متّى ٧: ١٢ و١تيموثاوس ١: ٥
أي أن هاتين الوصيتين تشتملان على كل جوهر الناموس والأنبياء وهما العهد القديم. ويحق أن يُزاد على ذلك أنهما تشتملان على تعليم المسيح والرسل، أي العهد الجديد بالإضافة إلى العهد القديم، لأن المحبة لله والناس هي خلاصة الدين كله. وقد قال المسيح إنه جاء ليكمل الناموس والأنبياء بنفسه (متّى ٩: ١٧) وبيَّن هنا كيفية تكميله إياهما أيضاً بواسطة تلاميذه إلى نهاية الزمان، وهذا وفق قوله «الْمَحَبَّةُ هِيَ تَكْمِيلُ النَّامُوسِ» (رومية ١٣: ١٠). وقوله «وَأَمَّا غَايَةُ الْوَصِيَّةِ فَهِيَ الْمَحَبَّةُ مِنْ قَلْبٍ طَاهِرٍ، وَضَمِيرٍ صَالِحٍ، وَإِيمَانٍ بِلاَ رِيَاءٍ» (١تيموثاوس ١: ٥).
بِهَاتَيْنِ ٱلْوَصِيَّتَيْنِ يَتَعَلَّقُ أي تقوم أربع من الوصايا العشر بحفظ الأولى، وست منها بحفظ الثانية.
ونفهم مما ذكره مرقس أن الناموسي اقتنع من قول المسيح، وتغيرت أفكاره عما كانت عليه عندما أتى إلى المسيح، لأنه أتى ليجربه (راجع ع ٣٤) فرجع يثني عليه (مرقس ١٢: ٣٢). ورأى المسيح أن الناموسي أدرك، فقال إنه ليس بعيداً عن ملكوت الله. ولا دليل لنا على أنه جاوز هذا الحد، فالذي يكتفي بقربه من الملكوت دون دخوله يدركه الهلاك وهو بباب السماء.
ونفهم مما قاله مرقس أيضاً أنه «لم يجسر أحد بعد ذلك» أن الفريسيين استخدموا يهوذا الخائن وشهود زور ليبلغوا مرامهم من المسيح. ونتج من شر الفريسيين خيرٌ لنا، لأنه لولا اعتراضاتهم ما حصلنا على أجوبة المسيح المفيدة.
٤١ «وَفِيمَا كَانَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ مُجْتَمِعِينَ سَأَلَهُمْ يَسُوعُ».
مرقس ١٢: ٣٥ الخ ولوقا ٢٠: ٤١ الخ
هذا الاجتماع هو نفس الذي ذُكر في ع ٣٤. ولعلهم كانوا محيطين به يتوقعون أن ينطق بما يشتكون به عليه.
سَأَلَهُمْ بعد أن سألوه فأفحمهم. وقد سألهم ليظهر للشعب جهل الفريسيين لكتبهم، وعدم معرفتهم بالصفات المميزة للمسيح المنتظر، وليعلّم تلاميذه كيف يفسرون النبوات المتعلقة به، وليُثبت لاهوته وسلطانه.
٤٢ «مَاذَا تَظُنُّونَ فِي ٱلْمَسِيحِ؟ ٱبْنُ مَنْ هُوَ؟ قَالُوا لَهُ: ٱبْنُ دَاوُدَ».
فِي ٱلْمَسِيحِ أي في شخصه وحقيقته.
ٱبْنُ مَنْ هُوَ؟ غايته من هذا السؤال أن يبين أنه ابن الله وابن الإنسان، أي أنه شخص واحد ذو طبيعتين.
ٱبْنُ دَاوُدَ أجابوه بذلك بلا توقف، لأن المسيح اشتهر عندهم بهذا الاسم بدليل أنهم لما رأوا معجزاته قالوا «ألعلَّ هذا هو ابن داود؟» (متّى ١٢: ٢٣) وأن المرأة الفينيقية صرخت إليه قائلة «ارْحَمْنَا يَا سَيِّدُ، يَا ابْنَ دَاوُدَ!» (متّى ٢٠: ٣٠) وأن الذين احتفلوا بدخوله أورشليم صرخوا قائلين «أوصنا لابن داود» وكذا كان صراخ الأولاد في الهيكل (متّى ٢١: ٩، ١٥) فذلك الجواب حق ولكنه بعض الحق (لوقا ١: ٣٢ ورومية ١: ٣، ٤). فاكتفى الفريسيون به غير ملتفتين إلى عدم كفايته لموافقة كل النبوات المتعلقة بالمسيح.
وجهل أكثر اليهود طبيعة المسيح الإلهية للحجاب الذي كان يفصل بين قلوبهم وبين نور الحق، وهو حجاب جعلهم يتوقعون أن يكون المسيح ملكاً زمنياً مثل كورش أو إسكندر الكبير أو يوليوس قيصر، يجلس على كرسي داود ويجدد عظمة المملكة اليهودية. فعلى ذلك لم يلزم عندهم أن يكون له سوى الطبيعة البشرية والمساعدة الإلهية.
٤٣، ٤٤ «٤٣ قَالَ لَـهُمْ: فَكَيْفَ يَدْعُوهُ دَاوُدُ بِٱلرُّوحِ رَبّاً قَائِلاً: ٤٤ قَالَ ٱلرَّبُّ لِرَبِّي ٱجْلِسْ عَنْ يَمِينِي حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءَكَ مَوْطِئاً لِقَدَمَيْكَ؟».
مزمور ١١٠: ١ وأعمال ٢: ٣٤ و١كورنثوس ١٥: ٢٥ وعبرانيين ١: ١٣ و١٠: ١٢، ١٣
يتبين من هذين العددين ثلاثة أمور: (١)إن داود كتب المزمور المقتبس منه، وهو المزمور ١١٠. (٢) أنه كتبه بالوحي. (٣)أنه لم ينبئ بملك عادي من نسله بالمسيح المنتظر.
يَدْعُوهُ دَاوُدُ أي في المزمور. والمقصود هنا خاصة مزمور ١١٠ لأن اليهود كلهم اعتقدوا أنه إنباء بالمسيح. ويؤيد ذلك آيات كثيرة (انظر أعمال ٢: ٣٤ و١كورنثوس ١٥: ٢٥ وعبرانيين ١: ١٣ و٥: ٦ و٧: ١٧ و١٠: ١٣).
بِٱلرُّوحِ أي بوحي الروح القدس فهو معصوم. وهذا قول واحد من أقوال كثيرة للمسيح تُثبت أن العهد القديم من وحي الله.
رَبّاً دعوة داود المسيح رباً اعتراف بأن المسيح أعظم منه، لأن هذا ما يقال من الأدنى إلى الأعلى. فلو كان المسيح مجرد إنسان من نسل داود لكان دون داود فكيف يليق بداود الملك العظيم المقتدر الذي لم يعرف رباً له إلا الله أن يدعو واحداً من نسله ربه. فهل يحسن بإبراهيم أن يدعو واحداً من نسله ربهُ. فهل يحسن بإبراهيم أن يدعو إسحاق ابنه أو يعقوب حفيده رباً له؟ فمن المحال أن يكرم الابن البشري رباً لأبيه.
ٱلرَّبُّ أي الآب، وهو الأقنوم الأول في الثالوث، وهو المتكلم.
لِرَبِّي هذا الرب هو المسيح ضرورة، لأن الله لا يخاطب بما خاطب به هذا الرب ملكاً أرضياً. والياء (ي) في ربي راجعة لداود.
عَنْ يَمِينِي يراد باليمين مكان الإكرام الأعظم (١ملوك ٢: ١٩ و١صموئيل ٢٠: ٢٥ ومتّى ٢: ٢١). والجلوس عن يمين الملك دليل على الاشتراك في المجد والسلطان الملكي.
أَعْدَاءَكَ مَوْطِئاً هذا مجاز مبني على عادة الملوك قديماً، فقد كانوا يضعون أقدامهم على رقاب أسراهم دلالة على كمال النصر (يشوع ١٠: ٢٤ و٢صموئيل ٢٢: ٤١ و١كورنثوس ١٥: ٢٥ وعبرانيين ١٠: ١٣) وتتم هذه النبوة بما يفعله المسيح في اليوم الأخير.
٤٥ «فَإِنْ كَانَ دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبّاً، فَكَيْفَ يَكُونُ ٱبْنَهُ؟».
لم يرد هنا جواب لهذا السؤال، ولكنه ورد في رومية ١: ٣، ٤ وهو أن المسيح إنسان وإله، فهو ابن داود في ناسوته، ورب داود في لاهوته. ولأنه إله كان في زمن داود كما كان منذ الأزل، رب داود وملكه. ولأنه إنسان كان ابنه، جاء من نسله. وإن كان الفريسيون جهلوا هذا الجواب كما ادعوا بسكوتهم، فهم أذنبوا لأنهم جهلوا النبوات أو تغافلوها، ولأن المسيح أعلن لهم سابقاً بتعليمه أنه ابن الله وابن الإنسان (يوحنا ١٠: ٢٤ - ٣٨). وهذا ما اشتكوا به عليه إلى بيلاطس (يوحنا ١٩: ٧) وسؤال قيافا المسيح «هَلْ أَنْتَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ؟» يدل على أنه لم يجهل ذلك الجواب (متّى ٢٦: ٦٣).
وفي هذا الأصحاح أدلة كثيرة على حكمة المسيح السامية، لأنه أوضح تعاليمه الصادقة، ولم يقع في شيء من الفخاخ التي أخفاها له أعداؤه الكثيرون البارعون في كل أنواع المكر والاحتيال. وعلاوة على ذلك فإنه أخجلهم وأبكمهم.
٤٦ «فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يُجِيبَهُ بِكَلِمَةٍ. وَمِنْ ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ لَمْ يَجْسُرْ أَحَدٌ أَنْ يَسْأَلَهُ بَتَّة».
مرقس ١٢: ٣٤ ولوقا ١٤: ٦ و٢٠: ٤٠
فَلَمْ يَسْتَطِعْ لم يستطيعوا لأنهم لم يريدوا لئلا يبرهنوا بكلامهم أنهم على ضلال.
يَسْأَلَهُ بَتَّة قصد أن يوقعه بما يشتكي به عليه. واعتزلوا ذلك لاختبارهم سوء عاقبته لهم.
الأصحاح الثالث والعشرون
في هذا الأصحاح آخر خُطب المسيح العلنية العامة. ولما فرغ من الخطاب خرج من الهيكل واقتصر بعد ذلك على تعليم تلاميذه. وكل هذا الأصحاح خطاب واحد لا مجموع أقوال مختلفة، كرر فيه بعض ما قاله قبلاً (انظر لوقا ١١: ٤٣ - ٤٥ و١٣: ٣٣ - ٣٦). وخلاصة هذا الخطاب هي إنذار الشعب وتحذيره من معلميه الدينيين. نعم فيه صرامة ولكنها نتجت عن محبته وشفقته، لأن غايته كانت تحذير الغنم من الذئاب.
١ «حِينَئِذٍ خَاطَبَ يَسُوعُ ٱلْجُمُوعَ وَتَلاَمِيذَهُ».
حِينَئِذٍ أي في الوقت الذي أبكم فيه المعترضين.
ٱلْجُمُوعَ وَتَلاَمِيذَهُ الأرجح أن التلاميذ كانوا قريبين منه وأن الجموع كانوا محيطين بهم.
٢ «قَائِلاً: عَلَى كُرْسِيِّ مُوسَى جَلَسَ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ».
نحميا ٨: ٤، ٨ وملاخي ٢: ٧ ومرقس ١٢: ٣٨ ولوقا ٢٠: ٤٦
كُرْسِيِّ مُوسَى كان موسى مشرِّعاً وقاضياً لبني إسرائيل (خروج ١٨: ١٣) وقد خلفه في ذلك معلمو الناموس ومفسروه، فحُسبوا أنهم جلوس على كرسيه.
جَلَسَ كان من عادات المعلمين في ذلك العصر أن يجلسوا وقت التعليم.
ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّون كان أكثر الكتبة من فرقة الفريسيين، ولذلك بكّتهم المسيح معاً. وكثيراً ما كان المسيح يحادث الكتبة في زمن تبشيره، ويجتهد أن يقنعهم بأنهم ضالون وأثمة. ولكنهم لم يستفيدوا شيئاً من تعليمه ولا من مشاهدتهم آياته، فأخذ يحذر تلاميذه منهم.
٣ «فَكُلُّ مَا قَالُوا لَكُمْ أَنْ تَحْفَظُوهُ فَٱحْفَظُوهُ وَٱفْعَلُوهُ، وَلٰكِنْ حَسَبَ أَعْمَالِهِمْ لاَ تَعْمَلُوا، لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ وَلاَ يَفْعَلُونَ».
رومية ٢: ١٩ الخ
فَكُلُّ مَا قَالُوا مما هو وفق شريعة موسى فقط، وحذرهم سابقاً من اتّباع تقاليدهم (متّى ١٥: ١ - ٦). وكان الكتبة والفريسيون أعضاء المجلس الكبير، فكانت لهم سلطة سياسية. ولهذا أمر يسوع تلاميذه أن يكرموهم الإكرام اللائق بوظيفتهم، ويطيعوهم في الأمور السياسية التي لا تخالف شريعة الله. وكانوا رؤساء الدين أيضاً، فوجب أن يطاعوا في كل ما يأمرون به من الشريعة الإلهية، ولو كانوا أشراراً.
حَسَبَ أَعْمَالِهِمْ لاَ تَعْمَلُوا ذكرت مخالفة أعمالهم لتعليمهم في رومية ٢: ١٨ - ٢٤. فأقدس الوظائف لا تقدس أصحابها. فمن الخطأ أن نكرم سيرة معلمي الدين إن كانت شريرة. وهذا الخطأ شاع في كل زمان ومكان. فيا له من توبيخ صارم أن نكون قوالين غير فعالين، كأنما ديانتنا هي باللسان فقط لا في القلب. وأكثر ما ينطبق هذا على رجال الدين. فليحذر خدامه قبل أن يحذروا الآخرين!
٤ «فَإِنَّهُمْ يَحْزِمُونَ أَحْمَالاً ثَقِيلَةً عَسِرَةَ ٱلْحَمْلِ وَيَضَعُونَهَا عَلَى أَكْتَافِ ٱلنَّاسِ، وَهُمْ لاَ يُرِيدُونَ أَنْ يُحَرِّكُوهَا بِإِصْبِعِهِمْ».
أَحْمَالاً ثَقِيلَةً أمر الفريسيون الشعب بحفظ الشريعة الموسوية الطقسية بكل اعتناء، فكان ذلك نيراً ثقيلاً كما شهد بطرس الرسول (أعمال ١٦: ١٠). وكلفوا الشعب بكثير من بذل الوقت والتعب والنفقات، فكان اليهود بما حمَّلهم الفريسيون كدوابٍ حُمِّلت أثقالاً فوق طاقتها.
لاَ يُرِيدُونَ أَنْ يُحَرِّكُوهَا فإنهم أبوا أن يشاركوا الشعب في شيء من نفقات الهيكل. ولم يكلفوا أنفسهم بممارسة شيء من الطقوس ليرضوا الله، ولم تكن عبادتهم قلبية ولو كلفتهم القليل، كحركة الإصبع.
٥ «وَكُلَّ أَعْمَالِهِمْ يَعْمَلُونَهَا لِكَيْ تَنْظُرَهُمُ ٱلنَّاسُ، فَيُعَرِّضُونَ عَصَائِبَهُمْ وَيُعَظِّمُونَ أَهْدَابَ ثِيَابِهِمْ».
متّى ٦: ١، ٢، ٥، ١٦ وعدد ١٥: ٣٨، ٣٩ وتثنية ٦: ٨ و٢: ١٢ وأمثال ٣: ٣
وَكُلَّ أَعْمَالِهِمْ أي الأعمال الدينية.
لِكَيْ تَنْظُرَهُمُ ٱلنَّاسُ فيمدحونهم بالتقوى، غير مكترثين برضى الله الذي هو القصد الوحيد من كل أمور الدين (متّى ٦: ٥)
فَيُعَرِّضُونَ عَصَائِبَهُمْ قال الله لشعبه بفم موسى في شأن الناموس «فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك» (خروج ١٣: ١٦) وقال في كلماته «اربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك» (تثنية ٦: ٨ و١١١: ١٨ وأمثال ٣: ١، ٣ و٦: ٢١). فاتخذ اليهود هذا المجاز حقيقة، وأخذوا أربع جمل من الشريعة الأولى (من خروج ١٣: ١ - ١٠) والثانية من خروج ١٣: ١١ - ١٦ والثالثة من تثنية ٥: ٤ - ٩ والرابعة من تثنية ١١: ١٣ - ٢١. وكتبوها على رقٍ وجعلوها أحرازاً ربطوها على عضد أيديهم اليسرى ليكون أقرب إلى القلب، وآخر على الجبهة بين العينين بربط من الجلد.
وكان كل يهودي مكلفاً بذلك متّى بلغ سن الثالثة عشرة. وكانوا يأتون ذلك وقت العبادة فقط. وأما الفريسيون فكانوا يلبسونها دائماً في كل مكان حتى في الأسواق، ويعرضونها أكثر من غيرهم للتظاهر بزيادة التقوى والغيرة في الناموس. ولم يأت اليهود ذلك إلا بعد سبي بابل.
أَهْدَابَ ثِيَابِهِمْ أمر الله اليهود أن يجعلوا على هدب الذيل عصابة أسمانجونية (عدد ١٥: ٣٧ - ٤١ وتثنية ٢٢: ١٢) ليتذكروا وصايا الله عندما ينظرون إليها كالخيط الذي يعقد على الإصبع ليذكر من ربطه سبب ربطه. ونسب اليهود إلى تلك العصابة قداسة خاصة، فلذلك لمست المرأة المصابة بنزف الدم مثلها من ثوب المسيح (متّى ٩: ٢٠ ولوقا ٨: ٤٤ انظر أيضاً متّى ١٤: ٣٦). وأمر الكتبة أن يكون عدد الخيوط الأسمانجونية في الهدب ٦١٣ وفق عدد أوامر الشريعة، على ما ظنوا. وكبر الفريسيون أهداب ثيابهم أكثر من غيرهم دلالة على زيادة اجتهادهم في حفظ دقائق الشريعة.
٦ «وَيُحِبُّونَ ٱلْمُتَّكَأَ ٱلأَوَّلَ فِي ٱلْوَلاَئِمِ، وَٱلْمَجَالِسَ ٱلأُولَى فِي ٱلْمَجَامِعِ».
ٱلْمُتَّكَأَ ٱلأَوَّلَ كانت المائدة من موائد الولائم عند اليهود مؤلفة من ثلاث قطع. على طرفي واحدة منها الاثنتان الأخريان على وضع عمودي. فتشبه مربعاً نزع أحد أضلاعه. فيكون الرابع مدخلاً لموزعي الطعام. وكانوا يضعون حول ثلاثة الجوانب الخارجة منها أسرة يتكئ عليها الأَكلة ورؤوسهم على أكفهم اليسرى متجهة إلى المائدة، وأرجلهم منفرجة إلى الوراء. فكان متكأ صاحب الوليمة في الصدر مقابل مدخل المائدة، والمتكأ الأول أي محل الشرف عن يمينه. فرغب الفريسيون فيه للكبرياء.
ٱلْمَجَالِسَ ٱلأُولَى كان في صدر كل مجمع يهودي صندوق تحفظ فيه رقوق الشريعة، ومنبر تقرأ عليه التوراة. وقرب ذلك المنبر مجالس يجلس عليها شيوخ المجامع تجاه الشعب، فرغب الفريسيون في الجلوس عليه تكبراً على غيرهم. وبذلك أخطأوا، وإلا فمجرد الجلوس عليها ليس خطية.
٧ «وَٱلتَّحِيَّاتِ فِي ٱلأَسْوَاقِ، وَأَنْ يَدْعُوَهُمُ ٱلنَّاسُ: سَيِّدِي سَيِّدِي».
ٱلتَّحِيَّاتِ فِي ٱلأَسْوَاقِ لم يكتفِ الفريسيون بالتحيات العادية التي يليق استعمالها بالجميع، بل أحبوا أن يحييهم الناس بأعظم التحيات بدعوى أنهم أقدس من غيرهم. فكانوا يذهبون إلى الأسواق حيث يكثر الناس، طمعاً في أن ينالوا التحيات هناك.
سَيِّدِي سَيِّدِي هذا ترجمة «ربي» في اليونانية ومعناها في الأصل رئيس، ثم أُطلقت على المعلم الديني. وكان عند اليهود ثلاثة ألقاب شرف يلقبون بها المعلمين قدر علمهم وقداستهم، وهي: راب ورابي ورابوني. والثاني أعظم من الأول والأخير أعظم من كليهما. فرغب الفريسيون أن يلقبوا ببعض تلك الألقاب.
وما أصدق هذا الوصف على رجال الدين الذين يهتمون بالمظاهر فقط، الذين لسوء الحظ مرات كثيرة يصدق فيهم القول «لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها». وما أشد انطباق هذا الكلام على الذين يتخذون الوظائف وسيلة للعظمة لا غاية للخدمة.
٨ «وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلاَ تُدْعَوْا سَيِّدِي، لأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدٌ ٱلْمَسِيحُ، وَأَنْتُمْ جَمِيعاً إِخْوَةٌ».
٢كورنثوس ١: ٢٤ ويعقوب ٣: ١ و١بطرس ٥: ٣
وأما أنتم فلا تُدعَوا سيدي: أي لا تقبلوا الألقاب التي تشير إلى الشرف الديني والأفضلية في التقوى أو السلطان المتعلق بها. وقد منع المسيح تلاميذه من قبول تلك الألقاب لأنها من علامات الكبرياء، ولأنها علامة رئاسة في الروحيات لم يسلم المسيح بأن تكون بين التلاميذ.
لأن معلمكم واحد المسيح: لا ريب في أن المسيح وحده هو المستحق أن يكون معلماً في الكنيسة، بمعنى أنه يسن شرائعها إذ هو وحده معصوم من الغلط. وكل من يدَّعي حق سن الشرائع من البشر، أو يغير الذي رسمه المسيح، يسلب حقوق المسيح، لأن المسيح هو معلم الكنيسة (يوحنا ١٣: ١٣)، وهو الرئيس الوحيد لها، ولم يزل حياً ليرشدها بحضوره الروحي القدوس. فهو لا يحتاج إلى خليفة
إِخْوَةٌ أي أنكم قدام الله وفي الكنيسة متساوون في الرتبة والشرف. وما قيل في هذا العدد لا يمنع أن يكون في كنيسة المسيح معلمون بأمره، يعلمون الشعب التعليم الذي وضعه هو، وأن يسموا بألقاب تشير إلى أنواع وظائفهم كرعاة وشيوخ الخ (كولوسي ١٢: ٢٨ وأفسس ٤: ١١) ولا يمنع من تلقيبنا بعض الناس بما يدل على اعتبارنا إياهم لتقدمهم في السن أو في العلم، ولكنه يمنع من ادعاء السلطان الشخصي في الكنيسة والأمور الروحية، ويمنع من روح الكبرياء ومحبة المدح والحصول على الإكرام العالمي.
٩ «وَلاَ تَدْعُوا لَكُمْ أَباً عَلَى ٱلأَرْضِ، لأَنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ».
ملاخي ١: ٦
أَباً عَلَى ٱلأَرْضِ منع هنا من إعطاء الإكرام والطاعة المختصين بالله وحده لأحد من الناس. فإقامة إنسان مقام الله عبادة وثنية كإقامة صنم. والمسيح لم يُجز لأحد أن يدَّعي على الكنيسة رئاسة كرئاسة الأب لعائلته. ولم يسمح لأحد أن يطيع غيره من الناس في الروحيات الطاعة التي تجب على الابن لأبيه في الأمور الدينية (رومية ١٤: ٤، ١٠، ١٢ و١بطرس ٥: ٣). وهذا لا يمنع الولد من أن يسمي والده أباً (أفسس ٦: ٤) ولا الشاب من أن يلقب بذلك الأكبر منه سناً احتراماً له (قضاة ١٧: ١٠ و٤٨: ١٩ و٢ملوك ٦: ٢١ و١٣: ١٤ وأعمال ٧: ٢ و٢٢: ١ و١كورنثوس ٤: ١٥ و١يوحنا ٢: ١٣، ١٤) ولا يمنع من تلك التسمية إشعاراً بالمحبة كما فعل بولس (١كورنثوس ٤: ١٤، ١٥ وفليمون ١٠). وكما فعل بطرس (١بطرس ٥: ١٣). إن كان الله أبانا فمن نحن بقية البشر مهما عظم مركزنا الديني.
لأَنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ بمعنى أنه رب الضمير الوحيد (أفسس ٤: ٦ وعبرانيين ١٢: ٩) فشرائعه التي في كتابه هي الشرائع الوحيدة التي كلف الكنيسة بها. وتعليم المسيح إيانا أُبوة الله من أفضل التعاليم. ولو لم يعلم العالم إلا ذلك لكفى أن يأتي من السماء إلى الأرض. نعم عرف الناس الله خالقاً وملكاً ودياناً قبل مجيء المسيح، لكنهم لم يعرفوه أباً.
١٠ «وَلاَ تُدْعَوْا مُعَلِّمِينَ، لأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدٌ ٱلْمَسِيحُ».
مُعَلِّمِينَ معنى هذا العدد كالعدد السابق. ورغب الفريسيون في ثلاثة ألقاب وهي «سيدي» و «أب» و «معلم» فحذر المسيح تلاميذه من طلب تلك الألقاب كبرياء، أو تلقيبهم الناس بها طاعة لهم في الروحيات. ولم يرد المسيح أن نقيم مقامه أحداً من البشر ولو أفضلهم، لأنهم ليسوا معصومين من الغلط ليكونوا معلمين مكانه. وليسوا قادرين أن يكفروا عن الآثام ككهنة. ولم يعينهم الله وسطاء بينه وبيننا لأنهم أناس انفعالاتهم كانفعالاتنا، يحتاجون مثلنا إلى دم المسيح وإرشاد الروح القدس. نعم يميل الناس أن يستندوا على رئيس ديني منظور، لكن الاستناد على المسيح غير المنظور أكثر أمناً. ورغب الكتبة في أن يكونوا رؤساء أحزاب تنسب إليهم كحزب هليل وحزب شمعي، أما المسيح فلم يشأ أن يكون في كنيسته أحزاب ولا أن تنسب تلك الأحزاب إلى البشر. ووبخ بولس الكورنثيين لمخالفتهم هذا (١كورنثوس ١: ١٢، ١٣) وقال يعقوب «لاَ تَكُونُوا مُعَلِّمِينَ كَثِيرِينَ يَا إِخْوَتِي، عَالِمِينَ أَنَّنَا نَأْخُذُ دَيْنُونَةً أَعْظَمَ!» (يعقوب ٣: ١) فالمسيح هو المعلم الوحيد في الروحيات الذي يجب أن نطيعه. فليس لأحد من الناس حق أن يأمر بشيء في الأمور الروحية لا يستطيع أن يُثبته بقوله «هكذا قال الرب».
١١ «وَأَكْبَرُكُمْ يَكُونُ خَادِماً لَكُمْ».
متّى ٢٠: ٢٦، ٢٧
تكلم المسيح سابقاً بما يوافق هذا المعنى، وفيه قاعدة ملكوته الضرورية وهي أن عظمة الإنسان على قدر نفعه. فالذي يخدم المسيح وكنيسته أكثر من غيره هو أعظم من ذلك الغير. والمسيح نفسه خير مثال لتلك العظمة لأنه «لم يأتِ ليخدَم بل ليخدُم». وسمَّى الناس الذين أضروا البشر بحروبهم كإسكندر الكبير ويوليوس قيصر ونابليون «عظماء». وأما المسيح فسمَّى خادمي البشر ونافعيهم «عظماء». فإذا رفضنا ألقاب الرئاسة وتلقبنا بألقاب الخدمة ونحن نخالف ذلك فعلاً، كان عملنا عبثاً.
١٢ «فَمَنْ يَرْفَعْ نَفْسَهُ يَتَّضِعْ، وَمَنْ يَضَعْ نَفْسَهُ يَرْتَفِع».
أيوب ٢٢: ٢٩ وأمثال ١٥: ٣٣ و٢٩: ٢٣ ولوقا ١٤: ١١ و١٨: ١٤ ويعقوب ٤: ٦ و١بطرس ٥: ٥
يكره الله المتكبرين ويخفض الأعين المرتفعة. والكبرياء من أعظم الموانع لنمو الفضائل المسيحية، بدليل قول المسيح «كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجداً بعضكم من بعض» (يوحنا ٥: ٤٤) فالله يحب المتواضعين ويرفعهم في حينه (١بطرس ٥: ٥). فالتواضع من أفضل البراهين على تجديد القلب وتقترن به مواعيد كثيرة.
١٣ «لٰكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ، لأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ فَلاَ تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلاَ تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ».
لوقا ١١: ٥٢
أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وجه المسيح بقية كلامه من وعظه في الهيكل إلى الكتبة والفريسيين، بعدما خاطب تلاميذه بالجزء الأول منه وذلك من عدد ١ - ١٨، وصرح بإثم معلمي الدين غير الأمناء من اليهود. فقال لهم ثماني مرات «ويلٌ لكم» وسبع مرات «أيها المراؤون» ومرتين «أيها الجهال والعميان» ومرة «أيها الحيات أولاد الأفاعي».
كان وعظ المسيح الأول العام مجموع تطويبات لتلاميذه الحقيقيين (ص ٥) وكان وعظه الأخير العام مجموع ويلات وتهديدات لأعدائه.
تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ الخطية الأولى التي وبخ عليها الكتبة والفريسيين هي محاربتهم للملكوت الجديد الذي أتى المسيح لينشئه بتعليمه، أي مقاومتهم للإنجيل. وكان هؤلاء باعتبارهم معلمي الشعب كحفظة مفاتيح قصر استعملوها للإغلاق دون الفتح، بدليل قوله «لأَنَّكُمْ أَخَذْتُمْ مِفْتَاحَ الْمَعْرِفَةِ. مَا دَخَلْتُمْ أَنْتُمْ، وَالدَّاخِلُونَ مَنَعْتُمُوهُمْ» (لوقا ١١: ٥٢) لأنهم رفضوا إنذار يوحنا المعمدان وتعاليم المسيح وشهادة معجزاته وأدلة النبوات الواضحة المتعلقة به المثبتة دعواه، وصدوا الناس عن معرفة طريق الخلاص بوضعهم الطقوس مكان قداسة القلب والسيرة.
ٱلدَّاخِلِينَ أي عامة الشعب الذين سمعوا المسيح بسرور (مرقس ١٢: ٣٧) ومالوا إلى الإيمان به، ولكن الرؤساء أنذروهم وأغروهم برفضه، وأغلقوا ملكوت السماء قدام الناس بثلاثة أمور: (١) سوء تعليمهم و(٢) سوء سيرتهم و(٣)اضطهادهم. ولم تزل أبواب السماء مغلقة قدام الناس في أماكن كثيرة بمثل تلك الأمور إلى هذه الساعة.
١٤ «وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ، لأَنَّكُمْ تَأْكُلُونَ بُيُوتَ ٱلأَرَامِلِ، وَلِعِلَّةٍ تُطِيلُونَ صَلَوَاتِكُمْ. لِذٰلِكَ تَأْخُذُونَ دَيْنُونَةً أَعْظَمَ».
مرقس ١٢: ٤٠ ولوقا ٢٠: ٤٧ و٢تيموثاوس ٣: ٦ وتيطس ١: ١١
الخطية الثانية: هي التي وبخ المسيح الكتبة والفريسيين عليها هي الطمع، فإنه حملهم على خطيتين: ظلم الناس، واتخاذ الدين وسيلة إلى حشد الأموال.
تَأْكُلُونَ بُيُوتَ ٱلأَرَامِلِ كان الكتبة والفريسيون فقهاء الشعب فوكل إليهم المحتضرون كتابة الوصية واتخذوهم أوصياء، فاغتنموا بذلك الفرصة لاختلاس أموال الناس، ولا سيما أموال الأرامل العاجزات عن مقاومتهم. واقتصر المسيح على أكلهم بيوت الأرامل لأن ظلمهم إياهن أفظع من ظلمهم غيرهن، لأنهن موضوع شفقة الله والإنسان.
تُطِيلُونَ صَلَوَاتِكُمْ أطالوا صلواتهم بسبب الطمع، فإنهم أطالوها ليحسبهم الناس أتقياء ويوكلوهم على أموالهم وأموال أولادهم، أو أن يقدموا لهم التقدمات باعتبار أنهم أولياء الله. قيل إن بعض الفريسيين كان يشغل ثلاث ساعات متوالية بالصلاة. والمسيح لم يوبخهم على مجرد إطالة الصلاة بل على غايتهم الخداعية من تلك الإطالة.
تَأْخُذُونَ أي تجلبون على أنفسكم باستحقاقكم.
دَيْنُونَةً أَعْظَمَ أي عقاب الله في جهنم. وكانت دينونتهم أعظم من دينونة غيرهم، لأنهم اتخذوا وظيفتهم التي هي رئاسة الشعب ووكالة الله سبباً في سلب أموال الناس، وجعلوا التقوى تجارة وستراً للإثم.
١٥ «وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ، لأَنَّكُمْ تَطُوفُونَ ٱلْبَحْرَ وَٱلْبَرَّ لِتَكْسَبُوا دَخِيلاً وَاحِداً، وَمَتَى حَصَلَ تَصْنَعُونَهُ ٱبْناً لِجَهَنَّمَ أَكْثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَفاً».
رؤيا ١٨: ٦
الخطية الثالثة: هي غيرتهم الطائفية التي لم تنتج عن محبة الحق.
تَطُوفُونَ ٱلْبَحْرَ وَٱلْبَرَّ هذا كلام جارٍ مجرى المثل يشير إلى أعظم الاجتهاد .
دَخِيلاً الدخيل الوثني يتهوَّد بقبوله الختان والمعمودية وسائر طقوس الديانة. فالمسيح لا يوبخ على الاجتهاد في إرشاد الوثنيين الجهلاء إلى الحق والخلاص شفقة على نفوسهم وغيرة لله، لكنه يوبخ على الاجتهاد الذي غايته نوال المدح من الناس وزيادة عدد الطائفة لزيادة القوة الشخصية.
ٱبْناً لِجَهَنَّمَ أي مثل الذين في جهنم وأهلاً لها. وهذا وصف لمن جاوز الحد في الشر. ولا نتوقع أن يتبع المرائين إلا المراؤون! فكان دخلاء الفريسيين حينئذٍ ليسوا وثنيين مخلصين ولا يهوداً مخلصين، فإنهم هدموا حواجز الخطية التي وضعها دينهم الأول، ولم يأخذوا شيئاً من حواجز الدين الثاني، فظلوا غائصين في شرور الوثنيين، وزادوا عليها شرور اليهود، فضوعفت لهم دينونة الدينين. ومثال أولئك الدخلاء بيت هيرودس، الذين كانوا أكبر الأشرار. وانتقاد المسيح لدخلاء الفريسيين لا يعني أنه يذم كل الدخلاء، فإن بعضهم كانوا من الأتقياء المخلصين (أعمال ١٣: ٤٣).
١٦ «وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْقَادَةُ ٱلْعُمْيَانُ ٱلْقَائِلُونَ: مَنْ حَلَفَ بِٱلْهَيْكَلِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلٰكِنْ مَنْ حَلَفَ بِذَهَبِ ٱلْهَيْكَلِ يَلْتَزِمُ».
متّى ١٥: ١٤ وع ٢٤ ومتّى ٥: ٣٣، ٣٤.
الخطية الرابعة: التي ارتكبها الكتبة والفريسيون هي تعليمهم الكاذب في أمر القسم.
ٱلْقَادَةُ ٱلْعُمْيَانُ كانوا بمنزلة القادة للشعب باعتبارهم معلميهم الروحيين، وكانوا كالعميان لأنهم جهلوا طريق الحق، وجرّوا غيرهم إلى طريق الباطل، فكانوا ضالين ومضلين.
ٱلْقَائِلُونَ أي في تعليمهم الشعب.
مَنْ حَلَفَ بِٱلْهَيْكَلِ نهى المسيح عن الحلف بالهيكل قبل ذلك، وصرح بأن ذلك كالحلف بالله (متّى ٥: ٣٤).
فَلَيْسَ بِشَيْء أي لا يوجد على الحالف شيئاً، فمن نذر شيئاً أو وعد بشيء وحلف على القيام بإيفائه بالهيكل، فكأنه لم ينذر ولم يعد. وكثيراً ما شاع الحلف بالهيكل بين اليهود.
بِذَهَبِ ٱلْهَيْكَلِ الأرجح أن المقصود بذلك القربان الذهبي في الخزانة المقدسة. فأذنب أولئك المعلمون لأنهم أجازوا تعليمهم الكذب والحنث خداعاً، والاستخفاف بالمُقسَم به الذي هو الله. وفي هذا التعليم تمييز باطل، والغاية منه تعظيم شأن القرابين وتفضيلها على الهيكل ليرغب الشعب في إكثار التقدمات، فيربح أولئك المعلمون.
يَلْتَزِمُ أي يجب عليه أن يفي بالوعد المقسم عليه.
لم يكن معلمو الناموس يريدون القسم على الإطلاق، ولكنهم جُرّوا للتساهل مع العامة الذين استعملوا القسم على أنواعه رغم التحذير والإنذار. ولكن هؤلاء المعلمين أخطأوا كما يخطئ رجال الدين والكنيسة مرات كثيرة، بأنهم ينزلون للناس بدلاً من أن يرفعوهم.
١٧ «أَيُّهَا ٱلْجُهَّالُ وَٱلْعُمْيَانُ، أَيُّمَا أَعْظَمُ: أَلذَّهَبُ أَمِ ٱلْهَيْكَلُ ٱلَّذِي يُقَدِّسُ ٱلذَّهَبَ؟».
ٱلْجُهَّالُ وَٱلْعُمْيَانُ لأنهم لم يستطيعوا أن يدركوا أن ليس للذهب قداسة في ذاته، وأن القداسة المنسوبة إليه كانت من الهيكل، وأن قداسة الهيكل كانت من الله الذي اتخذه بيتاً يُعبَد فيه. فإذاً تمييزهم بين الحلف بالهيكل والحلف بذهبه باطل، فكلاهما ليس بشيء، والاعتبار كله لإله الهيكل.
١٨ «وَمَنْ حَلَفَ بِٱلْمَذْبَحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلٰكِنْ مَنْ حَلَفَ بِٱلْقُرْبَانِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ يَلْتَزِمُ».
المذبح المقصود هنا هو مذبح المحرقات في دار الكهنة وهو مصنوع من النحاس. وكان طوله ٢٠ ذراعاً وعرضه ٢٠ ذراعاً وعلوه عشر أذرع (٢أخبار ٤: ١) وعليه قدموا كل ذبائحهم الدموية. واعتادوا أن يحلفوا به كثيراً.
بِٱلْقُرْبَانِ المقصود بالقربان هنا ما يقدم على المذبح، فجعلوه أقدس من المذبح ليزيدوا اعتباره في عيون الناس فيزيد ربحهم به.
يَلْتَزِمُ أي يثبت عليه أن يقوم بما حلف بالقربان أن يفعله.
١٩ «أَيُّهَا ٱلْجُهَّالُ وَٱلْعُمْيَانُ، أَيُّمَا أَعْظَمُ: أَلْقُرْبَانُ أَمِ ٱلْمَذْبَحُ ٱلَّذِي يُقَدِّسُ ٱلْقُرْبَانَ؟».
خروج ٢٩: ٣٧
ٱلْجُهَّالُ وَٱلْعُمْيَانُ هذا مثل ما ذكر في ع ١٧ فقد ميَّزوا بين أمرين لا فرق بينهما. فالذي قدس القربان هو المذبح الذي وُضع عليه، والذي قدس المذبح هو الله الذي ذلك المذبح له.
٢٠، ٢١ «٢٠ فَإِنَّ مَنْ حَلَفَ بِٱلْمَذْبَحِ فَقَدْ حَلَفَ بِهِ وَبِكُلِّ مَا عَلَيْهِ، ٢١ وَمَنْ حَلَفَ بِٱلْهَيْكَلِ فَقَدْ حَلَفَ بِهِ وَبِالسَّاكِنِ فِيهِ».
١ملوك ٨: ١٣ و٢أخبار ٦: ٢ ومزمور ٢٦: ٨ و١٣٢: ١٤
علّم المسيح في هذين العددين أن كل قسم بالمذبح أو القربان أو الهيكل أو الذهب هو بالحقيقة قَسمٌ بالله، وأن كل ما ميزه الفريسيون بين الأقسام بها باطل. فالأقسام أو الحلف بواحد مما ذُكر على أمور زهيدة إثمٌ. والأقسام بكل منها في أمور ذات بال يُلزم المُقسم بالقيام بما أقسم به عليه. فكان خطأ الفريسيين بأنهم غفلوا في تعليمهم التمييز بين الأقسام عن الله الشاهد في كل قسَمٍ.
بِالسَّاكِنِ فِيهِ أي بالله الذي كان الهيكل بيته، حيث أظهر مجده قديماً بين الكاروبيم (١ملوك ٨: ١١، ١٣ ومزمور ٨: ١) فكانت الذبائح التي تُقدم فيه لله وكذلك كل صلاة وتسبيح بناءً على أنه مكانٌ تلتقي به روح الإنسان بالله.
٢٢ «وَمَنْ حَلَفَ بِٱلسَّمَاءِ فَقَدْ حَلَفَ بِعَرْشِ ٱللّٰهِ وَبِالْجَالِسِ عَلَيْه».
مزمور ١١: ٤ ومتّى ٥: ٣٤ وأعمال ٧: ٤٩
بِٱلسَّمَاءِ أي السماء العليا حيث يُظهر الله مجده بنوع خاص.
بِعَرْشِ ٱللّٰهِ هذا مأخوذ من عادة الملوك الأرضيين أن يجلسوا على عرش لإظهار مجدهم للرعية. ونتيجة كل ما قيل في شأن الأقسام أنها كلها بالله، وأن كلها متساوية في إلزام الذي أقسم، إذ الشاهد بكلٍ منها هو الله. فلو بقي المسيح على الأرض بالجسد لوبخ كثيرين من الناس اليوم على نفس غلط الفريسيين.
٢٣ «وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ، لأَنَّكُمْ تُعَشِّرُونَ ٱلنَّعْنَعَ وَٱلشِّبِثَّ وَٱلْكَمُّونَ، وَتَرَكْتُمْ أَثْقَلَ ٱلنَّامُوسِ: ٱلْحَقَّ وَٱلرَّحْمَةَ وَٱلإِيمَانَ. كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَعْمَلُوا هٰذِهِ وَلاَ تَتْرُكُوا تِلْك».
لوقا ١١: ٤٢ ، ١صموئيل ١٥: ٢٢ وهوشع ٦: ٦ وميخا ٦: ٨ ومتّى ٩: ١٣ و٢: ٧
الخطية الخامسة: التي ارتكبها الكتبة والفريسيون هي أنهم جعلوا عرضيات الدين جوهرياته، وجوهرياته عرضياته، فاهتموا بالقشور دون اللباب.
تُعَشِّرُونَ أمر الله اليهود في شريعة موسى أن يؤدوا عُشر دخلهم نفقة على اللاويين (لاويين ٢٧: ٣٠ وعدد ١٨: ٢٠ - ٢٤) وعشراً آخر منه لخدمة الهيكل (تثنية ١٤: ٢٢، ٢٤) وعُشراً ثالثاً منه لخدمة لهيكل (تثنية ١٤: ٢٢، ٢٤) وعُشراً آخر ينفقه على الفقراء كل سنة ثالثة (تثنية ١٤: ٢٨، ٢٩). أي أن كل واحد من اليهود كان عليه أن ينفق مما يقرب ثُلث دخله في سبيل الله. هذا علاوة على ما كان يتبرع به.
ٱلنَّعْنَعَ وَٱلشِّبِثَّ وَٱلْكَمُّونَ هذه بقول صغيرة طيبة الرائحة، تستعمل غالباً في الأطعمة لتزيدها لذة. وقد تستعمل أدوية لكنها قليلة القيمة. واختلف اليهود في وجوب تأدية عشرها مع عشر حاصلات الحقول من الحنطة والخمر والزيت المعينة في الشريعة (تثنية ١٢: ١٧). فحكم الكتبة والفريسيون بوجوب تلك التأدية، فلم يلمهم المسيح على ذك الحكم، بل لامهم على أنهم أهملوا التدقيق في أمور أولى منها وألزم.
تَرَكْتُمْ أي غفلتم واستهنتم.
أَثْقَلَ ٱلنَّامُوسِ أي أهم مطالب الشريعة. نعم أن كل مطالب الله في الشريعة ذات شأن، ولكن أعظمها وأهمها قداسة القلب والسيرة وسائر الفضائل الروحية. لكن الفريسيين اعتنوا بالأمور العرضية كأنواع اللباس والطعام وحفظ الطقوس الخارجية، ولم يكترثوا بالتواضع والإيمان والمحبة ونحوها. فإن العهد القديم نفسه صرّح بما هو الأهم فيه (انظر إشعياء ١: ١٧ وميخا ٦: ٨ وهوشع ١٢: ٦)
ٱلْحَقَّ المقصود بالحق هنا التمييز الروحي بين العرض والجوهر، وبين الرمز والمرموز إليه، وظل الخيرات والخيرات نفسها (لوقا ١٢: ٥٧ ويوحنا ٧: ٢٤). ويصح أيضاً أن يراد بالحق هنا العدل.
ٱلرَّحْمَةَ أي إظهار الرفق والشفقة على الناس ولا سيما المصابون والخطاة (متّى ٥: ٧). وكثيراً ما قصر الفريسيون عن هذه الفضيلة (لوقا ٧: ٣٩ ويوحنا ٨: ٣ - ٥).
ٱلإِيمَانَ كثيراً ما ورد الإيمان في العهد القديم بمعنى الأمانة لله والاتكال عليه. وهذه الفضائل الثلاث (الرحمة والحق والإيمان) تشمل أعظم واجباتنا للناس ولله. أما الفريسيون فغفلوا عنها لأنهم كانوا ظالمين منتقمين محبين الذات خادعين مرائين، لكنهم عشروا النعنع والشبث والكمون بكل تدقيق.
هٰذِه أي الواجبات التي اعتنوا بها.
تِلْكَ أي الواجبات العظمى وأنهم اكتفوا بالجزء الأصغر من واجباتهم دون الأعظم وبذلوا كل الجهد في حفظ الطقوس الخارجية بدلاً من الطهارة القلبية. فالتقي بالحق هو الذي يهتم بشريعة الله كلها، بجزئياتها وكلياتها، ويحترم كل وصية منها الاحترام الذي أراده الله لها.
٢٤ «أَيُّهَا ٱلْقَادَةُ ٱلْعُمْيَانُ، ٱلَّذِينَ يُصَفُّونَ عَنِ ٱلْبَعُوضَةِ وَيَبْلَعُونَ ٱلْجَمَل».
ٱلْقَادَةُ ٱلْعُمْيَانُ أهم ما يضطر إليه القادة هو النظر الصحيح، وإلا أضلوا من يقودونهم. وكان عمى الفريسيين أنهم جهلوا خطايا قلوبهم، وهو أشر أصناف العمى، وهو سبب عدم تمييزهم بين الحق والباطل في الروحيات.
يُصَفُّونَ كان عادة اليهود تصفية الخمر والماء أحياناً قبل الشرب لئلا تكون في إحداها بعوضة، وهي بموجب الشريعة نجسة كالجمل. فأكلهما محرَّم (لاويين ١١: ٤، ٢٣، ٤١، ٤٢).
ما أبدع هذه المبالغة وما أوقعها في النفس! فالقول ببلع الجمل من قبيل المجاز الذي يزيد الكلام روعة وجمالاً.
يَبْلَعُونَ ٱلْجَمَل من أعظم الخلاف أن يجتهد الإنسان في حفظ الناموس إلى حدٍ يصفي عنده شرابه عن صغائر كالبعوضة، وهو ولو استطاع لبلع الحيوان الكبير المحرم أكله كالجمل! أراد المسيح بهذا أن يظهر غلط من يتجنب الصغائر ويرتكب الكبائر مطمئناً. ومثال ذلك ما تراءى في سيرة الفريسيين في بذل الدراهم ليهوذا الإسخريوطي ليسلم إنساناً زكياً إلى الموت، وهم يرفضون ضمها إلى خزانة الهيكل عندما ردها إليهم! واستئجار شهود زور على المسيح ووقوفهم خارج دار بيلاطس «صارخين اصلبه اصلبه» وهم يعتزلون دخول تلك الدار خوفاً من أن يتنجسوا. ولومهم التلاميذ على أكلهم الخبز بأيدٍ غير مغسولة، وهم يبطلون الوصية الخامسة من وصايا الله العشر بتعليمهم الكاذب في شأن القربان.
٢٥، ٢٦ «٢٥ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ، لأَنَّكُمْ تُنَقُّونَ خَارِجَ ٱلْكَأْسِ وَٱلصَّحْفَةِ، وَهُمَا مِنْ دَاخِلٍ مَمْلُوآنِ ٱخْتِطَافاً وَدَعَارَةً! ٢٦ أَيُّهَا ٱلْفَرِّيسِيُّ ٱلأَعْمَى، نَقِّ أَوَّلاً دَاخِلَ ٱلْكَأْسِ وَٱلصَّحْفَةِ لِكَيْ يَكُونَ خَارِجُهُمَا أَيْضاً نَقِيّاً».
مرقس ٧: ٤ ولوقا ١١: ٣٩
الخطية السادسة: التي وبخ المسيح الكتبة والفريسيين عليها هي تفضيلهم الطهارة الطقسية على طهارة القلب والسيرة.
خَارِجَ ٱلْكَأْسِ وَٱلصَّحْفَةِ كانوا يغسلون آنية الطعام بكل عناية خوفاً من النجاسة الطقسية (مرقس ٧: ٢ - ٥).
مَمْلُوآنِ ٱخْتِطَافاً وَدَعَارَةً هذا مجاز قُصد به أمران: (١) أنهم حصلوا على طعامهم وشرابهم بالظلم والخداع لأنهم طماعون. و(٢) أنهم شرهوا ونهموا في الطعام والشراب طوعاً لشهواتهم لا لتغذية أجسادهم.
ٱلأَعْمَى نسب المسيح إليه العمى لأنه لم يرَ الأمر الواضح الذي للبصير. وهو فرط جهالة من يدَّعي الطهارة بتنقيته خارج الإناء الذي لا يمس الطعام أو الشراب، وتركه داخله بلا غسل! وأظهر بهذا التعبير جهل الفريسيين باجتهادهم في تطهير أجسادهم وتركهم نفوسهم نجسة بخطايا يكرهها الله والناس.
نَقِّ أَوَّلاً دَاخِلَ.. الخ الكأس النظيفة هي النظيفة خارجاً وداخلاً. والإنسان الطاهر هو الطاهر طقسياً وأخلاقياً. فالأدب الظاهر ليس شيئاً ما لم يكن نتيجة الأدب الباطن. فأول واجبات الإنسان هو أن ينقي قلبه من الشر (إرميا ٤: ١٤). وهذا وفق قول الحكيم «فَوْقَ كُلِّ تَحَفُّظٍ احْفَظْ قَلْبَكَ، لأَنَّ مِنْهُ مَخَارِجَ الْحَيَاةِ» (أمثال ٤: ٢٣) إن الدين هو أساس الأخلاق لا الأخلاق أساس الدين، والله وحده يقدر أن يطهر داخل الإنسان (مزمور ٥١: ٧، ١٠ وحزقيال ٣٦: ٢٥، ٢٦ ويوحنا ٣: ٣، ٥).
٢٧، ٢٨ «٢٧ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ، لأَنَّكُمْ تُشْبِهُونَ قُبُوراً مُبَيَّضَةً تَظْهَرُ مِنْ خَارِجٍ جَمِيلَةً، وَهِيَ مِنْ دَاخِلٍ مَمْلُوءَةٌ عِظَامَ أَمْوَاتٍ وَكُلَّ نَجَاسَةٍ. ٢٨ هٰكَذَا أَنْتُمْ أَيْضاً: مِنْ خَارِجٍ تَظْهَرُونَ لِلنَّاسِ أَبْرَاراً، وَلٰكِنَّكُمْ مِنْ دَاخِلٍ مَشْحُونُونَ رِيَاءً وَإِثْماً».
لوقا ١١: ٤٤ وأعمال ٢٣: ٣
الخطية السابعة: التي وبخ المسيح الكتبة والفريسيين عليها هي الرياء. نعم إن الخطايا التي وبخهم عليها سابقاً لم تخلُص من الرياء، لكن المسيح وبخهم هنا على الرياء المحض الظاهر.
قُبُوراً مُبَيَّضَةً المؤمنون المخلصون هياكل حية مقدسة، وأما الفريسيون المراؤون فليسوا سوى قبور موتى مبيضة. وكان اليهود يحسبون لمس القبر ينجس، بناءً على قوله «كُلُّ مَنْ مَسَّ عَلَى وَجْهِ الصَّحْرَاءِ قَتِيلاً بِالسَّيْفِ أَوْ مَيْتًا أَوْ عَظْمَ إِنْسَانٍ أَوْ قَبْرًا، يَكُونُ نَجِسًا سَبْعَةَ أَيَّامٍ» (عد ١٩: ١٦، ١٨). وكان يهود أورشليم يبيضون قبورهم في الخامس عشر من شهر آذار كل سنة لينتبه لها الغرباء الزائرون، فلا يمسوها غفلة لئلا يتنجسوا. وفعلوا ذلك امتثالاً لقوله «فيعبر العابرون في الأرض، وإذا رأى أحد عظم إنسان يبني بجانبه صوة حتى يقبره القابرون» (حزقيال ٣٩: ١٥) وكان المسيح يخاطب اليهود بذلك في الزمن الذي كانوا قد أكملوا فيه تكليس القبور فكانت بيضاء جداً.
مِنْ خَارِجٍ جَمِيلَةً كان أغنياء اليهود يجتهدون أيضاً في تزيين قبور موتاهم إظهاراً لإكرامهم ومحبتهم لهم، ودلالة على غنى العائلة. ولا لوم عليهم في ذلك لأن الذين يعتقدون بقيامة الأموات يعتنون بمدافن الموتى. وقال المسيح إن الفريسيين مثل تلك القبور، فإن خارجها أبيض جميل، وداخلها عظام أموات! لأنهم يظهرون للناس أتقياء وهم يرتكبون الخطايا الفظيعة عمداً. وهذا هو الرياء الذي يكرهه الله.
مَشْحُونُونَ رِيَاءً وَإِثْماً كان الرياء ظاهرهم كالكلس على القبور: الإثم داخلهم كنجاسة القبور، كالحسد والشهوات والطمع والبُغض والانتقام وحب الرئاسة. والحق أن المرائين كالقبور نجسون ومنجَّسون.
٢٩، ٣٠ «٢٩ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ، لأَنَّكُمْ تَبْنُونَ قُبُورَ ٱلأَنْبِيَاءِ وَتُزَيِّنُونَ مَدَافِنَ ٱلصِّدِّيقِينَ، ٣٠ وَتَقُولُونَ: لَوْ كُنَّا فِي أَيَّامِ آبَائِنَا لَمَا شَارَكْنَاهُمْ فِي دَمِ ٱلأَنْبِيَاءِ!ِ».
لوقا ١١: ٤٧
الخطية الثامنة والأخيرة: التي وبخ المسيح الكتبة والفريسيين عليها هي تظاهرهم بزيادة الاحترام للأنبياء الموتى، وتلويم قاتليهم، بينما هم متمثلون بالقتلة، لا بالأنبياء ولا بالشهداء.
تَبْنُونَ قُبُورَ ٱلأَنْبِيَاءِ الخ أظهر اليهود إعجاباً ظاهرياً بصفات أولئك الأنبياء وإكراماً لأسمائهم، وقصدهم أن يحسبهم الناس أتقياء كالأنبياء غيورين للدين مثلهم. وكان الأولى أن يكرموهم بالسير في خطواتهم والاقتداء بفضائلهم. لكنهم عملوا عمل هيرودس الكبير، فمع أنه عملاق في الإثم بنى قبر داود وزيَّنه أفخر زينة.
وَتَقُولُونَ أي تظهرون بالفعل والكلام. فإنهم أبانوا غيظهم على آبائهم وكرههم لأعمالهم، لكنهم سلكوا سلوك آبائهم باضطهادهم الأتقياء وقصدهم قتل المسيح، فشاركوا آباءهم في قتل رجال الله.
٣١ «فَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنَّكُمْ أَبْنَاءُ قَتَلَةِ ٱلأَنْبِيَاء».
أعمال ٧: ٥١، ٥٢ و١تسالونيكي ٢: ١٥
تَشْهَدُونَ عَلَى أَنْفُسِكُم لأنكم تذمون الخطايا وترتكبونها، وتلومون القتلة وتتمثلون بهم، وتكرمون شهداء الأنبياء ولا تجرون بحسب تعاليمهم ولا تقتفون خطواتهم، فتشهدون على أنفسكم بأنكم تعرفون الحق وأنتم تسيرون في سبيل الشر. فلم يقصد المسيح أن بناءهم المدافن هو بمثابة شهادتهم على أنفسهم، بل اعتمد على أعمالهم، لأن شهادة ذلك البناء زور لمخالفتها سيرة حياتهم.
أَبْنَاءُ قَتَلَةِ ٱلأَنْبِيَاء وذلك ليس بالتسلسل الطبيعي، بل بأعمالكم الشريرة لأنها تظهر تسلسلكم منهم، وأنكم ورثتم خصالهم الخبيثة بأنكم تسيرون في سبلهم، تضطهدون الصديقين وتقصدون قتل المسيح، ورياؤكم في كل ذلك جعلكم مكروهين جداً في عيني الله.
٣٢ «فَٱمْلأُوا أَنْتُمْ مِكْيَالَ آبَائِكُمْ».
تكوين ١٥: ١٦ و١تسالونيكي ٢: ١٦
هذا أمرٌ لفظاً وخبرٌ معنى. فمناه أنهم سيبقون على ما هم عليه إلى أن يملأوا مكيال آبائهم. ويحسن أن نتصور لفهم هذا التشبيه مكيالاً كاد يمتلئ، وأنه متّى امتلأ يُنزع من مكانه. فأراد المسيح أن الأمة اليهودية منذ أيام الآباء ارتكبت إثماً فوق إثم، وذخرت لنفسها غضب الله. فكانت لا تحتاج أن تزيد على ما سلف من آثامها سوى قتل ابن الله ليمتلئ مكيال شرهم، ويأتي وقت نزعهم من مكانهم وزمن عقابهم. وذلك وفق قول الله لإبراهيم في شأن الأموريين «َفِي ٱلْجِيلِ ٱلرَّابِعِ يَرْجِعُونَ إِلَى هٰهُنَا، لأَنَّ ذَنْبَ ٱلأَمُورِيِّينَ لَيْسَ إِلَى ٱلآنَ كَامِلاً» (تكوين ١٥: ١٦). فلم يمتلئ مكيال شرهم إلا بعد مرور ٤٠٠ سنة من خطاب الله لإبراهيم. ويوافقه أيضاً ما قيل في الآيات الآتية (إرميا ٤٤: ٢٢ ورؤيا ١٤: ١٥، ١٨).
٣٣ «أَيُّهَا ٱلْحَيَّاتُ أَوْلاَدَ ٱلأَفَاعِي، كَيْفَ تَهْرُبُونَ مِنْ دَيْنُونَةِ جَهَنَّمَ».
متّى ٣: ٧ و١٢: ٣٤
هذا كلام قوي جداً ولا عجب إن ثاروا حانقين ساخطين. وقارن هذا القول بإنذار يوحنا المعمدان في متّى ٣: ٧.
أَيُّهَا ٱلْحَيَّاتُ شبههم بالحيّات لأنهم مثلها في الخداع والأذى.
أَوْلاَدَ ٱلأَفَاعِي سماهم قبلاً «أبناء قتلة» وسماهم هنا «أبناء الأفاعي» دلالة على المشابهة لشر الحيات.
كَيْفَ تَهْرُبُونَ أي ما دمتم على تلك الصفات لا يمكنكم أن تهربوا من الدينونة.
دَيْنُونَةِ جَهَنَّمَ أي الحكم عليهم بعذاب جهنم. وتكلم المسيح بذلك باعتبار أنه ديان إلهي لمن لا يصغون إلى إنذاره. وهذا خلاصة ما أنبأهم به من قوله «الويل لكم» ثماني مرات. وللمسيح وحده الحق بأن ينطق بمثل ذلك الكلام، لأنه وحده يعلم ما في القلوب، وهو الذي عينه الله دياناً للعالمين.
٣٤ «لِذٰلِكَ هَا أَنَا أُرْسِلُ إِلَيْكُمْ أَنْبِيَاءَ وَحُكَمَاءَ وَكَتَبَةً، فَمِنْهُمْ تَقْتُلُونَ وَتَصْلِبُونَ، وَمِنْهُمْ تَجْلِدُونَ فِي مَجَامِعِكُمْ، وَتَطْرُدُونَ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ».
متّى ١٠: ١٧ و٢١: ٣٤، ٣٥ وأعمال ٥: ٤٠ و٧: ٥٨، ٥٩ و٢٢: ١٩ و٢كورنثوس ١١: ٢٤، ٢٥
أَنْبِيَاءَ وَحُكَمَاءَ وَكَتَبَةً سمَّى اليهود معلميهم في الدين بهذه الأسماء، فاتخذها المسيح أسماء لرسله وسائر المبشرين الذين عزم على أن يرسلهم. وإرسالهم إلى الأشرار برهان على عظمة شفقته عليهم ورغبته في خلاصهم.
فَمِنْهُمْ تَقْتُلُونَ مثل استفانوس (أعمال ٧: ٥) ويعقوب (أعمال ١٢: ١، ٢)
وَتَصْلِبُونَ لم يكن لليهود يومئذٍ أن يصلبوا أحداً، لكنهم كانوا يسلّمون من يحكمون عليه بالموت صلباً إلى الرومان ليجروا الحكم فيه. ولا شك أنهم فعلوا ذلك بالمسيحيين. وعدم وروده في التواريخ ليس دليلاً على عدم حدوثه، لأن تواريخ تل الأزمنة قليلة ومختصرة جداً.
وَمِنْهُمْ تَجْلِدُونَ ومن أمثال ذلك ما ذُكر في سفر الأعمال (أعمال ٥: ٤٠ و٢٢: ١٩، ٢٤) وما ذُكر في ٢كورنثوس ١١: ٢٤، ٢٥.
فِي مَجَامِعِكُمْ (متّى ١٠: ١٧ وأعمال ٢٢: ١٩) لأن المجمع كان مكاناً للحكم والقصاص.
وَتَطْرُدُون الخ وقع ذلك على أكثر الرسل. ولنا مما ذُكر أن منح الله وسائط النعمة يعظم إثم الذين يرفضونها ويعجل عقابهم.
٣٥ «لِكَيْ يَأْتِيَ عَلَيْكُمْ كُلُّ دَمٍ زَكِيٍّ سُفِكَ عَلَى ٱلأَرْضِ، مِنْ دَمِ هَابِيلَ ٱلصِّدِّيقِ إِلَى دَمِ زَكَرِيَّا بْنِ بَرَخِيَّا ٱلَّذِي قَتَلْتُمُوهُ بَيْنَ ٱلْهَيْكَلِ وَٱلْمَذْبَحِ».
رؤيا ١٨: ٢٤ وتكوين ٤: ٨ و١يوحنا ٣: ١٢ و٢أيام ٢٤: ٢٠، ٢١
يَأْتِيَ عَلَيْكُمْ شبَّه المسيح هنا إثم الأمة اليهودية بسفكها الدم الزكيّ، وشبَّه ما استحقته من القصاص على ذلك بنهرٍ يعظُم بكل قتل ارتُكب من أيام هابيل إلى آخر قتل ترتكبه تلك الأمة. وكله يصب دفعة واحدة عليها في الأيام الأخيرة. فإن الأمة اليهودية صُورت في كل عصورها بشخص واحد. وأن الجيل الذي كان في عصر المسيح اشترك بسفكه دم المسيح ورسله في إثم الأمة كلها، بل في إثم كل قاتل منذ خلق الإنسان، ولذلك اشتركت في عقاب أولئك الأثمة (متّى ٢٧: ٢٥ وأعمال ٥: ٢٨) ومن ذلك خراب هيكلهم ومدينتهم، وقتل بعضهم وسبي الباقين.
كُلُّ دَمٍ زَكِيٍّ أي كل عقاب يستحقه سفاك الدم الزكي (٢ملوك ٢١: ١٦ و٢٤: ٤ وإرميا ٢٦: ١٥ ومرقس ٤: ١٣) ومثل ذلك قوله على بابل «وَفِيهَا وُجِدَ دَمُ أَنْبِيَاءَ وَقِدِّيسِينَ، وَجَمِيعِ مَنْ قُتِلَ عَلَى الأَرْضِ» (رؤيا ١٨: ٢٤). فالله عاقب العبرانيين على آثامهم في وقت ارتكابهم إياها بعض العقاب (إشعياء ٩: ١٢ - ١٧). وأبقى إيقاع بعضه على أولادهم الذين تبعوا خطواتهم الأثيمة وفقاً لقوله «أَفْتَقِدُ ذُنُوبَ الآبَاءِ فِي الأَبْنَاءِ فِي الْجِيلِ الثَّالِثِ وَالرَّابعِ مِنْ مُبْغِضِيَّ» (خروج ٢٠: ٥) نعم إن الله لا يحسب إثم الآباء على الأبناء إن كانوا أبرياء «اَلابْنُ لاَ يَحْمِلُ مِنْ إِثْمِ الأَبِ... بِرُّ الْبَارِّ عَلَيْهِ يَكُونُ، وَشَرُّ الشِّرِّيرِ عَلَيْهِ يَكُونُ» (حزقيال ١٨: ٢٠). وذلك بشرط أن لا يرتكب الابن خطية أبيه، ولا يلتمس له العذر عنها، وإلا كان شريكاً له فيها وفي عقابها. وكثيراً ما نرى أن نتائج خطايا الإنسان تقع على أولاده، كفقر أولاد السكارى والمسرفين والذين يخالفون شرائع الصحة والعفة.
دَمِ هَابِيلَ كان هابيل أول قتيل قتله أخوه قايين. وكان اليهود مثل ذلك القاتل روحاً وفعلاً، فشاركوه في العقاب. ويظهر من هذا أن الله يراقب كل المظالم التي تقع على عبيده، ولا بد أن يطالب بدمهم.
زَكَرِيَّا بْنِ بَرَخِيَّا لم يتحقق من هو زكريا هذا. لكن ظن أكثر المفسرين أنه النبي الذي ذُكر في سفر الأيام الثاني (٢أخبار ٢٤: ٢٠ - ٢٢) فإن اليهود قتلوه في دار بيت الرب، وقال عند موته «الرب ينظر ويطالب» ولكن ذاك كان ابن يهوياداع. ويحتمل أنه كان له اسمان كما كان لكثيرين من اليهود، مثل متّى الذي كان اسمه أيضاً لاوي، ومثل لباوس الذي سُمي أيضاً تداوس. ويحتمل أن يكون المقصود بالابن: الحفيد، وذلك وارد بكثرة في الكتاب المقدس. ويوافق ذلك أن يهوياداع مات في سن المئة والثلاثين، ولم يُقتل زكريا إلا بعد موته بمدة. وظن البعض أن المسيح لم يقل «ابن برخيا» لأن لوقا نقل كلام المسيح بدونه، ولم يوجد ذلك في قول متّى في أقدم النسخ. فعلَّة وقوعه هنا هي أن أحد النساخ في القرون الأولى أدخله تفسيراً، فحُسب زكريا بن يهوياداع زكريا بن برخيا كاتب النبوة المعروفة (زكريا ١: ١) ولعل هذا هو الأرجح.
ٱلَّذِي قَتَلْتُمُوه أي قتلته أمتكم، ولكنكم شاركتم القتلة في ذلك لأنكم نسجتم على منوالهم.
بَيْنَ ٱلْهَيْكَلِ وَٱلْمَذْبَح المقصود بالهيكل هنا قدس الأقداس، وبالمذبح مذبح المحرقة تجاهه في دار الكهنة (متّى ٢٦: ٦١ ويوحنا ٢: ١٩).
٣٦ «ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ هٰذَا كُلَّهُ يَأْتِي عَلَى هٰذَا ٱلْجِيلِ».
هذا نتيجة ملئهم مكيال آبائهم. فالذي أضاف آخر جزء إلى المكيال وملأه شريكٌ للذي وضع فيه أول جزء! ولا ظلم في ذلك لأنهم عملوا أعمال آبائهم، وأظهروا أن روحهم كروح أولئك الآباء. ولأنهم قادرون أن يتخلصوا من ورثة الإثم والقصاص بالتوبة وطلب الرحمة.
عَلَى هٰذَا ٱلْجِيلِ خربت أورشليم بعد ذلك بأربعين سنة، فلا بد أن كثيرين من المخاطبين وغيرهم من اليهود المعاصرين شاهدوا خرابها. وبهذا تم قول المسيح حقيقة. وظن كثيرون أن المسيح أراد بقوله «هذا الجيل» أمة اليهود بلا التفات إلى الزمان كما ورد في متّى ١٢: ٤٥ وأعمال ٢: ٤٠ وفي ٢: ١٥ وهو المرجح.
٣٧ «يَا أُورُشَلِيمُ يَا أُورُشَلِيمُ، يَا قَاتِلَةَ ٱلأَنْبِيَاءِ وَرَاجِمَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا، كَمْ مَرَّةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أَوْلاَدَكِ كَمَا تَجْمَعُ ٱلدَّجَاجَةُ فِرَاخَهَا تَحْتَ جَنَاحَيْهَا، وَلَمْ تُرِيدُوا».
لوقا ١٣: ٣٤ وتثنية ٣٢: ١١، ١٢ ومزمور ١٧: ٨ و٩١: ٤
يَا أُورُشَلِيمُ رثى المسيح تلك المدينة بهذا الكلام سابقاً (لوقا ١٣: ٣٤، ٣٥) إظهاراً لشفقته عليها بعد اضطراره إلى إنذارها. أما شفقته فكانت على شعب الأمة المضَلين. وخص المسيح أورشليم بالذكر لأنها المدينة المقدسة عند اليهود ومركز سياستهم ودينهم، ولأنها زادت على غيرها من المدن شراً كما زادت عليها عظمة. ولما رثى أورشليم لم يرثِ الساكنين فيها حينئذٍ فقط، بل رثى كل من سكنها في العصور الماضية، وكل من يسكنها في السنين المستقبلة فقد مثلوا جميعهم أمامه كأنه يخاطبهم وهم يصغون إليه.
قَاتِلَةَ ٱلأَنْبِيَاءِ أي المعتادة أن تسفك دم الأنبياء، والمستعدة أن تسفكه (١ملوك ١٨: ٤ ونحميا ٩: ٢٦ وإرميا ٢: ٣٠ و٢٦: ٢٣ وعبرانيين ١١: ٣٧). وأراد بالأنبياء رُسل الله في كل عصر. وأراد بقوله «قاتلة» كل المظالم والتعديات التي أوقعها اليهود على أولئك الرسل.
رَاجِمَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا متّى ٢١: ٣٥ ويوحنا ١٠: ٣١، ٣٩ وأعمال ٧: ٥٨ و٢١: ٣١ و٢٢: ٢٢، ٢٣.
كَمْ مَرَّةٍ... أَنْ أَجْمَعَ أظهر المسيح بهذا فرط محبته ورقة قلبه على أهل أورشليم، وشوقه الشديد إلى أن يحميهم ويعتني بهم. وأشار بذلك إلى وعظه وإرساله رسله أمام وجهه إليهم.
أَوْلاَدَكِ أي سكانك وسائر أمتك، وأراد بقوله «أجمع» أنه يحميهم من الهلاك الزمني والهلاك الأبدي. ورثى المسيح اليهود للمصائب التي ستأتي عليهم لصلبهم إياه. لكنه لم يرثِ نفسه للآلام التي ستقع عليه منهم.
كَمَا تَجْمَعُ ٱلدَّجَاجَةُ كثر هذا التشبيه في الكتاب المقدس دلالة على عناية الله وحمايته (تثنية ٣٢: ١١ ومزمور ١٧: ٨ و٣٦: ٧ و٥٧: ١ و٦١: ٤ وإشعياء ٣١: ٥ وملاخي ٤: ٢ ومتّى ٢٤: ٢٨).
وَلَمْ تُرِيدُوا (إشعياء ٢٨: ١٢ و٣٠: ١٥ ويوحنا ٥: ٤٠). نعم إن أفراداً من اليهود قبلوا المسيح وآمنوا به ونجوا، ولكن اليهود باعتبار أنهم أمة رفضوه وأظهروا عنادهم وشرهم برفضهم ما أظهره من المحبة لهم. وفي هذا العدد وما يليه بيان حرية الإنسان التامة، والمسؤولية التي عليه لمقاومته وعناده وشره برفضه محبة المسيح. وفيه أيضاً بيان سلطان الله المطلق الذي يظهر بقضائه على تلك الأمة، والتصريح بأنه لا بد من وقوع ذلك القضاء. ولا زال المسيح يشفق على الخطاة الساقطين إلى هاوية الهلاك، كما شفق يومئذٍ على أثمة اليهود. ولا زال يرغب في إنقاذهم، ويتضرع إليهم بكتابه المقدس، وكلام مبشريه، أن يأتوا إليه ليخلصوا. وعلة عدم نجاتهم الوحيدة هي أنهم لم يريدوا. ومِن رفض المسيح هلك لا محالة لأنه ليس بغيره الخلاص.
٣٨ «هُوَذَا بَيْتُكُمْ يُتْرَكُ لَكُمْ خَرَاباً».
بَيْتُكُمْ أي هيكلكم الذي كان سابقاً بيت الله (٢أخبار ٦: ٢ ومزمور ٢٦: ٨) لكن الله هجرهُ فصار بيتهم لا بيته.
خَرَاباً كان حينئذٍ خراباً من الناحية الروحية، ولكنه مزمع أن يصير خراباً حقيقياً فإن المسيح بعد نطقه بهذا الكلام بقليل ترك الهيكل إلى الأبد (متّى ١٤: ١) وهذا دليل على بدء خرابه. والذي قاله المسيح عن الهيكل وقع على أورشليم نفسها وعلى سائر بلاد اليهود. وبعد هذا الترك بقليل جاء الرومان آلة انتقام الله وأكملوا الخراب.
٣٩ «لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ لاَ تَرَوْنَنِي مِنَ ٱلآنَ حَتَّى تَقُولُوا: مُبَارَكٌ ٱلآتِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ».
مزمور ١٨: ٢٦ ومتّى ٢١: ٩
هذا وداع المسيح للهيكل وللأمة اليهودية وختام كلامه لها، وما قاله بعد إنما خاطب به رسله المختارين.
إِنَّكُمْ لاَ تَرَوْنَنِي لم يظهر المسيح بعد قيامته إلا لقليلين انتخبهم الله شهوداً بقيامته (أعمال ١٠: ٤٠، ٤١).
حَتَّى تَقُولُوا هذه نبوة برجوع اليهود في المستقبل إلى الرب (تثنية ٤: ٣٠، ٣١ وهوشع ٣: ٤، ٥ وزكريا ١٢: ١٠ و١٤: ٨ - ١١ ورومية ١١: ٢٥ - ٣٢) وهذه النبوة لم تتم بعد، ولكن لا بد من إتمامها.
مُبَارَكٌ ٱلآتِي الخ هذا مقتبس من مزمور ١١٨: ٢٦ وقد نادى به بعض التلاميذ عند الاحتفال بدخوله أورشليم (متّى ٢١: ٩) والذي اشترك فيه بعض الناس. كذلك سيكون نداء كل الأمة اليهودية عن يقين أن يسوع هو المسيح والترحيب به بسرور وقبوله بفرح.
الأصحاح الرابع والعشرون
١ «ثُمَّ خَرَجَ يَسُوعُ وَمَضَى مِنَ ٱلْهَيْكَلِ، فَتَقَدَّمَ تَلاَمِيذُهُ لِكَيْ يُرُوهُ أَبْنِيَةَ ٱلْهَيْكَلِ».
مرقس ١٣: ١ الخ ولوقا ٢١: ٥ الخ
خَرَجَ يَسُوع هذا خروجه الأخير من الهيكل، وقد ذهب بعده إلى جبل الزيتون (ع ٣) وتكلم معه تلاميذه في الطريق عن غرابة بناء الهيكل (مرقس ١٣: ٤).
أَبْنِيَةَ ٱلْهَيْكَلِ (راجع متّى ٢١: ١٢) أي كل ما بُني في أرضه من غُرف ودور وأروقة وأعمدة وأبواب جميلة مغشاة بالفضة والذهب، وكان أحدهما من النحاس الكورنثي. قال مرقس إن التلاميذ وجهوا أفكار المسيح إلى حجارة الهيكل. وقال يوسيفوس المؤرخ إن طول بعض تلك الحجارة كان ٤٥ ذراعاً، وعرضه ستاً، وسمكه خمساً، وإنه كان أكبر الحجارة في الجانب الشرقي من الهيكل حيث بُني الجدار من بطن الوادي إلى قمة جبل الموريَّا.
٢ «فَقَالَ لَـهُمْ يَسُوعُ: أَمَا تَنْظُرُونَ جَمِيعَ هٰذِهِ؟ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لاَ يُتْرَكُ هٰهُنَا حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ لاَ يُنْقَضُ!».
١ملوك ٩: ٧ وإرميا ٢٦: ١٨ وميخا ٣: ١٢ ولوقا ١٩: ٤٤
حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ لاَ يُنْقَضُ كان كلامه يظهر وقتئذٍ من أبعد الممكنات، لأن اليهود كانوا يومئذٍ في حال السلم والراحة. وكان الرومان في قوة لا يظن أحد أن تعصاها أمة صغيرة كاليهود. وكان الهيكل واسعاً غنياً في غاية السمو وافتخار الأمة به، ولكن بعد ٤٠ سنة أخربه الرومان في سنة ٧٠م، لأن اليهود عصوا الرومان فأرسل الرومان الجنود لإذلالهم. وأراد تيطس القائد الروماني أن يحتفظ بالهيكل، لكن أحد جنوده ألقى النار إلى الهيكل خلافاً لأمره. ولما بدأت تتقد فيه بذل جهده في إطفائها فلم يستطع، فتم خرابه.
وبعد أن استولى تيطس على المدينة والهيكل أمر بهدم المدينة والأسوار إلى أسسها، ولم يترك إلا ثلاثة أبراج بناها هيرودس الكبير في ناحية الشمال الغربي من المدينة. وفعل العسكر ذلك رغبة في إرضائه، وفي كشف ما دُفن هنالك من الكنوز. فحرث كيرنتيوس روفس أحد قواد تيطس الأرض التي كانت فيها أسس الهيكل. قيل إن الخراب بلغ مبلغاً غريباً حتى تعذر على من قصد ذلك المكان التصديق إنه كان مأهولاً. ولا يناقض نبوة المسيح ما يصادف اليوم من بقايا جدران المدينة التي أقيمت لتوسيع دائرة الهيكل، فإن بقاءها هنالك نتج عن مواراتها بالحجارة التي طُرحت عليها وقت الهدم. ولم يكن من قصد الجنود أن يبقوا حجراً على حجر فوقع ذلك رغماً عن إرادتهم. ولم تظهر بقايا تلك الجدران إلا بعد مرور سنين كثيرة.
٣ «وَفِيمَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ، تَقَدَّمَ إِلَيْهِ ٱلتَّلاَمِيذُ عَلَى ٱنْفِرَادٍ قَائِلِينَ: قُلْ لَنَا مَتَى يَكُونُ هٰذَا، وَمَا هِيَ عَلاَمَةُ مَجِيئِكَ وَٱنْقِضَاءِ ٱلدَّهْرِ؟».
١تسالونيكي ٥: ١ الخ
تنبأ لهم إرميا بمثل هذا الخراب في أيام نبوخذنصر، ويمكن مطالعة الكثير من أصحاحات هذه النبوة لمناسبتها ولزيادة التشابه بين السيد له المجد وهذا النبي العظيم إرميا، الذي تكلم بالحق ولم يشأ أن يساير الباطل.
جَبَلِ ٱلزَّيْتُون هو شرق أورشليم، وتُرى منه المدينة والهيكل بوضوح.
ٱلتَّلاَمِيذُ أي أربعة منهم وهم بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس (مرقس ١: ٣). وهذا لا يستلزم أن بقية التلاميذ لم يسمعوا الخطاب. إنما السؤال كان من الأربعة.
هٰذَا أي خراب أورشليم بناءً على ما قاله وهو في الهيكل (متّى ٢٢: ٣٨) وما قاله وهو على الطريق (ع ٢).
مَجِيئِكَ أشار المسيح إلى مجيئه الثاني في متّى ٢٣: ٣٩ وتوقع التلاميذ رجوعه يقيناً وحقيقة ليعاقب أعداءه ويملك ملكاً أرضياً، حتى أنهم بعد موته وقيامته كانوا لا يزالون يتوقعون قرب مجيئه (١تسالونيكي ٢: ١٩ و٣: ١٣ ويعقوب ٥: ٧ و١يوحنا ٢: ٢٨).
ٱنْقِضَاءِ ٱلدَّهْرِ لا نعرف ماذا قصدوا بانقضاء الدهر. هل أرادوا بها نهاية النظام الحاضر وبدء مُلك المسيح على الأرض كانتظارهم مع سائر اليهود، أو هل أرادوا نهاية العالم كله كما أنبأ المسيح (في متّى ١٣: ٣٩، ٤٠ وكما في متّى ٢٩: ٣٨). فجمعوا في هذا السؤال ثلاثة أشياء: (١) خراب الهيكل (٢) مجيء المسيح ثانيةً (٣) انقضاء العالم.
٤ «فَأَجَابَ يَسُوعُ: ٱنْظُرُوا، لاَ يُضِلَّكُمْ أَحَدٌ».
أفسس ٥: ٦ وكولوسي ١: ٨، ١٨ و٢تسالونيكي ٢: ٣ و١يوحنا ٤: ١
فَأَجَابَ يَسُوعُ نقرأ إجابته في أصحاحي ٢٤، ٢٥ كليهما، وهو ما تفوه به على الجبل. وفي هذا الجواب ثلاثة أمور تستحق الالتفات إليها: (١) إن المسيح لم يبين زمان حدوث ما أنبأ به. (٢) إنه أنبأ بأمرين هما: خراب أورشليم ونهاية العالم. وأولهما رمز إلى الثاني، فيعسر علينا كثيراً أن نميز أي الأمرين كان يشير إليه، وأين ينتهي كلامه عن الأول، وأين يبدأ الثاني. وليس هناك فاصل واضح، لكننا نعلم أن أول كلامه كان يشير بالأكثر إلى خراب أورشليم الذي هو رمز، وآخره إلى نهاية العالم الذي هو المرموز إليه. والذي يقرب أن يكون فاصلاً بينهما هو في متّى ٢٤: ٢٨. وكثير منه يشتمل على كلا الموضوعين. و(٣) أن تلك النبوة كسائر النبوات لم يقصد الله أن نفهمها حق الفهم إلا بعد أن تتم. وغايته منها أن تقوى ثقتنا بصدقه عند إتمامها، لا مجرد إنبائنا بالمستقبل (يوحنا ١٤: ٢٩)
ٱنْظُرُوا حذرهم يسوع قبل أن يجيب سؤالهم من أن يُخدعوا، فأنبأهم بأمور تظهر للناس أنها من علامات مجيئه وهي ليست كذلك.
٥ «فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ بِٱسْمِي قَائِلِينَ: أَنَا هُوَ ٱلْمَسِيحُ وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ».
إرميا ١٤: ١٤ و٢٣: ٢، ٢٥ ومتّى ٢٤: ١١، ٢٤ ويوحنا ٥: ٤٣
كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ أنبأهم بقيام كثيرين يخدعون الشعب فإن كل الأمة اليهودية كانت تنتظر مجيء المسيح وقتئذٍ، مما شجَّع كثيرين على الادعاء أنهم مسحاء، وحمل الأمة على تصديقهم.
بِٱسْمِي أي بدعوى أنهم مسحاء وأن نبوات العهد القديم تمت بهم، وبذلك يُخشى من أنهم يخدعون الرسل أنفسهم. قال يوسيفوس المؤرخ اليهودي إن مزورين وسحرة جذبوا إليهم كثيرين إلى البرية بعد أن وعدوهم بالمعجزات. فمنهم من جُنَّ ومنهم من عاقبة فيلكس الوالي. وكان من المزورين ذلك المصري الذي ذُكر في سفر الأعمال (أعمال ٢١: ٣٨) أنه جذب إليه كثيرين من الناس إلى جبل الزيتون واعداً إياهم أنه سيخرب أسوار أورشليم بكلمته. وقال أيضاً إن البلاد امتلأت بالمسحاء الكذبة، وإنه كل يوم كان يُمسَك أناسٌ منهم ويُقتلون.
٦ «وَسَوْفَ تَسْمَعُونَ بِحُرُوبٍ وَأَخْبَارِ حُرُوبٍ. اُنْظُرُوا، لاَ تَرْتَاعُوا. لأَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ كُلُّهَا، وَلٰكِنْ لَيْسَ ٱلْمُنْتَهَى بَعْدُ».
بِحُرُوبٍ كان وقت نطق المسيح بهذه النبوة سلام عام، ولكن صار بعده اضطرابات وفتن كثيرة وحروب هائلة في أماكن مختلفة، ومنها الحرب التي اشتعلت في الإسكندرية سنة ٣٨م بين المصريين واليهود المقيمين بها، ومنها حرب اتقدت في سلوكية قُتل فيها خمسون ألفاً من اليهود، وكثرت الحروب في المملكة الرومانية بين أحزابها فقُتل فيها أربعة أباطرة في ١٨ شهراً.
وفي هذه العبارات استعمل المسيح وظيفته النبوية على أكمل وجه، فحذر تلاميذه وأتباعه من الخطر ليحذِّروا الآخرين فينجون هم، وينجو من يسمعون ويتحذرون. ولكنهم لم يتحذروا لسوء الحظ.
لاَ تَرْتَاعُوا أي لا تخافوا من خراب أورشليم حينئذٍ، بل توقعوا علامات أخرى قبله.
٧ «لأَنَّهُ تَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ، وَتَكُونُ مَجَاعَاتٌ وَأَوْبِئَةٌ وَزَلاَزِلُ فِي أَمَاكِنَ».
٢أخبار ١٥: ٦ وإشعياء ١٩: ٢ وحجّي ٢: ٢٢
أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ تم ذلك بأن هاج خصام وقتل شديد بين اليهود والسامريين، وبين اليهود ومن سكن معهم المدن من اليونانيين، فقتل يونانيو قيصرية عشرين ألفاً من اليهود. ثم انتقم اليهود من اليونانيين الساكنين في القرى. وقام في الرومان قيصران أوثو وفيتليوس، فالتحمت الحرب بين أحزابهما.
مَجَاعَاتٌ منها المجاعة التي تنبأ بها أغابوس (أعمال ١١: ٢٨) وحدثت سنة ٤٩م. وكتب نبأ تلك المجاعات المؤرخون الوثنيون منهم تاسيتوس وسنيكا.
وَأَوْبِئَةٌ ومن ذلك وباء تفشى في روما سنة ٦٥م مات به ثلاثون ألفاً.
وَزَلاَزِلُ منها زلزلة في كريت سنة ٤٦م، وزلزلة في روما سنة ٥١ م وزلزلة في أفاميا سنة ٦٣ وزلزلة في لاذقية فريجية سنة ٦٠م وزلزلة في أورشليم سنة ٦٧م. وذكر أنه في أيام نيرون حدثت زلازل في كولوسي وسميرنا (أي إزمير) ومليتوس وساموس وخيوس وغيرها.
٨ «وَلٰكِنَّ هٰذِهِ كُلَّهَا مُبْتَدَأُ ٱلأَوْجَاعِ».
أي أن الأوجاع التي تكون وقت خراب أورشليم أشد من الأوجاع المذكورة، وأن تلك الحروب والزلازل والمجاعات وغيرها ليست أدلة على مجيء المسيح ونهاية العالم.
٩ «حِينَئِذٍ يُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى ضِيقٍ وَيَقْتُلُونَكُمْ، وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنْ جَمِيعِ ٱلأُمَمِ لأَجْلِ ٱسْمِي».
متّى ١٠: ١٧، ٣٢ ويوحنا ١٥: ٢٠ و١٦: ٢ وأعمال ٤: ٢، ٣ و٧: ٥٩ و١٢: ١ الخ و١بطرس ٤: ١٦ ورؤيا ٢: ١٠، ١٣
يُسَلِّمُونَكُم تنبأ المسيح أن لتلاميذه نصيباً من تلك المصائب، وهي الاضطهادات من الخارج. وهذا كان أول شرور أربعة تنبأ بأنها تقع على كنيسته الصغيرة.
يَقْتُلُونَكُمْ أي يقتلونكم أنتم ومن يؤمن إيمانكم (أعمال ٧: ٥٩، ٦٠ و٨: ٣، ٤ و١٢: ٢).
مُبْغَضِينَ أي من الوثنيين واليهود (أعمال ١٦: ١٩ - ٢٢ و١٩: ٢٨ و٢٨: ٢٢ و١بطرس ٢: ١٢ و٣: ١٦ و٤: ١٤). قال تاسيتوس المؤرخ الروماني إن المسيحيين فرقة مكروهة من الناس. وحسب الرومان اعتناق المسيحية إثماً يستحق مرتكبه الموت.
لأَجْلِ ٱسْمِي أي لاعترافكم بي ونسبتكم إليَّ ولسيركم سيرتي. وكان المسيحيون يهيجون بغض الرومان لهم لتوبيخهم إياهم على عبادة الأوثان، وعلى ما كانوا يرتكبونه من الرذائل.
١٠ «وَحِينَئِذٍ يَعْثُرُ كَثِيرُونَ وَيُسَلِّمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَيُبْغِضُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً».
متّى ١١: ٦ و١٣: ٥٧ و٢تيموثاوس ١: ١٥ و٤: ١٠
تنبأ المسيح في هذا العدد بضيق ثانٍ يأتي على كنيسته، وهو ارتداد بعض أعضائها وخيانتهم لإخوتهم.
يَعْثُرُ ارتد كثيرون عن المسيح للضيقات التي وقعوا فيها، وللاضطهاد ولخسارة المال والأصحاب والحياة، ولبطء نجاح الكنيسة وعدم مجيء المسيح في الحال. وكثيراً ما نرى في رسائل الرسل التحذير من الارتداد، مما يدلنا على كثرة وقوعه.
وَيُسَلِّمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أي أن المرتد منهم يسلم الثابت. قال تاسيتوس إنه في مدة اضطهاد نيرون الذي سماه «تأديباً» حكم على كثيرين من المسيحيين بالقتل بناءً على شهادة بعضهم. وكان ذلك التسليم إلى المجالس والقضاة الوثنيين.
وَيُبْغِضُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً لم يرد المسيح أن المؤمنين الحقيقيين يفعلون ذلك، بل المدَّعين أنهم مسيحيون. وأشد أعداء الكنيسة في كل عصورها كانوا من أعضائها المرتدين الذين أضروها إضراراً لم يستطعه غيرهم. وزاد لوقا على ما ذكره متّى هنا قول المسيح «سَوْفَ تُسَلَّمُونَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَالإِخْوَةِ وَالأَقْرِبَاءِ وَالأَصْدِقَاءِ» (لوقا ٢١: ١٦). وذكر متّى من أقوال المسيح مثل هذا قبلاً (متّى ١٠: ٢١).
١١ «وَيَقُومُ أَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ كَثِيرُونَ وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ».
متّى ٧: ١٥ وأعمال ٢٠: ٢٩ و١تيموثاوس ٤: ١ الخ و٢بطرس ٢: ١.
هذا شرٌ ثالث تنبأ المسيح بأنه يقع على الكنيسة، وهو نشوء بدع وتعاليم فاسدة فيها.
أَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ المقصود بالأنبياء هنا معلمو الديانة. وتدل الآيات التالية على تمام هذه النبوة: (أعمال ٢٠: ٣ ورومية ١٦: ١٧، ١٨ و٢كورنثوس ١١: ١٣ وغلاطية ١: ٧ - ٩ وكولوسي ٢: ١٧ و١تيموثاوس ١: ٦، ٧، ٢٠ و٤: ١و٢تيموثاوس ٢: ١٨، ١٩ و: ٦ - ٨ و٢بطرس ٢: ١، ٢ و١يوحنا ٢: ١٨ و٤: ١ و٢يوحنا ٧ ويوحنا ومتّى ٢٤: ٤). وقد وُصف الأنبياء الكذبة في هذه الآيات برسل كذبة ومعلمين كذبة، وأضداد المسيح وأرواح مضلة.
وذكر يوسيفوس عن قيام أنبياء كذبة بين اليهود قبل خراب أورشليم بل في زمن الحصار نفسه، وأنهم وعدوا الناس بنجاة من السماء فمنعوهم عن الهروب من المدينة ومن التسليم إلى الرومان حين عرضت عليهم شروط الصلح وثبتوهم على عنادهم.
١٢ «وَلِكَثْرَةِ ٱلإِثْمِ تَبْرُدُ مَحَبَّةُ ٱلْكَثِيرِينَ».
تنبأ المسيح هنا بالشر الرابع الذي يقع على كنيسته، وهو أنها تتأثر من الشرور التي تكثر في العالم فتشبه أهله. وهذا ما يشير إليه قوله «تَبْرُدُ مَحَبَّةُ ٱلْكَثِيرِينَ» وتمَّ ذلك كما نرى من الآيات التالية: (غلاطية ٣: ١ و١تيموثاوس ٦: ٩، ١٠ و٢تيموثاوس ١: ١٥ و٤: ١٠ ويعقوب ٢: ٢، ٦ وعبرانيين ١٠: ٢٥ ورؤيا ٢: ٤ و٣: ١٥.
١٣ «وَلٰكِنِ ٱلَّذِي يَصْبِرُ إِلَى ٱلْمُنْتَهَى فَهٰذَا يَخْلُصُ».
متّى ١٠: ٢٢ وعبرانيين ٣: ٦، ١٤ ورؤيا ٢: ١٠
يحتمل هذا الكلام معنيين: (١) أن الذي يبقى ثابتاً في إيمان المسيح بمحبة وغيرة، مع احتمال الإهانة والاضطهاد والفقر بدون فتور إلى وقت خراب أورشليم، لا يهلك فيها. جاء في التواريخ أنه لم يُقتل أحد من المسيحيين في وقت حصار أورشليم ولا في وقت خرابها. وزاد لوقا بنقله ما يوافق هذا المعنى وهو قول المسيح «وَلكِنَّ شَعْرَةً مِنْ رُؤُوسِكُمْ لاَ تَهْلِكُ» (لوقا ٢١: ١٨). (٢) أن الذي يثبت إلى يوم موته شهيداً أو يُقتل قتلاً من أجل اسمي، أو الذي يموت موتاً طبيعياً وهو مؤمن بي وبمجيئي الثاني في موكب الغلبة والانتصار ينال خلاصاً أبدياً. وفي كلا المعنيين يعلمنا أن الذي يثبت في إيمانه إلى نهاية ما عيَّنه الله من امتحانه ينال ثوابه (أفسس ٦: ١٣ ورؤيا ٢: ٧ - ١١، ١٧) وفيه وعظ بالصبر والثبات في أزمنة الضيق. ولنا مما سبق أمران: (١) فرط شر العالم قبل خراب أورشليم و(٢) مثله قبل نهاية العالم.
١٤ «وَيُكْرَزُ بِبِشَارَةِ ٱلْمَلَكُوتِ هٰذِهِ فِي كُلِّ ٱلْمَسْكُونَةِ شَهَادَةً لِجَمِيعِ ٱلأُمَمِ. ثُمَّ يَأْتِي ٱلْمُنْتَهَى».
رومية ١٠: ١٨ وكولوسي ١: ٦، ٢٣
بِبِشَارَةِ ٱلْمَلَكُوتِ أي الإنباء بالخلاص الذي بالمسيح.
فِي كُلِّ ٱلْمَسْكُونَةِ غلب استعمال المسكونة في العهد الجديد للمملكة الرومانية، كما يظهر من قول لوقا «فِي تِلْكَ الأَيَّامِ صَدَرَ أَمْرٌ مِنْ أُوغُسْطُسَ قَيْصَرَ بِأَنْ يُكْتَتَبَ كُلُّ الْمَسْكُونَةِ» (لوقا ٢: ١) ومثله ما جاء في أعمال ١١: ٢٨ ثم أُطلقت على كل ما عُلم من الأرض المسكونة في تلك الأيام.
ووفقاً لهذه النبوة بشر الرسل والمسيحيون الأولون بالإنجيل في كل أقطار الأرض المعروفة يومئذٍ، في نحو ثلاثين سنة بعد موت المسيح، أي قبل خراب أورشليم بنحو عشر سنين. ومما سهَّل نشر تلك البشارة نشوء كنيسة مسيحية في روما، لأن أخبار تلك المدينة كانت تبلغ كل مكان، لأنها عاصمة المملكة. كما سهَّل نشرها زيارة اليهود المتشتتين في الأرض مدينة أورشليم في عيد الفصح، فاستطاعوا بذلك أن يحملوا أخبار ما سمعوه من أمر الدين المسيحي إلى كل البلاد التي أقاموا بها. ويثبت ذلك قول بولس الرسول «أَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا؟ بَلَى! إِلَى جَمِيعِ الأَرْضِ خَرَجَ صَوْتُهُمْ، وَإِلَى أَقَاصِي الْمَسْكُونَةِ أَقْوَالُهُمْ» (رومية ١٠: ١٨) وقوله «الإنجيل الَّذِي قَدْ حَضَرَ إِلَيْكُمْ كَمَا فِي كُلِّ الْعَالَمِ أَيْضًا» وقوله «الإِنْجِيلِ، الَّذِي سَمِعْتُمُوهُ، الْمَكْرُوزِ بِهِ فِي كُلِّ الْخَلِيقَةِ الَّتِي تَحْتَ السَّمَاءِ» (كولوسي ١: ٦، ٢٣ أنظر أيضاً ٢تيموثاوس ٤: ١٧).
شَهَادَةً بمحبة الله ومقاصده الرحيمة للجنس البشري الساقط.
لِجَمِيعِ ٱلأُمَمِ لا لشعب الله المختار فقط. وذلك لكي يقبلوا الإنجيل أو يرفضوه فإن قبلوا كانت تلك الشهادة لهم وإن رفضوه كانت عليهم.
ثُمَّ يَأْتِي ٱلْمُنْتَهَى أي نهاية مدينة أورشليم وصيرورة اليهود أمة مستقلة. وحدث ذلك منذ أربعين سنة بعد النطق بهذا الكلام أي نحو سبعين سنة للميلاد. وأعلن المسيح أنه سيبشر بالإنجيل في كل المسكونة قبل تلك النازلة. وما ذكرناه هو وفق قول المسيح لكنه بعض ما دلَّ عليه لا كله. لأن فيه بيان انتشار الإنجيل بين قبائل الأرض قبل مجيء المسيح الثاني في يوم الدين. فلنا مما سبق أنه في الأيام الأخيرة تكثر وسائل معرفة الإنجيل إلى حد لم يعهده العالم قبل كترجمة كتاب الله إلى كل لغات الأرض، وإرسال المبشرين إلى كل أقطار الدنيا منادين بخلاص ابن الله.
ولنا من ذلك أنه كلما قرب المنتهى زاد علامتان من علاماته وضوحاً، إحداهما زيادة شرور العالم مع ارتداد بعض المحسوبين مسيحيين. والأخرى زيادة غيرة الكنيسة في المناداة بالإنجيل ونجاة الخطاة من الهلاك.
١٥ «فَمَتَى نَظَرْتُمْ «رِجْسَةَ ٱلْخَرَابِ» ٱلَّتِي قَالَ عَنْهَا دَانِيآلُ ٱلنَّبِيُّ قَائِمَةً فِي ٱلْمَكَانِ ٱلْمُقَدَّسِ لِيَفْهَمِ ٱلْقَارِئُ».
دانيال ٩: ٢٣، ٢٥، ٢٧ و١٢: ١١ ومرقس ١٣: ١٤ ولوقا ٢١: ٢٠ الخ
ما في هذا العدد إلى العدد السابع والعشرين يختص بالحوادث المتعلقة بخراب أورشليم.
فَمَتَى نَظَرْتُمْ المخاطبون هم مسيحيو اليهودية.
رِجْسَةَ ٱلْخَرَابِ أي الرجسة التي هي علة الخراب. ولا ريب في أن الرسل عرفوا ما أراد المسيح برجسة الخراب لكن يتعذر علينا الآن أن نعرفه. فظن بعضهم أنه أراد بها الجيش الروماني الذي كانت مقدمته تحمل تماثيل القياصرة الرومانيين وألوية على رؤوس عصيها تماثيل النسور. وكانوا يعبدون تلك التماثيل كآلهة. فيكون المقصود بقوله «قَائِمَةً فِي ٱلْمَكَانِ ٱلْمُقَدَّسِ» قيام الجيش أمام أورشليم في حصارها الأول بقيادة سستيوس غالوس سنة ٦٦ للميلاد، وفي حصارها الثاني بقيادة فسباسيانوس سنة ٦٨ وبقيادة تيطس سنة ٧٠. وما يوافق هذا قول لوقا «مَتَى رَأَيْتُمْ أُورُشَلِيمَ مُحَاطَةً بِجُيُوشٍ» فإنه قال ذلك مكان قول متّى «رِجْسَةَ ٱلْخَرَاب» الخ (لوقا ٢١: ٢٠). وظن آخرون أنها إشارة إلى تدنيس الهيكل عينه سنة ٦٦ بجماعة من اليهود سمّوا الغيورين دخلوا الهيكل للمحاماة عنه فحاربوا فيه وقتلوا وارتكبوا فظائع أُخر فيه. والأرجح الأول على أنه يصح أن يراد بها الأمران على أن الأول رجسة خارجية والثاني رجسة داخلية.
قَالَ عَنْهَا دَانِيآلُ (دانيال ١٩: ٢٦، ٢٧ و١١: ٣١ و١٢: ١١) أشار دانيال إلى اجتهاد أنتيوخس أبيفانس في أبطال المحرقة اليومية لله، والاستعاضة عنها بعبادة جوبتر أولمبيوس الذي أقام تمثاله في الهيكل المقدس. وقال المسيح إنه سيحدث مثل هذا التنجيس والتدنيس قبل خراب أورشليم، وإنه يكون علامة للمسيحيين.
قَائِمَةً فِي ٱلْمَكَانِ ٱلْمُقَدَّسِ كانت أورشليم عند اليهود مدينة مقدسة ولا سيما الهيكل (متّى ٤: ٥) وكذلك كانت الأرض حول تلك المدينة. وعلى هذا يصح أن يكون المقصود من قول المسيح «رجسة الخراب» الجيش الروماني حول المدينة، أو أفعال الغيورين الفظيعة داخل الهيكل.
لِيَفْهَمِ ٱلْقَارِئُ ظن أكثر المفسرين أن هذه العبارة زادها متّى لتنبيه القراء إلى ذلك التحذير، بناءً على أنه لو كان المسيح ذكرها في خطابه لقال «ليفهم السامع». ولا مانع من أنه هو نفسه ذكر تلك العبارة لعلمه أن كلامه سيُكتَب.
١٦ «فَحِينَئِذٍ لِيَهْرُبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجِبَالِ».
فَحِينَئِذٍ أي حين يحدث ما ذُكر يعلم المسيحيون أن المنتهى قريب، وأن الوقت الذي يجب فيه أن يبادروا إلى الهرب قد أتى.
فِي ٱلْيَهُودِيَّة هذا يدل على أن الخطر لم يكن على الذين في أورشليم فقط، بل كان على الذين في سائر اليهودية أيضاً.
إِلَى ٱلْجِبَالِ يحتمل أن المسيح لم يقصد بهذه الجبال جبالاً معينة. والأرجح أنه قصد أقرب الجبال إلى اليهودية ،وهي جبال جلعاد شرق الأردن. فكثيراً ما صارت الجبال ملجأ من العسكر لموافقتها للاختباء، ولتوفر كهوف السكن فيها. وقال أُوسابيوس المؤرخ المسيحي إن كثيرين من المسيحيين هربوا إلى «بيلا» شرق الأردن، وشمال أرض بيرية. ولم يُقتل أحدٌ منهم في الحصار. وبعدما بدأ سستوس غالوس في الحصار أخذ جزءاً من المدينة وأحرقه لأسباب مجهولة، ثم رفع الحصار وتنحى بجيشه عن المدينة، فاغتنم المسيحيون فرصة الهرب وكان ذلك في سنة ٦٨م.
١٧ «وَٱلَّذِي عَلَى ٱلسَّطْحِ فَلاَ يَنْزِلْ لِيَأْخُذَ مِنْ بَيْتِهِ شَيْئا».
أوجب بذلك الهروب سريعاً عند ظهور العلامة. ونفهم منه أن سلَّم البيوت كان خارجها، فيمكن الإنسان أن ينزل من على السطح بدون أن يدخل البيت. ولعل سطوح البيوت كانت عند ذاك متصلة حتى يمكن الإنسان أن يجتازها من سطح إلى آخر، ويسرع بالخروج من المدينة. وسبب هذا التنبيه أن نجاة حياتهم هي أهم من إنقاذ أمتعتهم، علاوة على أنها تثقلهم فتعيقهم عن الهرب.
١٨ «وَٱلَّذِي فِي ٱلْحَقْلِ فَلاَ يَرْجِعْ إِلَى وَرَائِهِ لِيَأْخُذَ ثِيَابَهُ».
الذي يخرج إلى الحقل يترك طبعاً رداءه أي ما يلبسه فوق ثيابه في البيت. فنهاه هنا عن أن يرجع ليأخذه مع شدة حاجته إليه في الجبال التي سيهرب إليها. فكان عليه أن يهرب من الحقل إلى الجبل رأساً.
١٩ «وَوَيْلٌ لِلْحَبَالَى وَٱلْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ ٱلأَيَّامِ».
لوقا ٢٣: ٢٩
أظهر المسيح بهذا الكلام حزنه على اللواتي يصعب عليهن الهروب بسبب حبلهم أو حمل أطفالهن، مما يصعِّب سرعة الهروب، واحتمال تقلبات الجو، والتعرض لمشقات العيش في الجبال.
٢٠ «وَصَلُّوا لِكَيْ لاَ يَكُونَ هَرَبُكُمْ فِي شِتَاءٍ وَلاَ فِي سَبْتٍ».
فِي شِتَاء لأنه يصعب السفر في ذلك الفصل لتوحل الطرق، وقصر النهار، وشدة البرد، وغزارة المطر في الجبال.
وَلاَ فِي سَبْتٍ لأنه يصعب السفر في ذلك اليوم، إما لتوبيخ الضمير لأنهم حسبوا السفر فيه محرماً بموجب الشريعة، أو لأنهم لا يقدرون أن يُخرجوا أمتعتهم من أبواب المدن فيه، أو لأن رجال الشرطة من اليهود يمنعونهم عن السفر فيه باعتباره ضد الشريعة. وهنا دليل قاطع على أن المسيح احترم شريعة السبت، ولا يريد كسرها كما اتهمه أعداؤه.
ويظهر من قول المسيح «صلوا لكي لا يكون» لا يوجد تناقضاً بين قضاء الله وإجابته الصلاة، لأنه قضى بخراب أورشليم مع قدرته أن يجعل أحوال ذلك الخراب غير ملجئة المسيحيين على السفر في شتاء أو سبت. وقول متّى «في سبت» من جملة الأدلة على أنه كتب إنجيله لأجل اليهود.
٢١ «لأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ ضِيقٌ عَظِيمٌ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ مُنْذُ ٱبْتِدَاءِ ٱلْعَالَمِ إِلَى ٱلآنَ وَلَنْ يَكُونَ».
دانيال ٩: ٢٦ و١٢: ١
ذكر المسيح ضيق تلك الأزمنة العظيم لينتبه تلاميذه لأمره بالهروب، وقد أوضحه لوقا أكثر مما أوضحه متّى (لوقا ٢١: ٢٤، ٢٥). وأنبأ به موسى (تثنية ٢٨: ٤٩ - ٥٧). وأنبأ به دانيال (دانيال ١٢: ١). وقال يوسيفوس إنه قتل من اليهود عند افتتاح المدينة مليوناً ومئة ألفاً، وأُسر منهم ٩٧ ألفاً، وعُذب كثيرون ثم قتلوا. وقـُتل في ضواحيها ٢٥٠ ألفاً. فبلغ كل القتلى مليون و٣٥٠ ألفاً. وقال إن الرومان صلبوا ممن أُسروا من اليهود مدة الحصار خلقاً كثيراً حتى لم يبقَ مكان لنصب الصلبان، ولم يجدوا صلباناً كافية لصلب كل أولئك الأسرى. وقال إنه مات كثيرون في المدينة من شدة الجوع، وإن بعض النساء قتلت أولادها وأكلتهم وقال «لو قارنا مصائب جميع الناس منذ الخليقة بما قاساه اليهود لوجدناه أعظم من جميعها». وزاد هول الحصار بأن بدءه كان في عيد الفصح، وكان حينئذٍ على قول البعض ثلاثة ملايين في تلك المدينة.
٢٢ «وَلَوْ لَمْ تُقَصَّرْ تِلْكَ ٱلأَيَّامُ لَمْ يَخْلُصْ جَسَدٌ. وَلٰكِنْ لأَجْلِ ٱلْمُخْتَارِينَ تُقَصَّرُ تِلْكَ ٱلأَيَّامُ».
إشعياء ٦٥: ٨، ٩ وزكريا ١٤: ٢، ٣
تُقَصَّرْ أي تُجعل أقصر مما اعتادوه من أوقات محاصرة المدن، أو أنها تقصر عما يتوقعونه بالنظر إلى قوة المدينة. فالأشوريون لم يستطيعوا أن يفتحوا صور إلا بعد حصار خمس سنين. والبابليون حاصروها ١٣ سنة. فلو اتحد أهل أورشليم ودافعوا عنها بغيرة وحمية ما أمكن الرومان نظراً لمتانتها أن يفتحوها إلا بعد محاصرتها سنين عديدة. ومع ذلك فإنهم فتحوها بعد حصار خمسة أشهر. على أنه حدثت الوقائع بين أهل اليهودية والرومان مدة نحو سنتين قبل ذلك.
لَمْ يَخْلُصْ جَسَدٌ لأن اليهود كان يقتل بعضهم بعضاً داخلاً، وكان الرومان يقتلونهم من خارج. فلو طال ذلك الوقت كأوقات الحصار المعتادة فنيت الأمة اليهودية بأسرها، وكان أسباب تقصير مدة الحصار سنة (١) أمر كلوديوس قيصر لهيرودس أغريباس بالكف عن تحصين المدينة بعدما شرع فيه سنة ٤٢، ٤٣م (٢) انقسام اليهود حزبين وتوانيهم عن الاستعداد اللازم للحصار قبل بدئه وعن الدفاع الواجب في وقته. (٣) إحراق يوحنا وسمعان رئيسي الحزبين أهراء الحنطة وبقية الأطعمة، وكان فيها ما يكفي كل سكان أورشليم عدة سنين وكان إحراقها قبل مجيء تيطس بقليل. (٤) مجيء تيطس بغتة، فلم يكن اليهود يتوقعونه، وكانوا مهتمين بفرائض الفصح، فاستولى تيطس على بعض حصون المدينة بلا حرب لعدم انتباه اليهود له. (٥) العناية الإلهية: لأنه لم تكن أسباب بشرية كافية لتقصير مدة الحصار. قال يوسيفوس العبري وتاسيتوس الوثني «إن هذه المصائب جاءت على اليهود من نقمة الله على قوم امتلأت كأس ذنوبهم» وتيطس بعد أن أجال نظره في المدينة وعلو أبراجها وأسوارها وعظم حجارتها قال «بمؤازرة الله قد ظفرنا في هذه الغزوة، وهو سبحانه الذي أخرج اليهود من هذه الحصون لأنه ماذا تستطيع أيادي البشر أو آلاتهم الحربية أن تصنع في مثل هذه الأبراج» ولم يرتضِ تيطس أن يكلل بعد هذه الغلبة نفسه بالمجد كما جرت عادة الرومان، وقال إنه لم يكن هو صاحب هذا الأمر والعمل، ولكن غضب الله على اليهود هو الذي أعطاه الغلبة. (٦) تغير فكر تيطس في كيفية الحصار، فإنه عزم في أول الأمر أن يبني سوراً حول أورشليم ويتركها إلى أن تسلم جوعاً. فلو بقي على ذلك لمرَّ عليه سنون قبل أن يفتح أورشليم. ولكنه بعد ما بنى جانباً من السور بدا له أن يهجم عليها ويفتحها عنوة.
ٱلْمُخْتَارِينَ أي المسيحيين الحقيقيين الذين آمنوا من بين اليهود. فلأجلهم قصر الله أيام الحرب لا لأجل اليهود. لأنه لو طالت الحرب في اليهودية لهلك المسيحيون في الجبال التي هربوا إليها جوعاً وبرداً. ولا يبعد عن الظن أن تلك الضيقات هي رمز إلى الضيقات التي تأتي على العالم قبل مجيء المسيح ثانيةً (دانيال ١٢: ١) وكما قصر الله مدة الضيقات الأولى لأجل مختاريه سيقصر الضيقات الأخيرة لأجلهم.
٢٣ «حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا أَوْ هُنَاكَ فَلاَ تُصَدِّقُوا».
مرقس ١٣: ٢١ ولوقا ١٧: ٢٣ و٢١: ٨
حِينَئِذٍ أي في وقت تلك الضيقات.
هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ انتظر اليهود أن الله يرسل النجاة في أشد الضيقات، فادَّعى كثيرون من المخادعين أنهم مسحاء وتبعهم كثيرون، ولا بد أنهم سألوا المسيحيين أن يصدقوهم أيضاً.
فَلاَ تُصَدِّقُوا قال ذلك لأنه قد أتى، ولم يبق لهم أن ينتظروا غيره.
٢٤ «لأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضاً».
تثنية ١٣: ١ و ع ٥: ١١ و٢تسالونيكي ٢: ٩، ١٠، ١١ ورؤيا ١٣: ١٣ ويوحنا ٦: ٣٧ و١٠: ٢٨، ٢٩ ورومية ٨: ٢٨ - ٣٠ و٢تيموثاوس ٢: ١٦
مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ انظر شرح عدد ٥.
أَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ انظر شرح ع ١١، ومتّى ٧: ١٤ و٢تسالونيكي ٢: ٩ - ١٢.
آيَاتٍ... وَعَجَائِب كاذبة كأفعال السحرة. وتنبأ موسى بمثل ذلك في تثنية ٣: ١ - ١٣. وكانت تظهر أنها صحيحة، حتى أنها لولا نعمة الله لخدعت المسيحيين أيضاً. ولعل المسيح أراد تحذير تلاميذه من توقع مجيئه الثاني على أثر خراب أورشليم.ولا شك أنه قصد تحذير شعبه في العصور الآتية من أن ينخدعوا بأقوال المعلمين الكذبة، كما حذرهم أيضاً بأفواه رسله (٢تسالونيكي ٢: ٨ - ١٢ و١تيموثاوس ٤: ١ - ٣ و٢تيموثاوس ٣: ١ - ٥ ورؤيا ١٣: ١٤ و١٩: ٢١.
٢٥ «هَا أَنَا قَدْ سَبَقْتُ وَأَخْبَرْتُكُمْ».
أنبأهم بذلك لئلا يسقطوا في التجربة ويضلوا، وليتحققوا صدق كلامه عند تمام هذه النبوة.
٢٦ «فَإِنْ قَالُوا لَكُمْ: هَا هُوَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ فَلاَ تَخْرُجُوا! هَا هُوَ فِي ٱلْمَخَادِعِ فَلاَ تُصَدِّقُوا».
أنبأ يوسيفوس بأن بعض المخادعين جذبوا الناس وراءهم إلى البرية، فمنهم من جذب إلى هناك أربعة آلاف نفس (انظر أيضاً أعمال ٢١: ٣٨). وبعضهم اختبأوا في الهيكل وغيره من مخابئ المدينة ليزيدوا إيهام تابعيهم. وكان اليهود ينتظرون أن يظهر المسيح في مكان غير الذي يتوقعونه.
٢٧ «لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ، هٰكَذَا يَكُونُ أَيْضاً مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلإِنْسَان».
لوقا ١٧: ٢٤
حقق المسيح لتلاميذه في هذا العدد والذي يليه انه لا يأتي في الخفاء بل في العلن كالبرق وكطيران النسور.
كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يكون مجيء المسيح كالبرق في أمرين: (١) أنه واضح و(٢) أنه فجأة (زكريا ٩: ١٤ ولوقا ١٠: ١٨). ويصح ما قيل هنا على مجيئه لخراب أورشليم، وعلى مجيئه لدينونة العالم. على أنه ينطبق بالأكثر على مجيئه يوم الدين كقوله «هُوَذَا يَأْتِي مَعَ السَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ» (رؤيا ١: ٧).
مِنَ ٱلْمَشَارِقِ... إِلَى ٱلْمَغَارِبِ لا دلالة في هذا على أن الجيش الروماني يأتي من المشارق لخراب أورشليم، أو أن المسيح يظهر في يوم الدين من الشرق أولاً، لأنه لم يقصد أن ينبئنا عن الجهة التي يأتي منها، بل غايته أن يخبرنا بكيفية مجيئه.
٢٨ « لأَنَّهُ حَيْثُمَا تَكُنِ ٱلْجُثَّةُ فَهُنَاكَ تَجْتَمِعُ ٱلنُّسُورُ».
أيوب ٣٩: ٣٠ ولوقا ١٧: ٣٨
كثيراً ما يستعير الكتاب المقدس النسور للجيوش الأجنبية التي يرسلها لعقاب الأمم المذنبة (مراثي إرميا ٤: ٩ وهوشع ٨: ١ وحبقوق ١: ٨). والذي يوضح المشابهة بينهما قوله «أَوْ بِأَمْرِكَ يُحَلِّقُ النَّسْرُ وَيُعَلِّي وَكْرَهُ؟ يَسْكُنُ الصَّخْرَ وَيَبِيتُ عَلَى سِنِّ الصَّخْرِ وَالْمَعْقَلِ. مِنْ هُنَاكَ يَتَحَسَّسُ قُوتَهُ. تُبْصِرُهُ عَيْنَاهُ مِنْ بَعِيدٍ. فِرَاخُهُ تَحْسُو الدَّمَ، وَحَيْثُمَا تَكُنِ الْقَتْلَى فَهُنَاكَ هُوَ» (أيوب ٣٩: ٢٧ - ٣٠) وقصد المسيح هنا ثلاثة أمور:
- تشبيه الأمة اليهودية بالجثة لأن أخلاقها فسدت، ولم تعُد صالحة إلا أن لتكون فريسة لجيوش الأمم، كما تكون الجثة فريسة لطيور السماء ووحوش البرية. وتشبيه الجيوش الرومانية بالنسور لأنها رسل الله لانتقامه من اليهود كما أنبأ موسى بقوله «يَجْلِبُ الرَّبُّ عَلَيْكَ أُمَّةً مِنْ بَعِيدٍ، مِنْ أَقْصَاءِ الأَرْضِ كَمَا يَطِيرُ النَّسْرُ الخ» (تثنية ٢٨: ٤٩). ومن غريب الاتفاق أنه كانت على أعلام الرومان صُوَر النسور.
- متّى فقدت أُمة أو كنيسة حياتها الأخلاقية والروحية وأشبهت جثة فاسدة أتت رسل الله للانتقام، كما وقع على الناس زمن الطوفان إذ أرسل الله مياهه فأغرقتهم، وكما حدث لسدوم وعمورة إذ أرسل الله ناره من السماء وأحرقهما، وكما جرى للكنعانيين إذ أرسل الله عليهم بني إسرائيل فأبادوهم، وكما لقي العشرة الأسباط أولاً ثم سبط يهوذا يوم فسدوا بعبادة الأوثان فأرسل الله عليهم البابليين فسبوهم، وكما أصاب المملكة الرومانية أيضاً يوم أرسل الله عليها جنود شمال أوربا فاستولوا عليها (إشعياء ٦٦: ١١ وحزقيال ٣٩: ٤) ولا ريب في أن مثل ذلك يقع على كل خادم خائن لله وولدٍ عاصٍ له.
- يرسل الله في اليوم الأخير ملائكته ليعاقب العالم الأثيم وهذا هو الإتمام الأعظم لهذا الإنذار بعد أن وقع جزئياً مراراً كثيرة في تاريخ العالم. فيظهر لنا هذا العدد ضرورة عقاب الخطية وتحقق وقوعه ولزوم شموله.
٢٩ «وَلِلْوَقْتِ بَعْدَ ضِيقِ تِلْكَ ٱلأَيَّامِ تُظْلِمُ ٱلشَّمْسُ، وَٱلْقَمَرُ لاَ يُعْطِي ضَوْءَهُ، وَٱلنُّجُومُ تَسْقُطُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ، وَقُوَّاتُ ٱلسَّمَاوَاتِ تَتَزَعْزَعُ».
دانيال ٧: ١١، ١٢ وإشعياء ١٣: ١٠ وحزقيال ٣٢: ٧ ويوئيل ٢: ١٠، ٣١ و٣: ١٥ وعاموس ٥: ٢٠ و٨: ٩ ومرقس ١٣: ٢٤ الخ ولوقا ٢١: ٢٥ الخ وأعمال ٢: ٢٠ ورؤيا ٦: ١٢
علم المسيح في هذا العدد وما يليه أنه يقترن بمجيئه الثاني تقلبات مخيفة في نظام الكون وجمع مختاريه. وقد رأى بعض المفسرين أن هذا لا يشير إلى خراب أورشليم. وقال آخرون إن كلام المسيح هنا مجاز أشار به إلى أمرين: (١) النوازل التي تحل باليهود بعد خراب مدينتهم كطردهم من الأرض المقدسة وبيعهم عبيداً للأمم. و(٢) سقوط الممالك الوثنية والانقلابات السياسية المشار إليها بإظلام الشمس الخ.
والحق أنه لا يستطيع أحدٌ أن يجزم بتعيين الوقت الذي أشار إليه المسيح، ولكن أكثر المفسرين اعتقدوا أن المسيح تكلم بهذا العدد وما بعده إلى نهاية الأصحاح عن مجيئه العظيم للدينونة. واستخدم في هذا أسلوب الأنبياء في أنهم نظروا إلى عظائم الأمور واعتبروها قريبة، ولم يلتفتوا إلى ما يسبقها من صغائرها. فهم كمن ينظر إلى الجبال على أمد بعيد فيرى قممها قريبةً من بعضها، ولا يرى الأودية الواسعة بينها.
وَلِلْوَقْتِ بَعْدَ ضِيقِ قال الذين اعتقدوا إن هذا يشير إلى مجيء المسيح في يوم الدين «هذا إنباء من عنده ألف سنة كيوم واحد» (٢بطرس ٣: ١٨) فالمدة بيننا وبين ذلك المجيء إن لم تكن «للوقت» أو في الحال لنا، فهي كذلك له. وقال بعض هؤلاء إن قصد المسيح بقوله «للوقت بعد ضيق الخ» أنه لا تكون علامات أخرى لذلك المجيء. ومن تلك العلامات ارتداد كثيرين، وشيوع الشر، وانتشار بشرى الخلاص في كل الأرض، وظهوره فجأةً، وإتيان ملائكة النقمة كالنسور. فليس بعد ما ذكره من العلامات إلا نهاية العالم. ورأى قليل من المفسرين أن ذلك إنباء بمصائب اليهود بعد خراب مدينتهم.
تُظْلِمُ ٱلشَّمْس الخ لعل هذا الإنباء يتم حقيقة ومجازاً، فالحقيقي لا يحتاج إلى تفسير، وهذا هو المعنى الوارد في ٢بطرس ٣: ١٠، ١٢ ورؤيا ٢٠: ٢١. وأما المجازي فيراد به الانقلاب السياسي والاضطراب والخطر كما ورد كذلك مراراً كثيرة في الكتاب (مزمور ١١٨: ٧ - ١٤ و٦٨: ١ وإشعياء ٣: ٩ و٥: ٣٠ و٢٤: ٢٣ و٣٤: ٢، ٤ وإرميا ٤: ٢٨ وحزقيال ٣٢: ٢، ٧، ٨ ويوئيل ٢: ٣١ و٣: ١٥ وعاموس ٨: ٩، ١٠ وميخا ٣: ٦ ورؤيا ٨: ١٢). وتوقع الناس في كل عصر إلى أن المصائب كالمجاعات والأوبئة والحروب من حوادث السماء الغريبة كالخسوف والكسوف وظهور النجوم ذوات الأذناب والشهب والنيازك.
وَقُوَّاتُ ٱلسَّمَاوَات يحتمل أن المقصود بالقوات العناصر التي ذكرها بطرس الرسول في قوله «وَتَنْحَلُّ الْعَنَاصِرُ مُحْتَرِقَةً» (٢بطرس ٣: ١٠).
٣٠ «وَحِينَئِذٍ تَظْهَرُ عَلاَمَةُ ٱبْنِ ٱلإِنْسَانِ فِي ٱلسَّمَاءِ. وَحِينَئِذٍ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلأَرْضِ، وَيُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلإِنْسَانِ آتِياً عَلَى سَحَابِ ٱلسَّمَاءِ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِير».
دانيال ٧: ١٣ وزكريا ١٢: ١٢ ومتّى ١٦: ١٧ ومرقس ١٣: ٢٦ ورؤيا ١: ٧
عَلاَمَةُ ٱبْنِ ٱلإِنْسَانِ تظهر تلك العلامة في غاية الوضوح، وتدل أوضح دلالة على مجيء ابن الإنسان حتى لا يشك في مجيئه أحد. ولم يخبرنا المسيح بماهية تلك العلامة، فالبحث عنها عبث. إنما نعلم أن دانيال أنبأ بمجيء المسيح ثانية (دانيال ٧: ١٣) والمسيح نفسه أنبأ بذلك المجيء (متّى ٢٦: ٢٧، ٢٨). وأنبأ بأنه يأتي في مجد أبيه مع الملائكة في سحاب السماء (٢٦: ٦٤ ولوقا ٢١: ٢٧ وأعمال ١: ١١ و١تسالونيكي ٤: ١٧ ورؤيا ١٩: ١٠ - ١٤). ونعلم أيضاً أن الله كلما ظهر لأحدٍ من الناس ظهر بنور لامع.
تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلأَرْضِ يحتمل هذا الكلام ثلاثة معان الثالث منها هو المرجح: (١) نواح أهل اليهودية. وسموا قبائل لأنهم قسموا في الأصل إلى اثنتي عشرة قبيلة. وسينوحون على ما ينزل بهم من المصائب كما أنبأ الله بلسان نبيه زكريا بقوله «وَأُفِيضُ عَلَى بَيْتِ دَاوُدَ وَعَلَى سُكَّانِ أُورُشَلِيمَ رُوحَ ٱلنِّعْمَةِ وَٱلتَّضَرُّعَاتِ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيَّ، ٱلَّذِي طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُونَ عَلَيْهِ كَنَائِحٍ عَلَى وَحِيدٍ لَهُ، وَيَكُونُونَ فِي مَرَارَةٍ عَلَيْهِ كَمَنْ هُوَ فِي مَرَارَةٍ عَلَى بِكْرِهِ. فِي ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ يَعْظُمُ ٱلنَّوْحُ فِي أُورُشَلِيمَ كَنَوْحِ هَدَدْرِمُّونَ فِي بُقْعَةِ مَجِدُّونَ. وَتَنُوحُ ٱلأَرْضُ عَشَائِرَ عَشَائِرَ » (زكريا ١٢: ١٠ - ١٤) وتمت نبوة المسيح بهذا المعنى لأنه قُتل من اليهود غير ما ذكرنا سابقاً خمسون ألفاً في الإسكندرية وعشرة آلاف في دمشق وثلاثة عشر ألفاً في سثوبولس ومثل ذلك كثير لا محل لذكره هنا. بلغت مناحة اليهود كل البلاد التي تشتتوا فيها وكانت مناحة الخوف أعظم من مناحة التوبة. (٢) نواح وثنيي العالم على سقوط أوثانهم وتلاشي عبادتهم الوثنية قبل مجيء المسيح عند امتداد ملكوته (مزمور ٢: ٥ وإشعياء ٢: ١٨ - ٢٠ و١كورنثوس ١٥: ٢٥). (٣) وهو الأهم، وكل ما سواه رمزٌ إليه: نواح غير التائبين وغير المؤمنين عند نهاية العالم المشار إليها بقوله «هُوَذَا يَأْتِي مَعَ السَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَالَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ الأَرْضِ» (رؤيا ١: ٧) وذلك لإتيان الدينونة عليهم ولرفضهم قبوله مخلّصاً لهم. فلا ينوح الذين طعنوه حقيقة يوم صلبه وحدهم (يوحنا ١٩: ٣٧) بل ينوح معهم الذين طعنوه في كل عصر بآثامهم ورفضهم إياه (عبرانيين ٦: ٦).
وَيُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلإِنْسَانِ أي ينظرون المسيح آتياً ليدين العالم. فالذين يعتقدون أن هذا الكلام يتعلق بخراب أورشليم يفهمون من هذا أن اليهود يرون من خراب أورشليم برهاناً واضحاً على صحة دعوى المسيح، لأنه أتم بذلك نبوءته.
عَلَى سَحَابِ ٱلسَّمَاءِ المسيح صعد إلى السماء في سحابة، وقيل إنه يأتي كما صعد (أعمال ١: ٩، ١١ ودانيال ٧: ١٣ ومتّى ٢٦: ٦٤ ورؤيا ١: ٧).
بقوة: تظهر قوة يسوع (١) بإيقاع النقمة على أورشليم والأمة اليهودية (٢) بامتداد ملكوته في العالم (٣) بإقامته الموتى يوم الدين (يوحنا ٥: ٢٩، ٣٠ و١كورنثوس ١٥: ٥٢) وحل العالم المادي (٢بطرس ٣: ٧، ١٠، ١٢).
وَمَجْدٍ كَثِير يظهر مجده عند إتيانه (١) بتأسيس مملكته على الأرض. (٢) بمجيئه بعد ذلك ليدين الأرض. ويأتي حينئذٍ منتصراً مسربلاً بالمجد بالمقارنة بتواضعه في مجيئه الأول. ويكون بعض ذلك المجد من صفاته الذاتية (متّى ٢٦: ٦٤) وبعضه من تجند الملائكة له وحضورهم معه (متّى ٢٥: ٣١)
٣١ «فَيُرْسِلُ مَلاَئِكَتَهُ بِبُوقٍ عَظِيمِ ٱلصَّوْتِ، فَيَجْمَعُونَ مُخْتَارِيهِ مِنَ ٱلأَرْبَعِ ٱلرِّيَاحِ، مِنْ أَقْصَاءِ ٱلسَّمَاوَاتِ إِلَى أَقْصَائِهَا».
متّى ١٣: ٤١ و١كورنثوس ١٥: ٥٢ و١تسالونيكي ٤: ١٦
القول هنا كالقول في متّى ١٣: ٤١، ٤٩ ولعل ذلك أُنجز جزئياً بنجاة المسيحيين عند خراب أورشليم وفقاً لوعده العام في مزمور ٩١: ١١. ولا شك أنه ينجز تماماً عند نهاية العالم حين يجمع كل مختاري الله إلى محل الأمن والراحة كما قيل في ١تسالونيكي ٤: ١٦.
بِبُوقٍ عَظِيمِ ٱلصَّوْت كما كان عند إعطاء الشريعة من طور سيناء (خروج ١٩: ١٨، ٢٠) وكما كان يجري عند اليهود تنبيهاً للاجتماع إلى الأعياد أو الحروب (لاويين ٢٥: ٩ وعدد ١٠: ١ - ١٠ وقضاة ٣: ٢٧ ومزمور ٨١: ٣ وإرميا ٤: ٥).
مُخْتَارِيهِ (متّى ١٣: ٣٩ و٤١ - ٤٣ و١كورنثوس ١٦: ٥١ ورؤيا ٧: ٢ - ٤).
مِنَ ٱلأَرْبَعِ ٱلرِّيَاحِ أي من كل جهات الأرض حسب الاصطلاح العبراني (تثنية ٤: ٣٢ و٣٠: ٤ ومزمور ١٩: ٦) والمعنى أن الملائكة تجمع شعب الله من كل مكان يكون فيه (مرقس ١٣: ١٧).
كان كل ما ذُكر في هذا الأصحاح جواباً لسؤال الرسل الثاني وهو «ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟» (ع ٣) فبدأ به ليبين علامات خراب أورشليم، وانتهى بتبيين علامات نهاية العالم. ثم أجابهم على السؤال الأول وهو قولهم «متّى يكون هذا؟» فبدأ بالإجابة عن وقت خراب أورشليم وانتهى بالإجابة عن وقت نهاية العالم
٣٢ «فَمِنْ شَجَرَةِ ٱلتِّينِ تَعَلَّمُوا ٱلْمَثَلَ: مَتَى صَارَ غُصْنُهَا رَخْصاً وَأَخْرَجَتْ أَوْرَاقَهَا، تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَرِيبٌ».
لوقا ٢١: ٢٩ الخ
فَمِنْ شَجَرَةِ ٱلتِّينِ ضرب المسيح لرسله مثل التينة قبل أن يجيبهم على سؤالهم ليبين لهم أن العلامات التي ذكرها تحقق الحوادث التي تليها، كما أن ورق شجرة التين يؤكد قرب الصيف.
٣٣ «هٰكَذَا أَنْتُمْ أَيْضاً، مَتَى رَأَيْتُمْ هٰذَا كُلَّهُ فَٱعْلَمُوا أَنَّهُ قَرِيبٌ عَلَى ٱلأَبْوَابِ».
يعقوب ٥: ٩
هٰذَا كُلَّهُ أي ما ذكره من العلامات التي تتقدم خراب أورشليم في ع ٥ - ١٥، ٢٤ وهذا جوابه الأول على سؤالهم، أي أن الخراب يلي ظهور العلامات سريعاً.
٣٤ «ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: لاَ يَمْضِي هٰذَا ٱلْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ هٰذَا كُلُّهُ».
متّى ١٦: ٢٨ و٢٣: ٣٦ ومرقس ١٣: ٣٠ الخ ولوقا ٢١: ٣٢ الخ
لاَ يَمْضِي هٰذَا ٱلْجِيلُ هذا جوابه الثاني على السؤال المذكور، أي أن أورشليم تخرب وبعض ذلك الجيل في الحياة. ومعدل حياة الجيل ما بين ثلاثين وأربعين سنة، وخراب أورشليم كان بعد أربعين سنة من وقت هذا الجواب. ولا شك أن كثيرين ممن كانوا أحياء على الأرض حينئذٍ شاهدوا خراب أورشليم، وأن واحداً من الأربعة الذين سألوا المسيح عن ذلك كان حياً وقت ذلك الخراب، وهو يوحنا.
حَتَّى يَكُونَ هٰذَا كُلُّهُ أي كل ما ذكره في شأن خراب أورشليم ومصائب الأمة اليهودية. وقال بعضهم معنى قوله «هذا كله» ما ذكرناه في شأن أورشليم في شرح عدد ٣٣، وزاد على ذلك ما قيل في ع ٢٩ - ٣١. وإن كل هذه النبوات تمت في عصر ذلك الجيل، أي في مدة نحو أربعين سنة، وأن بعضها تم حقيقة وبعضها تم مجازاً. ولا تناقض بين قولهم وقول من اعتقدوا أن تلك النبوات تتم أيضاً في يوم الدين، فيكون التمام الأول رمزاً إلى الثاني. واعتقد هؤلاء أن قصد المسيح بقوله «هذا الجيل» الأمة اليهودية التي جرى عليها ما لم يجرِ على أمة أخرى من أمم الأرض، فإنها تفرقت بن كل الأمم ولم تمتزج بهم منذ العصور البعيدة إلى الآن.
٣٥ «ٱلسَّمَاءُ وَٱلأَرْضُ تَزُولاَنِ وَلٰكِنَّ كَلاَمِي لاَ يَزُولُ».
مزمور ١٠٢: ٢٦ وإشعياء ٥١: ٦ وإرميا ٣١: ٣٥ الخ ومتّى ٥: ١٨ وعبرانيين ١: ١١ و١بطرس ١: ٢٥
قال المسيح ذلك تأكيداً لصحة إنبائه بخراب أورشليم ونهاية العالم، فإن أثبت شيء يعلمه الإنسان من المخلوقات هو نظام العالم، ولكن كلام المسيح أثبت منه، لأن العالم مع طول مدته ومتانته يزول، ولكن كلام ابن الله حقٌ لا يزول (مزمور ١٠٢: ٢٩ وإشعياء ٥١: ٦). وفيه إشارة إلى طول الزمان الذي يمضي قبل أن تتم نبوته التمام النهائي، وإلى حاجة إيمان الناس بتلك النبوات إلى تقوية وتثبيت.
٣٦ «وَأَمَّا ذٰلِكَ ٱلْيَوْمُ وَتِلْكَ ٱلسَّاعَةُ فَلاَ يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلاَ مَلاَئِكَةُ ٱلسَّمَاوَاتِ، إِلاَّ أَبِي وَحْدَهُ».
زكريا ١٤: ٧ ومرقس ٣: ٣٢ وأعمال ١: ٧ و١تسالونيكي ٥: ٢ و٢بطرس ٣: ١٠
ذٰلِكَ ٱلْيَوْمُ أي يوم الدين. فرغ من الكلام على وقت خراب أورشليم بعد أن أبان لهم علامتين لذلك (ع ٣٢ - ٣٤).
فَلاَ يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَد قال هذا لقطع رجاء الرسل أن يعرفوا وقت يوم الدين، فالأمر مؤكد والزمان مجهول.
وَلاَ مَلاَئِكَة الله لم يخبرهم. فيتضح إنه لم يرد أن يخبر تلاميذه بذلك الوقت. ويؤكد بذلك قوله «لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا الأَزْمِنَةَ وَالأَوْقَاتَ الَّتِي جَعَلَهَا الآبُ فِي سُلْطَانِهِ» (أعمال ١: ٧). وزاد مرقس على ما قيل هنا قوله «ولا الابن» (مرقس ١٣: ٣٢). وهذا وفق قوله «وَأَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ يَتَقَدَّمُ فِي الْحِكْمَةِ الخ» (لوقا ٢: ٥٢). وما نسب إليه من الجوع والإعياء والنوم والوجع والحزن والبكاء يبين أنه كان إنساناً تاماً كما ظهر من معجزاته إنه كان إلهاً تاماً. وإنه كان يمكنه إذا شاء أن يجعل ناسوته لا يستفيد من لاهوته لأنه «إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ اللهِ.. أَخْلَى نَفْسَهُ، آخِذًا صُورَةَ عَبْدٍ، صَائِرًا فِي شِبْهِ النَّاسِ» (فيلبي ٢: ٦، ٧). ولا نستطيع أن ندرك كيف أن يسوع باعتباره إنساناً لا يعرف الزمان الذي عينه باعتباره إلهاً. ولكن هذا ليس بأبعد من إدراكنا سر التثليث أو سر التجسد.
٣٧ «وَكَمَا كَانَتْ أَيَّامُ نُوحٍ كَذٰلِكَ يَكُونُ أَيْضاً مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلإِنْسَانِ».
بقية كلام المسيح في هذا الأصحاح تحذيرات من الغفلة عن يوم الدين والحث على الاستعداد له، لأنه علم أن عدم تعيينه وقت مجيئه للناس يحملهم على عدم توقعه. وضرب لهم لأجل تلك الغاية مثل الناس قبل الطوفان.
أَيَّامُ نُوحٍ هو العاشر من آدم، وكان واعظاً بالبر. وكان الناس في أيامه أشراراً جداً. وكان حكم الله قريب الوقوع عليهم وهم غافلون، فأرسله الله نذيراً لهم ينبئهم بالدينونة الآتية فبقوا في غفلتهم. لقد نبههم فلم يسمعوا وهكذا كما قال حزقيال (راجع حزقيال ٣٣: ٦ وما بعده).
مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلإِنْسَانِ أي مجيئه للدينونة، ويسمى أيضاً أيام ابن الإنسان (لوقا ١٧: ٢٦) «وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح» (تيطس ٢: ١٣). أنبأ المسيح إنه يكون الناس في مجيئه الثاني كما كان الناس في أيام نوح. وذكر الطوفان في هذا المقام يثبِّت نبأه في العهد القديم.
٣٨ «لأَنَّهُ كَمَا كَانُوا فِي ٱلأَيَّامِ ٱلَّتِي قَبْلَ ٱلطُّوفَانِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَزَوَّجُونَ وَيُزَوِّجُونَ، إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي دَخَلَ فِيهِ نُوحٌ ٱلْفُلْكَ».
تكوين ٦: ٢ الخ و٧: ٤، ١١ الخ ولوقا ١٧: ٢٦ الخ و١بطرس ٣: ٢٠
يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ أي يعيشون كعادتهم غير متوقعين حدوث الطوفان، مع أن نوحاً حذرهم ١٢٠ سنة (دون تعيين زمن حدوثه) وصنع الفلك أمام عيونهم (١بطرس ٣: ١٩، ٢٠ و٢بطرس ٢: ٥ و٣: ٦). فهم لم يخطئوا بالأكل والشرب، بل بالانهماك فيهما، غير ملتفتين إلى الإنذارات الإلهية.
٣٩ «وَلَمْ يَعْلَمُوا حَتَّى جَاءَ ٱلطُّوفَانُ وَأَخَذَ ٱلْجَمِيعَ، كَذٰلِكَ يَكُونُ أَيْضاً مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلإِنْسَانِ».
أُنذروا ولم يؤمنوا (٢بطرس ٢: ٥). فبقوا غير مكترثين وغير خائفين يولمون الولائم ويحتفلون في الأعراس وهم على شفا الهلاك. والأرجح أنهم لم يصدقوا نوحاً حتى دخل الفلك وبدأ المطر يقع إلى أن جرفتهم مياه الطوفان إلى الموت، ولم ينج سوى نوح وعائلته. فهكذا تكون حال الناس عند نهاية العالم، غير مؤمنين وغير مستعدين.
٤٠، ٤١ «٤٠ حِينَئِذٍ يَكُونُ ٱثْنَانِ فِي ٱلْحَقْلِ، يُؤْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُتْرَكُ ٱلآخَرُ. ٤١ اِثْنَتَانِ تَطْحَنَانِ عَلَى ٱلرَّحَى، تُؤْخَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَتُتْرَكُ ٱلأُخْرَى».
لوقا ١٧: ٣٤ الخ
هذان العددان متعلقان بعدد ٣١، وخلاصتهما أن الله يرسل ملائكته ليجمع مختاريه فيأخذ بعض الناس لملاقاة المسيح ويترك الآخرين للهلاك (دانيال ١٢: ٢). والذين ذُكروا فيهما رجال ونساء يمارسون أعمالهم العادية، بعضهم في الحقل والبعض في البيت. وذكرهم دون غيرهم بياناً لأن الله يهتم بمختاريه ولو كانوا من أدنى الناس، ويرسل ملائكته لتأخذهم إليه ولا تترك أحداً منهم. ويظهر من ذلك أن الأشرار والأبرار يبقون مخلصين إلى النهاية (لوقا ١٧: ٣٤). وهذا موافق لما ذكره الرسول بقوله «ثُمَّ نَحْنُ الأَحْيَاءَ الْبَاقِينَ سَنُخْطَفُ جَمِيعًا مَعَهُمْ فِي السُّحُبِ لِمُلاَقَاةِ الرَّبِّ فِي الْهَوَاءِ» ١تسالونيكي ٤: ١٧) ويتضح أن الكلام هنا على اليوم الأخير لا على خراب أورشليم من أن هذا لا تسبقه علامات بخلاف ذاك. وكان على المسيحيين في خراب أورشليم أن يهربوا. وأما هنا فيؤخذون.
٤٢ «اِسْهَرُوا إِذاً لأَنَّكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ يَأْتِي رَبُّكُمْ».
متّى ٢٥: ١٣ ومرقس ١٣: ٣٣ الخ ولوقا ٢١: ٣٦
كرر هنا الأمر بالانتباه والاستعداد بناءً على احتمال أن كل ساعة هي الساعة الأخيرة.
٤٣ «وَٱعْلَمُوا هٰذَا أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبُّ ٱلْبَيْتِ فِي أَيِّ هَزِيعٍ يَأْتِي ٱلسَّارِقُ، لَسَهِرَ وَلَمْ يَدَعْ بَيْتَهُ يُنْقَبُ».
متّى ١٤: ٢٥ ولوقا ١٢: ٣٨، ٣٩ و٢بطرس ٣: ١٠ ورؤيا ٣: ٣
رَبُّ ٱلْبَيْتِ لم يورد المسيح هذا الإنسان نموذجاً لتلاميذه، لأنه لم يعزم على السهر إلا عندما بلغه النبأ بمجيء السارق، والمسيح أمرهم أن يتوقعوا مجيئه دائماً، ولهذه الغاية عينها كتم عنهم وقت إتيانه. وضربوا المثل قديماً بمجيء السارق ليلاً لكل أمرٍ مفاجئ (١تسالونيكي ٥: ٢ و٢بطرس ٣: ١٠ ورؤيا ٣: ٣ و١٦: ٥). ووجه الشبه بين مجيء المسيح للدينونة ومجيء السارق ليلاً أن كلاً منهما يكون بغتة، فإن اللص يأتي حين يظن الناس نياماً، والمسيح يأتي والعالم غافل عنه. ويختلف مجيء المسيح عن مجيء السارق في أنه لا يخيف إلا من جعلوا كنزهم في هذا العالم فقط. وفي هذا إشارة إلى أنه سيكون الناس كلهم في خطر عظيم من الغفلة، وإنه يجب على عبيد الله أن يسهروا على الدوام أي كل الوقت لا وقتاً دون آخر.
فِي أَيِّ هَزِيعٍ قسم اليهود الليل قبل استيلاء الرومان عليهم إلى ثلاثة هُزُع، وقسموه بعد الاستعمار الروماني إلى أربعة، وجعلوا كل هزيع ثلاث ساعات. وذُكر الهزيع الثاني والهزيع الثالث في لوقا ١٢: ٣٨ والرابع في متّى ١٤: ٢٥.
٤٤ «لِذٰلِكَ كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضاً مُسْتَعِدِّينَ، لأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لاَ تَظُنُّونَ يَأْتِي ٱبْنُ ٱلإِنْسَانِ».
١تسالونيكي ٥: ٢، ٦.
غاية المسيح من كل تلك التنبيهات حث تلاميذه على الاستعداد والانتباه والأمانة والصلاة (لوقا ٢١: ٣٦) وبيَّن لهم حقيقة ذلك الاستعداد بقوله «اكنزوا لكم كنوزاً في السماء» (متّى ٦: ٢). وأوضحه بولس الرسول أيضاً (١تسالونيكي ٥: ٤ - ١١).
٤٥ «فَمَنْ هُوَ ٱلْعَبْدُ ٱلأَمِينُ ٱلْحَكِيمُ ٱلَّذِي أَقَامَهُ سَيِّدُهُ عَلَى خَدَمِهِ لِيُعْطِيَهُمُ ٱلطَّعَامَ فِي حِينِهِ؟».
لوقا ١٢: ٤٢ وأعمال ٢٠: ٢٨ و١كورنثوس ٤: ٢ وعبرانيين ٣: ٥
ٱلْعَبْدُ ٱلأَمِينُ هو من يقوم بكل ما يجب عليه لسيده.
ٱلْحَكِيمُ هو الذي يتوقع مجيء سيده (أمثال ٢٢: ٣ و٢٧: ١٢). فالأمانة والحكمة صفتان لازمتان للمسيحي.
سيده: المقصود بالسيد هنا الرب يسوع، بدليل قوله «أَنْتُمْ تَدْعُونَنِي مُعَلِّمًا وَسَيِّدًا، وَحَسَنًا تَقُولُونَ، لأَنِّي أَنَا كَذلِكَ» (يوحنا ١٣: ١٣).
أَقَامَهُ... عَلَى خَدَمِهِ يظهر من هنا أن العبد الذي أقامه كذلك رسول أو معلم روحي، ولكن المسيح لم يقصر كلامه على هذا فقط، بل عن كل إنسان منحه المعرفة والمال والوظيفة التي يستطيع بها التأثير في أفكار الناس وأعمالهم. وأوجب الله على مثل هذا أن يحاسب حساباً مدققاً على كل ما وُهبه. والسيد أقام ذلك العبد لا لإظهار شرفه أو رفعة مقامه، بل ليفيد غيره بتعليمه (١كورنثوس ٣: ٥ و٤: ١، ٢ و١٢: ٢٨ و١تسالونيكي ٥: ١٢، ١٣). وأراد بخدمه كنيسته التي هي عشيرة المسيح (أفسس ٣: ١٥).
لِيُعْطِيَهُمُ ٱلطَّعَامَ أي القوت الروحي أو الإرشاد والتعليم (عبرانيين ٥: ١٢ و١بطرس ٢: ٢). ولذلك سُمّي رؤساء الشعب الروحيون رُعاة (يوحنا ٢١: ١٥، ١٧ وأعمال ٢٠: ٢٨). ويعطي الله الناس الغنى والسلطان ووسائط أخرى يستطيع الخادم بها أن يساعد المحتاجين (لوقا ٢٢: ٢٦ و١كورنثوس ٣: ٢ و٤: ١، ٢ و١٤: ٢٢ و٢تيموثاوس ٢: ١٥ و١بطرس ٥: ٢، ٣.
فِي حِينِهِ أي وقت الحاجة. وأفضل أوقات فعل الخير هو الآن! وهذا وفق قول الرسول «حسب ما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان» (غلاطية ٦: ١٠). والخلاصة أن ذلك العبد يقوم بكل أعماله متوقعاً مجيء سيده في كل ساعة فيفحص فيها أعماله.
٤٦ «طُوبَى لِذٰلِكَ ٱلْعَبْدِ ٱلَّذِي إِذَا جَاءَ سَيِّدُهُ يَجِدُهُ يَفْعَلُ هٰكَذَا».
رؤيا ١٦: ١٥
طُوبَى... إِذَا جَاءَ سَيِّدُه هذا التطويب للأمين يوم مجيء الرب.
يَفْعَلُ هٰكَذَا أي يكون أميناً لسيده مهتماً براحة إخوته ونفعهم.
٤٧ «ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يُقِيمُهُ عَلَى جَمِيعِ أَمْوَالِه».
متّى ٢٥: ٢١، ٣٣ ولوقا ٢٢: ٢٩
يُقِيمُهُ الخ يبين من هذا أن عمله لا ينتهي بانتهاء حياته الأرضية، فخدمته على الأرض استعداد لخدمته العظمى في السماء. ولا إشارة بذلك إلى أفضلية بعض القديسين في السماء على الأرض في الرئاسة، إنما يستنتج منه عظمة الإثابة وإظهار رضى الله عليه. وعبَّر عن تلك الإثابة بما اعتاده الملوك بإظهار رضاهم على عبيدهم بترقيتهم ورفع مقامهم، كما فعل فرعون بيوسف (تكوين ٣٩: ٤، ٦) وذلك وفق قول المسيح «إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَخْدِمُنِي يُكْرِمُهُ الآبُ» (يوحنا ١٢: ٢٦). وقوله «كُنْتَ أَمِينًا فِي الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ» (متّى ٢٥: ٢١) (انظر أيضاً رومية ٨: ١٧ ورؤيا ٢: ٢٦ و٣: ٢١).
٤٨ «وَلٰكِنْ إِنْ قَالَ ذٰلِكَ ٱلْعَبْدُ ٱلرَّدِيُّ فِي قَلْبِهِ: سَيِّدِي يُبْطِئُ قُدُومَهُ».
ذٰلِكَ ٱلْعَبْدُ فرض هنا ذلك العبد عينهُ خائناً، بدل أن يكون أميناً.
فِي قَلْبِهِ أي ظن في قلبه وأظهر ظنَّه بعمله.
سَيِّدِي لم يزل يقرُّ بأنه عبده.
يُبْطِئُ قُدُومَهُ ذلك يشير إلى مضي زمان طويل قبل مجيء الرب. وحمله طول هذا الزمان على الظن أن سيده لا يرجع أبداً. وقول هذا العبد كقول القوم الذين ذكرهم بطرس الرسول بقوله «سَيَأْتِي قَوْمٌ قَائِلِينَ: أَيْنَ هُوَ مَوْعِدُ مَجِيئِهِ؟ لأَنَّهُ مِنْ حِينَ رَقَدَ الآبَاءُ كُلُّ شَيْءٍ بَاق هكَذَا مِنْ بَدْءِ الْخَلِيقَةِ» (٢بطرس ٣: ٣، ٤). (انظر أيضاً جامعة ٨: ١١ وحزقيال ١٢: ٢٧ ورومية ٢: ٤) وإبطاء المسيح قدومه امتحان لإيمان الكنيسة وعلة ارتداد كثيرين.
٤٩ «فَيَبْتَدِئُ يَضْرِبُ ٱلْعَبِيدَ رُفَقَاءَهُ وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مَعَ ٱلسُّكَارَى».
يَضْرِبُ ٱلْعَبِيدَ رُفَقَاءَهُ أي الأمناء من أولئك العبيد. فاتخذ ذلك العبد رتبته وسيلة إلى الظلم والإمعان في الشهوات واللذات المحظورة. ويحسب المسيح مثل هذا العبد كل مسيحي، ولا سيما المعلم الديني غير الأمين في وظيفته، إذ أنه يتخذ وظيفته فرصة لكي «يَسُودُ عَلَى الأَنْصِبَةِ» (١بطرس ٥: ٣) ويرافق الدنيويين، ويتهافت على مشتهيات هذا العالم.
٥٠ «يَأْتِي سَيِّدُ ذٰلِكَ ٱلْعَبْدِ فِي يَوْمٍ لاَ يَنْتَظِرُهُ وَفِي سَاعَةٍ لاَ يَعْرِفُهَا».
يَأْتِي رب العبد لا يمنع ولا يعيق قدوم السيد، فلا بد أن يأتي إلى كل العالم يوم الدين، وإلى كل إنسان يوم موته.
فِي يَوْمٍ لاَ يَنْتَظِرُه كرر هنا ما ذكره سابقاً من أنه يأتي بغتة حين لا يتوقع أحد إتيانه. ويصدق كلام المسيح هنا على الكنيسة كلها عند نهاية العالم، وعلى كل الناس عند موتهم. ويغلب أن يأتي الموت في وقتٍ يقل انتظاره فيه.
وَفِي سَاعَةٍ لاَ يَعْرِفُهَا هذا دليل على غرابة المفاجأة في مجيئه، فلا يسبقه النبأ به ولو بساعة واحدة.
٥١ «فَيُقَطِّعُهُ وَيَجْعَلُ نَصِيبَهُ مَعَ ٱلْمُرَائِينَ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَاءُ وَصَرِيرُ ٱلأَسْنَانِ».
متّى ١٨: ١٢ و٢٥: ٣٠
فَيُقَطِّعُهُ اعتاد القدماء أن يقتلوا المذنبين تقطيعاً (١صموئيل ١٥: ٣٣ و٢صموئيل ١٢: ٣١ ودانيال ٢: ٥ و٣: ٢٩ وعبرانيين ١١: ٣٧)
نَصِيبَهُ مَعَ ٱلْمُرَائِينَ لأنهم حُسبوا شر الناس لاجتهادهم في ان يخدموا سيدين: الأول بالقول والثاني بالفعل (رؤيا ٢١: ٢٧ و٢٢: ١٥)
ٱلْبُكَاءُ وَصَرِيرُ ٱلأَسْنَانِ هذا كناية عن اليأس والألم (متّى ٨: ١٢). وهما عقاب غير الأمين من المسيحيين، وهو عقاب مخيفٌ وأبديٌ. ولنا مما قيل في مثل العبد من ع ٤٢ - ٥١. إن صفات العبد الأمين خمس: (١) أنه أمين لسيده وأمين في وظيفته. (٢) أنه حكيم في توقع مجيء سيده، فهو يقول على الدوام «هُوَذَا الدَّيَّانُ وَاقِفٌ قُدَّامَ الْبَابِ» (يعقوب ٥: ٩) (٣) أنه صبور على بطء سيده (٤) يستعمل سلطانه لنفع غيره (٥) يُثاب بمدح سيده إياه ورفع مقامه. وصفات العبد الرديء خمس وهي: (١) يشك في مجيء سيده ويقول سيدي يبطئ قدومه (٢) يستعمل سلطانه لظلم غيره (٣) يلهو باللذات الجسدية (٤) يعاشر الدنيويين. (٥) يعاقب عقاباً فجائياً مخيفاً لا نهاية له.
الأصحاح الخامس والعشرون
١ «حِينَئِذٍ يُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمَاوَاتِ عَشَرَ عَذَارَى، أَخَذْنَ مَصَابِيحَهُنَّ وَخَرَجْنَ لِلِقَاءِ ٱلْعَرِيسِ».
أفسس ٥: ٢٩، ٣٠ ورؤيا ١٩: ٧ و٢١: ٢، ٩
هذا المثل كمثل الوكيل في الأصحاح السابق، يُعلم وجوب السهر والاستعداد لملاقاة المسيح عند مجيئه الثاني بغتة.
مَلَكُوتُ ٱلسَّمَاوَاتِ أي الملكوت الذي أتى المسيح ليقيمه على الأرض، وهو هنا يعني كنيسته المنظورة. ومشابهة الكنيسة للعريس سبق الكلام عنهما في شرح متّى ٢٢: ٢ (انظر أيضاً أفسس ٥: ٢٥ - ٣٢ ورؤيا ١٩: ٧، ٩ و٢١: ٢٩). والمقصود بالعريس المسيح، كما يتضح من مزمور ٤٥ وسفر نشيد الأنشاد. والعروس هي الكنيسة بجملتها.
عَشَرَ عَذَارَى المقصود بهن أعضاء الكنيسة بمقتضى الظاهر، حيث لا يتبين المؤمن بالحق منهم إلا في النهاية. وحال الكنيسة عند مجيء المسيح ثانية تشبه حالة العذارى هنا.
واستعار للكنيسة الإناث دون الذكور للمناسبة، فإن الكنيسة مؤنثة، وعادة الأعراس يومئذٍ أن تكون رفيقات العروس إناثاً. فليس للعذارى معنى خاص غير الإناث، ولا يصح أن نحسب كونهن عذارى دليلاً على زيادة طهارتهن، لأن خمساً منهن جاهلات. لكن ذلك ضروري لمناسبة المثل لأن عادة الأعراس في تلك الأيام أن تكون رفيقات العروس عذارى. ويوافق معنى المثل ما ورد في ٢كورنثوس ١١: ٢ ورؤيا ١٤: ٤. وليس المقصود أن عددهن عشراً سوى أنه وفق العادة. ويشبه ذلك ما ذكر في سفر راعوث (راعوث ٤: ٢). والعشرة عدد حسبه اليهود أقل ما يلزم لاجتماع قانوني في الصلاة، أو لاجتماع فرقة لأكل الفصح، أو لإقامة حفل عرس.
مَصَابِيحَهُنَّ كانت عادة اليهود أن يحتفلوا بالعرس ليلاً، فلزم أن يحملوا مصابيح للإضاءة والزينة. والمقصود بها هنا الإقرار بالدين (لوقا ١٢: ٣٥). وعدم التفريق بين المصابيح يدل على أنه لم يظهر فرق بين المؤمنين الحقيقيين والمؤمنين في الظاهر.
خَرَجْنَ لِلِقَاءِ ٱلْعَرِيسِ أي خرجن من بيوتهن إلى بيت العروس ليرافقنها في ملاقاة العريس عند مجيئه ليأخذها من بيت أبيها إلى بيته حيث الوليمة، ويذهبن معها إلى هناك. وسرد المثل على هذه الصورة يعطينا فكرة واضحة عن تلك العادات الشرقية القديمة، وكثير منها معمول بها حتى اليوم.
٢ «وَكَانَ خَمْسٌ مِنْهُنَّ حَكِيمَاتٍ، وَخَمْسٌ جَاهِلاَتٍ».
متّى ١٣: ٤٧ و٢٢: ١٠
حَكِيمَاتٍ أظهرن حكمتهن بأنهن اهتممن بأمور المستقبل واستعددن لها.
جَاهِلاَت كانت جهالتهن أنهن لم ينتبهن لأمور المستقبل وما تقتضي من الاستعداد. والفرق بين الحكيمات والجاهلات كالفرق بين الذي بنى بيته على الصخر والذي بنى بيته على الرمل (متّى ٧: ٢٤ - ٢٧). ولنا من هذا المثل أن الكنيسة لا تزال إلى آخر الزمان تشتمل على أعضاء مخلصين وأعضاء مرائين، كما ظهر في مثل الحنطة والزوان (متّى ١٣). ومساواة عدد الحكيمات للجاهلات ليس جوهرياً في المثل، فلا يلزم منه تساوي عدد المرائين والمخلصين.
٣ «أَمَّا ٱلْجَاهِلاَتُ فَأَخَذْنَ مَصَابِيحَهُنَّ وَلَمْ يَأْخُذْنَ مَعَهُنَّ زَيْتا».
أراد بذلك الإقرار ظاهراً بالدين دون النعمة الباطنة، فهن بمنزلة المزروع في الأرض المحجرة في مثل الزارع (متّى ١٣: ٥، ٢٠، ٢١).
٤ «وَأَمَّا ٱلْحَكِيمَاتُ فَأَخَذْنَ زَيْتاً فِي آنِيَتِهِنَّ مَعَ مَصَابِيحِهِنَّ».
أي اعترفن بالدين ظاهراً، ولكن كان لهن نعمة في الباطن. والمقصود بالزيت هنا النعمة التي هي موهبة الروح القدس (زكريا ٤: ٢، ١٢ وأعمال ١٠: ٣٨). ونحصل على هذه النعمة بالصلاة وغيرها من الوسائط الروحية (٢كورنثوس ١: ٢١ و١يوحنا ٢: ٢٠، ٢٧) ويمكن للمسيحيين بتلك النعمة أن «يضيئوا كأنوار في العالم» (فيلبي ٢: ١٥ و٢بطرس ١: ١٠).
٥ «وَفِيمَا أَبْطَأَ ٱلْعَرِيسُ نَعَسْنَ جَمِيعُهُنَّ وَنِمْنَ».
١تسالونيكي ٥: ٦
أَبْطَأَ ٱلْعَرِيسُ في هذا إشارة إلى طول المدة بين مجيء المسيح الأول ومجيئه الثاني. ولا ريب أنها أطول مما انتظرت الكنيسة، فقد مرَّ عليها أكثر من عشرين قرناً ولم يجئ العريس بعد.
نَعَسْنَ جَمِيعُهُنَّ وَنِمْنَ لا لوم عليهن بذلك في المثل ولا على الكنيسة في المعنى، لأن هذا النوم طبيعي لمن يطيلون السهر. والحكيمات نمن كالجاهلات، فلا بأس من النوم بعد تكميل الاستعداد. ولم تُمنع الجاهلات من دخول الوليمة لسبب نومهن.
٦ «فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلٌ، فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ».
متّى ٢٤: ٣١ و١تسالونيكي ٤: ١٦
نِصْفِ ٱللَّيْلِ هو الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى المصابيح المعدة للإضاءة، ويصعب فيه الحصول على لوازم المصابيح إذ لم تكن مهيأة. ولنا من هذا أن المسيح يأتي ثانية والناس في غفلة عن مجيئه.
صَارَ صُرَاخٌ الصوت الذي يوقظ الناس من نومهم في نصف الليل يكون غالباً مفاجئاً لكل العالم، فتسمعه كل أذن ويكون مخيفاً إذا لم يستعدوا له. وقد استنتج البعض من هذا الكلام أن المسيح يأتي في نصف الليل حقيقة، فجعلوا السهر جزءاً من العبادة الواجبة على المسيحي، ولكن الأرض كروية يأتي المسيح إليها في وقت واحد. فالوقت الذي يكون نصف الليل عند قوم يكون نصف النهار عند آخرين! وذلك الصوت الذي ينادى به العالم كله في ذلك اليوم ينادى به كل إنسان في نهاية حياته. والصارخ حينئذٍ هو الموت. والاستعداد اللازم لملاقاة العريس هو عينه لازم لملاقاة الموت.
٧ «فَقَامَتْ جَمِيعُ أُولَئِكَ ٱلْعَذَارَى وَأَصْلَحْنَ مَصَابِيحَهُنَّ».
فَقَامَتْ جَمِيعُ أُولَئِكَ ٱلْعَذَارَى هذا غير مقصور على النيام الأحياء على الأرض حين مجيء المسيح ثانيةً، فهو يصدق على جميع المدعوين مسيحيين الذين رقدوا في القبور منذ تأسيس الكنيسة إلى نهايتها. ولكن يعسر إيضاح ذلك في المثل.
أَصْلَحْنَ مَصَابِيحَهُنَّ ألزمتهن المناداة بإقبال العريس أن ينظرن في أحوال مصابيحهن ليرين أفيها زيتٌ أم لا. كذلك يلزم كل واحد يوم الموت ويوم مجيء الرب ثانية أن يمتحن نفسه كما أن الرب يمتحنه أيضاً. وكثيراً ما حدث أن المؤمنين عند موتهم أظهروا فضائلهم الروحية أعظم إظهار، كأن مصابيحهم أُصلحت جديداً بزيت النعمة. وقد يتفق أن يفاجئ الموت المسيحي بالحق وهو متوقع أن يحيا زماناً أطول في خدمة الرب، فيضطرب في أول الأمر حتى يضعف رجاؤه، فيكون كمصباح يكاد ينطفئ، ثم يرجع إلى نفسه ويرى أساس إيمانه ورجائه فيجدد ثقته، كأن مصباحه أُصلح من مصدر إلهي.
٨ «فَقَالَتِ ٱلْجَاهِلاَتُ لِلْحَكِيمَاتِ: أَعْطِينَنَا مِنْ زَيْتِكُنَّ فَإِنَّ مَصَابِيحَنَا تَنْطَفِئُ».
نلاحظ هنا أن الفرق ليس في المصباح من جهة شكله أو حجمه، بل: هل فيه زيت أم لا؟! كذلك في ديانتنا، يجب أن نعرف: هل نحن حسب الظاهر فقط، لنا صورة التقوى فقط؟
أَعْطِينَنَا مِنْ زَيْتِكُنَّ علة ذلك نظرهن في حال مصابيحهن إذ وجدنها كادت تنطفئ من الحاجة إلى الزيت، فظهرت جهالتهن بعدم استعدادهن الضروري. وفي هذا إشارة إلى أنه يأتي على كل إنسان وقت يُمتحن فيه دينه: هل هو دين قلبي؟ ويحتمل أن مصباح المرائي يكفيه مدة الحياة. ولكن متّى اضطُر أن يسير في وادي ظل الموت يظهر ضعف نوره وفراغه من الزيت، فيقع في الحيرة والاضطراب. وهنا طلبت الجاهلات إلى الحكيمات أن يعالجن نقصهن، كذلك سيطلب المسيحيون الدنيويون إلى المسيحيين أن يشاركوهم في فضائلهم، فيكونون كبلعام الذي لم يرد أن يحيا حياة الأبرار مع أنه أحب أن يموت موتهم، وأن تكون آخرته كآخرتهم (عد ٢٣: ١٠).
٩ «فَأَجَابَتِ ٱلْحَكِيمَاتُ: لَعَلَّهُ لاَ يَكْفِي لَنَا وَلَكُنَّ، بَلِ ٱذْهَبْنَ إِلَى ٱلْبَاعَةِ وَٱبْتَعْنَ لَكُنَّ».
لَعَلَّهُ لاَ يَكْفِي الخ أَبت الحكيمات إجابة طلب الجاهلات لأسباب كافية فأظهرن بذلك حكمتهن. والغاية من ذكر الحديث بين الحكيمات والجاهلات تعليمنا عدة حقائق: (١) أن كل إنسان يعطي الله حساباً عن نفسه لا عن غيره (مزمور ٤٩: ٧ ورومية ١٤: ١٢ و١بطرس ٤: ١٨). (٢) أن وقت الموت أو وقت مجيء الرب ليس وقت الحصول على النعمة، بل هو قبلهما. نعم ربما يوجد الزيت للبيع عند نصف الليل، ولكن لا أمل أن توجد النعمة بعد الموت أو في يوم في يوم الدين. (٣) أنه ليس لأحد من الناس أكثر مما يحتاج لنفسه من النعمة. فلا يقدر مسيحي أن يعطي غيره شيئاً من نعمته لتُحسَب للمعطى له، إنما كل ما يستطيعه هو أن يدل المحتاجين إلى المصدر الذي أخذ هو منه إن بقي وقت لذلك.
ٱبْتَعْنَ لَكُنَّ الشراء هنا كناية عن الرغبة في تحصيل المطلوب وترك كل شيء لأجله، كما ورد في إشعياء ٥٥: ١ ومتّى ٣: ٤٦ ورؤيا ٣: ١٨. فالنعمة لا تُشترى لأنها هبة الله.
١٠ «وَفِيمَا هُنَّ ذَاهِبَاتٌ لِيَبْتَعْنَ جَاءَ ٱلْعَرِيسُ، وَٱلْمُسْتَعِدَّاتُ دَخَلْنَ مَعَهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ، وَأُغْلِقَ ٱلْبَابُ».
لوقا ١٣: ٢٥
جَاءَ ٱلْعَرِيسُ لا بدَّ من أن يأتي المسيح وإن أبطأ قدومه.
وَٱلْمُسْتَعِدَّاتُ دَخَلْنَ مَعَهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ الآن في غيبة العريس تنوح الكنيسة وتصوم (متّى ٩: ١٥) ولكنه سيأتي ويأخذ عروسه لتكون معه (يوحنا ١٧: ٢٤) فيفرح بها وتفرح به (إشعياء ٦٢: ٥). فمهما حزنت بطول الانتظار فإنها ستعوَّض عنه بفرح الدخول إلى العرس. ويكون ذلك الفرح بمشاهدة المسيح والاقتراب منه ونوال القداسة والراحة وكل الخيرات السماوية بواسطته (رؤيا ١٩: ٧ - ٩ و٢١: ٢).
فزيت المستعدات هو نعمة الله في القلب، وهي الاستعداد الوحيد الضروري، فهي تشتمل على التوبة والإيمان والمسرة الطاهرة. فلا بد من أن المستعدات لملاقاة العريس السماوي تكون ثيابهن قد غُسلت بدم الحمَل، واكتسين بثوب بره وتجددن بروحه القدوس (مرقس ١٦: ١٦ ويوحنا ٥: ٢٤ وأعمال ٣: ١٩ و١تيموثاوس ٦: ١٧ - ١٩ و٢بطرس ٣: ١١، ١٢ ورؤيا ٢٢: ١١)
أُغْلِقَ ٱلْبَابُ ذُكِر إغلاق الباب في سفر التكوين أيضاً (تكوين ٧: ٩٦) وفي سفر الرؤيا (رؤيا ٣: ١٢). وهدف ذلك الإغلاق هو إبهاج الداخلين وراحتهم وأمنهم، ومنع دخول غيرهم. وإغلاق باب السماء يمنع أن يدخل إليه شيءٌ من الوجع أو العالم الشرير وإبليس المجرب وكل الشكوك والأهوال والخطايا والموت. ومعنى الباب هنا مدخل الرحمة بالمسيح (يوحنا ١٠: ٧، ٩) وهو الذي يدخل به الإنسان من الخطية إلى القداسة ومن الموت إلى الحياة ومن الشقاء إلى السعادة ومن العداوة لله إلى المصالحة معه. ويظل هذا الباب مفتوحاً للعالم بأجمعه إلى مجيء المسيح ثانيةً، ولعله يبقى مفتوحاً لكل إنسان إلى ساعة موته. ويستثنى من ذلك من جدَّف على الروح القدس، فإنه يوصد أمامه وهو في الحياة. وأفضل أوقات الدخول في ذلك الباب الساعة الحاضرة بدليل القول الرسولي «هوذا الآن وقت مقبول. هوذا الآن يوم خلاص» (٢كورنثوس ٦: ٢) ويسمى أيضاً باب الرحمة وباب الرجاء وباب الخلاص. وللمسيح سلطان عليه بدليل قوله «الَّذِي يَفْتَحُ وَلاَ أَحَدٌ يُغْلِقُ، وَيُغْلِقُ وَلاَ أَحَدٌ يَفْتَحُ» (رؤيا ٣: ٧) ويغلق دون كل إنسان عند موته ودون العالم يوم الدين (جامعة ٩: ١٠ و١١: ٣ ومتّى ٢٥: ٤٦ ورؤيا ٢٢: ١١).
١١ «أَخِيراً جَاءَتْ بَقِيَّةُ ٱلْعَذَارَى أَيْضاً قَائِلاَتٍ: يَا سَيِّدُ، يَا سَيِّدُ، ٱفْتَحْ لَنَا».
متّى ٧: ٢١ - ٢٣
عمل الجاهلات يشير إلى عمل من يطلب الرحمة بعد فوات وقتها وابتداء يوم الدين. وما قيل في إتيانهن إلى بيت العريس وطلبهن الدخول عبثاً يشير إلى ما يحدث لو أمكن المسيحيين المرائين أن يصلوا إلى باب السماء ويلحوا بسؤال الدخول.
١٢ «فَأَجَابَ: ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ: إِنِّي مَا أَعْرِفُكُنَّ».
مزمور ٥: ٥ وحبقوق ١: ١٣ ويوحنا ٩: ٣١
قد يكون في هذه العبارة إشارة إلى أن لا شيء ينفع الإنسان ليُدخله السماء بعد الموت، فهو سينال القرار حالاً إن كان سيبقى مع الله أم يبقى بدونه إلى الأبد. فلننتبه إذن قبل فوات الأوان.
مَا أَعْرِفُكُنَّ أي لا أعرفكن لأني لم أشاهدكن مع العروس لما دخلت. والمعنى الروحي أن المسيح لا يعرف المرائين تلاميذ له. فمعنى المعرفة هنا الإقرار والقبول كمعناها في قوله: «أَعْرِفُ خَاصَّتِي وَخَاصَّتِي تَعْرِفُنِي» (يوحنا ١٠: ١٤). فيجب أن تبدأ معرفة المسيح لنا في هذه الحياة ليعرفنا عند الموت وبعده إلى الأبد. وقول المسيح لأحدٍ من الناس «ما أعرفك» كافٍ لأن يكون أشد عقاب أبدي له (متّى ٧: ٢٣ و٢تيموثاوس ٢: ١٩). والنتيجة هي ما ورد في قوله «هُوَذَا عَبِيدِي يَشْرَبُونَ وَأَنْتُمْ تَعْطَشُونَ. هُوَذَا عَبِيدِي يَفْرَحُونَ وَأَنْتُمْ تَخْزَوْنَ. هُوَذَا عَبِيدِي يَتَرَنَّمُونَ مِنْ طِيبَةِ الْقَلْبِ وَأَنْتُمْ تَصْرُخُونَ مِنْ كآبَةِ الْقَلْبِ، وَمِنِ انْكِسَارِ الرُّوحِ تُوَلْوِلُونَ» (إشعياء ٦٥: ١٣، ١٤). فإذا غفل أحد عن الاستعداد ليوم الدين في هذه الحياة فإنه يضطرب في ساعة موته أو في يوم مجيء الرب. وإن اجتهد في جبر النقص بنفسه، أو بطلب مساعدة غيره من الناس كان اجتهاده عبثاً لأن استعداد النفس للدينونة عمل حياة الإنسان كلها، فلا يمكن أن يتم في المدة القصيرة بين النزع وهو مضطرب جداً ومفارقة النفس للجسد، ولا يمكن أن يتم في أهوال يوم الدين وانقلاب العالم.
١٣ «فَٱسْهَرُوا إِذاً لأَنَّكُمْ لاَ تَعْرِفُونَ ٱلْيَوْمَ وَلاَ ٱلسَّاعَةَ ٱلَّتِي يَأْتِي فِيهَا ٱبْنُ ٱلإِنْسَانِ».
متّى ٢٤: ٤٢، ٤٤ ومرقس ١٣: ٣٣، ٣٥ ولوقا ٢١: ٣٦ و١كورنثوس ١٦: ١٣ و١تسالونيكي ٥: ٦ و١بطرس ٥: ٨ ورؤيا ١٦: ١٥
هذا تكرار معنى متّى ٢٤: ٤٢. وخلاصة كل الأمثال التي ذكرها في هذا الخطاب من تأكيد مجيئه وعدم تعيين وقته وجوب السهر والاستعداد بالنعمة الإلهية لذلك، وانتهاز كل فرصة للقيام بالواجبات. والطريق الوحيدة للاستعداد ليوم مجيء المسيح هي أن نستعد كل يوم.
١٤ «وَكَأَنَّمَا إِنْسَانٌ مُسَافِرٌ دَعَا عَبِيدَهُ وَسَلَّمَهُمْ أَمْوَالَهُ».
متّى ١٨: ٢٤ و٢١: ٣٣ ولوقا ١٩: ١٢ الخ
مثل الوزنات كمَثل العذارى العشر، يعلِّمنا وجوب الاستعداد الدائم لمجيء المسيح والحساب. والعبيد هنا كالعذارى هناك، فالمقصود بالفريقين المسيحيون المعترفون بالمسيح علناً. والفرق بين المثلين في أمرين: (١) في مثل العذارى يحاسب الحكيمات عموماً والجاهلات كذلك، وفي مثل الوزنات يحاسب كل شخص بمفرده. (٢) في مثل العذارى لم يعين العمل لهن وهن ينتظرن العريس. وفي مثل الوزنات عيَّن العمل للعبيد وأمرهم بالاجتهاد فيه. فخلاصة تعليم الأول وجوب الاستعداد، وخلاصة تعليم الثاني وجوب الاجتهاد.
وضرب المسيح مثل الوزنات ليعلِّمنا وجوب العمل بكل قوة، وانتهاز كل فرصة في خدمته، ومكافأة الذين يفعلون ذلك، وعقاب المتهاونين. قال الحكيم «كُلُّ مَا تَجِدُهُ يَدُكَ لِتَفْعَلَهُ فَافْعَلْهُ بِقُوَّتِكَ، لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَل وَلاَ اخْتِرَاعٍ وَلاَ مَعْرِفَةٍ وَلاَ حِكْمَةٍ فِي الْهَاوِيَةِ الَّتِي أَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَيْهَا.» (جامعة ٩: ١٠) وقال الرسول «كُونُوا رَاسِخِينَ، غَيْرَ مُتَزَعْزِعِينَ، مُكْثِرِينَ فِي عَمَلِ الرَّبِّ كُلَّ حِينٍ، عَالِمِينَ أَنَّ تَعَبَكُمْ لَيْسَ بَاطِلاً فِي الرَّبِّ» (١كورنثوس ١٥: ٥٨).
كَأَنَّمَا إِنْسَانٌ أي أن المسيح يعامل الناس في ملكوته معاملة هذا الشخص لعبيده.
مُسَافِرٌ هذا إشارة إلى ذهاب المسيح إلى السماء وقت صعوده وبقائه هناك لا ينظره تلاميذه على الأرض إلى يوم مجيئه الثاني، بلا دليل ظاهر على حضوره لمكافأة الأمناء ومعاقبة الخائنين. وقوله «مسافر» هنا كقوله «سافر» في متّى ٢١: ٣٣.
عَبِيدَهُ أي أرقاءه لا أُجراءه. فهم كأليعازر الدمشقي في بيت إبراهيم، ويوسف في بيت فوطيفار. فبعض السادة رفع مقام بعض العبيد فوكل إليهم الأعمال ذات الشأن، وأذن لهم أن يعملوا ما أرادوا من الأعمال التجارية والصناعية، وأعطاهم رأس مال لذلك على شرط أن يعطوه قدراً معيناً من الربح. والظاهر أن العبيد المذكورين هنا ممن رُفع مقامهم، وبقوا على تلك الحال مدة سفر سيدهم. والمقصود بهؤلاء العبيد كل رسله والمبشرين والمعترفين باسمه، أي كنيسته على الأرض.
سَلَّمَهُمْ أَمْوَالَهُ ليستعملوها في خدمته. ودعا هذه الأموال «وزنات» أي البركات الروحية التي أعطاها لكنيسته بجملتها ولأعضائها بمفردهم. وهذه البركات وإن كانت روحية تشتمل على مواهب جسدية يمكن أن تستعمل لغايات روحية، ومنها المناصب، والقدرات العقلية، والفرص لعمل الخير، والغنى والعلم والفصاحة وتأثير السيرة، وكنوز النعمة كالكتب الإلهية وغيرها من الكتب المفيدة، وأيام الراحة والتبشير وخدمة بيت الله (أفسس ٤: ٨ - ١٢). وهذه الوزنات سلمها الله لكل المسيحيين فصاروا جميعهم وكلاءه.
١٥ «فَأَعْطَى وَاحِداً خَمْسَ وَزَنَاتٍ، وَآخَرَ وَزْنَتَيْنِ، وَآخَرَ وَزْنَةً كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ. وَسَافَرَ لِلْوَقْتِ».
رومية ١٢: ٦ و١كورنثوس ١٢: ٧، ١١، ٢٩ وأفسس ٤: ١١
خَمْسَ وَزَنَاتٍ (انظر شرح متّى ١٨: ٢٤) إن كانت الوزنة من الفضة فقيمة تلك الوزنات ١٢٥٠٠ جنيه ذهبي وإن كانت ذهباً فقيمتها ٣٠ ألف جنيهاً ذهبياً.
وَزْنَتَيْنِ أي نحو ١٢٠٠ جنيه ذهبي.
وَزْنَةً ٦٠٠ جنيهاً ذهبياً. والمقصود بتلك الوزنات القوى العقلية والجسدية والمواهب الروحية والفرص لعمل الخير التي يهبها الله بسخاء لشعبه. ووفرة النقود التي أعطاها للعبيد إشارة إلى عظمة قيمة أقل المواهب الروحية. ومما يستحق ذكره في هذا المثل أن السيد أعطى ذلك المال كله دفعة واحدة، ولم يكرر العطاء. لكن الرب يعطي عبيده مواهبه ووسائل فعل الخير بلا انقطاع.
عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ عرف السيد صفات كلٍ من أولئك العبيد فأعطاه من النقود ما يستطيع أن يتصرف به بما له من الحكمة والتدبير.
وأعطاهم تلك الوزنات ديناً لا هبة. كذلك أعطى الله البعض مواهب مختلفة لم يعطها غيرهم، فامتازوا على غيرهم بوسائل عمل الخير (رومية ١٢: ٦ و١كورنثوس ٤: ٧ و١٢: ٤ - ٣١ وأفسس ٤: ٧ - ١٢). وكل عطاياه ديْنٌ لا هبة، فكل من زاد قدرةً زاد مسئوليةً، فإن «مَنْ أُعْطِيَ كَثِيرًا يُطْلَبُ مِنْهُ كَثِيرٌ» (لوقا ١٢: ٤٨) والله لا يضع على أحد مسؤولية فوق طاقته، ولا ينتظر من أحد أكثر مما أعطاه، ولا يترك أحداً من شعبه بلا وزنة ولا مسؤولية. وأقل ما وكله إلى كل إنسان أن يرى نفسه مستعدة للسماء.
وَسَافَرَ لِلْوَقْتِ أشار بهذا إلى أن المسيح يراقب الكنيسة وهو غير منظور، وأنه لا يحاسب عبيده في الحال، وأن وقت غيبته هي كل المدة بين صعوده ومجيئه الثاني.
١٦، ١٧ «١٦ فَمَضَى ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْخَمْسَ وَزَنَاتٍ وَتَاجَرَ بِهَا، فَرَبِحَ خَمْسَ وَزَنَاتٍ أُخَرَ. ١٧ وَهٰكَذَا ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَتَيْنِ، رَبِحَ أَيْضاً وَزْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ».
فَمَضَى أي أخذ يتاجر فور سفر سيده.
وَتَاجَرَ الخ أي بذل الاجتهاد بالحكمة.
فَرَبِحَ خَمْسَ وَزَنَاتٍ كانت نتيجة اجتهاده تضاعُف ماله.
وكذا كان أمر صاحب الوزنتين. والمقصود بذلك أن المسيحي كلما استعمل مواهبه الروحية في عمل الخير زادت قوة ونفعاً، وكلما اغتنم الفرص لذلك العمل كثرت له. إن المسيحي الحقيقي يستعمل كل قواه لمجد المسيح وبنيان كنيسته، وذلك مما فرض عليه (رومية ١٤: ٢ و١كورنثوس ١٤: ١٢) ويجتهد في أن يتقدم وينمو في معرفة الله والنعمة والتقوى، ويقول مع داود «مَاذَا أَرُدُّ لِلرَّبِّ مِنْ أَجْلِ كُلِّ حَسَنَاتِهِ لِي؟» (مزمور ١١٦: ١٢) ومع بولس الرسول «يَا رَبُّ، مَاذَا تُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ؟» (أعمال ٩: ٦) فيحسب حريته وشرفه وفرحه أن يخدم المسيح وكنيسته على الدوام.
١٨ «وَأَمَّا ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَةَ فَمَضَى وَحَفَرَ فِي ٱلأَرْضِ وَأَخْفَى فِضَّةَ سَيِّدِهِ».
أَخْفَى اعتاد الناس قديماً أن يدفنوا أموالهم في الأرض لحفظها (متّى ١٣: ٤٤ - ٤٦). ويحتمل أن العبد فعل ذلك غيظاً من سيده، لأنه أعطى رفيقيه أكثر مما أعطاه، أو لفتوره وكسله في خدمة سيده، أو لأنه لم يتوقع رجوع سيده للمحاسبة. ورجا أنه إن رجع يكتفي بأن يأخذ ما سلمه إياه من المال. وعلى كل حال لم يعمل شيئاً مفيداً بوزنته. ويشير هذا العبد إلى الإنسان الذي يهمل استعمال قواه، وعدم انتهاز فرصه التي يمنحها الله له. وكثيرون مثل هذا العبد ويعتذرون اعتذاره. ومن وجوه ذلك الاعتذار:
(١) إنهم ليسوا في مقام عالٍ ليؤثروا في غيرهم. (٢) إنهم ضعفاء قليلو الفرص، فيعتذرون لأنهم عاجزون عن القيام بالأعمال العظيمة ويتركون كل عمل. (٣) إن الذين يقدرون على العمل المطلوب كثيرون، فلا حاجة لخدمتهم.
ثم إن الذي دفن مال سيده في المثل هو صاحب الوزنة الواحدة. ولكن كثيراً ما نرى أن أصحاب المواهب الكثيرة العظمى في الكنيسة يدفنونها، بأن يستعملوها لأنفسهم لا لله. ولعل ذكر أمر صاحب الوزنة الواحدة دلالة على التدقيق في الحساب. فإذا كان السيد يسأل عن وزنة واحدة دُفنت، فكم بالحري يسأل عن أعظم منها من المواهب المدفونة.
فِضَّةَ سَيِّدِه فهي ليست فضته ليتصرف بها كما يشاء. ومما زاد خطأه أنه كسل ورفيقاه اجتهدا، فكان يجب أن يحرك نشاطهما غيرته. الذي كسل في المثل واحد، لكن الذين يكسلون في الكنيسة كثيرون! منهم من يهمل تلاوة الكتاب المقدس والصلاة الانفرادية، أو يدنس يوم الرب، أو يحب العالم أو المال، فيصدق عليهم قول دانيال لبيلشاصر «أَمَّا اللهُ الَّذِي بِيَدِهِ نَسَمَتُكَ، وَلَهُ كُلُّ طُرُقِكَ فَلَمْ تُمَجِّدْهُ» (دانيال ٥: ٢٣).
١٩ «وَبَعْدَ زَمَانٍ طَوِيلٍ أَتَى سَيِّدُ أُولَئِكَ ٱلْعَبِيدِ وَحَاسَبَهُمْ».
بَعْدَ زَمَانٍ طَوِيلٍ كان يمكن الرسل أن يستنتجوا من ذلك أن مجيئه الثاني بعيد. وبُعد ذلك المجيء كافٍ ليمتحن أمانة الكنيسة كلها. وطول حياة كل إنسان كافٍ ليمتحن أمانته واجتهاده. ويوم الدين نهاية غياب ذلك السيد عن الكنيسة كلها.. ويوم وفاة كل إنسان نهاية غياب المسيح عنه.
أَتَى... وَحَاسَبَهُمْ مهما طالت مدة غياب السيد فلا بد أن يأتي. ويوم مجيئه يوم حساب (رومية ١٤: ١٠ و٢كورنثوس ٥: ١١). وهو يوم فرح للأمناء ويوم خوف وخزي للخائنين. ويظهر من هذا المثل أن الحساب لا ريب في وقوعه، وعمومه وتدقيقه، وأن الله لم يعط الإنسان شيئاً الآن لمجرد تمتعه به من الصحة أو القوة الجسدية أو المال، فكل شيء ديْنٌ يُحاسب عليه بكل تدقيق (١كورنثوس ١٤: ١٢) وعليه أن يستعد لذلك الحساب كل ساعة لجهله وقت مجيء سيده.
٢٠ «فَجَاءَ ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْخَمْسَ وَزَنَاتٍ وَقَدَّمَ خَمْسَ وَزَنَاتٍ أُخَرَ قَائِلاً: يَا سَيِّدُ، خَمْسَ وَزَنَاتٍ سَلَّمْتَنِي. هُوَذَا خَمْسُ وَزَنَاتٍ أُخَرُ رَبِحْتُهَا فَوْقَهَا».
كل إنسان يعطي لله حساباً عن نفسه لا عن غيره.
سَلَّمْتَنِي اعترف بأن كل ما كان له كان من مال سيده. فعلى المسيحيين أن يذكروا على الدوام ما أخذوه من الله ليستعدوا لإعطائه الحساب عنه.
رَبِحْتُهَا فَوْقَهَا أي ربحها لسيده لا لنفسه. وهذا مثل ما جاء في لوقا ١٩: ١٨. فيجب على المسيحي أن يحسب كل نتائج أتعابه لله لأنه هو يعطينا النعمة للحصول عليها (يوحنا ١٥: ٥ و١كورنثوس ١٥: ١٠) والنتائج الصالحة تتبع كل عملٍ عُمل باجتهاد وأمانة (يعقوب ٣: ١٣ ورؤيا ١٤: ١٣) وهي موضوع حقيقي للفرح (في ٢: ١٦). وهبات الله الروحية لنا لا تعفينا من الاجتهاد بدليل قول الرسول «تَمِّمُوا خَلاَصَكُمْ بِخَوْفٍ وَرِعْدَةٍ، لأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَامِلُ فِيكُمْ أَنْ تُرِيدُوا وَأَنْ تَعْمَلُوا مِنْ أَجْلِ الْمَسَرَّةِ» (فيلبي ٢: ١٢، ١٣).
٢١ «فَقَالَ لَهُ سَيِّدُهُ: نِعِمَّا أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلصَّالِحُ وَٱلأَمِينُ. كُنْتَ أَمِيناً فِي ٱلْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى ٱلْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ».
متّى ٢٤: ٤٧ ، ٢٣، ٣٤، ٤٦ ولوقا ١٢: ٤٤ و٢٢: ٢٩، ٣٠ وإشعياء ٥٣: ١١ وعبرانيين ٤: ٣ - ١١ و١٢: ٢ و٢تيموثاوس ٢: ١٢ و١بطرس ١: ٨ ورؤيا ٣: ٢١
نِعِمَّا وهي اختصار «نِعْم ما فعلت». وهذا المدح من فم الله أفضل من أعظم مديح من الناس وأشرف منه. وهذا مثل قوله في مدح مريم «عَمِلَتْ مَا عِنْدَهَا» أي على قدر استطاعتها (مرقس ١٤: ٨).
ٱلصَّالِحُ وَٱلأَمِينُ لم يقل الصالح والمجتهد، ولا الصالح والناجح، بل الصالح والأمين. فالأمانة كانت أكثر اعتباراً من سائر الصفات عند ذلك السيد، وكذلك هي عند الله.
أُقِيمُكَ عَلَى ٱلْكَثِيرِ لم يكن ثوابه الراحة بل اتساع دائرة عمله، وكذلك يثيب الله عبيده الأمناء (رومية ٢: ٦، ٧) فسعادة السماء لا تقوم بمجرد الراحة بل بسمو الخدمة.
فَرَحِ سَيِّدِكَ أي إلى وليمة فرح تجلس مع سيدك فيها. والعبد الذي يجلس مع سيده يكون قد تحرر. كذلك يثيب المسيح عبيده الأمناء حسب قوله «لاَ أَعُودُ أُسَمِّيكُمْ عَبِيدًا... لكِنِّي قَدْ سَمَّيْتُكُمْ أَحِبَّاءَ» (يوحنا ١٥: ١٥) وقوله «طُوبَى لأُولَئِكَ الْعَبِيدِ... اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ يَتَمَنْطَقُ وَيُتْكِئُهُمْ وَيَتَقَدَّمُ وَيَخْدُمُهُمْ» (لوقا ١٢: ٣٧) (انظر أيضاً ١كورنثوس ١٥: ٥٨ و٢تيموثاوس ٤: ٨ ورؤيا ٢: ١٠ و٣: ٢٠، ٢١). فالذين يدخلون في فرح السيد السماوي يكونون شركاء له في الفرح الذي ناله لأمانته في عمل الفداء، ويكونون رفقاءه في المجد. وذلك الفرح غير محدود في العظمة والبقاء. ولا شك أن هذا الثواب أعظم مما يستحقه أحدٌ من الناس أو يرجوه أو يتصوره.
٢٢، ٢٣ «٢٢ ثُمَّ جَاءَ ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَتَيْنِ وَقَالَ: يَا سَيِّدُ، وَزْنَتَيْنِ سَلَّمْتَنِي. هُوَذَا وَزْنَتَانِ أُخْرَيَانِ رَبِحْتُهُمَا فَوْقَهُمَا. ٢٣ قَالَ لَهُ سَيِّدُهُ: نِعِمَّا أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلصَّالِحُ ٱلأَمِينُ. كُنْتَ أَمِيناً فِي ٱلْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى ٱلْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِك».
ع ٢١
قول السيد لهذا العبد كقوله الذي قبله. والثواب على أمانته لا على قدر ربحه. فالإثابة واحدة بغضّ النظر عن مقدار الربح.
٢٤، ٢٥ «٢٤ ثُمَّ جَاءَ أَيْضاً ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَةَ ٱلْوَاحِدَةَ وَقَالَ: يَا سَيِّدُ، عَرَفْتُ أَنَّكَ إِنْسَانٌ قَاسٍ، تَحْصُدُ حَيْثُ لَمْ تَزْرَعْ وَتَجْمَعُ مِنْ حَيْثُ لَمْ تَبْذُرْ. ٢٥ فَخِفْتُ وَمَضَيْتُ وَأَخْفَيْتُ وَزْنَتَكَ فِي ٱلأَرْضِ. هُوَذَا ٱلَّذِي لَكَ».
دُعي صاحب الوزنة الواحدة إلى الحساب كصاحب الوزنات الخمس. وظهر في جوابه ضعف حجة من يتخذ قلة مواهبه وفرصه عذراً لعدم العمل. وإن الله يطلب أن يخدمه الإنسان، سواء كان قليل المواهب والفرص أم كثيرها. وهذا وفق قول الرسول «ثُمَّ يُسْأَلُ فِي الْوُكَلاَءِ لِكَيْ يُوجَدَ الإِنْسَانُ أَمِينًا» (١كورنثوس ٤: ٢). وقوله «إِنْ كَانَ النَّشَاطُ مَوْجُودًا فَهُوَ مَقْبُولٌ عَلَى حَسَبِ مَا لِلإِنْسَانِ، لاَ عَلَى حَسَبِ مَا لَيْسَ لَهُ» (٢كورنثوس ٨: ١٢).
عَرَفْتُ يظن كثيرون أنهم يعرفون الله، والحق أنه لا يعرفه أحد ما لم يشعر بأنه محبة، أي أبٌ رحيم جواد. ويخطئ بعضهم بأن يحسبه قاسياً كما أخطأ اليهود في أيام حزقيال فقالوا: «الآبَاءُ أَكَلُوا الْحِصْرِمَ وَأَسْنَانُ الأَبْنَاءِ ضَرِسَتْ» وقالوا «لَيْسَتْ طَرِيقُ الرَّبِّ مُسْتَوِيَةً» (حزقيال ١٨: ٢، ٢٥). وكذلك يخطئ من يحسبه رب رحمة بلا عدل، كمن قال عليه الله بلسان نبيه «ظَنَنْتَ أَنِّي مِثْلُكَ» (مزمور ٥٠: ٢١).
قَاسٍ أي طامعٌ بخيلٌ تطلب أكثر مما لك، وظالمٌ لا شفقة في قلبك على العاجزين. وبمثل ذلك يتهم الناس الله بدعوى أنه يكلفهم ما لا يستطيعونه، كتكليف فرعون بني إسرائيل أن يصنعوا الطوب المفروض عليهم بدون أن يعطيهم التبن (خروج ٥: ٧، ٨) فطلبوا عذراً لأنفسهم عن كسلهم فادعوا أن الله قاسٍ ظالم. فخطأهم في تصورهم صفات الله يمنعهم عن خدمته بفرح واجتهاد ومحبة.
تَحْصُدُ حَيْثُ لَمْ تَزْرَعْ وَتَجْمَعُ الخ هاتان الجملتان بمعنىً واحد، أتى بهما تأكيداً لمعنى قوله السابق إن السيد يكلفه بالعمل ويأكل الربح. وهو كذب ستر به كسله. وكثيرون يقولون ما قاله ذلك العبد فيلومون الله على آثامهم. فإن صدقناهم حكمنا بأن الله هو علة خطاياهم، فيشبهون بذلك أباهم آدم في قوله لله «الْمَرْأَةُ الَّتِي جَعَلْتَهَا مَعِي هِيَ أَعْطَتْنِي مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَكَلْتُ» (تكوين ٣: ١٢). والله خلاف ما قال ذلك العبد الكسلان، فإنه لا يحصد حيث لم يزرع، بل هو يزرع بركات كثيرة ويحصد قليلاً من الشكر والخدمة. نعم إنه ينتظر الحصاد حيث يزرع (إشعياء ٥: ٢) لا حيث لا يزرع.
فَخِفْتُ ادَّعى أنه خاف أن تضيع الوزنة بالاتجار بها فيعرض نفسه للوم سيده القاسي وعقابه، فخبأ الوزنة حفظاً لها. وتدل وقاحته في الجواب على كذب دعواه، فإنه لم يبال بغيظ سيدِه، وكان يعلم أنه ليس قاسياً. فلو خاف حقاً لنهض من كسله واجتهد في التجارة لكي لا يلام.
هُوَذَا ٱلَّذِي لَكَ أي هذه الوزنة التي أعطيتني إياها. فكأنه قال: هذا كل ما لك حق أن تسألني إياه. ولم يلتفت إلى تعطيل المال كل تلك المدة الطويلة، وخيبة رجاء سيده، وعدم قيامه هو بالخدمة التي على عبدٍ مثله. ويدلنا كلامه على أنه ظن عذره مقبولاً، وأن لا لوم عليه فصحَّ عليه قول الحكيم «اَلْكَسْلاَنُ أَوْفَرُ حِكْمَةً فِي عَيْنَيْ نَفْسِهِ مِنَ السَّبْعَةِ الْمُجِيبِينَ بِعَقْل» (أمثال ٢٦: ١٦). نعم أمكن ذلك العبد أن يرد الوزنة إلى سيده كما هي، لكن يستحيل أن يرد الإنسان إلى الله المواهب الروحية التي لم يستعملها بالحكمة، لأنه يكون بذلك قد أتلفها. فالمسيحي الكسلان شرٌ من العبد الكسلان، لأنه رد مال سيده وأما المسيحي الكسلان فبذَّره.
٢٦ «َأَجَابَ سَيِّدُهُ: أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلشِّرِّيرُ وَٱلْكَسْلاَنُ، عَرَفْتَ أَنِّي أَحْصُدُ حَيْثُ لَمْ أَزْرَعْ، وَأَجْمَعُ مِنْ حَيْثُ لَمْ أَبْذُرْ».
عرف السيد أن عذر العبد باطل، وأنه كسلان لا يحب سيده ولا يجتهد في خدمته.
يخطئ من يظن أن السيد يتساهل مع الفقراء ويقبلهم في السماء لأنهم فقراء، وهذا غير صحيح البتة. إذ أن الفقير الكسلان هو كالغني البخيل. كلاهما مخطئ. وعلينا أن نربح أنفسنا لملكوت الله بالجهد والتعب وجلب الثمار التي تليق بالحياة الأبدية.
ٱلشِّرِّيرُ كان شره كسله، وسوء ظنه في سيده. لقد أعطانا الله عقولنا وأجسادنا لنستعملها لمجده وخير الناس، فعدم استعمالنا إياها تبذيرٌ وإتلافٌ. فالوزنات التي ننفقها على أنفسنا تُحسب أنها مدفونة، وإهمال القيام بالواجبات شرعاً كالتعدي على الشريعة.
وَٱلْكَسْلاَنُ أبان كسله بأن أخفى مال سيده فلم يربح له شيئاً.
عَرَفْتَ وقع ذا الكلام من السيد موقع الشرط في جوابه، أي إن كنت قد عرفت ما قلتَ، كان يجب عليك أن تفعل حسبما عرفت وتضع مالي عند الصيارفة. وهذا يظهر من قول السيد «مِنْ فَمِكَ أَدِينُكَ أَيُّهَا الْعَبْدُ الشِّرِّيرُ عَرَفْتَ أَنِّي.. الخ» (لوقا ١٩: ٢٢). وهو مثل قول أليفاز «إِنَّ فَمَكَ يَسْتَذْنِبُكَ، لاَ أَنَا، وَشَفَتَاكَ تَشْهَدَانِ عَلَيْكَ» (أيوب ١٥: ٦). على أن السيد لم يسلِّم بصدق قول العبد إنه قاسٍ وظالم، كما أنه لم ينفِ عن نفسه التهمة لكي يثبت جهل العبد وكذبه بعدم تصرفه بحسب معرفته واعتقاده. فلو خاف حقاً لاجتهد في دفع غيظ سيده بما يحصله من ربح ذلك المال. ومثل عذر هذا الكسلان عذر كل خاطئ، فإن بطلان العذر يظهر يوم الدين، وتزيد به دينونته. إن أرملة صرفة لم تعتذر بفقرها حتى لا تقدم شيئاً لإيليا النبي (١ملوك ١٧: ١٢ - ١٥). ويوحنا وبطرس لم يمتنعا عن الوعظ لأنهما عديما العلم وعاميان (أعمال ٤: ١٣) ولا يجوز لأحد أن يهمل عمل الخير لقلة وسائله أو مواهبه.
٢٧ «فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَضَعَ فِضَّتِي عِنْدَ ٱلصَّيَارِفَةِ، فَعِنْدَ مَجِيئِي كُنْتُ آخُذُ ٱلَّذِي لِي مَعَ رِباً».
متّى ٢١: ١٢ ولوقا ١٩: ٢٣
ٱلصَّيَارِفَة هم الذين يأخذون المال برباً قليل ويعطونه سُلفةً للغير بربح أكثر منه. وشاع ذلك كثيراً في أيام الرومان. كان قصد السيد عندما أعطاه الوزنة أن يزيدها بالاتجار بها، ولكنه رأى أن أقل واجبات ذلك العبد أنه إن كسل عن الاتجار يضع فضته عند الصيارفة. وذلك عمل لا يقتضي نشاطاً أو تعباً، فيربح شيئاً. والربح القليل خير من لا شيء. فمنع الربح عن سيده خطأ يساوي منع رأس المال عنه. وما قيل هنا ليس دليلاً على جواز الربا أو منعه، لأنه إشارة إلى ما اعتاده أصحاب المال يومئذٍ. وقد حرَّمت الشريعة على اليهودي أن يأخذ الربا من ابن ملته، لكن سُمح له أن يأخذه من غيره (خروج ٢٢: ٢٥ وتثنية ٢٣: ١٩، ٢٠). ولم نجد من معنى روحي لذلك سوى أنه ينبغي أن نستعمل الروحيات لمنفعة قريبنا ومنفعة أنفسنا. وتلك الحكمة والتدبير اللذين يستعملهما الناس في الدنيويات. وبهذا أبطل السيد عذر العبد، وبيَّن فساد حجته. كذلك يبطل ما يأتيه الخطاة من الأعذار والحجج يوم الدين لإهمالهم الواجبات الدينية، لأنهم لم يبذلوا الجهد، ولا استعملوا ما وهبه الله لهم من الوسائل، ولم يطلبوا زيادة ذلك.
هل أخذ الربا مخالف لشريعة موسى؟ أليس أن الربا المعقول للأشخاص المحتاجين هو حافز لهم للعمل، وليس لابتزاز أتعابهم. وعلى هذا الأساس تقوم التجارة والعمران.
٢٨ «فَخُذُوا مِنْهُ ٱلْوَزْنَةَ وَأَعْطُوهَا لِلَّذِي لَهُ ٱلْعَشْرُ وَزَنَاتٍ».
خسر الكسلان كل الوسائل التي له وعُوقب شر عقاب. وظهرت زيادة خسارته بالمقارنة بزيادة ربح الأمين. ولم يرد المسيح بإعطاء ما للواحد للآخر نقل المواهب من الأول إلى الثاني، بل ما نراه كثيراً في العالم أن الله بعد ما يعطي بعض الناس فُرصاً لعمل الخير لا يستعملونها، يأخذها منهم ويهبها لغيرهم، فيكون للأول الخجل والندامة لأنه خسر ما كان يمكنه أن يحصل عليه من الثواب. وهذا مثل قول صموئيل لشاول الملك «يُمَزِّقُ الرَّبُّ مَمْلَكَةَ إِسْرَائِيلَ عَنْكَ الْيَوْمَ وَيُعْطِيهَا لِصَاحِبِكَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ» (١صموئيل ١٥ ٢٨). ويصح أن يقال بهذا المعنى أن الخيرات التي كانت للغني في الدنيا كانت للعازر المسكين في الآخرة. والغاية من هذا المثل كله إيقاظ ضمائر الغافلين من المعترفين بالمسيح وتأكيد إجراء الحساب الدقيق يوم الدين على كل ما أهملوه من واجباتهم، وعلى كل تعدياتهم، بدليل أن العبد الذي لم يقتُل ولم يلعن ولم يكذب ولم يسرق ولم يبذر مال سيده، حُكم عليه وعُوقب لمجرد كسله وإهماله.
٢٩ «لأَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ يُعْطَى فَيَزْدَادُ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَٱلَّذِي عِنْدَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ».
متّى ١٣: ١٢ ومرقس ٨: ١٨ و١٩: ٢٦ ويوحنا ١٥: ٢
هذا كلام جارٍ مجرى المثل مرَّ تفسيره في متّى ١٣: ١٢. ومثله قول الحكيم «يَدُ الْمُجْتَهِدِينَ تَسُودُ، أَمَّا الرَّخْوَةُ فَتَكُونُ تَحْتَ الْجِزْيَةِ» (أمثال ١٢: ٢٤). والمعنى أن الأمين يُجازى بأن يوكل إليه أعظم مما اؤتمن عليه أولاً. وأما الخائن فتؤخذ منه الوسائط التي أُعطيت له ويُعاقب عليها.
وَمَنْ لَيْسَ لَهُ أي من لا شيء له يدل على اجتهاده وأمانته في تصرفه بوكالته. فمن كان له وزنة ودفنها لم ينتفع بها ولم ينفع غيره بها، هو كمن ليس له شيءٌ. ولا يُقال إن لأحدٍ شيئاً إلا إن استعمله.
فَٱلَّذِي عِنْدَهُ أي ما أُعطيه من المواهب والوسائل أو الوكالة. وكثيراً ما نرى أمثلةً لما يقوله هذا العدد. فالمال ينتقل من أيدي أهل الكسل إلى أيدي أهل الاجتهاد. وعضو الجسد الذي لا يُستعمل يضمر ويضعف، ولكن الذي يُستعمل يعظم ويقوى. وكذلك القوى العقلية فإنها تقوى بالاستعمال وتضعف بدونه.
٣٠ «وَٱلْعَبْدُ ٱلْبَطَّالُ ٱطْرَحُوهُ إِلَى ٱلظُّلْمَةِ ٱلْخَارِجِيَّةِ، هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَاءُ وَصَرِيرُ ٱلأَسْنَان».
متّى ٨: ١٢ و٢٤: ٥١
انظر شرح متّى ٨: ١٢ وهنا قارن بين حال العبد البطال، فإنه قال للأول «ادخل» وقال عن الثاني «اطرحوه». فكان الأول في نور وفرح في بيت سيده، وكان الثاني في الظلمة الخارجية والحزن واليأس. فكان هذا العبد كالتينة التي بلا ثمر (لوقا ١٣: ٦ - ٩) وعقابه كعقاب الضيف الذي لم يكن عليه لباس العرس (متّى ٢٢: ١٣) وكعقاب المرائين (متّى ٢٤: ٥١) فخطيته كخطيتهم. وخلاصة معنى هذا المثل الروحي تظهر ثمان قضايا: (١) إن المسيحيين كلهم عبيد سيدٍ غاب عنهم. (٢) إن الله يهب لعبيده مواهب مختلفة وفرصاً متنوعة للخدمة. (٣) إنه ينتظر من كل مسيحي أن يستعمل مواهبه وما له من الوسائل على قدر طاقته، لمجده، لأن المسيحي نالها ليستعملها لا ليتزين بها. (٤) إن من تصرف بالمواهب بالحكمة والاجتهاد كما قصد الله زادها له كثيراً ونال الثواب والرضى. (٥) يأتي يوم فيه يُحاسب المسيحي على كل مواهبه ووسائطه وإن ذلك الحساب يكون خاصاً مدققاً بلا محاباة. (٦) يظن الخطاة أن الله قاسٍ ظالم بما يكلفهم به، ويمنعهم سوء ظنهم من إتيانهم إليه وخدمتهم له. (٧) يعتبر الله إهمال الواجبات تعدياً على شريعته، ويعاقب المهمل كما يعاقب المعتدي (عبرانيين ٢: ٣ و٦: ٧، ٨) (٨) يظهر يوم الدين بطلان كل ما يقدمه الخونة من الأعذار على عدم أمانتهم.
٣١ «وَمَتَى جَاءَ ٱبْنُ ٱلإِنْسَانِ فِي مَجْدِهِ وَجَمِيعُ ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلْقِدِّيسِينَ مَعَهُ، فَحِينَئِذٍ يَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيِّ مَجْدِهِ».
زكريا ١٤: ٥ ومتّى ١٦: ٢٧ و١٩: ٢٨ ومرقس ٨: ٣٨ وأعمال ١: ١١ و١تسالونيكي ٤: ١٦ و٢تسالونيكي ١: ٧ ويهوذا ١٤ ورؤيا ١: ٧
من هذا العدد إلى آخر الأصحاح بقية جواب المسيح على سؤال الرسل «مَا هِيَ عَلاَمَةُ مَجِيئِكَ وَانْقِضَاءِ الدَّهْرِ؟» (متّى ٢٤: ٣) وفيه يبيِّن ما سيحدث يوم الدين ويوضح الأعمال الواجبة على تلاميذ المسيح ليُظهروا محبتهم له مدة غيبته. لقد علَّمهم في مثل العذارى العشر وجوب السهر، وفي مثل الوزنات وجوب الاجتهاد، ويعلمهم هنا العمل الذي يرضاه، وهو إظهار الرحمة للمساكين والمصابين من شعبه، لأنه يحسب الإحسان إليهم إحساناً إليه. وكلام المسيح هنا ليس مثلاً، مع أنه شبَّه في ع ٣٢ ،٣٣ عمله بعمل الراعي الذي يفصل الخراف عن الجداء. لكنه يصوِّر أموراً مستقبلة لتظهر كأنها حدثت أمامنا.
جَاءَ المجيء الثاني للدينونة في نهاية العالم (متّى ١٣: ٤٠ و٢٤: ٣٠ وأعمال ١٦: ٣١ ورومية ٢: ١٦ و١كورنثوس ٤: ٥) وهذا ما أشار إليه بمجيء العريس (متّى ٢٥: ٦) ورجوع صاحب الوزنات من السفر (ع ١٩).
ٱبْنُ ٱلإِنْسَانِ سمى ابن الله نفسه بذلك بياناً لاتحاد لاهوته بالناسوت، وورد هذا اللقب نحو خمسين مرة في هذا الإنجيل. والمراد بذكره هنا أن المسيح حين يأتي ليدين العالم لا يأتي بمجرد لاهوته بل بطبيعتيه (يوحنا ٥: ٢٢).
فِي مَجْدِهِ أي في بهائه باعتباره ابن الله (يوحنا ١٧: ٥) وفي شرفه الذي أعطاه الآب إياه جزاء اتضاعه بتجسده وموته فادياً (مرقس ٨: ٣٨ وفيلبي ٢: ٩، ١٠ ومزمور ٩: ٧). وهذا تتميم لنبوة دانيال ٧: ١٣، ١٤.
ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلْقِدِّيسِينَ وصف الملائكة بالقديسين لطهارتهم (مرقس ٨: ٣٨ و٢تسالونيكي ١: ٧ ورؤيا ١٩: ١٤) ولتمييزهم عن الملائكة الساقطين. وقد خدم الملائكة القديسون المسيح في عمل الفداء واهتموا بذلك العمل (متّى ١٣: ٤٠ و٢٤: ٣١ ولوقا ٢: ٩ - ١٤ وعبرانيين ١: ١٤).
يَجْلِسُ ديّاناً وملكاً (يوحنا ٥: ٢٢) وظافراً بعد محاربته.
عَلَى كُرْسِيِّ مَجْدِهِ أي كرسيه المجيد (إشعياء ٦: ١ ودانيال ٧: ٩ ورؤيا ١٢: ١٣ و٢٠: ١١) فما أعظم الفرق بين حاله حينئذٍ، وحاله عندما كان طفلاً في مذود بيت لحم، وحاله عندما كان يجول وليس له محل يسند فيه رأسه، وحاله حين تركه تلاميذه وأحاط به أعداؤه يستهزئون به، وحاله حين وقف كمذنب أمام بيلاطس، وحين جُرح جَلداً ولبس الشوك، وحين صلب بين لصين.
٣٢ «وَيَجْتَمِعُ أَمَامَهُ جَمِيعُ ٱلشُّعُوبِ، فَيُمَيِّزُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ كَمَا يُمَيِّزُ ٱلرَّاعِي ٱلْخِرَافَ مِنَ ٱلْجِدَاءِ».
رومية ١٤: ١٠ و٢كورنثوس ٥: ١٠ ورؤيا ٢٠: ١٢ وحزقيال ٢٠: ٣٨ و٣٤: ١٧، ٢٠ ومتّى ١٣: ٤٩
جَمِيعُ ٱلشُّعُوبِ اليهود والأمم (متّى ٢٨: ١٩ ولوقا ٢٤: ٤٧) وهم جميع الأحياء والذين قاموا من الموت من أول خلق الإنسان إلى يوم القيامة (يوحنا ٥: ٢٨، ٢٩ و٢كورنثوس ٥: ١٠ ورؤيا ٢٠: ١٣). فما أعظم ذلك الجمع المشتمل على كل البشر والملائكة. وما أهم ذلك الاجتماع لنا، لأننا نكون هناك إما بين أهل الفوز والمسرة، أو بين أهل الخزي والعار والحزن.
فَيُمَيِّزُ يميِّز ملائكته (متّى ١٣: ٤١ ومرقس ٨: ٣) بين الأخيار والأشرار الذين يجتمعون في هذا العالم، ولكنهم ينفصلون يوم الدين إلى الأبد. وفي الدنيا يتميز بعض الناس على بعض بالغنى والشرف والعلم والتمدن، ولكن كل ذلك لا يعتبر يومئذٍ. فيومها الذي سيُعتبر صفاتهم الظاهرة بأعمالهم. ومن المعلوم أن تلك الصفات تختلف بمقتضى إيمانهم بالمسيح أو عدم إيمانهم به.
كَمَا يُمَيِّزُ ٱلرَّاعِي الخ يميز بسهولة وصواب. وهذا دليل على معرفة المسيح غير المحدودة، لأنه ميز بها بين عدد لا يحصى من البشر بالسهولة والإصابة اللتين يميز بهما كل يوم بين أفراد قطيعه الصغير من الغنم والمعزى. وهذا مثل قول حزقيال النبي «وَأَنْتُمْ يَا غَنَمِي، فَهكَذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ: هأَنَذَا أَحْكُمُ بَيْنَ شَاةٍ وَشَاةٍ، بَيْنَ كِبَاشٍ وَتُيُوسٍ» (حزقيال ٣٤: ١٧). وهو دليل واضح على أن العالم ينقسم في اليوم الأخير إلى قسمين فقط، كما قال المسيح في مثل الحنطة والزوان (متّى ١٣: ٣٠) ومثل السمك الجيد والرديء (متّى ١٣: ٤٨). وبين المؤمنين وغير المؤمنين (مرقس ١٦: ١٦) ولا قسم ثالث بين الذين قاوموا الإنجيل والذين اهتموا به.
٣٣ «فَيُقِيمُ ٱلْخِرَافَ عَنْ يَمِينِهِ وَٱلْجِدَاءَ عَنِ ٱلْيَسَارِ».
ٱلْخِرَافَ أراد بالخراف الصالحين، لأن الخراف وديعة لا تؤذي، ولأنها تحب راعيها وتخضع له، وتشعر باحتياجها إليه (متّى ١٨: ١٢ ويوحنا ١٠: ٧، ١٤ - ١٧ ومزمور ١٠٠: ٣). فكل الذين آمنوا بالمسيح وأظهروا إيمانهم بأعمالهم يُحسبون صالحين أو خراف رعيته.
عَنْ يَمِينِهِ أي في محل الشرف. والدعوة إليه علامة رضى الملك، فالذين في ذلك المكان يقيمون في رضى الملك وحمايته. وتقدم شرح مثل هذا في متّى ٣٢: ٤٤ (انظر أيضاً ١صموئيل ٢٠: ٢٥ و١ملوك ٢: ١٩ وأعمال ٢: ٢٥، ٣٣ وأفسس ١: ٢٠ وعبرانيين ١: ٣).
ٱلْجِدَاءَ المقصود بها الأشرار لأنها أقل من الخراف قيمة ونفعاً وألفة وطاعة.
عَنِ ٱلْيَسَارِ هو محل الإهانة، فالذين في هذا المكان يحكم عليهم الملك ويرفضهم.
٣٤ «ثُمَّ يَقُولُ ٱلْمَلِكُ لِلَّذِينَ عَنْ يَمِينِهِ: تَعَالَوْا يَا مُبَارَكِي أَبِي، رِثُوا ٱلْمَلَكُوتَ ٱلْمُعَدَّ لَكُمْ مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ».
رومية ١٤: ٩ ورؤيا ١٩: ١٦ ورومية ٨: ١٧ و١بطرس ١: ٤، ٩ و٣: ٩ ورؤيا ٢١: ٧ ومتّى ٢٠: ٢٣ ومرقس ١٠: ٤٠ و١كورنثوس ٢: ٩ وعبرانيين ١١: ١٦
ٱلْمَلِكُ سُمي المسيح في هذا الفصل «ابن الإنسان» و «الراعي» و «الديان» وسُمي هنا أيضاً «الملك». وسمى نفسه بالملك قبل منتهى اتضاعه بأقل من ثلاثة أيام. وكثيراً ما تكلم المسيح قبل ذلك في شأن ملكوته، لكن هذه أول مرة سمى نفسه ملكاً (رؤيا ١٧: ١٤ و١٩: ١٦). فالمسيح يجلس في يوم الدين ملكاً ودياناً ليمتحن ويحكم بالثواب والعقاب، ويُجري قضاءه. فالذي أتى أولاً بصورة عبد (فيلبي ٢: ٧) يأتي ثانياً ملكاً مجيداً. ولا يكون ملك اليهود فقط كما كُتب على الصليب، ولا ملك المختارين وحدهم، بل ملك العالمين، ملك الملوك ورب الأرباب.
تَعَالَوْا اليوم يقول للناس «تعالوا إليَّ» للخلاص فالذين يسمعونه ويأتون إليه يقول لهم «تعالوا» للمجد (يوحنا ١٤: ٣ و١٧: ٢٤) فهذا اعتراف المسيح بهم أمام وجه أبيه والملائكة الصالحين.
يَا مُبَارَكِي أَبِي كان هؤلاء محتقري العالم (متّى ١: ٢٢) فعلم الله أنهم له (٢تيموثاوس ٢: ١٩) فكانوا مباركيه وهم أحياء على الأرض. لكنهم لم يعلموا عظمة بركتهم حتى بلغوا السماء، وعلامات كونهم مباركي الآب أربع وهي: (١) أنهم منتخبون للخلاص (٢تسالونيكي ٢: ١٣ و١بطرس ١: ٢). (٢) أنهم عطية الآب للمسيح (يوحنا ١٧: ٦). (٣) إن الله قدرَّهم على صالح الأعمال بواسطة روحه القدوس. (٤) إن الله أحبهم ومجدهم في السماء.
رِثُوا يرثون لأنهم أبناء الله بالولادة الجديدة، ولأن المسيح اشترى لهم ذلك الميراث (رومية ٨: ١٤ - ١٧ وغلاطية ٣: ٢٩ و٤: ٦، ٧ وتيطس ٣: ٧ وعبرانيين ١: ١٤ ويعقوب ٢: ٥).
ٱلْمَلَكُوتَ أي كل الحقوق والبركات المختصة بالملكوت، ورأسه المسيح. وعلى هذا قال الرسول «لَيْسَ مَلَكُوتُ اللهِ أَكْلاً وَشُرْبًا، بَلْ هُوَ بِرٌّ وَسَلاَمٌ وَفَرَحٌ فِي الرُّوحِ الْقُدُسِ» (رومية ١٤: ١٧).
ٱلْمُعَدَّ الذي يزيد عظمة ذلك الميراث طول المدة التي صُرفت في إعداده، ووفرة كنوز حكمة الله وغناه التي أُنفقت عليه.
لَكُمْ أي أُعدَّ لكل فرد منكم على قدر حاجته، فلم يعد للبشر عموماً، ولا للكنيسة كلها، بل لكل نفس من المؤمنين.
مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ أي منذ الأزل، لا من بدء الخليقة، وذلك في قصد الثالوث الأقدس وقضائه. ومع أن الإعداد كان قبل إنشاء العالم إلا أنه لم يتم إلا بعد موت المسيح، لأن موته كان الجزء الأعظم من ذلك الإعداد. والمسيح صعد إلى السماء ليكمله بدليل قوله «أَنَا أَمْضِي لأُعِدَّ لَكُمْ مَكَانًا» (يوحنا ١٤: ٢) وإعداد ذلك الملكوت للمؤمنين منذ الأزل يؤكد ثبوته لهم وكماله في ذاته (أفسس ١: ٣ - ٥) وإنه هبة من إنعامه لا أجرة، لأنه أُعد قبل أن يُخلق المؤمنون (رومية ٦: ٢٣ و٨: ٢٩، ٣٠ وأفسس ١: ١١ و٢تسالونيكي ٢: ١٣ و١بطرس ١: ٢).
٣٥، ٣٦ «٣٥ لأَنِّي جُعْتُ فَأَطْعَمْتُمُونِي. عَطِشْتُ فَسَقَيْتُمُونِي. كُنْتُ غَرِيباً فَآوَيْتُمُونِي. ٣٦ عُرْيَاناً فَكَسَوْتُمُونِي. مَرِيضاً فَزُرْتُمُونِي. مَحْبُوساً فَأَتَيْتُمْ إِلَيَّ».
إشعياء ٥٨: ٧ وحزقيال ١٨: ٧ ويعقوب ١: ٢٧ وعبرانيين ١٣: ٣ ويوحنا ٥ ويعقوب ٢: ١٥، ١٦ و٢تيموثاوس ١: ١٦
لأَنِّي لا بد أن يُظهر المؤمنون بأعمالهم استعدادهم لذلك الملكوت المعد لهم، أي بكونهم معدين له كما هو معد لهم. ويظهر مما يأتي أن كل الناس يدانون في يوم القضاء حسب أعمالهم. ولا تناقض بين هذا وكون الخلاص بالإيمان، لأنه لا سبيل لإظهار صحة الإيمان إلا بالأعمال. وغاية الدينونة العلنية إظهار عدل الله في مجازاة الأخيار والأشرار، وهو يُعلن للمخلوقات بإظهار أعمالهم التي بُني الحكم عليها.
جُعْتُ... عَطِشْتُ... كُنْتُ غَرِيباً الخ ذكر المسيح هنا ستة أعمال فعلها الأبرار وأظهروا بها شفقتهم ورقتهم وعدم الاعتناء بذواتهم واستعدادهم لإنفاق أوقاتهم وأموالهم وقواهم وراحتهم على نفع إخوة المسيح لأجل المسيح.
ومن أمثلة إطعام الجياع ما جاء في ١ملوك ١٧: ١٠ - ١٥ وراعوث ٢: ١٤ - ١٧ ومن أمثلة سقى العطاش ما جاء في متّى ١٠: ٤٠ - ٤٢ ومن أمثلة إضافتهم للغرباء ما جاء في تكوين ١٨: ٢ - ٥ و١٩: ١ - ٣ ومن أمثلة كسوة العريان ما جاء في لو ٨: ٢، ٣، ٦ و١٠: ٣٠ - ٣٧ ومن أمثلة زيارة المسجونين ما جاء في إرميا ٣٨: ٧ - ١٣ و٢تيموثاوس ١: ١٦، ١٧ ومما يستحق الاعتبار في هذا الكلام ستة أمور: (١) إن الأعمال التي يثاب عليها المرء ليست أعمالاً عظيمة كإطلاق المسجونين أو شفاء المرضى، بل مجرد زيارتهم. فاعتذار من يهمل الواجبات الصغرى بدعوى أنه لم يتيسر له أن يقوم بالكبرى باطلٌ، لأنه قد ظهر من هذا المثل أن كل شخص يقدر أن يخدم الرب يسوع نفسه. (٢) المراحم التي ذُكرت هنا جسدية لا روحية، كتعليم الجهال ودعوة الخطاة إلى التوبة والإيمان والطاعة، مع أنها أعظم من الأولى. ولهذا سببان: (أ) أنها حُسبت كأنها فُعلت بالمسيح، فقال «جعت وعطشت» الخ، ولكن لم يصح أن يقول أنا جهلت فعلمتموني. أخطأت فدعوتموني إلى التوبة. ضللت فهديتموني، إلى غير ذلك من المراحم الروحية. و(ب) إن أُثيب على المراحم الصغرى فلا بد يُثاب على الكبرى، وعدم الاعتناء بالصغرى دليل على إهمال الكبرى «لأَنَّ مَنْ لاَ يُحِبُّ أَخَاهُ الَّذِي أَبْصَرَهُ، كَيْفَ يَقْدِرُ أَنْ يُحِبَّ اللهَ الَّذِي لَمْ يُبْصِرْهُ؟» (١يوحنا ٤: ٢٠). (٣) إن كل الأعمال التي ذُكرت هي من الخدمة الشخصية وإنكار الذات بإنفاق المال والعناية، وتدل على رقة القلب والمحبة الأخوية لأجل المسيح . وهذه كلها تبرهن أن الذين يقومون بها لهم روح السماء، فهم مستعدون لها. (٤) إن المسيح كان أعظم قدوة للعالم بممارسته مثل تلك الأعمال، فمَن عمل مثلها يظهر أنه شبه المسيح (٢كورنثوس ٨: ٩). (٥) لا داعي للمسيحي الحقيقي أن يخاف الحساب في يوم الدين، لأن قانون المحاسبة هو أن أفعال الرحمة التي يفعلها بالبشر تُحسب أنها فُعلت بالمسيح، وهذا خير اطمئنان له. (٦) كما يتنكر الملوك أحياناً ويجولون بين الرعية ليلاحظوا أعمالهم، يجول المسيح بين شعبه وهو غير منظور، إذ يتنكر في فقراء شعبه. فالذين يؤوون الغرباء من أتباع المسيح يمكنهم أن يستضيفوا ملائكة كما قال الرسول (عبرانيين ١٣: ٢) بل يستضيفون الرب يسوع نفسه.
٣٧ - ٣٩ «٣٧ فَيُجِيبُهُ ٱلأَبْرَارُ حِينَئِذٍ: يَارَبُّ، ٣٨ مَتَى رَأَيْنَاكَ جَائِعاً فَأَطْعَمْنَاكَ، أَوْ عَطْشَاناً فَسَقَيْنَاكَ؟ وَمَتَى رَأَيْنَاكَ غَرِيباً فَآوَيْنَاكَ، أَوْ عُرْيَاناً فَكَسَوْنَاكَ؟ ٣٩ وَمَتَى رَأَيْنَاكَ مَرِيضاً أَوْ مَحْبُوساً فَأَتَيْنَا إِلَيْكَ؟».
جواب الأبرار هنا أظهر تواضعهم، لأنهم شعروا أنهم لا يستحقوا المدح والثواب. فالذين يتواضعون على الأرض يبقون متواضعين في السماء. وأظهر أيضاً تعجبهم فقد جهلوا أنهم عندما فعلوا الخير بإخوتهم فعلوه بالمسيح، لأنهم لم يخدموه شخصياً. فتبين من أقوالهم أنهم لم يحسبوا نوال ذلك الثواب أجرة استحقوها بأعمالهم الصالحة، وقد أصابوا بذلك. ولا ضرورة للحكم بأن الأبرار نطقوا بنفس تلك الأجوبة، لكنها هي خلاصة أفكار قلوبهم، وقد عرفها فاحص القلوب وأعلنها.
٤٠ «فَيُجِيبُ ٱلْمَلِكُ: ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: بِمَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي هٰؤُلاَءِ ٱلأَصَاغِرِ، فَبِي فَعَلْتُمْ».
أمثال ١٤: ٣١ و١٩: ١٧ ومتّى ١٠: ٤٢ ومرقس ٩: ٤١ وعبرانيين ٦: ١٠
لنا من جواب المسيح أربعة أشياء: (١) إن المسيح عندما يجازي الأبرار لا يقتصر على اعتبار أعمالهم، بل يلاحظ غاياتهم من تلك الأعمال. (٢) إن الفضيلة المسيحية التي جُعلت هنا علامة الإيمان الصحيح بالمسيح هي المحبة، لأنها أعظم الفضائل، بدليل القول الرسولي «أَمَّا الآنَ فَيَثْبُتُ: الإِيمَانُ وَالرَّجَاءُ وَالْمَحَبَّةُ، هذِهِ الثَّلاَثَةُ وَلكِنَّ أَعْظَمَهُنَّ الْمَحَبَّةُ» (١كورنثوس ١٣: ١٣) ولأنها إكليل صفات الله فإنه محبة (١يوحنا ٤: ٨، ١٦). فإذا وُجدت المحبة في الإنسان وُجدت فيه سائر الفضائل، وإن فقدها فقد الكل. لقد جعل المسيح التواضع علامة الإيمان به في متّى ١٨: ٣، لأنه أساس تُبنى عليه سائر الفضائل في أول الأمر. لكن المحبة رأس ذلك البناء عند كماله «فَالْمَحَبَّةُ هِيَ تَكْمِيلُ النَّامُوسِ» (رومية ١٣: ١٠) وهي رباط الكمال (كولوسي ٣: ١٤). (٣) يحسب المسيح ما صُنع من المعروف لتلاميذه إكراماً له وأنه صُنع له، بحسب قوله «مَنْ يَقْبَلُكُمْ يَقْبَلُنِي. وَمَنْ سَقَى أَحَدَ هؤُلاَءِ الصِّغَارِ كَأْسَ مَاءٍ بَارِدٍ فَقَطْ بِاسْمِ تِلْمِيذٍ، فَالْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لاَ يُضِيعُ أَجْرَهُ» (متّى ١٠: ٤٠، ٤٢). وقوله لشاول وهو يضطهد الكنيسة «لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي؟» (أعمال ٩: ٤) وهذا دليل على شدة الاتحاد والشركة في الشعور بين المسيح وشعبه حتى أنه يحضر معهم حيث كانوا، ويشاركهم في فقرهم وضيقهم، ويحسب المساعدة لهم عين المساعدة له، واضطهادهم هو عين اضطهاده. ويظهر ذلك الاتحاد أيضاً من آيات كثيرة مثل (يوحنا ١٥: ٤ - ٦ و١كورنثوس ٦: ١٥ وأفسس ٥: ٢٣ - ٣٢).
إِخْوَتِي أي تلاميذي (يوحنا ٢٠: ١٧) وشركائي في ضيقتي (عبرانيين ٢: ١٠، ١١). والمسيح وهو ملك على عرش المجد لا يزال يحسب المؤمنين به من البشر إخوته.
هٰؤُلاَءِ ٱلأَصَاغِرِ أي الذين هم أقل اعتباراً واشتهاراً عند المؤمنين من غيرهم، والمحتقرون عند سائر أهل العالم. ومدح المسيح على صنع المعروف لإخوته لا يعني أننا لا نفعل الخير لغيرهم (متّى ٥: ٤٤).
٤١ «ثُمَّ يَقُولُ أَيْضاً لِلَّذِينَ عَنِ ٱلْيَسَارِ: ٱذْهَبُوا عَنِّي يَا مَلاَعِينُ إِلَى ٱلنَّارِ ٱلأَبَدِيَّةِ ٱلْمُعَدَّةِ لإِبْلِيسَ وَمَلاَئِكَتِهِ».
مزمور ٦: ٨ ومتّى ٧: ٢٣ و١٣: ٤٠، ٤٢ ولوقا ١٣: ٢٧ و٢بطرس ٤ ويهوذا ٦
ٱذْهَبُوا عَنِّي المسيح نفسه الذي قال لهم أولاً «تعالوا إليَّ» قال لهم أخيراً «اذهبوا عني». فالذين قالوا لله في حياتهم الدنيا «ابعد عنا» (أيوب ٢٢: ١٧) سيسمعونه يقول لهم ابعدوا عني. وهذا بدء عذاب جهنم لأن «أمام الله شِبَعُ سُرُورٍ» (مرقس ١٦: ١١) والبعد عنه الموت الثاني.
يَا مَلاَعِينُ هذا عكس ما قيل للأبرار، فإنه قال لهم «يا مباركي أبي». والملاعين هم المحرومون من كل خيرٍ ومسرة والمُعاقبون بالآلام والأحزان. ولم يقل لهم «يا ملاعين أبي» كما قال للأبرار «يا مباركي أبي» لأن من الله الخلاص، وأما الهلاك فيأتي على الناس من أعمالهم، فهم لعنةٌ على أنفسهم (إشعياء ٥٠: ١).
إِلَى ٱلنَّارِ ٱلأَبَدِيَّةِ هذه النار ليست للتطهير بل للعذاب، وهي علامة غضب الله على الخطاة لأنه بالنسبة إليهم «نَارٌ آكِلَةٌ» (عبرانيين ١٢: ٢٩) فعلى ذلك يكون عقابهم مؤكداً شديداً دائماً
ٱلْمُعَدَّةِ لإِبْلِيسَ وَمَلاَئِكَتِهِ سبق أن الملكوت أي السماء معدٌ للأبرار، ولكنه لم يقل إن جهنم معدَّة للأشرار، بل للشياطين (رؤيا ١٩: ٢٠ و٢٠: ١٨) والشياطين هم الملائكة الساقطون (يهوذا ٦ ورؤيا ١٢: ٨، ٩) وقد أُعدَّ لهم محل العذاب الذي استحقوه. فأشرار الناس اقتدوا بهم وشاركوهم في الإثم فأعدوا أنفسهم لمرافقتهم، فذهبوا إلى أماكنهم كما ذهب يهوذا الإسخريوطي إلى مكانه (أعمال ١: ٢٥) فإذاً دينونتهم عادلة.
٤٢ - ٤٥ «٤٢ لأَنِّي جُعْتُ فَلَمْ تُطْعِمُونِي. عَطِشْتُ فَلَمْ تَسْقُونِي. ٤٣ كُنْتُ غَرِيباً فَلَمْ تَأْوُونِي. عُرْيَاناً فَلَمْ تَكْسُونِي. مَرِيضاً وَمَحْبُوساً فَلَمْ تَزُورُونِي. ٤٤ حِينَئِذٍ يُجِيبُونَهُ هُمْ أَيْضاً: يَارَبُّ مَتَى رَأَيْنَاكَ جَائِعاً أَوْ عَطْشَاناً أَوْ غَرِيباً أَوْ عُرْيَاناً أَوْ مَرِيضاً أَوْ مَحْبُوساً وَلَمْ نَخْدِمْكَ؟ ٤٥ فَيُجِيبُهُمْ: ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: بِمَا أَنَّكُمْ لَمْ تَفْعَلُوهُ بِأَحَدِ هٰؤُلاَءِ ٱلأَصَاغِرِ فَبِي لَمْ تَفْعَلُوا».
أمثال ١٤: ٣١ و١٧: ٥ وزكريا ٢: ٨ وأعمال ٩: ٥
ما يستحق الاعتبار في هذه الأعداد سبعة أمور: (١) إن الأشرار دينوا هنا، لا أنهم سرقوا أو تعدوا الوصايا، بل لمجرد إهمالهم الواجبات، فلهم لم يُظهروا المعروف لتلاميذ المسيح ولا لمسيحهم بواسطتهم، فأظهروا عدم مشابهتهم للمسيح، وعدم استعدادهم لملكوته بعدم اعتنائهم بالفقراء والمحتاجين والغرباء والمسجونين. فإذا دين هؤلاء فبالأولى أن يُدان مرتكبو الفظائع، ويعاقب مُهملو النعمة والمجدفون والمضطهدون. (٢) إن الأعمال التي دينوا على إهمالها يستطيع أن يعملها كل إنسان يريد أن يقوم بها. (٣) خلاصة إثمهم إنهم عاشوا لأنفسهم، فأنفقوا عليها القوات والمواهب التي وهبها الله لهم لنفع غيرهم من البشر في تخفيف أحزانهم وتكثير أفراحهم. ولا يلزم من ذلك أن الأشرار يدانون يوم القضاء على مجرد ما أخطأوا به إلى إخوتهم بغضّ النظر عما ارتكبوه ضد الله، إذ الغاية هنا بيان عدل الله في عقاب الأشرار بأمثلة تدركها أذهان البشر. (٤) جهل الأشرار عظمة خطيتهم فظنوا أن حكم الله عليهم سيكون على إهمالهم ما يجب عليهم لغيرهم من الناس، ولم يفطنوا أنهم أهملوا بذلك ما يجب عليهم للمسيح. وخطايا الناس أفظع مما يظنون، ونتائجها تمتد دائماً إلى ما لم يخطر لهم على بال. (٥) ادَّعوا أن المسيح لو أتى بنفسه لكانوا خدموه، ولو عرفوا أنه يمكنهم خدمته بالإحسان إلى تلاميذه لأحسنوا إليهم. وكذلك الناس اليوم يخدعون أنفسهم بتركهم الواجبات الصغرى الحاضرة مدَّعين أنه لو فُتحت لهم الأبواب إلى كبار الواجبات لقاموا بها خير قيام. (٦) ليس في جوابهم شيءٌ يدل على التواضع أو التوبة، بل خلاصته تبرير أنفسهم، فصفاتهم في الآخرة تبقى كصفاتهم في الدنيا. ويمكن الناس أن يقوموا بأعمال تذيع صيتهم بين أهل الأرض، كما فعل الفلاسفة والأبطال والمكتشفون والمخترعون. ولكن ليس لمثل هؤلاء اعتبار في يوم الدين إن قال لهم المسيح «فَبِي لَمْ تَفْعَلُوا». (٧) إن قوله «بي» أساس يُبنى عليه ما يستحق الثواب من الأعمال.
٤٦ «فَيَمْضِي هٰؤُلاَءِ إِلَى عَذَابٍ أَبَدِيٍّ وَٱلأَبْرَارُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ».
دانيال ١٢: ٢ ويوحنا ٥: ٢٨، ٢٩ ورومية ٢: ٧ الخ ورؤيا ٢١: ١ - ٨
عَذَابٍ أَبَدِيٍّ... حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ هما حالان أولهما في أبعد بعدٍ عن الله. وثانيهما في أقرب قربٍ إليه. والأول أجرة الخطية، والثاني هبة الله، ولا يوجد موقف ثالث.
لقد وُصف كلاهما بما وُصف به الآخر. فإذاً يدوم شقاء الأشرار كما تدوم سعادة الأبرار. وورد هذا الوصف ٦٦ مرة في الإنجيل، في ٥١ منها بياناً لدوام سعادة الأبرار، ومرتين بياناً لسرمدية الله، وست مرات بياناً لدوام عقاب الأشرار. فعقاب الأشرار يبقى ما بقيت سعادة الأبرار ووجود الله وملكوت المسيح. ومن الشواهد على أبدية العقاب بعد الموت ما يأتي من الآيات (مزمور ٩: ١٧ وإشعياء ٣٣: ١٤ ومرقس ١٦: ١٦ ولوقا ١٦: ٢٦ ويوحنا ٣: ٣٦ و٢تسالونيكي ١: ٧ - ٩).
لقد أوضح السيد له المجد قيمة الديانة العملية المثمرة بإطعام الجائع وكسوة العريان ونفقة الخير والرحمة للفقير والمسكين. أي أن الإيمان يجب أن يعمل بالمحبة لأجل خدمة الآخرين، فإننا نتصل بالله مترجين نعمته ورحمته، ثم نتصل بأخينا الإنسان لنفرج كربه ونخفف ضيقه.
تتضمن الحياة الأبدية، علاوة على خلود النفس، أنها تكون في أحسن حال للعمل، وتنال أسمى السعادة والبركات والثواب بدون خطر السقوط في الخطية، وأنها تعاين الله وتكون مثله في القداسة. والمسيح هو الذي اشترى لها كل ذلك (٢تيموثاوس ١: ١٠). وكما أن الحياة الأبدية كناية عن كمال السعادة والقداسة، كذلك العذاب الأبدي كناية عن تمام الشقاء والإثم.
ومما يحقق لنا دوام العذاب في جهنم أنه لا يمكن أن يُغفر للخاطئ بلا توبة، ولا يمكنه أن يدخل السماء بدون تجديد قلبه. فكيف يستطيع ذلك في جهنم حيث لا تأثير للروح ولا لوسائط النعمة؟ فليس في الجحيم سوى كل ما يثبته في الإثم! وقد أخبرنا الله بكل هذا التحذير لأنه محبة، وهو يريدنا أن نهرب من الموت الأبدي وننال الحياة الأبدية. فإن صعب علينا الكلام عن عذاب الأشرار أو قراءة أخباره، فكم يصعب ويؤلم احتماله.
ولا بد أن جميع الناس يقفون يوم الدين عن يمين الديان أو عن يساره. فلنا الآن أن نختار الموقف الذي نحبه، إذ لا اختيار لنا في ذلك اليوم. ولا بد من أن جميعهم يسمعون إما قوله «تعالوا إليَّ» أو قوله «اذهبوا عني». ولنا الآن أن نختار سماع الصوت الذي نحبه. ولا بد من أن جميعهم ينالون إما الحياة الأبدية أو العذاب الأبدي، فحياتنا الزمنية ووسائط النعمة وُهبت من الله لكي نتمسك بالحياة الأبدية. فإهمالنا الحياة يعرِّض نفوسنا للموت والهلاك!
الأصحاح السادس والعشرون
ذكر متّى في هذا الأصحاح أربعة أمور جهَّزت الطريق لصلب المسيح، وهي إنباء المسيح عن موته (ع ١، ٢)، ومؤامرة الرؤساء عليه (ع ٣ - ٥)، ودهن مريم إياه لتكفينه (ع ٦ - ١٣)، وتعهُّد يهوذا بتسليمه (ع ١٤ - ١٦). ولم يذكر متّى هذه الأمور حسب ترتيب وقوعها.
١ «وَلَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ هٰذِهِ ٱلأَقْوَالَ كُلَّهَا قَالَ لِتَلاَمِيذِهِ».
هٰذِهِ ٱلأَقْوَالَ كُلَّهَا أي ما قاله لتلاميذه على جبل الزيتون (في متّى ٢٤، ٢٥) عندما أجاب على سؤال أربعة منهم (مرقس ١٣: ٣). ويظهر من هذا العدد ومن أسلوب التعليم أن أقوال المسيح هنا موجَّهة إلى الكل لا إلى الأربعة الذين سألوه. وهي أقوال تتعلَّق بممارسته لوظيفته النبوية. وما بقي من بشارة متّى يتعلق بممارسته لوظيفته الكهنوتية بآلامه وموته.
٢ «تَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ يَكُونُ ٱلْفِصْحُ، وَٱبْنُ ٱلإِنْسَانِ يُسَلَّمُ لِيُصْلَبَ».
مرقس ١٤: ١ الخ ولوقا ٢٢: ١ الخ ويوحنا ١٣: ١
تَعْلَمُونَ لم يقصد المسيح أن يعرِّفهم بموعد الفصح، فهُم يعرفونه، لكنه قصد أن يخبرهم بتسليمه إلى الموت حينئذٍ حسبما أنبأهم به في متّى ٢٠: ١٨.
بَعْدَ يَوْمَيْنِ كان الوقت الذي تكلم فيه مساء الثلاثاء أي ليلة الأربعاء فيكون هذان اليومان الأربعاء والخميس إلى مسائه، الذي هو أول يوم الجمعة ووقت أكل الفصح.
ٱلْفِصْحُ أي عيد اليهود الأعظم، أُمروا به في خروج ١٣. والفصح كلمة عبرانية معناها «العبور» إشارةً إلى عبور الملاك المُهلك عن بني إسرائيل حين قتل أبكار المصريين. وكانت مدة العيد ٧ أيام من ١٥ نيسان إلى ٢١ منه (لاويين ٢٣: ٥) ولم يجز اليهود أن يأكلوا في تلك المدة كله من الخبز سوى الفطير، ولذلك سُمي أيضاً عيد الفطير. واقتضت ممارسة الفصح خمسة أمور: (١) ذبح الخروف، و(٢) رش الدم على قائمتي باب وعتبةِ بيت المعيِّد، و(٣) شيّ الخروف صحيحاً من دون أن يُكسر عظم منه. وفي شيِّه رمزٌ إلى آلام المسيح من أجلنا (يوحنا ١٩: ٣٦ و١كورنثوس ٥: ٧)، و(٤) أكله مع الخبز الفطير والأعشاب المرة، و(٥) عدم إبقاء شيءٍ منه إلى الصبح.
واتَّفق اليهود أن لا ينقص عدد آكلي خروف الفصح في بيت واحد عن عشرة، وأن لا يزيدوا عن العشرين. فإن لم يبلغ سكان البيت الواحد العشرة اشترك بيتان في خروف واحد. وكانوا يأكلون الفصح في أول فرصة بسرعة، وأحقاؤهم ممنطقة، وأحذيتهم في أرجلهم، وعصيُّهم في أيديهم، إشارةً إلى خروجهم من مصر. والظاهر أن ذلك أُهمل قبل مجيء المسيح. وكانوا يجهزون الخروف في عاشر الشهر (خروج ١٢: ١ - ٦) وهذا أُهمل كذلك. واكتفوا في أيام المسيح برش الكهنة الدم في الهيكل في وقت ذبح الخروف عوضاً عن رشهم إياه في البيت كما أمرهم موسى. واستعملوا في أيام المسيح الخمر مع الخروف وهو ما لم تأمرهم الشريعة به. وكيفية أكل الفصح في أيام المسيح كانت كما يأتي:
يبدأون بشُرب كأس خمر ممزوجة بماءٍ بعد تقديم الشكر لله، وسُمِّيت هذه الكأس بالكأس الأولى. وبعد هذا يغسلون أيديهم ويقدمون شكراً مختصراً لله. ثم يضعون على مائدة الفصح هذه الأطعمة: الأعشاب المُرة والخبز الفطير والخروف وخليط التمر والزبيب والتين واللوز في الخل، فيأكلون أولاً قليلاً من الأعشاب المرَّة مع شكرٍ آخر، ثم يرفعون كل الأطعمة عن المائدة ويقدمون لكلٍّ كأساً كالأولى. وقيل إن علة رفع تلك الأطعمة جعل الأولاد يسألون عن سبب ذلك العيد (انظر خروج ١٢: ٢٦، ٢٧).
وكان رئيس المتكأ يبدأ حينئذٍ يروي لهم نبأ عبودية اليهود في مصر وأخبار نجاتهم وسبب فرض عيد الفصح. ثم يردّون الأطعمة إلى المائدة، ويقول رئيس المتكإ «هذا هو الفصح، فلنأكل لأن الرب فصح (عبر) عن بيوت آبائنا في مصر». ثم يرفع بيده بعض الأعشاب المرة ويقول «هذا إشارة إلى مرارة العبودية المصرية». ثم يرفع شيئاً من الفطير ويقول «هذا إشارة إلى سرعة نجاتهم» ثم يتلو مزموري ١١٣ و١١٤ ويصلي صلاة مختصرة، ويشرب كل واحد الكأس التي وُضعت قدامه وتُسمّى «الكأس الثانية». ثم يغسلون أيديهم ثانية ويأكلوا الفصح، ثم يغسلون أيديهم ويشربون كأس خمر سموها «كأس البركة» لأن رئيس المتكإ كان يقدم شكراً خاصاً مع شربها لله على صلاحه. وهذه هي الكأس هي التي يُظن أن المسيح أخذها لما رسم العشاء الرباني، وسماها بولس «كأس البركة» (١كورنثوس ١٠: ١٦). ثم يشربون كأساً أخرى عند الانصراف سُميت «الهلل» أي التهليل، لأنهم كانوا يهللون لله عند شربها بتلاوة مزمور ١١٥ - ١١٨. وبحسب هذه العادة رتل المسيح وتلاميذه قبل انصرافهم إلى جبل الزيتون. وكانوا أحياناً يرنمون «الهلل الأكبر» بتلاوة مزمور ١٢٠ - ١٣٨ وكانوا يجمعون ما بقي من الخروف ويحرقونه.
وجاءت لفظة الفصح في الإنجيل بثلاثة معانٍ: (١) خروف الفصح نفسه (مرقس ١٤: ١٢ ولوقا ٢٢: ٧)، و(٢) الخروف والعشاء (متّى ٢٦: ١٧ ومرقس ١٤: ١٤ ولوقا ٢٢: ١١)، و(٣) كل عيد الفطير، وهو المقصود هنا وفي لوقا ٢٢: ١ ويوحنا ٢: ١٣ و٦: ٤ و١١: ٥٥ و١٢: ١ و١٣: ١.
والفصح المذكور في الآية التي نفسرها هو الرابع في أيام خدمة المسيح. ذكر الأول في يوحنا ٢: ٢٣ والثاني في يوحنا ٥: ١ والثالث في يوحنا ٦: ٤ والرابع في آيتنا وفي يوحنا ١٣: ١.
يُسَلَّمُ أنبأهم قبلاً بأنه يسلم وعيَّن لهم هنا وقت التسليم بأنه يكون بعد يومين، أي في العيد.
لِيُصْلَبَ انظر شرح متّى ٢٧: ٣٥.
٣ «حِينَئِذٍ ٱجْتَمَعَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةُ وَشُيُوخُ ٱلشَّعْبِ إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ ٱلَّذِي يُدْعَى قَيَافَا».
حِينَئِذٍ ٱجْتَمَعَ أي أعضاء مجلس السبعين. والأرجح أن اجتماعهم كان بعد خروج المسيح من الهيكل، وهو الذي ذُكر في متّى ٢٤: ١. وربما تآمروا عليه وهو يتكلم مع تلاميذه بما ذُكر في متّى ٢٤، ٢٥.
رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ أي رؤساء الفرق الأربع والعشرين التي قُسم الكهنة إليها (١أيام ٢٤: ١ - ١٩).
ٱلْكَتَبَة حفظة الكتب المقدسة ومفسروها.
شُيُوخُ ٱلشَّعْبِ أي نوابه في المجلس الكبير. وكان الحبر الأعظم رئيسه.
دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ أي الحبر الأعظم. كان من عادة أعضاء ذلك المجلس أن يجتمعوا في إحدى ديار الهيكل، لكن كان يجوز أن يجتمعوا في دار رئيس الكهنة. ولعل غاية اجتماعهم في تلك الدار في ذلك الوقت إخفاء مشورتهم عن الشعب لأن ديار الهيكل كانت تغصُّ بالناس في أيام الفصح.
وأما وظيفة رئيس الكهنة فأول من تولاها هو هارون (خروج ٢٨). وكان يرثها الأكبر من سلالته في القرون الأولى من تاريخ بني إسرائيل (عدد ٣: ١٠). ولما استولى عليهم ملوك اليونان (نحو ١٦٠ سنة ق م) أخذوا يبيعون تلك الوظيفة لمن يدفع الثمن الأوفر. وبعدما استولى الرومان عليهم أخذوا يعزلون الرئيس ويقيمون غيره كما يشاؤون بقطع النظر عن الأهلية والكفاءة. وجرت هذه العادة منذ عصر هيرودس الكبير إلى زمان خراب أورشليم، وبلغ عدد الذين تداولوها ثمانية وعشرون في ١٠٧ سنة، ذُكر في الإنجيل ثلاثة منهم، هم حنان وقيافا وحنانيا. وكان يُلقب كل من أخذ تلك الوظيفة برئيس الكهنة ويجلس في المجلس الكبير طول حياته ولو عُزل.
قَيَافَا واسمه يوسف أيضاً كما قال يوسيفوس المؤرخ، وهو من الصدوقيين، وكان صهر حنان الذي تولى تلك الوظيفة قبله، ولم يزل يلقب برئيس الكهنة بعد انتقال الوظيفة إلى صهره (لوقا ٣: ٢ وأعمال ٤: ٥، ٦). وكان قيافا رئيساً للكهنة في سنة ٢٦ - ٣٦ م. ثم عزله فيتاليوس القائد الروماني بعد ست سنين من صلب المسيح.
٤ «وَتَشَاوَرُوا لِكَيْ يُمْسِكُوا يَسُوعَ بِمَكْرٍ وَيَقْتُلُوهُ».
مزمور ٢: ٢ ويوحنا ١١: ٤٧ وأعمال ٤: ٢٥ الخ
بِمَكْرٍ لأنهم لم يجسروا أن يفعلوا ذلك علانية. لقد قصدوا أن يقتلوا يسوع منذ أن أقام لعازر (يوحنا ١١: ٥٣) ومنعهم عنه قبلاً خوفهم من الشعب، لأن الكثيرين حسبوه نبياً (لوقا ٧: ١٦) وتأثروا كثيراً بتعاليمه (لوقا ٢١: ٣٨).
٥ «وَلٰكِنَّهُمْ قَالُوا: لَيْسَ فِي ٱلْعِيدِ لِئَلاَّ يَكُونَ شَغَبٌ فِي ٱلشَّعْبِ».
خروج ١٢: ١٦
لَيْسَ فِي ٱلْعِيدِ الخ كذا قصدوا أولاً بناءً على معرفتهم كثرة عدد المجتمعين في العيد، لأنهم لم ينقصوا في بعض السنين عن ثلاثة ملايين، ولعلمهم بكثرة عدد الجليليين بينهم، وهم الذين أخذ المسيح تلاميذ وأصدقاء كثيرين منهم. ولعلهم ذكروا الاحتفال الذي كان للمسيح عند دخوله المدينة منذ يومين، فخافوا أن يقوم عليهم أولئك الأصدقاء إذا هم قبضوا عليه علانية وقتئذٍ. ولكن خيانة يهوذا عدلت بهم عن ذلك القصد، لأنه أراهم طريقاً يمسكونه بها خفية فلا يكون شغب. وفي هذا بيان لتتميم الله مقاصده بالرغم من الأشرار، فإنه شاء أن يكون موت المسيح في وقت العيد لينتشر نبأ ذلك عن طريق كثرة المشاهدين، وليقترن موت المسيح بذبح خروف الفصح.
٦ «وَفِيمَا كَانَ يَسُوعُ فِي بَيْتِ عَنْيَا فِي بَيْتِ سِمْعَانَ ٱلأَبْرَصِ».
متّى ٢١: ١٧
بَيْتِ عَنْيَا في سفح جبل الزيتون الشرقي، وتُعرف اليوم باللعازرية، وهي تبعد نحو ثلاثة أرباع الساعة مشياً عن أورشليم، وهي وطن مريم ومرثا ولعازر، المكان الذي اعتاد المسيح أن يتردد عليه (لوقا ١٠: ٣٨ - ٤١ ومرقس ١١: ١١، ١٢) وكان في الأسبوع الأخير من حياته الأرضية يعلّم في الهيكل في النهار ويخرج في الليل ليبيت في جبل الزيتون (لوقا ٢٢: ٣٥). ويظهر من كلام متّى في آية الشرح وكلام البشيرين الآخرين أن الموضع الذي كان يبيت فيه هنالك هو بيت عنيا. ومن تلك القرية عينها صعد إلى السماء (لوقا ٢٤: ٥٠).
بَيْتِ سِمْعَانَ ٱلأَبْرَصِ إن كان سمعان أبرص بالفعل وكان حياً، فلا يمكن أن يحضر معهم، لأن شريعة موسى تمنعه من ذلك. وربما شفاه المسيح وبقي ملقباً بما كان عليه. وربما مات وبقي بيته يُنسب إليه. وظن البعض أنه أبو مريم ومرثا ولعازر، وظنه آخرون نسيباً لتلك العائلة، وأن العائلتين كانتا في بيته بناءً على قول يوحنا «صَنَعُوا لَهُ هُنَاكَ عَشَاءً. وَكَانَتْ مَرْثَا تَخْدِمُ، وَأَمَّا لِعَازَرُ فَكَانَ أَحَدَ الْمُتَّكِئِينَ مَعَهُ» (يوحنا ١٢: ٢). ولكن لم يخشَ يوحنا ذلك لأنه كتب إنجيله بعد خراب أورشليم حين لم يكن خطر عليهم.
٧ «تَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ ٱمْرَأَةٌ مَعَهَا قَارُورَةُ طِيبٍ كَثِيرِ ٱلثَّمَنِ، فَسَكَبَتْهُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ».
مرقس ١٤: ٣ الخ ويوحنا ١١: ١، ٢ و١٢: ٣ الخ
ٱمْرَأَةٌ قد تكون مريم أخت مرثا ولعازر. ويجب هنا أن يميز بين هذه المرأة والمرأة التي ذكرها لوقا في متّى ٧: ٣٦ - ٣٨ لأن تلك كانت في الجليل وهذه في بيت عنيا، وتلك كانت خاطئة مشهورة وهذه شهد لها المسيح بأنها اختارت النصيب الصالح، وتلك كانت في بيت سمعان الفريسي وهذه كانت في بيت سمعان الأبرص، وتلك دهنته في أول تبشيره وهذه دهنته في نهاية ذلك التبشير.
قَارُورَةُ في الأصل اليوناني هي وعاءٌ من رخام لين أبيض شفاف، استعمله القدماء كثيراً للأطياب الثمينة، ثم أطلقت على كل قنينة، سواء كانت من رخام أم من معدن أم زجاج. وكانت القوارير غالباً ذوات أعناق طويلة يسدون أفواهها بالطفال. فإذا أرادوا سكب الطيب منها كسروا العنق أو الطفال (مرقس ١٤: ٣).
طِيبٍ قال مرقس ويوحنا إن ذلك كان طيب ناردين (مرقس ١٤: ٣ ويوحنا ١٢: ٣) وهو أثمن ما عُرف يومئذٍ من الأطياب. كانوا يأتون به من بلاد الهند ويستخرجونه من نبات هناك. وهو سائل كالزيت ذو رائحة ذكية (نشيد الأنشاد ١: ١٢ و٤: ١٣، ١٤). وكان أغنياء الأقدمين يتطيبون به. وقال يوحنا إن مريم أتت بمناً من ذلك الطيب (يوحنا ١٢: ٣) وهو في اليوناني «لتراً» وهو وزن يوناني وروماني يعادل مئة درهم. وقال أيضاً «امْتَلأَ الْبَيْتُ مِنْ رَائِحَةِ الطِّيبِ» (يوحنا ١٢: ٣).
كَثِيرِ ٱلثَّمَنِ قال يهوذا إن قيمته تساوي ٣٠٠ دينار (يوحنا ١٢: ٥) وذلك نحو ١٠ جنيهات ذهبية، وكان الدينار وقتها أجر الفاعل في النهارً (متّى ٢٠: ٩). فيكون ثمن طيب تلك القارورة يعدل أجرة الفاعل سنة كاملة، بعد حذف الأيام التي لا يجوز العمل فيها. وهذا دليل على أن عائلة مريم كانت غنية حتى استطاعت تحمُّل مثل تلك النفقة.
سَكَبَتْهُ عَلَى رَأْسِهِ ويظهر من نبأ يوحنا أنها دهنت رجليه أيضاً ومسحتهما بشعرها. وكان دهن الرأس مألوفاً، وأما دهن القدمين فلم يكن كذلك، فهو دليل على تواضعها.
وَهُوَ مُتَّكِئٌ اعتاد الناس في أيام المسيح أن يتكئوا على الأسرَّة عند الأكل كما أوضحنا في شرح متّى ٢٠: ٦. وهذا الاتكاء سهَّل لمريم الوصول إلى رأسه وإلى قدميه. وقصدت مريم بذلك إكرام يسوع لاعتقادها أنه المسيح، ولإظهار شكرها لإقامته أخاها لعازر من الموت. ومثل هذا الإكرام يليق تقديمه لأعظم الملوك.
٨، ٩ «٨ فَلَمَّا رَأَى تَلاَمِيذُهُ ذٰلِكَ ٱغْتَاظُوا قَائِلِينَ: لِمَاذَا هٰذَا ٱلإِتْلاَفُ؟ ٩ لأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُبَاعَ هٰذَا ٱلطِّيبُ بِكَثِيرٍ وَيُعْطَى لِلْفُقَرَاءِ».
يوحنا ١٢: ٤ الخ.
فَلَمَّا رَأَى تَلاَمِيذُهُ ذٰلِكَ ٱغْتَاظُوا يظهر أن أصل هذا التذمر هو يهوذا (يوحنا ١٢: ٥) وهو أول ما ذُكر من كلامه في الإنجيل «قَالَ هذَا لَيْسَ لأَنَّهُ كَانَ يُبَالِي بِالْفُقَرَاءِ، بَلْ لأَنَّهُ كَانَ سَارِقًا، وَكَانَ الصُّنْدُوقُ عِنْدَهُ، وَكَانَ يَحْمِلُ مَا يُلْقَى فِيهِ» (يوحنا ١٢: ٦) فلو وصلت يده إلى ذلك المبلغ لسرق بعضه. وحمل تذمرُه غيرَه من التلاميذ على تكرير ما قاله هو. وكثيراً ما نشاهد أن تذمر جماعات كثيرة ينشأ من إنسان واحد وينتشر إلى غيره كنار في الحصيد. فعلى المسيحيين أن يعلموا أن الكثيرين سيتذمرون على أعمالهم الخيرية، لأنهم يجهلون غايتها.
هٰذَا ٱلإِتْلاَفُ لم يرَ التلاميذ فائدة أو منفعة من بذل ذلك الطيب بتلك الطريقة، لأنهم حسبوه إتلافاً وتبذيراً. كذلك كثيراً ما يحسب أهل العالم ما يبذله المسيحيون من الأموال في سبيل بشرى الخلاص بين الوثنيين إتلافاً وتبذيراً. والحق أن لا شيء مما نقدمه للمسيح هو إتلاف مهما كان ثميناً، كصرف الحياة في خدمته في البلاد البعيدة، أو بذلها من أجله كما بذلها الشهداء. ولا حقَّ لأهل العالم أن يتذمروا على المسيحيين بذلك لأنه لا يحق لكل مسيحي أن ينفق ماله كيف شاء كما يحق للعالمي أن يتصرف بماله كما يريد.
يُعْطَى لِلْفُقَرَاءِ أصل هذا الاعتراض من يهوذا لأنه لم يكن يبالي بالفقراء إنما اتخذ ذلك حُجة للتذمر (يوحنا ١٢: ٦). وكثيراً ما يستر الأشرار مقاصدهم السيئة بحجاب التقوى.
١٠ «فَعَلِمَ يَسُوعُ وَقَالَ لَـهُمْ: لِمَاذَا تُزْعِجُونَ ٱلْمَرْأَةَ؟ فَإِنَّهَا قَدْ عَمِلَتْ بِي عَمَلاً حَسَناً».
فَعَلِمَ يَسُوعُ أي علم كل ما يتعلق بذلك التذمر كالذي ابتدأه، والدواعي التي دعته إليه.
وَقَالَ لَـهُمْ كلم يسوع الجميع لكن كلامه كان توبيخاً ليهوذا الإسخريوطي على الخصوص. ويهوذا نفسه شعر بذلك وزاد عزمه على ما أضمره من الخيانة، كما تدل عليه القرينة في العدد ١٤ ومما قيل في مرقس ١٤: ١٠.
لِمَاذَا تُزْعِجُونَ ٱلْمَرْأَةَ؟ كان ذلك التذمر بالحقيقة على المسيح، كأنه لا يستحق ما فعلته تلك المرأة من إكرامه. وكأن له الحق أن يوبخهم على ذلك، لكنه لم يهتم إلا بانزعاج أفكار مريم. ولا ريب في أنها انزعجت من كلامهم «لأنهم كانوا يلومونها» (مرقس ١٤: ٥).
عَمَلاً حَسَناً حكم المسيح بحسن عملها لعلمه بحسن نيتها، لأنها فعلت ذلك احتراماً له، ولأنه كان موافقاً لمقتضى الحال، أي أنه كان جزءاً من تكفينه. هذا ما رآه المسيح، وأما الرسل فنظروا إلى عدم النفع الظاهر من عملها، فحكموا بخلاف ما حكم هو به. على أن إنفاقها ذلك على المسيح خير من إنفاقها إياه على ما تتحلى به أو تزين به بيتها، بل خير من انتفاع الفقراء الوقتي به.
١١ «لأَنَّ ٱلْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ، وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ».
تثنية ١٥: ١١ ويوحنا ١٢: ٨ ومتّى ١٨: ٢٠ و٢٨: ٢٠ ويوحنا ١٣: ٣٣ و١٤: ١٩ و١٦: ٥، ٢٨ و١٧: ١١
لأَنَّ ٱلْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ دفع المسيح اعتراضهم كأنهم أتوا به عن إخلاص. ولم يوبخ مُنشئ ذلك الاعتراض على ريائه. فذكر الاعتناء بالفقراء كأنه واجبٌ كل يوم على كنيسته إلى نهاية الزمان. وذلك موافق لما قيل في مزمور ٤١: ١ وأمثال ١٤: ٢١ و٢٩: ٧ وغلاطية ٢: ١٠.
وَأَمَّا أَنَا فَلَسْت الخ أي أن فرص إكرام جسده قاصرة على الزمن الحاضر، لأنه على وشك الموت والصعود إلى السماء، وعدم إقامته بالجسد في الأرض بعد.
١٢ «فَإِنَّهَا إِذْ سَكَبَتْ هٰذَا ٱلطِّيبَ عَلَى جَسَدِي إِنَّمَا فَعَلَتْ ذٰلِكَ لأَجْلِ تَكْفِينِي».
بيَّن المسيح هنا سبب حكمه بحُسن عمل مريم وخطإ تذمر التلاميذ، وكان اليهود ينفقون الكثير على تحنيط الموتى (يوحنا ١٩: ٣٩) واعتبروا هذا من الفضائل الواجبة، فقال المسيح إن ذلك الإنفاق كان لتكفينه، فلا داعي للاعتراض. ولا بد أم التلاميذ تعجبوا من كلامه وحزنوا وخجلوا، لأنهم لم يذكروا أن المسيح سيموت مع أنه أنبأهم بذلك مراراً (متّى ٢٠: ١٩ ولوقا ١٨: ٣١، ٣٢).
ظن البعض أن مريم قصدت بما عملت أن يكون جزءاً من تكفين المسيح، لأنها سمعت أنه سيموت صلباً، وحسبت أنه لا يكون لها فرصة لذلك بعد موته، فسبقت إليه قبل أن يموت. فإن صحَّ هذا الظن يكون أنها أدركت ما لم يدركه أحدٌ من الرسل. وظن آخرون (وهو الأرجح) أنها لم تقصد بذلك سوى إكرام للمسيح، وأن المسيح نسب إلى عملها معنىً لم تقصده. نعم أنها عملت حسناً ولكن عملها كان أحسن مما حسبته. ومهما كان الظن فقد قصد الله أن يكون دهن المسيح استعداداً لدفنه، وجعل مريم واسطة ذلك.
١٣ «ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: حَيْثُمَا يُكْرَزْ بِهٰذَا ٱلإِنْجِيلِ فِي كُلِّ ٱلْعَالَمِ، يُخْبَرْ أَيْضاً بِمَا فَعَلَتْهُ هٰذِهِ تِذْكَاراً لَهَ».
ٱلْحَقَّ قال هذه الكلمة تنبيهاً لهم لِما سيقوله.
هٰذَا ٱلإِنْجِيلِ هو بشارة خلاص للعالم بموت المسيح. وحقق المسيح للتلاميذ أنه حيث امتد خبر ما فعله هو لأجل خلاص البشر يُروَى ما عملته مريم له، وهذا أعظم ثواب.
فِي كُلِّ ٱلْعَالَمِ هذا تنبؤ بانتشار الإنجيل في كل الأرض.
يُخْبَرْ أَيْضاً بِمَا فَعَلَتْهُ هذه نبوءة غريبة تبيَّن صدقها منذ نحو ألفي سنة. فلو لم يكن المسيح ابن الله لاستحال أن يعلم أن عمل امرأة في بيت عنيا سيُذكَر بعد ألوف من السنين، ويُترجم خبره في كل لغات العالم جزاءً على ما عملته له.
ولم يوجد ملك في العالم مهما كان مقتدراً استطاع أن يحقق دوام ذكر عملٍ يتعلق به. ولا ريب أن مريم سرَّت لأن المسيح مدح عملها ووعد بدوام ذكرها، وإن لامها التلاميذ. وحصلت على ذلك الثواب لأنها لم تأتِ ما أتته بغية إن تُثاب ولا أن تشتهر بالكرم، بل لمجرد إكرام ربها. وهي مثال وقدوة حسنة لنا.
١٤ «حِينَئِذٍ ذَهَبَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلاثْنَيْ عَشَرَ، ٱلَّذِي يُدْعَى يَهُوذَا ٱلإِسْخَرْيُوطِيَّ، إِلَى رُؤَسَاءِ ٱلْكَهَنَةِ».
متّى ١٠: ٤ ومرقس ١٤: ١٠ ولوقا ٢٢: ٣ ويوحنا ٣: ٢٠، ٣٠
حِينَئِذٍ أي على أثر ما سبق. وقال الإنجيلي ذلك ليبين أن ما يأتي نتيجة ما سبق بغضّ النظر على قرب الزمان أو بُعده. وقد حرَّك توبيخ المسيح يهوذا ليتمم ما كان يفكر فيه.
يَهُوذَا ٱلإِسْخَرْيُوطِيَّ انظر شرح متّى ١٠: ٤. لم يهتم متّى ببيان ما حمل يهوذا على تسليم المسيح، فإنه ربَّى الطمع في قلبه حتى جعله طمَعُهُ آلةً مناسبة للشيطان (لوقا ٢٢: ٣) ولما خاب رجاؤه أن يملك المسيح على الأرض جسدياً، وما يتعلق بذلك من الشرف والغِنى لإنباء المسيح بموته (ع ٢) ولعلمه مقاصد رؤساء الكهنة من جهته (يوحنا ١١: ٤٧)، ولغيظه من إتلاف الطيب وتوبيخ المسيح له، أجاب داعي التجربة الشيطانية وذهب ليسلم المسيح طمعاً بالأجرة. نعم إن الشيطان هيَّج يهوذا على تلك الخيانة، لكن يهوذا خان ربَّه باختياره. وهذا من الأدلة القاطعة على أن محبة المال من شر فخاخ إبليس، وأنها مما يقود إلى أفظع الخطايا.
إِلَى رُؤَسَاءِ ٱلْكَهَنَةِ لعله ذهب إليهم وقت التئام مجمع السبعين للمؤامرة على المسيح كما ذُكر في (ع ٣) وكان ذلك مساء الثلاثاء، أي بعد يومين من العشاء، فبقي يهوذا عازماً على الخيانة فعلاً مدة يومين.
١٥ «وَقَالَ: مَاذَا تُرِيدُونَ أَنْ تُعْطُونِي وَأَنَا أُسَلِّمُهُ إِلَيْكُمْ؟ فَجَعَلُوا لَهُ ثَلاَثِينَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ».
خروج ٢١: ٣٢ وزكريا ١١: ١٢ ومتّى ٢٧: ٣
مَاذَا تُرِيدُونَ أَنْ تُعْطُونِي هذا برهان على تمام عزمه على تسليم المسيح إليهم، وهو وفق قول مرقس «ثُمَّ إِنَّ يَهُوذَا... مَضَى إِلَى رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِمْ» (مرقس ١٤: ١٠).
فَجَعَلُوا لَهُ لم يعطوه في الحال، بل وعدوه بتسليم المبلغ عند تسليمه المسيح إليهم.
ثَلاَثِينَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ أي ثلاثين شاقلاً من الفضة لأنه هو المعهود عندهم في المعاملات. والشاقل يساوي حول ١٢ جراماً من الفضة، فيكون مبلغ ما أخذه يقارب ٣٦٠ جراماً وهذا كان ثمن العبد (خروج ٢١: ٣٢). فبيع المسيح للموت كعبدٍ ليحرِّرنا من العبودية الدائمة للخطية والموت. ويحتمل أن قول زكريا «فَقُلْتُ لَـهُمْ: إِنْ حَسُنَ فِي أَعْيُنِكُمْ فَأَعْطُونِي أُجْرَتِي وَإِلاَّ فَامْتَنِعُوا. فَوَزَنُوا أُجْرَتِي ثَلاَثِينَ مِنَ الْفِضَّةِ» (زكريا ١١: ١٢) نبوءة بذلك. فما أعظم الفرق بين قيمة المسيح عند مريم وقيمته عند يهوذا، فإنها انفقت على إكرامه عند العشاء ثلاث مئة دينار، وباعه يهوذا للموت بأقل من ثُلث هذه القيمة.
١٦ «وَمِنْ ذٰلِكَ ٱلْوَقْتِ كَانَ يَطْلُبُ فُرْصَةً لِيُسَلِّمَهُ».
وَمِنْ ذٰلِكَ ٱلْوَقْتِ أي من وقت مشاورته للرؤساء من مساء يوم الثلاثاء، قبل الفصح بيومين (ع ٢، ٣). وظنَّ البعض أن يهوذا هذا كان من سكان أورشليم، ولذلك عرف رؤساء الكهنة أكثر من غيره من الرسل، وأنه حسب زعمه قد خاب أمله بيسوع فلم يكن المسيح المنتظر لكي يملك ملكاً أرضياً على اليهود.
فُرْصَةً أي وقتاً وموضعاً مناسبين لتسليمه (لوقا ٢٢: ٦) حتى لا يشاهد الشعب القبض عليه ويخلصوه.
لِيُسَلِّمَهُ لا يدلهم فقط على الموضع المناسب للقبض عليه، بل أن يشترك معهم فعلاً في القبض عليه. وخيانته هذه حملت الرؤساء على تغيير مقصدهم الأول (ع ٥).
ولا شكَّ أن في قصة يهوذا الإسخريوطي فوائد للكنيسة، كما في قصة امرأة لوط التي أمر المسيح بذكرها (لوقا ١٧: ٣٢) ونكتفي بأن نذكر سبعاً من تلك الفوائد:
- الحصول على أفضل الوسائط لا يضمن الخلاص، فقد كان يهوذا رسولاً مختاراً، ومن الاثني عشر، ورفيقاً للمسيح، شاهد معجزاته وسمع تعاليمه، وكان شريكاً لبطرس ويعقوب ويوحنا، ونال من وسائط النعمة ما لم ينله إبراهيم وموسى ودانيال وإشعياء، ومع كل ذلك هلك. وهذا يحقق صحة قول المسيح «من ليس له، فالذي عنده يُؤخذ منه» (متّى ٢٥: ٢٩).
- يمكن أن ينال الإنسان صيتاً حسناً بين الناس وهو بلا تقوى أمام الله. فإن المسيح أرسل يهوذا كسائر الرسل ليعلّم ويصنع الآيات. وظهر أنه ترك كل شيء لأجل المسيح كغيره من الرسل، ولم يظن أحدٌ منهم فيه سوءاً لأنهم عيَّنوه أميناً لصندوقهم. وحين قال المسيح للرسل «واحد منكم يسلمني» لم يفتكر أحد في يهوذا بل نظر إلى نفسه أولاً، بدليل قول كل واحد منهم «هل أنا يا رب؟».
- محبة المال خطر عظيم، وكان يهوذا من أول محبي المال، ويدل على ذلك قوله لهؤلاء الكهنة «ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟». نعم إن يهوذا ترك كثيراً عندما تبع المسيح، لكنه لم يترك طمعه فأهلكه، كثقبٍ واحد في السفينة يُغرقها في المال. فحب المال حمل دليلة على تسليم شمشون إلى الفلسطينيين، وحمل جيحزي على خداع نعمان والكذب على أليشع، وحمل حنانيا وسفيرة على أن يكذبا على الروح القدس، وحمل رسولاً من رسل المسيح على أن يرتكب أفظع الآثام وهو تسليم ابن الله إلى قاتليه. فعلينا أن ننتبه لقول الرسول «مَحَبَّةَ الْمَالِ أَصْلٌ لِكُلِّ الشُّرُورِ، الَّذِي إِذِ ابْتَغَاهُ قَوْمٌ ضَلُّوا عَنِ الإِيمَانِ، وَطَعَنُوا أَنْفُسَهُمْ بِأَوْجَاعٍ كَثِيرَةٍ» (١تيموثاوس ٦: ١٠).
- لا عجب من خيبة الأمل في الأصحاب. لأن المسيح نفسه ذاق مرارة كأس خيبة الأصدقاء، وصار بذلك قادراً على أن يشعر معنا ويرثي لنا في مثل تلك الحال (عبرانيين ٤: ١٥).
- شرَّ أعداء المسيح كان من أقرب أصحابه، كما أنبئ بذلك في مزمور ٤١: ٩. وهذا أضرَّ الكنيسة التي هي جسد المسيح في كل عصر أكثر من كل الأعداء، لأنه لا يقدر أحد أن يضرها مثل ضرر من تربَّى في حضنها.
- قد ينتج من الشر خيرٌ، فإن عاقبة خيانة يهوذا كانت أفضل برهان على صحة دعوى المسيح. لأنه بعد ما سلَّمه كان يجب أن يسكت ضميره، ويوقف توبيخ الآخرين له بأن يذكر شيئاً من عيوب المسيح. ولكن المسيح زكيٌّ بلا عيب، فرأينا يهوذا يطرح في الخزانة ما أخذه أجرة على إثمه قائلاً «أخطأت إذ سلمت دماً بريئاً». وهذا يفحم من يقول «ليس لنا شهادة عن بر المسيح سوى شهادة أصحابه».
- الندامة على الإثم لا تُصلح ما أفسده ولا تُسكت الضمير، فإن يهوذا ندم وردَّ الدراهم واعترف بإثمه، لكنه لم يقدر أن ينقذ المسيح بذلك، لأنهم أجابوه بقولهم «ماذا علينا؟ أنت أبصِر» (أي: هذه مشكلتك لا مشكلتنا). ولم يستطع يهوذا أن يسكت ضميره «فمضى وخنق نفسه». وأما الذي لا تنفعه الندامة فينفعه دم المسيح إذا لجأ إليه. ولكن يهوذا لم يفعل كذلك.
١٧ «وَفِي أَوَّلِ أَيَّامِ ٱلْفَطِيرِ تَقَدَّمَ ٱلتَّلاَمِيذُ إِلَى يَسُوعَ قَائِلِينَ: أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ نُعِدَّ لَكَ لِتَأْكُلَ ٱلْفِصْحَ؟».
خروج ١٢: ٦، ١٨ ومرقس ١٤: ١٢ ولوقا ٢٢: ٧
وَفِي أَوَّلِ أَيَّامِ ٱلْفَطِيرِ أي في يوم الخميس الرابع عشر من نيسان، حين يعزل كل خمير من بيوتهم (خروج ١٢: ١٥ - ١٧) وكانوا يأتون في هذا اليوم بخروف الفصح إلى الهيكل ويذبحونه هناك بين الساعة الثالثة والخامسة بعد الظهر (خروج ١٢: ٦ ولاويين ٢٣: ٥ ولوقا ٢٢: ٧). وحُسب ذلك اليوم أول أيام الفطير لأنه كان فيه ذلك الاستعداد. فأيام العيد الأصلية سبعة، ولكن إذا حسبنا ذلك اليوم من العيد كانت ثمانية. وبعد الغروب من نهار ذلك اليوم كان بدء يوم الجمعة، وهو هنا الخامس عشر من نيسان الذي كانوا يأكلون فيه الفصح حسب الوصية (خروج ١٢: ٦ - ٨ و٢٣: ٥).
مضى على المسيح يوم الأربعاء كله وجزءٌ من يوم الخميس وهو في بيت عنيا. ولم يذكر الإنجيليون شيئاً من أعماله في هذه المدة. وأكل المسيح الفصح مع تلاميذه في الوقت الذي اعتاد الإسرائيليون أكله فيه. وهذا يظهر من قول لوقا «وَجَاءَ يَوْمُ الْفَطِيرِ الَّذِي كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُذْبَحَ فِيهِ الْفِصْحُ» (لوقا ٢٢: ٧)، ويظهر من غيرة المسيح في القيام بكل الشريعة، ويظهر من استحالة أن يذبح الكهنة خروف الفصح ويرشوا دمه حول المذبح ويسلموه إلى بطرس ويوحنا في غير وقته. ويؤيد ذلك ما جاء في مرقس ١٤: ١٢، ١٦، ١٧.
تَقَدَّمَ ٱلتَّلاَمِيذُ الخ الأرجح أن ذلك كان صباح يوم الخميس وكانوا حينئذٍ في بيت عنيا، والواجب أن يأكلوا الفصح في أورشليم فكان لا بدَّ أن يستعدوا هناك قبل الوقت لأنهم غرباء.
١٨ «فَقَالَ: ٱذْهَبُوا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ، إِلَى فُلاَنٍ وَقُولُوا لَهُ: ٱلْمُعَلِّمُ يَقُولُ إِنَّ وَقْتِي قَرِيبٌ. عِنْدَكَ أَصْنَعُ ٱلْفِصْحَ مَعَ تَلاَمِيذِي».
يوحنا ١٣: ١
فَقَالَ ٱذْهَبُوا لم يذكر متّى عدد المرسلين، ولكن لوقا ذكر أنه أرسل اثنين هما بطرس ويوحنا (لوقا ٢٢: ٨).
إِلَى ٱلْمَدِينَةِ أي أورشليم
إِلَى فُلاَنٍ ذكر مرقس ولوقا أنه أعطاهما علامة يعرفان بها الإنسان الذي أرسلهما إليه، وهي أنه عند وصولهما إلى المدينة يلاقيهما إنسان حامل جرة ماء، وأمرهما أن يتبعاه ويخاطبا رب البيت الذي يدخله بالكلام الذي أمرهما به. فأقام لتلاميذه تلك العلامة برهاناً جديداً على معرفته الغيب. ولعله أتى ذلك لكيلا يدع سبيلاً ليهوذا إلى معرفة المكان فيخبر الرؤساء فيمسكوه في وقت الفصح، ولعله لم يذكر اسم رب البيت خوفاً عليه من الأعداء، لأنه من أصحاب المسيح الذين لم يعترفوا به علانية خوفاً من اليهود (يوحنا ١٢: ٤٢).
ٱلْمُعَلِّمُ الظاهر أن المسيح عُرف بهذا اللقب بين تلاميذه، فكان كافياً لأن يعرفه صاحب البيت وأنه مستحق اتخاذ مكان عنده. وكان اليهود معتادين إضافة من يحضرون العيد فكانوا يستعدون لها كل سنة.
وَقْتِي قَرِيب لا شك أن المسيح أشار بذلك إلى وقت آلامه وموته (يوحنا ١٢: ٢٣ و١٣: ٣٢ و١٧: ١). ولا نعلم هل فهم صاحب البيت أو التلميذان ذلك المعنى أم لا. ولعلهم ظنوه وقت ظهوره ملكاً.
مَعَ تَلاَمِيذِي ذلك يقتضي أن المكان كان واسعاً ليسع جماعة مثل هذه. قال متّى ولوقا إن ذلك المكان كان «عِلِّيَّةً كَبِيرَةً مَفْرُوشَةً مُعَدَّةً» (مرقس ١٤: ١٥). وأعدَّ يهود أورشليم كثيراً من الأماكن الكبيرة كتلك العلية لكثرة الغرباء الذين يأتون أورشليم لأكل الفصح، وجهزوها بالمفروشات كالحُصر، وبالموائد والأسرَّة للاتكاء، والماء والمغاسل والمناشف (يوحنا ١٣: ٤، ٥).
١٩ «فَفَعَلَ ٱلتَّلاَمِيذُ كَمَا أَمَرَهُمْ يَسُوعُ وَأَعَدُّوا ٱلْفِصْحَ».
قال لوقا «فانطلقا ووجدا كما قال لهما» (لوقا ٢٢: ١٣) وبذلك كان لهم برهان جديد على معرفته الغيب.
وَأَعَدُّوا ٱلْفِصْحَ أي اشتروا خروفاً وأخذوه إلى الهيكل بين الساعة الثالثة والخامسة بعد الظهر من ذلك النهار، فذبحه الكهنة ورشوا دمه حول المذبح، وأعطوه للرسل فطبخوه حسب الوصية، وأحضروا أعشاباً مرة وخبزاً فطيراً وصحافاً وكؤوساً. ويتبين من تمام الحديث أنهم أخذوا خمراً أيضاً.
٢٠ «وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ ٱتَّكَأَ مَعَ ٱلاثْنَيْ عَشَرَ».
مرقس ١٤: ١٧ الخ ولوقا ٢٢: ١٤ ويوحنا ١٣: ٢١
لَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ أي مساء الخميس عند الغروب، وهو بدء يوم الجمعة الخامس عشر من نيسان (تثنية ١٦: ٦).
وما يأتي هي حوادث حياة المسيح الأرضية في هذا اليوم، الذي هو آخر يوم له على الأرض وهي:
- المشاجرة بين التلاميذ في من منهم يكون أكبر. والأرجح في أن ذلك وقت اتكائهم على المائدة وغسل المسيح أرجلهم توبيخاً لهم على ذلك، وتعليماً لهم عن التواضع (لوقا ٢٢: ٢٤ ويوحنا ١٣: ٣ - ٥).
- أكل الفصح.
- تعيين المسيح للخائن وخروج ذلك الخائن.
- رسم العشاء الرباني
- يسوع يخبر بإنكار بطرس إياه وترك بقية الرسل له.
- خطاب المسيح الوداعي المذكور في يوحنا ١٤، ١٥، ١٦ وصلاته المذكورة في يوحنا ١٧.
- الترنيم والخروج من المدينة
- تألم يسوع في جثسيماني
- قبض العساكر عليه.
ٱتَّكَأَ كان بنو إسرائيل يأكلون الفصح في أول أمرهم وهم وقوف (خروج ١٢: ١١) ثم تركوا تلك العادة وبدلوها بالاتكاء على الأسرة مسندين أياديهم اليسرى آكلين بالأيادي اليمنى، واتخذوا عذرهم في ذلك أن الوقوف كان إشارة إلى أيام العبودية والهرب والخطر، وأن اتكاءهم بعده إشارة إلى وصولهم إلى أرض الميعاد واطمئنانهم وراحتهم.
وكان يوحنا في متكأ الرسل قدام المسيح حتى إذا مال إلى الوراء يلامس رأسه صدر المسيح (يوحنا ١٣: ٢٥). والأرجح أن يهوذا الإسخريوطي كان وراءه أو قريباً منه جداً حتى يمكنه أن يكلمه ولا يسمع غيره، وأن يناوله اللقمة يداً بيد (يوحنا ١٣: ٢٦). ولعل مشاجرة الرسل المذكورة في لوقا ٢٢: ٢٤ ابتدأت وقت الاتكاء، وكانت علتها المسابقة إلى المتكأ الأول. فغسل يسوع أرجل التلاميذ توبيخاً لهم على ذلك (يوحنا ١٣: ١ - ٢٠).
٢١ «وَفِيمَا هُمْ يَأْكُلُونَ قَالَ: ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ، إِنَّ وَاحِداً مِنْكُمْ يُسَلِّمُنِي».
فِيمَا هُمْ يَأْكُلُونَ انظر شرح ع ٢.
وَاحِداً مِنْكُمْ يُسَلِّمُنِي أنبأ المسيح قبل ذلك بأنه يُسلَّم إلى أيدي أعدائه (متّى ١٧: ٢٢ و٢٠: ١٨ ولوقا ٩: ٤٤). وأنبأ هنا أنه يقبل الخيانة، وأن الخائن واحد من الاثني عشر. وقال يوحنا إن المسيح قبل ما أنبأ بذلك «اضطرب بالروح» كأنه حمل فوق ما تحتمل طاقته. وهو أن يسلمه واحد من تلاميذه الذين اختارهم وأحبهم وأكرمهم. وذلك الاضطراب حمله على أن يشهد بما علم (يوحنا ١٣: ٢١) ويُحتمل أن المسيح أراد بهذا الإعلان أن يعلن ليهوذا الإسخريوطي أن مقاصده الشريرة كانت معلومة ليحثه على انتهاز فرصة التوبة إن شاء. وأعلن ذلك لبقية التلاميذ ليتوقعوا حدوثه ولا يتعجبوا منه. وليدفع ما يعتريهم من ضعف الإيمان عند حدوثه لو لم يخبرهم به لأنهم يذكرون حينئذٍ أنه عرفه قبل وقوعه وأنبأ به.
٢٢ «فَحَزِنُوا جِدّاً، وَٱبْتَدَأَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقُولُ لَهُ: هَلْ أَنَا هُوَ يَا رَبُّ؟».
فَحَزِنُوا جِدّاً نتج من هذا الإنباء حزن حقيقي لقلوب كل التلاميذ سوى يهوذا. أما هو فتظاهر بالحزن ولم يكن به من حزن.
وَٱبْتَدَأَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقُولُ دل قولهم على أن كلاً منهم (إلا يهوذا) خالٍ من ذلك القصد الشرير، وأنه شاعر بضعفه وقابليته للوقوع في تلك التجربة الفظيعة، وخائف أن يقع فيها. وأما قول يهوذا كقولهم فنتيجة رياء غريب وسترٌ لشرِّه. ولم يسأل المسيح إلا بعد الجميع (ع ٢٥). والظاهر أنه لم يشكَّ أحدٌ من التلاميذ في يهوذا، لكن كل واحد غيره شكَّ في نفسه قبل أن يشك فيه.
٢٣ «فَأَجَابَ: ٱلَّذِي يَغْمِسُ يَدَهُ مَعِي فِي ٱلصَّحْفَةِ هُوَ يُسَلِّمُنِي».
مزمور ٤١: ٩ ولوقا ٢٢: ٢١ ويوحنا ١٣: ١٨
ٱلَّذِي يَغْمِسُ يَدَهُ مَعِي الخ إذا قارنّا هذا العدد بما جاء في يوحنا ١٣: ٢٦ نعلم أن يسوع وضع يده في الصحفة مع يد يهوذا، وأن المسيح غمس اللقمة وناولها له. وهذه العلامة الأخيرة كانت سراً بين المسيح وبين يهوذا، يُحتمل أن بطرس اطَّلع عليها (يوحنا ١٣: ٢٣ - ٢٦) لأنه سأل يوحنا بالإشارة أن يسأل المسيح عمَّن قصده بقوله «إن واحداً منكم يسلمني» فاتكأ يوحنا على صدر يسوع وسأله سراً عن علامة يُعرف بها الشخص المراد. فكانت تلك العلامة لقمة غُمست في الصحفة وأُعطيت الخائن. وبهذه الخيانة تمت النبوة القائلة «رَجُلُ سَلاَمَتِي، الَّذِي وَثِقْتُ بِهِ، آكِلُ خُبْزِي، رَفَعَ عَلَيَّ عَقِبَهُ» (مزمور ٤١: ٩).
٢٤ «إِنَّ ٱبْنَ ٱلإِنْسَانِ مَاضٍ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنْهُ، وَلٰكِنْ وَيْلٌ لِذٰلِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي بِهِ يُسَلَّمُ ٱبْنُ ٱلإِنْسَانِ. كَانَ خَيْراً لِذٰلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَمْ يُولَد».
مزمور ٢٢ وإشعياء ٥٣ ودانيال ٩: ٢٦ ومرقس ٩: ١٢ ولوقا ٢٤: ٢٥، ٢٦، ٤٦ وأعمال ١٧: ٢، ٣ و٢٦: ٢٢، ٢٣ و١كورنثوس ١٥: ٣ ويوحنا ١٧: ١٢
هذا العدد تابع ما قاله يسوع في ع ٢١ وموجَّه إلى الكل.
ٱبْنَ ٱلإِنْسَانِ أي أنا الكلمة المتجسدة
مَاضٍ أي مائتٌ كما ورد في تكوين ١٥: ٢ ومزمور ٣٩: ١٣.
كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ أي في نبوات العهد القديم. (قابل مزمور ٤١: ٩ مع يوحنا ١٣: ١٨ وانظر إشعياء ٥٣: ٤ - ٩ ودانيال ٩: ٢٦، ٢٧). وتلك النبوات بُنيت على قضاء الله وعلمه السابق، وأُعلنت للتلاميذ لتكون عزاءً لهم زمن الأحزان بأن ما حدث لم يكن إلا بقصد الله وتعيينه بالحكمة والصلاح. ومثل هذا العزاء هو لكل مؤمن في كل ضيق وحزن.
وَلٰكِنْ وَيْلٌ قال هذا شفقةً على يهوذا لما سيجلبه على نفسه من العذاب الشديد. وتحذيراً له من العواقب.
كَانَ خَيْرا الخ هذا كلام جارٍ مجرى المثل، يُراد به عقاب هائل لا تُرجى له نهاية. وهو يدل على ثلاثة أمور:
(١) إن الإثم الذي عزم يهوذا على ارتكابه فظيعٌ جداً يوجب عليه القصاص الشديد. و(٢) إن ذلك القصاص لا بد منه. و(٣) إنه أبديٌ. لأنه لو كانت له نهاية ينال بعدها يهوذا الأفراح السماوية ما صحَّ أن يُقال عليه «خيرٌ له لو لم يولد». لأنه على فرض صحة ذلك يكون وجوده خيراً له. فإن قيل كيف يصح الحكم على يهوذا بأنه آثم مع أنه نفَّذ قضاء الله الأزلي قلنا (١) إن كل ما فعله إنما فعله باختياره، ولذلك فهو مسؤول بما فعل، لأن قضاء الله لم يسلبه حرية إرادته، ولم يجبره على الفعل ولا أغراه به. (٢) إنه فعل كل ما فعله بقصد شرير، لأنه خالف ضميره وشريعة الله، ورفض نصائح المسيح وربَّى الرذائل في قلبه، كالطمع والخيانة والجحود، فكفر النعمة ولم يشكر على أفضل وسائطها، وارتكب أشر الآثام على أعظم وأقدس البشر، لأزهد غاية وهي الحصول على ثلاثين من الفضة. (٣) لو رفع قضاء الله وعلمه السابق المسؤولية عن يهوذا ومنع جواز عقابه، لمنع جواز مكافأة البار، لأن بره من قضائه، لأن ذلك القضاء يعمُّ كل أفعال الناس (أعمال ١: ١٦ - ١٨ و٢: ٢٣ و٤: ٢٧، ٢٨).
٢٥ «فَسَأَلَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ: هَلْ أَنَا هُوَ يَا سَيِّدِي؟ قَالَ لَهُ: أَنْتَ قُلْتَ».
أَنْتَ قُلْتَ أي نعم. الأرجح أن المسيح أجاب يهوذا بذلك سراً، فلم يسمعه أحدٌ من التلاميذ. وسؤاله المسيح «هل أنا هو؟» من أكبر أنواع الرياء. وزاد المسيح على قوله «أنت قلت» قوله «ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة» (يوحنا ١٣: ٢٨). وهذا سمعه الجميع، لكنهم لم يفهموا لماذا كلمه به. والأرجح أنه خرج حالاً ولم يشترك مع سائر الرسل في العشاء الرباني كما شاركهم في أكل الفصح، بدليل قول يوحنا (الذي راعى ترتيب الحوادث دون غيره) «لَمَّا أَخَذَ اللُّقْمَةَ خَرَجَ لِلْوَقْتِ» (يوحنا ١٣: ٣٠) وكانت تلك اللقمة من الفصح كما هو ظاهر.
٢٦ «وَفِيمَا هُمْ يَأْكُلُونَ أَخَذَ يَسُوعُ ٱلْخُبْزَ، وَبَارَكَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى ٱلتَّلاَمِيذَ وَقَالَ: خُذُوا كُلُوا. هٰذَا هُوَ جَسَدِي».
مرقس ١٤: ١٢ الخ ولوقا ٢٢: ١٨ الخ و١كورنثوس ١١: ٢٣ الخ أعمال ٢: ٤٢ و١كورنثوس ١٠: ١٦
وَفِيمَا هُمْ يَأْكُلُونَ أي الفصح، وكانوا حينئذٍ على وشك النهاية (لوقا ٢٢: ١٥ - ٢٠ و١كورنثوس ١١: ٢٥) فلم يكونوا قد قاموا عن المائدة، ولم يزل خبز العشاء قدامهم.
أَخَذَ يَسُوعُ ٱلْخُبْزَ أي رغيفاً من الخبز الفطير الذي أمامه.
وَبَارَكَ أي طلب بركة الله عليه، أو شكر الله لأجله كما قال لوقا (لوقا ٢٢: ١٩ وبولس ١كورنثوس ١١: ٢٤). ولا يلزم من قوله «بارك» أنه حدث تغيير سري في الخبز، كما لم يلزم ذلك وقت إشباع الآلاف الخمسة في البرية. (قارن مرقس ١٤: ٢٢ بـ مرقس ٦: ٤١ وبـ لوقا ٩: ١٦ وبـ يوحنا ٦: ١١).
وَكَسَّرَ أشار بذلك إلى ما كان عازماً أن يحتمله من الآلام، وإلى جسده المكسور على الصليب لأجل آثامنا (١كورنثوس ١١: ٢٤)، أي أن جسده يُجرح ويُطعن ويُقتل. فالكسر إشارة إلى أن المسيح كفارةٌ وذبيحة عنا. وزاد لوقا على ذلك قوله «الذي يُبذل عنكم» (لوقا ٢٢: ١٩). والمقصود بذلك أن كل فوائد موت المسيح على الصليب لأجلهم، فكأنه قال «كما أني أعطيكم هذا الخبز المكسور لكي تأكلوه، هكذا أبذل لكم جسدي ليقتل لأجل خطاياكم».
وممّا فعله المسيح هنا سُمي العشاء الرباني أحياناً «كسر الخبز» (أعمال ٢: ٤٢ و١كورنثوس ١٠: ١٦) وكما أن القمح لا يُشبع الإنسان إلا إذا كُسر، كذلك المسيح لم يخلصنا إلا بموته عنا (يوحنا ١٢: ٢٤).
خُذُوا كُلُوا لنا من ذلك ثلاثة أمور:
- كما نأكل الخبز فنجعله جزءاً من أجسادنا، كذلك يجب أن نقبل المسيح في قلوبنا ونقتات به بالإيمان. والفعل الأول ضروري لحياة الجسد، والفعل الثاني ضروري لحياة النفس.
- كما أن الخبز المأكول يقوت أجسادنا، كذلك المسيح إذا قُبل بالإيمان يقيت نفوسنا. فالمسيح ليس مجرد الذبيحة لتبريرنا، بل هو أيضاً قوتٌ لنموِّنا في النعمة والقداسة. وجسد المسيح حياة العالم الروحية.
- إن أكلنا مع المسيح ومع بعضنا فإننا نشير إلى اتحادنا وشركتنا كأعضاء عائلة واحدة، مقترنين برأس واحد (١كورنثوس ١٠: ١٦) فالعشاء الرباني وليمة محبة للمسيح وتلاميذه. وعلى هذا يجب أن نمارس العشاء الرباني لمنفعته ومعناه.
هٰذَاِ أي الخبز.
هُوَ جَسَدِي في ذلك أمران: (١) ذلك الخبز رمزٌ إلى جسده، و(٢) إنه تذكار له. ولنا على أنه رمزٌ إلى جسد المسيح لا جسده حقيقة اثنا عشر برهاناً:
- العشاء الرباني سرٌّ، وفي كل سر رمزٌ ومرموز إليه. والخبز هو الرمز، وجسد المسيح المرموز إليه. فلو استحال الخبز وصار جسده، لم يبقَ رمزٌ، إنما يبقى المرموز إليه. فلا يكون العشاء حينئذٍ سراً.
- جسد المسيح الحقيقي كان أمامهم حياً، فلا يمكنهم أن يعتقدوا أنهم يأكلون جسده ويشربون دمه وهو لم يمُت بل كان يخاطبهم. وذلك ينافي أحكام عقولنا أن نعتقد أننا أكلنا جسد المسيح بعينه في العشاء الرباني، بينما ذلك الجسد بكماله في السماء. وإلا لكان للمادة خواص الروح، وللمحدود خواص غير المحدود.
- أخذ ذلك الخبز رمزاً يفيدنا بتعاليم جوهرية ويوافق قول المسيح «أَنَا هُوَ الْخُبْزُ الْحَيُّ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ. إِنْ أَكَلَ أَحَدٌ مِنْ هذَا الْخُبْزِ يَحْيَا إِلَى الأَبَدِ. وَالْخُبْزُ الَّذِي أَنَا أُعْطِي هُوَ جَسَدِي الَّذِي أَبْذِلُهُ مِنْ أَجْلِ حَيَاةِ الْعَالَمِ» (يوحنا ٦: ٥١). وقال ذلك قبل ما رسم العشاء الرباني بزمان طويل.
- اعتاد المسيح أن يستخدم المجاز في أغلب تعاليمه، وكثيراً ما حذر تلاميذه من أن يتخذوا المجاز حقيقة (يوحنا ٣: ٦٣). فلا شيء من الغرابة بأن يكون كلامه هنا مجازاً. ومن ذلك قوله «أَنَا هُوَ الْبَابُ» (يوحنا ١٠: ٩) و «أَنَا الْكَرْمَةُ الْحَقِيقِيَّةُ» (يوحنا ١٥: ١، ٥) وقوله «اَلزَّارِعُ الزَّرْعَ الْجَيِّدَ هُوَ ابْنُ الإِنْسَانِ. الزَّرْعُ الْجَيِّدُ هُوَ بَنُو الْمَلَكُوتِ. وَالزَّوَانُ هُوَ بَنُو الشِّرِّيرِ» (متّى ١٣: ٣٧، ٣٨). وقوله «تَحَرَّزُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَمِيرِ الْفَرِّيسِيِّينَ الَّذِي هُوَ الرِّيَاءُ» (لوقا ١٢: ١).
- أخذ ذلك الخبز رمزاً يوافق كل تعاليم الكتاب المقدس كقوله «الثَّلاَثَةُ الْقُضْبَانِ هِيَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، والثَّلاَثَةُ السِّلاَلِ هِيَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ» (تكوين ٤٠: ١٢، ١٨) وقوله «اَلْبَقَرَاتُ السَّبْعُ الْحَسَنَةُ هِيَ سَبْعُ سِنِينَ، وَالسَّنَابِلُ السَّبْعُ الْحَسَنَةُ هِيَ سَبْعُ سِنِينَ» (تكوين ٤١: ٢٦) وقوله «لأَنَّهُمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ مِنْ صَخْرَةٍ رُوحِيَّةٍ تَابِعَتِهِمْ، وَالصَّخْرَةُ كَانَتِ الْمَسِيحَ» (١كورنثوس ١٠: ٤) وقوله «لأَنَّ هَاجَرَ جَبَلُ سِينَاءَ فِي الْعَرَبِيَّةِ» (غلاطية ٤: ٢٥). وقوله «السَّبْعَةُ الْكَوَاكِبُ هِيَ مَلاَئِكَةُ السَّبْعِ الْكَنَائِسِ، وَالْمَنَايِرُ السَّبْعُ هِيَ السَّبْعُ الْكَنَائِسِ» (رؤيا ١: ٢٠) وقوله «نَحْنُ الْكَثِيرِينَ خُبْزٌ وَاحِدٌ» (١كورنثوس ١٠: ١٧) فلو صحَّ أن الخبز صار جسد المسيح بقوله «هذَا هُوَ جَسَدِي» لصحَّ أن أجساد المسيحيين صارت خبزاً بقوله «نَحْنُ الْكَثِيرِينَ خُبْزٌ وَاحِدٌ». وقِس على ذلك ما جاء في كثير من الأمثال (تكوين ١٥: ١ ومزمور ٣١: ٣ و٨٤: ١١ وحزقيال ٣٧: ١١ ويوحنا ١٠: ٧، ١١ وعبرانيين ١٢: ٢٩).
- إذا أخذنا قوله على الخبز حقيقة، وجب أن نأخذ قوله على الكأس كذلك، وكلاهما محال حتى عند القائلين بالاستحالة، لأنه إن كان قوله عن الخبز إنه جسده حقيقة وجب أن يكون له كل أعراض جسد المسيح، وإلا فهو مجاز لا حقيقة. والذين يعتقدون الاستحالة يقولون إن الخبز استحال إلى جسد المسيح دون أعراض هذا الجسد، فينفون ما يثبتون. ويلتزم أولئك المعتقدون التسليم بأن الكأس (لا الخمر التي فيها) صارت العهد الجديد بدم المسيح بدليل قوله «هذِهِ الْكَأْسُ هِيَ الْعَهْدُ الْجَدِيدُ بِدَمِي» (١كورنثوس ١١: ٢٥). ولم يقُل أحدٌ ذلك، وهو محال بنفسه. وإن سلمنا بالمحال وقلنا إن ذلك الخبز صار جسد المسيح، فالرغيف الذي كان في يده دون غيره، فليس الرغيف في الماضي ولا في المستقبل هو جسده.
- يدلنا على أن كلام المسيح هنا رمزي أنه بُني على كلام الكتاب في الفصح الذي هو رمزي بالإجماع، بدليل قوله عن خروف الفصح «تأكلون بعجلة. هو فصح للرب» أي الخروف رمز إلى الفصح أي عبور الملاك عن بيوت بني إسرائيل، ويستحيل أن يكون الخروف كذلك.
- يجب أخذ كلام المسيح مجازاً لأن الحقيقة تنافي شهادة الحواس. وإن قلنا: لا اعتبار لشهادة الحواس، لم يبقَ لنا شهادة صحيحة بمعجزات المسيح ورسله، ولا ثقة بقوله «هذا هو جسدي» لأن تلاميذه أدركوه بالسمع (وهو من الحواس) فلا تُعتبر شهادته ولا نثق بعيوننا حين نقرأه.
- يجب اتخاذ كلام المسيح عن الخبز مجازاً، لأن الحقيقة تخالف جوهر تعليم الإنجيل، لأنها تجعل الحياة الروحية متوقفة على تناول اللحم والدم بدلاً من أن تجعلها متوقفة على المؤثرات الروحية كالإيمان بالمسيح وفعل الروح القدس وفقاً لقوله «إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له» (رومية ٨: ٩).
- اتخاذ ذلك القول حقيقة يناقض قول بولس في خبز العشاء الرباني لأنه سماه «خبزاً» ثلاث مرات بعد أن باركه المسيح وكسره (١كورنثوس ١١: ٢٦ - ٢٨).
- اتخاذ ذلك القول حقيقة يلزم منه تكرار المعجزة في كل عشاء رباني، ويلزم منه أن كل شخص بقطع النظر عن صفاته الأخلاقية يستطيع عمل أعظم المعجزات.
- القول بالاستحالة يجعل العشاء الرباني ذبيحة، وهذا ينافي تعليم العهد الجديد لتصريحه بأن المسيح ذُبح مرة واحدة لأجل خطايا العالم (عبرانيين ٩: ٢٨ و١٠: ١٢ - ١٨).
وأما كون الخبز تذكاراً لجسد المسيح فعليه ثلاثة براهين:
- ما نقله لوقا عن المسيح وهو قوله «اِصْنَعُوا هذَا لِذِكْرِي» (لوقا ٢٢: ١٩)
- قول بولس في ما تسلمه من الرب «اِصْنَعُوا هذَا لِذِكْرِي.. فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَكَلْتُمْ هذَا الْخُبْزَ وَشَرِبْتُمْ هذِهِ الْكَأْسَ، تُخْبِرُونَ بِمَوْتِ الرَّبِّ إِلَى أَنْ يَجِيءَ» (١كورنثوس ١١: ٢٤ و٢٦).
- هذا السر بدل الفصح، وأكل الفصح تذكار للفصح الكبير الحقيقي (خروج ١٢: ١١).
٢٧ «وَأَخَذَ ٱلْكَأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ قَائِلاً: ٱشْرَبُوا مِنْهَا كُلُّكُمْ».
وَأَخَذَ ٱلْكَأْسَ اعتاد اليهود أن يشربوا في الفصح أربع كؤوس من الخمر. والأرجح أن الكأس المذكورة هنا هي الثالثة من الأربع، وهي تُشرب بعد أكل الخروف والأعشاب المرَّة والفطير (وتسمى كأس البركة) ودليل ذلك «تناولها بعد العشاء» (لوقا ٢٢: ٢٠ و١كورنثوس ١١: ٢٥).
وَشَكَرَ يجب علينا أن نشكر المسيح في كل عشاء رباني ونحن نذكر الفوائد التي كانت لنا من ذبيحته اقتداءً بالمفديين في السماء القائلين «مُسْتَحِق أَنْتَ أَنْ تَأْخُذَ السِّفْرَ وَتَفْتَحَ خُتُومَهُ، لأَنَّكَ ذُبِحْتَ وَاشْتَرَيْتَنَا للهِ بِدَمِكَ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَشَعْبٍ وَأُمَّةٍ، وَجَعَلْتَنَا لإِلهِنَا مُلُوكًا وَكَهَنَةً» (رؤيا ٥: ٩ و١٠). وسُمي العشاء الرباني لما فيه من تقديم الشكر «أفخارستيا» أي تقدمة الشكر.
وَأَعْطَاهُم أي الكأس كما أعطاهم الخبز، فلا شيء في عمله يدل على أن الكأس تختص بالرسل والخبز لهم ولغيرهم .
ٱشْرَبُوا مِنْهَا كُلُّكُم أمرهُ بذلك أعم من أمره بالخبز، فكأنه أراد أن يحذر كنيسته من ضلالة عرف أنها تحدث بعدئذٍ عند بعض الناس، وهي منع الكأس عن العامة.
٢٨ «لأَنَّ هٰذَا هُوَ دَمِي ٱلَّذِي لِلْعَهْدِ ٱلْجَدِيدِ ٱلَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ لِمَغْفِرَةِ ٱلْخَطَايَا».
خروج ٢٤: ٨ ولاويين ١٧: ١١وإرميا ٣١: ٣١ ومتّى ٢٠: ٢٨ ورومية ٥: ١٥ وعبرانيين ٩: ٢٢
هٰذَا هُوَ دَمِي أي رمز دمي وتذكاره كما جاء في أمر الجسد في شرح العدد ٢٦. وكان دم الحيوانات في القرون الماضية يرمز إلى دم المسيح. ومنذ ذلك الوقت صارت كأس العشاء الرباني أي خمرها تشير إليه (عبرانيين ٩: ١٣، ١٤).
ومعنى الدم هنا الحياة، وهو كذلك في تكوين ٩: ٤ ولاويين ١٧: ١٤. وكان دم المسيح دم حياته لأنه مات بسفكه، وهو دم ثمين، ودم ملكيٌّ، ودم زكي، ودم كفارة، ودم تقدمة اختيارية، ودم مقبول عند الله فداءً عن العالم.
ٱلَّذِي لِلْعَهْدِ ٱلْجَدِيدِ كانت العهود كلها تُثبَّت قديماً بسفك الدم (عبرانيين ٩: ١٩، ٢٠)، ولا اختلاف بين العهدين إلا في الواسطة. فالعتيق كان بدم الحملان على يد موسى (خروج ٢٤: ٨) والجديد كان بدم الحمل على يد المسيح (يوحنا ١: ٢٩) انظر للمقارنة بينهما ما ورد في غلاطية ٤: ٢١ - ٣١ وعبرانيين ٨: ٩ - ١٣ و١٠: ١٦ - ١٨ وقارن تثنية ٢٨: ١ و٣٠: ١٦ مع رومية ٧: ٢٥ و٨: ١). وفي العهد القديم تلميحات وإشارات إلى العهد الجديد (إرميا ٣١: ٣١ - ٣٤). أما دم خروف الفصح فرُشَّ على قائمتي الباب وعتبته، وأما دم المسيح فرُشَّ على قلوبنا. والملاك المُهلك جاوز بني إسرائيل ولم يُهلك أبكارهم لما رأى الدم. والله يتجاوز عنا في يوم الدين عند إهلاكه أصحاب القلوب التي لم تُرش بدم المسيح بنظره إلى هذا الدم.
ٱلَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ أي بدلاً من أن يسفك دمهم، والمراد بالكثيرين كل الذين يقبلون دم المسيح شرطاً لخلاصهم بموجب العهد الجديد. (متّى ٢٠: ٢٨ ورومية ٥: ١٥، ١٩ و١تيموثاوس ٢: ٦ وعبرانيين ٩: ٢٨ ورؤيا ٥: ١١ و٢٢: ١٧).
لِمَغْفِرَةِ ٱلْخَطَايَا أي لتحصيل الصفح عن الخاطئ. كان دم ذبائح العهد القديم يشير إلى ذلك الصفح ولم يحصله، لكن دم ابن الله الوحيد الكثير الثمن حصَّله (أعمال ٥: ٣١ وعبرانيين ٩: ٢٢) وذلك لثلاثة أسباب: (١) ذلك الدم جعل المغفرة ممكنة دون منافاة عدله وحقه، لأن المسيح مات بدل الخاطئ فأوفى العدل حقه وأثبت صدق الله. (٢) أنه جعل تلك المغفرة لائقة لأنه يطهر قلب الخاطئ ويزيل ميله إلى ارتكاب الإثم (١يوحنا ١: ٧ وتيطس ٢: ١٤). (٣) إنه يؤكد للخاطئ أن له مغفرة عند الله (مزمور ٣٠: ٤).
والتعليم المشار إليه بالخبز والكأس واحد، إلا أن الكأس توضح بعض أموره أكثر إيضاح. ومن ذلك أن المسيح مات على الصليب ذبيحة من أجل خطايانا (متّى ٢٠: ٢٨ ويوحنا ١: ٢٩ و١٢: ٢٤، ٣٢ و٣٣ و١٥: ١٣ ورومية ٣: ٢٥ و٥: ٦، ٨، ١٠ و١كورنثوس ١٥: ٣ وأفسس ٥: ٢ وعبرانيين ٧: ٢٢ و٩: ١٢، ١٦، ٢٦، ٢٨ و١٠: ١٠، ١٩ و١بطرس ٢: ٢٤ و١يوحنا ١: ٧ ورؤيا ١: ٥ و٥: ٩). ومنه أنه صار عهداً بين الله ويسوع، وهو أن الله يقبل موت المسيح بدلاً من الخاطئ، وبين المسيح والمؤمن به وهو أنه يقبله إذا آمن به وتاب. والكأس هي ختم هذا العهد. وفي أكل الخبز زيادة إيضاح لأمر ذي شأن، وهو أن المسيح يُشبع حياة الإنسان الروحية إذا قبله بالإيمان.
٢٩ «وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنِّي مِنَ ٱلآنَ لاَ أَشْرَبُ مِنْ نِتَاجِ ٱلْكَرْمَةِ هٰذَا إِلَى ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ حِينَمَا أَشْرَبُهُ مَعَكُمْ جَدِيداً فِي مَلَكُوتِ أَبِي».
رؤيا ١٩: ٧، ٩
إِنِّي مِنَ ٱلآنَ لاَ أَشْرَبُ أي إني لا أحضر معكم في هذا العشاء ثانية على الأرض بالجسد، لأني عازم أن أموت وتتم بموتي كل الرموز والإشارات. فهذا الفصح هو الفصح الأخير الذي آكله معكم. فعندما نجتمع في بيت أبي نشترك حينئذٍ في ما كان يشير إليه كل ما ذُكر.
نِتَاجِ ٱلْكَرْمَةِ أي الخمر، سمّاها كذلك بعد البركة، وهذا دليل على أنها لم تستحل إلى دمه. ومن المحال أن تستحيل إلى ذلك لأن كل قطرة من دمه كانت لا تزال تجري في عروقه.
ٱلْيَوْمِ أي الوقت
أَشْرَبُهُ مَعَكُمْ جَدِيداً الخ لم يُقصر العشاء الرباني على أن يكون بدلاً من فصح اليهود وتذكاراً لموت المسيح، بل كان أيضاً إيماءً وتلميحاً إلى وليمة عرس الحمَل في ملكوته السماوي وعربوناً لها. وأراد المسيح أن يتوقع المؤمنون به كلما تناولوا ذلك السر مجيئه الثاني بالجسد. فهو وليمة أرضية أشار بها المسيح إلى الوليمة السماوية. وأفراحنا الروحية هنا على مائدة الرب ظل للأفراح العلوية الدائمة. وقوله «أشربه» لا يلزم منه أن في السماء خمراً أو ما شابهها من المشتهيات الجسدية، ولا ولائم حقيقية هنالك. ولكن لأن الولائم تحل محل الأفراح والراحة بعد التعب والجهاد ومجتمع الأصحاب، ولأن الخمر كانت تُشرب في عيد الفصح فرحاً بالنجاة من عبودية مصر واعتياد شربها في كل الولائم في ذلك الوقت، استعارها المسيح كناية عن المسرات السماوية والفرح بالنجاة من رق الخطية. وأبان بقوله «معكم» أن كل تلاميذه يجتمعون به في السماء. وأشار بقوله «أشربه جديداً» إلى معناه الروحي. وأراد بقوله «ملكوت أبي» السماء حيث يملك بلا معارض.
٣٠ «ثُمَّ سَبَّحُوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ».
مرقس ١٤: ٢٦ الخ
سَبَّحُوا اعتاد اليهود أن يترنموا في آخر الفصح بمزموري ١١٥، ١١٦ فالأرجح أن المسيح وتلاميذه سبحوا الله بالترنيم بهما. ويظن أن المسيح في نحو ذلك الوقت بعد الترنيم أو قبله تحدَّث بما جاء في يوحنا ١٤ - ١٦، ثم صلاته المذكورة في يوحنا ١٧ منها. ويحسن أن يسبح الشعب ربَّه بترنيمات وتسابيح كلما اجتمعوا للعبادة، ولا سيما متّى اجتمعوا للعشاء الرباني وذكر الفوائد العظمى المتعلقة به.
خَرَجُوا إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ أي إلى بستان جثسيماني كما يدل عليه ما جاء في ع ٣٦.
وخلاصة ما ذُكر من أمر العشاء الرباني في عشر قضايا:
- رسم المسيح فريضة العشاء الرباني طقساً دائماً في كنيسته إلى أن يأتي ثانية، كما يتبين من أمره هنا. ومن قول بولس إنه «تسلَّم من الرب». فعلى كل المسيحيين ممارسة هذا السر (١كورنثوس ١١: ٢٦).
- لكل مسيحي نصيبٌ في فوائد موت المسيح، وهذا سبب ذكره ذلك الموت، في قوله «جسدي الذي أبذله لأجلكم» و «جسدي المكسور لأجلكم» و «دمي المسفوك لأجلكم».
- بُني ذلك السر على الفصح وحل محله، فذاك كان يذكر اليهود بنجاة أبكارهم من الهلاك الزمني، وهذا يذكر المسيحيين بالنجاة من الهلاك الأبدي لكل المفديين بموت المسيح فصحنا (رومية ٨: ٢ و١كورنثوس ٥: ٧) وهذا السر هو العلاقة بين النظام اليهودي والنظام المسيحي.
- هذا السر كما رسمه المسيح موافق جداً ليشخِّص أمامنا موت المسيح على الصليب،وليجعله مؤثراً فينا، لأن العناصر المحسوسة تعين النفس على إدراك الحقائق الروحية.
- يحضر المسيح مع شعبه روحياً كرئيس المتكأ كلما مارسوا العشاء الرباني بالطاعة والإيمان والتوبة والشكر، ويتحدون به اتحاداً مُحيياً. ويجدد لهم كل فوائد موته المُشار إليه بذلك السر وفوائد حياته في السماء. ولهذا يتضمن لنا أكثر مما تضمنه الفصح لليهودي التقي، لأن الفصح كان له مجرد تذكار ورمز، وأما العشاء الرباني فيزيد على ذلك بأنه اتحاد روحي حقيقي. فعلاوة على أنه إشارة إلى ما عمله المسيح لأجلنا فهو دلالة على أن المسيح حال فينا وفقاً لقول الرسول «مَعَ الْمَسِيحِ صُلِبْتُ، فَأَحْيَا لاَ أَنَا، بَلِ الْمَسِيحُ يَحْيَا فِيَّ. فَمَا أَحْيَاهُ الآنَ فِي الْجَسَدِ، فَإِنَّمَا أَحْيَاهُ فِي الإِيمَانِ، إِيمَانِ ابْنِ اللهِ، الَّذِي أَحَبَّنِي وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لأَجْلِي» (غلاطية ٢: ٢٠) وقوله «الَّذِينَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ مَا هُوَ غِنَى مَجْدِ هذَا السِّرِّ فِي الأُمَمِ، الَّذِي هُوَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ رَجَاءُ الْمَجْدِ» (كولوسي ١: ٢٧).
- لا تتوقَّف منفعة تناول هذا السر على كيفية ممارسته، ولا على ماهية الآنية التي يتناول منها، ولا على أن الخبز فطير أو خمير، ولا على رتبة خادم الدين، ولا على الكلمات التي ينطق بها لتخصيص الخبز والخمر بخدمة العشاء الرباني.. بل يتوقف على إيمان الذي يتناوله، لأنه كما أن الجسد يقتات بالخبز والخمر فيصيران جزءاً منه بالأكل والشرب، هكذا عندما نقبل بالإيمان خبز العشاء الرباني وخمره نصير شركاء جسد المسيح ودمه ونقتات به (١كورنثوس ١٠: ١٦).
- لا بد أن يُطحَن القمح قبل أن يؤكل خبزاً، ولا بد للعنب أن يُعصر قبل أن يُشرب خمراً. كذلك جسد المسيح لا يمكن أن يكون حياتنا ما لم يُسحق ويموت لأجلنا. وهذا ما يشير إليه استعمال الخبز والخمر في العشاء الرباني.
- العشاء الرباني، علاوة على ما ذُكر، إنباءٌ بوليمة عرس الحمل في السماء وظلٌ لها (ع ٢٩ ومرقس ١٤: ٢٥).
- رسم المسيح هذا السر لنذكر به موته لا حادثة أخرى من حوادث حياته الأرضية كميلاده أو تجليه أو صعوده. وأظهر بهذا أن موته هو الأمر الجوهري في دينه الذي يجب أن يؤمن به كل مسيحي ويستند عليه للخلاص.
- كلما مارس المسيحيون هذا السر شهدوا علناً بموت المسيح وخضوعهم للمصلوب وباتكالهم عليه، وهكذا «يخبرون بموته» كما أمر ١كورنثوس ١١: ٢٦ وشهدوا بأكلهم وشربهم مع غيرهم من المؤمنين أنهم إخوة في عائلة واحدة وأعضاء جسد واحد رأسه المسيح.
٣١ «حِينَئِذٍ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: كُلُّكُمْ تَشُكُّونَ فِيَّ فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ، لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: أَنِّي أَضْرِبُ ٱلرَّاعِيَ فَتَتَبَدَّدُ خِرَافُ ٱلرَّعِيَّةِ».
متّى ١١: ٦ ويوحنا ١٦: ٣٢ وزكريا ١٣: ٧
الأرجح أن الذي قاله المسيح هنا قاله وهو سائر إلى جثسيماني.
كُلُّكُمْ تنبأ قبل ذلك بأن واحداً من رسله يسلمه، وهذا خرج منهم (وهو يهوذا). وتنبأ هنا بأمرٍ يشترك فيه كل الباقين.
تَشُكُّونَ فِيَّ أي تقعون في أحوال يضعف بها إيمانكم بأني المسيح، حتى أنكم تستحون بي وتتركونني. وعلة شككم هو تسليمي إلى أعدائي على يد يهوذا وقبضهم عليَّ، وما يحدث لي من الإهانات ويصيبني من الآلام، خلاف ما كنتم تتوقعون أن يبلغه المسيح ابن الله.
فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ أي الليلة التي تناولوا فيها العشاء الرباني وسمعوا مواعظ المسيح الأخيرة. ففيها جُرِّبوا بإنكار المسيح، فسقطوا. كذلك يأتي يومٌ على المسيحيين يتجربون بأشد التجارب بعد أن يحصلوا على أحسن وسائط النعمة. ولا عجب أن صار الصليب عثرة للعالم، لأن رسل المسيح عثروا بظله قبل أن يُرفع المسيح عليه.
لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ في زكريا ١٣: ٧. علم الرب بسابق العلم ترك تلاميذه إياه وتمام تلك النبوة به. وفي الأصحاح الذي اقتبست تلك الآية منه إشارات كثيرة إلى المسيح وعمل الفداء منها ذكر فتح ينبوع للتطهير من الخطية، وذكر رجل في يده جروح جُرِح في بيت أحبائه، وذكر راعٍ هو رجل رفقة رب الجنود.
أَضْرِبُ ٱلرَّاعِيَ يحتمل أن يكون معنى هذا أن الله ضربه، أو أنه سلمه للضاربين (قارن خروج ٤: ٢١ مع خروج ٨: ١٥) وهو المراد هنا. وأجرى الله ذلك بسماحه لليهود والرومان أن يضربوه لأجل خطايا العالم (رومية ٨: ٣٢).
الراعي في هذه الآية هو المسيح كما يظهر من زكريا ١١: ٧ - ١٤. وأصل ما اقتبسه البشير في العبراني خطاب الله للسيف وأمره إياه بالضرب، ولا فرق بين الأصل والاقتباس في المعنى، فالاقتباس مجازٌ عقلي أُسند به الفعل إلى الآمِر. ومثله ما جاء في إشعياء ٥٣: ٤ - ١٠. فالذين ضربوه فعلوا باختيارهم ما قصد الله حدوثه، فلم يمكنهم ضربه لو لم يقضِ الله به.
خِرَافُ ٱلرَّعِيَّةِ المراد بالخراف هنا الرسل الذين هربوا عندما قُبض على المسيح كقطيع غنم مرتعب، وتطلق الخراف أحياناً على كل شعب الله (يوحنا ١٠: ١٦) ولعل المسيح أشار أيضاً بهذا القول إلى الأمة اليهودية التي كانت في الأصل رعية الله وتبددت منذ رفضت الراعي المضروب.
٣٢ «وَلٰكِنْ بَعْدَ قِيَامِي أَسْبِقُكُمْ إِلَى ٱلْجَلِيلِ».
متّى ٢٨: ٧، ١٠، ١٦ ومرقس ١٤: ٢٨ و١٦: ٧
بَعْدَ قِيَامِي قد أنبأ بقيامته مرتين قبل ذلك (متّى ١٦: ٢٠، ٢١ و٢٠: ١٩) وهذه هي المرة الثالثة. ولكن ليس هناك إشارة على أنهم أدركوا معنى هذا النبأ ولا أنهم تأثروا منه أكثر من ذي قبل.
أَسْبِقُكُم في هذا إشارة إلى عمل الراعي لخرافه فإنه «مَتَى أَخْرَجَ خِرَافَهُ الْخَاصَّةَ يَذْهَبُ أَمَامَهَا، وَالْخِرَافُ تَتْبَعُهُ» (يوحنا ١٠: ٤) وفيه إنباءٌ بأن الخراف وإن ضُرب الراعي وتبددت تُجمع أيضاً، وأنه سيجمع تلاميذه وإن تركوه. وقال ذلك ليكون تعزية لهم في وقت الحزن، وتشجيعاً لهم عند الخوف، وإعلاماً لهم أين يجدونه.
إِلَى ٱلْجَلِيلِ أمضى المسيح أكثر وقت تعليمه في الجليل، وآمن به هنالك أكثر تابعيه. والجليل وطن أكثر رسله، فمن الطبيعي أن يرجع إليه بعد قيامه. وما أجمل أن يعود تلاميذه إلى المكان الذي أخذهم منه لأن في ذلك قوة لهم هم بأمسِّ الحاجة إليها. ولكن عليهم أن يقيموا في مدينة أورشليم إلى أن يُلبسوا قوة من الأعالي، وبعد ذلك يتمم الوعد لهم. ولعله عيَّن حينئذٍ جبلاً قرب طبرية للاجتماع بهم (قابل متّى ٢٨: ١٦ مع يوحنا ٢١: ١). ولا يقتضي هذا أن المسيح خصص ذلك الاجتماع بالرسل وحدهم، ولعله جعله لكل المؤمنين به (لوقا ٢٤: ١٣ - ٣١، ٤١) لأن متّى قال في إنبائه بهذا الاجتماع إن بعض الحاضرين شكوا، فلا نظن أنهم من الرسل بعدما شاهدوه مراراً في أورشليم حياً بعد موته. والمرجح أن الاجتماع ضمَّ من يزيدون على ٥٠٠ أخ (١كورنثوس ١٥: ٦). وتعيينه الاجتماع العام في الجليل لا ينفي أن المسيح اجتمع أحياناً مع بعض تلاميذه في أورشليم قبل ذلك.
٣٣ «فَقَالَ بُطْرُسُ لَهُ: وَإِنْ شَكَّ فِيكَ ٱلْجَمِيعُ فَأَنَا لاَ أَشُكُّ أَبَداً».
وَإِنْ شَكَّ فِيكَ ٱلْجَمِيعُ يستنتج مما ورد في بشارتي متّى ومرقس أن بطرس تكلم بهذا بعدما خرجوا جميعاً من متكأ الفصح. لكن يظهر مما قاله لوقا ويوحنا أنه تكلم بذلك قبل خروجهم، فلعله قاله مرتين. ولا عجب إن كان المسيح يكرر التحذير لبطرس مرتين، فكرر بطرس إنكار شكه فيه كذلك. ومما يقوي ذلك أن التحذير الذي ذكره متّى ليس هو التحذير الذي ذكره لوقا (قارن هذا العدد مع لو ٢٢: ٣١، ٣٢)
لم يلتفت بطرس إلى ما في كلام المسيح من التعزية والوعد، بل إلى ما هو محزن فيه، فجاء جوابه كما يأتي:
فَأَنَا لاَ أَشُكُّ أظهر بطرس في هذا محبته للمسيح، كما أظهر مبادرته المعتادة إلى الرد السريع، والجسارة، وإظهار اتكاله على نفسه، وجهله بضعفه وكبريائه التي جعلته يظن أنه أثبت من سائر التلاميذ. فكان سقوطه سبيلاً له إلى أن يعلم أنه قابل السقوط. وكان على بطرس أن يتيقن ذلك في إنباء المسيح وليسأل الله المعونة. وذكر لوقا هنا أكثر مما ذكره متّى في شأن هذا الحديث (لوقا ٢٢: ٣١، ٣٢).
ولنا مما ذكر أربع فوائد: (١) العزم الشديد على تجنب الخطية لا يكفي ليمنع الإنسان من ارتكابها، وكذلك النذر والوعد وإن ختمه بدمه. (٢) لا أحد يعرف ضعفه وما سيرتكبه قبل أن يُجرَّب. (٣) قد يترك الله المسيحيين الحقيقيين يقعون في الخطايا الفظيعة ليعلِّمهم ضعفهم. (٤) يجب أن نسأل الله أن يعيننا على الدوام (٢كورنثوس ١٢: ٩، ١٠ وفي ٢: ١٢، ١٣ و٤: ١٣).
٣٤ «قَالَ لَهُ يَسُوعُ: ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنَّكَ فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ دِيكٌ تُنْكِرُنِي ثَلاَثَ مَرَّات».
مرقس ٤: ٣٠ ولوقا ٢٢: ٣٤ ويوحنا ١٣: ٣٨
يَصِيحَ دِيكٌ يحتمل صياح الديك ثلاثة معانٍ:
- الهزيع الأول من الليل المعروف عادة عند اليهود، كما يظهر من قول المسيح «لأَنَّكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ مَتَى يَأْتِي رَبُّ الْبَيْتِ، أَمَسَاءً، أَمْ نِصْفَ اللَّيْلِ، أَمْ صِيَاحَ الدِّيكِ، أَمْ صَبَاحًا» (مرقس ١٣: ٣٥).
- وقت من الوقتين اللذين اعتاد الديك أن يصيح فيهما. أولهما نحو نصف الليل، والثاني قرب الفجر.
- صياح الديك معين كما جاء في قوله «اللَّيْلَة قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ الدِّيكُ مَرَّتَيْنِ» (مرقس ١٤: ٣٠). فوجه الاختلاف بين البشيرين في هذا النبأ تُدفع بأن أحدهم أراد بصياح الديك أحد تلك المعاني، والآخر غيره. والظاهر أن متّى ويوحنا قصدا بصياح الديك قسماً من الليل، ومرقس ولوقا قصدا به صياح الديك حقيقة، لأنهما ذكرا أن الديك صاح مرتين. وذكر هذه النبوة الإنجيليون الأربعة. ولما تمت كانت دليلاً قاطعاً على أن المسيح يعلم الغيب بذاته فهو إله.
تُنْكِرُنِي ثَلاَثَ مَرَّات ظن بطرس أن إنكاره إياه ولو مرة واحدة محال، فقال المسيح له إنه ينكره ثلاث مرات. أي ينكر معرفته إياه كما جاء ذلك في إنباء المسيح (لوقا ٢٢: ٣٤) وفي إنكار بطرس (متّى ٢٦: ٧٤). وهو يتضمن إنكار أنه من تلاميذه (لوقا ٢٢: ٥٨). وهذا الإنكار ليس إلا إنكار إيمانه بأن المسيح ابن الله، وهو منافٍ لإقراره السابق (متّى ١٦: ١٦) وإثمٌ عظيم كان يمكن أن يهلكه، لولا توبته (لوقا ١٢: ٩). على أن كثيرين تمثلوا ببطرس في إنكار المسيح وقت الضيق ونسيان نذورهم.
٣٥ «قَالَ لَهُ بُطْرُسُ: وَلَوِ ٱضْطُرِرْتُ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ لاَ أُنْكِرُكَ! هٰكَذَا قَالَ أَيْضاً جَمِيعُ ٱلتَّلاَمِيذِ».
كان يجب أن يصدق بطرس أن المسيح يعرفه أكثر مما يعرف هو ذاته، لكنه ثبت على كلامه وزاد عليه. إنه يسهل على الإنسان ذكر الموت بشجاعة والموت بعيدٌ عنه، لكنه متّى لاقى الموت وجهاً لوجهٍ جَبُنَ وخاف أشد الخوف. فالاتكال على النفس مقدمة السقوط (أمثال ١٦: ١٨ و١كورنثوس ١٠: ١٢).
جَمِيعُ ٱلتَّلاَمِيذِ أظهر تأكيد بطرس أنه أمين للمسيح، فاقتدى به سائر الرسل، لكنهم جميعاً تركوا معلمهم وهربوا عند اقتراب الخطر (ع ٥٦). ولم يجبهم المسيح شيئاً على قولهم بل ترك الأمر إلى العاقبة لتظهر صدق قوله وقدر أمانتهم.
٣٦ «حِينَئِذٍ جَاءَ مَعَهُمْ يَسُوعُ إِلَى ضَيْعَةٍ يُقَالُ لَهَا جَثْسَيْمَانِي، فَقَالَ لِلتَّلاَمِيذِ: ٱجْلِسُوا هٰهُنَا حَتَّى أَمْضِيَ وَأُصَلِّيَ هُنَاكَ».
مرقس ١٤: ٣٢ الخ ولوقا ٢٢: ٣٩ الخ ويوحنا ١٨: ١
ضَيْعَةٍ أي أرض مزروعة، والمقصود بها هنا أرض محاطة بسياج، فيها أشجار زيتون وغيره، لأنها سُميت أيضاً بستاناً (يوحنا ١٨: ١، ٢٦) وكانت في جبل الزيتون. واسمها في العبراني جثسيماني. وكانت صالحة للتنزه والانفراد. ويحتمل أن صاحبها كان صديقاً ليسوع لأنه اعتاد أن يذهب إليها مع تلاميذه (لوقا ٢٢: ٣٩، ٤٠).
جَثْسَيْمَانِي كلمة عبرانية معناها «معصرة زيت» وهي شرق أورشليم على سفح جبل الزيتون الغربي (لوقا ٢٢: ٣٩) بينها وبين أورشليم وادي قدرون (يوحنا ١٨: ١). «وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ يَعْرِفُ الْمَوْضِعَ، لأَنَّ يَسُوعَ اجْتَمَعَ هُنَاكَ كَثِيرًا مَعَ تَلاَمِيذِهِ» (يوحنا ١٨: ٢).
وغاية المسيح في ذهابه إلى ذلك البستان هي أن يقوي نفسه بالصلاة لأجل آلامه المستقبلة، وأن يحتمل هناك بعض تلك الآلام التي يجب أن يحتملها، وأن يعطي أعداءه فرصة لأن يمسكوه بلا هياج ولا ضرر لتابعيه. وما عمله المسيح مثال لنا لنلجأ إلى الله وقت التجربة بالصلاة.
لِلتَّلاَمِيذِ أي لثمانية منهم.
ٱجْلِسُوا هٰهُنَا الأرجح أن المكان الذي أمرهم بالجلوس فيه كان قرب مدخل البستان، ووجودهم هناك كان مانعاً من أن يباغت المسيح أحدٌ وهو يصلي. وأشار بقوله «ههنا» إلى محل منفرد تحت أشجار البستان.
هُنَاكَ أي داخل البستان
٣٧ «ثُمَّ أَخَذَ مَعَهُ بُطْرُسَ وَٱبْنَيْ زَبْدِي، وَٱبْتَدَأَ يَحْزَنُ وَيَكْتَئِبُ».
متّى ١٤: ٢١ و١٧: ١ ولوقا ٨: ٥١
وأَخَذَ مَعَهُ أي انفرد بالتلاميذ الثلاثة المذكورين هنا دون سائر الرسل.
بُطْرُسَ وَٱبْنَيْ زَبْدِي أي يعقوب ويوحنا (متّى ١٠: ٢) وكان قد اختار هؤلاء الثلاثة ليشهدوا مجده الإلهي على جبل التجلي. واختارهم هنا شهود آلام نفسه وتواضعه لأنه قرَّبهم منه تعزية لهم. واحتياجه إلى مثل هذه التعزية دليل واضح على شدة حزنه واضطرابه.
وَٱبْتَدَأَ يَحْزَنُ وَيَكْتَئِبُ لا نقدر أن ندرك علة اكتئاب المسيح في البستان كل الإدراك، فهو من أسرار الفداء. ولا بد أنه احتمل هناك جزءاً من الآلام التي كان يجب أن يحتملها في فداء الخطاة، فوفَّى حينئذٍ بعض الدَّين الذي على الخطاة لشريعة الله، ووفَّى ما بقي منه وهو معلق على الصليب (إشعياء ٥٣: ٤ - ٦). وحَمل وقتئذٍ خطايا العالم، وحزن واكتأب من عظمة ثقل ذلك الحمل.
والأرجح أن الشيطان رجع إليه في ذلك الوقت يحاربه جديداً بأشد التجارب، لأن جزءاً من غلبة المسيح لأجلنا هو محاربته الشيطان عنا.
ولأن إبليس الذي هو الحية العتيقة علم أن وقته قصير، فجمع كل قواه للهجوم الأخير على «نسل المرأة» ليمنعه من إتمام عمله العظيم، لأن ما بقي من حياته الأرضية كان «ساعة أعدائه وسلطان الظلمة» (لوقا ٢٢: ٥٣). وهذا معنى قوله «لأَنَّ رَئِيسَ هذَا الْعَالَمِ يَأْتِي وَلَيْسَ لَهُ فِيَّ شَيْءٌ.. قُومُوا نَنْطَلِقْ مِنْ ههُنَا (أي إلى جثسيماني)» (يوحنا ١٤: ٣٠، ٣١).
ولعل طبيعته الإنسانية حُرمت حينئذٍ من تعزية الأب الذي حجب عنه وجهه كما حصل له وهو على الصليب. وذلك كان أشد عذاب له، ولكنه كان ضرورياً لاحتمال القصاص عن الخطاة. هذا مع معرفته كل حوادث الصلب قبل حدوثها من آلام الجسد والنفس، من خيانة أحد تلاميذه، وإنكار غيره له، وترك الجميع إياه، وكل ما جلبه عليه حسد الرؤساء وبغضهم من الإهانة وقسوة الرومان عليه وهزئهم به وضربهم إياه، واضطراب نفسه وآلام جسده على الصليب.
٣٨ «فَقَالَ لَـهُمْ: نَفْسِي حَزِينَةٌ جِدّاً حَتَّى ٱلْمَوْتِ. اُمْكُثُوا هٰهُنَا وَٱسْهَرُوا مَعِي».
مزمور ٥٥: ٤، ٥ ويوحنا ١٢: ٢٧
تألم المسيح لأجل الخطاة كل مدة حياته الأرضية، لكن آلامه زادت في تلك الساعة كثيراً.
حَتَّى ٱلْمَوْتِ المراد بذلك أنه اشتد حزنه كثيراً حتى كادت قواه الإنسانية لا تحتمله. ولربما لم يستطع احتماله، أو لم يأته ملاك من السماء يقويه (لوقا ٢٢: ٤٣)، أو أن آلامه كانت حينئذٍ مثل آلام الموت. ومما يعرف أن الناس قد يموتون من مجرد الحزن الشديد. فإذا كانت أحزان الإنسان الخاصة كافية لإماتته أحياناً، فكم بالأحرى تكون أحزان عالم الخطاة في قلب شخص واحد. قال لوقا «صَارَ عَرَقُهُ كَقَطَرَاتِ دَمٍ نَازِلَةٍ عَلَى الأَرْضِ» (لوقا ٢٢: ٤٤).
اُمْكُثُوا هٰهُنَا عيَّن المسيح لهم مكاناً يلبثون فيه وهو يبعد عنهم قليلاً. وذلك ليدفع عنهم ما يلحقهم من الألم بمشاهدتهم آلامه، أو أنه فضَّل أن يحتمل تلك الآلام بدون أن تراه عينٌ بشرية.
ٱسْهَرُوا مَعِي كإنسانٍ شعر باحتياجه إلى أن يشاركه غيره من البشر في شدة أحزانه، فتعزى قليلاً بقرب أولئك الأصحاب الأعزاء من البشر. لذلك سألهم أن يمكثوا بالقرب منه، وأمرهم أن يسهروا لأن ذلك يُظهر مشاركتهم له في الحزن، لأن النوم دليل على عدم الاكتراث بمصابه، ولأن سهرهم وقاية من مباغتة الأعداء له.
٣٩ «ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِيلاً وَخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي قَائِلاً: يَا أَبَتَاهُ، إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِّي هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ، وَلٰكِنْ لَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ».
عبرانيين ٥: ٧ ومتّى ٢٠: ٢٢ ويوحنا ١٢: ٢٧ ويوحنا ١٥: ٣ و٦: ٣٨ وفيلبي ٢: ٨
تَقَدَّمَ قَلِيلاً أي «انفصل عنهم نحو رمية حجر» (لوقا ٢٢: ٤١) وذلك ليجاهد في الصلاة بأكثر حرية. ولم يكن البعد بينه وبين التلاميذ الثلاثة كافياً لمنعهم في يقظاتهم بين نوماتهم المتوالية أن ينظروه تارة جاثياً على الأرض وطوراً مطروحاً عليها، وأن يسمعوا أجزاءً من صلواته لله. وعلى ذلك قيل في الرسالة إلى العبرانيين «الذين في أيام جسده إذ قدَّم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلِّصه من الموت» (عبرانيين ٥: ٧).
فخيرٌ لكل مسيحي أن ينفرد عن الناس للصلاة الشخصية، لأنه وقتها يستطيع أن يعبِّر عن أفكاره بحرية ويظهر تضرعاته واعترافه وهمومه ومخاوفه وآماله وطلباته لأجل غيره.
خَرَّ عَلَى وَجْهِه قال لوقا إنه جثا على ركبتيه. فلا بد من أنه خرَّ على وجهه بعد أن جثا من شدة تضرعه إلى الله.
يَا أَبَتَاهُ حُجب عن نفسه النور السماوي، ومع كل ذلك لم يشك في بنوته لله ومحبة الآب له. كذلك يعزينا نحن أحسن التعزية في أوقات الأحزان أن نعتبر الله أباً لنا، ونخاطبه باعتبار أنه كذلك، ذاكرين أنه «كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه» (مزمور ١٠٣: ١٣).
إِنْ أَمْكَنَ زاد مرقس على هذا قول يسوع «يَا أَبَا الآبُ، كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لَكَ» (مرقس ١٤: ٣٦) واقتبس لوقا قوله «إن شئت» (لوقا ٢١: ٤٢). أراد المسيح أن يزيل شدة مرارة الكأس التي كان يشربها، إن كان ممكناً أن تتم إرادة الآب بدونها، لأن إرادة المسيح كانت خاضعة لإرادة أبيه. نعم إن الله على كل شيء قدير، لكنه لا يخالف قضاءه الأزلي. وعدم مخالفته لذلك لا ينافي قدرته. فمراد المسيح بقوله «إن أمكن» إنه إن صحَّ بموجب عدل الله وصدقه وقداسته تخليص الخطاة بدون الآلام التي بدأ حينئذٍ يحتملها، فإنه يرغب في ذلك.
لْتَعْبُرْ عَنِّي لو عبرت الكأس عن المسيح لشربها الخطاة كلهم إلى الأبد، لأنه لا بد من أن يشربها إما هو أو الذين ناب عنهم.
هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ أي كأس الكفارة والموت (قارن هذا مع متّى ٢٠: ٢٢) وهي تشتمل على الآلام التي يجب أن يحتملها ليكفر عن آثام البشر. وينبغي أن نعلم أنه أشار بذلك إلى آلامه النفسية لا إلى آلامه الجسدية، لأن ما قاله لتلاميذه سابقاً في شأن موته ينفي ظنَّ خوفه من الموت الجسدي، ويدل على ذلك أيضاً أنه حين جُلد وصُلب وتألم لم ينزعج البتة. ويستحيل أن ابن البار يخاف من تسليم روحه عند الموت إلى يدي أبيه.
إن كأس آلام المسيح هي كأس خلاصنا، شرب كل ما فيها من المر وملأها لنا ابتهاجاً. فإن كانت كأس الأحزان لم تعبر عن ابن الله وهو يسأل ذلك، فهل يحقُّ لنا أن نتذمر إذا طلبنا منه رفع كأس الحزن عنا ولم تُرفع. على أن صلاة المسيح لم تكن عبثاً، لأن الله أجابه بمد يد المساعدة ليقويه على احتمال آلامه (عبرانيين ٥: ٧ ولوقا ٢٢: ٤٣). وسبب أنه لم يُجِز عنه تلك الكأس أنه لا طريق للخلاص بغير أن يشربها، لأن محبة الله لابنه تمنع تعذيبه بلا لزوم. فإنه لعظمة شفقته على البشر الساقطين لم يشفق على ابنه (رومية ٨: ٣٢).
لَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنَا كان المسيح إنساناً تاماً كما كان إلهاً تاماً.. فكانت له مشيئة إلهية. وكان قابلاً للوجع والحزن والضعف والخوف الذي يختص بالطبيعة البشرية (عبرانيين ٤: ١٥ و٥: ١). وقوله «لَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنَا» من جملة أقواله باعتبار أنه إنسان عليه حمل أكثر ما تستطيع طبيعته البشرية حمله. ولا ريب في أن الطبع البشري يطلب في مثل أحوال المسيح تخفيف ذلك إن أمكن، لأن مثل آلام المسيح مما يستحيل أن تختاره طبيعة بشرية. وحاشا للمسيح باعتباره إلهاً وإنساناً معاً أن يكون قد تحول ولو قليلاً في تلك الساعة عن قصده بالموت عن خطايا العالم أو الندم على ذلك.
بَلْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ بقيت طبيعته البشرية في كل ما اختارته أو رفضته ثابتةً في الخضوع لإرادة الآب (مزمور ٤٠: ٦، ٧ ويوحنا ٤: ٣٤)، فلم يكن يريد شيئاً منافياً لإنجاز عهد الفداء. ويظهر من قوله هنا انتصار الروح على الجسد، أي غلبة الروح النشيط الصبور الخاضع لإرادة الآب على الجسد الذي هو محدود القوة على احتمال الآلام. ونحن نظهر مشابهتنا للمسيح بإخضاع مشيئتنا لإرادة الله، وشربنا بالصبر كل كأس من كؤوس الحزن يضعها الآب بيدنا، وإلا فليس لنا روح المسيح ونحن ليس له.
بين أقوال المسيح التي ذكرها متّى ومرقس ولوقا من صلواته فرق زهيد، ولعل سبب ذلك أن كلاً منهم قصد إيراد المعنى لا الألفاظ بعينها. ولا يبعد عن الظن أن المسيح في صلواته الطويلة المكررة نطق بكل الكلمات التي ذكرها الإنجيليون وغيرها أيضاً. فذكر كل إنجيلي ما عرف منها أو استحسنه بحسب غايته.
٤٠ «ثُمَّ جَاءَ إِلَى ٱلتَّلاَمِيذِ فَوَجَدَهُمْ نِيَاماً، فَقَالَ لِبُطْرُسَ: أَهٰكَذَا مَا قَدِرْتُمْ أَنْ تَسْهَرُوا مَعِي سَاعَةً وَاحِدَةً؟».
ٱلتَّلاَمِيذِ أي الثلاثة: بطرس ويعقوب ويوحنا، وأتى إليهم للتعزية وليحذرهم من خطر التجربة.
فَوَجَدَهُمْ نِيَاماً قال لوقا إنهم ناموا حزناً (لوقا ٢٢: ٤٥). وقد أثبت الأطباء أن الحزن الشديد وتوقع الموت يجلب النوم الثقيل. ولكن يختلف تأثير ذلك باختلاف الطباع، فإنه يوقظ البعض وينيم البعض الآخر. وتخلَّص التلاميذ من شدة الحزن بالنوم، ولكن المسيح غلب الحزن بالصلاة. وكان فعلهم في تلك الساعة كفعلهم في جبل التجلي، لأنهم ناموا حينئذٍ والمسيح يصلي. ولا عجب من أن التلاميذ ناموا لأنه كان نحو نصف الليل.
فَقَالَ لِبُطْرُسَ وجَّه المسيح كلامه إلى بطرس لأن بطرس سبق ووعد بالمحبة للمسيح والثبوت فيها أكثر مما وعد بهما باقي الرسل.
أَهٰكَذَا مَا قَدِرْتُمْ أَنْ تَسْهَرُوا مَعِي كأنه قال: إن لم تستطيعوا مقاومة النوم فكيف تستطيعون مقاومة التجارب العظمى؟ قلتم إنكم مستعدون أن تموتوا معي، أفلا تقدرون أن تسهروا قليلاً معي في ضيقتي؟
سَاعَةً وَاحِدَةً لا دليل لنا على أن المسيح أراد بالساعة معناها الحقيقي، وأنها نفس الزمن الذي مضى عليهم وهم نائمون، أو أنه أراد بها «وقتاً قصيراً». وفي السؤال إظهار حزنه لنومهم وتعجُّبه منه، وتبكيته لهم عليه لأنهم لم يشعروا بالخطر المحيط بسيدهم وبهم أيضاً. ولأنهم نسوا مواعيدهم منذ عهد قصير، ولأنهم لم يظهروا المشاركة التامة له في الحزن. ولا شك في أنه زاد حزناً لما رآهم نائمين بعد ما طلب منهم أن يسهروا معه.
٤١ «اِسْهَرُوا وَصَلُّوا لِئَلاَّ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ. أَمَّا ٱلرُّوحُ فَنَشِيطٌ وَأَمَّا ٱلْجَسَدُ فَضَعِيفٌ».
مرقس ١٣: ٣٣ و١٤: ٣٨ ولوقا ٢٢: ٤٠، ٤٦ وأفسس ٦: ١٨.
اِسْهَرُوا وَصَلُّوا ذكر المسيح واجبين ينبغي أن يقترنا معاً، فكان عليهم أن يسهروا لأنهم كانوا حينئذٍ عُرضة لتجارب عظيمة، وليكونوا مستعدين لدفعها في أول هجومها وهم صاحون منتبهون. وعليهم أن يصلوا، أي أن يطلبوا معونة الله، لأن من الحماقة أن يحارب الإنسان الشيطان بدون طلب المعونة الإلهية. فيجب علينا أن نلجأ إلى الله في أول قدوم التجربة.
لِئَلاَّ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ ومعنى ذلك كمعنى الطلبة السادسة في الصلاة الربانية. فأراد أن يسهروا ويصلوا لئلا تغلبهم التجربة. والتجربة التي كانوا معرَّضين لها حينئذٍ هي فقدان ثقتهم بالمسيح وتركهم إياه عند زوال أمانيهم وآمالهم الأرضية. ولا يليق بأحد أن يدخل في التجربة اختيارياً لأن المسيح نفسه لم يدخل في التجربة إلا لما أصعده الروح (متّى ٤: ١).
أَمَّا ٱلرُّوحُ فَنَشِيطٌ أي ميلكم إلى السهر معي وإلى كل خدمة لي أمر حسن. قال ذلك وهو عالم أن بطرس سينكره والكل يتركونه، لأنه تأكد أنهم يحبونه وأنهم عازمون على أن يكونوا أمناء له وثابتين في الإيمان به. وإنهم قالوا بإخلاص إنهم مستعدون أن يمضوا معه إلى السجن وإلى الموت (لوقا ٢٢: ٣٣ ومتّى ٢٦: ٣٥). ولكن مجرد الميل الحسن إلى الصلاح لا يتكفل بحفظ الإنسان (سواء كان رسولاً أو غيره) من الوقوع في الخطية عند التجربة.
وَأَمَّا ٱلْجَسَدُ فَضَعِيفٌ المراد بالجسد هنا الانفعالات البشرية التي تجعل الإنسان ينفر من الألم والعار والخطإ وتعرُّض الروح للتجربة. وذكَّر المسيح رسله بضعف أجسادهم لا ليعذرهم على نومهم بل ليحثَّهم على السهر والصلاة. ومن اقتران الروح النشيط بالجسد الضعيف في المسيحي تحدث فيه المحاربة بين الطبيعتين الروحية والجسدية (رومية ٧: ٢١ - ٢٥). «لأن الجسد يشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر» (غلاطية ٥: ١٧) ولكن روح المسيح النشيط غلب الجسد الضعيف وقت التجربة. وأما الرسل فجسدهم الضعيف غلب روحهم النشيط حينئذٍ.
٤٢ «فَمَضَى أَيْضاً ثَانِيَةً وَصَلَّى قَائِلاً: يَا أَبَتَاهُ، إِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ تَعْبُرَ عَنِّي هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ إِلاَّ أَنْ أَشْرَبَهَا فَلْتَكُنْ مَشِيئَتُكَ».
فَمَضَى أَيْضاً ثَانِيَةً وَصَلَّى قال لوقا إنه «كَانَ يُصَلِّي بِأَشَدِّ لَجَاجَةٍ، وَصَارَ عَرَقُهُ كَقَطَرَاتِ دَمٍ نَازِلَةٍ عَلَى الأَرْضِ» (لوقا ٢٢: ٤٤).
أظهر متّى أن الفرق بين صلاة المسيح الأولى وصلاته الثانية، في زيادة تسليم إرادته إلى إرادة الآب، لأنه لم يسأل في الثانية أن تعبر الكأس عنه بل أن تكون له القدرة على إتمام إرادته تعالى. وأجاب الله صلاته كما أجاب صلاة بولس بأن أعانه على التجربة (٢كورنثوس ١٢: ٨ - ١٠) ومجيء الملاك لمساعدته كما قال لوقا دليل على أن طبيعة المسيح الإلهية لم تساعد طبيعته البشرية في وقت آلامه، لأن المسيح تألم كأحد البشر، واحتاج إلى تعزية بشرية كسائر الناس وإلى الضروريات الجسدية من مستلزمات القوت والكسوة وما أشبههما، وقوَّت الملائكة طبيعته البشرية كغيره من الأتقياء (عبرانيين ١: ٧).
٤٣ «ثُمَّ جَاءَ فَوَجَدَهُمْ أَيْضاً نِيَاماً، إِذْ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ ثَقِيلَةً».
لم يكف توبيخ المسيح للرسل وأمره إياهم بالسهر أن يمنعهم من النوم الذي تسلط عليهم. ولم يذكر متّى أن المسيح أيقظهم ولا أنه تركهم نائمين. لكن نستنتج من مرقس أنه أيقظهم، ولم يستطيعوا أن يجيبوه بشيءٍ لفرط ما عراهم من الخجل (مرقس ١٤: ٤٠).
٤٤ «فَتَرَكَهُمْ وَمَضَى أَيْضاً وَصَلَّى ثَالِثَةً قَائِلاً ذٰلِكَ ٱلْكَلاَمَ بِعَيْنِهِ».
تكرار الصلاة لفرط الأشواق القلبية ليس بالتكرار الباطل الذي نهى المسيح عنه (متّى ٦: ٧) ولا ريب في أن الله أجاب صلوات المسيح بمنحه القوة على احتمال كل ما كان عليه من الآلام، وهو وفق قول الكتاب «الَّذِي، فِي أَيَّامِ جَسَدِهِ، إِذْ قَدَّمَ بِصُرَاخٍ شَدِيدٍ وَدُمُوعٍ طَلِبَاتٍ وَتَضَرُّعَاتٍ لِلْقَادِرِ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنَ الْمَوْتِ، وَسُمِعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ تَقْوَاهُ» (عبرانيين ٥: ٧). ونحن عندما نصرخ إلى الله في بليَّة يهبنا القوة على احتمالها بالصبر والنعمة، لنستفيد منها استجابةً لصلواتنا التي ندعوه فيها لرفع تلك البلية عنا.
٤٥، ٤٦ «٤٥ ثُمَّ جَاءَ إِلَى تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ لَهُمْ: نَامُوا ٱلآنَ وَٱسْتَرِيحُوا. هُوَذَا ٱلسَّاعَةُ قَدِ ٱقْتَرَبَتْ، وَٱبْنُ ٱلإِنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَى أَيْدِي ٱلْخُطَاةِ. ٤٦ قُومُوا نَنْطَلِقْ. هُوَذَا ٱلَّذِي يُسَلِّمُنِي قَدِ ٱقْتَرَب».
إِلَى تَلاَمِيذِهِ ليس إلى الثلاثة فقط بل إلى الثمانية الآخرين أيضاً. ولم يظهر من كلامه هنا المعنى الذي قصده في خطابه لهم، لكن مقتضيات الحال توضحه، فإن المسيح كان يتوقع مجيء يهوذا الخائن بفرقة من العسكر ليقبض عليه، فوضع بعض تلاميذه قرب مدخل البستان كحراس يحفظونه من هجوم الأعداء عليه بغتة. وأخذ معه البعض وأمرهم بالسهر والصلاة، ثم انفصل عنهم قليلاً وصلى سائلاً الآب دفع تلك التجربة عنه إن أمكن، وإلا فيمنحه قوةً على احتمالها. فكانت نتيجة صلواته أنه تأكد أن عبور تلك الكأس عنه غير ممكن، ولكنه نال قدرةً على شربها، ولذلك امتنع عن طلب عبورها عنه، واستعد لاحتمال كل ما كان عليه أن يقوم به، فأنبأ تلاميذه بأنه لا حاجة إلى أن يسهروا ويصلوا معه بعد، وإن فرصة مساعدتهم له على مقاومة التجربة قد مضت.
وقد قصد المسيح بقوله «نَامُوا ٱلآنَ وَٱسْتَرِيحُوا» إعفاءهم مما أمرهم به في ع ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤١. وأباح لهم الراحة والنوم بدون تقييد بوقت معين فكأنه قال: لم يبقَ داعٍ لسهركم وصلاتكم معي، وإن فعلتم ذلك لا ينفعني الآن شيئاً. فإذاً ناموا واستريحوا متّى تريدون وبقدر ما تشتهون.
ٱلسَّاعَةُ قَدِ ٱقْتَرَبَتْ مضت ساعة السهر والصلاة التي ذُكرت في ع ٤٠ وأتت ساعة الآلام.
قُومُوا المرجح أن المسيح قال ذلك عند ابتداء ظهور «الجمع الكثير بالسيوف والعصي والمصابيح» والخلاف بين قوله هنا وقوله قبلاً «ناموا واستريحوا» لفظيٌ لا معنويٌ، لأن المقصود بأمره لهم بالنوم والاستراحة إباحة عدم السهر والصلاة لمنع الأعداء عنه ولنوال القوة له ولهم. وقال بعضهم إن قصد المسيح بقوله «ناموا واستريحوا» هو التعجب والاستغراب. فكأنه قال لهم: أهذا وقت النوم والراحة ومعلمكم يُسلَّم إلى الأعداء؟.. وهذا وفق قوله «لماذا أنتم نيام؟» (لوقا ٢٢: ٤٦) أي هذا وقت الانتباه والعمل لا وقت النوم والراحة.. قوموا ننطلق. وقال آخرون إنه أذن لهم في النوم والاستراحة بذلك القول على تقدير قوله «إن قدرتم» فيكون المقصود: أنا لا أمنعكم من النوم إن لم يمنعكم الأعداء، لكنهم لا بد أن يمنعوكم لأن الخائن قريبٌ منا. وقال البعض إنه مضت مدة بين قوله «ناموا واستريحوا» وبين قوله «قوموا ننطلق» وقد تركهم يسوع نائمين فيها حتى شاهد الجمع مقبلاً فأيقظهم بقوله الثاني. وكل هذه التفاسير مقبولة، والأرجح عندنا ما ذكرناه أولاً.
نَنْطَلِق لمقابلة الأعداء المقبلين، ولمواجهة الخطر الذي لم يُرِد أن يهرب منه أو يمنع وقوعه.
هُوَذَا ٱلَّذِي يُسَلِّمُنِي هو الذي أخبرهم به في عدد ٢١. وكان مستيقظاً مجتهداً في تسليم المسيح فيما كان أصحابه الأحد عشر نياماً.
٤٧ «وَفِيمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ، إِذَا يَهُوذَا أَحَدُ ٱلاثْنَيْ عَشَرَ قَدْ جَاءَ وَمَعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ بِسُيُوفٍ وَعِصِيٍّ مِنْ عِنْدِ رُؤَسَاءِ ٱلْكَهَنَةِ وَشُيُوخِ ٱلشَّعْبِ».
مرقس ١٤: ٤٣ الخ ولوقا ٢٢: ٤٧ الخ ويوحنا ١٨: ٣ وأعمال ١: ١٦.
ذكر البشيرون الأربعة القبض على المسيح، وقد شاهد متّى ويوحنا ذلك. ولعل مرقس نقل الخبر عن بطرس الذي هو شاهد عينٍ. والذي أورده لوقا أكثر اختصاراً مما ذكره غيره. ويوحنا وحده ذكر سقوط الجنود الذين قبضوا عليه إلى الأرض.
وَفِيمَا هُوَ يَتَكَلَّم أي أن وصول الأعداء أيقظهم من نومهم.
يَهُوذَا أي الإسخريوطي، فإنه كان يعرف ذلك الموضع الذي اعتاد المسيح أن يجتمع فيه بتلاميذه (يوحنا ١٨: ١).
أَحَدُ ٱلاثْنَيْ عَشَرَ ذُكر هذا ليبين فظاعة خيانته، فمع أنه من رسل المسيح أقنع الرؤساء أن يمسكوه في وقت العيد على غير قصدهم الأول.
جَمْعٌ كَثِيرٌ كان هذا الجمع مؤلفاً (١) من الجند المعين لخدمة الهيكل (يوحنا ١٨: ٣ ولوقا ٢٢: ٥٢). وكان هؤلاء يهوداً. وذُكروا أيضاً في ٢ملوك ١١: ٩ ويوحنا ٧: ٢ وأعمال ٤: ١ - ٣ وأتوا حاملين عصياً و(٢) من فرقة عساكر الرومان (يوحنا ١٨: ٣، ١٢) أرسلهم بيلاطس للقبض على المسيح، خاصة بطلب من مجلس السبعين، أو لخدمة ذلك المجلس خدمة عامة في مدة العيد. وهذا يوافق قول بيلاطس لأهل ذلك المجلس «عندكم حرَّاس» (متّى ٢٧: ٦٥) وكان رجال ذلك المجمع متسلحين بسيوف قصيرة. (٣) من خدم رئيس الكهنة الذين أتوا للمشاورة أو للمساعدة أو للشماتة بمصاب خصم سيدهم كما أظهروا بعد ذلك (ع ٦٧ ومرقس ١٤: ٦٥) (٤) من بعض أعضاء المجلس من الكهنة والشيوخ الذين أتوا بأنفسهم ليشاهدوا القبض عليه (لوقا ٢٢: ٥٣). ويحتمل أنه كان مع هؤلاء لفيف ممن اعتادوا أن يجتمعوا في المدينة إذ علموا أن فرقة من العسكر تذهب للقبض على أحد منهم. والظاهر أن رجال الجمع كانوا كثيرين كأنهم كانوا يتوقعون مقاومة عنيفة. وربما قصد الرؤساء بجمع أولئك الكثيرين أن يوقعوا الشبهة على المسيح أنه من كبار الأثمة وأهل الشغب. وأخذ ذلك الجمع مصابيح ومشاعل، مع أن القمر كان يومئذٍ بدراً بغية أن يفتشوا عن المسيح في مخابئ ذلك البستان، سواء في كهف أو ظل شجرة لظنهم أنه يختبئ فيه. وكان قدام هذا الجمع كله الخائن يهوذا.
مِنْ عِنْدِ رُؤَسَاءِ ٱلْكَهَنَة الخ أي من عند مجلس السبعين على ما يرجح.
٤٨، ٤٩ «٤٨ وَٱلَّذِي أَسْلَمَهُ أَعْطَاهُمْ عَلاَمَةً قَائِلاً: ٱلَّذِي أُقَبِّلُهُ هُوَ هُوَ. أَمْسِكُوهُ. ٤٩ فَلِلْوَقْتِ تَقَدَّمَ إِلَى يَسُوعَ وَقَالَ: ٱلسَّلاَمُ يَا سَيِّدِي! وَقَبَّلَهُ».
٢صموئيل ٢٠: ٩
أَعْطَاهُمْ عَلاَمَةً أي عيَّن لهم قبل الوقت ما يمنعهم من القبض على غير المسيح. وهذا ما كان يحتاج إليه القابضون، ولا سيما الجند الروماني ليميزوا بينه وبين تلاميذه.
أُقَبِّلُهُ القبلة علامة المحبة والصداقة والأمانة (خروج ٤: ٢٧ و١٨: ٨ و١صموئيل ٢: ٤١ و٢صموئيل ١٥: ٥) ولنا من عادات اليهود والمسيحيين الأولين إن التلاميذ كانوا يقبّلون معلمهم مثلما كان المؤمنون يقبل بعضهم بعضاً إكراماً (رومية ١٦: ١٦ و١تسالونيكي ٥: ٢٦).
أَمْسِكُوهُ.. بحرص هذا دليل على أن يهوذا خاف أن يأتي أصحاب المسيح ويخلصوه. أو أن المسيح يستعمل قوته في المحاماة عن نفسه. أو أن يتوارى عنهم كما كان يفعل سابقاً حين أحاط الأعداء به ليوقعوا به الضرر (لوقا ٤: ٣٠ ويوحنا ٨: ٥٩ و١٠: ٣٩).
َلِلْوَقْتِ تَقَدَّم أي يهوذا قبل كل الجمع.
ٱلسَّلاَمُ يَا سَيِّدِي! مما زاد فظاعة إثم يهوذا رياءه باتخاذ علامة الصداقة وتحية المودَّة وسيلة إلى خيانته القاسية بلا خوف ولا حياء. وهذا يذكرنا بقبلة يوآب الخادعة لعماسا (٢صموئيل ٢٠: ٩، ١٠).
٥٠ «فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: يَا صَاحِبُ، لِمَاذَا جِئْتَ؟ حِينَئِذٍ تَقَدَّمُوا وَأَلْقَوُا ٱلأَيَادِيَ عَلَى يَسُوعَ وَأَمْسَكُوهُ».
مزمور ٤١: ٩ و٥٥: ١٣
صَاحِبُ أي رفيق لا حبيب (متّى ٢٠: ١٣ و٢٢: ١٢).
لِمَاذَا جِئْتَ؟ لم يجهل المسيح غاية مجيئه فسأله لينبه ضميره ويجعله يتأمل في الإثم الذي ارتكبه. وزاد لوقا على ذلك قوله «يَا يَهُوذَا، أَبِقُبْلَةٍ تُسَلِّمُ ابْنَ الإِنْسَانِ؟» (لوقا ٢٢: ٤٨) وفي ذلك الوقت حدثت المخاطبة المذكورة في يوحنا ١٨: ٤ - ٨ بين المسيح وقادة العسكر.
٥١ «وَإِذَا وَاحِدٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَ يَسُوعَ مَدَّ يَدَهُ وَٱسْتَلَّ سَيْفَهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ، فَقَطَعَ أُذُنَهُ».
يوحنا ١٨: ١٠
وَاحِد أي بطرس (يوحنا ١٨: ١٠، ١١).
كتب يوحنا إنجيله بعد خراب أورشليم حين زال الخطر عن أتباع المسيح إذا ذُكر اسم أحدهم في أمر يتعرض به لانتقام الحكام.
ٱسْتَلَّ سَيْفَه لم يكن مع الرسل سوى سيفين (لوقا ٢٢: ٣٣) كان أحدهما مع بطرس وفق ما يُنتظر من صفاته في الشجاعة والتسرُّع.
عَبْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ ذكر يوحنا أن اسم هذا العبد كان ملخس. ولعل ذلك العبد كان المتقدم إلى القبض على يسوع.
فَقَطَعَ أُذُنَهُ أي الأذن اليمنى كما أبان يوحنا. كان التلاميذ قد سألوا المسيح قبلاً: أيضربون أم لا؟ (لوقا ٢٢: ٤٩) فلم يصبر بطرس إلى أن يسمع الجواب، فسبق إلى الضرب بسرعة. والدليل على ذلك أن سيفه أخطأ المقتل ولم يبلغ سوى أُذن العبد.
٥٢ «فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: رُدَّ سَيْفَكَ إِلَى مَكَانِهِ. لأَنَّ كُلَّ ٱلَّذِينَ يَأْخُذُونَ ٱلسَّيْفَ بِٱلسَّيْفِ يَهْلِكُونَ».
تكوين ٩: ٦ ورؤيا ١٣: ١٠
رُدَّ سَيْفَكَ وجَّه هذا الكلام إلى بطرس لأن السيف كان مسلولاً بيده. وأمر المسيح بذلك دليل واضح على أنه لم يُرد أن يحارب تلاميذه عنه.
إِلَى مَكَانِهِ أي إلى غمده.
كُلَّ ٱلَّذِينَ يَأْخُذُونَ ٱلسَّيْفَ الخ هذا كلام جارٍ مجرى المثل وجَّهه المسيح أولاً إلى بطرس، وقصد به أن مقاومته للجمع المقبل عليه من الجهالة، ولا ينفع المسيح ولا يرضيه، بل إنه يجلب الخطر على التلاميذ. ودفع الخطر عن بطرس بشفائه أذن ملخس التي لو بقيت مقطوعة لأقاموا الدعوى عليه. ولكن إبراء المسيح إياها منعهم من إقامة الدعوى خوفاً من إذاعة نبأ المعجزة. وكان يجب أن المشاهدين كلهم يتخذون تلك المعجزة برهاناً على أن يسوع شخص إلهيٌ. وقصد المسيح من قوله لبطرس ما ذُكر، تنبيه تلاميذه على أن مقاومتهم للجند تُعرضهم للقتل. ومعناه عموماً أن الغاصبين يُغصبون والمعتدين يُعتدى عليهم (تكوين ٩: ٦ ورؤيا ١٣: ١٠). والذي يصدق على الشخص يصدق على الأمة. فإذا سلَّت أمة سيوف الحرب للهجوم سلتها الأمة الأخرى للدفاع. وسيف العصيان يجلب على من يستله سيف الانتقام. وتتعلم الكنيسة من ذلك أن ربها لا يريد أن تحمي نفسها أو تنتصر على غيرها بالأسلحة الجسدية (٢كورنثوس ١٠: ٣، ٤) لأن أسلحتها روحية، وهي كلام الله والصلاة والصبر. والانتقام لله لا لها (رومية ١٢: ١٩) ولكن ذلك لا يمنع على الإطلاق استعمال السيف لأن الإنجيل يجيز ذلك في بعض الأوقات (رومية ١٣: ٤).
٥٣ «أَتَظُنُّ أَنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ ٱلآنَ أَنْ أَطْلُبَ إِلَى أَبِي فَيُقَدِّمَ لِي أَكْثَرَ مِنِ ٱثْنَيْ عَشَرَ جَيْشاً مِنَ ٱلْمَلاَئِكَةِ؟».
٢ملوك ٦: ١٧ ودانيال ٧: ١٠
أَتَظُنُّ قال ذلك تنبيهاً لإيمان بطرس ليذكر ما رآه من قوة المسيح، لأن عمله دلَّ على أنه نسي قدرة المسيح على المعجزات، وأنه شكَّ في عناية الله بابنه وظنَّه أنه قد تركه. وأكد المسيح بما قاله لبطرس وسائر الرسل أن تسليمه تمَّ باختياره لا رغماً عنه.
أَسْتَطِيعُ أي أقدر إن أردت مقاومة الأعداء.
ٱلآنَ أي في حال قبض الأعداء عليَّ. وخلاصة كل هذا الحديث أنه لو أراد المقاومة وسأل المدد لأرسل الآب السماوي له في الحال المعونة الكافية.
ٱثْنَيْ عَشَرَ جَيْشاً لعله ذكر هذا العدد من جيوش الملائكة وفقاً لعدد تلاميذه في الأصل، فكأنه قال: لي عند الآب بدلاً من اثني عشر شخصاً ضعفاء وأحدهم خائن، اثنا عشر جيشاً من الملائكة المقتدرين قوة. والجيش هنا في الأصل اليوناني «لجئون» أو فيلق، وهو القسم الأكبر من أقسام الجنود الرومان وعدد رجاله عندهم ستة آلاف. وذكر هذا العدد العظيم ليبين قوته بالنسبة إلى تلك الفرقة الصغيرة التي أتت لتقبض عليه. ويحتمل أنه لم يقصد بذلك سوى عدد لا يُحصى من الملائكة. فإذا كان ملاك واحد ضرب في ليلة واحدة ١٨٥ ألفاً من جنود الأشوريين (٢ملوك ١٩: ٣٥) فما قولك باثني عشر جيشاً ينقضّون على تلك الفرقة الصغيرة!
ويتعزَّى المسيحيون بمعرفتهم أن تحت أمر المسيح دائماً جيشاً من الملائكة هذا عدده، وأنه صاحب السلطان مع الآب، وأنه شفيعهم.
٥٤ «فَكَيْفَ تُكَمَّلُ ٱلْكُتُبُ: أَنَّهُ هٰكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ؟».
إشعياء ٥٣: ٧ الخ وع ٢٤ ولوقا ٢٤: ٢٥، ٤٤، ٤٦
فَكَيْفَ تُكَمَّلُ أي كيف تكمل إذا سألتُ الآب المساعدة ونجوتُ من الخطر المحيط بي؟
ٱلْكُتُبُ هي التي تنبئ بآلامه وموته (مزمور ٢٢ وإشعياء ص ٥٣ ودانيال ٩: ٢٦ وزكريا ١٣: ٧).
فالمسيح سلم نفسه إلى الأعداء بلا مقاومة لكي تكمل هذه النبوات وغيرها، ويجهز الخلاص للعالم. وتلك النبوات تظهر مشيئة الله وقصده. وليس من العدل أن يضع الله خطايا العالم على يسوع البار إلا وهو راضٍ بذلك. وقال ذلك تعزية للتلاميذ وتقوية لإيمانهم، لأنه أكَّد لهم أن كل تلك الحوادث المحزنة قضى بها الآبُ في سابق علمه. فهي لم تقع على المسيح بغتة، ويجب أن لا يعثر تلاميذه.
٥٥ «فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ قَالَ يَسُوعُ لِلْجُمُوعِ: كَأَنَّهُ عَلَى لِصٍّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفٍ وَعِصِيٍّ لِتَأْخُذُونِي! كُلَّ يَوْمٍ كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَكُمْ أُعَلِّمُ فِي ٱلْهَيْكَلِ وَلَمْ تُمْسِكُونِي».
لِلْجُمُوعِ أي لرؤساء الكهنة وقادة جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه (لوقا ٢٢: ٥٢).
كَأَنَّهُ عَلَى لِصٍّ لم يعترض المسيح على قبضهم عليه بل على طريقته ووقته، لأنهم قبضوا عليه كما يُقبض على شر الأشقياء وكما قبضوا على باراباس (يوحنا ١٨: ٤٠) كأنهم توقعوا أن يقاومهم مقاومة عنيفة لا كمعلم هادئ محب للسلام. وطريق القبض عليه كما ذُكر زاد عار تسليمه إلى الموت. وما ذكره متّى ليس كل العار الذي وقع عليه حينئذٍ، لأن العسكر والخدم أوثقوه أيضاً (يوحنا ٨: ١٢).
كُلَّ يَوْمٍ أي عدة أيام متوالية في ذلك الزمان، ومراراً في أثناء ممارسته وظيفته.
أَجْلِسُ هادئاً لا أؤذي أحداً، ولا أظهر شيئاً من القسوة التي تقتضيها أعمالكم واستعدادكم إلى أن تمسكوني.
أُعَلِّمُ فِي ٱلْهَيْكَلِ أي جهاراً حتى لا يكون لكم أن تتهموني بدسائس سرية تحتاجون بها إلى أن تقبضوا عليَّ سراً، ولأن علة دعواكم عليَّ هي كلماتي. فلماذا لم تمسكوني وأنا أُعلم أمامكم؟!
وَلَمْ تُمْسِكُونِي هذا دليل على أنكم لم تجسروا على ذلك علانية، وأنه لا حجَّة لكم تبرركم أمام الناس بقبضكم عليَّ (متّى ٢١: ٤٦).
٥٦ «وَأَمَّا هٰذَا كُلُّهُ فَقَدْ كَانَ لِكَيْ تُكَمَّلَ كُتُبُ ٱلأَنْبِيَاءِ. حِينَئِذٍ تَرَكَهُ ٱلتَّلاَمِيذُ كُلُّهُمْ وَهَرَبُوا».
مراثي إرميا ٤: ٢٠ وع ٥٤ ومرقس ١٤: ٥٠ ويوحنا ١٨: ٥
كُتُبُ ٱلأَنْبِيَاءِ أي الكتب التي أنبأت بآلامي وموتي. وخيانة يهوذا وظلمكم لم يكونا إلا بمقتضى قضاء الله الأزلي. فكرر لهم هنا ما قاله قبلاً لتلاميذه (ع ٥٤) وأظهر به لهم أن الذي قدَّرهم عليه لا أيديهم ولا عصيهم ولا سيوفهم ولا رُبطهم، بل مجرد إرادته، وكان ذلك إتماماً لمقاصد الله المكتوبة في كتب الأنبياء.
حِينَئِذٍ تَرَكَهُ ٱلتَّلاَمِيذُ لأنهم خافوا من هجوم الجند عليهم ليلاً، وبسبب خيبة آمالهم بالقبض على المسيح الذي لم يظهر شيئاً من قوته لإنقاذ نفسه. ولأن كلامه أبان أنه عزم أن يسلم نفسه إلى أيدي أعدائه ليفعلوا به ما قضى الله به. فخوفهم وخيبة آمالهم أنسياهم وعدهم أنهم لا يتركونه (ع ٣٥) فهربوا. ولا شك أن هربهم زاد كأس المسيح مرارة «لأنه داس المعصرة وحدهُ، ومن الشعوب لم يكن معه أحدٌ، ونظر ولم يكن له معين وتحيَّر إذ لم يكن له عاضد» (إشعياء ٦٣: ٣، ٥) والمسيح حين سلم نفسه إلى الأعداء سألهم أن يتركوا تلاميذه (يوحنا ١٨: ٨) وذكر متّى هنا أن كل التلاميذ هربوا، والظاهر أن اثنين منهم (وهما يوحنا وبطرس) عندما رأيا أن لا أحد لحق التلاميذ ليقبض عليهم، رجعا وتبعا المسيح من بعيد.
٥٧ «وَٱلَّذِينَ أَمْسَكُوا يَسُوعَ مَضَوْا بِهِ إِلَى قَيَافَا رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ، حَيْثُ ٱجْتَمَعَ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلشُّيُوخُ».
مرقس ١٤: ٥٣ الخ ولوقا ٢٢: ٥٤ الخ ويوحنا ١٨: ١٢، ١٣، ١٤
حُوكم المسيح أمام القضاة والحكام ست مرات: ثلاثاً قدام قضاة من اليهود، واثنتين أمام بيلاطس، وواحدة أمام هيرودس.. واستُهزئ به أربع مرات. وبُرّئ ثلاث مرات. وحُكم عليه مرتين. وأول محاكمة جرت عليه كانت أمام حنان رئيس الكهنة السابق، وبقي يُسمَّى برئيس الكهنة بعد عزلهِ، وبقيت سلطته الجبرية كما كانت قبل ذلك لتقدمه وفرط ذكائه. وفي هذه المحاكمة لم يُطلب شهود، ولم يذكرها سوى يوحنا (يوحنا ١٨: ١٣ - ٢٣). والمرة الثانية أمام قيافا، وذكرها متّى في هذا العدد ومرقس ١٤: ٥٣ - ٦٤. والثالثة أمام المجلس صباح يوم الجمعة، وذكر وقوف المسيح فيه وما جرى حينئذٍ لوقا وحده (لوقا ٢٢: ٦٦ - ٧١)، ولو أن متّى اقتصر على ذكر اجتماع المجلس والحكم وقتئذٍ (متّى ٢٧: ١). وكانت المحاكمة الأولى فحصاً استعدادياً. وكانت الثانية لإبراز الشهادات عليه من فمه ومن غيره، وحكموا عليه فيها ليلاً، وذلك لم يكن شرعياً. وكانت الثالثة للحكم بالموت عليه شرعاً. وفي أثناء تلك المحاكمات أنكره بطرس. ولا فرق بين ذكر إنكاره قبل ذكر المحاكمة وذكره بعدها. فاستحسن لوقا ذكره قبلها، واستحسنه متّى ومرقس بعدها، واستحسن يوحنا ذكره في أثناء كلامه على المحاكمة.
إِلَى قَيَافَا أي إلى قصر قيافا. والظاهر أن ذلك القصر كان واسعاً معداً لرئيس الكهنة، يشتمل على ساحة واسعة تحيط بها المخادع والغُرف. والأرجح أنه كان لكل من حنان وقيافا موضعاً خاصاً في ذلك القصر. وكان هناك إيوان (أو بيت كبير) ترتفع أرضه عن أرض الساحة (مرقس ١٤: ٦٦) كان يجلس فيه أعضاء مجلس السبعين أحياناً. وأوقف المسيح أمام قيافا ليسمع الدعوى عليه ثانية، لأنه وقف أمام حميه حنان (يوحنا ١٨: ١٩ - ٢٣). وكان ذلك في أثناء مجيء الأعضاء إلى المجلس في نحو الساعة الثانية بعد نصف الليل، على ما يُظن. وقُصد بالمحاكمة الليلية السرية أن لا تعرف بها الجماهير التي تحب يسوع فتحاول تخليصه من أيديهم، بينما هم (أي الرؤساء) يريدون هلاكه لا خلاصه.
وقيافا صدوقي كحنان (انظر شرح ع ٣) تولى رئاسة الكهنة عشر سنين، من سنة ٢٧ - ٣٧م، وهو الذي قال قبل ذلك: خير أن يموت المسيح (يوحنا ١١: ٥٠).
ٱلْكَتَبَةُ وَٱلشُّيُوخُ كان اجتماعهم، اجتماع المجلس الكبير الذي يسمَّى مجلس السبعين، بغتةً. وكان لا يُحسب الاجتماع شرعياً ما لم يكن عدد المجتمعين ثلاثة وعشرين فما فوق. وكان من قوانينهم أنهم مهما حكموا في ذلك المجلس ليلاً فإنه لا يُعد شرعياً ما لم يكرر نهاراً. ويُحتمل أنهم اجتمعوا سابقاً، وكانوا يتوقعون رجوع الفرقة التي ذهبت للقبض على المسيح. والمرجح أن قيافا دعاهم بعدما عرف أنه قُبض على المسيح.
٥٨ «وَأَمَّا بُطْرُسُ فَتَبِعَهُ مِنْ بَعِيدٍ إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ، فَدَخَلَ إِلَى دَاخِلٍ وَجَلَسَ بَيْنَ ٱلْخُدَّامِ لِيَنْظُرَ ٱلنِّهَايَةَ».
يوحنا ١٨: ١٥
َأَمَّا بُطْرُسُ فَتَبِعَه وذلك لأمرين: (١) محبته الشخصية للمسيح، و(٢) رغبته في مشاهدة ما يحدث.
إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ أي إلى ساحة الدار حيث أضرم الخدم ناراً للاصطلاء (لوقا ٢٢: ٥٥) وسبق بطرس تلميذ آخر هو يوحنا، وأدخل بطرس (يوحنا ١٨: ١٥، ١٦).
وَجَلَسَ بَيْنَ ٱلْخُدَّامِ جلس بعض الوقت كما هنا ووقف وقتاً آخر يصطلي كما ذكر يوحنا (يوحنا ١٨: ١٨) والظاهر أنه ظن أن لا أحد يعرفه ولا يلتفت إليه.
لِيَنْظُرَ ٱلنِّهَايَةَ يدل هذا على أن رغبة بطرس في مشاهدة ما يجري هنالك كانت سبب مجيئه.
٥٩ «وَكَانَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُّيُوخُ وَٱلْمَجْمَعُ كُلُّهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى يَسُوعَ لِكَيْ يَقْتُلُوهُ».
وَٱلْمَجْمَعُ كُلُّهُ أي كل من حضر المجلس من الأعضاء. والأرجح أن يوسف الرامي ونيقوديموس (وهما من أعضاء ذلك المجلس) كانا غائبين (لوقا ٢٣: ٥١ ويوحنا ٧: ٥٠، ٥١ و١٩: ٣٩).
٦٠ «فَلَمْ يَجِدُوا. وَمَعَ أَنَّهُ جَاءَ شُهُودُ زُورٍ كَثِيرُونَ، لَمْ يَجِدُوا. وَلٰكِنْ أَخِيراً تَقَدَّمَ شَاهِدَا زُورٍ».
مزمور ٢٧: ١٢ و٣٥: ١١ ومرقس ١٤: ٥٥، ٥٦ وأعمال ٦: ١٣ وتثنية ١٩: ١٥
فَلَمْ يَجِدُوا أي لم يجدوا شهادة يستطيعون أن يبنوا عليها الحكم بقتله «لأَنَّ كَثِيرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ زُورًا، وَلَمْ تَتَّفِقْ شَهَادَاتُهُمْ» (مرقس ١٤: ٥٦، ٥٩).
وَلٰكِنْ أَخِيراً أي بعد المحاورات عبثاً.
شَاهِدَا زُورٍ هذا أقل عددٍ تقوم به الشهادة شرعاً (عدد ٣٥: ٣٠ وتثنية ١٧: ٩ و١٩: ١٥).
٦١ «وَقَالاَ: هٰذَا قَالَ إِنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَنْقُضَ هَيْكَلَ ٱللّٰهِ، وَفِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَبْنِيهِ».
متّى ٢٧: ٤٠ ويوحنا ٢: ١٩
قال المسيح لليهود منذ ما يزيد عن سنتين قبل ذلك «انْقُضُوا هذَا الْهَيْكَلَ، وَفِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أُقِيمُهُ.. وَأَمَّا هُوَ فَكَانَ يَقُولُ عَنْ هَيْكَلِ جَسَدِهِ» (يوحنا ٢: ١٩، ٢١) وشهدوا عليه هنا بأنه قال ذلك عن الهيكل الحقيقي. وبين شهادتهم وقول المسيح فرق عظيم، لأنه قال إنه يقيمه في ثلاثة أيام إذا نقضوه هم. وهم شهدوا أنه قال: أنا أقدر أن أنقضه. وما قاله على جسده مجازاً قالوه على هيكل أورشليم حقيقة. وهذه الشهادة الكاذبة لم تنفعهم شيئاً لأن الشهود اختلفوا فيها. ولو أثبتوا عليه أنه هدَّدهم بأن يخرب الهيكل لحكموا عليه بالتجديف (أعمال ٦: ١٣). على أن أعضاء المجلس كلهم كانوا يعلمون ما أراد المسيح بالهيكل كل المعرفة، ودليل ذلك قول المجلس لبيلاطس «تَذَكَّرْنَا أَنَّ ذلِكَ الْمُضِلَّ قَالَ وَهُوَ حَيٌّ: إِنِّي بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَقُومُ» (متّى ٢٧: ٦٣).
٦٢ «فَقَامَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَقَالَ لَهُ: أَمَا تُجِيبُ بِشَيْءٍ؟ مَاذَا يَشْهَدُ بِهِ هٰذَانِ عَلَيْكَ؟».
مرقس ١٤: ٦ الخ
سؤال رئيس الكهنة هنا نتيجة عجزه عن أن يجد علة للشكوى ضده، فحاول أن يحمل المسيح على أن يشتكي على نفسه. وحَمل إنسانٍ أن يشتكي على نفسه إذا لم تثبت الدعوى عليه ينافي قوانين العدل. ومعنى السؤال: هل شهادة هذين الشاهدين عليك من جهة نقض الهيكل صادقة أم كاذبة؟ وقيام رئيس المجلس في مثل تلك الحال ليخاطب المدَّعى عليه دليل على أنه محتدٌّ لأنه عجز عن أن يجد علة على المسيح.
٦٣ «وَأَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ سَاكِتاً. فَسَأَلَهُ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ: أَسْتَحْلِفُكَ بِٱللّٰهِ ٱلْحَيِّ أَنْ تَقُولَ لَنَا: هَلْ أَنْتَ ٱلْمَسِيحُ؟ ٱبْنُ ٱللّٰهِ».
إشعياء ٥٣: ٧ ومتّى ٢٧: ١٢، ١٤ ولاويين ٥: ١ و١صموئيل ١٤: ٢٤، ٢٦.
فَكَانَ سَاكِتاً ولعل المجلس أيضاً بقي ساكتاً يتوقع الجواب من يسوع. وكان سكوت المسيح إتماماً لنبوة إشعياء (إشعياء ٥٣: ٧) ووفقاً لشهادة بطرس (١بطرس ٢: ٢٣). وسكت لعلمه أن المجلس قرر قتله، وأن كلامه لا يدفعهم إلى عدل أو رحمة. ولو فسر ما قصده من كلامه عن نقض الهيكل ما قبلوا تفسيره ولا تعليمه.
أَسْتَحْلِفُكَ بِٱللّٰهِ ٱلْحَيِّ هذا هو القسَم العادي في الشريعة اليهودية (عدد ٥: ١٩، ٢١ ويشوع ٧: ١٩) ومعناه: أسألك أن تحلف بالله أن تشهد بالحق كله، كأنك واقف في حضرة الإله الحي.
هَلْ أَنْتَ ٱلْمَسِيحُ؟ لا علاقة لهذا السؤال بشهادة الشاهدين، فظهر منه الدافع الحقيقي. فلم يكن حكم الإدانة بسبب كلام المسيح عن الهيكل، ولا أنه يهيج الفتنة بين الناس كما شهدوا عليه أمام بيلاطس (لوقا ٢٣: ٢) بل يدينونه لأنه وهو إنسان فقير ادَّعى أنه المسيح المنتظر.
ٱبْنُ ٱللّٰهِ يظهر من بشارة لوقا أن السؤال الواحد هنا هو مجموع سؤالين، أي «هل أنت المسيح؟» و «هل أنت ابن الله؟». ولم يفرِّق أنبياء العهد بين مضموني هذين السؤالين لأنهم اعتقدوا أن المسيح هو ابن الله (مزمور ٢: ٧ و٤٥: ٦، ٧ وإشعياء ٧: ١٤ و٩: ٦ وميخا ٥: ٢). وأما اليهود في أيام المسيح فالمرجح أنهم اعتقدوا أن المسيح نبي وملك وفاتح منتصر. وسبب ذلك السؤال كله هو أن يجدوا ما يشتكون به على المسيح من تجديف. ولم يكن يسوع مضطراً إلى الإجابة، فتكلم لا ليتخلَّص منهم، بل لئلا يستنتجوا من سكوته أنه رجع عن دعواه أنه المسيح ابن الله. وكان في وسعه أن ينجو من دعواهم أنه جدف إما بأن ينكر قوله إنه المسيح ابن الله، وهذا محال، وإما أن يعترف به ويبرهن صحته. لكنهم لم يسمحوا له بإقامة البرهان.
٦٤ «قَالَ لَهُ يَسُوعُ: أَنْتَ قُلْتَ! وَأَيْضاً أَقُولُ لَكُمْ: مِنَ ٱلآنَ تُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلإِنْسَانِ جَالِساً عَنْ يَمِينِ ٱلْقُوَّةِ، وَآتِياً عَلَى سَحَابِ ٱلسَّمَاءِ».
يوحنا ١٣: ٣١ ومزمور ١١٠: ١ وأعمال ٧: ٥٥ ودانيال ٧: ١٣ ومتّى ١٦: ٢٧ و٢٤: ٣٠ ولوقا ٢١: ٢٧ ويوحنا ١: ٥١ ورومية ١٤: ١٠ و١تسالونيكي ٤: ١٦ ورؤيا ١: ٧
أَنْتَ قُلْتَ هذا كقولك «نعم». فقال يسوع هنا إنه هو المسيح وإنه الله، وكذا فهم المجلس. ولم يقل لهم ما يدل على أنهم أخطأوا الفهم. ولنا من ذلك أنه يجب علينا أن نتكلم إذا فُهم من سكوتنا إنكار الحق. وجواب المسيح على طلب الحلف يثبت أن القَسَم في المحاكمة يجوز إذا كانت الدعوى حقيقية وذات شأن.
مِنَ ٱلآنَ تُبْصِرُونَ أي الذي أدعيه الآن بالكلام ستكتشفون صحته بالعيان. فالذي قدمه المسيح هنا علامةٌ على صحة دعواه، وإنذارٌ لهم وإنباءٌ بالدينونة.
جَالِساً عَنْ يَمِينِ ٱلْقُوَّةِ أي عن يمين الله، وذلك مكان الشرف والوقار والقضاء والراحة (مزمور ١١٠: ١ ودانيال ٧: ١٣، ١٤).
وبهذا نسب يسوع إلى نفسه النبوات التي أنبأ بها داود ودانيال بالمسيح. وربما أشار بقوله إنه ابن الإنسان إلى الفرق العظيم بين حال تواضعه وهو واقف يحاكم موثقاً كمذنب قريباً أن يموت مهاناً، وحال ارتفاعه حين يصير المحكوم عليه حاكماً والحاكمون محكوماً عليهم.
وَآتِياً عَلَى سَحَابِ ٱلسَّمَاءِ هذا كما في متّى ٢٤: ٣٠. كان الرؤساء قد طلبوا أن يُريهم آية من السماء فأبى (مرقس ٨: ٤١) ولكنه الآن وعدهم بتلك الآية وهي مجيئه الثاني ليدين العالم. ولعله أشار أيضاً إلى مجيئه الروحي ليهدم مدينتهم، وهو رمزٌ إلى مجيئه يوم الدين العظيم. وسؤال رئيس الكهنة عن أمرين: كون يسوع هو المسيح، وكونه ابن الله. فأجابه يسوع بالإيجاب، وزاد على المطلوب بقوله إنه ديان العالم.
٦٥ «فَمَزَّقَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ حِينَئِذٍ ثِيَابَهُ قَائِلاً: قَدْ جَدَّفَ! مَا حَاجَتُنَا بَعْدُ إِلَى شُهُودٍ؟ هَا قَدْ سَمِعْتُمْ تَجْدِيفَهُ!».
٢ملوك ١٨: ٣٧ و١٩: ١
فَمَزَّقَ... ثِيَابَهُ هذه هي العلامة المألوفة للحزن عند اليهود (٢ملوك ١٨: ٣٧). وقصد رئيس الكهنة أن يُظهر بها أسفه واقشعراره من فظاعة التجديف في حضرته. وكان هذا إغراءً للمجلس ليحكم على يسوع كما حكم هو عليه. وكان كل ما أظهره من الانفعالات رياءً لأنه فرح بسماع إقرار يسوع الذي سيتذرَّع به ليحكم عليه. على أنه بموجب شريعة موسى لا يجوز لرئيس الكهنة أن يمزق ثيابه (لاويين ١٠: ٦ و٢١: ١٠). ولعله نهي الشريعة عن تمزيق ثيابه يختص بحزنه الخاص بعائلته، لا في الحزن العام.
نتعجب من سرعة هذا الحكم مما يدل على تواطؤ المجتمعين، الذين انتظروا مجرد كلمة يقولها المتهم أمامهم ليحكموا عليه كالغوغاء التي لا تعرف العدالة ولا الإنصاف.
قَدْ جَدَّفَ لأنه ادَّعى لنفسه بعد أن حلَّفه الصفات المختصة بالله وحده. ولا شكَّ أن المسيح بجوابه ساوى نفسه بالآب. فلو كان مجرد إنسان لكان جوابه تجديفاً، ولكان القضاء عليه عدلاً (يوحنا ١٠: ٣١ - ٣٣). ولكنه لم يكن مجرد إنسان، ولم يتكلم بغير الحق، فهو لم يجدف. فكان على أعضاء المجلس أن ينظروا في دعواه ليعلموا أحقٌ هي أم لا، لكنهم صرفوا أذهانهم عما يثبت دعواه من البراهين القاطعة، وافترضوا بدون أدنى دليل أنه خادع.
٦٦ «مَاذَا تَرَوْنَ؟ فَأَجَابُوا: إِنَّهُ مُسْتَوْجِبُ ٱلْمَوْتِ».
لاويين ٢٤: ١٦ ويوحنا ١٩: ٧
مَاذَا تَرَوْنَ؟ طلب بهذا حكم المجلس باعتباره رئيساً.
إِنَّهُ مُسْتَوْجِبُ ٱلْمَوْتِ «الجميع حكموا عليه» بذلك (مرقس ١٤: ٦٤) وقولهم «إنه مستوجب الموت» صورة الحكم التي اعتادها اليهود في حكمهم على المدَّعى عليه بالقتل عندما كان لهم السلطان على إجراء ذلك. ولكن الرومان منعوهم عنه (يوحنا ١٨: ٣١) فلم يبقَ لهم إلا صورة الحكم.
وحكموا على المسيح بما ذُكر بناء على ما قيل في شريعة موسى التي أمرت برجم المجدِّف (لاويين ١٤: ١٠ - ١٦ وتثنية ١٨: ٢٠). وكان يمكن لأعضاء المجلس أن يأمروا الناس برجم يسوع بالرغم من الحكام الرومان، فهكذا فعلوا باستفانوس الشهيد المسيحي الأول، كما كان يمكنهم أن يستأذنوا بيلاطس في ذلك. ولكنهم لم يفعلوا هذا خوفاً من أن كثيرين من الشعب يدافعون عن يسوع ويعملون على إنقاذه، فاستحسنوا أن يسألوا بيلاطس أن ينفِّذ حكمهم بأن يقتله. وكان القتل عند الرومان في مثل هذه الحادثة بالصلب، وهذا علة صلب يسوع دون رحمة. وكان أعضاء ذلك المجلس يعتبرون حكمهم نهائياً. لكنهم اضطروا أن يجتمعوا أيضاً ليجعلوا هذا الحكم شرعياً، لأن تلمودهم منع المحاكمة ليلاً. فاجتمعوا ثانيةً بعد طلوع الفجر وكرروا طلب الحكم عليه (متّى ٢٧: ١ ولوقا ٢٢: ٧). وهذه نهاية استماع الدعوى على يسوع ثانية أمام قضاة اليهود.
وما حكموا به عليه لم يكن شرعياً بموجب كتاب التلمود (وهو من أقدس كتب اليهود) لأن التلمود لم يُجز للمجلس أن يفحص ليلاً عن دعوى جنائية يمكن أن يحكم على من تثبت عليه بالموت. ومنع أن يُحكم على المدَّعى عليه بالموت في نفس اليوم الذي يُحاكم فيه. ومنع أن يُحكم عليه بذلك بمجرد شهادته على نفسه. فإذا كان الناس حكموا على ذلك البار واهب الحياة بأنه مستوجب الموت، فهل غريب إذا حكموا على أحد عبيده ظلماً؟ أو يحق لذلك العبد أن يتذَّمر؟
٦٧ «حِينَئِذٍ بَصَقُوا فِي وَجْهِهِ وَلَكَمُوهُ، وَآخَرُونَ لَطَمُوهُ».
إشعياءد ٥: ٦ و٥٣: ٣ ومتّى ٢٧: ٣٠ ولوقا ٢: ٦٣ ويوحنا ١٩: ٣
حِينَئِذٍ بَصَقُوا كان البصق، ولا يزال، غاية الإهانة، وعلامة الكره الشديد (عدد ١٢: ١٤ وأي ٣٠: ١٠ وإشعياء ٥٠: ٦). وكان الذين بصقوا هم غير رجال الشرطة القساة وحراس الهيكل وخدَم رئيس للكهنة (مرقس ١٤: ٦٥ ولوقا ٢٢: ٦٣). والأرجح أن أولئك العسكر ورفقاءهم أخذوا يسوع من المحكمة إلى الدار. وربما عند ذلك تمكن المسيح من مشاهدة بطرس وسمع كلامه باللعنات والأقسام (لوقا ٢٢: ٦١) والتفت إليه. ونظرته تلك أبكت بطرس بكاءً مراً. وكان من عاداتهم يومئذٍ أن يسلموا المحكوم عليه بالموت إلى العسكر ليهينوه ويهزأوا به كما شاءوا. فالظاهر أن أعضاء المجلس سلموا يسوع إلى أولئك الفئات من الناس وذهبوا إلى بيوتهم وبقوا فيها إلى الصباح. والأرجح أن وقت انصرافهم كان نحو الساعة الثالثة بعد نصف الليل، فيكون المسيح قد احتمل إهانة أولئك القساة وتعذيبهم نحو ثلاث ساعات.
لَكَمُوهُ أي ضربوه بجمع الكف ليظهروا بغضهم وإهانتهم وغيظهم مما نسبوا إليه من التجديف.
لَطَمُوهُ أي ضربوه براحة اليد وهذه طريقة أخرى لتعذيبه وإظهار ما سبق. وقد أنبأ إشعياء بكل هذه الإهانات منذ سبع مئة سنة قبل وقوعها (إشعياء ٥٠: ٦ و٥٣: ٣، ٧).
٦٨ «قَائِلِينَ: تَنَبَّأْ لَنَا أَيُّهَا ٱلْمَسِيحُ، مَنْ ضَرَبَكَ؟».
مرقس ١٤: ٦٥ ولوقا ٢٢: ٦٤
قال مرقس إنهم غطوا وجهه ولكموه وقالوا له تنبأ إلخ (مرقس ١٤: ٦٥). وفعلوا ذلك هزءاً بادِّعائه أنه نبي لأن النبي يقدر أن يعرف ضاربه وإن كان وجهه مغطى. ولأن المسيح صبر على ذلك ولم يجبهم بشيء اتخذوا ذلك دليلاً على أنه لا يستطيع أن يعلم من ضربه وأنه خادع. فوا أسفاه! كيف أن اليدين اللتين أبكمتا الأرواح وسكَّنتا البحار والرياح وتكلمتا بكلمة الحياة صارتا عرضةً لقساوة أولئك الأشقياء نحو ثلاث ساعات!
فما أعظم الفرق بين ما صار إليه المسيح وما يليق أن يكون فيه. فإن المنقذ هنا صار موثقاً، والديان مشكواً عليه، ورئيس المجد مهاناً، والقدوس البار محكوماً عليه بالذنب، وابن الله محسوباً مجدفاً، والذي هو القيامة والحياة مسلَّماً للموت، ورئيس الكهنة الأزلي مديناً من رئيس الكهنة الوقتي.
٦٩ «أَمَّا بُطْرُسُ فَكَانَ جَالِساً خَارِجاً فِي ٱلدَّارِ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ جَارِيَةٌ قَائِلَةً: وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ يَسُوعَ ٱلْجَلِيلِيِّ».
مرقس ١٤: ٦٦ ولوقا ٢٢: ٥٥ ويوحنا ١٨: ١٦، ١٧، ٢٥
أَمَّا بُطْرُسُ فَكَانَ جَالِساً ذكر دخول بطرس دار رئيس الكهنة في ع ٥٨ وإن خدَم البيت أضرموا ناراً في ساحة الدار ليصطلوا. والاصطلاء كان حينئذٍ مقبولاً لأنه كان ليل، وأورشليم عالية، وكان الشهر نيسان العبراني، فدخل بطرس بينهم ليصطلي. ونتعلم من هذا أنه من الخطر على تلاميذ المسيح أن يخالطوا أعداءه، ولو لأسباب جائزة بنفسها.
جَارِيَةٌ أي إحدى إماء قصر رئيس الكهنة وهي البوابة (مرقس ١٤: ٦٦ ويوحنا ١٨: ١٧)
وَأَنْت أي أنا أعرف أن يوحنا تلميذ يسوع (١٨: ١٦) ولابد أنك أنت كذلك. وهذه الجارية سألت بطرس قبل هذا أو بعده قائلة «أَلَسْتَ أَنْتَ أَيْضًا مِنْ تَلاَمِيذِ هذَا الإِنْسَانِ؟» (يوحنا ١٨: ١٧).
٧٠ «فَأَنْكَرَ قُدَّامَ ٱلْجَمِيعِ قَائِلاً: لَسْتُ أَدْرِي مَا تَقُولِينَ».
فَأَنْكَرَ هذا إنكاره الأول وكانت علتهُ حياؤه وخوفه، كما أن إيمانه بالمسيح ضعُف وهو يرى المسيح ضعيفاً كل الضعف عند القبض عليه. ولعله قال في نفسه: إقراري بالمسيح يضرني ولا يفيده.
لَسْتُ أَدْرِي مَا تَقُولِينَ هذا تجاهل أظهر به أعظم الاستغراب من اتهامها إياه أنه من تلاميذ يسوع، وزاد على هذا قوله «لست أنا» (يوحنا ١٨: ١٧). وقوله «لَسْتُ أَعْرِفُهُ يَا امْرَأَةُ!» (لوقا ٢٣: ٥٧).
٧١ «ثُمَّ إِذْ خَرَجَ إِلَى ٱلدِّهْلِيزِ رَأَتْهُ أُخْرَى، فَقَالَتْ لِلَّذِينَ هُنَاكَ: وَهٰذَا كَانَ مَعَ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ».
وخَرَجَ إِلَى ٱلدِّهْلِيزِ اعتزل بطرس ضوءَ النار وذهب إلى ظلمة الدهليز ليتجنب التفاتهم وأسئلتهم، فإنه خاف على حياته. ولا شكَّ أن ضميره كان يؤنبه ويزيده خوفاً.
قال مرقس إنه في أثناء ذلك صاح الديك أول مرة (مرقس ١٤: ٦٨) ولم يكن ذلك الهزيع المعروف عندهم «بصياح الديك» لأن ذلك كان قرب الفجر، وإنكار بطرس الأول كان في بدء محاكمة يسوع نحو نصف الليل أو بعده بقليل.
رَأَتْهُ أُخْرَى، فَقَالَت الخ يظهر من قول مرقس أن الجارية الأولى أخبرت الجارية الثانية بظنها أن بطرس من تلاميذ المسيح بقولها «إن هذا منهم» (مرقس ١٤: ٦٩) وإن الجارية الثانية قالت ذلك أمام آخرين. ويظهر مما قال لوقا ويوحنا أن آخرين صدقوها بالخبر والاستفهام (لوقا ٢٢: ٥٨ ويوحنا ١٨: ٢٥).
٧٢ «فَأَنْكَرَ أَيْضاً بِقَسَمٍ: إِنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ ٱلرَّجُلَ».
فَأَنْكَرَ أَيْضاً هذا إنكاره الثاني.
بِقَسَمٍ أتى ذلك إثباتاً لصدق ما قال ودفعاً للريبة والشبهة عنه. فنرى من ذلك أن سقوط بطرس كان متسارعاً منذ بدئه، وقد نسي ما قاله المسيح عن خطية الحلف (متّى ٥: ٣٤) وزاد ذلك الإثم على كذبه.
إِنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ ٱلرَّجُلَ هذا قوله للجارية، وأما ما خاطب به الآخرين الذي صدَّقوها بسؤالهم فقوله «لست أنا» (يوحنا ١٨: ٢٥).
٧٣ «وَبَعْدَ قَلِيلٍ جَاءَ ٱلْقِيَامُ وَقَالُوا لِبُطْرُسَ: حَقّاً أَنْتَ أَيْضاً مِنْهُمْ، فَإِنَّ لُغَتَكَ تُظْهِرُكَ».
قضاة ١٢: ٦ ولوقا ٢٢: ٥٩
وَبَعْدَ قَلِيلٍ أي بعد نحو ساعة (لوقا ٢٢: ٥٩). وفي تلك المدة كان بطرس قد رجع من الدهليز إلى النار (يوحنا ١٨: ٢٥).
ٱلْقِيَامُ وَقَالُوا كان بين أولئك القيام نسيب ملخس الذي قطع بطرس أذنه (يوحنا ١٨: ٢٦).
لُغَتَكَ تُظْهِرُكَ أرادوا بذلك أن لهجته تدل على أنه جليلي. ومن جملة ما يميز أهل الجليل عن أهل اليهودية أن الجليليين كانوا يفرقون في نطق السين والثاء. والمسيح قضى أكثر الوقت في الجليل فلذلك سُمِّي جليلياً. وكان أكثر تلاميذه الأولين من هناك، فنسبوا كل تلاميذه إلى الجليل (مرقس ١٤: ٧٠ ولوقا ٢٢: ٥٩ وأعمال ٢: ٧).
٧٤ «فَٱبْتَدَأَ حِينَئِذٍ يَلْعَنُ وَيَحْلِفُ: إِنِّي لاَ أَعْرِفُ ٱلرَّجُلَ! وَلِلْوَقْتِ صَاحَ ٱلدِّيكُ».
يَلْعَنُ وَيَحْلِفُ أي يسأل الله أن يعاقبه إن كان كاذباً. ولعل القسم هنا كان أشدَّ مما سبقه من أقسام.
إِنِّي لاَ أَعْرِفُ ٱلرَّجُلَ! هذا إنكاره الثالث. ولم يظهر في هذه الحادثة إن كان ثلاثة أشخاص اتهموا بطرس، ولم يظهر أنه دفع التهم بثلاثة أجوبة فقط، بل الأرجح أن الذين اشتركوا فيها كثيرون، وأنه كرر الإنكار بأقوال مختلفة متوالية في وقت قصير بدليل تنوع أنباء الإنجيليين الأربعة. والأمر الجوهري إن بطرس أُتهم ثلاث مرات متميزة، وأنه أنكر المسيح ثلاث مرات كذلك. والأرجح أنه في كل مرة من هذه الثلاث كانت الاتهامات من الحاضرين كثيرة ومتنوعة، وكانت إنكاراته كذلك. فذكر بعض البشيرين بعضها وذكر البعض بعضاً آخر. ومما يقوي ذلك أنه يبعد عن الظن أن لا يكون في مدة الساعات الثلاث التي جرت فيها المحاكمة وبطرس بين أعداء المسيح سوى ثلاثة أسئلة وثلاثة أجوبة. والخلاصة أن عدد مرات السؤال والجواب كانت ثلاثة كما ذُكر، ولكن الأسئلة والأجوبة في كلٍ منها كانت متعددة.
صَاحَ ٱلدِّيكُ أشار متّى بذلك إلى صياح الديك المعتاد في مثل ذلك الوقت، ولذلك سُمي الهزيع الثالث «صياح الديك» وأوله الساعة الثالثة بعد منتصف الليل (مرقس ١٣: ٣٥) ولم يلتفت متّى إلى عدد مرات ذلك الصياح، ولكن مرقس ذكر أن هذا الصياح هو الصياح الثاني (مرقس ١٤: ٧٢). فالظاهر أن بطرس لم ينتبه إلى الصياح الأول ولم يتأثر به.
٧٥ «فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ كَلاَمَ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ: إِنَّكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ تُنْكِرُنِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَخَرَجَ إِلَى خَارِجٍ وَبَكَى بُكَاءً مُرّاً».
ع ٣٤ ومرقس ١٤: ٣٠ ولوقا ٢٢: ٦١، ٦٢ ويوحنا ١٣: ٣٨
فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ صاح الديك أمرٌ زهيد في نفسه ولكن الروح جعله واسطة لتنبيه ضمير بطرس. وقال لوقا «إنه عندما صاح الديك التفت المسيح ونظر إلى بطرس» (لوقا ٢٢: ٦١). والأرجح أن ذلك كان عند نهاية المحاكمة وتسليم يسوع إلى الشرطة ليهزأوا به قبل أن غطوا وجهه. وقصد المسيح بنظره إلى بطرس حينئذٍ أربعة أمور:
- أن يذكره بإنبائه له أنه سينكره، ووعد بطرس له بالثبات.
- إظهار حزنه على أن أحد أحبائه أنكره.
- تبكيت بطرس لتنبيه ضميره.
- إظهار شفقته على بطرس ومحبته له. ولم يكن في تلك النظرة شيءٌ من الغضب. وتأثير صياح الديك مع نظر يسوع ذكَّر بطرس بالحوار السابق بينه وبين المسيح (ع ٣٣ - ٣٥) وأقنعه بفظاعة إثمه وقاده إلى التوبة.
خَرَجَ إِلَى خَارِجٍ الخ لم يكن خروجه هرباً من الخطر، بل لفرط حزنه الذي حبَّب إليه الانفراد. وبكى لخجله وأسفه على ما كان من ضعفه وخوفه وكفره بالنعمة، وإثمه بأنه أنكر المسيح بأقسام بعد افتخاره بشجاعته وثباته. والحق أن إثمه كان عظيماً جداً لأنه ارتكبه بعد أن كان تلميذاً للمسيح ثلاث سنين، سمع أثناءها تعاليمه وشاهد معجزاته، وكان واحداً من الثلاثة المتميِّزين على غيرهم، وتعشى معه منذ بضع ساعات، وسمع تحذيره له من هذا الإثم، ووعده قائلاً «ولو متُّ معك لا أنكرك». وكانت دواعي هذا الإنكار قليلة لأن أحداً لم يهدده ولا اعتدى عليه. وشاهد يوحنا هناك، ويوحنا معروف أنه من تلاميذ المسيح، ولم يصبه شيءٌ.. غير أن أسف بطرس لم يكن كأسف يهوذا، لأن أسف يهوذا كان أسف اليأس، وأسف بطرس أسف التوبة الحقيقية. والدليل على ذلك انفراده وشدة ندمه ودوام تأثيره. فكانت توبته كتوبة داود (مزمور ٥١). فالفرق بين المرائي والمسيحي أن الأول يسقط ولا يقوم، والآخر يسقط ويقوم تائباً متواضعاً متجدد الحياة الروحية. وما قيل عن بطرس هنا آخر ما لنا من خبره إلى صباح يوم الأحد حين ذهب مع يوحنا إلى القبر.
وفي هذه الحادثة خمس فوائد:
- ضعف الإنسان في عمل الصلاح. فبطرس الرسول رفيق المسيح سقط، والذي كان أول معترف أن المسيح ابن الله صار أول منكرٍ أنه يعرف الرجل. والذي سُمي بالصخرة ظهر في وقت التجربة أنه قصبة مرضوضة. فمن من الناس يستطيع أن يتكل على نفسه؟ إن أشد العزم وكثرة النذور لا يكفلان الإنسان من السقوط ساعة التجربة.
- إذا دخل المسيحي بين أعداء المسيح ولم يُعلن أنه من أصحابه يُخشى عليه بعد قليل أن يُعتبر من أعدائه.
- خطوة واحدة في سبيل الإثم تقود إلى ثانية، والثانية تقود إلى ثالثة، وهلم جراً، كما كان من أمر بطرس. فخطوته الأولى كانت الاتكال على ذاته كما ظهر من قوله «إن شك فيك الجميع فأنا لا اشك أبداً». والثانية الكسل الروحي، فإن المسيح أمره أن يسهر ويصلي فنام. والثالثة أنه ترك المسيح وهرب خوفاً. والرابعة معاشرته الأشرار دون أن يضطره أحدٌ لذلك. وهذه الخطوة قادته إلى الخامسة، وهي إنكار المسيح ثلاث مرات باللعن والحلف.
- يُظهر السلوك بعد التوبة الحقيقية صدق التوبة وعمقها. والسلوك هو الشرط الضروري لنوال المغفرة لا سببه، لأن سببه هو دم يسوع وشفاعته.
- المسيحي الحقيقي عرضة للسقوط في الخطية كغيره من الناس، لكنه لا يخطئ عمداً بارتكاب ما يعلم إنه خطية. ومتّى سقط في شيء من ذلك تاب وعاد إلى مقاومة الإثم.
الأصحاح السابع والعشرون
١ «وَلَمَّا كَانَ ٱلصَّبَاحُ تَشَاوَرَ جَمِيعُ رُؤَسَاءِ ٱلْكَهَنَةِ وَشُيُوخُ ٱلشَّعْبِ عَلَى يَسُوعَ حَتَّى يَقْتُلُوهُ».
مزمور ٢: ٢ ومرقس ٢٢: ٦٦ و٢٣: ١ ويوحنا ١٨: ٢٨
وَلَمَّا كَانَ ٱلصَّبَاحُ أي صباح يوم الجمعة. قال لوقا في ذلك «ولما كان النهار» (لوقا ٢٢: ٦٦) والأرجح أنهما أرادا وقت شروق الشمس.
جَمِيعُ رُؤَسَاءِ ٱلْكَهَنَةِ وَشُيُوخُ ٱلشَّعْبِ نفهم مما قاله مرقس ولوقا أن هذا الاجتماع كان اجتماع مجلس السبعين، وهو غير الاجتماع الذي كان ليلاً (مرقس ١٥: ١ ولوقا ٢٢: ٦٦) ونفهم من قوله «جميع» أكثر أعضاء المجلس، لأننا نعلم أن بعض الأعضاء لم يوافقوا الآخرين على مقاصدهم في أمر المسيح (لوقا ٢٣: ٥٠، ٥١). والأرجح أن هذا الاجتماع كان في أحد أروقة الهيكل، لأنه مكان الاجتماع القانوني. وقال لوقا إنهم أصعدوه (أي من دار رئيس الكهنة) إلى مجمعهم.
حَتَّى يَقْتُلُوهُ لم يذكر متّى وقوف المسيح أمام هذا المجمع وما جرى في المحاكمة، ولكن لوقا ذكر ذلك بالتفصيل (لوقا ٢٢: ٦٦ - ٧١). وهذه وقفة ثالثة وقفها المسيح أمام رؤساء اليهود فالأولى كانت أمام حنان، والثانية أمام قيافا، والثالثة التي ذُكرت هنا. وكانت لهم في هذا الاجتماع غايتان:
الأولى: جعل ما حكموا به ليلاً شرعياً، لأن التلمود يقول إن الحكم بقتل المذنب لا يكون شرعياً ما لم يكن نهاراً، وإنه لا يجوز امتحان ذلك المذنب والحكم عليه في جلسة واحدة.
الثانية: الاتفاق على أي طريق يرفعون بها الدعوى إلى بيلاطس ليحملوه على أن يحكم عليه بالموت.
ويستنتج مما جرى بعد ذلك أنهم اتفقوا على ثلاثة أمور:
- الأول: أن يسألوا بيلاطس أن يُجري حكمهم بقتل يسوع بلا سؤال (يوحنا ١٨: ٣٠)
- والثاني: فإذا لم يسلم بيلاطس بذلك اشتكوا على يسوع بأنه ادَّعى أنه ملك اليهود، فعصى قيصر، وقاد غيره إلى العصيان، بدليل سؤال الوالي له: «أأنت ملك اليهود؟» (ع ١١) وقولهم لبيلاطس «إِنَّنَا وَجَدْنَا هذَا يُفْسِدُ الأُمَّةَ، وَيَمْنَعُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ، قَائِلاً: إِنَّهُ هُوَ مَسِيحٌ مَلِكٌ» (لوقا ٢٣: ٢).
- والثالث: إن لم ينجحوا في الأمرين الأول والثاني، اشتكوا عليه أنه ادَّعى أنه ابن الله (يوحنا ١٩: ٧) وذلك تجديف يستحق مرتكبه القتل، بموجب ناموسهم. ولكن النتيجة كانت أن بيلاطس لم يسلم لهم بالأمر الأول، وبرَّأه بعد الفحص من الأمر الثاني (لوقا ٢٣: ٤، ١٤، ١٥، ٢٢) ورأى أن الأمر الثالث ليس جنايةً عند الرومان. فلم يبق لهم إلا أن يرجعوا إلى الأمر الثاني وهو دعواهم أنه خان قيصر، فألزموا بيلاطس على غير إرادته أن يحكم عليه بالموت (يوحنا ١٩: ١٢، ١٥) فإذاً المسيح قُتل بدعوى لم يحكم بها مجمع السبعين.
٢ «فَأَوْثَقُوهُ وَمَضَوْا بِهِ وَدَفَعُوهُ إِلَى بِيلاَطُسَ ٱلْبُنْطِيِّ ٱلْوَالِي».
متّى ٢٠: ١٩ ويوحنا ١٨: ٣١ وأعمال ٣: ١٣
أَوْثَقُوهُ الظاهر أنهم حلوا وثاقهُ لما أتوا به إلى الهيكل، لأنهم أتوا به موثقاً من البستان (يوحنا ١٨: ١٢) وذهبوا به كذلك من عند حنان إلى قيافا (يوحنا ١٨: ٢٤).
وَمَضَوْا بِهِ وهم جمهور وافرٌ ليلقوا الرعب في قلوب أصحاب المسيح، لئلا يخلّصوه منهم، ليوهموا بيلاطس أن الذي جاءوا به إليه ارتكب ذنباً فظيعاً.
وَدَفَعُوهُ لكي يحكم عليه بالقتل كجانٍ مستوجب الموت، فأرادوا أن يجعلوا الوالي آلة يجري مقاصدهم، لأن الرومان لم يسمحوا لهم بتوقيع عقوبة الموت (يوحنا ١٨: ٣١). (وكما جاء في تاريخ يوسيفوس المؤرخ اليهودي) وتسليمهم بذلك شهادة على صحة مجيء المسيح حقيقة، بدليل قول رئيس الآباء يعقوب: «لاَ يَزُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُوذَا وَمُشْتَرِعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ شِيلُونُ» (تكوين ٤٩: ١٠). فكان يجب أن ينتبهوا لذلك. وحصلوا بدفع يسوع إلى بيلاطس على شيء من مرماهم، وهو أنه نُقل من أيديهم إلى أيدي الرومان قبل أن يسمع أصحابه بالقبض عليه، فيعجزون عن الدفاع عنه.
بِيلاَطُسَ كان أرخيلاوس بن هيرودس الكبير آخر ملك على اليهودية. نُفي من حكمه سنة ٦م، ومن ذك الوقت أخذ قيصر يقيم الولاة على اليهودية. وكان بيلاطس سادس والٍ على اليهودية عيَّنه طيباريوس قيصر، فتولى حكم اليهودية عشر سنين من ٢٧ - ٣٦م. وتولى ٦ سنوات قبل صلب المسيح وأربعاً بعده. وكان قاسياً (لوقا ١٣: ١) ظالماً سريع التقلب، عصيه اليهود مراراً، وسفك دماء كثيرين إخماداً لفتنهم، فأبغضوه أشد البغض وشكوه مراراً لقيصر. على أنه كان بصيراً في بيان الحق والعدل، لكن لم تكن له قوة أدبية ليحامي عن الحق عند المقاومة. فكان يكره اليهود ويبغضهم، لكنه خاف أن يشكوه للإمبراطور. وعُزل من ولايته في نحو الوقت الذي عُزل فيه قيافا من كهنوته. وكان مقام الوالي غالباً في قيصرية على شاطئ بحر الروم (أعمال ٢٣: ٣٣ و٢٥: ١ و٤: ٦، ١٣). ولكنه كان يذهب إلى أورشليم في أيام الأعياد العظيمة ليمنع الشغب والتشويش ويجري الأحكام. وكان منزل الوالي في أورشليم في القصر الذي يُسمى قصر هيرودس الكبير على جبل صهيون.
٣ «حِينَئِذٍ لَمَّا رَأَى يَهُوذَا ٱلَّذِي أَسْلَمَهُ أَنَّهُ قَدْ دِينَ، نَدِمَ وَرَدَّ ٱلثَّلاَثِينَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ إِلَى رُؤَسَاءِ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُّيُوخِ».
متّى ٢٦: ١٤، ١٥
رَأَى يَهُوذَا... أَنَّهُ قَدْ دِين لا يظهر من قول متّى في أي وقت حدث ما أتاه يهوذا هنا، ولعل ذلك كان بعد أن عرف أنه حُكم على يسوع في بيت قيافا وأُتي به إلى الهيكل لإثبات الحكم عليه شرعاً، فتبعهم يهوذا إلى هناك ودخل الهيكل وتكلم مع الكهنة قبلما ذهبوا بالمسيح إلى بيلاطس، وبقي بعضهم هناك، ورجع البعض إلى الهيكل.
نَدِمَ لا بدَّ أن يهوذا عرف قبل أن سلَّم سيده أن دينونته ستكون نتيجة ذلك التسليم إلى أعدائه، ولكنه لم يندم إلا بعد وقوع النتيجة. ومعنى ندمه هنا تغير مشاعره، فلم يفرح بعد ذلك بما كسبه من الفضة بتسليم ربه، فبقي طمعه إلى ذلك الوقت حجاباً على عينيه حتى لم يرَ فظاعة خيانته. لكن لما حصل على بغيته لم يستطع سروره بها أن يغطي عينيه. ولم يكن ندمه عند ذاك توبة حقيقية وإلا لحمله على طلب المغفرة فينالها. والتوبة الصحيحة تقود المذنب إلى المسيح، ولكن ندمه أبعده عنه. وهي تقود إلى حياة الطهر، وذاك قاده إلى زيادة الإثم لأنه زاد على خيانته بأن قتل نفسه. وكان ندمه كندم قايين وشاول الملك، منتجاً لليأس والعذاب. فعندما وبخهُ ضميره وشعر بالنتائج المرعبة التي جلبها على نفسه، اتخذه إبليس آلة اختيارية له لإتمام مقاصده، ثم تركه بلا تعزية وبلا رجاء. وهكذا تنفتح عينا كل من كان خاطئاً عاجلاً أو آجلاً، فيرى فظاعة خطيته ومرارة نتائجها بعد مرور فرص التوبة (أمثال ١: ٢٦ - ٢٨، ٣١) ومما ذُكر من أمر يهوذا نعرف شيئاً من عذاب الضمير الذي يقع على خطاة الجحيم حيث دودهم لا يموت (مرقس ٩: ٤٤).
رَدَّ ٱلثَّلاَثِينَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ الأرجح أنه أخذ تلك الفضة حتى أُتي بالمسيح إلى دار رئيس الكهنة ليلاً، فجاء بالمبلغ الذي كان قد اشترط عليه (متّى ٢٦: ١٤) مما يدل على أنه هو كل الأجرة (وهي نحو ثلاث جنيعات ذهبية) لا عربونها كما ظن بعضهم. وردَّه تلك الأجرة يدل على أنه قصد الرجوع عن كل ما ارتكب من أمور خيانته، ويثبت أن الطمع كان علة تلك الخيانة.
إن ما اختبره يهوذا في ما ذُكر اختبره كثيرون من الناس بعده، وهو أن بعض ما يتوقع الإنسان الحصول عليه يظهر ثميناً لذيذاً جميلاً، ولكنه يراه بعد الحصول عليه بلا قيمة لأن كل ربح العالم لا يشتري راحة الضمير.
٤ «قَائِلاً: قَدْ أَخْطَأْتُ إِذْ سَلَّمْتُ دَماً بَرِيئاً. فَقَالُوا: مَاذَا عَلَيْنَا؟ أَنْتَ أَبْصِرْ».
١صموئيل ٢٥: ١٧، ٢٤ وأعمال ١٨: ١٥
أَخْطَأْتُ اعترف بخطئه خيفة من نتيجته، لا شعوراً بفظاعته في ذاته.
سَلَّمْتُ دَماً بَرِيئاً أي دم إنسان بريء. ضميره هو الذي ألجأه إلى هذا الاعتراف، وبه دان نفسه وأوقع عليها اللعنة، لأنه مكتوب «مَلْعُونٌ مَنْ يَأْخُذُ رَشْوَةً لِكَيْ يَقْتُلَ نَفْسَ دَمٍ بَرِيءٍ. وَيَقُولُ جَمِيعُ الشَّعْبِ: آمِينَ» (تثنية ٢٧: ٢٥) وظن يهوذا بشهادته ليسوع بالبراءة أنه ينقض ما حكموا به عليه. إن ذلك الدم البريء لو التجأ إليه يهوذا بالتوبة الحقيقية والإيمان لكفَّر عن إثمه وأنقذه من الهلاك الأبدي. وكان له زميل هو اللص المصلوب الذي استنجد بالسيد حينما قال له «اذكرني يا رب متّى جئت في ملكوتك».
وسيرة يهوذا توضح قول الكتاب «غَضَب الإِنْسَانِ يَحْمَدُكَ» (مزمور ٧٦: ١٠) فلا شك أنه سمح بدخول يهوذا الإسخريوطي بين الرسل ليؤدي هذه الشهادة ببراءة المسيح لأنه عاشره معاشرة متواصلة نحو ثلاث سنين. فلو رأى فيه شيئاً من العيب أو سمع منه أدنى كلمة شريرة لكان أول المخبرين بهما لكي يبرر نفسه أمام الآخرين ويسكت ضميره. فلو ذكر الكتاب أن أحد تلاميذ المسيح سلمه إلى الموت ولم يذكر شيئاً مما يتعلق بتبرئته، لاتخذ أعداء المسيحية ذلك دليلاً على أنه خادع. ولو كانت الشهادة بطهارة المسيح وبره من أصدقائه فقط لاتخذ الأعداء ذلك حجة لرفض دينه. فباعتراف يهوذا سُدَّت أفواه المعترضين.
مَاذَا عَلَيْنَا؟ أي حصلنا على مطلوبنا فلا يهمنا شيء آخر. وفي هذا أربعة أمور:
- الأول: إن رؤساء الكهنة لم يبالوا بندم يهوذا شيئاً. ولو اهتموا به ما استطاعوا إزالته وإراحة ضميره.
- الثاني: إن قساوة قلوب أولئك الرؤساء كانت في غاية الغرابة، إذ لم يبالوا سوى بالقبض على المسيح وقتله، ولم يلتفتوا إلى ذلك البرهان الجديد على براءة المسيح فقد قصدوا أن يقتلوه، بريئاً كان أم مذنباً.
- الثالث: إن الذين يتخذهم الأشرار آلة لإجراء مقاصدهم الشريرة لا يجدون ممن اتخذوهم شفقة أو تعزية أو نجاة في وقت البليَّة وسوء العواقب. وصداقة الأشرار لا فائدة منها.
- الرابع: الإثم يكون في قبضة الإنسان قبل أن يرتكبه، ولكنه متّى ارتكبه خرج من سلطانه. ولو ندم واعترف به، وردَّ ما ربحه بواسطته، فلا يمكنه أن يرد الأمر إلى ما كان عليه. فبعد ندَم يهوذا وكل ما نتج عنه لم يزل المسيح موثقاً ويهوذا خائناً.
إن المسيحي الحقيقي عرضة للسقوط في الخطية كغيره من الناس لكنه لا يخطئ عمداً بارتكاب ما يعلم أنه خطية، ومتّى سقط فربما تاب وعاد إلى مقاومة الإثم. وحديث سقوط بطرس مما يزيد ثقتنا بصدق الإنجيل. فلو كان الإنجيل من تصورات البشر وتأليفهم لم يذكر مثل ذلك لمن كانوا أول أنصار الدين والمبشرين به. والواقع إننا نقرأ هذا الحديث في البشائر الأربع مع أن الذي أوضح ذلك الخبر أكثر من سائر الإنجيليين هو مرقس الذي كتب إنجيله بإرشاد بطرس نفسه.
أَنْتَ أَبْصِرْ أي نحن أعطيناك أجرتك وانتهى أمرنا معك. فإن كنت قد سلمت دماً بريئاً فأنت المطالب، فلا نرفع عنك المسؤولية ولا نشاركك فيها. ولو قبل رؤساء الكهنة قوله اعترافاً له بإثمه وحلوه منه لبقي عليه كما كان. وهذا هو المثال الوحيد في الكتاب المقدس لاعتراف بشرٍ لبشر، وهو بلا فائدة. ومثله سائر اعترافات الإنسان لغيره من الناس سواء قالوا «مَاذَا عَلَيْنَا؟ أَنْتَ أَبْصِرْ!» أم قالوا «نحن نحلُّك». ولكنه لو اعترف للمسيح بدلاً من أن يعترف لأولئك الرؤساء لغفر لهُ.
٥ «فَطَرَحَ ٱلْفِضَّةَ فِي ٱلْهَيْكَلِ وَٱنْصَرَفَ، ثُمَّ مَضَى وَخَنَقَ نَفْسَهُ».
٢صموئيل ١٧: ٢٣ وأعمال ١: ١٨
فَطَرَحَ ٱلْفِضَّةَ فعل ذلك لأن ما رغب فيه في أول الأمر كرهه في نهايته.
فلو أمكنه أن يطرح ذنب الخيانة عن نفسه بطرحه الفضة من يديه لأصاب بما عمل. فالخاطئ الذي لا يغفر المسيح له لا بد من أن يأخذ أجرة خطيته، وهي الحزن واليأس والموت، لأن الذي يزرع للجسد فمن الجسد يحصد فساداً. وأمثلة ذلك عخان وجيحزي وحنانيا وسفيرة ويهوذا. ونتعلم من هذا أنه مهما ربح الإنسان من الخطية اختلاساً من الناس بالخداع، أو اختلاساً من الله بتدنيسه يومه، ففرحه بذلك الربح لا يساوي حزنه من توبيخات ضميره، وذلك وفق قول الحكيم «كُنُوزُ الشَّرِّ لاَ تَنْفَعُ» (أمثال ١٠: ٢).
فِي ٱلْهَيْكَلِ أي مكان في الهيكل، وهو إما محفلهم هناك قبل انصرافهم وذهاب بعضهم إلى بيلاطس مع يسوع وبقاء البعض في الهيكل لأجل الخدمة. والأرجح هو الأخير.
وَٱنْصَرَفَ من الهيكل ومن المدينة.
وَخَنَقَ نَفْسَهُ لأنه شعر بأن حياته حملٌ لا يطاق فإنه أملَ أن يستريح بطرح الفضة، فلم يجد راحة. فرأى بعد ذلك أن يقتل نفسه بغية الراحة، وخاب أيضاً، لأنه لا ملجأ من اليأس إلا جنب المسيح المطعون. والقبر ليس ملجأ من ذلك. وقصة يهوذا تذكرنا بقصة شاول الملك خاصة في ندامته بعد أوانها وفي قتله نفسه (١صموئيل ١٥: ٣٠).
ذكر متّى هنا أن يهوذا خنق نفسه ولم يذكر شيئاً من أحوال ذلك. وأما بطرس فقال في مخاطبته التلاميذ بعد نحو أربعين يوماً «فإن هذا (أي يهوذا) اقتنى حقلاً من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشقَّ من الوسط، فانسكبت أحشاؤه كلها» (أعمال ١: ١٨). ونستنتج من كل ما ذُكر أن يهوذا علَّق نفسه فوق مكان شاهق، فانقطع الحبل فهوى وكان ما كان. والظن أنه الجبل الذي هو عبر وادي هنوم جنوب أورشليم تجاه جبل صهيون.
٦ «فَأَخَذَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ ٱلْفِضَّةَ وَقَالُوا: لاَ يَحِلُّ أَنْ نُلْقِيَهَا فِي ٱلْخِزَانَةِ لأَنَّهَا ثَمَنُ دَمٍ».
لاَ يَحِلُّ هذا مبنيٌ على ما جاء في شريعة موسى (تثنية ٢٣: ١٨) ولذلك كانوا لا يلقون في خزانة الهيكل شيئاً من المسكوكات الأجنبية، وفي الوقت ذاته كان ذلك ثمن دم اشتروه. ولما جاء الشاري يريد أن يبيعه لهم أبوا، فكانوا قساة في الناحيتين. وهكذا علقت بهم جريمة الصلب للأبد.
فِي ٱلْخِزَانَةِ أي الصناديق الموضوعة في دار النساء (متّى ١٥: ٥) وكانوا يحسبون ما يُلقى فيها مقدساً، وسمّوه «قرباناً» أي «تقدمة لله». فرؤساء الكهنة قتلوا المسيح بلا شعور بالخطية، ودنسوا أنفسهم بدمه وهم يظهرون الخوف من ذنب زهيد، كوضع فضة يهوذا في الخزانة.
ثَمَنُ دَمٍ أي أجرة قاتل إنسان، وهي هنا الفضة التي أعطوها ليهوذا ليسلم المسيح.
٧ «فَتَشَاوَرُوا وَٱشْتَرَوْا بِهَا حَقْلَ ٱلْفَخَّارِيِّ مَقْبَرَةً لِلْغُرَبَاءِ».
فَتَشَاوَرُوا أي أعضاء المجلس، وكان موضوع مؤامراتهم: ماذا يفعلون بالفضة التي ردها يهوذا، ولعلهم فعلوا ذلك بعد صلب يسوع بقليل.
حَقْلَ ٱلْفَخَّارِيّ هو أرض تُعرف بهذا الاسم. والأرجح أنها سميت كذا لأن الخزافين قديماً كانوا يأخذون منها التراب لعمل الفخار. وإذا أخذ من الأرض ترابها لا تبقى صالحة للزراعة فتُباع رخيصة.
مَقْبَرَةً لِلْغُرَبَاءِ الأرجح أن هؤلاء الغرباء ليسوا من الأمم، لأنه لم يكن من مسؤوليات رؤساء الكهنة أن يُعدوا مقبرة لهم. فهي لغرباء اليهود من دخيل أو أصيل إذا مات في أورشليم فقيراً أو مخذولاً. ويحتمل أن يهوذا أول من دُفن هناك، ولذلك قيل إنه «اقتنى حقلاً» (أعمال ١: ١٨).
٨ «لِهٰذَا سُمِّيَ ذٰلِكَ ٱلْحَقْلُ «حَقْلَ ٱلدَّمِ» إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ».
أعمال ١: ١٩
حَقْلَ ٱلدَّمِ أي الذي اشتُري بثمن الدم.
هٰذَا ٱلْيَوْمِ أي الوقت الذي كتب فيه متّى إنجيله وهو نحو عام ٦٠م.
٩ «حِينَئِذٍ تَمَّ مَا قِيلَ بِإِرْمِيَا ٱلنَّبِيِّ: وَأَخَذُوا ٱلثَّلاَثِينَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ، ثَمَنَ ٱلْمُثَمَّنِ ٱلَّذِي ثَمَّنُوهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ».
حِينَئِذٍ تَمَّ مَا قِيلَ الذي فعله رؤساء الكهنة بدون قصد كان إتماماً لنبوة رآه متّى متمماً لبعض نبوات العهد القديم.
بِإِرْمِيَا ٱلنَّبِيِّ ما ذكره متّى اقتبسه معنى لا لفظاً، وهو من زكريا لا من إرميا (زكريا ١١: ١٣). ظن بعضهم أن متّى اقتصر على ذكر «النبي» دون اسمه كما هو في الترجمة السريانية وبعض النسخ اليونانية. والذي يؤيد هذا أن متّى اقتبس من زكريا ثلاث مرات غير هذه، ولم يذكر اسمه (متّى ٢١: ٥ و٢٦: ٣١ و٢٧: ٩، ١٠). وإن بعض الكتبة أدخل اسم إرميا بناءً على ما قيل في (متّى ١٨: ٢ - ٦) منه.
وظن آخرون أن متّى نفسه كتب اسم زكريا مختصراً، أي أشار إليه بالحرفين الأولين من اسمه في التهجئة اليونانية، والفرق بينهما وبين الحرفين الأولين من إرميا في تلك اللغة زهيد فغلط الكاتب بالنسخ. وكان الاختصار المذكور شائعاً يومئذٍ كما هو شائع الآن.
وظن غيرهم إن سفر إرميا كان اسماً لمجموع النبوات في كتاب واحد، لأنه كان أول ذلك المجموع في كتبهم القديمة. والترتيب المعروف هو ترتيب السبعين الذين ترجموا العهد القديم إلى اليوناني. والظاهر أن الأول هو الأرجح.
وَأَخَذُوا ٱلثَّلاَثِينَ الخ الثلاثون من الفضة في كلام النبي زكريا هي أجرته من الشعب لممارسة وظيفته بينهم. وهذا المبلغ كان ثمن عبدٍ، فلذلك كان تأدية هذه الأجرة له وهو نبي الله إهانة لله. وأمر النبي أن يلقيها للفخاري علامة للرفض قائلاً «الثَّمَنَ الْكَرِيمَ الَّذِي ثَمَّنُونِي بِهِ» (زكريا ١١: ١٣). ولا شك أن الكلام المذكور يخبر بما جرى على المسيح، لأن زكريا النبي ذكر أنه كان بمنزلة راعٍ، والراعي رمزٌ إلى المسيح الذي هو الراعي الصالح لشعب الله. والثمن الزهيد الذي أُعطي لزكريا (وهو ثمن أرض) كالثمن الزهيد الذي أعطاه الرؤساء من دم المسيح. والفضة التي ردها النبي إشارة إلى تلك التي ألقاها يهوذا في الهيكل وأبى الرؤساء أن توضع في الخزانة. وإلقاء النبي تلك الفضة في هيكل الرب إلى الفخاري يشبه شراء الرؤساء حقل الفخاري بالفضة التي ألقاها يهوذا في الهيكل.
١٠ «وَأَعْطَوْهَا عَنْ حَقْلِ ٱلْفَخَّارِيِّ، كَمَا أَمَرَنِي ٱلرَّبُّ».
زكريا ١١: ١٢، ١٣
عَنْ حَقْلِ ٱلْفَخَّارِيِّ وفي كلام النبي أنها أُلقيت إلى الفخاري ثمن حقله.
كَمَا أَمَرَنِي ٱلرَّبُّ أشار بذلك إلى قوله في الأصل «فَقَالَ لِي الرَّبُّ: أَلْقِهَا» (زكريا ١١: ١٣).
١١ «فَوَقَفَ يَسُوعُ أَمَامَ ٱلْوَالِي. فَسَأَلَهُ ٱلْوَالِي: أَأَنْتَ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ؟ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: أَنْتَ تَقُولُ».
مرقس ١٥: ٢ ولوقا ٢٣: ٣ ويوحنا ١٨: ٣٣ ويوحنا ١٨: ٣٧ و١تيموثاوس ٦: ١٣
فَوَقَفَ يَسُوعُ أَمَامَ ٱلْوَالِي هذا وقوف المسيح الرابع للمحاكمة. وكان أول وقوف له أمام والٍ، ووقف بعده مرتين أمامه. وحكم بيلاطس ثلاثاً بأنه بريء. واجتهد ثلاثاً في أن يطلقه. ورفض اليهود إطلاقه ثلاثاً وطلبوا موته. والمكان الذي وقف فيه كان قصر هيرودس الذي كان يقيم فيه الوالي في أورشليم، وكان على جبل صهيون يوصل بينه وبين الهيكل قنطرة. وكان وقت إتيانهم إلى الوالي نحو ساعة بعد شروق الشمس. وذكر يوحنا بالتفصيل ما تركه متّى واختصره. فنعلم مما قاله يوحنا أن رؤساء الكهنة خاطبوا الوالي خارجاً ولم يدخلوا القصر خيفة أن يتنجسوا به، لأن الوالي من الأمم فلا بد من أن يكون في قصره شيء من الخمير، فلو دخلوا تنجسوا ولم يمكنهم أن يأكلوا من الولائم المقدسة المختصة بالفصح وبقيت سبعة أيام! وخرج بيلاطس واستقبلهم خارجاً (يوحنا ١٨: ٢٩) وسألهم أي شكاية لهم على يسوع. فأجابوه بأول الأمور الثلاثة التي اتفقوا عليها، وسألوه أن يحكم على يسوع دون أن يذكروا له ذنباً وقالوا «لَوْ لَمْ يَكُنْ فَاعِلَ شَرّ لَمَا كُنَّا قَدْ سَلَّمْنَاهُ إِلَيْكَ!» (يوحنا ١٨: ٣٠) لكن بيلاطس أبى أن يحكم عليه بناءً على هذه التهمة، وقال لهم «خُذُوهُ أَنْتُمْ وَاحْكُمُوا عَلَيْهِ حَسَبَ نَامُوسِكُمْ» (يوحنا ١٨: ٣١). فكأنه قال: أنا لا أحكم على أحد ما لم أعلم ذنبه، فأجروا أنتم ما تستطيعونه من الأحكام. فأبوا أن يفعلوا كما قال، لأنهم قصدوا قتل يسوع، وهم لا يستطيعون ذلك بموجب القانون الروماني، فخاب أملهم من هذا الأمر.
أَأَنْتَ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ؟ هذا السؤال يدل على ماهَّية الشكوى الثانية على يسوع، وهي التهمة الثانية التي اتفقوا عليها، وهي ادعاؤهم أنه المسيح ملك اليهود، كما يتبين من سؤال بيلاطس ليسوع هنا (يوحنا ١٨: ٣٣) ومن قول لوقا «ابْتَدَأُوا يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ قَائِلِينَ: إِنَّنَا وَجَدْنَا هذَا يُفْسِدُ الأُمَّةَ، وَيَمْنَعُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ، قَائِلاً: إِنَّهُ هُوَ مَسِيحٌ مَلِكٌ» (لوقا ٢٣: ٢) وظن الرؤساء أن بيلاطس ربما يخاف من التساهل بهذه القضية لأنها دعوة سياسية ودينية معاً، ولأنه علم أن اليهود كانوا ينتظرون ملكاً يحررهم من عبودية الرومان ويعيدهم إلى مجدهم القديم. فظنوا بيلاطس يتوهم أن يسوع يقصد ذلك ويحكم عليه خوفاً من الرومان وغيظاً منه. وفي هاتين الشكايتين لم يُذكر شيءٌ من أمر التجديف الذي حكموا عليه به في مجلسهم.
وسأله بيلاطس «أأنت ملك؟» ليرى هل من شيءٍ في ادعائه المُلك ينافي حق الرومان أو يعرضه للخطر. فسأل يسوع بيلاطس قبل أن يجاوبه على سؤاله نفياً أو إيجاباً ما يلزم منه أن يبين بيلاطس له أي معنى قصد بالمُلك؟ أمعنى رومانياً سياسياً، أم معنى يهودياً روحياً؟ وهو قوله «أَمِنْ ذَاتِكَ تَقُولُ هذَا، أَمْ آخَرُونَ قَالُوا لَكَ عَنِّي؟» (يوحنا ١٨: ٣٤ - ٣٧).
أَنْتَ تَقُولُ أقر يسوع أنه ملك (١تيموثاوس ٦: ١٣) ولكنه فسَّر لبيلاطس أن ملكه روحي لا دنيوي بقوله «ملكوتي ليس من هذا العالم». وعلى ذلك لم يكن فيه شيءٌ مناف لحقوق قيصر (يوحنا ١٨: ٣٣ - ٣٨). فيسوع لم يصرح بأنه ملك إلا بعد أن وقع في أيدي أعدائه، لأنه أزمع أن يملك بواسطة الصليب. وأما صفات ملكوت المسيح فهي: (١) إن له سلطاناً على قلوب الناس. (٢) إن له سلطاناً على من يطيعونه باختيارهم. (٣) إنه يتأسس على موت المسيح. (٤) إن الروح القدس يصونه ويوسعه. (٥) إن شريعته مشيئة الله. (٦) إن سياسته كلها روحية. (٧) إن غايته مجد الله والحمل. (٨) إن نجاحه يتضمن تمجيد كل المفديين.
وكانت نتيجة امتحان بيلاطس للمسيح أنه صرح بتبرئته الأولى بقوله «أنا لست أجد فيه علة واحدة» (يوحنا ١٨: ٣٨). فكان يجب عليه أن يطلقه حينئذٍ.
١٢ «وَبَيْنَمَا كَانَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُّيُوخُ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ لَمْ يُجِبْ بِشَيْءٍ».
متّى ٢٦: ٦٣ ويوحنا ١٩: ٦
يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ هيَّجت تبرئة بيلاطس ليسوع غضب الرؤساء عليه، فرفعوا أصواتهم بشكايات مختلفة لم يذكرها متّى. لكن فهمنا بعضها من قول لوقا «كَانُوا يُشَدِّدُونَ قَائِلِينَ: إِنَّهُ يُهَيِّجُ الشَّعْبَ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ مُبْتَدِئًا مِنَ الْجَلِيلِ إِلَى هُنَا» (لوقا ٢٣: ٥).
لَمْ يُجِبْ بِشَيْءٍ هذا كان وفق نبوة إشعياء (إشعياء ٥٣: ٧) وقد ذكرها بطرس أيضاً (١بطرس ٢: ٢٣). وكانت علة سكوته معرفته أن اليهود صمموا على قتله، وأنه لا ينفعه شيءٌ من كل ما يمكنه قوله. وإنه شهد سابقاً للحق فلم تبقَ حاجة إلى ذلك حينئذٍ. وكانت شكايتهم كلها بلا إثبات ببراهين ولا شهود، فلم يحاول دفعها، لأنه لو دفعها جاءوا بغيرها كثيراً. وإذا اقتنع بيلاطس بأجوبته فليس له شجاعة أدبية على أن يطلقه.
١٣، ١٤ «١٣ فَقَالَ لَهُ بِيلاَطُسُ: أَمَا تَسْمَعُ كَمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ؟ ١٤ فَلَمْ يُجِبْهُ وَلاَ عَنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى تَعَجَّبَ ٱلْوَالِي جِدّا».
متّى ٢٦: ٦٢ ويوحنا ١٩: ١٠
فَقَالَ لَهُ بِيلاَطُسُ ظن بيلاطس أن المسيح يجيبه إذا لم يرد إجابة اليهود. ولكن كانت النتيجة واحدة، أي أن المسيح بقي ساكتاً. ولعل غاية بيلاطس من سؤاله هي الوقوف على علة جديدة يبنى عليها الحكم بعقابه أو بإطلاقه.
كَمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ؟ سمَّى بيلاطس شكايات اليهود «شهادات» مع أنها كانت بلا إثبات. ولعل هذا كان من الأسباب التي حملت يسوع على السكوت، ليُظهر لبيلاطس أنه كان يجب عليه أن يطلب من المشتكين أن يثبتوا دعاويهم، ولا يسأل المشكو عليه ليدينه من اعترافه. وكانت الشكوى عليه أنه يهيج الشعب للعصيان . والبراهين على بطلان تلك الشكوى واضحة لا تحتاج إلى كلام، وهي سيرته المشهورة للناس واعتراضه على الذين أرادوا أن يصيروه ملكاً. وأنه ليس له أسلحة وجيش، ولم يقل كلمة تغري الناس بالعصيان.
تَعَجَّبَ ٱلْوَالِي لأنه رأى يسوع جرى على خلاف عادة المشكو عليهم، ولا سيما المتهمون بإثارة العصيان على الدولة، فقد رفض الدفاع عن نفسه وهو عرضة للموت. والمتهمون بمثل ذلك يتوقع أن يكونوا قساة لا يخشون الكلام.
وإذ كان بيلاطس محتاراً فيما يعمل، وسمعهم أثناء شكاويهم يرددون اسم «الجليل» (لوقا ٢٣: ٦) خطر على باله أنه يمكنه التخلص من هذه الدعوى بإرسال يسوع إلى هيرودس أنتيباس ملك الجليل، الذي كان وقتها في أورشليم ليعيِّد الفصح، فأرسله إليه ليحاكمه، وتبعه رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه. وفي هذا برهان على ضعف بيلاطس، فهو يتهرب من الحق، ويحاول أن يخفف عن ضميره بإحالة الشكاوى إلى هيرودس بزعم أنه يهودي فيمكنه الفصل في الأمر أكثر منه، لا سيما وأن يسوع كان تابعاً لسلطنة هيرودس.
فسأله هيرودس مسائل كثيرة وهزأ به هو وعساكره، فبقي يسوع ساكتاً ولم يجبه بشيءٍ. وهذا وقوف يسوع الخامس للمحاكمة. فبرأه هيرودس برده إياه إلى بيلاطس بدون أن يحكم عليه بشيء (لوقا ٢٣: ٦ - ١٢، ١٥). وهذه تبرئة ثانية ليسوع شهد بيلاطس بها بقوله «ولا هيرودس أيضاً» (لوقا ٢٣: ١٥). وبعد رجوع يسوع من عند هيرودس دعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء إلى دار الاجتماع خارج الولاية (لوقا ٢٢: ١٣) وجلس على كرسي الولاية وهو كرسي يمكن نقله، كان يجلس عليه الولاة الرومان وقت القضاء الشرعي. وقال للشعب: «وَقَالَ لَهُمْ:«قَدْ قَدَّمْتُمْ إِلَيَّ هذَا الإِنْسَانَ كَمَنْ يُفْسِدُ الشَّعْبَ. وَهَا أَنَا قَدْ فَحَصْتُ قُدَّامَكُمْ وَلَمْ أَجِدْ فِي هذَا الإِنْسَانِ عِلَّةً مِمَّا تَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ.، وَلاَ هِيرُودُسُ أَيْضًا، لأَنِّي أَرْسَلْتُكُمْ إِلَيْهِ. وَهَا لاَ شَيْءَ يَسْتَحِقُّ الْمَوْتَ صُنِعَ مِنْهُ» (لوقا ٢٣: ١٤ و١٥). وهذه تبرئتهُ الثالثة العلنية من أنه يهيج فتنة على قيصر (أعمال ٣: ١٣) وهذا يذكرنا بقصة بلعام الذي بارك إسرائيل ثلاث مرات بعد ما استأجره بالاق للعنة (عدد ٢٤: ١٠). فكان يجب على بيلاطس أن يطلقه حينئذٍ.
١٥ «وَكَانَ ٱلْوَالِي مُعْتَاداً فِي ٱلْعِيدِ أَنْ يُطْلِقَ لِلْجَمْعِ أَسِيراً وَاحِداً، مَنْ أَرَادُوهُ».
مرقس ١٥: ٦ الخ ولوقا ٢٣: ١٧ ويوحنا ١٨: ٣٩.
فِي ٱلْعِيدِ أي أسبوع العيد كله، لأن «العيد» اسم لذلك الأسبوع.
يُطْلِقَ... أَسِيراً لم يُعلم زمن ابتداء هذه العادة ولا علتها، ولا بد من أن غايته كانت كرشوة لليهود ليتحملوا نير الرومان، فأطلقوا لهم في ذلك العيد الأسير الذي يريدونه تذكاراً لخروج بني إسرائيل من مصر.
١٦ «وَكَانَ لَـهُمْ حِينَئِذٍ أَسِيرٌ مَشْهُورٌ يُسَمَّى بَارَابَاسَ».
كان هذا الإنسان أحد جماعة أثاروا فتنة على الرومان وقتلوا بعضهم (مرقس ١٥: ٧ ولوقا ٢٣: ١٩). فكان هذا الإنسان مرتكباً فعلاً ما اتهموا به يسوع كذباً، وكان فوق ذلك لصاً قاتلاً.
١٧، ١٨ «١٧ فَفِيمَا هُمْ مُجْتَمِعُونَ قَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ: مَنْ تُرِيدُونَ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ؟ بَارَابَاسَ أَمْ يَسُوعَ ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْمَسِيحَ؟ ١٨ لأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُمْ أَسْلَمُوهُ حَسَداً».
لَـهُمْ أي للمجتمعين في القصر من عامة الناس ليطلبوا إطلاق أسير حسب العادة (مرقس ١٥: ٨)
بَارَابَاسَ أَمْ يَسُوعَ علم بيلاطس أن رؤساء اليهود سلموا يسوع حسداً، وأن العامة احترمته، فتحوَّل عن الرؤساء وسأل العامة آملاً أنهم يطلبون إطلاق يسوع فيتخلص من إلحاح الرؤساء في طلب قتله، لأنه كان يريد أن يطلق يسوع (لوقا ٢٣: ٢٠). فارتكب بيلاطس بهذا السؤال ذنباً عظيماً على يسوع إذ جعله مساوياً لقاتل مشهور بالشرور والمعاصي، وجعل البريء بموجب شهادته أثيماً محكوماً عليه بالموت. وأخطأ في ظنه أن الشعب يختار إطلاق محسنٍ كيسوع على إطلاق مسيء كباراباس.
١٩ «وَإِذْ كَانَ جَالِساً عَلَى كُرْسِيِّ ٱلْوِلاَيَةِ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ٱمْرَأَتُهُ قَائِلَةً: إِيَّاكَ وَذٰلِكَ ٱلْبَارَّ، لأَنِّي تَأَلَّمْتُ ٱلْيَوْمَ كَثِيراً فِي حُلْمٍ مِنْ أَجْلِه».
جَالِساً لعلَّ ما يأتي حدث وهو ينتظر جواب الشعب على سؤاله.
عَلَى كُرْسِيِّ ٱلْوِلاَيَةِ كان هذا الكرسي «فِي مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ «الْبَلاَطُ» وَبِالْعِبْرَانِيَّةِ «جَبَّاثَا» (يوحنا ١٩: ١٣). وهذا كان قدام القصر ليحضره اليهود ولا يتدنسون.
أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ٱمْرَأَتُهُ إنه لأمر غريب أن تكون الوحيدة التي تكلمت كلمة حسنة في المسيح وابتغت إطلاقه من بيلاطس هي امرأة وثنية، مع أن تلاميذه تركوه، وجمهور أُمتِه صرخ قائلاً «اصلبهُ». ولعلها سمعت أخبار المسيح من خِدم بيتها أو من زائراتها.
إِيَّاكَ وَذٰلِكَ لا ريب في أنه بلغها أخبار معجزات المسيح وقوته الغريبة، وتحققت أنه بار مما سمعته من أخباره، فخافت على زوجها وسائر العائلة من نقمة إلهية إن حُكم عليه.
ٱلْبَارَّ هذه الشهادة من أغرب الأمور، وقد قدمتها امرأة بيلاطس تبرُّعاً.
تَأَلَّمْتُ... فِي حُلْمٍ حَلِمت في الليلة البارحة حلماً أخافها كثيراً، ثم وجدت صور ذلك الحلم الهائل تتعلق بأمر الشخص الواقف أمام زوجها للمحاكمة. ومرادها باليوم الليلة الماضية لأنها كانت عندهم جزءاً من اليوم.
اعتبر القدماء أن الأحلام إعلانات إلهية أكثر مما نعتبرها الآن. ومن غرائب الاتفاق أن تحلم بشخص لم تعرف من أمره شيئاً، ولم يكن قد قُبض عليه عند حلمها. ولا عجب أن الله الذي أرى فرعون وساقيه وخبازه وبختنصر وغيرهم من الوثنيين أحلاماً غير عادية، يُري تلك المرأة حلماً يحذر زوجها به من ارتكاب تلك الخطية الفظيعة.
٢٠ «وَلٰكِنَّ رُؤَسَاءَ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُّيُوخَ حَرَّضُوا ٱلْجُمُوعَ عَلَى أَنْ يَطْلُبُوا بَارَابَاسَ وَيُهْلِكُوا يَسُوعَ».
مرقس ٥: ١١ ولوقا ٢٣: ١٨ يوحنا ١٨: ٤٠ وأعمال ٣: ١٤
كان اختيار إطلاق الأسير للشعب لا للرؤساء، فخاف الرؤساء أن يذهب كل جهدهم باطلاً ويخيب رجاؤهم إن اختار الشعب يسوع. فأسرعوا يخاطبون الشعب، واجتهدوا في أن يقنعوهم بأن يطلبوا إطلاق باراباس. ولعلهم قالوا للشعب إن باراباس محب للوطن وإن الرومان قبضوا عليه لأنه سعى في تحرير اليهود وحارب لأجل حقوقهم وإن يسوع جليلي (وأغلب اليهود يكرهون الجليليين) وأن مجلس السبعين حكم عليه بالموت. ومهما كان كلامهم فخلاصته مدح باراباس وذم يسوع. فلم يتركوا شيئاً من الوسائل التي حثهم عليها مكرهم وحسدهم وبغضهم وخبثهم.
٢١ «فَسَأَلَ ٱلْوَالِي: مَنْ مِنَ ٱلاثْنَيْنِ تُرِيدُونَ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ؟ فَقَالُوا: بَارَابَاسَ».
فَسَأَلَ ٱلْوَالِي كان ذلك بعد أن أعطاهم فرصة كافية للنظر في من يختارونه. وتلك الساعة كانت من أهم الساعات في تاريخ الأمة اليهودية، فيها يختارون يسوع مسيحاً وملكاً لهم، أو يرفضونه.
مَنْ مِنَ ٱلاثْنَيْنِ أي يسوع أم باراباس.
فَقَالُوا: بَارَابَاسَ اختاروا اللص القاتل ورفضوا الفادي الذي هو بلا عيب. وكان ذلك عمل الشعب والرؤساء معاً. وقد ذكر بطرس هذا في موعظته يوم الخمسين: «أَنْتُمْ أَنْكَرْتُمُ الْقُدُّوسَ الْبَارَّ، وَطَلَبْتُمْ أَنْ يُوهَبَ لَكُمْ رَجُلٌ قَاتِلٌ، وَرَئِيسُ الْحَيَاةِ قَتَلْتُمُوهُ.. وَالآنَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكُمْ بِجَهَالَةٍ عَمِلْتُمْ، كَمَا رُؤَسَاؤُكُمْ أَيْضًاً» (أعمال ٣: ١٤، ١٥، ١٧).
٢٢ «قَالَ لَـهُمْ بِيلاَطُسُ: فَمَاذَا أَفْعَلُ بِيَسُوعَ ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْمَسِيحَ؟ قَالَ لَهُ ٱلْجَمِيعُ: لِيُصْلَبْ!».
فَمَاذَا أَفْعَلُ بِيَسُوعَ سؤال خطير للغاية، وهو سؤال للأجيال كلها لا لذلك الجيل وحده. وعلى الجواب يتوقف إخلاصنا للمبدأ السامي الذي اعتنقناه، ونريد أن نحيا ونموت من أجله.. في هذا السؤال تعجُّب وشيء من سؤال الشعب أن يعيدوا نظر الاختيار بين يسوع وباراباس. ولعله نتج عن أمله أن يطلبوا إطلاق الاثنين، فيكون له حجة لمقاومة الرؤساء وإطلاق يسوع بلا خوف من أن يشكوه إلى الإمبراطور. أو أنهم إذا لم يطلبوا إطلاقه طلبوا قصاصاً خفيفاً له يجريه عليه ويطلقه.
ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْمَسِيحَ قال ذلك ترغيباً للشعب في إطلاقه. وكان عليه أن يسأل ضميره لا الشعب: ماذا يفعل بيسوع ويطرد اليهود كما طردهم الوالي غاليون عندما أتوا ببولس إلى كرسي الولاية (أعمال ١٨: ١٢ - ١٦). ولا بد أن يعرض هذا السؤال عينه على كل واحد منا في وقت من أوقات حياته، ويضطر أن يختار ماذا يفعل بيسوع: هل يقبله مخلصاً وحيداً أم يرفضه.
لِيُصْلَب إذا قيل: لماذا طلب اليهود صلب يسوع وهذا العقاب ليس من وسائل معاقبات اليهود؟ ولم يطلبوا رجمه أو قتله بطريق أُخرى من طرق القتل المعتادة عندهم. قلنا: هذا لأن بيلاطس جعل يسوع بمنزلة واحدة مع باراباس، لأن الرومان حكموا على باراباس بالموت، فلو أُجري عليه الحكم لقتلوه صلباً. فلو طلبوا إطلاق يسوع لصُلب باراباس، ولكنهم طلبوا إطلاق باراباس فوقع الصلب على المسيح. ولعل الذين بدأوا يصرخون: «ليُصلب» هم الرؤساء، وتبعهم الشعب حالاً في ذلك، وكرر هؤلاء العبارة. على أي حالٍ لقد حثَّ الرؤساء الشعب (كما ذُكر في ع ٢٠). وغاية الرؤساء من صلب يسوع الذي هو أقبح طرق العقاب أمران: الأول التشفي من البغض. والثاني أن يجعلوا اسم المسيح مكروهاً إلى حدٍّ لا يلتفت فيه أحدٌ إلى دعواه. ولا بد أنه كان لله مقاصد في ذلك نفذوها هم بدون قصد إتماماً لإنباء المسيح (متّى ٢٠: ١٩ و٢٦: ٢ ويوحنا ٣: ١٤ و٨: ٢٨)، وتحقيقاً لنبوة إشعياء من أنه يكون محتقراً ومخذولاً من الناس (إشعياء ٥٣). والأرجح أن الذين صرخوا قائلين «ليُصلب» ليسوا هم الذين هتفوا منذ خمسة أيام قائلين «أوصنا» (متّى ٢١: ٨ ولوقا ١٢: ١٢، ١٣) على أنه يحتمل أن يكون منهم من اشترك في الأمرين. ولكنه من العجب أنه لم يصرخ أحد بين أولئك الألوف قائلاً: «ليُطلَق».
٢٣ «فَقَالَ ٱلْوَالِي: وَأَيَّ شَرٍّ عَمِلَ؟ فَكَانُوا يَزْدَادُونَ صُرَاخاً قَائِلِينَ: لِيُصْلَبْ».
فَقَالَ ٱلْوَالِي: وَأَيَّ شَرٍّ عَمِلَ؟ هذا استفهام إنكاري معناه أن يسوع لم يعمل شراً. قال لوقا إنه سألهم ذلك ثلاث مرات. وذكر متّى أن الشعب طلب صلب يسوع ثلاث مرات. (ع ٢١، ٢٢، ٢٣) وذكر لوقا أن بيلاطس قال إنه لم يجد فيه علةً تستحق الموت، وأن هيرودس لم يجد ذلك أيضاً. ثم عرض عليهم أن يجلده أملاً أن يكتفوا بمشاهدة تعذيبه ثم يطلبون إطلاقه، فيكون قد خلصهُ من عقاب أعظم. وكان ذلك اعترافاً من بيلاطس بجُبنه وضعفه لأنه سمح بجلد إنسان حكم علناً بأنه بار. وقد ظلم بيلاطس المسيح ظلمين: الأول: مساواته بباراباس، والثاني التسليم بجلده كمذنب.
لِيُصْلَبْ قصد بيلاطس بسؤاله أن يجيبوه ببيان ذنب يسوع، ولكنهم أجابوه بتكرار قولهم «ليُصلب» وهذا نتيجة عجزهم عن تبيين ذنب له، وإقرار بأنه لا ذنب عليه، وإلا فلو عرفوا له ذنباً لذكروه. وهذا تبرير آخر عند المحاكمة فوق ما سبقه من يهوذا، ومن بيلاطس، ومن امرأته. فهو لم يتألم لإثمٍ عليه، بل لآثام العالم.
٢٤ «فَلَمَّا رَأَى بِيلاَطُسُ أَنَّهُ لاَ يَنْفَعُ شَيْئاً، بَلْ بِٱلْحَرِيِّ يَحْدُثُ شَغَبٌ، أَخَذَ مَاءً وَغَسَلَ يَدَيْهِ قُدَّامَ ٱلْجَمْعِ قَائِلاً: إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ دَمِ هٰذَا ٱلْبَارِّ. أَبْصِرُوا أَنْتُمْ».
تثنية ٢١: ٦ - ٩
يَحْدُثُ شَغَبٌ حدث الشغب في اليهودية مرات قبل ذلك، فأصاب بيلاطس لومٌ شديد من طيباريوس قيصر، فخاف أن زيادة هذا الشغب يجلب عليه لوماً أشد، ربما يسبِّب عزله. ومن العجب أن الرؤساء كانوا يخافون الشغب من القبض على المسيح، وأن اجتهاد بيلاطس في إطلاق المسيح كاد يكون علَّة الشغب، وكانت العلة لذلك لو لم يرجع عنه.
أَخَذَ مَاءً وَغَسَلَ يَدَيْهِ فعل هذا العمل كناية عن أنه بريء من كل ما يجرونه بعد ذلك على يسوع. وكان اليهود يفهمون المراد بذلك (تثنية ٢١: ٦ ومزمور ٧٣: ١٣). ولا نظن أن بيلاطس أخذ تلك الإشارة عن اليهود، لأنها مسألة منطقية. ولكن طلب بيلاطس أن يدفع المسؤولية عنه بذلك الفعل لا يجديه نفعاً. نعم إنه غسل يديه بالماء، ولكن ذلك لم يغسل قلبه من الذنب، وقد دان نفسه لأنه سلم إلى الموت من حكم ببراءته، وبأنه حاكم ضعيف يقضي بمقتضى صراخ الشعب بما هو خلاف اعتقاده. ففي عمله شهادة للمسيح، وعلى نفسه، وعلى اليهود. والمرجح أنه ظن أن الشعب يأبى أن يأخذ المسؤولية كلها على نفسه، ويرجع عن طلبه.
إِنِّي بَرِيءٌ هذا القول لم يبرئه، لأنه لم يطلق المسيح.
هٰذَا ٱلْبَارِّ دعاه باراً (كما دعته امرأته ع ١٩) وهو مزمع أن يسلمه إلى الموت ويُطلق بدلاً منه المذنب الشهير باراباس. وهذا شهادة لقول الرسول «إِنَّ الْمَسِيحَ أَيْضًا تَأَلَّمَ... الْبَارُّ مِنْ أَجْلِ الأَثَمَةِ» (١بطرس ٣: ١٨)
أَبْصِرُوا أَنْتُمْ أي أن مسؤولية الحكم على هذا البار بالموت لا بد أن تقع على أحد، فأنا لا أحملها، فتكون عليكم بمعرفتكم واختياركم.
٢٥ «فَأَجَابَ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ: دَمُهُ عَلَيْنَا وَعَلَى أَوْلاَدِنَا».
تثنية ١٩: ١٠ ويشوع ٢: ١٩ و٢صموئيل ١: ١٦ و١ملوك ٢: ٣٢ وأعمال ٥: ٢٨.
دَمُهُ عَلَيْنَا أي إذا كان باراً يُعاقب أحدٌ بموته فذلك علينا. فلم ينجح بيلاطس في إنقاذ المسيح، لأن الشعب حمل كل مسؤولية موته طوعاً واختياراً. وهذا القول لم يخفف جرم بيلاطس من حكمه على المسيح، لكنه جعلهم شركاءه في ظلمه بذلك الحكم. وقولهم «دَمُهُ عَلَيْنَا» مبنيٌ على الشريعة القديمة. وهي أنه إذا شكا أحدٌ غيره كذباً وظهر كذبه عوقب بما كان يُعاقب به المشكو لو لم يظهر الكذب. وعلى هذه الشريعة حُكم على شكوى دانيال بطرحهم في جب الأسود، ووقع على أدوني بازق (قضاة ١: ٧) وحُكم على أجاج ملك عماليق (١صموئيل ١٥: ٣٣).
وَعَلَى أَوْلاَدِنَا أي العقاب الذي يترتب على قتل يسوع إن كان بريئاً نأخذه ميراثاً لأولادنا كما أخذناه نصيباً لنا. على أنه لا حقَّ لهم أن يدعوا على لأولادهم بتلك النقمة الإلهية، لكنها أتت عليهم بعدالته، لأنه بعد ذلك بأربعين سنة هُدمت مدينتهم ونُقض هيكلهم ومات أكثر من مليون من أولادهم بالجوع والسيف، وصُلب ألوف منهم.
قال يوسيفوس المؤرخ اليهودي «إنه لم يبقَ محل للصلبان للناس» وظل أغلب أولادهم متشتتين في العالم عرضة للإهانة والاضطهاد، حتى لم تحتمل أُمة تحت السماء ما احتملوه. ولم يخطر على بالهم عاقبة اللعنة التي دعوا بها على أنفسهم يومئذٍ. على أن تلك اللعنة تتحول إلى بركة للذين يتوبون منهم، ويؤمنون بأن يسوع هو المسيح. وإن ذلك الذي كان عليهم انتقاماً يصير لهم تطهيراً. فإن قيل: كيف يعاقب الله الأولاد بذنوب آبائهم وقد قال بفم حزقيال «اَلنَّفْسُ الَّتِي تُخْطِئُ هِيَ تَمُوتُ. اَلابْنُ لاَ يَحْمِلُ مِنْ إِثْمِ الأَبِ، وَالأَبُ لاَ يَحْمِلُ مِنْ إِثْمِ الابْنِ. بِرُّ الْبَارِّ عَلَيْهِ يَكُونُ، وَشَرُّ الشِّرِّيرِ عَلَيْهِ يَكُونُ» (حزقيال ١٨: ٢٠). قلنا لا يلحق عقاب الوالدين بالأولاد إلا إذا مدحوا أعمال آبائهم، وتبعوا خطواتهم، وشعروا بشعورهم. ويقول الوحي إن الأمة اليهودية سترفض أعمال أسلافها، وستؤمن أن يسوع هو المسيح، وستنجو حينئذٍ من تلك اللعنة (زكريا ١٢: ١٠ - ١٤).
ومن العجب أن اليهود بعد أن قالوا: دمه علينا وعلى أولادنا، أنكروا ذلك بعد قليل بقولهم للرسل «أَمَا أَوْصَيْنَاكُمْ وَصِيَّةً أَنْ لاَ تُعَلِّمُوا بِهذَا الاسْمِ؟ وَهَا أَنْتُمْ قَدْ مَلأْتُمْ أُورُشَلِيمَ بِتَعْلِيمِكُمْ، وَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْلِبُوا عَلَيْنَا دَمَ هذَا الإِنْسَانِ» (أعمال ٥: ٢٨).
٢٦ «حِينَئِذٍ أَطْلَقَ لَـهُمْ بَارَابَاسَ، وَأَمَّا يَسُوعُ فَجَلَدَهُ وَأَسْلَمَهُ لِيُصْلَبَ».
إشعياء ٥٣: ٥ ومرقس ١٥: ١٥ ولوقا ٢٣: ١٦، ٢٤، ٢٥ ويوحنا ١٩: ١، ١٦
أَطْلَقَ لَهُمْ بَارَابَاسَ أطلق مرتكب الذنب الذي اتهموا المسيح به كذباً، وهو العصيان على الرومان. فنجا ذلك المحكوم عليه بالموت من العقاب الذي وقع على يسوع. وكذلك كل خطاة العالم المحكوم عليهم بالموت يستطيعون أن ينجوا من عقابهم، لأن إثم الجميع وُضع على ذلك البار.
فَجَلَدَهُ هذا بعد ما حكم عليه بالصلب جرياً على عادة الرومان في من حُكم عليهم بالصلب. وكان إيلام ذلك شديداً، لأنهم كانوا يعرُّون الذي يريدون جلده ويربطونه إلى عمود منحنياً ويضربونه على ظهره بالسوط، وكان ذلك السوط سيوراً من الجلد مربوطاً بأطرافها قِطعٌ حادة من معدن أو عظمٍ، فكانت تمزق الجلد واللحم أيضاً. وكثيراً ما كان يُغشى على المجلودين أو يموتون من الألم. وكان الجلادون من عساكر الرومان الذين لا يشفقون على أحد من اليهود، لأنهم كانوا يهينون الأمة اليهودية كلها ويبغضونها، ولم يكونوا مقيدين بالشريعة اليهودية التي تمنع ما يزيد على أربعين جلدة، فضربوه بقدر ما شاءوا.
ومُنع في الشريعة الرومانية أن يُجلد أحدٌ من الرومانيين وخصوا الجلد بالعبيد وبأهل البلاد التي استولوا عليها لأنهم كانوا عندهم بمنزلة العبيد (أعمال ٢٢: ٢٥)
وقد فسَّر إشعياء غاية المسيح في احتمال آلام الجلد بقوله «هُوَ مَجْرُوحٌ لأَجْلِ مَعَاصِينَا... وَبِحُبُرِهِ شُفِينَا» (إشعياء ٥٣: ٥)
وَأَسْلَمَهُ لِيُصْلَبَ لم يستطع بيلاطس أن يسلمه لو لم يكن «مُسَلَّمًا بِمَشُورَةِ اللهِ الْمَحْتُومَةِ وَعِلْمِهِ السَّابِقِ» (أعمال ٢: ٢٣). وأسلمه إلى العسكر الروماني ليجري عليه الحكم. وكان بذلك كأنه أسلمه إلى اليهود، لأنه صُلب بموجب حكم مجلس السبعين كما يظهر من قول لوقا «وَأَسْلَمَ يَسُوعَ لِمَشِيئَتِهِمْ» (لوقا ٢٣: ٢٥). وقصد متّى بقوله «ليُصلب» القضاء بالصلب، ولكنه ذكر الصلب نفسه بعد ذلك (ع ٣٥). وبهذا الحكم خالف بيلاطس ضميره وتحذير زوجته، فدمُ المسيح عليه كما كان على اليهود، لأنه حكم باعتبار إنه قاضٍ جالس على كرسي القضاء الروماني، وكان الصلب عقاباً رومانياً، والذين صلبوا المسيح جنود رومانية كانت تحت أمره، وهو الذي أمر بكتابه العنوان الذي وُضع فوق الصليب.
٢٧ «فَأَخَذَ عَسْكَرُ ٱلْوَالِي يَسُوعَ إِلَى دَارِ ٱلْوِلاَيَةِ وَجَمَعُوا عَلَيْهِ كُلَّ ٱلْكَتِيبَةِ».
مرقس ١٥: ١٦ ويوحنا ١٩: ٢ وأعمال ١٠: ١
إِلَى دَارِ ٱلْوِلاَيَةِ الظاهر أنهم جلدوا المسيح خارج دار الولاية، وأرجعوه إليها بعد أن جلدوه.
ٱلْكَتِيبَةِ أي فرقة من عسكر الرومان الذي كان تحت أمر بيلاطس. كان في سوريا أربعة جيوش رومانية يسمَّى كل منها «لجيئوناً» Legion كان ثلاثة منها تقيم بقيصرية والرابع يقيم بأورشليم. وعدد اللجيئون ستة آلاف جندي إذا كانت كاملة، ولم يطلقوها على أقل من ٤٦٠ جندياً.
ولعل سبب تسليم بيلاطس المسيح إلى مثل هذا العدد الكبير هو أن رؤساء الكهنة حذروا بيلاطس من أن أصحاب يسوع قد يخلصونه عنوة.
٢٨ «فَعَرَّوْهُ وَأَلْبَسُوهُ رِدَاءً قِرْمِزِيّاً».
لوقا ٢٣: ١١
فَعَرَّوْهُ عروه قبل الجلد. ثم ألبسوه بعد أن جلدوه، ثم عروه أيضاً. فلم يشفقوا عليه بما شاهدوه من جراحه الزرقاء الدامية المحاطة بالورم من شدة الجلد.
رِدَاءً قِرْمِزِيّاً وسمي أرجواناً أيضاً. والأرجح أن هذا الرداء كان من الأردية العتيقة الذي تركه أحد الولاة في القصر، وكان الأرجوان من ملابس الحكام والأغنياء (لوقا ١٦: ٩ ورؤيا ٧: ٤). وكان قيصر روما نفسه يلبس ثوباً من الأرجوان، فألبس العسكر يسوع ذلك الثوب هزءاً بدعواه أنه ملك اليهود، كما هزأ اليهود قبلاً بدعواه إنه نبي (متّى ٢٦: ٦٨).
٢٩ «وَضَفَرُوا إِكْلِيلاً مِنْ شَوْكٍ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَصَبَةً فِي يَمِينِهِ. وَكَانُوا يَجْثُونَ قُدَّامَهُ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِهِ قَائِلِينَ: ٱلسَّلاَمُ يَا مَلِكَ ٱلْيَهُودِ».
مزمور ٦٩: ١٩ وإشعياء ٥٣: ٣
إِكْلِيلاً مِنْ شَوْكٍ أي من نبات شائك، وصنعوا له ذلك بدلاً من إكليل الذهب المرصَّع بالجواهر التي اعتاد الملوك أن يلبسوه، وفعلوا ذلك هزءاً منه بأنه ملك.
وَقَصَبَةً فِي يَمِينِهِ كان من عادة الملك أن يحمل صولجاناً بيده عند امتثال بعض الرعية أمامه إشارة إلى سلطانه (أستير ٤: ١١ و٨: ٤). والصولجان عصا معكوفة الرأس مصنوعة من الذهب أو العاج أو غيرهما من المواد النفيسة. ويُقال عن الملك الصارم بذي عصاً (أي صولجان) من حديد (مزمور ٢: ٩ و١٢٥: ٣). فوضع الجند القصبة في يد المسيح بدلاً من الصولجان لزيادة الهزء به.
وَكَانُوا يَجْثُونَ قُدَّامَهُ كأنه هيرودس الملك أو طيباريوس قيصر.
ٱلسَّلاَمُ يَا مَلِكَ فعلوا ذلك تمثيلاً لما كان يفعله الناس عند مواجهة الملوك.
٣٠ «وَبَصَقُوا عَلَيْهِ، وَأَخَذُوا ٱلْقَصَبَةَ وَضَرَبُوهُ عَلَى رَأْسِهِ».
إشعياء ٥٠: ٦ ومتّى ٢٧: ٦٧
بَصَقُوا بعد أن أظهروا له الإكرام الملكي تهكماً أخذوا يهينونه بالبصق عليه، وهو من أقبح ضروب الإهانة.
وَأَخَذُوا ٱلْقَصَبَةَ وَضَرَبُوهُ عَلَى رَأْسِهِ كانت القصبة هنا بمنزلة الصولجان، دليل القوة لصاحبه، فضربوه بها بياناً لقوتهم على الهزء به. وبضربه على رأسه دخل شوك إكليله في الجبهة والرأس. وهذه إهانة ثالثة ليسوع. فالأولى إهانة خدام الهيكل والرئيس له (متّى ٢٦: ٦٧)، والثانية إهانة هيرودس وعسكره (لوقا ٢٣: ١١)، والثالثة إهانة جنود بيلاطس كما ذكر هنا. وكان كل ذلك إتماماً لنبوة نطق بها منذ سبع مئة سنة قبل إتمامها، وهي قوله «بَذَلْتُ ظَهْرِي لِلضَّارِبِينَ، وَخَدَّيَّ لِلنَّاتِفِينَ. وَجْهِي لَمْ أَسْتُرْ عَنِ الْعَارِ وَالْبَصْقِ» (إشعياء ٥٠: ٦). وقصد العسكر بما فعلوه ثلاثة أمور: الأول تلذذهم بالقساوة. والثاني التشفي من غيظهم على يهودي، والثالث إظهار الاحترام لقيصر لظنهم أن يسوع اعتدى على حقوقه بدعوى أنه ملك. ويسوع باعتبار أنه إنسان كان يشعر بألم الضرب كغيره من الناس، وكذلك بألم التهكم والإهانة. وفيها كلها لم يفه بكلمة، مع أنه كان يسهل عليه أن يظهر سلطانه وقوته ويميتهم جميعاً في لحظة. فاحتماله كل ذلك بالصبر والسكوت اختياراً دليل على عظمته الملكية. وغايته من احتمال تلك الإهانة على الأرض في دار بيلاطس هو ضمان الإكرام لنا في السماء. «لِذٰلِكَ رَفَّعَهُ ٱللّٰهُ أَيْضاً، وَأَعْطَاهُ ٱسْماً فَوْقَ كُلِّ ٱسْمٍ ١٠ لِكَيْ تَجْثُوَ بِٱسْمِ يَسُوعَ كُلُّ رُكْبَةٍ مِمَّنْ فِي ٱلسَّمَاءِ وَمَنْ عَلَى ٱلأَرْضِ وَمَنْ تَحْتَ ٱلأَرْضِ، ١١ وَيَعْتَرِفَ كُلُّ لِسَانٍ أَنَّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ هُوَ رَبٌّ لِمَجْدِ ٱللّٰهِ ٱلآبِ» (في ٢: ٩ - ١١).
لقد أخذ الجنود يهزأون بيسوع بعد أن دخل بيلاطس قصره، بدليل قول البشير «فَخَرَجَ بِيلاَطُسُ أَيْضًا خَارِجًا» (يوحنا ١٩: ٤، ٥). فكانت النتيجة أن صرخ رؤساء الكهنة والخدام مكررين قولهم «اصْلِبْهُ! اصْلِبْهُ!». فكأن مشاهدتهم يسوع في حال اتضاعه أوقدت فيهم نار البغض والحسد من جديد. فبيلاطس الذي تربى في العسكر واعتاد سفك الدم حتى صار عنده بمنزلة الماء كان أرق قلباً من اليهود، واشمأز أن يفعل ما طلبوه، وقال لهم: «خُذُوهُ أَنْتُمْ وَاصْلِبُوهُ». فكأنه قال لهم: أبيح لكم ما هو على خلاف الشريعة، وأغض النظر عنه (يوحنا ١٩: ٦). لكن رؤساء الكهنة رفضوا ما عرضه بيلاطس عليهم، لأنهم أرادوا أن يتم صلبه بموجب الشريعة الرومانية وبسلطان الرومان. وذكروا حينئذٍ العلة الحقيقية التي حملتهم على طلب قتل المسيح، وهي الأمر الثالث الذي اتفقوا عليه، وهو التجديف، بدليل قولهم «لَنَا نَامُوسٌ، وَحَسَبَ نَامُوسِنَا يَجِبُ أَنْ يَمُوتَ، لأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ ابْنَ اللهِ» (يوحنا ١٩: ٧) وهذا لم يذكروه قبلاً لبيلاطس. ومرادهم أن يظهروا لبيلاطس أن يسوع إن لم يستوجب الموت بشرع الرومان فهو يستحقه بموجب الشريعة اليهودية. فلما سمع بيلاطس كلامهم أخذ يسوع أيضاً إلى دار الولاية وفحص دعواه من جديد (يوحنا ١٩: ٩ - ١١) وهذا فحص سادس للمسيح. وبعد أن أكمل بيلاطس الفحص خرج وجلس على كرسي الولاية ثالثة واجتهد أن يخلص يسوع. وكان آخر التماسه من اليهود قوله «هُوَذَا مَلِكُكُمْ!. أَأَصْلِبُ مَلِكَكُمْ؟» (يوحنا ١٩: ١٢ - ٢٥).
لا ندري مقدار الإخلاص في هذا الكلام وهل قصد بيلاطس ما قاله؟ أم أن ذلك محاولة اليائس الأخيرة لإنقاذ بريء؟ وعند ذلك ترك رؤساء الكهنة شكواهم على يسوع بالتجديف ورجعوا إلى الشكوى الأولى، وهي أنه عصى قيصر بدعواه أنه ملك، بدليل قولهم «إِنْ أَطْلَقْتَ هذَا فَلَسْتَ مُحِبًّا لِقَيْصَرَ. كُلُّ مَنْ يَجْعَلُ نَفْسَهُ مَلِكًا يُقَاوِمُ قَيْصَرَ! لَيْسَ لَنَا مَلِكٌ إِلاَّ قَيْصَرَ!» (يوحنا ١٩: ١٢، ١٥). فاستسلم لطلبهم خوفاً من أن يشتكوه أنه ليس محباً لقيصر!
والوقت الذي شُغل بمحاكمة يسوع كان نحو ثلاث ساعات، وذلك من الصبح إلى الساعة الثالثة قبل الظهر.
وإذا راجعنا الحوادث التي جرت أثناء محاكمة المسيح رأينا بطرس قد أنكر يسوع ثلاث مرات، وأن يسوع حوكم أمام رؤساء اليهود ثلاث مرات: واحدة أمام حنان وواحدة أمام قيافا والثالثة قدام المجلس صباحاً. وحوكم ثلاث مرات أمام غير اليهود، اثنتين أمام بيلاطس وواحدة أمام هيرودس. واختار اليهود ثلاث مرات إطلاق باراباس، ورفضوا إطلاق يسوع ثلاثاً، واجتهد بيلاطس ثلاث مرات أن يقنع الشعب باختيار إطلاق يسوع، وأعلن براءته ثلاث مرات (لوقا ٢٢: ٤، ١٤، ١٥، ٢٢). وحُذر اليهود ثلاثاً: حذرهم المسيح بمجيئه ثانية للدينونة (متّى ٢٦: ٢٤)، ويهوذا باعترافه (ع ٤)، وبيلاطس بشهادته ببراءة يسوع (ع ٢٤).
٣١ «وَبَعْدَ مَا ٱسْتَهْزَأُوا بِهِ، نَزَعُوا عَنْهُ ٱلرِّدَاءَ وَأَلْبَسُوهُ ثِيَابَهُ، وَمَضَوْا بِهِ لِلصَّلْبِ».
إشعياء ٥٣: ٧
نَزَعُوا عَنْهُ ٱلرِّدَاءَ أي الرداء القرمزي، ولم يذكر شيئاً من أمر إكليل الشوك.
ثِيَابَهُ الخارجية والداخلية (يوحنا ١٦: ٢٣، ٢٤)
وَمَضَوْا بِهِ لِلصَّلْبِ «كَشَاةٍ تُسَاقُ إِلَى ٱلذَّبْحِ» (إشعياء ٥٣: ٧). فتم ما أنبأ به هو نفسه من جهة صلبه (متّى ٢٠: ١٩ و٢٦: ٤٥).
وصُلب في الساعة الثالثة أي قبل الظهر بنحو ثلاث ساعات (مرقس ١٥: ٢٥). وما ورد في بشارة مرقس يوافق ما ذكره متّى ولوقا. وأما ذكر الساعة السادسة في يوحنا فالأرجح أنها من غلط الناسخين، لأن اليونانيين كانوا يدلون على الأعداد بأحرف، والفرق بين الحرف الدال على «ثلاثة» والحرف الدال على «ستة» زهيد جداً. ويؤيد ذلك أن في بعض النسخ القديمة لبشارة يوحنا تذكر «الثالثة» بدل «السادسة» كما في بشارة مرقس. وظن بعضهم أن يوحنا استعمل الحساب اليهودي فوقع ذلك الخلاف. وكان اليوم عند الرومان كاليوم عند الأوربيين، يبدأ من نصف الليل، فتكون السادسة في يوحنا وقت طلوع الشمس، وهو بداءة محاكمة يسوع عند بيلاطس، وهي التي قصدها يوحنا بـ «تلك الساعة».
٣٢ «وَفِيمَا هُمْ خَارِجُونَ وَجَدُوا إِنْسَاناً قَيْرَوَانِيّاً ٱسْمُهُ سِمْعَانُ، فَسَخَّرُوهُ لِيَحْمِلَ صَلِيبَهُ».
عدد ١٥: ٣٥ و١ملوك ٢١: ١٣ وأعمال ٧: ٥٨ وعبرانيين ٢٤: ١٢ ومرقس ٢٣: ٢٦ وأعمال ٢: ١٠ و٦: ٩
خَارِجُونَ إلى مكان الصلب خارج المدينة. ولهذا قال الكتاب «فَإِنَّ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي يُدْخَلُ بِدَمِهَا عَنِ الْخَطِيَّةِ إِلَى «الأَقْدَاسِ» بِيَدِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ تُحْرَقُ أَجْسَامُهَا خَارِجَ الْمَحَلَّةِ. لِذلِكَ يَسُوعُ أَيْضًا، لِكَيْ يُقَدِّسَ الشَّعْبَ بِدَمِ نَفْسِهِ، تَأَلَّمَ خَارِجَ الْبَابِ» (عبرانيين ١٣: ١١ و١٢). وهذا وفق شريعة موسى في أمر المحكوم عليهم بالموت (عدد ١٥: ٣٥ انظر أيضاً ١ملوك ٢١: ١٣ وأعمال ٧: ٥٨) وبذلك تمم يسوع الرموز بكونه ذبيحة عن الخطية (لاويين ٤: ١٢ و١٦: ٢٧ وعدد ١٩: ٣).
إِنْسَاناً قَيْرَوَانِيّاً أي من القيروان، وهي مدينة في ليبيا في شمال أفريقيا تسمى «سارنيكا» وكانت وقتئذٍ من أملاك الرومان، وسكنها كثيرون من اليهود (أعمال ٢: ١٠) لأن بطليموس لاجي أرسل منهم إلى هناك مئة ألف قبل ذلك بـ ٣٠٠ سنة، فزادوا كثيراً حتى صار لهم مجمع خاص في أورشليم (أعمال ٦: ٩). وكان بعضهم من أول المبشرين المسيحيين (أعمال ١١: ٢٠ و١٣: ١). والمرجح أن سمعان القيرواني أتى إلى أورشليم حينئذٍ للاحتفال بعيد الفصح. وذكر مرقس إنه كان أبا إسكندر وروفس كأنهما معروفان عند المسيحيين (مرقس ١٥: ٢١).
فَسَخَّرُوهُ الخ الذين سخروه هم الجنود. وكانت العادة إن الذي يحمل الصليب هو المحكوم عليه بالصلب، فكان حمل الصليب دلالةً على شدة العار والهوان والمصيبة. وكان يسوع قد حمله في أول الطريق (يوحنا ١٩: ١٧) والظاهر إنه أعيا عن حمله لشدة ضعف جسمه من الجلد والهزء والأرق، ولذلك سخَّر العسكر سمعان بحمله. ولم يكن أحد من اليهود أو الرومان يحمل باختياره صليب المحكوم عليه لما في ذلك من العار. ولعل سمعان كان أول من صادفوه في الطريق بعد عجز يسوع عن حمل صليبه، أو لأنهم رأوه أجنبياً فاستخفوا به، أو لعله ظهر على وجهه شيءٌ من إمارات الشفقة على يسوع فسخَّروه. وإن كان سمعان مات مؤمناً بالمسيح فلا شك أنه يحسب الآن ذلك العار أعظم مجدٍ له.
٣٣ «وَلَمَّا أَتَوْا إِلَى مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ جُلْجُثَةُ، وَهُوَ ٱلْمُسَمَّى: مَوْضِعَ ٱلْجُمْجُمَةِ».
مرقس ١٥: ٢٢ ولوقا ٢٣: ٣٣ ويوحنا ١٩: ١٧
الموضع الذي صُلب يسوع فيه مجهول الآن وقد كثرت الآراء فيه. وقلما التفت كتبة الأسفار الإلهية إلى تعيين أماكن الحوادث التي ذكروها.
جُلْجُثَةُ كلمة عبرانية معناها جمجمة. والأرجح أن إطلاق هذا الاسم على مكان صلب يسوع لأنه أكمة مدورة خالية من الصخور والأشجار، تشبه جمجمة الإنسان شكلاً وهيئة. فلا صحة لقول بعضهم إنه سمي بذلك لكثرة ما طُرح فيه من جماجم القتلى. ومما يبطل هذا القول أن اليهود كانوا يدفنون كل عظم من عظام البشر في الأرض بكل احتراس واعتناء. وكل ما نعرفه من أمر الموضع الذي صُلب فيه المخلص خمسة أمور:
الأول: إنه خارج المدينة (ع ٣١) والثاني: إنه قريب من المدينة (يوحنا ١٩: ٢٠) والثالث: إنه على جانب الطريق والشارع (مرقس ١٥: ١٩) والرابع: إنه كان قريباً من أحد البساتين الكثيرة التي كانت محيطة بأورشليم، وكان في ذلك البستان قبر ليوسف الرامي (يوحنا ١٩: ٤١) والخامس: إن المكان كان يُعرف عند العامة بالجمجمة (لوقا ٢٣: ٣٣).
٣٤ «أَعْطَوْهُ خَلاًّ مَمْزُوجاً بِمَرَارَةٍ لِيَشْرَبَ. وَلَمَّا ذَاقَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَشْرَبَ»
مرقس ٦٩: ٢١ وع ٤٨
أَعْطَوْهُ المرجح أن الذين أعطوهُ يهود لأنه لم يكن من عادات الرومان، ولأن اليهود كانوا يتبرعون به لكل محكوم عليه بالموت عند قتله. ولأن رجال الدين اليهود أعلنوا أنه من أعمال التقوى، بناءً على قول الحكيم «أعطوا مسكراً لهالك وخمراً لمري النفس. يشرب وينسى فقره، ولا يذكر تعبه أيضاً» (أمثال ٣١: ٦، ٧)
خَلاًّ مَمْزُوجاً بِمَرَارَةٍ وقال مرقس «أَعْطَوْهُ خَمْرًا مَمْزُوجَةً بِمُرّ » (مرقس ١٥: ٢٣) فإن عسكر الرومان كان يشرب نوعاً من الخمر رخيصاً حامضاً يختلف عن الخل قليلاً، فيصح أن يعبر عن كل منهما بالثاني. والمرارة والمر كثيراً ما يردان بمعنى واحد، وهو شراب من الأعشاب المرة كالأفسنتين وأمثاله، ممزوجاً بماء بزر الخشخاش. وغايتهم من مزج الخمر به وإعطائه للمصلوب تسكين آلامه بإسكاره وتخديره. والظاهر أن المسيح ذاته إكراماً لمن أظهر له المعروف بإعطائه إياه أبى أن يشربه، لأنه فضَّل أن يكون شاعراً بآلامه، فيشرب الكأس التي أعطاه الآب ليشربها، وشربها كلها (مزمور ٦٩: ٢١).
٣٥ «وَلَمَّا صَلَبُوهُ ٱقْتَسَمُوا ثِيَابَهُ مُقْتَرِعِينَ عَلَيْهَا، لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِٱلنَّبِيِّ: ٱقْتَسَمُوا ثِيَابِي بَيْنَهُمْ، وَعَلَى لِبَاسِي أَلْقَوْا قُرْعَةً».
مرقس ١٥: ٢٤ ولوقا ٢٣: ٣٤ ويوحنا ١٩: ٢٤ ومزمور ٢٢: ١٨.
صَلَبُوهُ كان الصلب شر الميتات المعروفة قديماً لما فيه من التشهير والعار والآلام الشديدة وطول مدة العذاب، فقد يبقى المصلوب حياً ثلاثة أيام، يعتريه عطشٌ وجوعٌ وأرقٌ وحمى من التهاب الجراح، ولا يستطيع الحركة التي تزيد آلامه.
ولم يكن الصلب من أنواع العقاب عند اليهود، فمن المحال أن يهودياً يصلب يهودياً. والمراد بالتعليق «على خشبة» في التوراة هو ما نعرفه الآن بالشنق (تثنية ٢١: ٢٢، ٢٣). وأصل الصلب جاء من بلاد الفرس، واستعمله المصريون واليونانيون. ولم يصلبوا الرومان رومانياً، بل خصوا ذلك الموت بالعبيد وشر الأثمة وأهل الولايات التي استولوا عليها لأنهم حسبوهم كالعبيد. وكراسوس (القائد الروماني) سيج الطريق من مدينة كبيوا إلى مدينة روما بصلبان العبيد الذين عصوا الرومان. وصلب أوغسطس قيصر ستة آلاف عبد في جزيرة صقلية لأنهم عصوه. وكان الصليب قطعتين متعارضتين من الخشب فيهما عمود يدخل بين رجلي المصلوب ليحمل بعض ثقله فلا يتمزق لحم مدخل المسامير فيسقط المصلوب. وكانوا ينصبون الصليب أحياناً رأسياً ويرفعون الإنسان عليه ويسمرونه، ولكنهم كانوا يضعونه على الأرض أفقياً ويمدون المصلوب بعد أن يعروه عليه ويسمرونه بمسامير في رجليه ويديه على خشبة الصليب. وكانوا أحياناً يسمرون اليدين فقط ويربطون الرجلين بحبال على الصليب (والظاهر أنهم سمروا يدي يسوع ورجليه معاً بدليل ما جاء في بشارة لوقا، لوقا ٢٤: ٣٩، ٤٠). ثم يرفعون الصليب بالمصلوب وينصبونه رأسياً في حفرة معدة له. وكانوا أحياناً يُنزلون الصليب في حفرته بسرعة وعنف لتخليع مفاصل المصلوب وتشديد عذابه. وكان ارتفاع رجلي المصلوب فوق الأرض من نصف ذراع إلى ذراع. ولما سمَّر العسكر يسوع على صليبه صلى قائلاً «يَا أَبَتَاهُ، اغْفِرْ لَهُمْ، لأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ» (لوقا ٢٣: ٣٤).
وأوضحت النبوات والرسائل غاية صلب يسوع، وهي أن يكون ذبيحة الكفارة عن خطايا الناس، وأن يحتمل اللعنة التي وجبت على الخطاة، فتم بصلبه قوله «الْمُعَلَّقَ مَلْعُونٌ مِنَ الله» (تثنية ٢١: ٢٣) وليوفي الدين الذي على الإنسان ويصالحه مع الله. فصار اسم الصليب بعد أن مات عليه المسيح إشارة إلى الشرف والبركة والفداء، بعد أن كان علامة العار واللعنة والعذاب.
ٱقْتَسَمُوا ثِيَابَهُ أي القميص وما فوقه (يوحنا ١٩: ٢٣، ٢٤). وكانت ثياب المصلوب نصيب الصالبين، وكان الذين صلبوا المسيح أربعة نزعوا ثيابه قبل صلبه.
مُقْتَرِعِينَ عَلَيْهَا أي على قميصه لأنه كان «بِغَيْرِ خِيَاطَةٍ، مَنْسُوجًا كُلُّهُ مِنْ فَوْقُ» (يوحنا ١٩: ٢٣) ومقامرتهم تحت الصليب دليل على عدم شفقتهم على المصلوب.
مَا قِيلَ بِٱلنَّبِيِّ القول المشار إليه وارد في مزمور ٢٢: ١٨ وهو نبوة خاصة بيسوع، لأنه لم يجرِ مثلها على داود. وكانت تعرية المسيح من ثيابه أمراً لا يُعتد به بالنسبة إلى ما احتمله باختياره لما «أَخْلَى نَفْسَهُ» من كل الأمجاد السماوية لأجلنا (فيلبي ٢: ٦).
٣٦ «ثُمَّ جَلَسُوا يَحْرُسُونَهُ هُنَاكَ».
عدد ٥٤
حرسوهُ لئلا يأتي أصحابه وينزلوه عن الصليب حياً. وكان الحراس بعدئذٍ شهوداً بصحة دعوى المسيح (ع ٥٤).
٣٧ «وَجَعَلُوا فَوْقَ رَأْسِهِ عِلَّتَهُ مَكْتُوبَةً: هٰذَا هُوَ يَسُوعُ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ».
مرقس ١٥: ٢٦ ولوقا ٢٣: ٣٨ ويوحنا ١٩: ١٩
فَوْقَ رَأْسِهِ عِلَّتَهُ أي علة صلبه. وكانت العادة أن يحمل المحكوم عليه بالصلب إعلان سبب صلبه إلى حيث يُصلب، وهناك يوضع فوق رأسه.
هٰذَا هُوَ يَسُوعُ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ علة صلبه عند بيلاطس دعواه إنه ملك. وكتب هذا العنوان بثلاث لغات كانت شائعة في سوريا وقتئذٍ، وهي العبرانية واليونانية واللاتينية. وذكر مرقس أن العنوان كان «ملك اليهود» (مرقس ١٥: ٢٦) . وقال لوقا إن كان «هٰذَا هُوَ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ» (لوقا ٢٣: ٣٨) وقال يوحنا إنه كان «يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ مَلِكُ الْيَهُودِ» (يوحنا ١٩: ١٩) والمعنى واحد. ولعل اختلاف الألفاظ لاختلافها في لغات العنوان الثلاث، بأن نقل بعضهم عن إحدى اللغات وبعضهم عن لغات أُخرى. وقصد بيلاطس بذلك العنوان تعيير اليهود بصلب ملكهم. واعترضه الرؤساء على ما كُتب فلم يبالِ بهم (يوحنا ١٩: ٢٠) فما لقَّب المجوس به يسوع عند ميلاده تمجيداً له لقبه به بيلاطس عند موته هزءاً به. والعنوان كله حق، لأن معنى يسوع مخلص، وتولى المُلك بآلامه وموته.
٣٨ «حِينَئِذٍ صُلِبَ مَعَهُ لِصَّانِ، وَاحِدٌ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَوَاحِدٌ عَنِ ٱلْيَسَار».
إشعياء ٥٣: ١٢ ومرقس ١٥: ٢٧ ولوقا ٢٣: ٣٢، ٣٣ ويوحنا ١٩: ١٨
الأرجح أن هذين اللصين هما من رفقاء باراباس وشركائه في الفتنة والقتل (مرقس ١٥: ٧) وكان قد حُكم عليهما قبلاً بالموت. فلو قُضي على باراباس بالقتل لصُلب على الأرجح بين ذينك اللصين، فأخذ يسوع مكانه. وكان ذلك إتماماً للنبوة القائلة «أُحصي مع أثمة» (إشعياء ٥٣: ١٢). على أن بيلاطس لم يقصد بذلك سوى الإهانة تهكُماً بأنه ملك، وأنه لا بدَّ من وزيرين لإكرامه وخدمته. وهذا مما زاد عار صلب المسيح وما احتمله من أجلنا لكيلا نُحصى نحن مع الأثمة. فالمكانان اللذان أخذهما اللصان عن يمينه وعن يساره هو ما طلبه سابقاً ابنا زبدي على غير علم (متّى ٢٠: ٢١).
٣٩ «وَكَانَ ٱلْمُجْتَازُونَ يُجَدِّفُونَ عَلَيْهِ وَهُمْ يَهُزُّونَ رُؤُوسَهُمْ».
مزمور ٢٢: ٧، ٩ و١٠: ٢٥ ومرقس ١٥: ٢٩ ولوقا ٢٣: ٣٥
ٱلْمُجْتَازُونَ أي المارون اتفاقاً، أو لمجرد مشاهدة المصلوب، أو بقصد التشفي منه.
يُجَدِّفُونَ أي يشتمون بأقوال مختلفة، وهذا خلاف ما يتوقع من الطبيعة البشرية، لأن آلام ذلك المصلوب كان يجب أن تحرك شفقتهم عليه. وكان المجدفون عليه ثلاث فئات: المجتازون (ع ٣٩)، ورؤساء الكهنة (ع ٤١)، والعسكر (لوقا ٢٣: ٣٦).
ييَهُزُّونَ رُؤُوسَهُمْ هزءاً وشماتة (أيوب ١٦: ٤ وإشعياء ٣٧: ٢٢ وإرميا ١٨: ١٦). وكل ذلك ليتم ما أُنبئ به (مزمور ٢٢: ٧ و١٠٩: ٢٥).
٤٠ «قَائِلِينَ: يَا نَاقِضَ ٱلْهَيْكَلِ وَبَانِيَهُ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، خَلِّصْ نَفْسَكَ! إِنْ كُنْتَ ٱبْنَ ٱللّٰهِ فَٱنْزِلْ عَنِ ٱلصَّلِيبِ».
متّى ٢٦: ٦١، ٦٣ ويوحنا ٢: ١٩
يَا نَاقِضَ ٱلْهَيْكَلِ أي يا مدَّعي نقض الهيكل. وتهكموا عليه بذلك بناءً على الشهادة التي أُديت عليه زوراً في أثناء محاكمته في مجلس اليهود (متّى ٢٦: ٦١). وعلى ما قاله مجازاً في بدء تبشيره (يوحنا ٢: ١٩) ولعل الرؤساء كرروا هذه الشكوى على مسامع الجموع عندما عرض عليهم بيلاطس أن يختاروا بين يسوع وباراباس، ليقنعوهم أن يختاروا باراباس دون يسوع، لأن اليهود كانوا يفتخرون بالهيكل كل الافتخار، ويغتاظون من أقل شيءٍ يشينه. وهذه الشكوى هي قولهم «يَا نَاقِضَ ٱلْهَيْكَلِ ..» هي كل ما استطاع أعداء المسيح أن يعيبوه عليه بعد أن نظروا في كل سيرته ثلاثاً وثلاثين سنة. على أنهم لم يستطيعوا إثباتها عليه مع أنهم استأجروا شهود زور لذلك.
خَلِّصْ نَفْسَكَ! فكأنهم قالوا إن من استطاع أن ينقض الهيكل ويبنيه في ثلاثة أيام يقدر أن يخلص نفسه، لأن من قدر على الأعظم يسهل عليه الأصغر.
إِنْ كُنْتَ ٱبْنَ ٱللّٰهِ هذا كقول الشيطان للمسيح وقت التجربة (متّى ٤: ٣) وتهكموا عليه بهذا بناءً على دعواه إنه ابن الله عند المحاكمة (متّى ٢٦: ٦٣، ٦٤).
فَٱنْزِلْ عَنِ ٱلصَّلِيبِ علَّقوا تصديقهم أن المسيح ابن الله على نزوله عن الصليب. ولكن إن كانت كل المعجزات التي أجراها في ما يزيد عن ثلاث سنين لم تبرهن لهم صحة تلك القضية، فكيف تثبتها هذه المعجزة الوحيدة؟ نعم إن المسيح لم يفعل لهم هذه المعجزة التي طلبوها، ولكنه أتاهم بأعظم منها، وهي قيامته من القبر، لأن الانتصار على الموت أعظم من الهروب منه بنزوله عن الصليب. وأكثر الناس يشبهون هؤلاء المجدفين، يرغبون في مخلص لا صليب له ولا لأحد من أتباعه.
٤١ «وَكَذٰلِكَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ أَيْضاً وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ مَعَ ٱلْكَتَبَةِ وَٱلشُّيُوخِ قَالُوا».
رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ... مَعَ ٱلْكَتَبَةِ وَٱلشُّيُوخِ هم أعضاء مجلس السبعين، وقد أتوا ليفرحوا بمشاهدة آلام عدوهم. فعجباً من شدة بغض هؤلاء للمسيح، فإنهم لم يكتفوا بتسليمه إلى الموت، بل رغبوا في مشاهدة آلامه. ولم يزُل غضبهم عليه بعد موته، بل بقوا يبغضونه ويعيرونه وهو في القبر (متّى ٢٧: ٦٣). وكان على رؤساء الكهنة أن يجتمعوا حينئذٍ في الهيكل ليحتفلوا بالعيد المقدس بدلاً من أن يذهبوا ويقفوا عند الصليب ليشاهدوا آلام المسيح (لا ٢٣: ٧).
٤٢ «خَلَّصَ آخَرِينَ وَأَمَّا نَفْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَا. إِنْ كَانَ هُوَ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ فَلْيَنْزِلِ ٱلآنَ عَنِ ٱلصَّلِيبِ فَنُؤْمِنَ بِهِ».
خَلَّصَ آخَرِينَ لم يقولوا هذا عن إخلاص، بل كان قصدهم أن يسوع ادَّعى أنه يخلص أجساد الناس من المرض والموت بقوته، وأنه فعل ذلك بمساعدة بعلزبول، وادَّعى تخليص نفوس لكونه المسيح. أو لعلهم لفظوا ذلك استهزاءً باسمه يسوع (أي مخلص) الذي كُتب فوق رأسه على الصليب. وما قالوه تهكماً هو الحق عينه، لأن المسيح جاء إلى الأرض ليخلص آخرين، وخلصهم بموته.
وَأَمَّا نَفْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَا ظنوا عدم تخليصه نفسه هو نتيجة عجزه، واستنتجوا من هذا العجز إن كل معجزاته كانت خداعاً وسحراً.. فما أبعد ظنهم عن الحقيقة، فهو أراد أن لا يخلص نفسه ليخلص آخرين، وليس ممكناً أن يخلص نفسه والآخرين معاً. ولو خلص نفسه لهلك الجنس البشري بأسره (متّى ٢٦: ٥٣، ٥٤)
إِنْ كَانَ هُوَ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ قالوا ذلك بناءً على دعواه إنه ملك، وبناءً على ما كتب في العنوان من أنه ملك اليهود. على أن يسوع أثبت ببراهين كثيرة أنه ملك إسرائيل. فموته من أجل خطايا العالم أعظم البراهين على ذلك، لأن به تمت النبوات بملكه (إشعياء ٥٣ ودانيال ٩: ٢٤ - ٢٧).
فَنُؤْمِنَ بِهِ كذا ادَّعوا، ولكن لو نزل عن الصليب لبقوا ينكرون دعواه. وتركوا هذا البرهان كما تركوا غيره، بدليل إنهم لم يقتنعوا بقيامته وهي أعظم المعجزات (متّى ٢٨: ١٤، ١٥). هم قالوا: لينزل عن الصليب فنؤمن به، وأما نحن فنقول: آمنا به لأنه لم ينزل عنه. ولو نزل ما استطاع أحدٌ من الناس أن يؤمن به لخلاص نفسه.
٤٣ «قَدِ ٱتَّكَلَ عَلَى ٱللّٰهِ، فَلْيُنْقِذْهُ ٱلآنَ إِنْ أَرَادَهُ! لأَنَّهُ قَالَ: أَنَا ٱبْنُ ٱللّٰهِ».
مزمور ٢٢: ٨
أنبأ داود بأنهم سيعيرون المسيح بهذه الكلمات قبل النطق بها بألف سنة (مزمور ٢٢: ٨). وقصدهم بقولهم إنه «ٱتَّكَلَ عَلَى ٱللّٰه» أما إنه خدع نفسه بظنه أنه اتكل عليه، وأما أنه ادعى الاتكال كذباً.
عيَّروه أولاً بأنه ما قدر أن يخلص نفسه، وزادوا عليه هنا أن الله لم يرد أن يخلصه. واتخذوا ذلك حجة قاطعة على أنه ليس ابن الله، لأنه لا يوجد أب يقدر أن يخلص ابنه ويخذل ابنه! ونسوا ما جاء في كتبهم أن المسيح يكون «مُصَاباً مَضْرُوباً مِنَ ٱللّٰهِ وَمَذْلُولاً. وَهُوَ مَجْرُوحٌ لأَجْلِ مَعَاصِينَا، مَسْحُوقٌ لأَجْلِ آثَامِنَا... وَٱلرَّبُّ وَضَعَ عَلَيْهِ إِثْمَ جَمِيعِنَا» (إشعياء ٥٣: ٤ - ٦). ونسوا ما قاله داود في مزمور ٢٢. وتوهموا أن المسيح ليس ابن الله لأن الله تركه مدة من الوقت. ويتوهم كثيرون أن الذين يتركهم الله في المصاب على الأرض ليسوا أبناء الله بالتبني، كأن المصاب علامات غضب الله عليهم.
٤٤ «وَبِذٰلِكَ أَيْضاً كَانَ ٱللِّصَّانِ ٱللَّذَانِ صُلِبَا مَعَهُ يُعَيِّرَانِهِ».
مرقس ١٥: ٣٢ ولوقا ٢٣: ٣٩
ٱللِّصَّانِ... يُعَيِّرَانِه ابتدأ كلاهما يعيرانه معاً. ولم يذكر متّى ألفاظ تلك التعييرات ولكن ذكرها لوقا. وقال أيضاً إن واحداً منهما تاب بعد ذلك وهو على الصليب، وصلى للمسيح ونال منه مغفرة إثمه والوعد بالدخول إلى الفردوس (لوقا ٢٣: ٣٩ - ٤٣) ومن العجب أن اللصين عيراه، مع أن المتوقع من شركاء المصاب أن يشفق كل منهم على الآخر ويجتهد في تعزيته. ولكن المصائب لا تليِّن القلب ولا تغير الطبيعة الخاطئة، فإن ذلك ليس إلا فعل النعمة الإلهية.
وما أظهره المسيح من الحلم والصبر على تلك التعييرات خير مثال لنا إذا عيَّرنا الناس بغير حق.
وفي تلك الأثناء وكَل يسوع العناية بأُمه إلى يوحنا (يوحنا ١٩: ٢٦، ٢٧).
٤٥ «وَمِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى كُلِّ ٱلأَرْضِ إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ».
عاموس ٨: ٩ ومرقس ١٥: ٣٣ ولوقا ٢٣: ٤٤
وَمِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ... إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ أي من الظهر إلى العصر.
كَانَتْ ظُلْمَةٌ كانت هذه الظلمة معجزة، لأنه لا يمكن أن تُكشف الشمس إلا والقمر هلال، وكان يومئذٍ عيد الفصح وهو يقع والقمر بدرٌ. وكان لائقاً للطبيعة أن تلبس ثوب الحداد حزناً وتعجباً من إثم الناس الذين صلبوا ذاك الذي هو نور العالم وشمس البر. وكانت تلك الظلمة (١) إشارة إلى مصارعة يسوع قوات الظلمة الروحية. (٢) توبيخاً للمجدفين عليه وتسكيتاً موقوتاً لهم عن تعييراتهم، مع أنها لم تؤثر فيهم أكثر مما أثرت الظلمة المصرية في فرعون (خروج ١٠: ٢٢، ٢٧). (٣) إشارة إلى احتجاب وجه الآب عنه وحرمانه من التعزية السماوية. ولكن تلك الظلمة كانت لا شيء بالنسبة إلى الظلمة التي تكاثفت على قلب المسيح وهو يحمل ثقل خطايا الناس، فجعلته يصرخ «إلهي إلهي، لماذا تركتني؟» (مرقس ١٥: ٣٤). (٤) إظهاراً لاشتراك الطبيعة مع المسيح في آلامه وفزعها من فظاعة إثم قاتليه.
عَلَى كُلِّ ٱلأَرْضِ قُصد بذلك أحياناً اليهودية فقط، وأحياناً أخرى اليهودية وما جاورها من البلاد. ولا نعلم إن كان قد قُصد به كل العالم أو لا. وذكر بعض المؤرخين المسيحيين المصريين حدوث تلك الظلمة، ومنهم ترتيليان وأوريجانوس من آباء الكنيسة. وذكر أيضاً بعض المؤرخين الوثنيين ومنهم فليغون الروماني، فقد قال هذا إن تلك الظلمة حدثت في السنة الرابعة عشرة من ملك طيباريوس، وكانت مما لم يسبق لها نظير في الكثافة، وأن النجوم ظهرت حينئذٍ.
ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَة نفهم من ذلك أن الظلمة زالت بعد هذه الساعة وعاد ضوء الشمس.
٤٦ «وَنَحْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ صَرَخَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلاً: إِيلِي إِيلِي، لَمَا شَبَقْتَنِي (أَيْ: إِلٰهِي إِلٰهِي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟».
عبرانيين ٥: ٧ ومزمور ٢٢: ١
وَنَحْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ صَرَخَ يتبين أن المسيح بقي ساكتاً في ساعات الظلمة الثلاث.
بِصَوْتٍ عَظِيمٍ هذا دليل على شدة الألم
إِيلِي إِيلِي لفظة عبرانية مكررة اقتبسها يسوع من المزامير (مزمور ٢٢: ١). وقال مرقس إن المسيح قال «إلوي إلوي» وهذا مثل إيلي إيلي، إلا أن مرقس نقله بلفظه السرياني كما نطق به المسيح. وكتب داود المزمور الذي اقتبس يسوع منه تلك اللفظة على آلام نفسه، فكانت ضيقاته وانتصاراته رمزاً إلى ضيقات المسيح وانتصاراته. وما قاله الرؤساء في ع ٤٣ هزءاً بيسوع مقتبس من مزمور ٢٢: ٨. وإلقاء القرعة المذكور في ع ٣٥ مأخوذ من ع ١٨ من ذات المزمور.
وقول يسوع «إِيلِي إِيلِي» هو القول الرابع الذي نطق به على الصليب، ولم يذكره إلا متّى ومرقس، وهما لم يذكرا غيره مما قاله على الصليب.
لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟ لم يقل: لماذا سمحت أن يجلدني العسكر ويسمرني على الصليب، وأن يعيرني الناس؟ لكن قال: لماذا تركتني أنت؟ لأن هذا أقسى من كل ما كان في كأس آلامه.
شعر المسيح في شدة آلامه التي احتملها لأجل خطايا العالم بأنه متروك من الله الذي حجَب وجهه عنه باعتبار أنه نائب الخطاة.
وعامله كمذنبٍ ليظهر غضبه على الخطية، وحجب وجهه عن ابنه وقتاً قصيراً لكيلا يحجبه عنا إلى الأبد، كما كان عدله يقتضي لو لم يمت المسيح. وكان احتجاب وجه الآب عن ابنه جزءاً من دَيْن عدله على الخاطئ الذي أوفاه نائبنا مؤدياً ثمن فدائنا، لأنه ذاق الموت عن كل إنسان (عبرانيين ٢: ٩) ولأنه جعل وهو «لَمْ يَعْرِفْ خَطِيَّةً، خَطِيَّةً لأَجْلِنَا، لِنَصِيرَ نَحْنُ بِرَّ اللهِ فِيهِ» (٢كورنثوس ٥: ٢١) وهذا إتمام لقول إشعياء «أَمَّا الرَّبُّ فَسُرَّ بِأَنْ يَسْحَقَهُ بِالْحَزَنِ. إِنْ جَعَلَ نَفْسَهُ ذَبِيحَةَ إِثْمٍ» (إشعياء ٥٣: ١٠).
ولا ريب أن في ذلك تكرير آلامه في جثسيماني. والأرجح أن الشيطان في ذلك الوقت شدد تجاربه بدليل قول المسيح «هذِهِ سَاعَتُكُمْ وَسُلْطَانُ الظُّلْمَةِ» (لوقا ٢٢: ٥٣) ولم يصرخ يسوع من آلامه الجسدية بل صرخ من احتجاب وجه أبيه عنه. وإذا كانت نتيجة احتجاب وجه الله عن المسيح ذلك الصراخ الذي لم ينتج عن كل آلامه الجسدية، فكم تكون شدة عذاب الهالكين باحتجاب وجه الله عنهم إلى الأبد. ومع أن يسوع رأى الآب قد تركه فإنه لم يزل واثقاً به بدليل قوله: «إلهي إلهي» لا «الله الله».
والحق أن الله لم يترك يسوع حقيقة، لأنه في ذلك الوقت عينه كان يقوم بالعمل الذي سُرَّ الله بأن يضعه عليه، وأحبه باعتبار كونه ابنه ساعتئذٍ أكثر من كل محبته له فيما مضى، لكنه صرف وجهه عنه باعتبار أنه كفيل الخطاة.
(ذهب كثيرون إلى أن تفسير قوله «إيلي إيلي.. الخ» ليس في الأصل، بل كتبه أحد الناسخين، لأن متّى إنجيله للعبرانيين وهم لا يحتاجون إلى تفسير الكلمات العبرانية).
٤٧ «فَقَوْمٌ مِنَ ٱلْوَاقِفِينَ هُنَاكَ لَمَّا سَمِعُوا قَالُوا: إِنَّهُ يُنَادِي إِيلِيَّا».
كان هؤلاء قوم من اليهود لأن العسكر الروماني لا يعرف شيئاً من أمر إيليا. وهناك تشابه بين «الوي» و «إيليا» فربما توهَّم بعض السامعين أنه ينادي إيليا. والأرجح أنهم فهموا قوله، ولكنهم حرفوه للهزء بدعواه أنه المسيح، لأن اليهود توقعوا أن إيليا يأتي قبلما يأتي المسيح، وتظاهروا الآن أنهم يتوقعوا مجيء إيليا إليهم.
٤٨ «وَلِلْوَقْتِ رَكَضَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَأَخَذَ إِسْفِنْجَةً وَمَلأَهَا خَلاًّ وَجَعَلَهَا عَلَى قَصَبَةٍ وَسَقَاهُ».
مزمور ٦٩: ٢١ ومرقس ١٥: ٣٦ ولوقا ٢٣: ٣٦ ويوحنا ١٩: ٢٩
وَلِلْوَقْتِ في نحو هذا الوقت قال يسوع أيضاً «أنا عطشان» (يوحنا ١٩: ٢٢). فجاء أحدهم بالإسفنجة إجابة لقول المسيح. ولعله أتى ذلك من قبيل الشفقة، لأن العطش من علامات شدة الآلام على الصليب (انظر شرح آية ٣٥). ولعله أتى ذلك هزءاً إذ قال هو نفسه «اتْرُكُوا. لِنَرَ هَلْ يَأْتِي إِيلِيَّا لِيُنْزِلَهُ!» (مرقس ١٥: ٣٦). وكيف كان قصد ذلك الإنسان بما فعله كان عمله أشرف له من أن يضع التاج على رأس أعظم ملوك الأرض، لأنه إذا كان إعطاء كأس ماء بارد لأحد تلاميذ المسيح الصغار لا يذهب بلا أجر، فبالأولى أن يُثاب من أعطى المعلم نفسه مثل ذلك.
إِسْفِنْجَةً أتى بإسفنجة لأن الحال لم تسمح باستعمال الكأس. ولعل تلك الإسفنجة كانت سدادة لآنية من الخل كان يشربه العسكر.
خَلاًّ أي خمراً حامضاً كان يشربها العسكر إطفاءً للعطش. وكان هذا الخل مثل الخل الذي قُدم له أولاً سوى أنه ليس فيه شيء من المر والمخدرات، وهو مثل ما قدم له العسكر هزءاً به (لوقا ٢٣: ٣٦)
عَلَى قَصَبَةٍ لا حاجة إلى أن يكون طول تلك القصبة أكثر من ذراع لكي يبلغ بها الواقف على الأرض شفتي المسيح. وسمى يوحنا تلك القصبة «زوفا» لأنها كانت من نبات الزوفا.
وَسَقَاهُ فشرب (يوحنا ١٠: ٣٠) إنجازاً للنبوة القائلة «فِي عَطَشِي يَسْقُونَنِي خَلاً» (مزمور ٦٩: ٢١).
٤٩ «وَأَمَّا ٱلْبَاقُونَ فَقَالُوا: ٱتْرُكْ. لِنَرَى هَلْ يَأْتِي إِيلِيَّا يُخَلِّصُهُ».
ٱلْبَاقُونَ فَقَالُوا: ٱتْرُكْ هذا لا ينافي قول مرقس إن ساقيه قال ذلك أيضاً (مرقس ١٥: ٣٦) ومعناه أنه لا حاجة إلى أن يعطوه شيئاً، لأنه يتوقع إتيان إيليا ليعزيه وينشطه ويقويه. فقال الساقي «إن الذي سقيته يكفيه إلى أن يأتيه حسب توقعه». ويظهر من هذه السخرية أنهم لم يرهبوا شيئاً من ظلمة الساعات الثلاث الماضية. والأرجح أنهم نسبوها إلى علة طبيعية.
٥٠ «فَصَرَخَ يَسُوعُ أَيْضاً بِصَوْتٍ عَظِيمٍ، وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ».
مرقس ١٥: ٣٧ ولوقا ٢٣: ٤٦
صَرَخَ لم يذكر متّى ما قاله يسوع في صراخه، وهو قوله «قد أُكمل» (يوحنا ١٩: ٣٠). ولم يذكر متّى قوله الآخر وذكره لوقا (لوقا ٢٣: ٤٦). ولعل ذلك الصراخ كان هتاف الفرح لأنه أكمل عمل الفداء. وصراخه بصوت عظيم عند موته دليل على أنه لم يمت ضعفاً وإعياءً بل أنه كان في تمام قوته.
وكانت أقوال المسيح على الصليب سبعة، ثلاثة قبل الظلمة وأربعة بعدها:
- الأول: صلاته من أجل أعدائه (لوقا ٢٣: ٣٤)
- الثاني: وعده اللص التائب بالفردوس (٢٣: ٤٣)
- الثالث: تكليف يوحنا برعاية العذراء (يوحنا ١٩: ٢٧)
- الرابع: صراخه إلى الله عند شدة آلامه (متّى ٣٧: ٤٦ ومرقس ١٥: ٣٤)
- الخامس: قوله «أَنَا عَطْشَانُ» (يوحنا ١٩: ٢٨)
- السادس: قوله «قَدْ أُكْمِلَ» (يوحنا ١٩: ٣٠)
- السابع: تسليمه روحه إلى الله بكل ثقة واطمئنان (لوقا ٢٣: ٤٧)
أَسْلَمَ ٱلرُّوحَ أي مات. وعبر الإنجيليون كلهم عن موته بهذه العبارة، وهى تعني أنه مات اختياراً، وهذا وفق قوله «إني أضع نفسي لآخذها أيضاً. ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها» (يوحنا ١٠: ١٧، ١٨)،وقول النبي «إِنَّهُ سَكَبَ لِلْمَوْتِ نَفْسَهُ» (إشعياء ٥٣: ١٢).ومات في الساعة التاسعة أي وقت تقديم الذبيحة المسائية، بعد ست ساعات من صلبه ونحو ثماني عشرة ساعة من القبض عليه في البستان.
ويندر أن يموت المصلوب بعد وقت قصير كهذا أي في ست ساعات، والغالب أن يموت المصلوب بلا واسطة غير الصلب بعد ٣٦ ساعة. وقد بقى بعض المصلوبين ثلاثة أيام أو أربعة، فظنَّ أكثر المفسرين إنه كان لموته سبب لم يُعهد في المصلوبين. وقال الأطباء إن علة موته سريعاً هو تمزق صمامات القلب بضغط الدم عليها من الصلب وشدة الاكتئاب ومما جرى عليه سابقاً من شدة حزنه في البستان والسهر والجلد وهزء العسكر به. وذلك يوافق قول يوحنا (يوحنا ١٤: ٣٤) إن عسكرياً طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء. ووجود دم وماء في القلب ينتج من تمزُّق صمامات الدم عن سائر أجزاء القلب لأنه ينفصل بذلك مصل.
واحتمل المسيح كل ما احتمله نيابةً عنا، فجُلد لكي نُشفى بحبُره، ودين وهو بارٌ لنتبرر ونحن أثمةن ولبس إكليل الشوك لنلبس إكليل المجد، وعُرِّي من ثوبه ليكسونا ثوب بره، ورُذل وأهين لنكرَم، وأحصي مع الأثمة لنُحصى مع الأبرار، وقبل أن يتَّهم بالعجز عن تخليص نفسه ليخلِّص نفوس الغير إلى التمام، ومات شر الميتات لنحيا إلى الأبد في خير المجد والسعادة. فلا موت ذا أهمية كموته، لأنه أوفى به الدين العظيم الذي لله على الخطاة، وفتح أبواب الحياة لكل المؤمنين، وقام بكل مطالب الشريعة ليكون الله باراً ويبرر الأثمة، وقدم كفارة تامة عن خطايا الناس، وانتصر على الشيطان انتصاراً كاملاً، وأوضح فظاعة الخطية، وبيَّن عظمة محبة الله ورأفته.
٥١ «وَإِذَا حِجَابُ ٱلْهَيْكَلِ قَدِ ٱنْشَقَّ إِلَى ٱثْنَيْنِ، مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلُ. وَٱلأَرْضُ تَزَلْزَلَتْ، وَٱلصُّخُورُ تَشَقَّقَتْ».
خروج ٢٦: ٣١ وأيوب ٣: ١٤ ومرقس ١٥: ٣٨ ولوقا ٢٣: ٤٥
حِجَابُ ٱلْهَيْكَلِ هو الحجاب الفاصل بين القدس وقدس الأقداس. وكان من إسمانجوني موشى بذهب، طوله نحو ٢٨ ذراعاً وعرضه نحو ١٤ ذراعاً. ولم يكن يجوز لأحد سوى رئيس الكهنة أن يدخل إلى ما وراءه، وكان رئيس الكهنة يدخل قدس الأقداس مرة واحدة في السنة «وليس بِلاَ دَمٍ» (خروج ٢٦: ٣١ و٣٠: ١٠ ولاويين ١٦: ٢ - ١٩ وعبرانيين ٩: ٧)
ٱنْشَقَّ كان انشقاقه في التاسعة التي هي وقت تقديم الذبيحة المسائية، ووقت تبخير الكاهن في القدس أمام الحجاب.
ويشير انشقاق ذلك الحجاب إلى ثلاثة أمور:
- موت المسيح في ذلك الوقت عينه، ويوضحه قول كاتب رسالة العبرانيين «طَرِيقًا كَرَّسَهُ لَنَا حَدِيثًا حَيًّا، بِالْحِجَابِ، أَيْ جَسَدِهِ» (عبرانيين ١٠: ٢٠). فقد انشق في ذلك الوقت حجابان، حجاب جسد يسوع، وحجاب الهيكل.
- نسخ النظام الموسوي وإبطال كل الطقوس التي كانت تشير إلى الكفارة. لأن الكفارة الحقيقية تمَّت بموت المسيح لأنه حمل الله الحقيقي الذي ذُبح، ودخل رئيس الكهنة الأعظم إلى قدس الأقداس السماوية بدم نفسه ليشفع فينا (عبرانيين ٦: ١٩،٢٠ و٩: ١٢، ٢٤). وأُقيمت عبادة روحية بدل العبادة الطقسية، فلا حاجة بعد إلى رئيس كهنة أرضي، ولا إلى رش دم في قدس الأقداس، ولا إلى التبخير في الهيكل. قد أُنجزت كل النبوات بالمسيح وأُكمل عمل الفداء.
- إزالة كل حاجز بين الله والإنسان، لأن الحجاب كان يرمز إلى أن طريق الإنسان إلى الله مغلق، وكان شقه إشارة إلى فتح طريق حديث حي يصل به الإنسان إلى الله. وقد بطُل أن يكون قدس الأقداس في أورشليم مكاناً خاصاً لحضور الله بين الناس، وأنه يسوغ لكل إنسان أن يقترب من الله ويقف في محضره الأسنى، لأن قدس الأقداس السماوية فُتح له.
والذين شاهدوا انشقاق الحجاب هم الكهنة دون غيرهم، فأخبروا الآخرين، لأن كثيرين منهم آمنوا بالمسيح (أعمال ٦: ٧). ولا ريب من أن مشاهدتهم ذلك أثرت فيهم كثيراً.
وَٱلأَرْضُ تَزَلْزَلَتْ لم يذكر هذه الحادثة وما في العددين الآتيين أحد من البشيرين سوى متّى، وهي ليست زلزلة طبيعية بل خارقة الطبيعية، وهي شهادة إلهية بأمور محسوسة تشير إلى أهمية موت المسيح. واعتبرت الزلازل في الكتاب المقدس في الغالب إنها علامة لحضور الله وقوته (قضاة ٥: ٤ و٢صموئيل ٢٢: ٨ ومزمور ٧٧: ١٨ و٩٧: ٤ و١٠٤: ٣٢ وعاموس ٨: ٩ وحبقوق ٣: ١٠). ولم تكن تلك الزلزلة هائلة أو ضارة ليكون لها ذكر في تواريخ العالم، بل كانت إشارة إلى اشتراك الخليقة الجمادية مع الخلائق الروحية في الانفعالات. وكما أن الشمس في السماء حجبت نورها لكي لا تشاهد آلام المسيح، كذلك الأرض ارتجفت من فظاعة إثم سكانها بصلبهم رب المجد. وكأن ذلك كان جواباً لقول الهازئين بالمسيح «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَانْزِلْ عَنِ الصَّلِيبِ!» (متّى ٢٧: ٤٠).
وَٱلصُّخُورُ تَشَقَّقَت تشقق الصخور مما يحدث كثيراً وقت الزلزلة. وحدوثه عند موت المسيح كان علامة غضب الله، ووعظاً وإنذاراً للناس الذين أظهروا بأعمالهم أن قلوبهم كانت أقسى من الصخور، لأن الصخور تشققت وقلوبهم لم تزل على حالها.
٥٢، ٥٣ «٥٢ وَٱلْقُبُورُ تَفَتَّحَتْ، وَقَامَ كَثِيرٌ مِنْ أَجْسَادِ ٱلْقِدِّيسِينَ ٱلرَّاقِدِينَ ٥٣ وَخَرَجُوا مِنَ ٱلْقُبُورِ بَعْدَ قِيَامَتِهِ، وَدَخَلُوا ٱلْمَدِينَةَ ٱلْمُقَدَّسَةَ، وَظَهَرُوا لِكَثِيرِينَ».
وَٱلْقُبُورُ تَفَتَّحَتْ كانت القبور يومئذٍ حفراً في صخور يسد كل منها بحجرٍ كبير، فالزلزلة دحرجت تلك الحجارة عن تلك القبور. وفي ذلك إشارة إلى أن موت المسيح سيكون علة فتح كل القبور، وإبطال سلطة الموت وكسر قيوده.
ٱلْقِدِّيسِينَ سمى الكتاب المقدس بذلك المؤمنين من الأحياء والأموات. والقرينة تبين المعنى هنا. ولم يذكر البشير من هم أولئك القديسون وكم هم، ولا المدة التي عاشوها بعد قيامتهم، ولا كيف انتقلوا من الأرض. فالبحث عن ذلك عبث وليس من ورائه فائدة.
ٱلرَّاقِدِينَ أي الموتى (١كورنثوس ١٥: ١٨، ٢٠ و٢تسالونيكي ٤: ١٥). ووجه الشبه بين موت الأبرار والرقاد هو مثل النوم والراحة بعد التعب والعودة إلى الوجدان في الأجساد. فكما يستيقظ الراقدون هنا في صباح الزمني يستيقظ الراقدون في المسيح في صباح القيامة الأبدي. والأرجح أن الذين قاموا يومئذٍ كانوا ممن ماتوا من عهد قريب، وإلا ما عرف الذين شاهدوهم أنهم كانوا موتى وقاموا. والواقع أنهم عرفوهم كذلك.
خَرَجُوا مِنَ ٱلْقُبُورِ بَعْدَ قِيَامَتِهِ يظهر من هذا أنهم لم يقوموا إلا بعد أن قام المسيح. وظهورهم حينئذٍ برهان على أن المسيح غلب الموت وصار باكورة الراقدين (١كورنثوس ١٥: ٢٠ و٢٣ وكولوسي ١: ١٨). وذكر متّى قيامتهم قبل وقتها ليجمع في مكان واحد كل المعجزات المقترنة بموت المسيح، كعادته في جمع الحوادث المتماثلة بغضّ النظر عن أوقاتها. فانه حدثت زلزلة عند قيامته (متّى ٢٨: ٢) روى لنا نتيجتها مع خبر الزلزلة التي حدثت عند موته
ٱلْمَدِينَةَ ٱلْمُقَدَّسَةَ أي أورشليم ودعيت مقدسة لأنه كان فيها هيكل الله المقدس، وكانت مركز العبادة.
وَظَهَرُوا لِكَثِيرِينَ لأنهم لو ظهروا لاثنين أو ثلاثة فقط لظنَّ الناس أنهم توهموا ذلك، والأرجح أن الذين شاهدوهم كانوا من تلاميذ المسيح. وظن بعضهم إنهم بقوا أحياء على الأرض مدة الأربعين يوماً التي بقى فيها المسيح على الأرض بعد قيامته، وأنهم صعدوا معه كما قاموا معه.. ولكن لا دليل على ذلك.
٥٤ «وَأَمَّا قَائِدُ ٱلْمِئَةِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ يَحْرُسُونَ يَسُوعَ فَلَمَّا رَأَوُا ٱلزَّلْزَلَةَ وَمَا كَانَ، خَافُوا جِدّاً وَقَالُوا: حَقّاً كَانَ هٰذَا ٱبْنَ ٱللّٰهِ».
ع ٣٦ ومرقس ١٥: ٣٩ ولوقا ٢٣: ٤٧
َأَمَّا قَائِدُ ٱلْمِئَةِ هو قائد العسكر الذين صلبوا المسيح وحرسوه
وَٱلَّذِينَ مَعَهُ هم أربعة جنود سخروا أولاً بالمسيح وهو على الصليب (لوقا ٢٣: ٣٦)
مَا كَانَ أي كل ما اقترن بموت المسيح من الحوادث، وهي الظلمة، وصبر المسيح وصلاته من أجل قاتليه، ووعده بالفردوس لأحد المصلوبين معه، وصراخه عند موته، مع الزلزلة عندما أسلم الروح.
خَافُوا جِدّاً لأنهم حسبوا الظلمة والزلزلة من أدلة غضب الله.
وَقَالُوا الأرجح أن القائد قال ذلك أولاً وتبعه الآخرون.
هٰذَا ٱبْنَ ٱللّٰهِ اتهم المسيح بأمرين: التجديف بدعواه أنه ابن الله، وإثارة الفتنة على الدولة الرومانية، وبرره بيلاطس مراراً من الأمر الثاني. واشتكى الرؤساء عليه إلى بيلاطس بالأمر الأول، ولعل القائد كان حاضراً وقتئذٍ وسمع ما قيل. ولا شك أنه سمع أيضاً والأربعة الذين معه قول اليهود الواقفين يستهزئون «إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب» وظنوا في أول الأمر إن دعوى المسيح باطلة، وإنه كان إنساناً فقط ومذنبا أيضاً. ولكن بعدما شاهدوا حوادث الساعة السادسة ومعجزاتها تحققوا إنه لم يكن مثيراً للفتنة ولا مجدفاً ولا إنساناً عادياً، بل إنه أحد الآلهة، وأنه يستحق اللقب الذي ادَّعى به. وذكر لوقا أن هذا القائد قال أيضاً «إن هذا الإنسان كان باراً» أي غير خادع (لوقا ٢٣: ٤٧). فتكون شهادة لوقا كشهادة متّى، لأنه إذا كان غير خادع فهو صادق بدعواه أنه ابن الله.
أثرت معجزات الصلب في أولئك الوثنيين الذين جهلوا أعمال المسيح السابقة وتعاليمه أكثر مما أثرت في رؤساء اليهود الدين حصلوا على وسائط معرفة الحقيقة من جهة المسيح، لأنهم لم يخافوا ولم يقتنعوا. فلا أقسى من قلوب الذين يعلمون الحق ويقاومونه.
وكانت التأثيرات العظمى بعد موت المسيح أربعة:
- التأثير في الهيكل بأن شق حجابه
- التأثير في الأرض بأن تزلزلت وصخورها تشققت
- التأثير في عالم الموت بأن قام الموتى
- التأثير الذي يقود للإيمان في قلوب المشاهدين من قائد المئة (لوقا ٢٣: ٤٧) وممن معه من الجند (ع ٥٤) ومن الجموع هنالك (لوقا ٢٣: ٤٨)
٥٥ «وَكَانَتْ هُنَاكَ نِسَاءٌ كَثِيرَاتٌ يَنْظُرْنَ مِنْ بَعِيدٍ، وَهُنَّ كُنَّ قَدْ تَبِعْنَ يَسُوعَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ يَخْدِمْنَهُ».
لوقا ٨: ٢، ٣
نِسَاءٌ كَثِيرَاتٌ وكان معهن بعض معارفه (لوقا ٢٣: ٤٩) ومن جملتهن يوحنا الرسول (يوحنا ١٩: ٣٥). وكانت أم المسيح هنالك في أول الصلب. والأرجح أنها لم تستطع أن تحتمل مشاهدة ابنها يتألم، فسمحت ليوحنا أن يأخذها إلى بيته بعد ما طلب منه المسيح ذلك (يوحنا ١٩: ٢٧) لأنها لم تذكر حينئذٍ مع تلك النساء.
يَنْظُرْنَ مِنْ بَعِيدٍ كان وقوفهن بعيداً إما من شدة الحزن، وإما من الخوف، وإما من دفع العسكر إياهن. وكن في أول الأمر عند الصليب (يوحنا ١٩: ٢٥، ٢٦)
تَبِعْنَ يَسُوعَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ شغل سفر يسوع من الجليل نحو ستة أشهر، وهو يجول في برية شرق الأردن
يَخْدِمْنَهُ أي ينفقن عليه من أموالهن (لوقا ٨: ٢)
٥٦ «وَبَيْنَهُنَّ مَرْيَمُ ٱلْمَجْدَلِيَّةُ، وَمَرْيَمُ أُمُّ يَعْقُوبَ وَيُوسِي، وَأُمُّ ٱبْنَيْ زَبْدِي».
ص ١٣: ٥٥ ومرقس ١٥: ٤٠
مَرْيَمُ ٱلْمَجْدَلِيَّةُ ذكرت هذه المرأة في (متّى ٢٨: ٢ ومرقس ١٦: ١٩ ولوقا ٨: ٢ ويوحنا ٢٠: ١ و١١ - ١٨). وكانت من المجدل، وهي قرية على الشاطئ بحر الجليل الغربي، قرب مدينة طبرية. وكان الرب قد أخرج منها سبعة شياطين.
وَمَرْيَمُ أُمُّ يَعْقُوبَ وَيُوسِي هي امرأة كلوبا (يوحنا ١٩: ٢٥) وكلوبا هو حلفى (متّى ١٩: ٣)
أُمُّ ٱبْنَيْ زَبْدِي هي سالومة (مرقس ١٥: ٤٠) وابناها يعقوب ويوحنا (متّى ١٠: ٢) ولعلها ذكرت هنالك ما سألت المسيح عنه لولديها (متّى ٢٠: ٢٠). وأنه لو أجابها لذلك لكان ابناها مصلوبين بدل اللصين.
وفي نحو ذلك الوقت أتى اليهود إلى بيلاطس وسألوه أن يستعمل الوسائط لتعجيل موت المصلوبين، لكيلا تبقى أجسادهم معلقة على الصليب إلى الغد. فأمر الجنود بكسر سيقان المصلوبين، فكسروا ساقي اللصين، وطعن أحدهم جنب يسوع لكي لا يبقى شك في موته.
٥٧ «وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ، جَاءَ رَجُلٌ غَنِيٌّ مِنَ ٱلرَّامَةِ ٱسْمُهُ يُوسُفُ وَكَانَ هُوَ أَيْضاً تِلْمِيذاً لِيَسُوعَ».
ٱلْمَسَاءُ أي المساء الأول، وذلك نحو العصر (انظر شرح متّى ١٤: ١٥) لأن المسيح مات في الساعة التاسعة من النهار.
جَاءَ إلى قصر بيلاطس.
رَجُلٌ غَنِيٌّ كان أكثر تلاميذ المسيح فقراء خلافاً لهذا التلميذ. ولا شك أن الغِنى بركة إذا أراد أربابه أن ينفقوه في سبيل الله.
مِنَ ٱلرَّامَةِ لم يتحقق أي الرامات، لأن الرامات كانت كثيرة في عهد إسرائيل. ولعلها الرامة التي ولد فيها صموئيل النبي (١صموئيل ١: ١٠، ١٩) شمال أورشليم وعلى مسافة نحو ست ساعات منها.
يُوسُفُ كان هذا الرجل «مشيراً شريفاً» أي أحد أعضاء مجلس السبعين (مرقس ١٦: ٢٣). وكان «صالحاً باراً» (لوقا ٢٣: ٥٠). وممن ينتظرون ملكوت الله حسب قول الأنبياء (مرقس ١٦: ٤٣ ولوقا ٢: ٢٥، ٣٨ و٢٣: ٥١) وكان مخالفاً لرفقائه في المجلس بدليل قوله «هذَا لَمْ يَكُنْ مُوافِقًا لِرَأْيِهِمْ وَعَمَلِهِمْ» (لوقا ٢٣: ٥١)
تِلْمِيذاً لِيَسُوعَ قال يوحنا «إنه وَهُوَ تِلْمِيذُ يَسُوعَ، وَلكِنْ خُفْيَةً لِسَبَبِ الْخَوْفِ مِنَ الْيَهُودِ» (يوحنا ١٩: ٣٨).
٥٨ «فَهٰذَا تَقَدَّمَ إِلَى بِيلاَطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ. فَأَمَرَ بِيلاَطُسُ حِينَئِذٍ أَنْ يُعْطَى ٱلْجَسَدُ».
وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ هذا يقتضي شجاعة عظيمة، لأنه عرَّض نفسه للعار بكونه من تابعي المصلوب. وعرَّضها لخطر الحكومة لأن ما عمله يُعتبر اشتراكاً مع المقتول في ذنبه. ولولا الخوف من ذلك الخطر لربما كان قد طلبه غيره كيوحنا وبطرس وبعض النساء اللواتي خدمنه وهو حي. ولا نستبعد أن يوسف الرامي عُزل من مجلس السنهدريم بسبب ذلك، وأقل ما لحقه من ذلك إنه حرم نفسه بلمسه جثة المسيح من كل احتفالات العيد. وما كان يمكنه أن ينزل جسد المسيح ويدفنه إلا بإذن الوالي، وإنما طلب يوسف ذلك وفقاً لشريعة موسى لأنها أمرت بدفن المعلق على الخشبة في نهار قتله، وحسبت إبقاءه ليلاً بلا دفن تنجيساً للأرض (تثنية ٢١: ٢٢، ٢٣). وكان سبب آخر للرغبة في دفنه نهاراً لأنه كان وقت العيد واليوم الذي صلب فيه كان استعداداً للسبت (يوحنا ١٩: ٣١). واعتاد الرومان أن يتركوا جثث المصلوبين على صلبانهم حتى تفنى أو تأكلها الجوارح، وأما اليهود فاعتادوا أن يطرحوا جثث المصلوبين في حفرة في وادي هنوم، ولذلك سُمي ذلك الوادي «وادي الجثث» وكانوا يطرحون كل أقذار المدينة هنالك. والأرجح أن جثتي اللصين طرحتا هنالك. ولولا طلب يوسف لطُرح جسد المسيح معهما كما كان قصد رؤساء اليهود.
أَمَرَ بِيلاَطُسُ حِينَئِذٍ قال مرقس إن بيلاطس تعجب لما سمع أن يسوع مات سريعاً هكذا، فدعا قائد المئة واستخبره عن ذلك (مرقس ١٥: ٤٤). فلما تحقق إنه مات أذن ليوسف أن يأخذه ليدفنه مع أنه عرف أن ذلك يغيظ رؤساء اليهود. وسمح ليوسف بذلك لأنه كان غنياً شريف النفس والوظيفة. ولعله سمح بذلك طاعةً لضميره أيضاً.
وفي سبق العلم الإلهي أنه سيقوم أناس ينكرون موت المسيح، فكثَّر بعنايته براهين موته، فمنها طعن جنبه بالحربة (يوحنا ١٩: ٣٤، ٣٥)، وإقرار قائد المئة بذلك لبيلاطس (مر١٥: ٤٥). وشهادة رؤساء اليهود أنفسهم في العرض الذي قدموه إلى بيلاطس (ع ٣٦)
٥٩ «فَأَخَذَ يُوسُفُ ٱلْجَسَدَ وَلَفَّهُ بِكَتَّانٍ نَقِيٍّ».
وأخذ يوسف الجسد: وساعده على ذلك نيقوديموس الذي هو مثله في أنه من أعضاء مجلس السبعين. وهذا أتى بمئة مناً من مزيج مر وعود. ولا شك أنه كان مثل يوسف، لم يوافق رفاقه في حكمهم على يسوع، لأنه خالفهم قبلاً في عزمهم على مقاومة يسوع (يوحنا ٧: ٥٠ - ٥٢).
وَلَفَّهُ بِكَتَّانٍ نَقِيٍّ وهذا لا يفعلونه إلا للأغنياء والشرفاء. وكان ذلك الكتان شقة طويلة تحيط بالجسم مراراً. ولا شك أن الأطياب وُضعت على الجسم تحت اللفافة الأولى.
٦٠ «وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ ٱلْجَدِيدِ ٱلَّذِي كَانَ قَدْ نَحَتَهُ فِي ٱلصَّخْرَةِ، ثُمَّ دَحْرَجَ حَجَراً كَبِيراً عَلَى بَابِ ٱلْقَبْرِ وَمَضَى».
إشعياء ٥٣: ٩
فِي قَبْرِهِ أي القبر الذي أعدَّه يوسف لنفسه. لأنه لم يكن للمسيح قبر كما لم يكن له سرير يوم ميلاده، ولا مسكن في حياته الأرضية. وتم بوضعه في ذلك القبر قول النبي «جُعِلَ مَعَ الأَشْرَارِ قَبْرُهُ، وَمَعَ غَنِيٍّ عِنْدَ مَوْتِهِ» (إشعياء ٥٣: ٩). ولعل معنى قوله «جُعِلَ مَعَ الأَشْرَارِ قَبْرُهُ» هو ما قصده رؤساء اليهود لأنهم أرادوا أن يُطرح جسده في وادي هنوم كأجساد سائر المصلوبين. ومعنى قوله «وَمَعَ غَنِيٍّ عِنْدَ مَوْتِهِ» ما قصده الله إبطالاً لقصد اليهود، بدفن المسيح في قبر يوسف الغني. وكان ذلك القبر في بستان قرب الجلجثة أي مكان الصلب (يوحنا ١٩ : ٤١)
ٱلْجَدِيد كان دفن يسوع في قبر جديد لائقاً به نظراً لمقامه الحقيقي، وضرورياً لرفع كل شك في قيامته لئلا يقال بعدها إن غيره قام. فكل ما تعلق بدفن المسيح كان من إكرامه الإكرام الواجب له.
نَحَتَهُ فِي ٱلصَّخْرَةِ كون ذلك القبر منحوتاً في صخرة يدفع اعتراضهم بعد ذلك أن أصحابه سرقوه، بدعوى أن العسكر كانوا يحرسون باب القبر من جانب، فرفع تلاميذه الحجارة من الجانب الآخر!
دَحْرَجَ حَجَراً الخ كانت هيئة ذلك الحجر كهيئة حجر الرحى نحتوا لها قدام القبر طريقاً يرتفع جانبها الأبعد من القبر قليلاً دفعاً للحجر من السقوط عن القبر، ودحرجوه عن محيطه إلى الطريق المنحوتة أمام القبر لسد بابه تماماً.
٦١ «وَكَانَتْ هُنَاكَ مَرْيَمُ ٱلْمَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ ٱلأُخْرَى جَالِسَتَيْنِ تُجَاهَ ٱلْقَبْرِ».
مَرْيَمُ ٱلأُخْرَى هي أم يعقوب ويوسي التي ذكرت في العدد ٥٦ (مرقس ١٥: ٤٦). وكانت هذه مع رفيقتها المجدلية جالستين هنالك لتشاهدا كل ما يحدث، ولم تذهبا إلا بعد ذهاب الجميع. اقتصر متّى على ذكر هاتين المرأتين، وأما لوقا فذكر النساء ولم يعين عددهن ولا أسماءهن وقال «رَجَعْنَ وَأَعْدَدْنَ حَنُوطًا وَأَطْيَابًا» بغية اكتمال تحنيطه بعد مضي السبت (لو ٢٣: ٥٥، ٥٦)
٦٢ «وَفِي ٱلْغَدِ ٱلَّذِي بَعْدَ ٱلاسْتِعْدَادِ ٱجْتَمَعَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ إِلَى بِيلاَطُسَ».
ٱلاسْتِعْدَادِ شاع هذا الاسم عند اليهود لليوم السادس من كل أسبوع لأنه كان استعداداً لليوم الذي يليه وهو السبت. فكانوا يعدون فيه ما يلزم من المأكل والمشرب والوقود وغيرها من لوازم السبت. وكان أول السبت مغرب الجمعة. وقوله «الغد» في هذه الآية يحتمل معنيين. الأول مساء الجمعة بعد الغروب، والثاني صباح السبت، لأن هذا الغد كان يوم السبت وهو من مغرب الجمعة إلى مغرب السبت. ولا شك أن المعنى هنا مساء الجمعة، لأن الرؤساء لم يمكنهم أن يتركوا القبر بلا حراس ليلة واحدة لشدة خوفهم من أن تلاميذه يسرقون جسده.
ٱجْتَمَعَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ الخ أي أعضاء المجلس الكبير وهؤلاء مع أنهم نالوا مأربهم من قتل المسيح لم يزالوا مهتمين بأمره، لأن اجتماعهم في غير وقته أي في يوم السبت دليل على اضطراب أفكارهم.
٦٣ «قَائِلِينَ: يَا سَيِّدُ، قَدْ تَذَكَّرْنَا أَنَّ ذٰلِكَ ٱلْمُضِلَّ قَالَ وَهُوَ حَيٌّ: إِنِّي بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَقُومُ».
متّى ١٦: ٢١ و١٧: ٢٣ و٢٠: ١٩ و٢٦: ٦١ ومرقس ٨: ٣١ و١٠: ٣٤ ولوقا ٩: ٢٢ و١٨: ٣٣ و٢٤: ٦، ٧ ويوحنا ٢: ١٩
تَذَكَّرْنَا كان هؤلاء الرؤساء يرسلون جواسيس ليراقبوا يسوع وينقلوا إليهم كل كلمة يسمعونها منه (لوقا ٢٠: ٢٩)
ٱلْمُضِلَّ كانوا يتهمونه بأنه يضل الشعب (يوحنا ١٧: ١٢). ومن الغريب أنهم لم يستحوا من ذمِّهم في يسوع بهذه النميمة أمام بيلاطس مع أنهم سمعوا تصريحه مراراً ببراءته. واتخذوا أمامه عدم إنقاذ الله ليسوع من الموت دليلاً على كذب دعواه.
بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَقُومُ الظاهر أنهم فهموا هذا من قول يسوع «انْقُضُوا هذَا الْهَيْكَلَ، وَفِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أُقِيمُهُ» (يوحنا ٢: ١٩). مع أنهم ادعوا في محكمتهم أن معناه غير ذلك. ولعلهم استنتجوه أيضاً من قول يسوع للكتبة «كَمَا كَانَ يُونَانُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَثَلاَثَ لَيَالٍ» (متّى ١٢: ٤٠). والأعجب أنهم فهموا هذا المعنى من كلام المسيح مع أن الرسل لم يفهموه يوم قاله، وأنهم ذكروه حين كان يوحنا وبطرس قد نسياه. فالحسد والبغض ينبهان أفكار الناس أحياناً أكثر من الصداقة والمحبة على أن عرض رؤساء اليهود لبيلاطس ما ذكر شهادة بأن المسيح أنبأ قبل موته بقيامته بعد ثلاثة أيام.
٦٤ «فَمُرْ بِضَبْطِ ٱلْقَبْرِ إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلثَّالِثِ، لِئَلاَّ يَأْتِيَ تَلاَمِيذُهُ لَيْلاً وَيَسْرِقُوهُ، وَيَقُولُوا لِلشَّعْبِ إِنَّهُ قَامَ مِنَ ٱلأَمْوَاتِ، فَتَكُونَ ٱلضَّلاَلَةُ ٱلأَخِيرَةُ أَشَرَّ مِنَ ٱلأُولَى».
مُرْ بِضَبْطِ ٱلْقَبْرِ أي اختمه واحرسه بالعسكر
إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلثَّالِث استعمالهم هذه العبارة بدل العبارة التي استعملوها في الآية السابقة وهي قولهم «بعد ثلاثة أيام» دليل على أنهم أرادوا بالعبارتين معنى واحداً، أي أنهم لم يقصدوا بقولهم «بعد ثلاثة أيام» ٧٢ ساعة بل يوماً كاملاً بين جزئين من يومين. وما قصدوه بذلك هو عين ما قصده المسيح.
يَسْرِقُوهُ أي يأخذوا جسده خفية. ويظهر من قولهم هذا عمى قلوبهم من البغض والحسد والكبرياء، حتى إنهم لم يظنوا إمكان قيامته، وإلا ما ظنوا أن ختم الوالي وحراسة العسكر يمنعانها.
ٱلضَّلاَلَةُ ٱلأَخِيرَة اتهموا المسيح إنه مضل وأرادوا بالضلالة الأولى قوله «بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَقُومُ» (ع ٦٣). وبالضلالة الأخيرة قول تلاميذه بعد أن يسرقوه «إِنَّهُ قَامَ مِنَ ٱلأَمْوَات»وقولهم «ٱلضَّلاَلَةُ ٱلأَخِيرَةُ أَشَرَّ مِنَ ٱلأُولَى» دليل على أن شهادة الرسل بقيامة المسيح تثبت صحة كل ما ادَّعاه أكثر من كل تعليمه ومعجزاته
٦٥ «فَقَالَ لَـهُمْ بِيلاَطُسُ: عِنْدَكُمْ حُرَّاسٌ. اِذْهَبُوا وَٱضْبُطُوهُ كَمَا تَعْلَمُونَ».
يظهر لنا من قول بيلاطس أنه كانت فرقة من العسكر تحت أمر رؤساء الكهنة في وقت العيد، فأذن لهم أن يستخدموها لحراسة القبر. أو أنه كتب أمراً بتعيين جماعة من الجند لتلك الحراسة وأعطاهم إياها عند قوله «عِنْدَكُمْ حُرَّاسٌ» أي أمرت لكم بذلك. ولا يبعد أن يكون من عينوا لحراسة القبر هم الذين عينوا لحراسة يسوع على الصليب. ومما يثبت أن الذين عُينوا كانوا من الجند الروماني أنهم عندما قام المسيح ذهبوا إلى رؤساء الكهنة وأخبروهم بما كان (متّى ٢٨: ١١) وأنهم مسؤولون لبيلاطس (متّى ٢٨: ١٤). وموافقة بيلاطس على طلب الرؤساء تدل على رغبته في إرضائهم، وأن ضميره لم يؤنبه على تسليم البريء إلى الموت.
٦٦ «فَمَضَوْا وَضَبَطُوا ٱلْقَبْرَ بِٱلْحُرَّاسِ وَخَتَمُوا ٱلْحَجَرَ».
دانيال ٦: ١٧
ضَبَطُوا ٱلْقَبْرَ كل ما أتاه الرؤساء من الوسائط لمنع انتشار الخبر الكاذب بالقيامة صار أثبت برهان على صحة وقوعها، لأنه بذلك لم يبقَ محل للخداع، ولا إمكان لظن بوقوعه.
بِٱلْحُرَّاسِ الأرجح أنهم كانوا ستة عشر، يسهر في كل مخفر أربعة منهم كما كان في سجن بطرس (أعمال ١٢: ٤).
خَتَمُوا ٱلْحَجَرَ الأرجح أنهم لصقوا طرف خيط بالشمع الأحمر على صخرة القبر وطرفه الآخر بحجر الباب، وختموا شمع الطرفين. وأن الخاتم الذي ختموا به كان خاتم بيلاطس أعطاه لقائد العسكر. فكان نزع الختم به خيانة توجب القتل على مرتكبها. وحدث مثل هذا يوم وُضع دانيال في جب الأسود (دانيال ٦: ١٧).
فالاحتياطات التي اتخذت لمنع الخداع وسرقة الجسد ثلاثة: أي كون الحجر ثقيلاً، ووجود الختم، والحراس.
دخل يسوع القبر كما يدخله كل الناس على الرغم منهم. ولكن دخول المسيح إياه جعل ما كان مظلماً منيراً لتابعيه. ومكثه مدةً تحت سلطان الموت جزءٌ من اتضاعه ليفدي البشر (رومية ١٤: ٩) و «يُشْبِهَ إِخْوَتَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ» (عبرانيين ٢: ١٧).
الأصحاح الثامن والعشرون
١ «وَبَعْدَ ٱلسَّبْتِ، عِنْدَ فَجْرِ أَوَّلِ ٱلأُسْبُوعِ، جَاءَتْ مَرْيَمُ ٱلْمَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ ٱلأُخْرَى لِتَنْظُرَا ٱلْقَبْرَ».
مزمور ١٦: ١ ولوقا ٢٤: ١ ويوحنا ٢٠: ١ ومتّى ٢٧: ٥٦
نأتي الآن إلى صفحة مشرقة بالنور، إذ بعد اشتداد الظلمة يأتي الفجر، وبعد الصليب تبزغ أنوار القيامة المجيدة. هذا هو موضوع كرازتنا، ليس المصلوب فقط بل القائم من الأموات الذي صار باكورة الراقدين.
وَبَعْدَ ٱلسَّبْتِ أي يوم الراحة اليهودي وهو اليوم السابع من الأسبوع.
عِنْدَ فَجْرِ أَوَّلِ ٱلأُسْبُوعِ عبر مرقس عن ذلك بقوله «بَاكِرًا جِدًّا... إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» (مرقس ١٦: ٢) وعبر عنه لوقا بقوله «أول الفجر» (لوقا ٢٤: ١) وعبر عنه يوحنا بقوله «بَاكِرًا، وَالظَّلاَمُ بَاق» (يوحنا ٢٠: ١). وكل هذه العبارات بمعنى واحد، وهو الصباح. وربما نتج ما يظهر من الفرق بينها أن بعض البشيرين ذكر وقت خروج النساء من بيوتهن ليزرن القبر، وذكر البعض وقت وصولهن إليه. وذلك اليوم أي أول الأسبوع وهو يوم الأحد، صار من ذلك الوقت السبت المسيحي تذكاراً لقيامة المسيح فيه.
مَرْيَمُ ٱلْمَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ ٱلأُخْرَى كانت هاتان المرأتان آخر من ترك الصليب والقبر مساء الجمعة (متّى ٢٧: ٥٦، ٦١) وكانتا أول من زار القبر صباح الأحد. واقتصر يوحنا علي ذكر مريم المجدلية لأنها أشهر، ولأن المسيح ظهر لها عند قيامته. وذكر مرقس امرأة ثالثة هي سالومة (مرقس ١٦: ١) وأتى بعد هؤلاء الثلاث فرقة أخرى من النساء حاملات حنوطاً وهن اللواتي تبعن يسوع من الجليل (لوقا ٢٣: ٥٥، ٥٦ و٢٤: ١ - ١٠) ولم يتحقق أن تكون يونا (وهي امرأة خوزي وكيل هيرودس لوقا ٨: ٣) مع الفرقة الأولى أو الفرقة الثانية (لوقا ٢٤: ١٠)
لِتَنْظُرَا ٱلْقَبْرَ فعلتا ذلك للتعزية في حزنهما، ولإظهار إكرامهما لذلك الميت، وليريا هل بقي القبر كما تركتاه. وبقي سبب آخر لم يذكره متّى وذكره مرقس ولوقا وهو إتيانهما بأطياب لتكميل تحنيط جسد المسيح، لأنه لم يكمل يوم الجمعة للسرعة في دفنه. ولربما كان من جملة ما حملهما على ذلك بعض الرجاء أن يحدث شيء غريب في اليوم الثالث من دفنه على ما أنبأ به سابقاً. ويظهر أنهما لم يعرفا شيئاً من أمر الحراس الذين أرسلوا إلى هنالك يوم الجمعة بعد غيابهما، ولا من أمر ختم القبر، فلم تهتما إلا بدحرجة الحجر عن باب القبر لأنهما لا تقدران على دحرجته (مرقس ١٦: ٣).
٢ «وَإِذَا زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ حَدَثَتْ، لأَنَّ مَلاَكَ ٱلرَّبِّ نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَجَاءَ وَدَحْرَجَ ٱلْحَجَرَ عَنِ ٱلْبَابِ، وَجَلَسَ عَلَيْه».
مرقس ١٦: ٥ يوحنا ٢٤: ٤ ويوحنا ٢٠: ١٢
زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ هذا تكرار ما حدث عند موت المسيح. وعندما دحرج الملاك الحجر زادت القيامة وقاراً وهيبة، وذلك يليق بها، كما أنه نبّه الحراس ليشاهدوا الملاك عند نزوله.
مَلاَكَ ٱلرَّبِّ... وَدَحْرَجَ لم تشاهد المرأتان هذا لأنه حدث قبل وصولهما (مرقس ١٦: ٢ - ٤) ولوقا ٢٤: ٢ ويوحنا ٢٠: ١). ودحرجة الملاك للحجر لم تكن لأجل المسيح، فلم يكن هناك مانع من خروجه من القبر بجسده الذي اتخذه عند القيامة (يوحنا ٢٠: ١٩، ٢٦) بل لأجل النساء والتلاميذ ليدخلوا القبر ويتحققوا قيامته.
لم يشاهد أحد من البشر قيامة المسيح أثناء قيامته. وهرب الحراس قبل وصول المرأتين (لوقا ٢٤: ٢ ويوحنا ٢٠: ١) وقال الملاك لهما «لَيْسَ هُوَ هٰهُنَا، لأَنَّهُ قَامَ» (ع ٦)
أنبأ الملائكة مريم بولادة المسيح، ونادوا بها للرعاة، وأعانوا المسيح وقت التجربة، وشددوه عند آلامه في جثسيماني، ودحرجوا الحجر عن القبر، وبشروا النساء بقيامته.
وَجَلَسَ عَلَيْه هذا شاهده الحراس قبلما هربوا.
٣ «وَكَانَ مَنْظَرُهُ كَٱلْبَرْقِ، وَلِبَاسُهُ أَبْيَضَ كَٱلثَّلْجِ».
دانيال ١٠: ٦
مَنْظَرُهُ كَٱلْبَرْقِ أي لامع لمعاناً باهراً (خروج ٣٤: ٢٩ ، متّى ١٧: ٢ ، رؤيا ١: ١٤)
وَلِبَاسُهُ أَبْيَضَ كَٱلثَّلْجِ إشارة إلى الطهارة وإلى صفات الملائكة (دانيال ٧: ٩ ، رؤيا ٣: ٤، ٥، ١٨ و٤: ٤، ٦: ١١، ٧: ٩، ١٣)
٤ «فَمِنْ خَوْفِهِ ٱرْتَعَدَ ٱلْحُرَّاسُ وَصَارُوا كَأَمْوَاتٍ».
ٱرْتَعَدَ ٱلْحُرَّاسُ نسب متّى ارتعادهم إلى مشاهدتهم الملاك. ولكن لا ريب في أنه أثر فيهم أيضاً ارتجاف الأرض من الزلزلة، ولمعان النور الباهر، ودحرجة الحجر عن الباب.
وَصَارُوا كَأَمْوَاتٍ هذا دليل على شدة هولهم حتى فقدوا القوة وأغمى عليهم، وكان ذلك قبل وصول المرأتين. وحلَّ الحراس من الملائكة محل الحراس من العسكر.
٥ «فَقَالَ ٱلْمَلاَكُ لِلْمَرْأَتَيْنِ: لاَ تَخَافَا أَنْتُمَا، فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَطْلُبَانِ يَسُوعَ ٱلْمَصْلُوبَ».
فَقَالَ ٱلْمَلاَكُ كان جوابه على سؤال غير ملفوظ، وهو خوف المرأتين. والبشير متّى لم يذكر هنا سوى ملاك واحد وهو المتكلم، وهذا لا يمنع من أن يكون هنالك غيره من الملائكة كما ذكر البشيرون الآخرون، ومن أن يكون بعض الملائكة خارج القبر وبعضهم داخله، وأن يكون بعضهم وقوفاً والبعض جلوساً (مرقس ١٥: ٥ ولوقا ٢٤: ٤ ويوحنا ٢٠: ١٢)
لِلْمَرْأَتَيْن الأرجح أن مريم المجدلية عندما رأت القبر مفتوحاً جرت إلى المدينة وأخبرت بطرس ويوحنا، وأنها لم تسمع ما قاله الملاك، لأنها لو سمعت أخباره بقيامة المسيح ما قالت لهما «أَخَذُوا السَّيِّدَ مِنَ الْقَبْرِ، وَلَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ!» (يوحنا ٢٠: ٢) وما قالت لمن ظنته البستاني «إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ حَمَلْتَهُ فَقُلْ لِي أَيْنَ وَضَعْتَهُ، وَأَنَا آخُذُهُ» (يوحنا ٢٠: ١٥).
لاَ تَخَافَ كانت مشاهدة الملاك والقبر مفتوحاً كافية لأن ترهبهما، فبادر الملاك إلى مخاطبتهما حاملاً معه كلمات الاطمئنان.
إِنِّي أَعْلَمُ علم من هيئة مجيئهما وحديثهما وما في أيديهما من الأطياب.
يَسُوعَ ٱلْمَصْلُوبَ عُرِف بين الملائكة بهذا اللقب (رؤيا ٥: ٦ و٧: ٩)
٦ «لَيْسَ هُوَ هٰهُنَا، لأَنَّهُ قَامَ كَمَا قَالَ. هَلُمَّا ٱنْظُرَا ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي كَانَ ٱلرَّبُّ مُضْطَجِعاً فِيهِ».
متّى ١٢: ٤٠ و١٦: ٢١ و١٧: ٢٣ و٢٠: ١٩
شهد ملاكان بهذه الشهادة لنساء أُخر داخل القبر ( لوقا ٢٤: ٦، ٧ )
برهنت قيامة المسيح صحَّة دعواه وأن دينه حق إلهي (أعمال ٢: ٢٢، ٢٤) وبرهنت أيضاً حياة المسيح بعد موته وقوته (رومية ٥: ١١).
وهي عربون الحياة المستقبلة لكل مؤمن (١كورنثوس ١٥: ٢٠، ٣٢)
كَمَا قَالَ متّى ١٢: ٤ و١٦: ٢١ و١٧: ٢٣ ويوحنا ٢: ١٨ - ٢٢
ٱنْظُرَا ٱلْمَوْضِعَ الخ لتتحققا من عدم وجود جسد فيه، وهذا يثبت قولي إنه قام.
ٱلرَّبُّ لم يقل ربكما بل «الرب» إثباتاً أنه الله. فالذي دعاه «المصلوب» قبلاً دعاه هنا «الرب».
٧ «وَٱذْهَبَا سَرِيعاً قُولاَ لِتَلاَمِيذِهِ إِنَّهُ قَدْ قَامَ مِنَ ٱلأَمْوَاتِ. هَا هُوَ يَسْبِقُكُمْ إِلَى ٱلْجَلِيلِ. هُنَاكَ تَرَوْنَهُ. هَا أَنَا قَدْ قُلْتُ لَكُمَا».
متّى ٢٦: ٣٢ ومرقس ١٦: ٧
لِتَلاَمِيذِهِ أي كل التلاميذ ولا سيما لبطرس (مرقس ١٦: ٧)
يَسْبِقُكُمْ إِلَى ٱلْجَلِيلِ الجليل هو القسم الشمالي من الأرض المقدسة حيث قضي المسيح أكثر وقت خدمته فيه. ووعد تلاميذه قبل موته أن يجتمع معهم في الجليل بعد قيامته. وليس معنى قوله «يسبقكم» أنه يسير قدامهم في الحال، بل أنه عازم على إنجاز وعده باجتماعه معهم هناك. وعلة اجتماعه معهم في الجليل لا في أورشليم الاحتراس من شيوع أمره، وهياج الاضطهاد على تلاميذه، ولأن مساكن أكثر تلاميذه هناك.
أَنَا قَدْ قُلْت الخ قال الملاك هذا تأكيداً وتحقيقاً لما سبق وقاله
٨ «فَخَرَجَتَا سَرِيعاً مِنَ ٱلْقَبْرِ بِخَوْفٍ وَفَرَحٍ عَظِيمٍ، رَاكِضَتَيْنِ لِتُخْبِرَا تَلاَمِيذَهُ».
فَخَرَجَتَا... مِنَ ٱلْقَبْرِ هذا دليل واضح على أنهما كانتا داخل القبر.
بِخَوْفٍ وَفَرَحٍ قلما يجتمع الخوف والفرح معاً، فاجتماع الاثنين الآن هو دليل آخر على عظمة المشهد وروعته. وكان خوفهما بسبب مشاهدة الملاك وسماع صوته. وكان فرحهما بسبب تبشيره إياهما بقيامة المسيح.
رَاكِضَتَيْنِ رغبتهما في تبشير التلاميذ بقيامة المسيح حملتهما علي الإسراع والهرب، والأرجح أن هاتين المرأتين كانتا مريم أم يعقوب وسالومة (مرقس ١٦: ٨). أما مريم المجدلية التي كانت معهما في أول الأمر فإنها رأت القبر مفتوحاً وظنت أن جسد المسيح قد سُرق، فرجعت إلى المدينة لتخبر بطرس ويوحنا، ولذلك لم تشاهد الملاك. ثم عادت إلى القبر، ولكن بطرس ويوحنا سبقاها إليه وشاهداه فارغاً، ورجعا إلى المدينة. ثم وصلت مريم وبقيت هناك، وظهر المسيح لها قبل الجميع (مرقس ١٦: ٩)
٩ «َفِيمَا هُمَا مُنْطَلِقَتَانِ لِتُخْبِرَا تَلاَمِيذَهُ إِذَا يَسُوعُ لاَقَاهُمَا وَقَالَ: سَلاَمٌ لَكُمَا. فَتَقَدَّمَتَا وَأَمْسَكَتَا بِقَدَمَيْهِ وَسَجَدَتَا لَه».
مرقس ١٦: ٩ ويوحنا ٢٠: ١٤
لاَقَاهُمَا هذا ظهور المسيح الثاني بعد قيامته، وكان الأول ظهوره للمجدلية (مرقس ١٦: ٩) فمرقس قصد بقوله «أولاً» الظهور الأول من الثلاثة التي اقتصر عليها، كما أراد بقوله «أخيراً» آخر هذه الثلاثة. فيحتمل أنه ظهر قبلها.
سَلاَمٌ لَكُمَا هذا السلام تعزية لهما في حزنهما على موته، وتهنئة لهما بقيامته.
أَمْسَكَتَا بِقَدَمَيْهِ وَسَجَدَتَا لَهُ إمساكهما بقدميه حقق لهما قيامته، وقبوله سجودهما إثبات للاهوته لأنهما احترمتاه وسجدتا له باعتبار أنه شخص إلهي، ولذلك لم يرفض شيئاً مما فعلتاه من علامات الإكرام، ورفض ما فعلته مريم المجدلية (يوحنا ٢٠: ١٧). ولا شك أن علة ذلك هو إكرامها له باعتبار أنه صديق بشري.
١٠ «فَقَالَ لَـهُمَا يَسُوعُ: لاَ تَخَافَا. اِذْهَبَا قُولاَ لإِخْوَتِي أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى ٱلْجَلِيلِ، وَهُنَاكَ يَرَوْنَنِي».
يوحنا ٢٠: ١٧ ورومية ٨: ٢٩ وعبرانيين ٢: ١١
لاَ تَخَافَا لأنهما خافتا طبعاً لمشاهدتهما بغتة يسوع حياً بعد تيقنهما أنه مات.
لإِخْوَتِي أي تلاميذي. وسمّاهم إخوة بالمعنى الروحي. وهذه أول مرة دعا تلاميذه إخوة له. ولو أنه قال قبلها على وجه العموم «مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَةَ أَبِي... هُوَ أَخِي» (متّى ١٢: ٥٠) وتخصيص تلاميذه وقتئذٍ بذلك الاسم إشارة إلى أنه غفر لهم تركهم إياه وشكهم فيه وإنكارهم إياه، وأكد لهم بذلك محبته لهم، وأمَّنهم كما أمَّن يوسف إخوته الذين باعوه إلى مصر بقوله «أَنَا يُوسُفُ أَخُوكُمُ» (تكوين ٤٥: ٤). فيسوع مع إنه هو غالب الموت والجحيم لم يزل يحسب تلاميذه إخوة له.
إِلَى ٱلْجَلِيلِ هذا تكرار لوعده لهم (متّى ٢٦: ٣٢) ووعد الملاك للمرأتين (ع ٧). وقصد المسيح أن يكون الاجتماع هناك عاماً.
١١ «وَفِيمَا هُمَا ذَاهِبَتَانِ إِذَا قَوْمٌ مِنَ ٱلْحُرَّاسِ جَاءُوا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَأَخْبَرُوا رُؤَسَاءَ ٱلْكَهَنَةِ بِكُلِّ مَا كَانَ».
فِيمَا هُمَا ذَاهِبَتَانِ أي في أثناء ما سبق.
قَوْمٌ مِنَ ٱلْحُرَّاسِ هذا دليل على أن الحراس تشتتوا من شدة الخوف، فذهب بعضهم إلى جهة والبعض إلى جهة أخرى. ولكن تركهم القبر بلا إذن عرَّضهم للقصاص الشديد. على أن هروبهم هو شهادة بصحَّة حوادث القيامة، لأنه لا يمكن أن يهربوا ويعرضوا أنفسهم لذلك القصاص إلا لهولٍ عظيم.
وَأَخْبَرُوا رُؤَسَاءَ ٱلْكَهَنَةِ في هذه فرقتان من المخبِّرين: الأولى المرأتان، وكان خبرهما بشارة التلاميذ. والثانية الحراس وكان خبرهم إنذاراً وعلة حزن وخجل للرؤساء.
وأخبر الحراس رؤساء الكهنة لأن بيلاطس جعل الحراس يومئذٍ تحت أمر أولئك الرؤساء، ولا بد أن ذلك الخبر أزعجهم كثيراً لأنهم مبغضو المسيح وقاتلوه، وأزعج الصدوقيين منهم أكثر مما أزعج سائرهم لأنهم أنكروا إمكانية القيامة (أعمال ٤: ٤٢). وقيامة المسيح تبطل زعمهم بأن لا قيامة ولا أرواح! وكان الرؤساء قد وعدوا أن يؤمنوا بالمسيح إن نزل عن الصليب (متّى ٢٧: ٤٢) فوجب أن يؤمنوا به لما هو أعظم من النزول عن الصليب بشهادة حراسهم. وهم كانوا قد طلبوا آية من المسيح، ووعدهم بآية يونان النبي، فأنجز وعده (متّى ١٢: ٣٩، ٤٠) فكان عليهم أن يتوبوا ويؤمنوا به.
بِكُلِّ مَا كَانَ أي الزلزلة، وإتيان الملاك، وانفتاح القبر.
١٢ «فَٱجْتَمَعُوا مَعَ ٱلشُّيُوخِ، وَتَشَاوَرُوا، وَأَعْطَوُا ٱلْعَسْكَرَ فِضَّةً كَثِيرَةً».
فَٱجْتَمَعُوا مَعَ ٱلشُّيُوخِ اجتمع رؤساء الكهنة المتفقون على قتل المسيح، في مجلس السبعين. ولا شك أن يوسف الرامي ونيقوديموس لم يجتمعا معهم.
تَشَاوَرُوا أي رأوا آراء مختلفة حتى اتفقوا على واحدٍ منها، والظاهر أنه لم يخطر على بالهم أن يخبروا الشعب بحقيقة الواقع، لأنه لو عرف الشعب بظهور الملائكة وكل ما صار لاستنتجوا بالضرورة أن دعوى المسيح صادقة، ولكانوا آمنوا به.
أَعْطَوُا ٱلْعَسْكَرَ فِضَّةً كَثِيرَةً أي رشوهم رشوة وافرة، وكانوا قد رشوا الإسخريوطي وشهود الزور قبل الصلب، واضطروا بعد الصلب أن يرشوا العسكر بأكثر من ذلك.
١٣ «قَائِلِينَ: قُولُوا إِنَّ تَلاَمِيذَهُ أَتَوْا لَيْلاً وَسَرَقُوهُ وَنَحْنُ نِيَامٌ».
ظهر عجزهم وحيرتهم من أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى حجة يقبلها العقل أعظم مما ذكروا. وأي عاقل يصدق أن تلاميذه الذين هم صيادون من الجليل يجسرون على فتح قبر يحرسه الجنود الرومان؟ أو أنهم إن جسروا على ذلك يكون لهم أدنى رجاء للنجاح، لأنه لا يتوقع أن يكون أولئك الحراس كلهم نياماً في وقت واحد مع علمهم أن قصاص من ينام وقت الحراسة هو الموت (أعمال ١٢: ١٩)؟ فإن صح أن الحراس كانوا نياماً كلهم، فمن أين عرفوا أن تلاميذه سرقوه؟ ليس لهم إذاً سوى أن يقولوا: نمنا واستيقظنا فوجدنا القبر مفتوحاً خالياً من الميت. ولو كان بعضهم نياماً والبعض ساهرين لنبَّه الساهرون النائمين، ومنعوا التلاميذ من السرقة! ولو صح أن الحراس ناموا وتركوا التلاميذ يسرقون الجسد ويشيعون الخبر الكاذب بقيامته ما صدق أحد أن الرؤساء لا يغضبون على الحراس ويسرعون إلى بيلاطس ويشتكون عليهم ويطلبون قصاصهم، ويسألونه القبض على التلاميذ وعقابهم على خيانتهم الحكومة بنزع الختم! وإن لم يقم المسيح فأي منفعة للتلاميذ من سرقة جسده وادعاء قيامته، إذ ليس لهم من ذلك سوى العار والعذاب والموت.
١٤ «وَإِذَا سُمِعَ ذٰلِكَ عِنْدَ ٱلْوَالِي فَنَحْنُ نَسْتَعْطِفُهُ، وَنَجْعَلُكُمْ مُطْمَئِنِّينَ».
ذٰلِكَ أي أنكم كنتم نياماً وقت الحراسة.
ٱلْوَالِي أي بيلاطس
نَسْتَعْطِفُهُ الأرجح أنهم اعتمدوا أن يرشوه لأنه كان مشهوراً بحب الرشوة، فوعدوهم بعد أن رشوهم بأن يرضوا ببلاطس حتى يعفو عن الحراس ويصفح عما ارتكبوه من مخالفتهم القوانين العسكرية، إن بلغه خبر نومهم. ولكن لا دليل على أن بيلاطس سأل عن هذا الأمر.
وَنَجْعَلُكُمْ مُطْمَئِنِّينَ كان الرؤساء مستعدين أن يعدوا الحراس بكل شيء في سبيل أن يغيروا شهادتهم بالواقع.
١٥ «فَأَخَذُوا ٱلْفِضَّةَ وَفَعَلُوا كَمَا عَلَّمُوهُمْ، فَشَاعَ هٰذَا ٱلْقَوْلُ عِنْدَ ٱلْيَهُودِ إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ».
إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ أي اليوم الذي كتب فيه متّى بشارته، وكان ذلك بعد نحو ثلاثين سنة للقيامة، لأن اليهود كانوا وقتئذٍ يعتقدون صدق ذلك الخبر الكاذب، وما زالوا يصدقونه إلى الآن، مع أنه قد مرَّ عليه أكثر من ١٨٠٠ سنة.
١٦ «وَأَمَّا ٱلأَحَدَ عَشَرَ تِلْمِيذاً فَٱنْطَلَقُوا إِلَى ٱلْجَلِيلِ إِلَى ٱلْجَبَلِ، حَيْثُ أَمَرَهُمْ يَسُوعُ».
ٱلأَحَدَ عَشَرَ تِلْمِيذاً اقتصر على ذكر هؤلاء لأنهم أشهر ممن سواهم من المؤمنين.
ٱنْطَلَقُوا لم ينطلقوا إلا بعد نهاية عيد الفصح، فأقل ما مكثوه في أورشليم كان ثمانية أيام بعد قيامة المسيح، لأن يوحنا ذكر حضورهم هنالك في الأحد الذي قام المسيح فيه، والأحد الذي بعده (يوحنا ٢٠: ١٩، ٢٦)
إِلَى ٱلْجَبَلِ لا شيء يعين لنا هذا الجبل، والمرجح أنه قرب بحر الجليل
حَيْثُ أَمَرَهُمْ يَسُوعُ (متّى ٢٦: ٣٢).
١٧ «وَلَمَّا رَأَوْهُ سَجَدُوا لَهُ، وَلٰكِنَّ بَعْضَهُمْ شَكُّوا».
وَلَمَّا رَأَوْهُ يدلنا ما ذُكر في هذه الآية على أنه كان للمسيح تلاميذ غير الأحد عشر رسولاً المذكورين آنفاً، لان الأحد عشر شاهدوه قبلاً في أورشليم ونفوا شكوكهم (يوحنا ٢٠: ٢٠، ٢٧، ٢٨). والأرجح أن الذين اجتمعوا بالمسيح في الجليل غير الأحد عشر، وهؤلاء ذكرهم بولس بقوله «بَعْدَ ذلِكَ ظَهَرَ دَفْعَةً وَاحِدَةً لأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِمِئَةِ أَخٍ» (١كورنثوس ١٥: ١٦) وهذا الاجتماع عينه المسيح قبل موته (إشعياء ٢٦: ٣٢) وأخبر به المسيح أيضاً (ع ١٠)
سَجَدُوا لَهُ كان هذا السجود عبادة روحية، وعبدوه باعتبار كونه ملكاً ومسيحاً وابن الله المنتصر على الموت.
بَعْضَهُمْ شَكُّوا ولا نعجب من هذا الشك فإن الخبر بالقيامة كان غريباً جداً وغير منتظر، والأرجح أنهم نسوا قوله إنه بعد ثلاثة أيام يقوم. وكان هذا الشك وقتياً، بسبب عدم تحققهم في أول الأمر أنه هو الذي عرفوه قبل الموت، لأنه كان قد حدث بعض التغيير في منظره بعد القيامة عاق أقرب معارفه عن تحققه فوراً. وهذا ما جرى مع مريم المجدلية التي ظنته في أول الأمر البستاني (يوحنا ٢٠: ١٥) وهو ما جرى مع التلميذين اللذين ذهبا معه إلى عمواس (لوقا ٢٤: ١٦، ٣١) وما جرى مع بطرس ويوحنا وغيرهما عند بحر الجليل (يوحنا ٢١: ١، ٤). وساقتهم تلك الشكوك إلى التحقيق فلم يتركوا لنا شكاً في صحة قيامته، لأنهم فحصوا كل شيء قبل أن يؤمنوا بالقيامة.
ولا بد أن يكون المسيح قد ظهر لتلاميذه مراراً كثيرة في الأربعين يوماً التي بقي فيها على الأرض بعد قيامته لم يذكر سوى بعضها (يوحنا ٢٠: ٣٠ وأعمال ٣١) والذي ذُكر منها عشرة:
- ظهوره لمريم المجدلية: يوحنا ٢٠ : ١٢، ١٨ ومرقس ١٦: ٩ - ٢٠
- لبعض النساء الراجعات من القبر: متّى ٢٨: ٩، ١٠
- لبطرس (لوقا ٢٤: ٣٤ و١كورنثوس ١٥: ٥) ولعله ظهر له بعد الظهر بقليل
- لتلميذين منطلقين إلى عمواس (مرقس ١٦: ١٢ ولوقا ٢٤: ١٣) وكان ذلك نحو المساء.
- لعشرة تلاميذ في أورشليم مساء يوم قيامته (لوقا ٢٤: ٣٦، ٤٢)
(وكانت هذه الخمسة كلها يوم قيامته في أورشليم أو بالقرب منها).
- للأحد عشر في الأحد الثاني بعد قيامته (لوقا ٢٠: ٢٦).
(وكان ذلك أيضاً في أورشليم)
- لسبعة من الرسل على شاطئ بحر الجليل (يوحنا ٢١: ١، ٤٢).
- لأكثر من خمس مئة أخ مع الأحد عشر رسولاً علي جبل في الجليل (متّى ٢٨: ١٦ و١كورنثوس ١٥: ٦).
- ليعقوب (١كورنثوس ١٥: ٧).
- لكل رسله يوم صعوده وظهر لهم أولاً في أورشليم ثم في بيت عنيا حيث صعد (لوقا ٢٤: ٥٠).
والأدلة على صحة قيامة المسيح كثيرة نقتصر على عشرة منها:
- ظهوره مراراً بعد قيامته، فلو ظهر مرة واحدة لأمكن أن يُقال إن الذين شاهدوه توهموا. ولأنه ظهر ليس أقل من عشر مرات لم يبق في ذلك شك
- كثرة الشهود بقيامته فلو شهد واحد إنه رآه عشر مرات لبقي باب الشك، ولكن الشهود كانوا أكثر من واحد، حتى وصل عددهم إلى أكثر من خمس مئة.
- طول المدة التي ظهر فيها وهي أربعون يوماً، ومرات ظهوره المذكورة كانت ستاً مختلفة. وكانت قيامة المسيح موضوع حديث الرسل وتأملاتهم وصلواتهم في كل تلك المدة، فكان لهم وقت كافٍ لفحص الأمر بالتأني والتدقيق.
- وضوح ظهوره في كل مرة، فإن منها ما كان في الصباح، ومنها ما كان في المساء، ومنها ما كان بينهما. وظهر داخل البيت، وعلي الطريق، وعلى شاطئ البحر، وعلى قمة الجبل، وفي أوقات معينة. وهذه الأحوال تمنع من الخداع.
- تحقق المشاهدون قيامته بشهادة حواسهم، فإنهم رأوه مراراً في أيام مختلفة حتى لم يبق في نفوسهم شك في أنه هو هو. وسمعوه يتكلم، فمريم المجدلية عرفته من صوته، وسمع التلاميذ خطابه الطويل لهم. ولمسوه (متّى ٢٨: ٩ ولو ٢٤: ٣٩) وأكلوا معه فإنه تعشى مع اثنين في عمواس (لو ٢٤: ٣٩، ٤٣) وتغدَّى مع سبعة من التلاميذ عند بحر الجليل (يوحنا ٢١)
- لم تكن قيامته منتظرة، ولو انتظرها الذين شاهدوا المسيح بعد قيامته لظنوا أن آمالهم خدعتهم وتصوراتهم زينت لهم ذلك. وتدل الأخبار على أنهم لم يصدقوها إلا بصعوبة. فليس توما وحده الذي شك فيها إلى أن التزم بقوة البيان ليؤمن بها.
- التغيير العظيم الذي حدث في الرسل حينئذٍ، فإنهم انتقلوا من حالة اليأس إلى الرجاء ومن الجبن إلى الشجاعة، وما علة ذلك إلا صحة قيامته.
- ختم الرسل شهادتهم بصحة القيامة بدمائهم.
- اعتقاد كل المسيحيين من ذلك اليوم إلى هذه الساعة بصحة تلك القيامة.
- اتخاذ الأحد يوم راحة بدلاً من السبت، فإن حفظ اليوم السابع كان فرضاً دينياً نحو أربعة آلاف سنة فيستحيل أن تتفق الكنيسة بأسرها على إبداله بالأحد لأمر لم يحدث.
ولنا في قيامة المسيح ثلاث فوائد كبرى:
- البرهان القاطع على صحة دعوى المسيح، فالقيامة شهادة سماوية إلهية، واعتقدها الرسل وشهدوا بها، واستندوا عليها في تبشيرهم. ولولا صحة القيامة لكان الدين المسيحي باطلاً (١كورنثوس ١٥: ١٤).
- تحقق انتصار المسيح على عدو الإنسان الأخير أي الموت فإنه كل من قام من الموت قبله خضع له ثانيةً، أما المسيح فقام ولا يتسلط عليه الموت بعد.
- قيامة المسيح إنباءٌ بالقيامة العامة وعربون لها، لأن المسيح «قَدْ قَامَ مِنَ الأَمْوَاتِ وَصَارَ بَاكُورَةَ الرَّاقِدِينَ» (١كورنثوس ١٥: ٢٠).
قيامة المسيح معجزة المعجزات:
مما يدل على أن قيامة المسيح معجزة المعجزات أنها تشتمل على كل ما هو خارق للطبيعة في سائر المعجزات. ولنا على ذلك أربعة براهين:
- تغيير نظام الخليقة بتلك الزلزلة غير العادية.
- تغيير شرائع المادة بأن الجسد الذي قام المسيح به كان غير خاضع لنواميس المادة، لأنه دخل الغُرف والأبواب مغلقة، وتوارى عن أبصار مشاهديه وهو بينهم.
- انتصار المسيح على سلطان الموت بقيامته وإقامته غيره من موتى القديسين
- ظهور الملائكة حراساً للقبر ورسلاً إلى الناس.
١٨ «فَتَقَدَّمَ يَسُوعُ وَكَلَّمَهُمْ قَائِلاً: دُفِعَ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَعَلَى ٱلأَرْضِ».
دانيال ٧: ١٣ ،١٤ ومتّى ١١: ٢٧ ولوقا ١: ٣٢ و١٠: ٢٢ ويوحنا ٣: ٣٥ و٥: ٢٢ و١٣: ٣ و١٧: ٢ وأعمال ٢: ٣٦ ورومية ١٤: ٩ و١كورنثوس ١٥: ٣٧ وأفسس ١: ١٠، ٢١ وفيلبي ٢: ٩، ١٠ وعبرانيين ١: ٢ و٢: ٨ و١بطرس ٣: ٢٢ ورؤيا ١٧: ١٤
فَتَقَدَّمَ يَسُوعُ هذا يدل على أن المسيح كان بعيداً عنهم في أول الأمر، فاقترب من الكل أو ممن شكوا فزال شكهم لأنهم تأكدوا أنه هو هو، كما زال شك توما كذلك في غير هذا الوقت (يوحنا ٢٠: ٢٧، ٢٨) .
دُفِعَ أي من الآب إلى الابن باعتبار أنه إنسان وإله. والسلطان الذي دُفع إليه حينئذٍ كان له منذ الأزل باعتبار كونه إلهاً، ولكنه أخلى نفسه منه عند تجسده تنازلاً ليكفر عن خطايا الناس، وأُعيد إليه عند قيامته. فسياسة الكون الآن في يد المسيح لإجراء عمل الفداء.
إِلَيَّ الضمير راجع إلى يسوع المسيح الإله المتجسد. وهذا مما يثبت لاهوت المسيح، لأنه من المحال أن يتقلد المخلوق صفات الخالق، والمحدود صفات غير المحدود. وأن يستعمل البشر قوة الله غير المتناهية.
كُلُّ سُلْطَانٍ دُفع إليه ذلك إثابةً على اتضاعه، وليمارسه لإجراء عمل الفداء (دانيال ٧: ١٤ ورومية ١٤: ٩ وأفسس ١: ٢٠، ٢٣ وفيلبي ٢: ٩، ١١ وكولوسي ٢: ١٠ وعبرانيين ١: ٣، ٦ و١٢: ٢ و١بطرس ٣: ٢٢ ورؤيا ١٧: ١٤)
فِي ٱلسَّمَاءِ :
- ليرسل الروح القدس (يوحنا ١٥: ٢٦ وأعمال ١: ٥، ٨ و٢: ٤، ٣٣ و٤: ٣١)
- ليرسل الملائكة (أعمال ٥: ١٩ و١٢: ٧ و٢٧: ٢٣ وأفسس ١: ٢٠، ٢٣)
- ليشفع عند الآب (رومية ٨: ٣٤ وعبرانيين ٧: ٢٥)
- ليسمع صلوات شعبه ويستجيبها (١يوحنا ٥: ١٤، ١٥)
عَلَى ٱلأَرْض ليجعل العناصر طوع أمره ومتممة مقاصده، وليجعل غضب الإنسان يحمده (مزمور ٧٦: ١٠)، وليفدي شعبه ويحفظهم، ويؤسس كنيسته ويعتني بها ويحميها، ويمد ملكوته في العالم.
١٩ «فَٱذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ ٱلأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِٱسْمِ ٱلآبِ وَٱلابْنِ وَٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ».
مرقس ١٦: ١٥ وإشعياء ٥٢: ١٠ ولوقا ٢٤: ٤٧ وأعمال ٢: ٣٨، ٣٩ ورومية ١٠: ١٨ وكولوسي ١: ٢٣
انتهت بشارة متّى بأمر ووعد، كلاهما ذو شأن عظيم. وبعد أن تحققت القيامة صار على التلاميذ واجبات خطيرة يجب أن يقوموا بها بكل أمانة: عليهم أن يتلمذوا الناس بالتعليم الصحيح قبل أن يعمدوهم بهذا الإيمان الذي يغير العالم.
فَٱذْهَبُوا الفاء هنا سببية فإن المسيح أخذ كل السلطان، وأوجب عليهم أن يذهبوا غير ملتفتين إلى ضعفهم، متكلين على حضوره معهم وتقويته إياهم. ولم يقصر أمره بالذهاب على رسله ولا على من حضر وقتئذٍ من المؤمنين، بل وجَّهه إلى كل مسيحي منذ ذلك الوقت إلى نهاية الزمان، وهذا ظاهر من وعده في ع ٢٠ «هَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ». ومن الواضح أنه لا يصح قصر ذلك الوعد على من لا يعيش إلى انقضاء الدهر. كما أن قصر الأمر المقترن بالوعد على الأحد عشر تلميذاً مستحيل. وذلك ما فهمته الكنيسة من أمره واتخذته دستوراً لها (أعمال ٨: ٤)
وَتَلْمِذُوا أي ارشدوا الناس إلى معرفة الإنجيل ليصيروا مسيحيين، لا بالإجبار بل بالتعليم، لتقتنع عقولهم وضمائرهم فيقبلوا المسيح وخلاصه. وهذه هي الوظيفة العظيمة الوحيدة التي سلمها المسيح كنيسته. فهي لم توكل لتخضع الأمم بل لتعلمهم. وسيف الروح أي كلمته هو السلاح الوحيد الذي يجب أن يستعمل لامتداد ملكوته.
جَمِيعَ ٱلأُمَم كان إرسال المبشرين بالإنجيل في أول الأمر إلى اليهود ( ص ١٠) ولكن المسيح أطلقه هنا، فأمر بتبشير كل الناس يهوداً وأمماً. وهذا يناقض أراء اليهود، لأنهم اعتقدوا أن معرفة الدين الحق مقصورة عليهم، حتى أن تلاميذ المسيح توقفوا عن طاعة هذا الأمر لتعصبهم اليهودي (أعمال ١١: ٣ و١٥: ٥ وغلاطية ٢: ١٢) فمضت عليهم سنون وهم يتأخرون عن إجرائه حتى ألزمهم الاضطهاد في أورشليم أن يذهبوا منها ويبشروا الأمم ولم يُقدِم بطرس على إجراء ذلك إلا برؤيا من السماء. ولم تُقدِم الكنيسة عليه إلا بشهادة بطرس لهم بتلك الرؤيا (أعمال ١٠).
وتبين مما ذكر:
- أن الدين المسيحي سيكون دين كل أهل الأرض، لا أحد أديانها.
- أن هذا الدين موافق لاحتياجات جميع الناس (رومية ١: ١٦ و١٠: ١٢)
- يجب أن تكون الكنيسة بأسرها لجنة عظيمة لنشر الإنجيل إلى أن يؤمن الناس كلهم بالمسيح.
وَعَمِّدُوهُم هذا هو الجزء الثاني من توكيل المسيح للمؤمنين، وهو أن يعمدوا الناس إذا قبلوا تعليمهم وآمنوا بالمسيح. والتعميد هو استعمال الماء في الروحيات إشارة إلى تطهير القلب وفعل الروح القدس وختم عهد الله للمؤمن. وأعطى الله هذا العهد أولاً لإبراهيم ونسله وجدده المسيح بعد قيامته. فهو في العهد الجديد بدل الختان في العهد القديم، ولذلك يسمح بالمعمودية لأطفال المؤمنين كما للبالغين (أعمال ١٦: ١٥، ٣٣). والفرق أن الأطفال يُعلمون بعد المعمودية والبالغين قبلها. ولا بد من اقتران التعميد بالتعليم عند الإمكان.
تتضمن المعمودية باسم الثالوث الأقدس خمسة أمور:
- أن الله جوهر واحد في ثلاثة أقانيم.
- أن المعمودية بأمره وسلطانه.
- تعهد المعتمد بخدمة الله ووقفه نفسه لتلك الخدمة.
- الاعتراف بدين المسيح علانية.
- الفوز بالفوائد المقترنة بالتعهد لله.
ٱلآبِ وَٱلابْنِ وَٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ الاعتماد باسم الآب إقرار بكونه خالقاً معتنياً متسلطاً دياناً محسناً تمجيده غاية الإنسان العظمى. والاعتماد باسم الابن إقرار بكونه إلهاً ونبياً وكاهناً وملكاً ووسيطاً بطاعته وموته. والاعتماد باسم الروح القدس إقرارٌ بأنه إله، وأنه يقدس وينير ويرشد ويعزي. وكان الأمم محتاجين إلى أن يعتمدوا باسم الثلاثة الأقانيم الإلهية لأنهم لم يعترفوا بواحد منها في أديانهم الوثنية، ولكن اليهود الذين تنصروا في عهد المسيح لم يحتاجوا إلا أن يعتمدوا باسم المسيح، لأنهم بختانهم أقروا بالآب والروح القدس (أعمال ٢: ٣٨ و٩: ٤٨ و١٩: ٥ ورومية ٦: ٣ وغلاطية ٣: ٢٧)
وهذه الآية من البراهين التي تثبت عقيدة الثالوث، أي أن الله واحد في ثلاثة أقانيم متساوين في الجوهر والمجد والكرامة والقدرة. وتدل على وحدانيته، بدليل القول «باسم» لا «بأسماء». وتدل على إن الآب الله والابن الله والروح القدس الله، وإلا كان المعتمد يعتمد باسم إله وباسم مجرد إنسان وباسم صفة من الصفات الإلهية، وهذا محال.
وخلاصة ما قيل في المعمودية أربعة أمور:
- أنها إشارة: وهي تقوم باستعمال الماء إما بالرش أو بالسكب أو بالتغطيس مرة واحدة أو ثلاث مرات. وكيفية استعمال الماء ليس من الأمور الجوهرية. والأرجح أن الاستعمال الغالب هو الرش. ولا أهمية لعدد المرات، والمشار إليه بذلك هو فعل الروح القدس في تطهير القلب.
- الإقرار بالإيمان: فإن المعتمد يقر بإيمانه أن الله واحد مثلث الأقانيم، وبوظائف كل من هذه الأقانيم كما هي معلنة في الكتاب المقدس.
- علامة عهد وختم له: وذلك بين الله والإنسان. أما الله فيتعهد بأنه يكون إلهاً للمعتمد المؤمن ولنسله. وأما الإنسان فيتعهد بالخضوع لله إلى الأبد.
- رسم للدخول في كنيسة المسيح المنظورة.
٢٠ «وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ. وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ ٱلأَيَّامِ إِلَى ٱنْقِضَاءِ ٱلدَّهْرِ. آمِين».
أعمال ٢: ٤٢
عَلِّمُوهُمْ من التعليم ما يسبق الإيمان ومنه ما يليه. فالسابق هو التلمذة كما فُهم من قوله «تلمذوا». وهنا أمر بالتعليم الذي يلي الإيمان، وهو كل ما يحتاج إليه المؤمن لبنيانه في طاعة المسيح الكاملة. والمعمودية التي تليها تلك الطاعة لا تنفع شيئاً. فإذاً وجب على المعمِّد أن يعلّم، ووجب على المعمَّد أن يتعلم ويعمل.
جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ وصايا المسيح بلا زيادة ولا نقصان هي قانون إيمان المسيحيين وأعمالهم (أعمال ٢٠: ٢٧ و١كورنثوس ١: ١٧ و٢: ٤ ورؤيا ٢٢: ١٨، ١٩) وتلك الوصايا تتضمن تعاليم العهد القديم كما يظهر من عدة مواعظ للمسيح، ومن تعليم روحه للرسل المعلن لنا في رسائلهم. والظاهر أن لا إشارة في هذا القول إلى التقليد بل فيه منافاة له.
هَا أَنَا مَعَكُمْ هو وعد التشجيع الدائم بهذا المخلص الدائم بعطفه علينا وصحبته إيانا، فإذا كنا تلاميذه بالحق فعلينا أن نحقق هذا الإيمان بحياتنا وسلوكنا ونغلب العالم معه.
هذا هو الوعد الثمين المقترن بالأمر العظيم، وعد به تابعيه تشجيعاً لهم على المناداة بإنجيله. نعم إنه عند صعوده ظهر لهم أنه فارقهم، لكنه أكَّد لهم هنا أنه وإن لم ينظروه يكون حاضراً معهم ليرشدهم ويحميهم ويلهمهم ويوبخهم ويؤدبهم. لأن تأسيس ملكوته في العالم يحتاج إلى وسائط كثيرة قوية، والتلاميذ قليلون ضعفاء. فوعده بأن يكون معهم أكد لهم وجود كل ما يحتاجون إليه للنجاح. ويتم قوله لتلاميذه «ها أنا معكم» بأربع طرق:
- إرسال روحه القدوس الذي يخبرهم بكل ما له.
- كلامه في الإنجيل.
- اتحاده بالمؤمن في العشاء الرباني، إذ يهب له مظاهر محبته ونعمته بنوع خاص.
- مكثه في قلوب المؤمنين.
وفي هذا الوعد ثلاث فوائد:
- البرهان على لاهوت المسيح، لأنه وعد بأن يكون مع كل تلميذ من تلاميذه إلى نهاية الزمان.
- البرهان على أن المسيح هو الرأس الوحيد للكنيسة المنظورة وغير المنظورة على الأرض وفي السماء. وبهذا أظهر سر اسمه «عمانوئيل» أي الله معنا.
- تأكيد حضور الله مع الذين له في كل زمان ومكان، لأن قوله هنا لم يقتصر على الرسل لأنهم لم يبقوا إلى انقضاء الدهر، بل يعم كل المؤمنين به في كل عصر. وعلى هذا يمكن أن يكون المسيح قريباً منا كما كان قريباً من الذين سكنوا معه في الناصرة، وكانوا معه في السفينة على مياه بحر الجليل. ويمكننا أن نقترب منه كما اقترب يوحنا يوم كان متكئاً على صدره في العشاء، وكما اقتربت مريم منه يوم كانت جالسة عند قدميه تسمع صوته.
وسر قوة الكنيسة ونجاحها هو شعورها بحضور المسيح معها
إِلَى ٱنْقِضَاءِ ٱلدَّهْرِ أي أن المسيح يكون مع تلاميذه على الأرض في الروح غير منظور إلى ذلك الوقت. لكن حضوره مع شعبه لا ينتهي بانقضاء الدهر، بل يبقى بحضوره معهم في السماء روحاً وجسداً فينظرونه كما هو (١يوحنا ٣: ٢) ويمجدونه ويتمتعون به إلى الأبد.
وهذه نهاية بشارة متّى أعلن بها لليهود أن يسوع المسيح بن داود حسب نبوات العهد القديم باقتباسه ٤٥ شهادة منها. ولم يذكر صعود المسيح كما ذكره (مرقس ١٦: ١٩، ٢٠ ولوقا ٢٤: ٥٠ - ٥٣ وأعمال ١: ٩ - ١٢) لكن متّى أشار إلى ذلك الصعود في أماكن (منها متّى ٢٢: ٤٤ و٢٤: ٣٠ و٢٥: ١٤، ٣١ و٢٦: ٦٤).
ملحق
بلغت مقتبسات متّى من العهد القديم نحو خمسة وسبعين جُمعت في الجدول الآتي:
| متّى ١: ٢٣ |
إشعياء ٧: ١٤ |
| ٢: ٦ |
ميخا ٥: ٢ |
| ٢: ١٥ |
هوشع ١١: ١ |
| ٢: ١٨ |
إرميا ٣١: ١٥ |
| ٣: ٣ |
إشعياء ٤٠: ٣ |
| ٤: ٤ |
تثنية ٨: ٣ |
| ٤: ٦ |
مزمور ٩١: ١١ |
| ٤: ٧ |
تثنية ٦: ١٦ |
| ٤: ١٠ |
تثنية ٦: ١٣ |
| ٤: ١٥ |
إشعياء ٨: ٢٣ و٩: ١ |
| ٥: ٥ |
مزمور ٣٧: ١١ |
| ٥: ٢١ |
خروج ٢٠: ١٣ |
| ٥: ٣٧ |
خروج ٢٠: ١٤ |
| ٥: ٣١ |
تثنية ٢٤: ١ |
| ٥: ٣٣ |
لاويين ١٩: ١٢ وتثنية ٢٣: ٢٣ |
| ٥: ٣٨ |
خروج ٢١: ٢٤ |
| ٥: ٤٣ |
لاويين ١٩: ١٨ |
| ٨: ٤ |
لاويين ١٤: ٢ |
| ٨: ١٧ |
إشعياء ٥٣: ٤ |
| ٩: ١٣ |
هوشع ٦: ٦ |
| ١٠: ٣٥ |
ميخا ٧: ٦ |
| ١١: ٥ |
إشعياء ٣٥: ٥ و٢٩: ١٨ |
| ١١: ١٠ |
ملاخي ٣: ١ |
| ١١: ١٤ |
ملاخي ٤: ٥ |
| ١٢: ٣ |
١صموئيل ٢١: ٦ |
| ١٢: ٥ |
عدد ٢٨: ٩ |
| ١٢: ٧ |
هوشع ٦: ٦ |
| ١٢: ١٨ |
إشعياء ٤٣: ١ |
| ١٢: ٤٠ |
يونان ١: ١٧ |
| ١٢: ٤٢ |
١ملوك ١٠: ١ |
| ١٣: ١٤ |
إشعياء ٦: ٩ |
| ١٣: ٣٥ |
مزمور ٧٨: ٢ |
| ١٥: ٤ |
خروج ٢٠: ١٢ و٢١: ١٧١٥: ٨ |
| ١٥: ٨ |
إشعياء ٢٩: ١٣ |
| ١٧: ٢ |
خروج ٣٤: ٢٩ |
| ١٧: ١١ |
ملاخي ٣: ١ و٤: ٥ |
| ١٨: ١٥ |
لاويين ١٩: ١٧ |
| ١٩: ٤ |
خروج ١: ٢٧ |
| ١٩: ٥ |
خروج ٢: ٢٤ |
| ١٩: ٧ |
تثنية ٢٤: ١ |
| ١٩: ١٨ |
خروج ٢٠: ١٢ ولاويين ١٩: ١٨ |
| ٢١: ٥ |
زكريا ٩: ٩ |
| ٢١: ٩ |
مزمور ١١٨: ٢٥ |
| ٢١: ١٣ |
إشعياء ٥٦: ٧ وإرميا ٧: ١١ |
| ٢١: ١٦ |
مزمور ٨: ٢ |
| ٢١: ٤٢ |
مزمور ١١٨: ٢٢ |
| ٢١: ٤٤ |
إشعياء ٨: ١٤ |
| ٢٢: ٢٤ |
تثنية ٢٥: ٥ |
| ٢٢: ٣٢ |
خروج ٣: ٦ |
| ٢٢: ٣٧ |
تثنية ٦: ٥ |
| ٢٣: ٣٩ |
لاويين ١٩: ١٨ |
| ٢٣: ٤٤ |
مزمور ١١٠: ١ |
| ٢٣: ٣٥ |
تكوين ٤: ٨، ٢أيام ٢٤: ٢١ |
| ٢٣: ٣٨ |
مزمور ٦٢٩: ٢٥ وإرميا ١٢: ٧ و٢٢: ٥ |
| ٢٣: ٣٩ |
مزمور ١١٨: ٢٦ |
| ٢٤: ١٥ |
دانيال ٩: ٢٧ |
| ٢٤: ٢٩ |
إشعياء ١٣: ١٠ |
| ٢٤: ٣٧ |
تكوين ٦: ١١ |
| ٢٦: ٣١ |
زكريا ١٣: ٧ |
| ٢٦: ٥٢ |
تكوين ٩: ٦ |
| ٢٦: ٦٤ |
دانيال ٧: ١٣ |
| ٢٧: ٩ |
زكريا ١١: ١٣ |
| ٢٧: ٣٥ |
مزمور ٢٢: ١٨ |
| ٢٧: ٤٣ |
مزمور ٢٢: ١٨ |
| ٢٧: ٤٦ |
مزمور ٢٢: ١ |
Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
D - 70007
Stuttgart
Germany
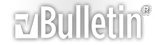




 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس