المقدمة: وفيها ثمانية فصول
الفصل الأول: في اسم هذا السفر
اسم هذا السفر في اليونانية «إيركسيس» أي اعمال واسمه في العربية «الأعمال»أو أعمال الرسل. وليس لنا من دليل على أنه سُمي بهذا الاسم بالوحي ولا على أن كاتبه سماه به. ولكن نعلم أن المسيحيين سموه به منذ القرون الأولى للمسيحية. ولم يُسمّ به لأنه يشتمل على كل اعمال الرسل بل على بعض ما عملوه في تأسيس الكنيسة وبنيانها.
ولم ينبئنا بأعمال كل الرسل في خدمة الكنيسة فإن أكثره يتعلق بأعمال رسولين هما بطرس وبولس. فالمسيح اختار بطرس ليفتح أبواب الكنيسة المسيحية لليهود وللأمم (متّى ١٦: ١٨ و١٩). واختار بولس أعظم وسيلة لنشر الإنجيل بين الأمم. ودعا المسيح وهو على الأرض الأول ودعا وهو في السماء الثاني.
الفصل الثاني: في كاتب هذا السفر
كاتب هذا السفر لوقا كاتب البشارة الثالثة. ولنا على ذلك ثلاثة أدلة:
- الأول: إجماع المسيحيين منذ أول العهد إلى الآن على نسبته إلى لوقا.
- الثاني: ما ينتج من مقابلة مقدمة هذا السفر بمقدمة بشارة لوقا ولا سيما قوله في مقدمة الأعمال «الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيولس» بقوله في مقدمة البشارة «رأيت أنا... أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلوس» ولنا من ذلك أمران (١) أن كاتب سفر الأعمال كتب سفر آخر قبله (٢) أنه كتب هذا السفر إلى الذي كتب إليه ذلك ولا يصدق هذان الأمران إلا على لوقا.
- الثالث: أن أسلوب الكتابة في الإثنين واحد في اللفظ والتركيب. فالذي يقرأ السفرين يرى جلياً أن الثاني تابع للأول أي أن الثاني يُبتدأ حيث ينتهي الأول. وقد سبق الكلام على ترجمة الكاتب في مقدمة بشارته فراجعها هناك لكي نقول بالاختصار أنه أهلٌ لأن يكتب هذا السفر لأنه كان رفيق بولس في أكثر أسفاره وفي مدة سجنه في قيصرية ورومية فعرف حقيقة ما كتبه من سمعه ووعظ بولس ومحاوراته علاوة على ما شاهده بنفسه من الأمور التي ذكرها.
الفصل الثالث: في زمن كتابة هذا السفر ومكانها
نستنتج من ص ٢٨: ٣٠ من هذا السفر أنه كُتب في سنة ٦٣ ب . م في رومية أي بعد السنة الثانية من وصول بولس إلى تلك المدينة. فإنه ذُكر في ع ١٦ من ذلك الأصحاح بلوغه رومية في ع ٣٠ بقاؤه هنالك سنتين ولم يُذكر بعد ذلك شيء من أمر بولس.
الفصل الرابع: في غاية كتابة هذا السفر
ظن بعضهم أن غاية كتابة هذا السفر بيان تاريخ كنيسة المسيح في ثلاثين سنة بعد إنشائها أي منذ ٣٣ للميلاد إلى سنة ٦٣ ولنا على هذا الظن أنه ليس فيه ذكر لحال كنيسة أورشليم بعد إيمان بولس ولا من نبإ بإنشاء الكنيسة المسيحية في دمشق ولا في مصر ولا في بابل ولا في رومية. وليس فيه من ذكر لبعض أسفار بولس وكثير من مصائبه التي ذُكرت في (٢كورنثوس ١١: ٢٥). وقد ترك فيه ذكر خدمة أكثر الرسل للكنيسة واقتصر على ذكر بعض أعمال اثنين بطرس وبولس.
والأصح أن غاية هذا السفر بيان أن المسيح أنجز وعده بإرسال الروح القدس بإنشاء الكنيسة ومدها بين اليهود والأمم في المملكة الرومانية مبتدأة من أورشليم منتشرة من مدينة إلى مدينة في تلك المملكة حتى بلغت رومية. وشغل ذلك الانتشار نحو ثلاثين سنة. أو بيان أنه كيف استمر المسيح يُجري عمل الفداء الذي ابتدأه هو وهو على الأرض بالجسد بعد موته وهو غير منظور بواسطة الروح القدس على وفق قوله في (يوحنا ١٦: ٧ - ١٣).
الفصل الخامس: في من كُتب هذا السفر إليه
كُتب هذا السفر إلى ثاوفيلوس وهو رجل شريف يوناني عالم مؤمن بالمسيح. والأرجح أنه كُتب أيضاً لفائدة المؤمنين من اليهود والأمم عامة. وإنما قدمه لذلك الرجل إكراماً كالعادة الجارية عند المؤلفين يومئذ وفي هذه الأيام.
الفصل السادس: في نسبة هذا السفر إلى البشائر والرسائل
نسبة هذا السفر إلى البشائر والرسائل كنسبة حلقة إلى سلسلتين تصل إحداهما بالأخرى وهو تتمة البشائر ومقدمة الرسائل. وفيه إنجاز نبوءات البشائر من جهة حلول الروح القدس واقتدار الرسل على صنع المعجزات العظيمة ومشاركة الأمم لليهود في حقوق كنيسة الله واضطهاد المسيحيين وانتصارهم على أعدائهم وبيان الوسائط التي أعدت الرسل لكتابة الرسائل كالاختبار والسلطان على ذلك. وبيان أنه من هو بولس الذي كتب أكثر تلك الرسائل ومن دعاه رسولاً وما الذي جعله أهلاً لكتابة ما كتبه وتفصيل تاريخ الكنائس والأشخاص التي كتب رسائله إليها.
فلولا هذا السفر ما عرفنا شيئاً من أمر حلول الروح القدس يوم الخمسين ولا موت استفانوس شهيداً ولا تنصر كرنيليوس ولا الحوادث الغريبة المتعلقة باهتداء بولس ولا تفاصيل انتشار الكنيسة من أورشليم إلى رومية.
الفصل السابع: في فوائد هذا السفر
من فوائد هذا السفر غير ما ذكرناه في غاية كتابته ونسبته إلى ما كُتب قبله وما كُتب بعده من العهد الجديد تاريخ كنيسة المسيح في طفوليتها وكيفية نشوئها وانتظامها وكيفية تحرر أعضائها رويداً رويداً من رق الطقوس اليهودية وتمتعهم بحرية الديانة المسيحية وروحيتها.
ومنها بيان ما ألمّ بالكنيسة من مقاومة اليهود والأمم في بعض عصر طيباريوس الأمبراطور الروماني وكل عصر كليغولا وكلوديوس وبعض أيام نيرون وانتصارها على كل ذلك. ومنها بيان أهمية المناداة بقيامة المسيح لإثبات صحة الديانة المسيحية كما يظهر من مواعظ الرسل وتأثيرها في السامعين. ومنها زيادة ما فعله الأقنوم الثالث أي الروح القدس في عمل الفداء. فيحسن أن نسمي العهد القديم أعمال الآب والبشائر أعمال الابن وهذا السفر أعمال الروح القدس بواسطة الرسل. وفيه من أقوى الأدلة على صحة الدين المسيحي سرعة انتصارات ذلك الدين وعظمتها مع كثرة المقاومين وقوتهم وقلة المسعفين وضعفهم.
الفصل الثامن: في قسمي هذا السفر
هذا السفر قسمان الأول من ص ١ إلى ص ١٢ ويشتمل على انتشار الديانة المسيحية بين اليهود على يد بطرس الرسول والثاني من ص ١٣ إلى ص ٢٨ ويشتمل على انتشارها بين الأمم على يد بولس.
الأصحاح الأول
خطاب المسيح الأخير بعد قيامته وصعوده ع ١ إلى ١١
١ «اَلْكَلاَمُ ٱلأَوَّلُ أَنْشَأْتُهُ يَا ثَاوُفِيلُسُ، عَنْ جَمِيعِ مَا ٱبْتَدَأَ يَسُوعُ يَفْعَلُهُ وَيُعَلِّمُ بِهِ».
لوقا ١: ٣
اَلْكَلاَمُ ٱلأَوَّلُ أي البشارة الثالثة التي ألفها الكاتب لوقا.
يَا ثَاوُفِيلُسُ انظر شرح (لوقا ١: ٣) وهذا الرجل هو الذي كُتب إليه هذا السفر للغاية التي كُتبت إليها البشارة وهي أنه كان يرغب في معرفة صحيح الحوادث المتعلقة بانتشار الديانة المسيحية التي لا بد من أنه كان قد شاع فيها أقوال مختلفة. وكان من غاية الروح القدس أيضاً في إلهام لوقا كتابته إفادة المؤمنين من اليهود والأمم في كل عصر لأنه كما كان يهمهم أن يعرفوا حقيقة حوادث حياة المسيح على الأرض في أول عهدها. وكان لوقا أهلاً لكتابة هذه الحوادث لأنه كان رفيق بولس في بعض أسفاره وممن سمعوا تعليمه فضلاً عن إلهام الروح القدس ص ١٦: ١٠و١٧ و٢٠: ١ - ٦ وص ٢٧ وص ٢٨.
عَنْ جَمِيعِ أي كل الأمور الجوهرية التي معرفتها ضرورية لثبوت إيمان المطالع أو السامع.
مَا ٱبْتَدَأَ أراد لوقا أن يبيّن كون ما كتبه في بشارته أول عمل المسيح وتعليمه وهو على الأرض في الجسد وأن ما سيكتبه في هذا السفر ما استمر يعمله ويعلّمه بروحه وهو في السماء. ويحتمل أنه ذكر الابتداء على اصطلاح العبرانيين ومعناه عندهم الشروع في الفعل كما في العربية (تكوين ٤: ٢٦ و٩: ٢٠ ومتّى ٤: ١٦ ومرقس ٦: ٧ و١٠: ٣٢ و١٤: ٦٥).
يَفْعَلُهُ لأجل خلاص البشر وهذا يتضمن أتعابه ومعجزاته وما أتاه من أعمال الرحمة واحتمله من آلامه وموته وقيامته.
وَيُعَلِّمُ بِهِ مما يتعلق بصفاته تعالى ومقاصده في خلاص البشر.
يُفهم من هذه الآية أن لوقا قصد أن يفعل في هذا السفر ما فعل في بشارته فإنه كتب في البشارة ما فعله المسيح رأساً وأنه سيكتب في هذا السفر تفصيل ما يفعله بواسطة رسله الذين هو أرسلهم وألهمهم بروحه أن يبشروا بإنجيله ويؤسسوا كنيسته.
٢ «إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ فِيهِ، بَعْدَ مَا أَوْصَى بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلرُّسُلَ ٱلَّذِينَ ٱخْتَارَهُمْ».
مرقس ١٦: ١٩ ولوقا ٩: ٥١ و٢٤: ٥١ وع ٩ و١تيموثاوس ٣: ١٦ متّى ٢٨: ١٩ ومرقس ٦: ١٥ ويوحنا ٢٠: ٢١ وص ١٠: ٤١ و٤٢
إِلَى ٱلْيَوْمِ أي اليوم الأربعين بعد قيامته كما يُفهم من ع ٣ وكتب لوقا في بشارته ما ينتهي إلى ذلك (لوقا ٢٤: ٥١).
ٱرْتَفَعَ فِيهِ أي صعد إلى السماء في سحابة كأنها حملته ع ٩. واقتصر لوقا على هذه العبارة من نبإ صعوده لأنه كان معلوماً ومشهوراً ولأنه أنبأ به سابقاً في بشارته. فجعل هنا ما كان نهاية تلك البشارة بداءة هذا السفر.
أَوْصَى بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ كل ما فعله يسوع على الأرض فعله بواسطة الروح القدس واقتياده (متّى ١٢: ٢٠ ولوقا ٤: ١ و١٨ ويوحنا ٣: ٣٤ و٢٠: ٢٢). وإيصاؤه تلاميذه بما يفعلونه بعد موته كان بإرشاد الروح القدس كسائر أعماله. وكثيراً ما أشار سفر الأعمال إلى فعل الروح القدس وذكره خمسين مرة مع أن البشائر الأربع كلها لم تذكره سوى أربعين مرة. والإيصاء الخاص المشار إليه هنا أمره إياهم بأن يذهبوا إلى العالم أجمع ويكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها (مرقس ١٦: ١٥) وأمره الوقتي بأن يقيموا بأورشليم إلى ما بعد حلول الروح القدس (لوقا ٢٤: ٤٨ و٤٩).
ٱلرُّسُلَ أي الأحد عشر الباقين بعد خيانة يهوذا وموته.
ٱلَّذِينَ ٱخْتَارَهُمْ (متّى ١٠: ١ - ١٠ ولوقا ٦: ١٢ - ١٦).
٣ «اَلَّذِينَ أَرَاهُمْ أَيْضاً نَفْسَهُ حَيّاً بِبَرَاهِينَ كَثِيرَةٍ، بَعْدَ مَا تَأَلَّمَ، وَهُوَ يَظْهَرُ لَهُمْ أَرْبَعِينَ يَوْماً، وَيَتَكَلَّمُ عَنِ ٱلأُمُورِ ٱلْمُخْتَصَّةِ بِمَلَكُوتِ ٱللّٰهِ».
مرقس ١٦: ١٤ ولوقا ٢٤: ٣٦ ويوحنا ٢٠: ١٩ و٢٦ و٢١: ١ و١٤ و١كورنثوس ١٥: ٥
اَلَّذِينَ أَرَاهُمْ أَيْضاً نَفْسَهُ حَيّاً في أوقات مختلفة.
بِبَرَاهِينَ كَثِيرَةٍ بصرية وسمعية ولمسية حتى تيقنوا أنه هو هو وأنه حي بالجسد. اجتمع بهم في أوقات وأمكنة مختلفة وفعل بعض المعجزات أمامهم (يوحنا ٢١: ٦ و٧) فعلموا أنه صديقهم القديم القادر كما يعهدونه (لوقا ٢٤: ٣٦ - ٤٨ ويوحنا ٢٠: ١٩ - ٢١). ووقوفهم على تلك البراهين أقنعهم ومكنهم من أن يكونوا شهوداً بقيامته.
ولنا ستة أمور تقنعنا أن تلك البراهين قاطعة.
- الأول: أن الرسل لم يكونوا يتوقعونها حتى يمكن أن آمالهم تخدعهم (يوحنا ٢٠: ٢٥).
- الثاني: أنهم كانوا يعرفون يسوع حق المعرفة إذ كانوا معه كل يوم مدة تنيف على ثلاث سنين.
- الثالث: أن عدد الشهود واتفاقهم في الشهادة يمنعان إمكان أنهم غلطوا.
- الرابع: طول المدة للفحص عن أمر قيامته وتحققه فإنها كانت أكثر من شهر.
- الخامس: ظهور يسوع في أوقات مختلفة وأحوال مختلفة وأماكن مختلقة تحققوا في كل منها أنه هو يسوع.
- السادس: أنه أظهر بعد قيامته الصفات التي أظهرها عينها قبل موته كعطفه عليهم وتجديده المواعيد والأوامر التي خاطبهم بها قبل الموت.
بَعْدَ مَا تَأَلَّمَ أي مات مصلوباً وعبّر عن ذلك الموت بالتألم نظراً لشدة الآلام التي احتملها به ومثل ذلك ما في (ص ٣: ١٨ و١٧: ٣ وعبرانيين ١٣: ١١ و١بطرس ٣: ١٨).
وَهُوَ يَظْهَرُ لَهُمْ انظر شرح (متّى ٢٨: ١٧).
أَرْبَعِينَ يَوْماً لم يُذكر تعيين المدة بين قيامة المسيح وصعوده في غير هذا الموضع وهي على قدر أيام صومه وتجربته وأيام إقامة موسى في طور سينا وأيام صوم إيليا في البرية.
ِيَتَكَلَّمُ عَنِ ٱلأُمُورِ ٱلْمُخْتَصَّةِ بِمَلَكُوتِ ٱللّٰه كلامه بعد قيامته على الموضوع الذي كان يتكلم فيه قبل موته برهان على أنه الذي تألم هو هو وأن أفكاره ومقاصده لم تتغير شيئاً. والمراد «بملكوت الله» هنا الملكوت الذي أتى هو ليؤسسه على الأرض (انظر شرح متّى ٣: ٢) وعلى الخصوص كنيسته. ويتضمن ذلك التكلم عدة أمور نذكر خمسة منها:
- الأول: نجاز نبوءات الكتاب المقدس بيسوع (لوقا ٢٤: ٤٧).
- الثاني: التبشير بالإنجيل لكل الأمم (لوقا ٢٤: ٤٧).
- الثالث: أمره للرسل بواجبات وظيفتهم من تبشير وتلمذة وتعميد إلى غير ذلك (متّى ٢٨: ١٩ و٢٠).
- الرابع: وعده بحضوره معهم (متّى ٢٨: ٢٠).
- الخامس: إنباؤه إيّاهم بأنهم يتعمدون بالروح القدس (لوقا ٢٤: ٤٩ وأعمال ١: ٨).
٤ «وَفِيمَا هُوَ مُجْتَمِعٌ مَعَهُمْ أَوْصَاهُمْ أَنْ لاَ يَبْرَحُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ، بَلْ يَنْتَظِرُوا «مَوْعِدَ ٱلآبِ ٱلَّذِي سَمِعْتُمُوهُ مِنِّي».
لوقا ٢٤: ٤٣ و٤٩ يوحنا ١٤: ١٦ و٢٦ و٢٧ و١٥: ٢٦ و١٦: ٧ وص ٢: ٣٣
وَفِيمَا هُوَ مُجْتَمِعٌ مَعَهُمْ الأرجح أنهم كانوا متشتتين واجتمعوا بأمره والمكان مذكور أنه في أورشليم والوقت كان أحد الأيام الأربعين المعلومة والأرجح أنه كان قرب صعوده.
لاَ يَبْرَحُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ أي لا يغيبوا عنها كما فعلوا على أثر موته.
مَوْعِدَ ٱلآبِ أي حلول الروح القدس وسمي «موعد الآب» لأن الآب وعد به في العهد القديم (إشعياء ٤٤: ٣ ويوئيل ٢: ٢٨ و٢٩) الذي سمعتموه مني (لوقا ٢٤: ٤٩ ويوحنا ١٤: ١٦ و٢٦ و١٥: ٢٦ و١٦: ٧ - ١٣).
٥ «لأَنَّ يُوحَنَّا عَمَّدَ بِٱلْمَاءِ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَسَتَتَعَمَّدُونَ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ، لَيْسَ بَعْدَ هٰذِهِ ٱلأَيَّامِ بِكَثِيرٍ».
متّى ٣: ١١ وص ١١: ١٦ و١٩: ٤ يوئيل ٣: ١٨ وص ٢: ٤ و١١: ١٥
هذا كلام المسيح لا كلام لوقا ذكر به التلاميذ ما قيل سابقاً في مقابلة معمودية يوحنا المعمدان بمعموديته. قابل ما في (متّى ٣: ١١ بما في يوحنا ١: ٣٣ ولوقا ٣: ١٦). قيل هناك أن يوحنا يعمد بالماء وأن المسيح سيعمد بالروح القدس والنار وكان هذا الوعد على وشك أن يتم بنوع عجيب.
لَيْسَ بَعْدَ هٰذِهِ ٱلأَيَّامِ بِكَثِيرٍ أي في يوم الخمسين والمدة بينه وبين الصعود ليست سوى عشرة أيام وكان وقت التكلم قرب وقت الصعود.
٦ «أَمَّا هُمُ ٱلْمُجْتَمِعُونَ فَسَأَلُوهُ: يَا رَبُّ، هَلْ فِي هٰذَا ٱلْوَقْتِ تَرُدُّ ٱلْمُلْكَ إِلَى إِسْرَائِيلَ؟»
متّى ٢٤: ٣ إشعياء ١: ٢٦ ودانيال ٧: ٢٧ وعاموس ٩: ١١
وَأَمَّا هُمُ ٱلْمُجْتَمِعُونَ هذا الاجتماع غير الاجتماع الذي ذُكر في ع ٤ لأنه كان بعده في يوم الصعود (ع ٩) على جبل الزيتون (ع ١٢) قرب بيت عنيا (لوقا ٢٤: ٥٠).
هَلْ فِي هٰذَا ٱلْوَقْتِ الخ هذا السؤال نتيجة ما اعتقده اليهود عامة من أن المسيح يكون ملكاً أرضياً يحرر أمة الإسرائيليين من سلطة الرومانيين ويرد عظمتها التي كانت لها في أيام داود وسليمان على وفق المواعيد (إشعياء ١: ٢٦ ودانيال ٧: ٢٧). فاجتهد المسيح أن ينفي هذا الوهم وأن يعلم تلاميذه أن ملكوته روحي ليس من هذا العالم. وموته أبطل كل رجاء تلاميذه زمنية ملكوته (لوقا ٢٤: ٢١). لكن قيامته ووعده بحلول الروح القدس جدد ذلك الرجاء إذ تحققوا أنه هو هو وأن ليس للموت من سلطان عليه فإذاً هو أقدر من كل أعدائه. وإذ كان الوعد بحلول الروح القدس مقترناً بسائر المواعيد في شأن عظمة ملكوت المسيح وبهائه (يوئيل ٣: ١ و٢) لم يشكوا في أن غاية المسيح رد الملك لإسرائيل. والأمر الوحيد الذي ترددوا فيه هو أنه ألآن يرد لهم ذلك الملك أم بعد ولذلك سألوه.
٧ «فَقَالَ لَهُمْ: لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا ٱلأَزْمِنَةَ وَٱلأَوْقَاتَ ٱلَّتِي جَعَلَهَا ٱلآبُ فِي سُلْطَانِهِ».
متّى ٢٤: ٣٦ ومرقس ١٣: ٣٢ و١تسالونيكي ٥: ١
لم يسأل الرسل عن سوى وقت رد الملك والمسيح لم يجبهم إلا على ذلك. وترك إصلاح غلطهم في حقيقة ملكوته إلى وقت حلول الروح القدس لأنهم يعرفونها حينئذ حسناً. وأبى في جوابه أن يعيّن لهم الوقت بناء على المبدأ وهو أن الله لا يخبر الناس بأوقات الحوادث العظيمة المتعلقة بملكوته. ومثل ذلك كان جوابه للرسل حين قالوا «قُلْ لَنَا مَتَى يَكُونُ هٰذَا» (متّى ٢٤: ٣) وهو قوله «وَأَمَّا ذٰلِكَ ٱلْيَوْمُ وَتِلْكَ ٱلسَّاعَةُ فَلاَ يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلاَ مَلاَئِكَةُ ٱلسَّمَاوَاتِ، إِلاَّ أَبِي وَحْدَهُ» (متّى ٢٤: ٣٦) انظر أيضاً (١تسالونيكي ٥: ١ و٢ و٢بطرس ٣: ١٠) ولكنه وجه أفكارهم إلى الاستعداد للقيام بما يجب عليهم من الخدمة.
ٱلأَزْمِنَةَ وَٱلأَوْقَاتَ التي تحدث فيها الأمور المستقبلة.
ٱلَّتِي جَعَلَهَا ٱلآبُ فِي سُلْطَانِهِ أي عيّنها بحكمته الأزلية وأبقى معرفتها لنفسه حتى أن الملائكة أنفسهم لا يعرفونها ولا المسيح عينه باعتبار أنه إنسان (مرقس ١٣: ٣٢) ولا يليق بالإنسان أن يسأل عنها (متّى ٢٤: ٣٦). ولا نعلم علة ذلك إنما نعلم أن الناس لو علموها وعرفوا أنها بعيدة لغفلوا عن الاستعداد لها وأهملوا السهر والانتظار أو علموا أنها قريبة لخافوا فعجزوا عن القيام بما يجب عليهم.
٨ «لٰكِنَّكُمْ سَتَنَالُونَ قُوَّةً مَتَى حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ عَلَيْكُمْ، وَتَكُونُونَ لِي شُهُوداً فِي أُورُشَلِيمَ وَفِي كُلِّ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَٱلسَّامِرَةِ وَإِلَى أَقْصَى ٱلأَرْضِ».
لوقا ٢٤: ٤٩ وص ٢: ١ و٤ لوقا ٢٤: ٤٨ ويوحنا ١٥: ٢٧ وع ٢٢ وص ٢: ٣٢
وعدهم المسيح بذلك تعزية لهم على إباءته الإجابة عن سؤالهم.
سَتَنَالُونَ قُوَّةً على القيام بما يجب عليكم باعتبار كونكم رسلاً وهي القوة التي يهبها لهم الروح القدس كوعد يسوع إياهم سابقاً بأنهم يفهمون معاني نبوءات العهد القديم وأنهم يذكرون كلامه وأنهم يصنعون معجزات وأنهم يُعطون قوة التكلم حتى يهتدي الناس بأقوالهم ويرجعوا إلى الله بالإيمان بالمسيح وقوة على احتمال المصائب.
مَتَى حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ عَلَيْكُمْ في هذا تعيين الوقت لنوالهم القوة وهو بعد عشرة أيام.
تَكُونُونَ لِي شُهُوداً ما كان عليهم أن يأتوا بآراء أنفسهم بل أن يخبروا الناس بما علموا من تعاليم المسيح وسيرته ومعجزاته وصلبه وقيامته ومواعيده بما رأوا وسمعوا (ع ٢١ و٢٢ وص ٢: ٣٢ و١٠: ٣٩ ولوقا ٢٤: ٤٨ ويوحنا ١٥: ٢٧ و١يوحنا ١: ١).
وكان عليهم أن يكونوا شهوداً بالتبشير وبقداسة السيرة ومحبة كل منهم للآخر وصبرهم في الضيق وموتهم في سبيل الحق إذا اقتضت الحال.
ولتقديم تلك الشهادة اختارهم يسوع رسلاً ورافقوه ثلاث سنين وشاهدوا أعماله وسمعوا تعليمه فصاروا بذلك أهلاً للشهادة وكان عددهم وخلوصهم ينفيان كل شي في صحة شهادتهم.
ووجوب تأدية تلك الشهادة غير مقصور على الرسل لأن المسيح قصد أن تكون كنيسته كلها شاهدة بصدق تعاليمه وجودتها وسعة الخلاص لكل من يؤمن وأن كل عضو من أعضاء تلك الكنيسة رجلاً وامرأة كبيراً وصغيراً يكون شاهداً له.
فِي أُورُشَلِيمَ قصة مملكة اليهود ومركز ديانتهم لأن المسيح قصد أن اليهود يُبشرون بالإنجيل أولاً. وهناك قبل شهادتهم ألوف يوم الخمسين وبعده بقليل وبقي الرسل يؤدون شهادتهم إلى ما بعد أن قتل هيرودس يعقوب (قابل ما في ص ٨: ١ بما في ص ١٢: ١ و٢). وكانت مدة بقائهم في أورشليم نحو ثماني سنين.
وَفِي كُلِّ ٱلْيَهُودِيَّةِ أي القسم الجنوبي من أقسام الأرض المقدسة الثلاثة وهي الأماكن المجاورة لأورشليم.
وَٱلسَّامِرَةِ القسم المتوسط بين الجليل واليهودية (انظر شرح متّى ٢: ٢٢). وكان أهل السامرة يشبهون اليهود في بعض الوجوه والأمم في وجوه أُخر. وكان معبدهم في جبل جرزيم. وكان يسوع قد أمر رسله أن لا يذهبوا قبل موته إلى السامرة للتبشير (متّى ١٠: ٥). وشهادة الرسل في السامرة ذُكرت في (ص ٨: ١ - ٢٥ و٩: ٣١).
وَإِلَى أَقْصَى ٱلأَرْضِ هو ما أعطاه الآب ابنه (مزمور ٢: ٨). والقول هنا كالقول في (متّى ٢٨: ١٩ ومرقس ١٦: ١٥).
٩ «وَلَمَّا قَالَ هٰذَا ٱرْتَفَعَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، وَأَخَذَتْهُ سَحَابَةٌ عَنْ أَعْيُنِهِم».
لوقا ٢٤: ٥١ ويوحنا ٦: ٦٢ وع ٢
ٱرْتَفَعَ إلى السماء (ع ١١) بجسده لأنهم شاهدوه صاعداً كذلك. ولم يختف بل إن السحابة أخذته وكان ذلك في النهار أمام عيون كل الرسل وهو يتكلم وزاد لوقا في بشارته أنه كان يباركهم حين انفرد عنهم ولو غاب عنهم خفية أو ليلاً لم يتحققوا أنه صعد إلى السماء ولكنهم تحققوا ذلك بالمشاهدة وتحققوا أن الله راضٍ به. وأنه حيّ في السماء يجري عمل الفداء. ولم يصعد أحد إلى السماء بالجسد إلا هو وأخنوخ (تكوين ٥: ٢٤ وعبرانيين ١١: ٢٥) وإيليا (٢ملوك ٢: ١١).
أَخَذَتْهُ سَحَابَةٌ كثيراً ما كانت السحابة علامة حضور الله لأنه هكذا حضر على طور سينا حين إعطائه الشريعة (خروج ٢٠: ١٦). واقتاد شعبه إسرائيل في البرية بعمود سحاب وترآى في قدس الأقداس في الهيكل بسحابة من نور (١ملوك ٨: ١٠ و١١ وإشيعاء ٦: ١ - ٤) وجاء في المزامير أن الله جعل السحاب مركبته (مزمور ١٠٤: ٣). وقيل في الإنجيل أن المسيح ظللته وقت التجلي سحابة وتكلم الله من وسطها (متّى ١٧: ٥). وأنبأ الكتاب بأن المسيح يأتي ثانية في السحاب (مرقس ١٤: ٦٢ ورؤيا ١: ٧ انظر أيضاً دانيال ٧: ١٣ ومتّى ٢٤: ٣٠ و٢٦: ٦٤).
لم يذكر متّى ولا يوحنا صعود المسيح ولعل علة هذا أن الصعود كان معروفاً ومشهوراً بين الذين كتبا إليهم وندر ذكره في الرسائل لكنه كثيراً ما ذُكر فيها أنه قام وجلس عن يمين الآب وهذا يستلزم صعوده إلى السماء. ولنا في الصعود خمسة أمور:
- الأول: أنه معجزة تثبت صحة دعوى يسوع.
- الثاني: إظهار أن ملكوت المسيح سماوي روحي.
- الثالث: أنه كان ضرورياً لحلول الروح القدس.
- الرابع: أنه كان ضرورياً لممارسة المسيح الشفاعة على وفق فعل رئيس الأحبار الذي كان بعد أن يقدم الذبيحة يدخل إلى قدس الأقداس لكي يكفر عن الشعب (لاويين ١٦: ١١ - ١٤ وعبرانيين ٧: ٢٥ و٩: ٧ - ١٢ و٢٤).
- الخامس: أنه كان ضرورياً ليمارس المسيح وظيفته الملكية (١كورنثوس ١٥: ٢٥ وأفسس ١: ٢٠ - ٢٢ وفيلبي ٢: ٦ - ١١).
١٠ «وَفِيمَا كَانُوا يَشْخَصُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ، إِذَا رَجُلاَنِ قَدْ وَقَفَا بِهِمْ بِلِبَاسٍ أَبْيَضَ».
متّى ٢٨: ٣ ومرقس ١٦: ٥ ولوقا ٢٤: ٤ ويوحنا ٢٠: ١٢ وص ١٠: ٣ و٣٠
يَشْخَصُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ أي ينظرون إما أسفاً على ذهابه أو توقعاً لرجوعه أو أملاً أن يحدث أمر غريب يتعلق برد الملك إلى إسرائيل (ع ٦).
رَجُلاَنِ أي ملاكان بهيئة رجلين كالملاكين اللذين كانا في قبر المسيح (يوحنا ٢٠: ١١) ووصفهما لوقا في بشارته بأنهما «رجلان بثياب براقة» (لوقا ٢٤: ٤).
وَقَفَا ظهرا بغتة ولم يشاهدا آتيين.
١١ «وَقَالاَ: أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْجَلِيلِيُّونَ، مَا بَالُكُمْ وَاقِفِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ؟ إِنَّ يَسُوعَ هٰذَا ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ عَنْكُمْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ سَيَأْتِي هٰكَذَا كَمَا رَأَيْتُمُوهُ مُنْطَلِقاً إِلَى ٱلسَّمَاءِ».
ص ٢: ٧ و١٣: ٣١ دانيال ٧: ١٣ ومتّى ٢٤: ٣٠ و مرقس ١٣: ٢٦ ولوقا ٢١: ٢٧ ويوحنا ١٤: ٣ و١تسالونيكي ١: ١٠ و٤: ١٦ و٢تسالونيكي ١: ١٠ ورؤيا ١: ٧
أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْجَلِيلِيُّونَ إن الملائكة على ما ذُكر في الإنجيل كانوا غالباً يصرحون باسم من يخاطبونه وهنا خاطب الملاكان جماعة فصرحا بنسبتهم إلى وطنهم لأن الأحد عشر كانوا كلهم من الجليل.
مَا بَالُكُمْ... تَنْظُرُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ كان خطاب الملاكين للتوبيخ وللتعزية أما التوبيخ فعلى توقعهم رجوع المسيح حالاً بدون تغيّر أو بمجد عظيم لانه أخبرهم بلزوم ذهابه إلى الآب (يوحنا ٦: ٦٢ و٢٠: ١٧). فكان الجدير بهم أن يرجعوا ليمارسوا العمل الذي وكله المسيح إليهم على الأرض لا أن يشخصوا بشوق وحزن إلى السماء إلى حيث صعد المسيح.
ٱرْتَفَعَ عَنْكُمْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ليجلس عن يمين الآب محل الإكرام والمسرة به (مرقس ١٤: ٦٢ و١٦: ١٩ وأعمال ٧: ٥٥ ورومية ٨: ٣٤ وأفسس ١: ٢٠ وعبرانيين ١: ٣).
سَيَأْتِي هٰكَذَا كَمَا رَأَيْتُمُوهُ الخ أي يوم الدين وهذا يحقق لنا مجيئه ثانية وأنه يأتي كما ذهب في جسده وروحه ومحبته لإخوته وسائر صفاته بدون تغير كما كان هو على الأرض يوبخ الفريسيون المرائين ويرحب بالنائب المؤمن. وأنه كما ذهب في السحابة منظوراً كذلك «يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ» (رؤيا ١: ٧ انظر أيضاً زكريا ١٤: ٤ ومتّى ٢٤: ٣٠ و١تسالونيكي ٤: ١٦ ويهوذا ع ١٤ و١٥).
رجوع الرسل إلى أورشليم ع ١٢ إلى ١٤
١٢ «حِينَئِذٍ رَجَعُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ مِنَ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلزَّيْتُونِ، ٱلَّذِي هُوَ بِٱلْقُرْبِ مِنْ أُورُشَلِيمَ عَلَى سَفَرِ سَبْتٍ».
لوقا ٢٤: ٥٢
جَبَلَ ٱلزَّيْتُونِ انظر شرح (متّى ٢١: ١). عيّن الكاتب موقع مكان هذا الصعود في بشارته بأنه كان قرب بيت عنيا وهي على السفح الجنوبي الشرقي (لوقا ٢٤: ٥٠).
سَفَرِ سَبْتٍ هذا بعد الجبل عن أورشليم لا بعد محل الصعود وسفر السبت مسافة مشهورة عندهم لم يعينها موسى بل مشايخ اليهود وهي ٢٠٠٠ خطوة. قيل وحسبوا أن ذلك مسافة ما بين كل طرف من أطراف معسكر الإسرائيليين في البرية إلى خيمة الاجتماع وقطع هذه المسافة كان جائزاً لكل إسرائيلي حينئذ فأجازوا قطع مثلها بعد ذلك. وزاد الكاتب في بشارته على ما كُتب هنا أن التلاميذ سجدوا ليسوع ورجعوا بفرح عظيم (لوقا ٢٤: ٥٢) وهذا على وفق قول المسيح لهم «أَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللّٰهِ فَآمِنُوا بِي» (يوحنا ١٤: ١).
١٣ «وَلَمَّا دَخَلُوا صَعِدُوا إِلَى ٱلْعُلِّيَّةِ ٱلَّتِي كَانُوا يُقِيمُونَ فِيهَا: بُطْرُسُ وَيَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا وَأَنْدَرَاوُسُ وَفِيلُبُّسُ وَتُومَا وَبَرْثُولَمَاوُسُ وَمَتَّى وَيَعْقُوبُ بْنُ حَلْفَى وَسِمْعَانُ ٱلْغَيُورُ وَيَهُوذَا بْنُ يَعْقُوب».
ص ٩: ٣٧ و٣٩ و٢٠: ٨ متّى ١٠: ٢ الخ ولوقا ٦: ١٤ الخ يهوذا ١
ٱلْعُلِّيَّةِ يحتمل أنها هي العليّة التي أكلوا فيها الفصح الأخير والعشاء الرباني وذُكرت في (مرقس ١٤: ١٥). ونستنتج مما قيل في (لوقا ٢٤: ٥٣) أن الرسل كانوا يصرفون معظم النهار في الهيكل ثم يسهرون جميعاً في العلية.
يُقِيمُونَ فِيهَا وقتياً وهم يتوقعون حلول الروح القدس.
بُطْرُسُ وَيَعْقُوبُ الخ هذه قائمة الرسل الرابعة في العهد الجديد وتختلف عن القوائم الثلاث التي سبقتها بأنه لم يُذكر اسم يهوذا الاسخريوطي فيها وتقديم بعض الأسماء على بعض فإن أندراوس ذُكر في بشارة لوقا ثانياً وذُكر توما في تلك البشارة ثامناً وذُكر هنا سادساً.
فهؤلاء القليلو العدد الفقراء المحتقرون كانوا بلا مساعدة بشرية آلة الله لرد العالم إلى الخضوع له تعالى بالإيمان بيسوع المسيح مصلوباً.
١٤ «هٰؤُلاَءِ كُلُّهُمْ كَانُوا يُواظِبُونَ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ عَلَى ٱلصَّلاَةِ وَٱلطِّلْبَةِ، مَعَ ٱلنِّسَاءِ، وَمَرْيَمَ أُمِّ يَسُوعَ، وَمَعَ إِخْوَتِهِ».
ص ٢: ١ و٤٦ لوقا ٨: ٢ و٣ و٢٣: ٤٩ و٥٥ و٢٤: ١٠ متّى ١٣: ٥٥ ويوحنا ٧: ٣ و٥
كان الرسل موعودين بإرسال الروح القدس ومع ذلك لم يفتأوا يطلبونه. وكان من جملة الدواعي أيضاً للصلاة مفارقة معلمهم إياهم وما كان عليهم من العمل العظيم الذي وكله الرب إليهم وكثرة أعدائهم.
بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ أي كأنهم شخص واحد وعلة ذلك اشتراكهم في حزن واحد ومحبة واحدة لسيدهم ورجاء واحد.
ٱلنِّسَاءِ منهنّ اللواتي تبعن يسوع من الجليل (متّى ٢٧: ٥٥ ولوقا ٨: ٢ و٣ و٢٣: ٤٩ و٥٥ و٢٤: ١٠) واللواتي نعرف أسماءهنّ منهنّ مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وسالومي امرأة زبدي ويونا امرأة خوزي وسوسنة وبعض هؤلاء من أنسباء يسوع ولعل البعض زوجات بعض الرسل (١كورنثوس ٩: ٥).
وَمَرْيَمَ أُمِّ يَسُوعَ كان يسوع قد وكل يوحنا بها وكانت عنده في منزله منذ الصلب.
مَعَ إِخْوَتِهِ انظر شرح (متّى ١٢: ٤٦) وكانوا في أول أمرهم غير مؤمنين بيسوع (يوحنا ٧: ٥) والظاهر أنهم اقتنعوا بقيامته وآمنوا به.
انتخابهم رسولاً بدلاً من الاسخريوطي ع ١٥ إلى ٢٦
١٥ «وَفِي تِلْكَ ٱلأَيَّامِ قَامَ بُطْرُسُ فِي وَسَطِ ٱلتَّلاَمِيذِ، وَكَانَ عِدَّةُ أَسْمَاءٍ مَعاً نَحْوَ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ. فَقَالَ».
رؤيا ٣: ٤
فِي تِلْكَ ٱلأَيَّامِ أي التي بين صعود المسيح ويوم الخسمين وهي عشرة.
قَامَ بُطْرُسُ أي شرع في الخطاب وهذا من مصطلحات الكتاب (لوقا ١٥: ١٨). وكان من سجية بطرس المعلومة أن يكون المبتدئ في الرأي والعمل انظر شرح (متّى ١٦: ١٦ و١٨) والأرجح أنه كان أكبرهم سناً فلاق به أن يكون المتقدم في ما ذُكر.
ِٱلتَّلاَمِيذ المؤمنين من الرسل وغيرهم وسُموا بذلك لأنهم تعلموا في مدرسة يسوع.
أَسْمَاءٍ أي أشخاص كما في (ص ٤: ١٢ و١٨: ١٥ وأفسس ١: ٢١ ورؤيا ٣: ٤).
نَحْوَ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ لا يلزم من ذلك أنه لم يكن في أورشليم غيرهم من المؤمنين بل أن الذين اجتمعوا حينئذ كانوا كذلك ولعله كان بينهم بعض السبعين المذكورين في (لوقا ١٠: ١) ونيقوديموس ويوسف الرامي وبعض المئة الذين شاهدوه في الجليل بعد قيامته.
١٦ «أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلإِخْوَةُ، كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتِمَّ هٰذَا ٱلْمَكْتُوبُ ٱلَّذِي سَبَقَ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ فَقَالَهُ بِفَمِ دَاوُدَ، عَنْ يَهُوذَا ٱلَّذِي صَارَ دَلِيلاً لِلَّذِينَ قَبَضُوا عَلَى يَسُوعَ».
مزمور ٤١: ٩ ويوحنا ١٣: ١٨ لوقا ٢٢: ٤٧ ويوحنا ١٨: ٣
أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلإِخْوَةُ كلام معتاد في افتتاح الخطاب للإكرام والتودد والتنبيه (ص ١٣: ٢٦).
يَنْبَغِي أَنْ يَتِمَّ أي لا بد من أن يتم لأنه أنباء الروح القدس ولم ينبئ به الروح إلا لأن حدوثه لا ريب فيه فالنبوءة ليست بعلته.
هٰذَا ٱلْمَكْتُوبُ أي الجزء مما كُتب في أسفار الله وهذا ما ذُكر في (ع ٢٠ نقلاً عن مزمور ٦٩: ٢٥) وهو أن داره تصير خراباً ووظيفته يأخذها آخر. وفسره بعضهم بما ذُكر في (مزمور ٤١: ٩).
سَبَقَ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ فَقَالَهُ بِفَمِ دَاوُدَ هذا بينة جلية على أن داود كان موحى إليه وهو يوافق شهادة العهد الجديد كله بأن كتبة العهد القديم كانوا «مسوقين من الروح القدس» (٢بطرس ١: ٢١).
عَنْ يَهُوذَا أي الاسخريوطي وما كُتب عنه هو «أن تكون داره خراباً» الخ ( ع ٢٠).
ٱلَّذِي صَارَ دَلِيلاً الخ (متّى ٢٦: ٤٧ ويوحنا ١٨: ٢ و٣).
١٧ «إِذْ كَانَ مَعْدُوداً بَيْنَنَا وَصَارَ لَهُ نَصِيبٌ فِي هٰذِهِ ٱلْخِدْمَةِ».
متّى ١٠: ٤ ولوقا ٦: ١٦ ع ٢٥ وص ١٢: ٢٥ و٢٠: ٢٤ و٢١: ١٩
مَعْدُوداً بَيْنَنَا أي أحد الرسل الاثني عشر (لوقا ٦: ١٣ - ١٦). وهذا لا يلزم أنه كان في أول أمره مؤمناً حقيقياً لأن يسوع شهد قبل أن سلمه يهوذا الاسخريوطي بمدة طويلة أنه شيطان (يوحنا ٦: ٧٠ و٧١). وسبق الكلام على فوائد الكنيسة من اختيار المسيح يهوذا المذكور رسولاً في شرح (متّى ٢٦: ١٦).
وَصَارَ لَهُ نَصِيبٌ الخ في الوظيفة الرسولية أي انه كان له كل الوسائل إلى معرفة الحق كسائر الرسل وكل الحقوق التي كانت لهم ولكنه أضاعها باختياره وحرم نفسه إيّاها. واضطر بطرس إلى ما ذُكر هنا بياناً لصحة النبوءة إذ لا يمكن إثبات ترك وظيفة ومقام ما لم يُثبت أنهما كانا للتارك.
١٨ «فَإِنَّ هٰذَا ٱقْتَنَى حَقْلاً مِنْ أُجْرَةِ ٱلظُّلْمِ، وَإِذْ سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ ٱنْشَقَّ مِنَ ٱلْوَسَطِ، فَٱنْسَكَبَتْ أَحْشَاؤُهُ كُلُّهَا».
متّى ٢٦: ١٥ و٢٧: ٥ و٧ و٨ و٢بطرس ٢: ١٥
الأرجح أن هذه الآية والتي تليها ليستا من خطاب بطرس بل هما من تفسير لوقا إذ لا حاجة لبطرس إلى أن يخبر التلاميذ الذين يخاطبهم بما حدث ليهوذا منذ أقل من أربعين يوماً ولا داعي لأن يفسر لهم معنى «حقل دماً» وهو من كلمات لغتهم المعلومة ولكن لوقا كتب إلى أناس في غير اليهودية بعد نحو ثلاثين سنة من حدوث تلك الأمور. ويقوي ذلك قوله «صار ذلك معلوماً عند جميع سكان أورشليم» فلو كان ذلك كلام بطرس لقال صار معلوماً عندكم.
هٰذَا ٱقْتَنَى حَقْلاً نعلم من بشارة لوقا أن الكهنة اشتروا هذا الحقل من الفضة التي ألقاها يهوذا في الهيكل (متّى ٢٧: ٦ - ١٠). ولكن يصح أن يُقال أن يهوذا اقتنى هذا الحقل لأنه كان علة اقتنائه وقد أُشتري بماله. ويحتمل أنه نُسب إليه أيضاً فقيل حقل يهوذا. وهو مجاز شائع في كل اللغات المشهورة ومثله ما جاء في (متّى ٢٧: ٦٠) من أن يوسف نحت قبره في الصخرة والمعنى أنه كان على ذلك وما جاء في (ص ٧: ٢١ و١٦: ٢٢ ومتّى ٢: ١٦ و١كورنثوس ٧: ١٦ و١تيموثاوس ٤: ١٦).
مِنْ أُجْرَةِ ٱلظُّلْمِ أي من الفضة التي أخذها من اليهود أجرة على تسليم يسوع وهو عمل في غاية الفظاعة.
وَإِذْ سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ ٱنْشَقَّ الخ انظر شرح (متّى ٢٧: ٥). أن يهوذا الاسخريوطي لشدة انتباهه لإثمه وفرط يأسه اختار الانتحار على الحياة مع توبيخ ضميره. والمظنون أنه خنق نفسه بحبل شده بشجرة على شاهق انقطع الحبل فسقط وكان ما ذُكر هنا. ولا خلاف بين ما ذكره متّى وما ذكره لوقا في هذا الأمر لأن متّى لم يذكر شيئاً مما حدث ليهوذا بعد أن خنق نفسه ولوقا لم يخبر شيئاً بما جرى عليه قبل أن يسقط.
١٩ «وَصَارَ ذٰلِكَ مَعْلُوماً عِنْدَ جَمِيعِ سُكَّانِ أُورُشَلِيمَ، حَتَّى دُعِيَ ذٰلِكَ ٱلْحَقْلُ فِي لُغَتِهِمْ «حَقْلَ دَمَا» (أَيْ: حَقْلَ دَمٍ)» .
وَصَارَ ذٰلِكَ مَعْلُوماً أي كل ما كان من أمر شراء الحقل وميتة يهوذا الهائلة. ونعلم من بشارة متى أن ذلك الحقل كان قبل ذلك حقل الفخاري وصار مقبرة للغرباء.
حَتَّى دُعِيَ الخ ذكر لوقا علة أخرى غير التي ذكرها متى لتسمية الحقل «بحقل الدم» فإن متّى ذكر أن العلة كون الثمن ثمن دم يسوع وذكر لوقا أنها موت صاحبه يهوذا شر ميتة دموية. ومعنى قوله «لغتهم» اللغة السريانية أو الآرامية التي كانت شائعة يومئذ في اليهودية. وهذا من الأدلة على أن هذه الآية من كلام لوقا لا كلام بطرس.
٢٠ «لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي سِفْرِ ٱلْمَزَامِيرِ: لِتَصِرْ دَارُهُ خَرَاباً وَلاَ يَكُنْ فِيهَا سَاكِنٌ، وَلْيَأْخُذْ وَظِيفَتَهُ آخَرُ».
مزمور ٦٩: ٢٥ مزمور ١٠٩: ٨
الكلام في هذه الآية هو ما أُشير إليه في ع ١٦ يقول بطرس «ينبغي أن يتم».
لِتَصِرْ دَارُهُ خَرَاباً... سَاكِنٌ (مزمور ٦٩: ٢٥) اقتبس بطرس هذه الآية من الترجمة السبعينية بقليل من الاختصار وبدل الجمع بالمفرد. وتكلم داود فيها على ما يصيب كل أعداء المسيح وحملها بطرس على يهوذا لأنه كان من أولئك الأعداء. والآية التاسعة من هذا المزمور قيلت على يسوع في (يوحنا ٢: ١٧ والآية ٢١) منه حملت عليه أيضاً في (متّى ٢٧: ٣٤).
وَلْيَأْخُذْ وَظِيفَتَهُ آخَرُ (مزمور ١٠٩: ٨) وهذا مقتبس من ترجمة السبعين بحروفه وهذا المزمور وأمثاله كالمزمور السادس والمزمور الثاني والعشرين و٢٨ و٤٣ وصف بها داود حزنه وآلامه من اضطهادات شاول إياه وخيانة أبيشالوم له وصح حملها على يسوع لأن داود كان رمزاً إلى المسيح فإن يسوع احتمل مثلما احتمل داود فالذي وجب على مضطهدي داود وجب على مضطهدي يسوع. رأى داود أن عدوه لا يستحق الوظيفة التي كانت له ووجوب أن تؤخذ منه وتُعطى لغيره. وما صح على هذا العدو صح على يهوذا عدو المسيح.
٢١، ٢٢ «فَيَنْبَغِي أَنَّ ٱلرِّجَالَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَمَعُوا مَعَنَا كُلَّ ٱلزَّمَانِ ٱلَّذِي فِيهِ دَخَلَ إِلَيْنَا ٱلرَّبُّ يَسُوعُ وَخَرَجَ، مُنْذُ مَعْمُودِيَّةِ يُوحَنَّا إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ فِيهِ عَنَّا، يَصِيرُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ شَاهِداً مَعَنَا بِقِيَامَتِهِ».
مرقس ١: ١ ع ٩ يوحنا ١٥: ٢٧ وع ٨ وص ٤: ٣٣
فَيَنْبَغِي أي بناء على النبوءتين المتعلقة إحداهما بترك الوظيفة والأخرى بوجوب أن يأخذها آخر.
ٱلرِّجَالَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَمَعُوا مَعَنَا وشاهدوا معجزات المسيح وسيرته الصالحة وسمعوا أقواله فهؤلاء أهل لأن يأخذوا الوظيفة التي تركها يهوذا ولعله أشار بذلك إلى بعض السبعين تلميذاً المذكورين في (لوقا ١٠: ١ و٢).
دَخَلَ إِلَيْنَا... وَخَرَجَ هذا كلام اصطلاحي يدل على اتصال المخالطة (تثنية ٢٨: ١٩ و٣١: ٢ و١صموئيل ٢٩: ٦ ومزمور ١٢١: ٨).
مُنْذُ مَعْمُودِيَّةِ يُوحَنَّا أي من حين عمد يوحنا المعمدان يسوع (متّى ٤: ١٢ و١٧ ومرقس ١: ١٤) وذلك ابتداء خدمة يسوع العلنية وحينئذ جمع تلاميذ وانتخب رسلاً على غير ذلك من أعماله المعلومة.
إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ فِيهِ أي نحو ثلاث سنين ونصف سنة.
يَصِيرُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ شَاهِداً مَعَنَا بِقِيَامَتِهِ أي رسولاً لأن الرسل عُينوا شهوداً بقيامة المسيح فإن تلك القيامة من أركان دين المسيح وأول ما يثبت صحة دعواه. هكذا أظهر الرسل بتبشيرهم (ص ٢: ٢٣ و٣: ١٥ و٤: ٣٣ و٥: ٣٢ و١٠: ٤٠ وبكتابتهم رومية ١: ٤ و٤: ٢٤ و١٠: ٩ وغلاطية ١: ١ و١بطرس ١: ٣). ومن شروط أهلية الشاهد للشهادة بقيامة المسيح أن يكون قد عرفه معرفة كاملة قبل موته ثم يراه بعد قيامته ويتحقق أنه هو هو. أشاع اليهود أن تلاميذ يسوع سرقوا جسده من القبر (متّى ٢٨: ١٣) فمن لم يشاهد سوى معجزاته وصلبه لم يكن لشهادته بالقيامة تأثير. ولما أراد بولس إثبات أهليته لهذه الشهادة قال «ألست أنا رسولاً... أما رأيت يسوع المسيح رباً».
٢٣ «فَأَقَامُوا ٱثْنَيْنِ: يُوسُفَ ٱلَّذِي يُدْعَى بَارْسَابَا ٱلْمُلَقَّبَ يُوسْتُسَ، وَمَتِّيَاسَ».
ص ١٥: ٢٢
فَأَقَامُوا ٱثْنَيْنِ الأرجح أنهما كانا أفضل من الباقين في الحكمة والتقوى والأهلية للوظيفة وأنهما كانا متساويين في الفضل حتى لم يستطيعوا إيثار أحدهما على الآخر.
ٱلَّذِي يُدْعَى بَارْسَابَا أي ابن القَسَم أو ابن الراحة وابن السبي.
ٱلْمُلَقَّبَ يُوسْتُسَ أي العادل ولعله لقب به لاستقامة سيرته. واعتاد اليهود أن يسموا الإنسان بعدة أسماء كما رأينا في قائمة الرسل (متّى ١٠: ٢ - ٤).
وَمَتِّيَاسَ أي عطية الرب ولا نعلم من أمره سوى ما ذُكر هنا.
٢٤ «وَصَلَّوْا قَائِلِينَ: أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلْعَارِفُ قُلُوبَ ٱلْجَمِيعِ، عَيِّنْ أَنْتَ مِنْ هٰذَيْنِ ٱلٱثْنَيْنِ أَيّاً ٱخْتَرْتَهُ».
١صموئيل ١٦: ٧ و١أيام ٢٨: ٩ و٢٩: ١٧ وإرميا ١١: ٢٠ و١٧: ١٠ وص ١٥: ٨ ورؤيا ٢: ٢٣
وَصَلَّوْا لجأوا إلى الصلاة لأهمية الأمر في انتخاب رسول فيجب علينا أن نقتدي بالرسل في انتخابنا معلماً دينياً أو راعي كنيسة بأن نطلب الإرشاد من الرب. ولجأوا إليها أيضاً لعجزهم عن التمييز بين ذينك الاثنين والظاهر أن أحدهم ناب عن الباقين بتقديم الطلبات وهم شاركوه في الباطن.
ٱلْعَارِفُ قُلُوبَ ٱلْجَمِيعِ معرفة القلب من الأمور المختصة بالله (١أيام ٢٨: ٩ ومزمور ١٣٩: ١ و٢٣ وإرميا ١٧: ١٠). ويدل على أنهم وجهوا هذه الصلاة إلى المسيح خمسة أمور:
- الأول: أنّ المسيح يُسمى في العهد الجديد غالباً بالرب (أعمال ٢: ٣٦ و٧: ٥٩ و٦٠ و١٠: ٣٦ و١كورنثوس ٢: ٨ وفيلبي ٢: ١١ ورؤيا ١١: ٨).
- الثاني: أنّ الإنجيل نسب إلى المسيح معرفة القلوب (يوحنا ٢: ٢٥ و٦: ٦٤ و١٦: ١٩ و٢١: ١٧ ورؤيا ٢: ١٨ و٢٣).
- الثالث: قول لوقا في بشارته ٢٤: ٥ أن التلاميذ سجدوا ليسوع والسجود يستلزم الصلاة.
- الرابع: أن التلاميذ اعتادوا أن يسجدوا ليسوع بعد قيامته كما يبين من فعل استفانوس (أعمال ٧: ٥٩).
- الخامس: أن موضوع الصلاة كان مما يختص بالمسيح لأنه هو الذي انتخبهم حسب قوله في (يوحنا ٦: ٧٠) وعيّن عددهم وعلمهم وكان ذانك الشخصان من خلطائه التلاميذ فقد عرفهما بالاختبار.
أَيّاً ٱخْتَرْتَهُ ليكون رسولاً.
٢٥ «لِيَأْخُذَ قُرْعَةَ هٰذِهِ ٱلْخِدْمَةِ وَٱلرِّسَالَةِ ٱلَّتِي تَعَدَّاهَا يَهُوذَا لِيَذْهَبَ إِلَى مَكَانِهِ».
ع ١٧
قُرْعَةَ أي نصيب أو وظيفة.
هٰذِهِ ٱلْخِدْمَةِ أي الرسولية.
وَٱلرِّسَالَةِ زادها لوقا على الخدمة تفسيراً لها أي بياناً لنوع الخدمة وهو الرسولية.
ٱلَّتِي تَعَدَّاهَا يَهُوذَا أي أظهر أنه ليس بأهل لها إذ لم يقم بمقتضاها.
لِيَذْهَبَ إِلَى مَكَانِهِ الضمير في مكانه راجع إلى يهوذا ولا ريب في أن المقصود بمكانه محل عقاب الخطأة ونُسب إليه لأنه أوجبه على نفسه لتسليمه سيده ولقتله نفسه. وسقط يهوذا من مكانه الرسولي لأنه لم يستحق ذلك الذي يختص بالأتقياء وهو إنسان خائن طمع محب للمال فلم يبق له مكان إلا مكان أمثاله الهالكين والأبالسة. وأشار المسيح إلى ذلك بقوله «وَيْلٌ لِذٰلِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي بِهِ يُسَلَّمُ ٱبْنُ ٱلإِنْسَانِ. كَانَ خَيْراً لِذٰلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَمْ يُولَدْ» (متّى ٢٦: ٢٤). وقال ذلك في العشاء الأخير على مسمع من كل الرسل ولا ريب في أن ذلك أثر فيهم حتى لم ينسوه وتحققوا أنه قصد بذلك الرجل يهوذا الإسخريوطي حين سلم المسيح إلى قاتليه وانتحر. وكل إنسان يهيء مكاناً له في الأبدية بتصرفه هنا. فالذي سيرته على الأرض سماوية يذهب إلى السماء والذي سيرته دنيوية نصيبه مع أهل الدنيا (مزمور ٩: ١٧ ومتّى ٥: ٣٠ و١٠: ٢٨ ولوقا ١٦: ٢٣ ورؤيا ٢٠: ١٤).
٢٦ «ثُمَّ أَلْقَوْا قُرْعَتَهُمْ، فَوَقَعَتِ ٱلْقُرْعَةُ عَلَى مَتِّيَاسَ، فَحُسِبَ مَعَ ٱلأَحَدَ عَشَرَ رَسُولاً».
ثُمَّ أَلْقَوْا قُرْعَتَهُمْ كان إلقاء القرعة شائعاً بين الإسرائيليين لتعيين ما خفي عليهم من الأمور ذات الشأن ومن أمثال ذلك تعيين تيس لعزازيل وتمييزه عن تيس الذبيحة (لاويين ١٦: ٨). وتعيين عاخان الخائن (يشوع ٧: ١٦ - ١٨). وتقسيم أرض الميعاد بين أسباط إسرائيل (عدد ٢٦: ٥٥ ويشوع ص ١٥ إلى ص ١٧). وانتخاب شاول ملكاً (١صموئيل ١٠: ٢٠ و٢١). وتعيين نوبة الكهنة في خدمة الهيكل (١أيام ٢٤: ٥). وأمر داود بتعيين النوبة بالقرعة وبقي الناس يجرون في ذلك إلى أيام المسيح (لوقا ١: ٩). قيل في سفر الأمثال «ٱلْقُرْعَةُ تُلْقَى فِي ٱلْحِضْنِ، وَمِنَ ٱلرَّبِّ كُلُّ حُكْمِهَا» (أمثال ١٦: ٣٣).
اعتبر اليهود القرعة كرفع الأمر إلى الله تعالى في المهمات حين كان يعسر عليهم الحكم فيها وليس من دليل على أن التلاميذ استعملوا القرعة في أيام العهد الجديد غير ما ذُكر هنا. فإنه مدة ما كان المسيح معهم لم يستعملوها وبعد حلول الروح القدس عليهم في يوم الخمسين ولم يبقوا في حاجة إليها. وطرق إلقاء القرعة كثيرة فلا نعلم أي طريق القوا فيها قرعتهم ولعلهم كتبوا الاسمين على قطعتين من رق أو ورق البردي أو خشبتين ووضعوهما في إناء وهزوا الإناء إلى أن ارتفع إحداها إلى الأرض فالاسم الذي فيها هو اسم من وقعت القرعة عليه.
فَوَقَعَتِ ٱلْقُرْعَةُ عَلَى مَتِّيَاسَ أي ثبت بتلك القرعة أن متياس هو المنتخب رسولاً.
حُسِبَ مَعَ ٱلأَحَدَ عَشَرَ رَسُولاً أي حُسب من ذلك الوقت فصاعداً الثاني عشر من الرسل مساوياً لكل منهم. ولم يُذكر بعد ذلك في موضع من العهد الجديد فلا نعلم أين بشر ولا أين مات.
وتعيين المسيح بولس بعد ذلك رسولاً لم يبطل انتخاب متياس أو يلزم منه أن تعيينه كان فضولياً لأن بولس عُيّن رسولاً مخصوصاً زيادة على الرسل الأولين وأُهِّل لذلك بمشاهدته المسيح عياناً (١كورنثوس ١٥: ٨ و٩: ١ وأعمال ٢٢: ٨ و٩ و١٤ و١٥ و٢٦: ١٧ و١٨).
ولنا في انتخاب متياس ثلاثة أمور:
- الأول: أنه انتُخب لمجرد أخذ موضع يهوذا إتماماً لعدد الرسل أي ليكونوا اثني عشر شاهدعينٍ بقيامة المسيح.
- الثاني: أنه لا دليل في ذلك على أن للرسل خلفاء بل هو دليل على أن وظيفتهم خاصة وقتية انتهت بموتهم.
- الثالث: أنه من المحال أن يُقام لهم خلفاء بعد نهاية جيلهم لاستحالة أن يقدموا الشهادة التي يعينون لها أي الشهادة المبنية على معاينتهم ما يشهدون به. نعم أن وظيفة المبشرين والرعاة والمعلمين تدوم ما دامت الكنيسة على الأرض ولكن وظيفة الرسل ليست كذلك لأنها انحصرت فيهم.
الأصحاح الثاني
حلول الروح القدس ع ١ إلى ١٣
١ «وَلَمَّا حَضَرَ يَوْمُ ٱلْخَمْسِينَ كَانَ ٱلْجَمِيعُ مَعاً بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ».
خروج ٢٣: ١٧ ولاويين ٢٣: ١٥ وتثنية ١٦: ٩ و١٠ و١٦ وص ٢٠: ١٦ ص ١: ١٤
يَوْمُ ٱلْخَمْسِينَ أحد أعياد اليهود الثلاثة العظمى التي يجب أن يحضر فيها كل الذكور في أورشليم (خروج ٢٣: ١٦). وسُمّي «يوم الخمسين» لأنه كان حسب أمر موسى بعد سبعة أيام من ثاني الفصح (لاويين ٢٣: ١١ - ١٦ وتثنية ١٦: ٩) وسُمّي أيضاً عيد الجمع وعيد الحصاد لأنه كان في أيام حصاد الحنطة يقدم فيه كل إنسان رغيفين من باكورة حصاده مع تقدمات أُخر معينة (لاويين ٢٣: ١٣ وعدد ٢٨: ٢٦) وكان العيد يوماً واحداً.
واعتبر اليهود أن ذلك اليوم هو اليوم الذي أنزل الله فيه الشريعة وهذا لم يُذكر في التوراة. ولا ريب في أن الله اختار ذلك اليوم لإرسال الروح القدس ليشاهد الذين كانوا يجتمعون فيه في أورشليم من جمع اليهود الكثيرة في كل قطر (ع ٩ - ١١) الغرائب التي تعلقت بحلول الروح القدس في ذلك اليوم ويسمعوا وعظ الرسل وتبشيرهم بقيامة المسيح بعد صلبه وموته لنفع نفوسهم ولكي يوزعوا البشرى في كل البلاد التي يرجعون إليها. وذلك اليوم كان يوم ميلاد الكنيسة المسيحية أي جماعة المؤمنين بالمسيح. وفيه كانت الحادثة العظمى الثانية في تاريخ العالم وهي مجيء الأقنوم الثالث ليمكث هنا ويخولنا فوائد عمل الفداء وكانت الأولى مجيء الأقنوم الثاني لعمل الفداء.
ٱلْجَمِيعُ أي كل المؤمنين في أورشليم وهم يشتملون على المئة والعشرين المذكورين آنفاً (ص ١: ١٥) والرسل.
مَعاً الأرجح أن ذلك كان في العلية حيث اجتمعوا حين انتخبوا متياس (ص ١: ١٣) ولو أنهم اجتمعوا في الهيكل لذكر الكاتب ذلك. وكان اجتماعهم في الصباح باكراً (ع ١٥). وذهب كثيرون أن ذلك اليوم كان يوم الأحد بدليل قوله «تَحْسُبُونَ لَكُمْ مِنْ غَدِ ٱلسَّبْتِ مِنْ يَوْمِ إِتْيَانِكُمْ بِحُزْمَةِ ٱلتَّرْدِيدِ سَبْعَةَ أَسَابِيعَ تَكُونُ كَامِلَةً» (لاويين ٢٣: ١٥) لكن ذهب بعض المفسرين أن معنى السبت عيد الفصح لا يوم السبت الواقع في أيام الفطير.
بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ كما ذُكر في (ص ١: ١٤) والمعنى أنهم كانوا متحدين في الشوق إلى حلول الروح القدس وفي رجاء ذلك والصلاة لأجل إتيانه وذلك الاتحاد شرط دائم على المسيحيين ليحل فيهم الروح القدس.
٢ «وَصَارَ بَغْتَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ صَوْتٌ كَمَا مِنْ هُبُوبِ رِيحٍ عَاصِفَةٍ وَمَلأَ كُلَّ ٱلْبَيْتِ حَيْثُ كَانُوا جَالِسِين».
ص ٤: ٣١
بَغْتَةً أي بدون توقع لأن المسيح لم يعيّن لهم اليوم ولا الساعة ولا كيفية الحلول بل أمرهم أن يتوقعوا حلول الروح دائماً.
مِنَ ٱلسَّمَاءِ أي الجو فوق الرأس خلافاً للعادة لأن صوت الريح يأتي من جهة هبوبها أي جهة الأفق.
صَوْتٌ كَمَا مِنْ هُبُوبِ رِيحٍ عَاصِفَةٍ لم يقل أنه صوت الريح بل كالصوت المنبعث عن الريح وهذا هو الأمر الغريب إذ لم يكن من ريح ولا مطر ولا رعد ولا زلزلة. كذلك أظهر الله حلوله في طور سينا (خروج ١٩: ١٩) بدليل قوله «فَكَانَ صَوْتُ ٱلْبُوقِ يَزْدَادُ ٱشْتِدَاداً جِدّاً، وَمُوسَى يَتَكَلَّمُ وَٱللّٰهُ يُجِيبُهُ بِصَوْتٍ» (انظر أيضاً عبرانيين ١٢: ١٩). وأُشير إلى فعل الروح بهبوب الريح في (يوحنا ٣: ٨) ووجه الشبه أن الريح شديدة الفعل مع أنها غير منظورة. وأشار المسيح إلى منح الروح القدس بالنفخ (يوحنا ٢٠: ٢٢). والمقصود بذلك الصوت التنبيه وبيان قوة الروح القدس العجيبة.
وَمَلأَ كُلَّ ٱلْبَيْتِ أتى الصوت من السماء واتخذ البيت مستقراً ليهتدي إليه السامعون.
٣ «وَظَهَرَتْ لَهُمْ أَلْسِنَةٌ مُنْقَسِمَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نَارٍ وَٱسْتَقَرَّتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ».
أَلْسِنَةٌ مُنْقَسِمَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نَارٍ هذه المعجزة الثانية مما دل على حلول الروح القدس وهي ليست ناراً حقيقية بل شبه النار على هيئة الألسنة كعادة اللهب وقد كثر هذا التشبيه في الكتاب المقدس «كلسان ذهب» (يشوع ٧: ٢١) «ولسان البحر» (يشوع ١٥: ٥ و١٨: ١٩) ومعنى قوله «منقسمة» أنها متفرقة كل منها مستقل لا منتشرة باتصال عن لهب واحد أو أن كل لسان منها منقسم أي ذو شعبتين. وكون علامة ظهور الروح القدس ناراً موافق لما قيل في المسيح أنه «يعمدنا بالروح القدس وبالنار» والنار رمز إلى التطهير والهدى والغيرة والقوة. وكثيراً ما أعلن الله ظهوره بالنار كما في أمر العليقة الملتهبة (خروج ٣: ٢ و٣) وكما ترآى في طور سينا (خروج ١٩: ١٦ - ٢٠ انظر أيضاً خروج ١٥: ١٧ وتثنية ٤: ٢٤ ومزمور ١٨: ١٢ - ١٤ وحزقيال ١: ٤ وعبرانيين ١٢: ٢٩).
وَٱسْتَقَرَّتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أي على رؤوسهم كما يرجح. ونستنتج من قوله أولاً «ظهرت» وقوله ثانياً «استقرت» أنها كانت دائرة في فضاء المكان ثم هبطت على كل منهم. ولم يعيّن الكاتب هل كان ذلك للرسل دون غيرهم أو كان لكل المؤمنين إنما بيّن أن الذين استقرت عليهم الألسنة النارية هم الذين حل عليهم الروح.
٤ «وَٱمْتَلأَ ٱلْجَمِيعُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ، وَٱبْتَدَأُوا يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ أُخْرَى كَمَا أَعْطَاهُمُ ٱلرُّوحُ أَنْ يَنْطِقُوا».
ص ١: ٥ مرقس ١٦: ١٧ وص ١٠: ٤٦ و١٩: ٦ و١كورنثوس ١٢: ١٠ و٢٨ و٣٠ و١٣: ١ و١٤: ٢ الخ
وَٱمْتَلأَ ٱلْجَمِيعُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ أي من تأثيراته الداخلية وهذا إنجاز لوعد المسيح في قوله «لٰكِنَّكُمْ سَتَنَالُونَ قُوَّةً مَتَى حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ» (ص ١: ٨). وكان الرسل قد حصلوا على شيء من تأثير الروح القدس لكنهم لم يمتلئوا منه إلا حينئذ.
وَٱبْتَدَأُوا يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ أُخْرَى هذه المعجزة الثالثة للدلالة على حلول الروح القدس عليهم وكانت المعجزات الثلاث برهاناً للرسل على إنجاز المسيح وعده لهم بإرسال الروح وبياناً لأهمية تلك الهبة وكانت تنبيهاً لغيرهم وآية لإقناعهم بصحة تعاليم الرسل. وقصد بقوله «ألسنة أخرى» لغات غير لغتهم وكانت لغتهم الآرامية أي السريانية الكلدانية فإنهم أخذوا يتكلمون بلغات لم يتعلموها وبعض هذه اللغات ذُكر في (ع ٩ - ١١) وكانت تلك المعجزة بألسنة المتكلمين لا في آذان السامعين كما يظهر من (ص ١٠: ١٤ و١٩: ٦ و١كورنثوس ١٢: ١٠).
وفي هذه المعجزة خمس ملاحظات:
- الأولى: أنها معجزة عظيمة جداً لأن أولئك الرسل كانوا أميين لا فرصة لهم لأن يتعلموا اللغات الغريبة ولم يكن لهم ما يدعوهم إلى ذلك قبل حلول الروح وفي لحظة صاروا يعرفون مفردات تلك اللغات الكثيرة ومركّباتها وألفاظها المختلفة والتمكن من أحكام التلفظ بها حتى كأنهم من أهلها.
- الثانية: أنها كانت إنجازاً لمواعيد العهد القديم إذ قيل «إِنَّهُ بِشَفَةٍ لَكْنَاءَ وَبِلِسَانٍ آخَرَ يُكَلِّمُ هٰذَا ٱلشَّعْبَ» (إشعياء ٢٨: ١١). ونعلم أن النبي أشار إلى ذلك من قول بولس الرسول في (١كورنثوس ١٤: ٢١).
- الثالثة: أنها إنجاز لما أنبأ به يسوع بقوله «إنهم يتكلمون بألسنة أخرى» (مرقس ١٦: ١٧).
- الرابعة: أنه لا يلزم مما ذُكر هنا أن كل رسول كان يحسن التكلم بكل من اللغات المذكورة بعد ذلك بل أن بعضهم تكلم ببعض اللغات وبعضهم بلغة أو بلغات أخرى.
- الخامسة: أن الغاية من إعطاء هذه الآية للرسل كالغاية من إعطاء سائر المعجزات وهي البرهان على صدق الإنجيل وكون الرسل هم رسل الله. وتلك المعجزات كانت ضرورية في بداءة التبشير بالإنجيل. وليس من دليل على أن الرسل استعملوا تلك اللغات في تبشيرهم وتعليمهم إلا على سبيل المعجزة ليقنعوا الشعب بصحة تعاليمهم والبرهان على ذلك قول الرسل «مَنْ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانٍ يَبْنِي نَفْسَهُ، وَأَمَّا مَنْ يَتَنَبَّأُ فَيَبْنِي ٱلْكَنِيسَةَ» (١كورنثوس ١٤: ٤). وقوله أيضاً «إِذاً ٱلأَلْسِنَةُ آيَةٌ لاَ لِلْمُؤْمِنِينَ، بَلْ لِغَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ» (١كورنثوس ١٤: ٢٢) وقوله «لٰكِنْ فِي كَنِيسَةٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَكَلَّمَ خَمْسَ كَلِمَاتٍ بِذِهْنِي لِكَيْ أُعَلِّمَ آخَرِينَ أَيْضاً، أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ كَلِمَةٍ بِلِسَانٍ» (١كورنثوس ١٤: ١٩). وكان بولس يحسن التكلم بلغات مختلفة أكثر من غيره ومع ذلك لم يفهم لغة أهل ليكأونيّة (ص ١٤: ١١) ولم يحتج في كل البلاد التي بشر فيها إلا إلى التكلم باللغة اليونانية كما احتاج إليها في كتابته رسائله. ومع ذلك ظن بعض الناس أن الرسل تكلموا في جولانهم في البلدان بألسنة أهل البلاد الخاصة بالقوة التي حصلوا عليها يوم حلول الروح القدس ونسبوا النجاح العظيم الذي كان على أيدهم إلى نوالهم تلك القوة.
٥ «وَكَانَ يَهُودٌ رِجَالٌ أَتْقِيَاءُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ سَاكِنِينَ فِي أُورُشَلِيمَ».
رِجَالٌ أَتْقِيَاءُ أي يخافون الله ويجتهدون في سبيل الديانة اليهودية على قدر معرفتهم.
مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ أي من بلاد كثيرة مختلفة انتشرت فيها الديانة اليهودية.
سَاكِنِينَ فِي أُورُشَلِيمَ لعل بعض هؤلاء أتوا من الخارج وسكنوا في أورشليم دائماً متوقعين مجيء المسيح المنتظر في ذلك الوقت ولكن أكثره أتى إلى تلك المدينة رغبة في حضور عيد الفصح وعيد الخمسين. وكان لليهود المتغربين رغبة شديدة في مثل ذلك الحضور. قيل أنه حين أتى إليها تيطس وحاصرها وقت العيد كان فيها نحو ثلاثة آلاف نفس.
٦ «فَلَمَّا صَارَ هٰذَا ٱلصَّوْتُ، ٱجْتَمَعَ ٱلْجُمْهُورُ وَتَحَيَّرُوا، لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ كَانَ يَسْمَعُهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِلُغَتِهِ».
هٰذَا ٱلصَّوْتُ الأرجح أن هذا الصوت هو الصوت الذي كان كمن هبوب ريح عاصفة ع ٢ وأنه سمعه الذين في المدينة على اختلاف أبعادهم من مصدره. وظن بعضهم أن المراد «بالصوت» هنا الخبر المنتشر في المدينة بتلك المعجزة.
ٱجْتَمَعَ ٱلْجُمْهُورُ لا يلزم من ذلك أن هذا الجمهور اجتمع في البيت بل أنه اجتمع حوله. والأرجح أن الرسل خرجوا حينئذ ليخاطبوه.
كُلَّ وَاحِدٍ كَانَ يَسْمَعُهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِلُغَتِهِ كان أولئك الناس مختلفي اللغات ومع ذلك سمع كل منهم بعض الرسل يخاطبه بلغته وتكلم الرسل إما بالدور وإما كل واحد مع جماعة من الجمهور منفردة عن غيرها.
٧ «فَبُهِتَ ٱلْجَمِيعُ وَتَعَجَّبُوا قَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَتُرَى لَيْسَ جَمِيعُ هٰؤُلاَءِ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ جَلِيلِيِّينَ؟».
ص ١: ١١
فَبُهِتَ ٱلْجَمِيعُ وَتَعَجَّبُوا قيل في العدد السابق أنهم تحيروا وكل هذه الكلمات تشير إلى عظمة تأثير العجيبة في المشاهدين.
قَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ هذا مجموع أقوال كثيرين.
أَتُرَى لَيْسَ جَمِيعُ هٰؤُلاَءِ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ جَلِيلِيِّينَ لو كان التلاميذ من بلدان مختلفة لم يكن من عجب من تكلمهم بلغات مختلفة لكنهم كانوا من بلاد واحدة. وعرفوا أنهم جليليون من هيئتهم وأثوابهم إن كان المخاطبون هم الرسل دون غيرهم. وإن كان الرسل وغيرهم من المؤمنين فاعتبروهم جليليين لاتباعهم يسوع نبي الجليل.
٨ «فَكَيْفَ نَسْمَعُ نَحْنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا لُغَتَهُ ٱلَّتِي وُلِدَ فِيهَا».
هذا الاستفهام للتعجب. والمراد باللغة التي وُلد فيها المتكلم اللغة التي ينشأ عليها منذ الطفولية لا التي يحصلها بالدرس.
٩ «فَرْتِيُّونَ وَمَادِيُّونَ وَعِيلاَمِيُّونَ، وَٱلسَّاكِنُونَ مَا بَيْنَ ٱلنَّهْرَيْنِ، وَٱلْيَهُودِيَّةَ وَكَبَّدُوكِيَّةَ وَبُنْتُسَ وَأَسِيَّا».
تكوين ١٠: ٢٢ و١٤: ١ وإشعياء ٢١: ٢ وإرميا ٢٥: ٢٥ وحزقيال ٣٢: ٢٤ ودانيال ٨: ٢ تكوين ٢٤: ١ و١بطرس ١: ١
ذكر لوقا البلاد التي أتى منها اليهود بيان عدد اللغات التي تكلم بها المخاطبون وعظمة المعجزة. ولم يذكر تلك البلاد بلا ترتيب بل ذكرها على نسق دل على معرفته البلاد والسكان إذ ذكر أولاً أولاد سام ثم أولاد يافث ثم أولاد حام وابتدأ بذكر البلاد في آسيا شرقاً ثم البلاد غرباً على ترتيب مواقعها حتى بلغ أوربا ثم أفريقية ثم رجع أخيراً إلى آسيا.
فَرْتِيُّونَ أي أهل فرتيا وهي قسم من مملكة الفرس في جوار خليج العجم سُبي كثيرون من اليهود إليها سنة ٦٠٠ قبل الميلاد وبقي كثيرون منهم هنالك.
وَمَادِيُّونَ أي أهل مادي وهي بلاد في الشمال الغربي من بلاد فارس وجنوبي بحر الخزر ولعلها نُسبت إلى ماداي بن يافث (تكوين ١٠: ٢). وكثيراً ما ذُكرت مادي في الكتاب المقدس مع فارس لاتحاد المملكتين مراراً (٢ملوك ١٧: ٦ و١٨: ١١ وأستير ١: ٣ و٤ و١٨ و١٩ وإرميا ٢٥: ٢٥ ودانيال ٥: ٢٨ و٦: ٨ و٨: ٢٠ و٩: ١).
عِيلاَمِيُّونَ ذُكروا مراراً في العهد القديم وهم سلالة عيلام بن سام (تكوين ١٠: ٢٢ و١٤: ١ وعزرا ٢: ٧ و٨: ٧ ونحميا ٧: ٢٢ و٣٤ وإشعياء ١١: ١١ و٢١: ٢ و٢٢: ٦) وكانت بلادهم في عصر دانيال ولاية من مملكة فارس (دانيال ٨: ٢) وتسمى اليوم كردستان وهي على تخم بلاد العجم الغربي وكانت قاعدتها قديماً شوشان واشتهرت بعظمتها لأن محيطها كان خمسة عشر ميلاً وبنفاسة القصر الذي بناه فيها أحشويروش.
مَا بَيْنَ ٱلنَّهْرَيْنِ أي بين دجلة والفرات وسُميت هذه البلاد أيضاً فدان آرام (أي حراثة النجد لأن معنى فدان حراثة ومعنى آرام نجد أي أرض مرتفعة) (تكوين ٢٥: ٢٠) وفي هذه الأرض أور الكلدانيين مولد إبراهيم (تكوين ١١: ٣١).
وَٱلْيَهُودِيَّةَ ذكرها هنا تكملة للأماكن التي كان السامعون منها. وكانت لهجة سكان اليهودية تمتاز عن لهجة سكان الجليل. ولا بد من أنه كان أكثر السامعين من اليهودية.
كَبَّدُوكِيَّةَ ولاية من ولايات آسيا الصغرى الشرقية كانت قاعدتها في أيام الرومانيين قيصرية حدها من الجنوب والشرق جبل طورس ومخرج الفرات وحدودها شمالاً وغرباً كانت تختلف كثيراً في أزمنة مختلفة.
وَبُنْتُسَ ولاية في شمالي آسيا الصغرى على شاطئ البحر الأسود ولذلك سُميت بنتس وهي لفظة لاتينية معناها البحر.
وَأَسِيَّا المراد بآسيا هنا الجزء الغربي من آسيا الصغرى أي بر الأناضول وكانت قاعدتها أفسس.
١٠ «وَفَرِيجِيَّةَ وَبَمْفِيلِيَّةَ وَمِصْرَ، وَنَوَاحِيَ لِيبِيَّةَ ٱلَّتِي نَحْوَ ٱلْقَيْرَوَانِ، وَٱلرُّومَانِيُّونَ ٱلْمُسْتَوْطِنُونَ يَهُودٌ وَدُخَلاَء».
ص ١٦: ٦ و١٨: ٢٣ ص ٣: ١٣ و١٤: ٢٤ و١٦: ٦ متّى ٢٧: ٣٢ وص ١١: ٢٠ و١٣: ١
فَرِيجِيَّةَ ولاية في آسيا الصغرى تحدها شمالاً بيثينية وجنوباً بيسيدية وشرقاً غلاطية وكبدوكية وغرباً ليديا وميسيا.
بَمْفِيلِيَّةَ ولاية من آسيا الصغرى على شاطئ البحر المتوسط يحدها شمالاً بيسيدية وجنوباً البحر وشرقاً جبل طورس وغرباً فريجية.
وَمِصْرَ هي البلاد المعروفة شمالي أفريقيا تُسقى أراضيها بمياه النيل. وكانت لغتها قديماً القبطية سكنها في العصور الخالية كثيرون من اليهود. وهناك تُرجمت أسفار العهد القديم أولاً إلى اليونانية في عهد بطليموس وتُعرف بترجمة السبعين.
لِيبِيَّةَ بلاد شمالي أفريقية وغبربي مصر.
ٱلْقَيْرَوَانِ مدينة في ليبية غربي اسكندرية وعلى أمد خمس مئة ميل منها وهي من مدن طرابلس الغرب اليوم وكان فيها يومئذ عدد وافر من اليهود وكان من أهلها سمعان القيرواني الذي سُخر بحمل صليب المسيح (متّى ٢٧: ٣٢ ولوقا ٢٣: ٢٦) وذُكر بعض القيروانيين بين المسيحيين الأقدمين (أعمال ١١: ٢٠ و١٣: ١).
وَٱلرُّومَانِيُّونَ ٱلْمُسْتَوْطِنُونَ أي اليهود الذين اتخذوا إيطاليا وطناً لهم وأتوا أورشليم ليحتفلوا بالعيد فتكون لغتهم اللاتينية فإن بمبيوس لما استولى على اليهودية نحو السنة الستين قبل الميلاد ألوفاً من أهلها وأخذهم إلى رومية فكانوا بمنزلة عبيد للرومانيين ثم حُرروا وبقوا هنالك ساكنين في قسم من المدينة على نهر تيبر.
يَهُودٌ أي إسرائيلون أصلاً.
وَدُخَلاَءُ هم الذين هادوا من الأمم.
١١ «كِرِيتِيُّونَ وَعَرَبٌ، نَسْمَعُهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا بِعَظَائِمِ ٱللّٰهِ؟».
ص ٢٧: ٧ و١٢ و١٣
كِرِيتِيُّونَ من جزيرة كريت وتُسمى أحياناً كندية وهي في بحر الروم طولها نحو مئتي ميل وعرضها نحو خمسين ميلاً وهي غربي سورية وعلى أمد نحو خمس مئة ميل منها وهي التي ترك فيها بولس تيطس لخدمة الإنجيل (تيطس ١: ٥).
عَرَبٌ هم سكان بلاد العرب ولغتهم العربية.
نَسْمَعُهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا لم تكن اللغات التي تكلم الرسل بها أقل من سبع أو ثمانٍ ما عدا لهجاتها المختلفة ولم يكن من سبيل إلى الخداع أو الانخداع لأن كل واحد من السامعين حكم بمعرفتهم لغته وشهد بذلك لغيره. والذي حيرهم أن المتكلمين بتلك اللغات جليليون (ع ٧) ولا سبيل لأهل الجليل في جليلهم أن يسمعوا تلك اللغات وليسوا بعلماء لكي يتعلموها.
بِعَظَائِمِ ٱللّٰهِ هذا يعم التسابيح والتشكرات لله على ما صنع من العظائم بإرساله ابنه إلى العالم وفي إقامته إياه من الموت وبإصعاده إياه إلى السماء وبإجرائه المعجزات باسمه.
١٢ «فَتَحَيَّرَ ٱلْجَمِيعُ وَٱرْتَابُوا قَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا؟».
فَتَحَيَّرَ ٱلْجَمِيعُ وَٱرْتَابُوا أي عجبوا من غرابة الأمر عجباً عظيماً وشكوا في تعيين العلة فما استطاعوا أن يحكموا أمن الله هي أم من غيره.
١٣ «وَكَانَ آخَرُونَ يَسْتَهْزِئُونَ قَائِلِينَ: إِنَّهُمْ قَدِ ٱمْتَلأُوا سُلاَفَةً».
آخَرُونَ يَسْتَهْزِئُونَ لعل هؤلاء من سكان أورشليم لم يفهموا شيئاً من اللغات الأجنبية فحكموا أن كلام الرسل لا معنى له.
ٱمْتَلأُوا سُلاَفَةً أي سكروا كثيراً حتى لم يستطيعوا أن يتلفظوا بما له معنى وهذا أسهل طريق للتخلص من تأثير تلك المعجزة. ويغلب أن يكون في كل جمع فريقان من الناس الفريق الواحد تقي كالذين سألوا «ما عسى أن يكون هذا» والآخر شقي كالذين قالوا «امتلأوا سلافة». ومثل هذا الجمع كان الجمع في أثينا يوم تكلم بولس «كَانَ ٱلْبَعْضُ يَسْتَهْزِئُونَ، وَٱلْبَعْضُ يَقُولُونَ: سَنَسْمَعُ مِنْكَ عَنْ هٰذَا أَيْضاً» (ص ١٧: ٣٢ انظر أيضاً متّى ١١: ١٩ ويوحنا ٧: ٢٠ و٨: ٤٨ وأعمال ٢٦: ٢٤).
موعظة بطرس ع ١٤ إلى ٣٦
١٤ « فَوَقَفَ بُطْرُسُ مَعَ ٱلأَحَدَ عَشَرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ لَهُمْ: أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْيَهُودُ وَٱلسَّاكِنُونَ فِي أُورُشَلِيمَ أَجْمَعُونَ، لِيَكُنْ هٰذَا مَعْلُوماً عِنْدَكُمْ وَأَصْغُوا إِلَى كَلاَمِي».
تقسم هذه الموعظة إلى أربعة أقسام:
- الأول: تبرئة الرسل ع ١٤ و١٥.
- الثاني: بيان أن الحادثة إتمام نبوءة (ع ١٦ - ٢١).
- الثالث: إيضاح أن يسوع المصلوب قد قام وأن ذلك تمام نبوءات.
- الرابع: أن الرسل شهود بذلك والروح القدس شاهد به أيضاً فإذاً يسوع رب ومسيح (ع ٢٢ - ٣٦).
بُطْرُسُ انظر ما أعظم التغير الذي طرأ على هذا الرسول منذ نحو اثنين وخمسين يوماً فإنه كان يومئذ جباناً أنكر المسيح وصار اليوم شجاعاً يشهد بجراءة غريبة بقيامة يسوع وصحة دعواه وما ذلك إلا نتيجة فعل الروح القدس وهذا من عظائم معجزات ذلك اليوم.
مَعَ ٱلأَحَدَ عَشَرَ أي الرسل العشرة ومتياس الذي انتخبوه حديثاً (ص ١: ٢٦). وكان وقوف الأحد عشر مع بطرس بياناً أنهم رضوه نائباً عنهم وصدقوا كلامه ولعلهم زادوا على كلام بطرس شيئاً. والأرجح أنه تكلم حينئذ بالآرامية العامية المعروفة بالسريانية وكانت شائعة يومئذ في اليهودية.
أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْيَهُودُ أي اليهود أصلاً.
وَٱلسَّاكِنُونَ فِي أُورُشَلِيمَ أصلاء ودخلاء.
١٥ «لأَنَّ هٰؤُلاَءِ لَيْسُوا سُكَارَى كَمَا أَنْتُمْ تَظُنُّونَ، لأَنَّهَا ٱلسَّاعَةُ ٱلثَّالِثَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ».
١تسالونيكي ٥: ٧
لأَنَّ هٰؤُلاَءِ هو وسائر الرسل.
لَيْسُوا سُكَارَى هذا نفي لقولهم «امتلأوا سلافة».
لأَنَّهَا ٱلسَّاعَةُ ٱلثَّالِثَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ أي قبل الظهر بثلاث ساعات وهي ساعة صلاة الصبح عند اليهود وذكر ذلك دليلاً على صحة نفيه السكر عنه وعن سائر التلاميذ لأنه لا أحد من اليهود يشرب الخمر قبل تلك الصلاة ولو من أكبر المدمنين ويؤيد ذلك قول الرسول «ٱلَّذِينَ يَسْكَرُونَ فَبِٱللَّيْلِ يَسْكَرُونَ» (١تسالونيكي ٥: ٧). وكان من عوائد اليهود في الأعياد أنهم لا يأكلون ولا يشربون شيئاً قبل صلاة الصبح كما تشهد به كتبهم وهذا برهان بطرس الأول.
١٦ «بَلْ هٰذَا مَا قِيلَ بِيُوئِيلَ ٱلنَّبِيِّ».
في هذا العدد برهان بطرس الثاني على نفي السكر المذكور وهو أن ما حسبوه سكراً هو فعل الروح القدس إتماماً لنبوءة يوئيل بما يحدث في أيام المسيح وهو فوق كونه دليلاً على نفي تهمة برهان على إتيان المسيح الموعود به.
١٧ « يَقُولُ ٱللّٰهُ: وَيَكُونُ فِي ٱلأَيَّامِ ٱلأَخِيرَةِ أَنِّي أَسْكُبُ مِنْ رُوحِي عَلَى كُلِّ بَشَرٍ، فَيَتَنَبَّأُ بَنُوكُمْ وَبَنَاتُكُمْ، وَيَرَى شَبَابُكُمْ رُؤىً وَيَحْلُمُ شُيُوخُكُمْ أَحْلاَماً».
إشعياء ٤٤: ٣ وحزقيال ١١: ١٩ و٣٦: ٢٧ ويوئيل ٢: ٢٨ و٢٩ وزكريا ١٢: ١٠ ويوحنا ٧: ٣٨ و٢ ١٥: ٤٥ و٢١: ٩
هذا مقتبس من (يوئيل ٢: ٢٨ - ٣٢) ومعناه على وفق ما في الأصل العبراني وألفاظه تقرب مما في ترجمة السبعين.
فِي ٱلأَيَّامِ ٱلأَخِيرَةِ قصد اليهود بهذه العبارة الوقت منذ مجيء المسيح إلى نهاية العالم أي كل زمن ملكوته ومجده وسموه بالأيام الأخيرة مقابلة بأيام الآباء والملوك والأنبياء التي هي الأيام الأولى (إشعياء ٢: ٢). ولا يدل ذلك على أنهم توقعوا نهاية العالم على أثر مجيء المسيح لأنهم توقعوا أن يملك مدة طويلة على الأرض. وقصد كتبة العهد الجديد بها زمان الإنجيل الذي بداءته يوم الخمسين (عبرانيين ١: ٢ و١بطرس ١: ٢٠ و٢بطرس ٣: ٣ و١يوحنا ٢: ١٨).
أَسْكُبُ هذا مجاز والحقيقة أنه يهب الروح القدس بكثرة كالماء الوافر وذلك مثل قول بولس في (تيطس ٣: ٦ انظر أيضاً أيوب ٣٦: ٢٧ وإشعياء ٤٤: ٣ و٤٥: ٨ وزكريا ١٢: ١٠ وملاخي ٣: ١٠) وغاية ذلك السكب تقديس النفس.
رُوحِي هو الأقنوم الثالث من اللاهوت وأرسله الله لإكمال عمل الفداء لأنه يقود الناس إلى المسيح لينالوا فوائد الخلاص وعمله الخاص تجديد قلوب الناس (يوحنا ٣: ٥ و٦) وإنماء الفضائل الروحية (غلاطية ٥: ٢٢ - ٢٥ وتيطس ٣: ٥ - ٧) فنجاح الإنجيل متوقف على عمله (إشعياء ٣٢: ١٥ و١٦). وبواسطته فعل الرسل المعجزات شهادة ليسوع (١كورنثوس ٤: ١٠) وظهر تأثيره يوم عيد الخمسين بتقويته الرسل على الوعظ وبتجديد قلوب ثلاثة آلاف من الناس.
كُلِّ بَشَرٍ أي كل صنف من الناس يهوداً وأمماً وصغاراً وكباراً. وما فهم بطرس أن ذلك معنى النبوءة إلى بعد إعلان خاص في يافا (ص ١٠).
فَيَتَنَبَّأُ أي يتكلم بقوة الروح القدس كما تكلم شاول الملك في الأيام القديمة (١صموئيل ١٠: ١٠ و١٩: ٢٠ - ٢٤) وإتمام هذا الوعد بُيّن في (ص ١١: ٢٨ و١٩: ٦ و٢١: ٩ و١٠ و١كورنثوس ١٤: ٣٤).
وَيَرَى شَبَابُكُمْ رُؤىً نظر صور الأشياء وهي غير موجودة كأنها موجودة حقيقة. هذا من الطرق التي أعلن الله إرادته فيها (أيوب ٣٣: ١٥) وهذا لم يكن في يوم الخمسين بل كان بعده كما كان من أمر استفانوس (ص ٧: ٥٥) وأمر بولس وحنانيا (ص ٩: ٣ و١٠) وكرنيليوس (ص ١٠: ٣) وبطرس (ص ١٠: ١٠ و١١) ويوحنا (رؤيا ص ١ - ص ٢٢).
وَيَحْلُمُ شُيُوخُكُمْ أَحْلاَماً وهذا طريق آخر من طرق إعلان الله للناس وكان ذلك كثيراً في العهد القديم (تكوين ٢٠: ٣ و٣١: ١١ و٢٤ و٣٧: ٥ وعدد ١٢: ٦) وجرى ذلك في العهد الجديد مراراً (متّى ١: ٢٠ و٢: ١٢ و١٣ و١٩ و٢٢) ولا نعلم كيف كانوا يميّزون وقتئذ بين أحلام الإعلان والأحلام العادية. ولا دليل لنا على أن الله يكلم الناس اليوم بأحلام فإذاً لا اعتبار لها في هذه الأيام.
١٨ «وَعَلَى عَبِيدِي أَيْضاً وَإِمَائِي أَسْكُبُ مِنْ رُوحِي فِي تِلْكَ ٱلأَيَّامِ فَيَتَنَبَّأُونَ».
ص ٢١: ٤ و٩ و٢٠ و١كورنثوس ١٢: ١٠ و٢٨ و١٤: ١ الخ
عَبِيدِي أَيْضاً وَإِمَائِي مراده تعالى بذلك منح المواهب الروحية لكل رتبة من الناس للأدنين كما للأعلين (غلاطية ٣: ٢٨) وتم ذلك بإعطائه القوة لصيادي الجليل على أن يكونوا معلمي العالم ولطابيثا وليدية وبريسكلا أن يكنّ أمثلة التقوى. ولعل المراد «بالعبيد والإماء» محبو الله بقطع النظر عن رتبهم لا المماليك لأنهم أضيفوا إلى الله وذلك على وفق ما جاء في (مزمور ٨٦: ١٦ و١١٦: ١٦ ولوقا ١: ٣٨).
فَيَتَنَبَّأُونَ لا يلزم من هذا أنهم يعلمون ما في المستقبل لأن التنبوء جاء في الكتاب لثلاثة معان غير علم الغيب وهي التسبيح لله (لوقا ١: ٢٧) والتعليم الروحي بإرشاد روح الله (متّى ٧: ٢٢) والتكلم بألسنة غريبة كما كان في يوم الخمسين وهذه كلها من آيات الرحمة.
١٩ «وَأُعْطِي عَجَائِبَ فِي ٱلسَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ وَآيَاتٍ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ: دَماً وَنَاراً وَبُخَارَ دُخَان».
يوئيل ٢: ٣٠ و٣١
عَجَائِبَ معجزات وغرائب. وذكرت في الإنجيل غالباً مع الآيات (متّى ٢٤: ٢٤ ومرقس ١٣: ٢٢ ويوحنا ٤: ٤٨ ورومية ١٥: ١٩). وبعض هذه العجائب من متعلقات الجو والكواكب وبعضها من متعلقات الأرض وهذه كلها من آيات النقمة. وهذا مثل نبوءة المسيح في (لوقا ١٩: ٤٤) وهي أن يوم الافتقاد يكون يوم رحمة للذين يقبلون الرحمة ويوم نقمة للذين يرفضونها.
دَماً الخ أي فتنة وحرياً وقتلاً وتخريب المدن وإحراقها. تم أول هذه النبوءة بخلاص ألوف من أهل اليهودية يوم الخمسين وبعده وتم آخرها بخراب أورشليم وما حدث في وقته من البلايا.
٢٠ «تَتَحَوَّلُ ٱلشَّمْسُ إِلَى ظُلْمَةٍ وَٱلْقَمَرُ إِلَى دَمٍ، قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ يَوْمُ ٱلرَّبِّ ٱلْعَظِيمُ ٱلشَّهِيرُ».
متّى ٢٤: ٢٩ ومرقس ١٣: ٢٤ ولوقا ٢١: ٢٥
انظر الشرح (متّى ٢٤: ٢٩ وانظر أيضاً إشعياء ١٢: ١٠ وحزقيال ٣٢: ٧ ومرقس ١٣: ٢٤ و٢بطرس ٣: ٧ - ١٠). ولا يلزم من الكلام أن ذلك التحول سيكون حقيقياً بل المعنى أنه يظهر كذلك للناظر فالكلام مجاز وتمثيل للنوازل التي تقع على الأرض من الحروب والأوبئة والزلازل كما يمثل بشروق الشمس على الإنسان بالنجاح والبركة (إشعياء ٦٠: ٢٠ وإرميا ١٥: ٩ وعاموس ٨: ٩ ورؤيا ٦: ١٢ و٨: ١٢ و٩: ٢ و١٦: ٨). ولعل خراب أورشليم ليس سوى واحد من تلك النوازل وسيأتي غيرها حين يشاء الله.
قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ يَوْمُ ٱلرَّبِّ أي أن هذه النبوءة بكل ما تتضمنه من الوعد في (ع ١٧ و١٨) والوعيد في (ع ١٩ و٢٠) تتم قبل إتيان يوم الرب أي يوم الدين الذي لا يعرف وقته إلا الله. ولا تنحصر بركة نبوءة يوئيل في يوم الخمسين بل ما كان فيه منها عربون نجاح الإنجيل في القرون التالية وكذلك لعنة تلك النبوءة لم تنحصر في يوم خراب أورشليم بل ذلك الخراب مقدمة الأهوال في يوم الدينونة الرهيبة.
ٱلْعَظِيمُ ٱلشَّهِيرُ وُصف بذلك لوفرة بركاته لشعب الله ولشدة هوله لأعدائه.
٢١ «وَيَكُونُ كُلُّ مَنْ يَدْعُو بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ يَخْلُصُ».
رومية ١٠: ١٣
هذه الآية وعد بالرحمة لكل من يسأل الله بالإيمان في أثناء تلك الضيقات فهي رجاء الوعد مع أهوال الوعيد لكي لا ييأس أحد.
بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ أي بالرب نفسه (مزمور ٧٩: ٦ وزكريا ١٣: ٩) والأرجح أن بطرس أراد بالرب هنا يسوع المسيح كما عنى بولس في (رومية ١٠: ١٣ و١٤ و١كورنثوس ١: ٢).
يَخْلُصُ من كل أهوال الوعيد. وهذا الوعد يصح في كل الأحوال وهو وعد بالنجاة الجسدية والنجاة الروحية. ومما يستحق الاعتبار هنا أن لا أحد من المسيحيين هلك في خراب أورشليم لأنهم هربوا من أورشليم إلى شرقي الأردن ونجوا وكذلك يكون المسيح ملجأ للمؤمنين في يوم الدين.
اتخذ بطرس كلام يوئيل بياناً لأن الله في الأيام الأخيرة من تاريخ العالم يظهر عظمة رحمته بهبته الروح وشدة نقمته لكي يقبل الناس الخلاص وينجوا من النقمة وفي كلامه هنا خمس فوائد:
- الإنذار بالخطر.
- وجوب الاستعداد لتوقيّه.
- أن الله مستعد لمنح الخلاص.
- أن الشرط الوحيد الدعاء ولا شرط أهم من هذا.
- أنه من يهلك فهو على هلاك نفسه.
٢٢ «أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلإِسْرَائِيلِيُّونَ ٱسْمَعُوا هٰذِهِ ٱلأَقْوَالَ: يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ رَجُلٌ قَدْ تَبَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ قِبَلِ ٱللّٰهِ بِقُوَّاتٍ وَعَجَائِبَ وَآيَاتٍ صَنَعَهَا ٱللّٰهُ بِيَدِهِ فِي وَسَطِكُمْ، كَمَا أَنْتُمْ أَيْضاً تَعْلَمُونَ».
يوحنا ٣: ٢ و١٤: ١٠ و١١ وص ١٠: ٣٨ وعبرانيين ٢: ٤
هذه الآية بداءة القسم الثالث من موعظة بطرس وهو إيضاح أن يسوع المصلوب قد قام وارتفع إلى السماء وتمجّد على وفق المواعيد المتعلقة بالمسيح فكان عليهم أن يتوبوا عن خطيئتهم في قتله ويؤمنوا به فيخلصوا.
يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ كان اسم يسوع شائعاً بين اليهود فنعته بالناصري على ما اشتهر به تمييز له عن يسوع آخر. ولا ريب في أن بطرس كان وقتئذ على جانب عظيم من الشجاعة حتى استطاع أن يعترف هكذا بمن صُلب بأمر الحاكم كمذنب (منذ خمسين يوماً وكان هو نفسه قد أنكر أنه يعرفه) لما كان يترتب من العار والخطر على الاعتراف به.
تَبَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ قِبَلِ ٱللّٰهِ أي ثبت بالدليل القاطع أن الله أحبه وأرسله. وهذا مثل قول نيقوديموس ليسوع «نَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ مِنَ ٱللّٰهِ مُعَلِّماً، لأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَعْمَلَ هٰذِهِ ٱلآيَاتِ ٱلَّتِي أَنْتَ تَعْمَلُ إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱللّٰهُ مَعَهُ» (يوحنا ٣: ٢).
بِقُوَّاتٍ وَعَجَائِبَ وَآيَاتٍ ثلاث كلمات مترادفات والفرق بينهما اعتباري فالقوات المعجزات بالنظر إلى قوة الفاعل ومنها شفاء المرضى وإقامة الموتى. والعجائب المعجزات بالنظر إلى تأثيرها في المشاهد ومنها الغرائب المتعلقة بميلاد المسيح وموته وقيامته. والآيات المعجزات باعتبار أنها أدلة على صحة التعليم المقترن بها ومنها جودة تعليمه وأفعاله وعمله ما في الغيب.
صَنَعَهَا ٱللّٰهُ بِيَدِهِ الضمير في يده يرجع إلى يسوع وهذا موافق لشهادة يسوع نفسه حين كان يصنع المعجزات (يوحنا ٥: ١٩ و٣٠) فهي تصديق الله لصحة دعوى ابنه (يوحنا ٥: ٣٦).
فِي وَسَطِكُمْ أي في بلادكم وأرضكم أورشليم وسائر اليهودية. والأرجح أن كثيرين من السامعين كانوا قد شاهدوا كثيراً من تلك المعجزات.
كَمَا أَنْتُمْ أَيْضاً تَعْلَمُونَ بالمشاهدة البصرية أو بشهادة من شاهد بعينيه فإن أنباء أعمال المسيح كانت منتشرة في كل تلك الأرض (متّى ٤: ٢٤ و٢٥ ومرقس ٣: ٨). واليهود لم ينكروا يومئذ أنه صنع المعجزات بل نسبوا إليه أنه كان يصنعها بقوة بعلزبول (متّى ٩: ٣٤ ومرقس ٣: ٢٢ ويوحنا ١٥: ٢٤).
٢٣ «هٰذَا أَخَذْتُمُوهُ مُسَلَّماً بِمَشُورَةِ ٱللّٰهِ ٱلْمَحْتُومَةِ وَعِلْمِهِ ٱلسَّابِقِ، وَبِأَيْدِي أَثَمَةٍ صَلَبْتُمُوهُ وَقَتَلْتُمُوه».
متّى ٢٦: ٢٤ ويوحنا ٢٢: ٢٢ و٢٤: ٤٤ وص ٣: ١٨ و٤: ٢٨ و٥: ٣٠
قال الرسول ذلك دفعاً لاعتراض يخطر على بال السامعين مما جرى على يسوع وهو أن من صُلب ومات موت الهوان ليس هو بالمسيح وإثباتاً لضرورة موته إتماماً لمقاصد الله وأنه قام من الموت وهم شهود لذلك وأنه ارتفع إلى يمين الله ولذلك أرسل روحه القدوس بآيات قوته في يوم الخمسين.
مُسَلَّماً بِمَشُورَةِ ٱللّٰهِ الذي شاهده الناس من أمور موت المسيح كان من أعمال البشر والواقع أن علة موته الأصلية قضاء الله وقصده كما يتبين من النبوءات في العهد القديم (إشعياء ٥٢: ١٣ و١٥: ٥٣: ١ - ١٢ وزكريا ١١: ١٢ و١٢: ١٠ و١٣: ٧) وما قيل هنا قيل في (ص ٤: ٢٧ و٢٨) وهو قوله «ٱجْتَمَعَ عَلَى فَتَاكَ ٱلْقُدُّوسِ يَسُوعَ، ٱلَّذِي مَسَحْتَهُ، هِيرُودُسُ وَبِيلاَطُسُ ٱلْبُنْطِيُّ مَعَ أُمَمٍ وَشُعُوبِ إِسْرَائِيلَ، لِيَفْعَلُوا كُلَّ مَا سَبَقَتْ فَعَيَّنَتْ يَدُكَ وَمَشُورَتُكَ أَنْ يَكُونَ». والمراد بالمشورة هنا الرأي المبني على الحكمة. وغاية بطرس من هذا بيان أن موت المسيح كان بمقتضى تلك المشورة لا على رغمه بدليل قوله هو أيضاً (متّى ٢٦: ٥٣ ويوحنا ١٩: ١٠ و١١) ولو كان على رغمه لبطلت دعواه أنه المسيح ابن الله.
وَعِلْمِهِ ٱلسَّابِقِ هذا يؤكد حدوث الأمر لعلة ما. وما سبق من هذه الآية أعلن أن تلك العلة كانت قضاء الله (رومية ٨: ٢٩).
وَبِأَيْدِي أَثَمَةٍ أي بواسطة بيلاطس والجند الروماني لأنه لم يكن لليهود يومئذ من سلطان على قتل أحد والصلب ليس من معاقبات اليهود بل من معاقبات الرومانيين.
صَلَبْتُمُوهُ وَقَتَلْتُمُوهُ أي أنتم أيها اليهود فالذنب ذنبكم لأنه لو لم يرد الشعب قتله ويصرخ طالباً ذلك لم يحكم عليه بيلاطس بل أطلقه (لوقا ٢٣: ١٨ - ٢١) فنسب بطرس إلى المخاطبين أفظع الخطايا وهو أنهم رفضوا مسيحهم وقتلوه وهو رجاء آبائهم الذين وُعدوا به منذ زمن طويل وملكهم ومخلصهم فعظمة مقامه زادت فظاعة إثمهم.
وفي ما قيل هنا برهان على أن قضاء الله لا ينفي اختيار الإنسان فإن الله قضى بموت المسيح وأما اليهود والرومانيين ففعلوا ما فعلوه باختيارهم. فسبق العلم بحادثة لا ينفي اختيار محدثها كما أن ذكرها بعد وقوعها لا ينفي ذلك الاختيار. فلله حق أن يعاقب اليهود على بغضهم ليسوع وقتلهم إياه لكنه لا يعاقبهم على إتمام مقاصده.
٢٤ «اَلَّذِي أَقَامَهُ ٱللّٰهُ نَاقِضاً أَوْجَاعَ ٱلْمَوْتِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ مُمْكِناً أَنْ يُمْسَكَ مِنْهُ».
ع ٣٢ وص ٣: ١٥ و٤: ١٠ و١٠: ٤٠ و١٣: ٣٠ و٣٤ و١٧: ٣١ ورومية ٤: ٢٤ و٨: ١١ و١كورنثوس ٦: ١٤ و١٥: ١٥ و٢كورنثوس ٤: ١٤ وغلاطية ١: ١ وأفسس ١: ٢٠ وكولوسي ٢: ١٢ و١تسالونيكي ١: ١٠ وعبرانيين ١٣: ٢٠ و١بطرس ١: ٢١
هذه المناداة الأولى علناً بقيامة المسيح على أنه لا بد من أن أنباءها قد شاعت قبلاً على غير هذا السبيل.
اَلَّذِي أَقَامَهُ ٱللّٰهُ أي من الموت وهذا عين ما أراد بطرس إثباته وبإقامة الله ليسوع براءة من تهمة اليهود وشهادة بصحة دعواه وهو مما أنبأ به المسيح قبل موته.
نَاقِضاً أَوْجَاعَ ٱلْمَوْتِ هذا مجاز وهو استعارة مكنية فإن المتكلم شبه آلام الموت في نفسه بقيود وأثبت لها النقض دلالة على التشبيه المضمر في النفس أو هو استعارة تبعية شُبهت بها الإقامة من الموت بحل قيود الأسير ومثل هذا جاء في (مزمور ١٨: ٥ و١١٩: ٦١ وإشعياء ٦٦: ٧ وإرميا ٢٢: ٢٣ وهوشع ١٣: ١٣). ويغلب أن يسبق الموت أوجاع ولذلك أضاف الأوجاع إليه. ولا يلزم من هذا أن المسيح أُلم بعد الموت إنما المراد أن حال موته كانت حال الاتضاع والأسر فرفعه الله وأطلقه من تلك الحال حين أقامه.
إِذْ لَمْ يَكُنْ مُمْكِناً الخ نظراً للواقع فإنه لم يمكن نظراً إلى مقام شخص المسيح لأنه رئيس الحياة (ص ٣: ١٥) ولأن له حياة في نفسه (يوحنا ١: ٤ و٥: ٦٢) ولأن له سلطاناً أن يضع حياته وأن يأخذها أيضاً (يوحنا ١٠: ١٨). ولم يكن نظراً إلى ما يقتضيه عمل الفداء الذي تعهد المسيح به لكي يُخضع الشيطان ويهدم ملكه ويخلص شعبه (عبرانيين ٢: ١٤) ولم يمكن نظراً إلى قضاء الله ومواعيد الكتاب المقدس كما سيبيّنه.
٢٥ «لأَنَّ دَاوُدَ يَقُولُ فِيهِ: كُنْتُ أَرَى ٱلرَّبَّ أَمَامِي فِي كُلِّ حِينٍ، أَنَّهُ عَنْ يَمِينِي، لِكَيْ لاَ أَتَزَعْزَعَ».
مزمور ١٦: ٨ الخ
لأَنَّ دَاوُدَ يَقُولُ بإلهام الروح القدس.
فِيهِ أي في المسيح الذي هو المتكلم كما يتضح من (ع ٢٩ - ٣١ و١٣: ٣٦) واقتبس بطرس هنا من (مزمور ١٦: ٨ - ١١) جرياً على ترجمة السبعين وهو يفرق عن الأصل العبرانية بكلمة واحدة لفظاً لا معنىً وما قاله بفم داود في ذلك المزمور أنباء الروح القدس بما يشعر به المسيح وهو على الأرض.
أَرَى ٱلرَّبَّ أي أنظر إليه معيناً ومعتمداً فاتخذ هنا الله بمنزلة جبار بأس متسلح بسيف وترس.
أَمَامِي أي قريباً منى ليعينني عند الحاجة حالاً. .
عَنْ يَمِينِي هنا المسيح على يسار الله لأن اليسار موضع الوقاية فلا منافاة بين قوله هنا وقوله في (متّى ٢٦: ٦٤) ففيه أن الله كملك جالس على كرسيه وابنه على يمينه أي موضع الشرف وكلا الأمرين كناية.
لِكَيْ لاَ أَتَزَعْزَعَ أي لا تغلبني شدة المصائب ولا قوة الأعداء.
٢٦ «لِذٰلِكَ سُرَّ قَلْبِي وَتَهَلَّلَ لِسَانِي. حَتَّى جَسَدِي أَيْضاً سَيَسْكُنُ عَلَى رَجَاءٍ».
لِذٰلِكَ سُرَّ قَلْبِي فرح المسيح لما كان على الأرض بالنظر إلى اتحاده بالآب وبأنه عمل بمقتضى إرادته (لوقا ٢١: ١٠ ويوحنا ١١: ٤٢) وبتيقنه أن أباه ينجيه من كل ضيقاته وينصره على أعدائه. وهذا كقول الرسول «ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِ ٱلسُّرُورِ ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَهُ ٱحْتَمَلَ ٱلصَّلِيبَ مُسْتَهِيناً بِٱلْخِزْيِ» (عبرانيين ١٢: ٢).
وَتَهَلَّلَ لِسَانِي وفي الأصل العبراني ابتهجت روحي وترجمها السبعون بما في المتن لأن اللسان آلة الروح في إظهار الابتهاج.
جَسَدِي أَيْضاً سَيَسْكُنُ عَلَى رَجَاءٍ جعل القبر بمنزلة مسكن وقتي لتوقعه القيامة سريعاً وفي الأصل العبراني يسكن مطمئناً وترجمة السبعون بلفظتي «على الرجاء» لأن الرجاء علة الاطمئنان.
٢٧ «لأَنَّكَ لَنْ تَتْرُكَ نَفْسِي فِي ٱلْهَاوِيَةِ وَلاَ تَدَعَ قُدُّوسَكَ يَرَى فَسَاداً».
تكوين ٤٢: ٣٨ و٢صموئيل ٢٢: ٦ وأيوب ١٠: ٢١ و٢٢ ومزمور ٣٠: ٣ و٨٦: ١٣ و٨٩: ٤٨ وإشعياء ١٤: ٩ وحزقيال ٣١: ١٦ ومتّى ١١: ٢٣ و١كورنثوس ١٥: ٥٥
لأَنَّكَ لَنْ تَتْرُكَ نَفْسِي أي لن تتركني.
فِي ٱلْهَاوِيَةِ أي في محل الأرواح مع سائر الموتى تحت سلطان الموت إلى يوم القيامة العامة. وكانت ثقة المسيح كذلك كل مدة حياته وفي ساعة موته حين استودع الآب نفسه.
قُدُّوسَكَ هذا أحد نعوت المسيح يشير إلى كونه موقوفاً لعبادة الله كما مر في التفسير (يوحنا ١٧: ١٩). ونُعت أيضاً «بالقدوس» لأنه أقدس من كل من سواه في الطهارة والتقوى (لوقا ٤: ٣٤ وأعمال ٣: ١٤ وعبرانيين ٧: ٢٦ ورؤيا ١٥: ١٤ و١٦: ٥).
يَرَى فَسَاداً أي لا يبقى زمناً طويلاً في القبر حتى يعتريه البلى كما يعتري سائر الموتى على وفق قوله «إلى التراب تعود» (تكوين ٣: ١٩). ومعنى الآية كلها أن المسيح متيقن أن الله يقيمه سريعاً من بين الأموات فلا يبقى جسده ولا نفسه تحت سلطان الموت.
٢٨ «عَرَّفْتَنِي سُبُلَ ٱلْحَيَاةِ وَسَتَمْلأُنِي سُرُوراً مَعَ وَجْهِكَ».
عبرانيين ١٢: ٢
هذه الأية كالتي قبلها في بيان اطمئنان المسيح وهو على الأرض.
عَرَّفْتَنِي سُبُلَ ٱلْحَيَاةِ أي ما يتوصل به من الموت إلى الحياة. والمعنى أن المسيح وثق بأن الله يعيده إلى الحياة نفساً وجسداً وهذا يتضمن صعوده إلى السماء أيضاً وتكليله هناك بالمجد والكرامة.
سَتَمْلأُنِي سُرُوراً مَعَ وَجْهِكَ أي تكمل فرحي حين أقوم بمشاهدتك في السماء حيث تمجدني وهذا كما جاء في (أفسس ١: ٢٠ - ٢٢ وعبرانيين ٩: ٢٤ و١٢: ٢).
٢٩ «أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلإِخْوَةُ، يَسُوغُ أَنْ يُقَالَ لَكُمْ جِهَاراً عَنْ رَئِيسِ ٱلآبَاءِ دَاوُدَ إِنَّهُ مَاتَ وَدُفِنَ، وَقَبْرُهُ عِنْدَنَا حَتَّى هٰذَا ٱلْيَوْمِ».
١ملوك ٢: ١٠ وص ١٣: ٣٦
غاية بطرس في هذه الآية وما بعدها حتى الآية الحادية والثلاثين بيان أن داود تنبأ بذلك بقيامة المسيح ولم يتكلم به على نفسه.
أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلإِخْوَةُ خاطبهم في (ع ١٤) بقوله «أيها اليهود» إشارة إلى أرض سكنهم وفي (ع ٢٢) بقوله «أيها الإسرائيليون» إشارة إلى كونهم ورثة مواعيد الله لإسرائيل.
يَسُوغُ أَنْ يُقَالَ لأنه معلوم ومسلم أن داود مات وفني وأن ذلك لم يحط مقامه وشرفه باعتبار أنه ملك مقتدر ونبي تقي.
رَئِيسِ ٱلآبَاءِ نُعت بهذا لأنه أول البيت الملكي في يهوذا الذي توقع اليهود إتيان المسيح من نسله.
إِنَّهُ مَاتَ وَدُفِنَ كما كُتب عنه في العهد القديم ولم يدع أحدٌ أنه قام فلذلك لا يصدق عليه ما تقدم من كلام المزمور.
قَبْرُهُ عِنْدَنَا في مدينة أورشليم في الجزء الذي بناه منها وعُرف بمدينة داود (١ملوك ٢: ١٠) وكان على جبل صهيون وهنالك دُفن أكثر ملوك يهوذا. فتح قبره أولاً يوحنا هركانوس المكابي وهو رئيس الأحبار ثم فتحه هيرودس الكبير وأخذ ما بقي فيه من النفائس ووجود ذلك القبر عندهم إلى ذلك اليوم واعتقادهم أن داود لم يقم منه دليل قاطع على أن كلام النبوءة يصدق على غيره لا عليه.
٣٠ «فَإِذْ كَانَ نَبِيّاً، وَعَلِمَ أَنَّ ٱللّٰهَ حَلَفَ لَهُ بِقَسَمٍ أَنَّهُ مِنْ ثَمَرَةِ صُلْبِهِ يُقِيمُ ٱلْمَسِيحَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ لِيَجْلِسَ عَلَى كُرْسِيِّهِ».
٢صموئيل ٧: ١٢ و١٣ ومزمور ١٣٢: ١١ ولوقا ١: ٣٢ و٦٩ ورومية ١: ٣ و٢تيموثاوس ٢: ٨
فَإِذْ كَانَ نَبِيّاً أي ملهماً من الله قادراً على الأنباء بالأمور المستقبلة (٢صموئيل ٢٣: ٢) تكلم بنبوءات كثيرة على المسيح (قابل مزمور ٢٢: ١ مع متّى ٢٦: ٤٦ ولوقا ٢٤: ٤٤ وقابل مزمور ٢٢: ١٨ مع متّى ٢٧: ٣٥ وقابل مزمور ٦٩: ٢١ مع متّى ٢٧: ٣٤ و٣٨ وقابل مزمور ٦٩: ٢٥ مع أعمال ١: ٢٠).
عَلِمَ لأن الله عرفه ذلك بواسطة ناثان النبي (٢صموئيل ٧: ١٢ و١٦ ومزمور ١٣٢: ١١). وذُكر أيضاً مثل ذلك في مزمور ٨٩: ٣ و٤ و٣٥ - ٣٧).
حَلَفَ لَهُ بِقَسَمٍ (مزمور ٨٩: ٣ و٣٥).
مِنْ ثَمَرَةِ صُلْبِهِ أي من نسله.
يُقِيمُ ٱلْمَسِيحَ قصد بالوعد سليمان أولاً ثم نسله وأتمه أخيراً بالمسيح وهكذا اعتقد اليهود وفسره كتبة الإنجيل (متّى ١٢: ٢٣ و٢١: ٩ و٢٢: ٤٢ و٤٥ ومرقس ١١: ١٠ ويوحنا ٧: ٤٢). وعلم داود أن تلك النبوءة كانت تشير إلى المسيح ولا تنحصر في أحد قبله لأن من جملة الوعد هو أن «كرسي مملكته يكون إلى الأبد» (٢صموئيل ٧: ١٣). وصرح بطرس أن داود هكذا فهم الوعد.
حَسَبَ ٱلْجَسَدِ أي أن المسيح من نسل داود حسب طبيعته البشرية فلو كان يسوع مجرد إنسان لم يكن من داع إلى هذا القيد فهو دليل على أن بطرس اعتقد أن للمسيح طبيعة أخرى غير الطبيعة البشرية وهي طبيعته الإلهية.
لِيَجْلِسَ عَلَى كُرْسِيِّهِ أي ليخلفه في الملك مسيحاً (مرقس ١١: ١٠ ولوقا ١: ٣٢ وص ١٥: ١٠). فالنبوءة من جهة المسيح تتضمن أمرين الأول أنه يُقام من الموت. والثاني أنه يملك إلى الأبد مُلكاً يعم كل ممالك الأرض. وكون مُلك المسيح روحياً لا يمنع كونه حقيقياً فيشبه ملك داود في مجده وشموله كل شعب الله.
٣١ «سَبَقَ فَرَأَى وَتَكَلَّمَ عَنْ قِيَامَةِ ٱلْمَسِيحِ أَنَّهُ لَمْ تُتْرَكْ نَفْسُهُ فِي ٱلْهَاوِيَةِ وَلاَ رَأَى جَسَدُهُ فَسَاداً».
مزمور ١٠٦: ١٠ وص ١٣: ٣٥
سَبَقَ فَرَأَى علم ذلك قبل حدوثه بالوحي وعلمه أيضاً من نبوءة ناثان ولذلك استطاع أن يتكلم بيقين وزاده يقيناً قسم الله المذكور في الآية السابقة.
وَتَكَلَّمَ في المزمور ١٦ ويلزم من ذلك أن داود كتب هذا المزمور بعد ذلك الإعلان أي بيان أن نفس المسيح لم تُترك في الهاوية الخ فذلك التكلم نبوءة.
عَنْ قِيَامَةِ ٱلْمَسِيحِ صرّح بطرس بالوحي بأن داود قال ذلك في قيامة المسيح. وهذا يتضح أيضاً من أن داود رأى جسده فساداً ولم يقم.
أَنَّهُ لَمْ تُتْرَكْ نَفْسُهُ الخ انظر شرح ع ٢٧.
٣٢ «فَيَسُوعُ هٰذَا أَقَامَهُ ٱللّٰهُ، وَنَحْنُ جَمِيعاً شُهُودٌ لِذٰلِكَ».
ع ٢٤ ص ١: ٨
أبان بطرس في ما مرّ أنّ قيامة يسوع مضمون نبوءة وصرّح هنا أن هذه النبوءة قد تمّت وأن المسيح قد قام والبرهان على ذلك شهادة الرسل وغيرهم من التلاميذ الذين شاهدوه حياً بعد موته. انظر شرح الكلام على القيامة في (متّى ٢٨: ١٦).
٣٣ «وَإِذِ ٱرْتَفَعَ بِيَمِينِ ٱللّٰهِ، وَأَخَذَ مَوْعِدَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ مِنَ ٱلآبِ، سَكَبَ هٰذَا ٱلَّذِي أَنْتُمُ ٱلآنَ تُبْصِرُونَهُ وَتَسْمَعُونَهُ».
ع ٣٤ وص ٥: ٣١ وفيلبي ٢: ٩ وعبرانيين ١٠: ١٢ يوحنا ١٤: ٢٦ و١٥: ٢٦ و١٦: ٧ و١٣ وص ١: ٤ ص ١٠: ٤٥ وأفسس ٤: ٨
ٱرْتَفَعَ بإقامته من الموت وارتقائه من الاتضاع الذي تنازل إليه لعمل الفداء وعاد إلى المجد الذي كان له قبل إنشاء العالم (يوحنا ١٧: ٥) واستولى على السلطان المطلق باعتبار أنه ملك ومسيح (متّى ١٨: ١٨).
أَخَذَ مَوْعِدَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُس (ص ١: ٤ ويوحنا ١٤: ٢٦) أي الروح القدس الموعود به من الآب للابن ليرسله إلى تلاميذه والموعود به من الآب وهذا الوعد يتضمن أمرين الأول أن الروح القدس لا يأتي إلا بعد رجوع المسيح إلى السماء. والثاني أنه هبة الآب والابن (يوحنا ١٤: ٢٦ و١٥: ٢٦ و١٦: ٧).
سَكَبَ هٰذَا ٱلَّذِي أَنْتُمُ ٱلآنَ الخ أي الروح القدس الذي أنتم شاهدتم تأثيره أي معجزاته. وما سمعوه تكلّمهم بلغات غريبة. فنسب بطرس إلى المسيح ما نسبه إلى الآب في ع ١٧ وذاك دليل على قيامته فضلاً عن شهادة التلاميذ بها.
٣٤ «لأَنَّ دَاوُدَ لَمْ يَصْعَدْ إِلَى ٱلسَّمَاوَاتِ. وَهُوَ نَفْسُهُ يَقُولُ: قَالَ ٱلرَّبُّ لِرَبِّي، ٱجْلِسْ عَنْ يَمِينِي».
برهن بطرس في هذه الآية والتي تليها من مزمور آخر أن داود لم يتنبأ بشأن نفسه.
لأَنَّ دَاوُدَ لَمْ يَصْعَدْ إِلَى ٱلسَّمَاوَاتِ أي بجسده ليأخذ المجد والكرامة على يمين الآب كما يتضح مما قيل في ع ٢٩ وعلى ذلك لا تصدق تلك النبوءة على داود بل تصدق على المسيح بالضرورة.
قَالَ ٱلرَّبُّ لِرَبِّي أي الآب للابن (مزمور ١١٠: ١). أبان بطرس في ما سبق أن النبوءة لا تصدق على داود لأنه لم يقم من الموت ولم يصعد بجسده إلى السماء ولم يجلس على يمين الله فهي تصدق بالضرورة على غيره وهو المسيح. وزاد على ذلك هنا أن داود دعا الذي صعد ربه فإذاً يستحيل أن يقصد نفسه بتلك النبوءة فالذي أخبر به أبان أنه ذريته وربه. وأورد المسيح هذه الآية نفسها إفحاماً للكتبة (متّى ٢٢: ٢٤) فإذاً المسيح رب داود ورب الجميع.
ٱجْلِسْ عَنْ يَمِينِي أي أن الآب دعا الابن إلى المساواة له في المجد والسلطان وهذا ليس هو المجد الأصلي الذي يستحقه باعتبار كونه إلهاً بل المجد الذي ناله باعتبار كونه فادياً ووسيطاً جزاء لاتضاعه لأجل خلاص البشر وهذا على وفق ما قيل في (فيلبي ٢: ١ - ١١ وأفسس ١: ٢١ وعبرانيين ١: ٣ و٨ و١٣ و١٠: ١٢ و١٢: ٢٠ و١بطرس ٣: ٢).
٣٥ «حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءَكَ مَوْطِئاً لِقَدَمَيْكَ».
مزمور ١١٠: ١ ومتّى ٢٢: ٤٤ و١كورنثوس ١٥: ٢٥ وأفسس ١: ٢٠ و٢٢ وعبرانيين ١: ١٣
أي حتى تتم غاية أعمال الفداء إلى النهاية (١كورنثوس ١٥: ٢٤ - ٢٨).
٣٦ «فَلْيَعْلَمْ يَقِيناً جَمِيعُ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ أَنَّ ٱللّٰهَ جَعَلَ يَسُوعَ هٰذَا، ٱلَّذِي صَلَبْتُمُوهُ أَنْتُمْ، رَبّاً وَمَسِيحاً».
ص ٥: ٣١
فَلْيَعْلَمْ يَقِيناً أي ليقتنع الجميع بدون ريب بناء على النبوءات وشهادتنا والعجائب التي شاهدتموها أن المسيح قد أتى وأنه الآن في السماء.
جَمِيعُ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الذي كان برهاناً لبيت إسرائيل هو برهان لسائر الناس إنما وجه الخطاب إلى الإسرائيليين لأنهم أول المدعوين.
أَنَّ ٱللّٰهَ جَعَلَ أي أظهر أنه جعل الخ. هذا غاية خطابه ونتيجته.
يَسُوعَ هٰذَا الذي جال في هذه الأرض وتكلم معكم وصنع المعجزات قدامكم ومات على الصليب نفسه.
ٱلَّذِي صَلَبْتُمُوهُ بأن طلبتم من بيلاطس قتله.
رَبّاً أي إلهاً على الجميع (رومية ٩: ٥) ورأساً فوق كل شيء للكنيسة (أفسس ١: ٢٢ و يوحنا ١٧: ٢).
وعلى هذه الصفة يملك الآن في السماء وسوف يأتي ليدين العالم. وجعله حينئذ إلهاً لا ينافي كونه كذلك منذ الأزل لكن استتر مجده وهو في حال الاتضاع إجراء لعمل الفداء.
وَمَسِيحاً (ع ٣١) أي ممسوحاً من الله ليخلص العالم (يوحنا ٤: ٤٢) وهو الموعود به بالأنبياء. وحكم بطرس عليهم بأنهم هم صلبوا ربهم ومسيحهم مما يحملهم على أن يخجلوا ويلوموا أنفسهم ويخافوا.
تأثير وعظ بطرس وحلول الروح القدس ع٣٧ إلى ع ٤٧
٣٧ «فَلَمَّا سَمِعُوا نُخِسُوا فِي قُلُوبِهِمْ، وَسَأَلُوا بُطْرُسَ وَسَائِرَ ٱلرُّسُلِ: مَاذَا نَصْنَعُ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلإِخْوَةُ؟».
زكريا ١٢: ١٠ ولوقا ٣: ١٠ وص ٩: ٦ و١٦: ٣٠
فَلَمَّا سَمِعُوا هذا البرهان الصريح أن يسوع الذي صلبوه هو المسيح.
نُخِسُوا فِي قُلُوبِهِمْ هذا يدل على ألم نفساني شديد وحزن عظيم لشعورهم بإثمهم بما فعلوا والخطر الذي عرضوا أنفسهم له وهي نتيجة طبيعيّة من تأثير الحق ومن تأثير الروح القدس أيضاً.
مَاذَا نَصْنَعُ لننجو من نتيجة خطيئتنا أي لنزيل غضب الله عنا ونُنقذ من العقاب الذي نستحقه. وهذا السؤال يدل على اجتهادهم في النجاة ورغبتهم في التعلم واستعدادهم للخضوع لإرادة الله. فسؤالهم كسؤال بولس للمسيح (أعمال ٩: ٦) وسؤال السجان لبولس وسيلا (أعمال ١٦: ٣٠). والشعور بالخطيئة والندامة والخوف أفضل استعداد لقبول بشارة الإنجيل. ومما يبين قوة الحق وشدة تأثير الروح فإن اليهود الذين رفضوه وقتلوه لم يستطيعوا أن يعتذروا عن إثمهم بل اعترفوا به وسألوا الإرشاد للنجاة من العقاب.
٣٨ «فَقَالَ لَهُمْ بُطْرُسُ: تُوبُوا وَلْيَعْتَمِدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عَلَى ٱسْمِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِغُفْرَانِ ٱلْخَطَايَا، فَتَقْبَلُوا عَطِيَّةَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ».
لوقا ٢٤: ٤٧ وص ٣: ١٩
فَقَالَ لَهُمْ بُطْرُسُ بالنيابة عن سائر الرسل على وفق أمر المسيح بأن «يُكْرَزَ بِٱسْمِهِ بِٱلتَّوْبَةِ وَمَغْفِرَةِ ٱلْخَطَايَا» (لوقا ٢٤: ٤٧).
تُوبُوا انظر شرح (متّى ٣: ٢). التوبة تتضمن الحزن على الخطيئة والعزم على تركها والاعتراف بها جهاراً والرجوع عنها إلى الله بالطاعة والقداسة. هذا فوق الخوف من العقاب لأنهم خافوا قبل أن سألوا عن طريق الخلاص فذلك الخوف علة ذلك السؤال.
وكانت دعوة بطرس للتوبة في موعظته الأولى الإنجيليّة كدعوة يوحنا المعمدان في أول تبشيره. والتوبة هي الشرط الضروري للمغفرة ولا خلاص بدونها.
وَلْيَعْتَمِدْ انظر شرح (متّى ٣: ٦). أمر المسيح تلاميذه أن يعمدوا المؤمنين (متّى ٢٨: ١٩ ومرقس ١٦: ١٦) فقبول المعمودية إقرار المعتمد علناً بإيمانه أن يسوع هو المسيح وربه ومخلصه وهي رمز إلى تطهير القلب بالروح القدس وختم العهد الجديد وعلامة الاشتراك في كنيسة المسيح.
عَلَى ٱسْمِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لا يلزم من ذلك أن لا يعتمدوا باسم الآب والروح القدس كما أمر المسيح في (متّى ٢٨: ١٩) واقتصر بولس على طلب اعتمادهم باسم يسوع لأنهم نظراً لكونهم يهوداً كانوا يعترفون دائماً بالآب وروحه فكان إيمانهم ناقصاً من جهة كون يسوع هو المسيح ابن الله. ولما سلموا بذلك واعترفوا بخطاياهم وقصدوا أن يتركوها وأن يتخذوا المسيح فادياً ومبرراً ورباً ودياناً في اليوم الأخير كانوا أهلاً لقبول المعمودية المسيحية دلالة على اتحادهم بالمسيح وكنيسته وهذا على وفق ما ذُكر في (ص ١٩: ٥).
وذكر بطرس المعمودية كأمر معلوم لأن يوحنا المعمدان مارسها منذ سنين وكذلك يسوع وتلاميذه.
لِغُفْرَانِ ٱلْخَطَايَا كلها لا خطيئة صلب المسيح فقط. ونوال هذا الغفران غاية التوبة والمعمودية فالتوبة شرط ضروري للمغفرة والمعمودية واجبة لأن المسيح أمر بها فلا قوة لها في نفسها على إزالة الخطيئة.
فَتَقْبَلُوا عَطِيَّةَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ إضافة العطية إلى الروح بيانيّة والمعنى فتأخذوا عطية هي الروح القدس. والذي ينالونه هو الذي يلزمه لتجديد قلوبهم وتقديسها والتعزية وراحة الضمير فلا يقتضي ذلك أن ينالوا موهبة المعجزات كالتكلم بألسنة غريبة وما شاكل ذلك لأن تلك كانت تُعطى أحياناً لا دائماً. فالوعد بذلك الروح لا ينفي أنهم قبلوا بعض تأثيراته قبلاً لأن إتيانهم إلى ذلك المكان وإصغاءهم إلى الوعظ ونخس قلوبهم وسؤالهم عن الخلاص من تأثيراته فتكون تلك العطية مكملة لفعل الله في قلوبهم لكي يأتوا بأثمار الروح التي هي «مَحَبَّةٌ فَرَحٌ سَلاَمٌ، طُولُ أَنَاةٍ لُطْفٌ صَلاَحٌ، إِيمَانٌ وَدَاعَةٌ تَعَفُّفٌ» (غلاطية ٥: ٢٢ و٢٣).
٣٩ «لأَنَّ ٱلْمَوْعِدَ هُوَ لَكُمْ وَلأَوْلاَدِكُمْ وَلِكُلِّ ٱلَّذِينَ عَلَى بُعْدٍ، كُلِّ مَنْ يَدْعُوهُ ٱلرَّبُّ إِلٰهُنَا».
يوئيل ٢: ٢٨ وص ٣: ٢٥ ص ١٠: ٤٥ و١١: ١٥ و١٨: و١٤: ٢٧ و١٥: ٣ و٨ و١٤ وأفسس ٢: ١٣ و١٧
لأَنَّ ٱلْمَوْعِدَ بالروح القدس.
هُوَ لَكُمْ وَلأَوْلاَدِكُمْ أي لكم أنتم اليهود جميعاً بناء على كونكم شعب الله المختار وإن كنتم قد صلبتم المسيح. وهذا كقول يوئيل الذي سبق الكلام عليه (يوئيل ٢: ٢٨) وهو أيضاً مثل ما في (إشعياء ٤٤: ٣ و٥٩: ٢١).
لِكُلِّ ٱلَّذِينَ عَلَى بُعْدٍ أي الأمم الذين سُموا أيضاً «أَجْنَبِيِّينَ عَنْ رَعَوِيَّةِ إِسْرَائِيلَ، وَغُرَبَاءَ عَنْ عُهُودِ ٱلْمَوْعِدِ» (أفسس ٢: ١٢). وما قيل هنا موافق للنبوءات في (إشعياء ٢: ٢ و٤٠: ٥ و٥٤: ٤ وميخا ٤: ١ و٢ وعاموس ٩: ١٢) وما في العهد الجديد (ص ١٠: ٤٥ و١١: ١٥ - ١٨ و١٤: ٢٧). ولم يكن بطرس وسائر الرسل يعرفون أن الأمم يستطيعون أن يكونوا مسيحيين ما لم يقبلوا أولاً الرسوم اليهودية وعسر عليهم أن يسلموا باستغناء الأمم عن الختان وحفظ سنن موسى لكي يُقبَلوا في الكنيسة المسيحية.
كُلِّ مَنْ يَدْعُوهُ ٱلرَّبُّ دعوة الله للإنسان أصل حصوله على الإيمان والخلاص لا الاتفاق ولا إرادته البشرية. وتلك الدعوة نعمة منه تعالى وهي ظاهرة للحواس وباطنة للقلب وتُعرض على الإنسان بواسطة الإنجيل والمبشرين الذين ينادون به وبواسطة الروح القدس. ولا بد أن يتم قصد الله في كل نفس اختارها ودعاها.
٤٠ «وَبِأَقْوَالٍ أُخَرَ كَثِيرَةٍ كَانَ يَشْهَدُ لَهُمْ وَيَعِظُهُمْ قَائِلاً: ٱخْلُصُوا مِنْ هٰذَا ٱلْجِيلِ ٱلْمُلْتَوِي».
وَبِأَقْوَالٍ أُخَرَ كَثِيرَةٍ يتضح من هذا أن ما ذُكر هنا ليس سوى جزء مما وعظ به الرسل ذلك اليوم وأنه هو الأهم.
كَانَ يَشْهَدُ لَهُمْ بصحة الحوادث التي ذكرها والمواعيد التي أوردها والخطر من إهمال الإنذار والترحيب بالذين يتوبون ويؤمنون.
وَيَعِظُهُمْ أي يحثهم على قبول دعوة الله للخلاص.
ٱخْلُصُوا الخ هذا غاية وعظه. فهم مطالبون بأن يستعملوا الوسائط التي أعدها الله للنجاة باستفراغ المجهود وباعتزالهم الأشرار كما يأتي.
مِنْ هٰذَا ٱلْجِيلِ ٱلْمُلْتَوِي أي من مشاكله يهود هذا العصر. وهذا إنذار بالخطر من الاقتداء بغير المؤمنين في الآراء والإعمال لأن الذي يشاركهم في الرأي والعمل يشاركهم في النقمة والعقاب. وكان يهود ذلك العصر موصوفين بكثرة ارتكاب الآثام (متّى ١١: ١٦ - ١٩ و١٢: ٣٩ - ٤٢ و١٦: ٤ ومرقس ٨: ٣٨) وأعلنوا شرهم برفضهم المسيح وصلبهم إيّاه وصعب على الموعوظين أن يخلصوا من ذلك الجيل لأن رؤساء الفريسيين كانوا كثيرين الهيبة والسلطة على الشعب. ووصف ذلك الجيل بالالتواء لأنه أبى الرشد إلى طريق الحق والاستقامة. ولنا مما مر ثلاث فوائد:
- الأولى: أنه من أراد أن يخلص فعليه أن يجتهد في خلاص نفسه.
- الثاني: أن الإنسان في خطر شديد من غرور العالم والاقتداء بالرفاق الأشرار لئلا يقودوه إلى الهلاك إما بالهزء أو التملق أو التهديد ولعل الخطر من ذلك لم يكن يومئذ أعظم من الخطر منه اليوم.
- الثالثة: أنه على من يرغب في الخلاص أن يحترز من مشاكلة العالم ويرضى أن يكون مبغضاً ومهاناً ومضطهداً بغية المجد الأبدي والسعادة السرمدية.
٤١ «فَقَبِلُوا كَلاَمَهُ بِفَرَحٍ، وَٱعْتَمَدُوا، وَٱنْضَمَّ فِي ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ نَحْوُ ثَلاَثَةِ آلاَفِ نَفْسٍ».
كَلاَمَهُ في مغفرة الخطايا بيسوع المسيح.
بِفَرَحٍ قبلوا كلامه بفرح لأنهم وجدوا به طريق النجاة من الخطر الذي أحزنهم وراحة الضمير من أثقاله.
وَٱعْتَمَدُوا طوعاً لأمر المخلص (متّى ٢٨: ١٩) وبياناً لتوبتهم وإيمانهم بالمسيح وختماً لتعهدهم ودخولهم في الكنيسة المنظورة.
وَٱنْضَمَّ إلى جماعة المؤمنين بالمسيح بالمعمودية كما تدل القرينة.
فِي ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ أي يوم الخمسين. وكان ابتداء الوعظ في الساعة الثالثة من صباحه. ولم يذكر هنا شيئاً من كيفيّة المعمودية أبالرش كانت أم بالتغطيس والأرجح أنها كانت بالرش لأن الوقت يضيق بتغطيس ثلاثة آلاف والأحوال لا توافق ذلك. وأدخل الرسل أولئك الناس حالاً في الكنيسة إذ لم يكن ما يحملهم على الرياء أو ما يلقي الشك في إخلاصهم.
ثَلاَثَةِ آلاَفِ نَفْسٍ كان انضمام هؤلاء إلى الكنيسة باكورة الزرع الذي زرعه المسيح على ما في قوله «إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير» ونتيجة انسكاب الروح القدس في يوم واحد مع التبشير بالإنجيل وهو عربون ما يتوقع في العصور الآتية على وفق مواعيد الكتاب. وهذا تاريخ مختصر لنشوء الكنيسة المسيحيّة.
٤٢ «وَكَانُوا يُواظِبُونَ عَلَى تَعْلِيمِ ٱلرُّسُلِ، وَٱلشَّرِكَةِ، وَكَسْرِ ٱلْخُبْزِ، وَٱلصَّلوَاتِ».
ع ٤٤ ص ٢٠: ٧ و١١ و١كورنثوس ١٠: ١٦ ص ١: ١٤ وع ٤٦ ورومية ١٢: ١٢ وأفسس ٦: ١٨ وكولوسي ٤: ٢ وعبرانيين ١٠: ٢٥
وَكَانُوا يُواظِبُونَ هذا يدلّنا على أنهم بعد ما آمنوا واعتمدوا وأُهينوا واضطُهدوا بقوا ثابتين على الإيمان (مع علمنا من سرعة انضمامهم إلى الكنيسة) وثبوتهم أصح برهان على صحة إيمانهم وتجددّهم.
عَلَى تَعْلِيمِ ٱلرُّسُلِ لم تغنهم موهبة الروح القدس عن استعمال وسائط النعمة فكانوا يصغون إلى مواعظ الرسل.
وَٱلشَّرِكَةِ أي مشاركة الرسل وسائر التلاميذ في آمالهم وأهوالهم وأفراحهم وأحزانهم واحتمال الإهانات والأخطار والخسائر المالية وغير ذلك من الخارجيّات ومشاركتهم أيضاً في مواضيع الصلاة والتسبيح والمحادثة. وبُنيت هذه المشاركة على اتحادهم برأس واحد هو المسيح.
وَكَسْرِ ٱلْخُبْزِ الأرجح أن معنى ذلك أنهم كانوا يأكلون الطعام العادي جماعات كعائلة واحدة ويختموا تناول الطعام بتناول العشاء الرباني كما أن المسيح أكل مع الرسل الفصح أولاً ثم ختم ذلك بتناول العشاء الرباني. وكانت المدد بين مرات تناول ذلك العشاء قصيرة وكان تكراره كذلك وسيلة إلى تمثيل موت المسيح أمامهم ذبيحة عن خطاياهم (ص ٢٠: ٧ و١١ و١كورنثوس ١٠: ١٦). ولا يلزم مما ذُكر أنهم لم يشربوا يومئذ الكأس وأنه لا يجوز تقديمها للعامة لأن كسر الخبز عبارة اصطلاحية يراد بها تناول الشكلين.
وَٱلصَّلَوَاتِ الرغبة في الصلاة نتيجة انسكاب الروح القدس بدليل قوله تعالى بلسان نبيّه «وَأُفِيضُ عَلَى بَيْتِ دَاوُدَ وَعَلَى سُكَّانِ أُورُشَلِيمَ رُوحَ ٱلنِّعْمَةِ وَٱلتَّضَرُّعَاتِ» (زكريا ١٢: ١٠) والاتحاد في الحس الباطن يحمل على الاتحاد في التضرع لله. وأتوا ذلك أيضاً امتثالاً لأمر الرب في بشارة متّى (متّى ١٨: ١٩). ومثل هذا الاتحاد في الصلاة لا ينفك أبداً علامة حياة الكنيسة ونموها ورغبتها وهي آية حضور الروح القدس فيها. وإهمال الصلاة الجمهورية علامة الفتور في الدين وانفصال الروح القدس عن البيعة. والأمور الأربعة المذكورة في هذه الآية هي الأعمال الأولى في بدء كنيسة المسيح الأولى بعد الاعتراف بالإيمان بواسطة المعمودية كما مرّ في (ع ٤١).
٤٣ «وَصَارَ خَوْفٌ فِي كُلِّ نَفْسٍ. وَكَانَتْ عَجَائِبُ وَآيَاتٌ كَثِيرَةٌ تُجْرَى عَلَى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ».
مرقس ١٦: ١٧ وص ٤: ٢٣ و٥: ١٢
خَوْفٌ من الله الناتج عن الشعور بحضوره بينهم. وهذا الخوف منع الأعداء من أن يضطهدوا الكنيسة يومئذ وكان ذلك ضرورياً لها في طفوليتها.
فِي كُلِّ نَفْسٍ كان ذلك الخوف عامّاً للتلاميذ ولأعدائهم وعلته معرفتهم الحوادث المتعلقة بموت المسيح وقيامته والمعجزات التي صنعها الرسل باسمه وعجائب يوم الخمسين واتباع ألوف لذلك المذهب الحديث فضلاً عن تأثير روح الله في قلوب الجميع.
عَجَائِبُ وَآيَاتٌ كَثِيرَةٌ الخ انظر شرح (ع ٢٢) وهذا على وفق وعد المسيح للرسل (مرقس ١٦: ١٧). والأصحاح الثالث شرح لهذه الآية إذ فيه ذكر إحدى تلك العجائب بالتفصيل.
٤٤ «وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا مَعاً، وَكَانَ عِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مُشْتَرَكاً».
ص ٤: ٣٢ و٣٤
ٱلَّذِينَ آمَنُوا بأن يسوع هو المسيح وكان ذلك جوهر الفرق بينهم وبين غيرهم.
مَعاً في الفكر والحس فضلا عن كونهم جماعة واحدة ممتازة. ومع أنهم كانوا من أماكن مختلفة (ع ٥) اتفقوا في الصلاة والتسبيح وسمع التعليم. وهذا الاتحاد من أعظم وسائط النمو الروحي. وتأثير الإنجيل الحق هو جمع المتفرقين إلى واحد.
وَكَانَ عِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مُشْتَرَكاً كما كان بين المسيح وهو على الأرض والاثني عشر فإنهم كانوا كأهل بيت واحد. ولم يحسب أحد منهم ما له لنفعه الخاص بل حسبه كأمانة ينفقها عند الحاجة على إخوته في الكنيسة وأُشير إلى هذه الشركة المالية في (ص ٤: ١٢ و٥: ١ - ١١). ولم نجد من دليل على أن المسيح أو أحداً من الرسل أمر بذلك بل كان هو دليلاً على حب بعضهم لبعض وعلى أنه تبرع وكانت مقتضيات الأحوال يومئذ تُلجئ إليه.
٤٥ «وَٱلأَمْلاَكُ وَٱلْمُقْتَنَيَاتُ كَانُوا يَبِيعُونَهَا وَيَقْسِمُونَهَا بَيْنَ ٱلْجَمِيعِ، كَمَا يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ٱحْتِيَاجٌ».
إشعياء ٥٨: ٧
وَٱلأَمْلاَكُ وَٱلْمُقْتَنَيَاتُ كالأرضين والبيوت.
كَانُوا يَبِيعُونَهَا أي كان يبيعها الأغنياء لإفادة إخوتهم الفقراء. ولا بيّنة على أنهم باعوا كل أملاكهم بل كانو يبيعون ما تدعو إليه الحاجة.
وَيَقْسِمُونَهَا بَيْنَ ٱلْجَمِيعِ أي الفقراء والمحتاجين بينهم ولنا في هذا التقسيم خمس ملاحظات:
- الأولى: أنه لم يكن في غير أورشليم.
- الثانية: أنه تبرّع (ص ٥: ٤).
- الثالثة: أن المسيح لم يأمر به ولا الرسل في شيء من رسائلهم.
- الرابعة: أن الموزّع لم يكن إلا بعض المال (يوحنا ١٩: ٢٧ وأعمال ١٢: ١٢).
- الخامسة: أنه كان وقتياً نظراً لمقتضيات الأحوال. فإنه كان بينهم كثيرون من مؤمني اليهود الغرباء الذين أتوا إلى أورشليم للاحتفال بالفصح ولم يعزموا على الإقامة هنالك. ولكنهم بعدما آمنوا بالمسيح بغية التعليم الروحي ولم يقبلهم أقاربهم وأصحابهم من اليهود وكان سكان أورشليم الذين آمنوا بالمسيح ممنوعين من وسائل المعاش العادية. فإذاً ليس ذلك بدليل على أن من واجبات المسيحيين في كل مكان وزمان أن تكون الأملاك والمقتنيات مشتركة بينهم. فكانت الكنيسة في أول أمرها ممتازة بالسخاء على فقرائها وذلك من نتائج انسكاب الروح القدس في قلوبهم وبرهان على صحة ديانتهم أعظم من التكلم بالألسنة الغريبة والتنبوء لأن حب المال طبيعي لا يغلبه إلا النعمة. فعلى الكنيسة في كل عصر أن تعتني بفقرائها (متّى ٢٦: ١١).
كَمَا يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ٱحْتِيَاج هذا دليل على أنه لم يكن المبيع والتوزيع دفعة واحدة بل كان عند الحاجة على توالي الأوقات وكان الذين يقسمون الثمن هم الرسل (ص ٤: ٣٤ و٣٥).
٤٦ «وَكَانُوا كُلَّ يَوْمٍ يُواظِبُونَ فِي ٱلْهَيْكَلِ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. وَإِذْ هُمْ يَكْسِرُونَ ٱلْخُبْزَ فِي ٱلْبُيُوتِ، كَانُوا يَتَنَاوَلُونَ ٱلطَّعَامَ بِٱبْتِهَاجٍ وَبَسَاطَةِ قَلْبٍ».
لوقا ٢٤: ٥٣ وص ٥: ٤٢ ص ١: ١٤ ع ٤٢
كَانُوا أي المؤمنين بأن يسوع هو المسيح.
يُواظِبُونَ في أوقات الصلاة المعيّنة في الساعة الثالثة والساعة التاسعة من النهار.
فِي ٱلْهَيْكَلِ لأنه محل العبادة لآبائهم ولهم ولأنهم كانوا لا يزالون يمارسون الفروض والسنن اليهودية اقتداء بالمسيح وبناء على أن الديانة المسيحية تكملة للديانة الموسوية وزادوا على ذلك صلوات وترانيم جديدة وبعض الرسوم كالمعمودية والعشاء الرباني وذكر تعاليم المسيح. وكان الرسل يذهبون كذلك إلى الهيكل رغبة في تبشير الجموع هنالك بالمسيح وبياناً أن ديانة المسيح لا تنافي شريعة موسى. وما عرفت الكنيسة استغناءها عن الطقوس اليهودية وأنها أُكملت بالمسيح إلا شيئاً فشيئاً. وعرفوا ذلك من تعليم الروح القدس إيّاهم ومن الاختبار وتعاليم الرسل كما هي في رسائلهم.
يَكْسِرُونَ ٱلْخُبْزَ انظر شرح (ع ٤٢).
فِي ٱلْبُيُوتِ لأنه لم يكن في أورشليم بيت واحد يسع كل جماعة المسيح فيه والظاهر أنهم اجتمعوا فرقاَ في بيوت مختلفة لأجل التعليم والصلاة والترنم وكانوا يختمون الاجتماع بالأكل معاً كأهل بيت واحد ثم بتناول العشاء الرباني.
بِٱبْتِهَاجٍ من الجميع أغنياء وفقراء فالأغنياء فرحوا بالعطاء والفقراء بشكر المحسنين على إحسانهم. فديانة المسيح تهب لأتباعها من الابتهاج ما لا تهبه ديانة غيرها لتابعيها ونالت الكنيسة في أيامها الأولى ذلك مع أنها كانت محتقرة ومبغضة من الناس. وذلك على وفق ما أنبأ به المسيح (متّى ٥: ١٢ ويوحنا ١٦: ٢٢).
بَسَاطَةِ قَلْبٍ أي إخلاص لخلوّهم من الحسد والكبرياء وحب الذات ولقناعتهم وشكرهم. ولنا مما ذُكر أن الكنيسة المسيحية امتازت في أول أمرها بخمسة أمور:
- الأول: المواظبة على سمع كلام الله.
- الثاني: المحبة الأخوية.
- الثالث: السخاء الحامل على إنكار الذات.
- الرابع: الصلاة الجمهوريّة.
- الخامس: تناول الطعام وعشاء الرب معاً.
٤٧ «مُسَبِّحِينَ ٱللّٰهَ، وَلَهُمْ نِعْمَةٌ لَدَى جَمِيعِ ٱلشَّعْبِ. وَكَانَ ٱلرَّبُّ كُلَّ يَوْمٍ يَضُمُّ إِلَى ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّذِينَ يَخْلُصُونَ».
لوقا ٢: ٥٢ وص ٤: ٣٣ ورومية ١٤: ١٨ ص ٥: ١٤ و١١: ٢٤
مُسَبِّحِينَ لوقا ٢٤: ٥٣.
وَلَهُمْ نِعْمَةٌ لوقا ٢: ٥٢ (انظر الشرح).
لَدَى جَمِيعِ ٱلشَّعْبِ أي أكثر اليهود ولا بد أن الصدوقيين ورؤساء الكهنة مستثنون من ذلك لأنهم هيّجوا الشعب بعد قليل على المسيحيين كما هيّجوه قبلاً على المسيح وكانت علة تلك النعمة عند الشعب طهارة سيرتهم ووفرة إحسانهم إلى الفقراء. ولا ريب في أن الله وهبها لهم وسيلة إلى نمو الكنيسة في أول نشوئها.
وَكَانَ ٱلرَّبُّ كُلَّ يَوْمٍ يَضُمُّ يجب الإقرار بأن نجاح الكنيسة من عمل الله لا من الوسائط البشرية مع لزومها إذ ليس هو مما في طاقة البشر. وهذا كقول الرسول «أَنَا غَرَسْتُ وَأَبُلُّوسُ سَقَى، لٰكِنَّ ٱللّٰهَ كَانَ يُنْمِي. إِذاً لَيْسَ ٱلْغَارِسُ شَيْئاً وَلاَ ٱلسَّاقِي، بَلِ ٱللّٰهُ ٱلَّذِي يُنْمِي» (١كورنثوس ٣: ٦ و٧ انظر أيضاً أعمال ٥: ١٤ و١١: ٣٤) وهذا تاريخ الكنيسة الأولى أياماً كثيرة.
ٱلْكَنِيسَةِ أصل معناها الجماعة المدعوة لله الموقوفة له ثم أُطلقت على كل أهل محفل ومن ثم أُطلقت على المحفل نفسه (أعمال ١٩: ٣٩ و٤١) في الأصل اليوناني (١كورنثوس ١١: ١٨). والمراد بها هنا جماعة المؤمنين بالمسيح رجالاً ونساء ممن اعتمدوا اعترافاً بإيمانهم. وكانوا يجتمعون في مكان واحد للعبادة من صلاة وسجود وتسبيح ولسمع تعليم الرسل. والأمر الجوهري الذي جعل الجماعة كنيسة هو الإيمان بالمسيح ولا دليل على أنه كان للكنيسة نظام معيّن فتنظمت على حسب اقتضاء الأحوال.
ٱلَّذِينَ يَخْلُصُونَ نُعتوا بذلك لأن غاية دعوة الله إيّاهم وتوبتهم وإيمانهم وانضمامهم إلى الكنيسة نوال الخلاص وهؤلاء ممن خلصوا من هذا الجيل الملتوي (ع ٤٠) ومن سلطان الخطيئة وعاقبتها.
وما صدق على الكنيسة في أول أمرها صدق عليها منذ ذلك العهد إلى هذه الساعة وسيصدق عليها إلى النهاية وهو أن يضم إليها كل يوم الذين دعاهم الله وتابوا وآمنوا بالمسيح واعترفوا باسمه على الأرض حتى لا يبقى أحدٌ لم ينل الخلاص. والوسائل الأولى لم تزل هي الوسائل الكافية المؤثرة اليوم وهي الصلاة والتعليم الإنجيلي وفعل الروح القدس.
الأصحاح الثالث
إبراء الأعرج ع ١ إلى ١٠
١ «وَصَعِدَ بُطْرُسُ وَيُوحَنَّا مَعاً إِلَى ٱلْهَيْكَلِ فِي سَاعَةِ ٱلصَّلاَةِ ٱلتَّاسِعَة».
ص ٢: ٤٦ مزمور ٥٥: ١٧ وص ٢: ١٥ و١٠: ٣
قيل في (ص ٢: ٤٣) «وَكَانَتْ عَجَائِبُ وَآيَاتٌ كَثِيرَةٌ تُجْرَى عَلَى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ» واختار كاتب هذه السفر واحدة منها وذكرها بالتفصيل لأنها كانت وسيلة إلى وعظ بطرس اليهود ثانية.
وَصَعِدَ بُطْرُسُ وَيُوحَنَّا مَعاً كان بين هذين التلميذين ألفة قوية منذ أول تاريخهما فإن يوحنا مع أندراوس أنبأ بطرس بالمسيح وهما شريكان في الصيد (يوحنا ١: ٤١) ودُعيا إلى الرسولية معاً (لوقا ٥: ١٠) وذهبا معاً لتهيئة الفصح الأخير (لوقا ٢٢: ٨) وأدخل يوحنا بطرس إلى دار رئيس الكهنة (يوحنا ١٨: ١٦) وذهبا معاً إلى القبر (يوحنا ٢٠: ٦) ولما أنبأ يسوع بطرس بمستقبله سأله في الحال عن مستقبل يوحنا وكان معه (يوحنا ٢١: ٢١) وذهبا معاً إلى السامرة للتبشير (ص ٨: ١٤).
إِلَى ٱلْهَيْكَلِ جاء في خاتمة بشارة لوقا أن الرسل بعد صعود المسيح كانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله وجاء في (ص ٢: ٤٦) أن المؤمنين «كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل» وهذا دليل أن المسيحيين في أول أمرهم كانوا يذهبون مع سائر اليهود إلى الهيكل للعبادة ولم يهملوا الطقوس اليهودية إلا على توالي الأيام ولم يتركوها كل الترك إلا بعد أن هُدم الهيكل وبطلت بالضرورة الذبائح اليهودية وما يتعلق بها من الرسوم. ولم يكونوا يحسبون الذبائح التي تقدم فيه ذات فاعلية ترفع الخطيئة بل كانوا يحسبونها إشارة إلى الذبيحة الواحدة الكاملة التي قدمها المسيح على الصليب.
فِي سَاعَةِ ٱلصَّلاَةِ ٱلتَّاسِعَةِ أي وقت تقديم الذبيحة المسائية كما عيّن موسى فأحب اليهود أن يجعلوا وقتها وقتاً للصلاة أيضاً (عدد ٢٨: ٤ و٨).
٢ «وَكَانَ رَجُلٌ أَعْرَجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ يُحْمَلُ، كَانُوا يَضَعُونَهُ كُلَّ يَوْمٍ عِنْدَ بَابِ ٱلْهَيْكَلِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْجَمِيلُ لِيَسْأَلَ صَدَقَةً مِنَ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ ٱلْهَيْكَلَ».
ص ١٤: ٨ يوحنا ٩: ٨
ِأَعْرَجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّه ذكر ذلك بياناً أن علته ليست بمرض عرضي إنما هي داء خلقي لا تستطيع المعالجة البشرية إبراءه. فشفاء مثل ذلك رحمة أعظم من شفاء مصاب حديث ومعجزة بيّنة يستحيل أن تكون خداعاً وهي تشبه شفاء المسيح للمقعد عند بركة بيت حسدا إذ كان ذلك مصاباً منذ ثمان وثلاثين سنة (يوحنا ٥: ٥) وهذا منذ أربعين سنة منذ ميلاده (ص ٤: ٢٢).
يُحْمَلُ فإذاً كان عاجزاً عن المشي.
كَانُوا يَضَعُونَهُ... عِنْدَ بَابِ ٱلْهَيْكَلِ كانت العادة قديماً أن يتسول الفقراء عند باب الهياكل الوثنية كما يتسول أمثالهم عند باب هيكل إسرائيل إذ لم يكن يومئذ مستشفيات للمرضى ولا متصدقات للبائسين فكانوا مفتقرين إلى صدقات الأغنياء ولذلك قصدوا المحل الذي يُشاهدون فيه كثيراً وكانوا يقصدون أيضاً أبواب بيوت الأغنياء (لوقا ١٦: ٢٠) وجوانب الشوارع (مرقس ١٠: ٤٦ ولوقا ١٨: ٣٥ ويوحنا ٩: ١ - ٨).
ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْجَمِيلُ هيرودس الكبير الذي كان ملك اليهود في وقت ميلاد المسيح أصلح الهيكل وزيّنه حتى صار من أجمل أبنية العالم لأنه كان مبنياً من الرخام الأبيض وعليه كثير من صفائح الذهب (انظر شرح متّى ٢١: ١٢). ولم نتحقق أي الأبواب التسعة التي كانت للهيكل ذلك الباب المرجح أنه الباب الذي بين دار النساء ودار الأمم وهو على جانب الهيكل الشرقي تجاه وادي قدرون وهو أجمل جميع أبواب الهيكل وأكثر من سائرها داخلين ولذلك قصده المتسولون. قال يوسيفوس أن ذلك الباب كان مصنوعاً من النحاس الكورنثوسي مغشى بصفائح الذهب والفضة وعلوه خمسون ذراعاً وعرضه أربعون ذراعاً وكان يشغل فتحه وإغلاقه خمسة وعشرين رجلاً.
٣ «فَهٰذَا لَمَّا رَأَى بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا مُزْمِعَيْنِ أَنْ يَدْخُلاَ ٱلْهَيْكَلَ، سَأَلَ لِيَأْخُذَ صَدَقَة».
طلب المصاب من الرسولين كما يطلبه من غيرهما فلا دليل أنه عرفهما وتوقع منهما الشفاء.
٤ «فَتَفَرَّسَ فِيهِ بُطْرُسُ مَعَ يُوحَنَّا وَقَالَ: ٱنْظُرْ إِلَيْنَا!».
لا ريب في أن روح الله ألهمهما أن يفعلا ما فعلاه حينئذ تثبيتاً للتعليم الذي بشرا به ولعلهما رأيا شيئاً من إمارات وجهه تدل على أنه أهل لأن يكون موضوع المعجزة فغايتهما من كلامهما له أن يوجّها أفكاره إليهما ويحققا له شفقتهما عليه وإرادتهما أن يسعفاه وينشئا في قلبه أمل إحسانهما إليه ويبيّنا له أن ما سيناله من الشفاء منهما.
٥ «فَلاَحَظَهُمَا مُنْتَظِراً أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا شَيْئا».
هو توقع شيئاً من النقود. ووقوفهما أمامه ومخاطبتهما إياه أنهضا آماله.
٦ «فَقَالَ بُطْرُسُ: لَيْسَ لِي فِضَّةٌ وَلاَ ذَهَبٌ، وَلٰكِنِ ٱلَّذِي لِي فَإِيَّاهُ أُعْطِيكَ: بِٱسْمِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلنَّاصِرِيِّ قُمْ وَٱمْشِ».
ص ٤: ١٠
لَيْسَ لِي فِضَّةٌ وَلاَ ذَهَبٌ لا ريب في أن هذا أوقعه في اليأس منهما لأنه أي نفع يتوقع السائل من مفلس. لكن بطرس أراد أن يبيّن له أنه أراد أن يهبه مالاً لو استطاع وأنه لم يمنعه من ذلك سوى العُدم. ويظهر من قول بطرس هنا أن الرسل لم يتخذوا عمل المعجزات وسيلة إلى جمع المال لكنهم جروا على سنن قوله تعالى «مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا» وديانة المسيح لا تعطي تابعيها فضة أو ذهباً بل تهب لهم ما هو خير من ذلك وهو المواهب الروحية كشفاء النفس من داء الإثم والعجز الناشئ عنه.
ٱلَّذِي لِي لم يقصد أن قوة الشفاء ذاتية فيه بل أنه أودعها وأُوتمن عليها بدليل قوله ما معناه أن مصدر البرء يسوع المسيح.
بِٱسْمِ يَسُوعَ أي بسلطانه (مرقس ١٦: ١٧ و١٨). وعلينا هنا أن نلتفت إلى الفرق بين المسيح والرسل في عمل المعجزات فإنهم أتوها باسم غيرهم وأما يسوع ففعلها بقوة نفسه بدليل قوله للمفلوج: «لك أقول لك قم الخ» (لوقا ٥: ٢٤).
ٱلنَّاصِرِيِّ نُعت بذلك تمييزاً عمن شاركوه في اسمه كما مر في (ص ٢: ٢٢) وهو ما عُرف واشتهر به وكان عنوان صليبه «يسوع الناصري إلخ» فما قصد الناس به الإهانة جعله الله اسماً مكرماً. ولا ريب في أن هذا الأعرج كان قد سمع أنباء يسوع ولعله شاهده أحياناً يدخل الهيكل وهو جالس هناك يتسوّل.
قُمْ وَٱمْشِ أبان بطرس أنه لا يريد أن يشفيه ما لم يُرد الشفاء ويعمل ما يستطيعه وكان لا بد له من إيمان قوي ليعزم على القيام ويبذل جهده فيه طوعاً لأمر الرسول. وكذلك من يريد اليوم خلاص نفسه ولا بد له من مثل ذلك الإيمان والعزم والبشر عاجزون عن خلاص أنفسهم ولكن الله لا يخلصهم ما لم «يريدوا ويجتهدوا» (فيلبي ٢: ١٢ و١٣). في هذا العالم كثيرون من المحتاجين واحتياجاتهم مختلفة فإن لم يكن لنا فضة أو ذهب لم ترتفع المسؤولية عنا إذ يلزم أن نعطي مما لنا مثل إظهار مشاركتنا لهم في المصاب ومنحهم النصائح وتعليمهم الروحيات وأقل ما يمكننا هو أن نتكلم معهم ببشاشة أو بكلمة لطيفة ولعل ذلك أنفع لهم من الفضة والذهب.
٧ «وَأَمْسَكَهُ بِيَدِهِ ٱلْيُمْنَى وَأَقَامَهُ، فَفِي ٱلْحَالِ تَشَدَّدَتْ رِجْلاَهُ وَكَعْبَاهُ».
وَأَمْسَكَهُ بِيَدِه دلّ بذلك بطرس على صدقه وإخلاصه وإيمانه بأن له قوة الشفاء وبيان استعداده لمساعدة المصاب وتقوية رجائه وإيمانه بأنه يقوم. كذلك فعل المسيح في شفاء الولد (مرقس ٩: ٢٧).
تَشَدَّدَتْ رِجْلاَهُ هذا نتيجة إيمانه وطاعته (ع ١٦).
٨ «فَوَثَبَ وَوَقَفَ وَصَارَ يَمْشِي، وَدَخَلَ مَعَهُمَا إِلَى ٱلْهَيْكَلِ وَهُوَ يَمْشِي وَيَطْفُرُ وَيُسَبِّحُ ٱللّٰهَ».
إشعياء ٣٥: ٦
فَوَثَبَ من الفرح بالبرء والرغبة في امتحان قوته الجديدة.
وَصَارَ يَمْشيِ هذا ما زاد المعجزة غرابة فإنه لم يمشِ خطوة واحدة في حياته ثم قدر أن يمشي كمن اعتاد المشي بالممارسة.
إِلَى ٱلْهَيْكَلِ أي إلى داره حيث اعتاد الشعب الاجتماع ولا بد من أن الدار كانت حينئذ غاصة بالناس لأنه كان وقت الذبيحة المسائية ودخل مرافقاً للتلميذين وابتغى بالدخول تقديم الشكر لله في بيته على الشفاء.
وَيُسَبِّحُ ٱللّٰهَ كما يجب على المحسن إليه. وأظهر بذلك يقينه أن الله هو الذي شفاه وأن الرسولين لم يكونوا سوى آلة لشفائه.
٩، ١٠ «وَأَبْصَرَهُ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ وَهُوَ يَمْشِي وَيُسَبِّحُ ٱللّٰهَ. وَعَرَفُوهُ أَنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي كَانَ يَجْلِسُ لأَجْلِ ٱلصَّدَقَةِ عَلَى بَابِ ٱلْهَيْكَلِ ٱلْجَمِيلِ، فَٱمْتَلأُوا دَهْشَةً وَحَيْرَةً مِمَّا حَدَثَ لَهُ».
ص ٤: ١٦ و٢١
جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ الذي كان في دار الهيكل من أصحاب الرسل وأعدائهم ولا بد من أن الخبر شاع حالاً في المدينة (ص ٤: ١٦).
وَعَرَفُوهُ اعتادوا أن يشاهدوه يستعطي عند الباب وتحققوا من هو وفي أي حال كان فلم يكن من وسيلة للخداع ولا الانخداع لأن الذي شوهد مقعداً منذ أربعين سنة شاهدوه حينئذ يمشي.
فَٱمْتَلأُوا دَهْشَةً وَحَيْرَةً الدهشة هنا عجب يذهل الإنسان عن نفسه لغرابة ما يحدث. والحيرة العجب لجهل علة الحادث. وكان الناس يعلمون أن شفاءه بوسائط غير بشرية وبذلك تمت نبوءة إشعياء بما يحدث بعد مجيء المسيح في قوله «حينئذ يقفز الأعرج كالإيل» (إشعياء ٣٥: ٦).
اجتماع الشعب في رواق سليمان وخطاب بطرس لهم ع ١١ إلى ٢٦
١١ «وَبَيْنَمَا كَانَ ٱلرَّجُلُ ٱلأَعْرَجُ ٱلَّذِي شُفِيَ مُتَمَسِّكاً بِبُطْرُسَ وَيُوحَنَّا، تَرَاكَضَ إِلَيْهِمْ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ إِلَى ٱلرِّوَاقِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ «رِوَاقُ سُلَيْمَانَ» وَهُمْ مُنْدَهِشُونَ» .
يوحنا ١٠: ٢٣ وص ٥: ١٢
مُتَمَسِّكاً بِبُطْرُسَ وَيُوحَنَّا أتى ذلك بياناً لممنونيته لهم وشهادة للقوم أنهما هم المحسنان إليه ورغبته في أن لا يفارقهما بعد وفي أن يجعل نصيبه كنصيبهما في الدين المسيحي.
تَرَاكَضَ إِلَيْهِمْ من سائر أدوّر الهيكل ومن المدينة لما سمعوا نبأ المعجزة بغية أن يشاهدوا الذي شُفي ومن شفاه وكيف كان ذلك.
رِوَاقُ سُلَيْمَانَ انظر شرح (يوحنا ١٠: ٢٣) وهو في دار الأمم على جانب الهيكل الشرقي وهو أطول من الهيكل بخمس عشرة ذراعاً من كل من الجانبين وكانت دعائم سقفه مئة واثنين وستين عموداً.
مُنْدَهِشُونَ أي متعجبون جداً وذلك تأثير طبيعي من مشاهدة أمر غريب كهذا.
١٢ «فَلَمَّا رَأَى بُطْرُسُ ذٰلِكَ قَالَ لِلشَّعْبِ: أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلإِسْرَائِيلِيُّونَ، مَا بَالُكُمْ تَتَعَجَّبُونَ مِنْ هٰذَا، وَلِمَاذَا تَشْخَصُونَ إِلَيْنَا كَأَنَّنَا بِقُوَّتِنَا أَوْ تَقْوَانَا قَدْ جَعَلْنَا هٰذَا يَمْشِي؟».
كان بذلك الاجتماع الفرصة التي رغب فيها الرسل للتبشير بيسوع المسيح في دار الهيكل لكثيرين من الشعب مستعدين بتلك المعجزة للإصغاء إلى كلامهم.
قَالَ لِلشَّعْبِ كان كلام الرسول جواباً لسؤال في قلوبهم دلت عليه إمارات وجوههم وتعجبهم وسؤال بعضهم لبعض في شأن تلك المعجزة.
مَا بَالُكُمْ تَتَعَجَّبُونَ كما يظهر من أقوالكم ومنظركم. كان عجبهم في محله بالنظر إلى غرابة الأمر الواقع لكنهم لم يصيبوا بنسبتهم الفعل العجيب إلى الرسولين.
لِمَاذَا تَشْخَصُونَ إِلَيْنَا كأننا نحن فعلنا ذلك بقوتنا فالصواب أن تشخصوا إلى الله وتنسبوا الشفاء له.
أَوْ تَقْوَانَا أي بقدرة وهبها الله لنا جزاء على مخافتنا إياه وفقاً لما جاء في (يوحنا ٩: ٣١). يميل الإنسان طبعاً إلى الشهرة والمجد ولا سيما الذين من أصل حقير. وبطرس ويوحنا لم يكونا سوى صيادي سمك أصلاً فكانا عرضة لتلك التجربة لكنهما لم يعطياها مكاناً دقيقة واحدة بل حولا المجد عنهما إلى الله وحده.
١٣ «إِنَّ إِلٰهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، إِلٰهَ آبَائِنَا، مَجَّدَ فَتَاهُ يَسُوعَ، ٱلَّذِي أَسْلَمْتُمُوهُ أَنْتُمْ وَأَنْكَرْتُمُوهُ أَمَامَ وَجْهِ بِيلاَطُسَ، وَهُوَ حَاكِمٌ بِإِطْلاَقِهِ».
ص ٥: ٣٠ يوحنا ٧: ٣٩ و١٢: ١٦ و١٧: ١ متّى ١٢: ١٨ و٢٧: ٢ و٢٠ ومرقس ١٥: ١١ ولوقا ٢٣: ١٨ و٢٠ و٢١ ويوحنا ١٨: ٤٠ و١٩: ١٥ وص ١٣: ٢٨ لوقا ٢٣: ٢٠ ويوحنا ١٩: ٤ و١٢
إِلٰهَ أي لا فضل لنا في شيء إنما كل الفضل لله.
إِلٰهَ آبَائِنَا هذا بدل من إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب الآباء الأولين. وسمّي الله إله الآباء لأنهم عبدوه وهو أظهر لهم نفسه محباً لهم ومحامياً عنهم (تكوين ٢٦: ٢٤ و٢٨: ١٣ وخروج ٣: ٦ و١٥). وسماه كذلك بياناً أنه يظهر لأولئك الأولاد الرحمة والمحبة اللتين أعلنهما قديماً لآبائهم. وأن الرسولين لم يناديا ببدعة أو ديانة تنافي دين الآباء. ونسبا تلك المعجزة ليسوع إيضاحاً أنها تكملة لما وعد به أولئك الآباء (تكوين ١٢: ٣ وغلاطية ٣: ١٦).
مَجَّدَ فَتَاهُ يَسُوعَ هذا غاية المعجزة وهي إثبات أن يسوع هو المسيح كما أثبت أنه كذلك بإقامته وإصعاده إيّاه. فمعنى «مجد» هنا صدق دعواه وأعلن عظمته لأن تلك المعجزة علامة رضى الله ومسرته بابنه (يوحنا ١٧: ١ وأفسس ١: ٢٠ - ٢٢ وفيلبي ٢: ٩ - ١١ وعبرانيين ٢: ٩). ودعا يسوع «فتاه» وفقاً للنبوءة في (إشعياء ٤٢: ١) واقتبسها متى في الأعمال أربع مرات هنا وفي (ع ٢٦ وص ٤: ٢٧ و٣٠). ولقب «بفتى» الله أو «بعبده» لأنه أجرى مقاصد الله بغية فداء العالم. أهان الناس يسوع برفضهم مقاصد دعواه وقتلهم إياه ظلماً أما الله فمجده عكس ما فعلوا بإقامته إياه ثم بهذه المعجزة التي تثبت صحة قيامته لأنه لو كان باقياً ميتاً ما استطاع تلاميذه أن يفعلوا ما فعلوه باسمه.
ٱلَّذِي أَسْلَمْتُمُوهُ أَنْتُمْ غاية بطرس من هذا بيان أن صلب يسوع لا يستلزم أنه ليس بالمسيح وأنهم أسلموه إلى الرومانيين ليقتلوه.
وَأَنْكَرْتُمُوهُ أي أنكرتم أنه المسيح الملك (يوحنا ١٩: ١٥).
وَهُوَ حَاكِمٌ بِإِطْلاَقِهِ (متّى ٢٧: ١٧ - ٢٥ ولوقا ٢٣: ١٦ - ٢٣ ويوحنا ١٨: ٣٨ و١٩: ٤ و١٢). قابل بطرس أولاً فعلهم بفعل الله فإنه مجده وهم أسلموه وأنكروه وقابله ثانية بفعل بيلاطس فإنه حكم ببراءته وأراد إطلاقه أما هم فصرخوا «ليُصلب».
١٤ «وَلٰكِنْ أَنْتُمْ أَنْكَرْتُمُ ٱلْقُدُّوسَ ٱلْبَارَّ، وَطَلَبْتُمْ أَنْ يُوهَبَ لَكُمْ رَجُلٌ قَاتِلٌ».
مزمور ١٦: ١٠ ومرقس ١: ٢٤ ولوقا ١: ٣٥ وص ٢: ٢٧ و٤: ٢٧ ص ٧: ٥٢ و٢٢: ١٤
أَنْكَرْتُمُ دعواه أنه المسيح وقداسته وبراءته مع أن بيلاطس الوثني شهد له (مرقس ١٥: ٧ ولوقا ٢٣: ١٩).
ٱلْقُدُّوسَ هذا أحد نعوت المسيح.
ٱلْبَارَّ أي البريء من كل خطيئة. وحكم عليه مجلس السبعين بالموت بدعوى أنه مجدف (متّى ٢٦: ٦٥) بلا دليل ولا شاهد وشكوه إلى بيلاطس مدعين أنه مهيّج فتنة (لوقا ٢٣: ٢) فحكم أنه بريء مما اتهموه. والذي زاد إثمهم أنهم طلبوا قتله بعد أن حكم الحاكم ببراءته فأظهروا بذلك أنهم اعتمدوا أن يقتلوه بحجة أو بلا حجة.
طَلَبْتُمْ... رَجُلٌ قَاتِلٌ أي باراباس (متّى ٢٧: ٢١). فقابل يسوع البار القدوس بذلك القاتل إظهاراً لفظاعة إثمهم لإيثارهم رجلاً على ابن الله وقاتلاً على بريء.
١٥ «وَرَئِيسُ ٱلْحَيَاةِ قَتَلْتُمُوهُ، ٱلَّذِي أَقَامَهُ ٱللّٰهُ مِنَ ٱلأَمْوَاتِ، وَنَحْنُ شُهُودٌ لِذٰلِكَ».
عبرانيين ٢: ١٠ و٥: ٩ و١يوحنا ٥: ١١ ص ٢: ٢٤ و٣٢
رَئِيسُ ٱلْحَيَاةِ أي مصدر الحياة كلها ولا سيما الروحية وسلطان الحياة وواهبها لمن يشاء (يوحنا ١: ٤ و٥: ٢١ و٢٦ و١٤: ٦ و١كورنثوس ١٥: ٤٥ وعبرانيين ٢: ١٠ و١يوحنا ٥: ١١). ودعاه كذلك مقابلة له بباراباس سالب الحياة الذي آثروه وأجبروا بيلاطس على أن يجري مرادهم (مرقس ١٥: ٧ ولوقا ٢٣: ١٩).
قَتَلْتُمُوهُ لأنكم سبب قتله.
ٱلَّذِي أَقَامَهُ ٱللّٰهُ (ص ٢: ٢٤ و٣٢) هذا أعظم برهان على صحة دعوى يسوع. وكانت شهادة الرسل بقيامته معظم تبشيرهم.
١٦ «وَبِٱلإِيمَانِ بِٱسْمِهِ، شَدَّدَ ٱسْمُهُ هٰذَا ٱلَّذِي تَنْظُرُونَهُ وَتَعْرِفُونَهُ، وَٱلإِيمَانُ ٱلَّذِي بِوَاسِطَتِهِ أَعْطَاهُ هٰذِهِ ٱلصِّحَّةَ أَمَامَ جَمِيعِكُم».
متّى ٩: ٢٢ وص ٤: ١٠ و١٤: ٩ و١بطرس ١: ٢١
بِٱلإِيمَانِ أي إيمان الرسولين فإنهما فعلا المعجزة بإيمانهما به بمقتضى وعد المسيح في (متّى ١٧: ٢٠) ولا ينفي ذلك أنه كان للأعرج إيمان أيضاً حين قال له بطرس «باسم يسوع الناصري قم وامش» إلا أنه لم يتوقع في أول الأمر سوى شيء من النقود.
بِٱسْمِهِ اي باسم يسوع وهذا لا يفرق معناه عن معنى قولنا يسوع نفسه فالاسم هنا بمعنى الشخص أو الذات (ص ١: ١٥ و٤: ١٢ وأفسس ١: ٢١ ورؤيا ٣: ٤). فالرسولان لم يأخذا اسم يسوع كرقية أو طلسم ليفعلوا به العجائب إنما كان يسوع نفسه يصنعها بواسطتهما.
ٱلَّذِي تَنْظُرُونَهُ وَتَعْرِفُونَهُ أي تشاهدونه الآن صحيحاً وتعلمون أنه كان قبل ذلك مقعداً فإذاً لا ريب في حقيقة المعجزة. وأراد بطرس أيضاً أنه لا يكون ريب في علتها أنها هي ذلك المصلوب.
هٰذِهِ ٱلصِّحَّةَ أَمَامَ جَمِيعِكُمْ أن ما أصابه منذ أربعين سنة قد زال كما يمكنكم أن تحكموا بنظركم إيّاه واقفاً وماشياً أمامكم.
١٧ «وَٱلآنَ أَيُّهَا ٱلإِخْوَةُ، أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكُمْ بِجَهَالَةٍ عَمِلْتُمْ، كَمَا رُؤَسَاؤُكُمْ أَيْضاً».
لوقا ٢٣: ٣٤ ويوحنا ١٦: ٣ وص ١٣: ٢٧ و١كورنثوس ٢: ٨ و١تيموثاوس ١: ١٣
أَيُّهَا ٱلإِخْوَةُ أظهر بطرس غاية اللطف بدعوتهم إخوة بعدما أثبت عليهم أفظع الخطايا.
بِجَهَالَةٍ أي بجهلكم أن يسوع هو المسيح لانتظاركم أنه يكون ملكاً أرضياً غالباً منتصراً وهذا مما يجعل المغفرة لكم ممكنة. وذلك على وفق صلاة المسيح (لوقا ٢٣: ٣٤) ووفق قول بولس في خطيئته وخطيئة الأمم (ص ١٣: ٢٧ و١٧: ٣٠ و١تيموثاوس ٦: ١٣). ولم يذكر ذلك كعدو كافٍ لأنهم كانوا مذنبين لما كان لهم من الوسائط لمعرفة الحق لو أرادوا استعمالها فإنهم أبوا قبول البراهين التي قدمها يسوع فأغمضوا عيونهم وأغلقوا قلوبهم وخطئوا بأنهم أبغضوا محباً باراً وقتلوه. ولولا جهلهم أنه المسيح لما كان لخطيئتهم من مغفرة. فغاية بطرس من هذا الكلام أن يقودهم إلى التوبة بدفع اليأس عنهم وتبشيرهم بالرحمة والغفران.
كَمَا رُؤَسَاؤُكُمْ أَيْضاً هذا كقول بولس «لأَنْ لَوْ عَرَفُوا لَمَا صَلَبُوا رَبَّ ٱلْمَجْد» (١كورنثوس ٢: ٨) فإن هؤلاء الرؤساء السبب الأول لقتله فإنهم كانوا مملوئين حسداً وبغضاً فهيجوا الشعب عليه وكانوا ضالين ومضلين ومع ذلك كله لم يقطع رجاء خلاصهم بشرط التوبة.
١٨ «وَأَمَّا ٱللّٰهُ فَمَا سَبَقَ وَأَنْبَأَ بِهِ بِأَفْوَاهِ جَمِيعِ أَنْبِيَائِهِ، أَنْ يَتَأَلَّمَ ٱلْمَسِيحُ قَدْ تَمَّمَهُ هٰكَذَا».
لوقا ٢٤: ٤٤ وص ٢٦: ٢٢ مزمور ٢٢ وإشعياء ٥٠: ٦ و٥٣: ٥ الخ ودانيال ٩: ٢٦ و١بطرس ١: ١٠ و١١
فَمَا سَبَقَ وَأَنْبَأَ بِهِ في شأن حياة يسوع المسيح.
بِأَفْوَاهِ جَمِيعِ أَنْبِيَائِهِ حسب بطرس أقوال جميع الأنبياء شهادة للمسيح لأن «شَهَادَةَ يَسُوعَ هِيَ رُوحُ ٱلنُّبُوَّةِ» (رؤيا ١٩: ١٠ انظر شرح لوقا ٢٤: ٢٧).
قَدْ تَمَّمَهُ هٰكَذَا بإنكاركم وإنكار رؤسائكم إياه وتسليمه إلى الموت. فإذاً ما فعلتموه على وفق النبوءات برهان قاطع على أن يسوع هو المسيح. وبذلك دفع بطرس الاعتراض الذي من شأنه أن يخطر على بال كل يهودي وهو أنه لا يمكن أن يكون يسوع هو المسيح لأنه رُفض وصُلب لو لم يجر ذلك عليه لم يكن هو الذي شهد له وانبأ به جميع الأنبياء.
١٩ «فَتُوبُوا وَٱرْجِعُوا لِتُمْحَى خَطَايَاكُمْ، لِكَيْ تَأْتِيَ أَوْقَاتُ ٱلْفَرَجِ مِنْ وَجْهِ ٱلرَّبِّ».
ص ٢: ٣٨
فَتُوبُوا لأن خطيئتكم توجب التوبة عليكم وجهلكم لا يغلق دونكم أبواب المغفرة.
ٱرْجِعُوا عن عدم إيمانكم بالمسيح ورفضكم إيّاه إلى قبوله بالإيمان ومن الخطيئة إلى القداسة (ص ٩: ٣٥) ومن طريق الهلاك إلى طريق الخلاص. ولم يضف إلى كلامه ما أضافه في (ص ٢: ٣٨). لأن المعمودية أمر مسلم به إذ عُمّد ثلاثة آلاف في تلك الأيام علامة لتوبتهم.
لِتُمْحَى خَطَايَاكُمْ أي لتغفر ذنوبكم مغفرة تامة. وفي العبارة مجاز مبني على بعض عوائد تلك الأيام وهو أن المديون كان يكتب على لوح مغشى بالشمع بقلم من الحديد فكان الدائن متى استوفى ما له من الدين محا الكتابة بالطرف الآخر من ذلك القلم فلم يبق للكتابة من أثر. كذلك الله لا يذكر خطايا التائبين إليه فكأنه محاها بمغفرته (مزمور ٥١: ١ و٩ وإشعياء ٤٣: ٢٥ وإرميا ١٨: ٢٣ وكولوسي ٢: ١٤).
لِكَيْ تَأْتِيَ أَوْقَاتُ ٱلْفَرَجِ أي لكي تشتركوا في فوائد ملكوت المسيح فتنالوا راحة الضمير والشعور بالمصالحة لله وفرح الروح القدس ويقين الرجاء والتعزية الإلهية في الضيق.
كان اليهود جميعاً يتوقعون الفرج في أيام المسيح بنوال النجاة من عبودية الرومانيين والنجاح الزمني والراحة والمجد الدنيوي بناء على ما في النبوءات وحسبوا أن ذلك الفرج للأمة اليهودية بأسرها فحقق بطرس لهم أن الفرج قد أتت أوقاته وأنه فرج روحي وأن نواله بالتوبة والإيمان ولهذا لم يستفيدوا سوى القليل منهم فإذا آمنوا أتت أوقاته لهم كما أتت لغيرهم من المؤمنين.
مِنْ وَجْهِ ٱلرَّبِّ أي من الله الذي هو مصدر هذا الفرج. ذهب بعضهم إلى أن أوقات الفرج المذكورة في هذه الآية يراد بها أوقات الراحة السماوية التي التوبة والحصول على الغفران استعداد لها (عبرانيين ٤: ٩ - ١١).
تأتي أوقات الفرج الآن إلى كل مدينة وقرية وبيت وقلب متى وُجدت التوبة وقبول المسيح بالإيمان.
٢٠ «وَيُرْسِلَ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ٱلْمُبَشَّرَ بِهِ لَكُمْ قَبْلُ».
وَيُرْسِلَ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ لم يتضح هنا ما قصده بطرس أمجيء المسيح الأول هو أم مجيئه الثاني. فإن كان الأول فذكر بطرس إياه هنا لأنه بداءة الفرج الذي أطلقه على كل عمل الفداء من أوله إلى آخره. فإذاً يكون أوله بإرسال يسوع المسيح ليُعلن الله للناس ويعلمهم الأمور السماوية ويفديهم وتبقى أوقات الفرج إلى أن يأتي المسيح ثانية في نهاية العالم للدينونة. فبطرس دعا اليهود إلى التوبة لكي يشتركوا في كل فوائد ذلك الفرج. والأرجح أن الإرسال هنا هو المجيء الأول لأنه لم يقل ويرسل ثانية وقد ذُكر في ع ٢٦ أنه أتى إليهم. وإذا كان المراد المجيء الثاني كان المعنى توبوا لأن الله يريد أن تتوقعوا دائماً مجيء المسيح للدينونة وتستعدوا له كأنه على الباب.
ٱلْمُبَشَّرَ بِهِ لَكُمْ قَبْلُ بأنبياء العهد القديم ويوحنا المعمدان فإنم بشروا بمجيئه وصفاته وأعماله وموته وقيامته.
٢١ «ٱلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ ٱلسَّمَاءَ تَقْبَلُهُ، إِلَى أَزْمِنَةِ رَدِّ كُلِّ شَيْءٍ، ٱلَّتِي تَكَلَّمَ عَنْهَا ٱللّٰهُ بِفَمِ جَمِيعِ أَنْبِيَائِهِ ٱلْقِدِّيسِينَ مُنْذُ ٱلدَّهْرِ».
ص ١: ١١ متّى ١٧: ١١ لوقا ١: ٧٠
قصد بطرس هنا أن يدفع اعتراضاً خطر على بال اليهود وهو أن يسوع ليس هو المسيح لأن المسيح على اعتقادهم لا بد من أنه يبقى بالجسد على الأرض دائماً ملكاً منتصراً ولذلك قالوا «نَحْنُ سَمِعْنَا مِنَ ٱلنَّامُوسِ أَنَّ ٱلْمَسِيحَ يَبْقَى إِلَى ٱلأَبَدِ، فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَفِعَ ٱبْنُ ٱلإِنْسَانِ» (يوحنا ١٢: ٣٤).
ٱلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ ٱلسَّمَاءَ تَقْبَلُهُ أي تكون مسكناً له وانبغاء ذلك من مقتضيات القضاء الإلهي ومن انه أجدر به أن يصعد إلى السماء من أن يبقى على الأرض. وقد سبق المسيح إلى ذكر واحد من أسباب اتخاذه السماء مسكناً وهو إرساله الروح القدس (يوحنا ١٦: ٧) ومنها إجراء عمل الفداء وسياسة الكنيسة وشفاعته بشعبه باعتبار أنه رئيس الأحبار (رومية ٨: ٣٤ و١كورنثوس ١٩: ٢٥ وعبرانيين ٢: ٢٥ و٩: ٢٤ و١٠: ١٣ و١يوحنا ١: ١ و٢).
ٍأَزْمِنَةِ رَدِّ كُلِّ شَيْء أشار بهذا إلى أوقات انتصار الإنجيل التام بواسطة فعل الروح القدس وتبشير خدم المسيح حين تصير ممالك الأرض ملك الرب يسوع المسيح (رؤيا ١١: ١٥). وتجثو له كل ركبة ويعترف به كل لسان (١كورنثوس ١٥: ٢٥). وذلك كمال كل مقاصد الله في فداء العالم فيرجع العالم حيئنذ إلى حال الطهارة والطاعة والسعادة التي كان عليها قبل دخول الخطيئة.
والفرق بين «أوقات الفرج» و «أزمنة رد كل شيء» أنّ الأولى أوقات الإنجيل المتعلقة بمجيء الروح القدس وأن الثانية أوقات الدينونة والثواب والعقاب المتوقعة على مجيء المسيح ثانية. والتوبة هي استعداد للبركات الجزئية الأولى وللبركات الكلية الأخرى. وكان كلاهما مقترنين في أفكار التلاميذ الأولين. وكانوا قد شاهدوا الأولى وتوقعوا الأخرى بشوق شديد ورجاء وطيد (٢بطرس ٣: ١٢).
ٱلَّتِي تَكَلَّمَ عَنْهَا ٱللّٰهُ هذا قيد لذلك الرد فلا يلزم منه خلاص كل البشر بل كل ما وعد الله به من أول النبوءات إلى آخرها لأن الأنبياء أنبأوا بالرد المذكور. ذهب بعضهم إلى أن معنى هذه العبارة أن يسوع يبقى في السماء فلا تأتي أزمنة رد كل شيء إلا بعد إيمان اليهود فكأن بطرس قال توبوا وآمنوا لكي يأتي المسيح ثانية ويستعلن المجد الموعود به عند مجيئه. ولكن لا سند لهذا التفسير.
أَنْبِيَائِهِ ٱلْقِدِّيسِينَ (لوقا ١: ٧٠) هذا يشتمل على الوعد لآدم (تكوين ٣: ١٥) وإبراهيم (تكوين ٢٢: ١٨) وغيرهما من الأنبياء.
٢٢ «فَإِنَّ مُوسَى قَالَ لِلآبَاءِ: إِنَّ نَبِيّاً مِثْلِي سَيُقِيمُ لَكُمُ ٱلرَّبُّ إِلٰهُكُمْ مِنْ إِخْوَتِكُمْ. لَهُ تَسْمَعُونَ فِي كُلِّ مَا يُكَلِّمُكُمْ بِهِ».
تثنية ١٨: ١٥ و١٨ و١٩ وص ٧: ٣٧
هنا دعوة إلى التوبة وإلى قبول المسيح بناء على أقوال موسى وسائر الأنبياء فإن اليهود ادعوا أن قبول يسوع مسيحاً رفض لموسى بدليل قول البشير «فَشَتَمُوهُ وَقَالُوا: أَنْتَ تِلْمِيذُ ذَاكَ، وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّنَا تَلاَمِيذُ مُوسَى. نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ مُوسَى كَلَّمَهُ ٱللّٰهُ، وَأَمَّا هٰذَا فَمَا نَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هُوَ» (يوحنا ٩: ٢٨ و٢٩). فأبان بطرس أن موسى أنبأ بيسوع فرفضهم إيّاه رفض لموسى.
فَإِنَّ مُوسَى قَالَ كان قول موسى من أعظم ما يعتمده اليهود من الأقوال وذكره بطرس في هذه العبارة باعتبار أنه مشترع ونبي فإنه أنبأ بمجيء المسيح وأمرهم بالطاعة له. فإذاً لا يستلزم الثقة بأنبائه والطاعة لأمره.
لِلآبَاءِ أي سلفائهم القدماء من بني إسرائيل.
نَبِيّاً هذا مقتبس من (تثنية ١٨: ١٥ - ١٩) ومعنى «النبي» هنا من يعلن إرادة للناس وينوب عنه تعالى ويرسل بسلطانه. ويسوع المسيح باعتبار كونه كلمة الله أولى بأن يُدعى نبياً.
مِثْلِي لم يقصد موسى بهذا أن يكون المسيح مثله في كل شيء ولكن وجه المماثلة أنه مقام من الله كما كان موسى إلى أن أتى هو (عدد ١٢: ٦ - ٨) وأنه أعطى الإنجيل شريعة الرحمة كما أعطى موسى التوراة شريعة العدل وأنه أطلق إسرائيل الروحي من عبودية الشيطان والخطيئة كما أطلق موسى إسرائيل من عبودية مصر وأنه شفع في شعبه عند الله كما شفع موسى في شعبه على الأرض مراراً. وكون المسيح أعظم من موسى لا يمنع المشابهة بينهما. وبُيّنت أفضلية المسيح على موسى في (عبرانيين ٣: ٢ - ٦).
سَيُقِيمُ لَكُمُ ٱلرَّبُّ إذاً المسيح لم يدع النبوءة من تلقاء نفسه ولم يقمه الناس نبياً بل الرب.
مِنْ إِخْوَتِكُمْ أي الأمة اليهودية وهذا وفق النبوءات بأنه من نسل إبراهيم ونسل داود (انظر شرح متّى ١: ١).
لَهُ تَسْمَعُونَ أي يجب عليكم أن تطيعوه باعتبار أنه رسول الله بإعلان سماوي.
فِي كُلِّ مَا يُكَلِّمُكُمْ بِهِ واعتقد معنى ما جاء في التثنية لا لفظه (تثنية ١٨: ١٨). واعتقد اليهود أن هذه النبوءة تشير بنوع خاص إلى المسيح كما يتضح من سؤال لجنة مجلسهم الأكبر ليوحنا المعمدان (يوحنا ١: ٢١ و٢٥).
٢٣ «وَيَكُونُ أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ لاَ تَسْمَعُ لِذٰلِكَ ٱلنَّبِيِّ تُبَادُ مِنَ ٱلشَّعْبِ».
اكتفى بطرس بمعنى قول موسى دون لفظه إذ غايته بيان فظاعة المعصية وشدّة عقابها.
لاَ تَسْمَعُ لِذٰلِكَ ٱلنَّبِيِّ أي لا تطيع أوامره بناء على أنها أوامر الله فرفض كلامه ليس سوى رفض كلام الله الذي أرسله (لوقا ١٠: ١٦ ويوحنا ١٣: ٢٠).
تُبَادُ مِنَ ٱلشَّعْبِ في الأصل «أُطَالِبُهُ» (تثنية ١٨: ١٩) أي أعاقبه وكان أغلب العقاب عند الإسرائيليين إبادة المذنب من الشعب (خروج ١٢: ١٥ و١٩: ٣١ و٣٠: ٣٣ وعدد ١٥: ٣١ و١٩: ١٣ ولاويين ٧: ٢٠ و٢١ و٢٥ و٢٧). والإبادة أو القطع من شعب الله على الأرض رمز إلى القطع من النصيب السماوي ومقدمة له ما لم يُدفع بالتوبة. فأكد بطرس بما ذُكر لليهود أنهم عرضوا أنفسهم لأشد العقاب برفضهم مسيحهم وبقتلهم إيّاه بغية أن يتوبوا ويجدوا الرحمة. فما قاله بطرس على اليهود يصدق على كل الذين يعرضون عن المسيح ويعصون أوامره،
٢٤ «وَجَمِيعُ ٱلأَنْبِيَاءِ أَيْضاً مِنْ صَمُوئِيلَ فَمَا بَعْدَهُ، جَمِيعُ ٱلَّذِينَ تَكَلَّمُوا، سَبَقُوا وَأَنْبَأُوا بِهٰذِهِ ٱلأَيَّامِ».
وَجَمِيعُ ٱلأَنْبِيَاءِ أي كل الذين أنبأوا بما في المستقبل أنبأوا بالمسيح.
مِنْ صَمُوئِيلَ ذكر صموئيل لأنه أول الأنبياء الذين قاموا بعد موسى وهو منشئ مدرسة بني الأنبياء فإنه لم يقم نبي بين موسى وصموئيل لكن الله أعلن إرادته «بالأوريم والتميم» (خروج ٢٨: ٣٠ وعدد ٢٧: ٢١) ونبوءته عن المسيح في (٢صموئيل ٧: ١٣ - ١٦).قابل ذلك بما في (عبرانيين ١: ٥).
أَنْبَأُوا بِهٰذِهِ ٱلأَيَّامِ أي بحوادثها التي تتعلق بيسوع الناصري فإذاً كان على اليهود أن يسمعوا أقوال أولئك الأنبياء ويقبلوا المسيح بتوبتهم عما مضى.
٢٥ «أَنْتُمْ أَبْنَاءُ ٱلأَنْبِيَاءِ، وَٱلْعَهْدِ ٱلَّذِي عَاهَدَ بِهِ ٱللّٰهُ آبَاءَنَا قَائِلاً لإِبْراهِيمَ: وَبِنَسْلِكَ تَتَبَارَكُ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلأَرْضِ».
ص ٢: ٣٩ ورومية ٩: ٤ و٨ و١٥: ٨ وغلاطية ٣: ٢٦ تكوين ١٢: ٣ و١٨: ١٨ و٢٢: ١٨ و٢٦: ٤ و٢٨: ١٤ وغلاطية ٣: ٨
أَبْنَاءُ ٱلأَنْبِيَاءِ أي تلاميذهم وأتباعهم وهذا كما في (متّى ١٢: ٢٧). فبناء على كونهم أبناء الأنبياء وجب عليهم أن يسمعوا لهم ويغنموا مواعيد الرحمة المرسلة إليهم على أيديهم وجوهر ذلك أن يقبلوا المسيح.
وَٱلْعَهْدِ أي وأبناء العهد أي ذلك العهد الموجه إليهم بتوجيهه إلى إبراهيم إبيهم.
عَاهَدَ بِهِ ٱللّٰهُ آبَاءَنَا اعتبر الله إبراهيم نائب سائر الأنبياء فلما عاهده عاهد جميع الأنبياء.
قَائِلاً لإِبْراهِيمَ (تكوين ١٢: ٣ و٢٢: ١٨).
وَبِنَسْلِكَ أي المسيح كما صرّح بولس في (غلاطية ٣: ١٦).
تَتَبَارَكُ أي أن يسوع يكون واسطة لمنح كل البركات الأرضية والسماوية.
جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلأَرْضِ أي كل الناس اليهود والأمم.
٢٦ «إِلَيْكُمْ أَوَّلاً، إِذْ أَقَامَ ٱللّٰهُ فَتَاهُ يَسُوعَ، أَرْسَلَهُ يُبَارِكُكُمْ بِرَدِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عَنْ شُرُورِهِ».
متّى ١٠: ٥ و١٥: ٢٤ ولوقا ٢٤: ٤٧ وص ١٣: ٣٢ و٣٣ و٤٦ ع ٢٢ متّى ١: ٢١
إِلَيْكُمْ أَوَّلاً أنتم اليهود. ابتدأ هذا العهد يتم فيهم قبل سائر الشعوب. وكذلك أوصى المسيح تلاميذه بتبشيرهم أولاً (لوقا ٢٤: ٤٧ انظر أيضاً أعمال ١٣: ٤٦ ورومية ١: ١٦ و٢: ٩ و١٠ و١١: ١١).
إِذْ أَقَامَ ٱللّٰهُ إنجازاً للعهد. ومعنى «أقام» هنا كمعنى أقام في (ع ٢٢) أي أرسل لا أحيا بعد الموت.
فَتَاهُ يَسُوعَ أنظر شرح ع ١٣.
يُبَارِكُكُمْ وفاء بكل ما وعد به إبراهيم.
بِرَدِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عَنْ شُرُورِهِ هذا شرط كل العهود والمواعيد للآباء أو للأنبياء فلا منفعة منها إلا بالتوبة كما أنه لا شفاء للمسموم إلا بامتناعه عن شرب السم (إشعياء ص ٥٩ ومتّى ص ٢١)، فالامتناع عن الإثم ليس مجرد شرط البركة بل هو الجزء الأكبر منها لأن معظم تلك البركات ليس التحرر من رق الرومانيين بل من عبودية الخطيئة. ويقوم ردهم من الشرور إلى القداسة بإيمانهم بالمسيح. والنتيجة هنا كما في ع ١٩. وقد تمت النبوءة بمجيء المسيح فلم يبق عليهم إلا أن ينتفعوا به بالتوبة.
وهذه الموعظة تشبه موعظة يوم الخمسين في ثلاثة أمور مهمة:
- الأول: تقديم البراهين من الأسفار المقدسة أن يسوع هو المسيح.
- الثاني: إثبات الخطيئة على اليهود برفضهم مسيحهم وصلبهم إيّاه.
- الثالث: المناداة بالرحمة بواسطته والدعوة إلى التوبة والإيمان به.
الأصحاح الرابع
بطرس ويوحنا أمام المجلس ع ١ إلى ٢٢
١ «وَبَيْنَمَا هُمَا يُخَاطِبَانِ ٱلشَّعْبَ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمَا ٱلْكَهَنَةُ وَقَائِدُ جُنْدِ ٱلْهَيْكَلِ وَٱلصَّدُّوقِيُّونَ».
عدد ٤: ٢٣ ولوقا ٢٢: ٤ و٥٢ وص ٥: ٢٤
يُخَاطِبَانِ ٱلشَّعْبَ كانا يخاطبان في دار الأمم حيث اجتمع كثيرون من الشعب (ص ٣: ١١).
ٱلْكَهَنَةُ كان للكهنة سلطان في التعاليم الدينية فكان لهم أن يسمحوا بالتعليم جهراً أو يمنعوه وكانوا أربعاً وعشرين فرقة (١ أيام ٢٤: ١ - ١٩) وكانت كل فرقة تخدم أسبوعاً ويتعين ما لكل منها بالقرعة (لوقا ١: ٩).
وَقَائِدُ جُنْدِ ٱلْهَيْكَلِ كان معظم حرس الهيكل من اللاويين وكان عليهم أن يمنعوا الشغب والهيجان وكان قائدهم لاوياً لا من الرومانيين لأن قائد الجند الروماني لم يحضر الهيكل إلا وقت الفتنة الشديدة (ص ٢١: ٣١).
ٱلصَّدُّوقِيُّونَ أحد أحزاب اليهود الثلاثة المشهورة انظر شرح (متّى ٣: ٧) وكانوا مغتاظين من تعليم الرسل أكثر من سواهم لأن ذلك التعليم كان منافياً كل المنافاة لمبدإ الصدوقيين الخاص وهو أنه لا قيامة فإذا ثبت أن يسوع قام فلا مانع من أن يقوم غيره أيضاً. أما الفريسيون فكانوا أكثر الناس مضادة ليسوع في حياته على الأرض لأنه كان ينفي تقليداتهم التي هي أعظم مبادئهم في مقاومة الرسل. والظاهر أن بعض الشعب الذين شاهدوا المعجزة وسمعوا وعظ الرسولين تحمس وذهب وأنبأ رؤساء الشعب المذكورين بما كان فأتى أولئك الرؤساء لمجرد المقاومة لا لتحقق صحة ما حدث.
٢ «مُتَضَجِّرِينَ مِنْ تَعْلِيمِهِمَا ٱلشَّعْبَ، وَنِدَائِهِمَا فِي يَسُوعَ بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلأَمْوَات».
متّى ٢٢: ٢٣ وص ٢٣: ٨
مُتَضَجِّرِينَ أبغضوا يسوع ودينه وهو حي على الأرض لأنه أبطل بعض تعاليمهم ووبخهم على أعمالهم وحط سلطانهم عن الشعب فتآمروا عليه ليقتلوه وأنقذوا مقاصدهم ثم اجتهدوا أن يخفوا نبأ قيامته برشوة حراس القبر الرومانيين (متّى ٢٨: ١٣). وكانوا يظنون أنهم لاشوا تعليم الناصري بقتلهم إيّاه لكنهم رأوا في تعليم الرسل ما نفى ذلك الظن وأبان لهم خيبتهم في المقاصد والاجتهاد.
مِنْ تَعْلِيمِهِمَا ٱلشَّعْبَ لم يكن همهم للخوف من أن الرسولين يضران الشعب بتعليمهما لأنهما أظهرا بشفاء واحد منهم أن غايتهما النفع لا الضرر إنما كان للخوف من انحطاط سلطانهم هم لأن الكهنة ادّعوا أنهم هم دون غيرهم معلمو الشعب. وغاظهم أن ذينك الجليليين علما بدون استئذانهم. ولم يبحثوا عن صحة المعجزة أو عدمها لكي يقفوا على برهان أنهما رسولا الله أو لا فاكتفوا بأنهما لم يسألاهم الإذن في التعليم.
وَنِدَائِهِمَا فِي يَسُوعَ بِٱلْقِيَامَةِ الخ غاظهم موضوع المناداة علاوة عن التعليم نفسه. وكان اليهود قد اتفقوا من الفريقين الصدوقيين والفريسيين على يسوع ليقتلوه فحزنوا جميعاً لما سمعوه من تجديد دعواه أنه هو المسيح واغتاظ الصدوقيون أكثر من الجميع لأن مناداة الرسولين بقيامة المسيح كانت تنفي عقيدتهم العظمى فكانت فرقتهم في خطر التلاشي بزيادة تلك المناداة. وعرف الرسولان أن تعليمهما هذا يهيّج عليهما غضب الرؤساء لكنهما صرحا به بكل شجاعة. ومن المحال أن هذين اللذين كانا قبل قليل من الجبناء يصيران الآن من أول الشجعان لو لم يكونا قد شاهدا المسيح عياناً بعد قيامته ونالا قوة من العلاء لكي يشهدا بما شاهدا.
٣ «فَأَلْقَوْا عَلَيْهِمَا ٱلأَيَادِيَ وَوَضَعُوهُمَا فِي حَبْسٍ إِلَى ٱلْغَدِ، لأَنَّهُ كَانَ قَدْ صَارَ ٱلْمَسَاءُ».
كانت المعجزة في الساعة التاسعة (ص ٣: ١) فلم يبق للرؤساء وقت قبل الغروب لالتئام المجلس الكبير بعدما شغل الرسولان سائر النهار بالوعظ.
٤ «وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا ٱلْكَلِمَةَ آمَنُوا، وَصَارَ عَدَدُ ٱلرِّجَالِ نَحْوَ خَمْسَةِ آلاَفٍ».
لوقا ١١: ٣١ وص ٢: ٤١ ويعقوب ١: ٢٠
لم تستطع مقاومة الرؤساء للرسولين وحبسهما أن يمنعا تأثير المعجزة والتعليم في قلوب الشعب لأن الروح جعل لها ذلك التأثير العظيم فإذا سُجن أصحاب الحق فالحق نفسه لا يُسجن.
ٱلْكَلِمَةَ التعليم في يسوع المسيح.
وَصَارَ عَدَدُ ٱلرِّجَالِ الخ الأرجح أنه أراد بذلك عدد النفوس كما في (ص ٢: ٤١) وذكر الرجال تغليباًً.
نَحْوَ خَمْسَةِ آلاَفٍ منهم مئة وعشرين آمنوا قبل يوم الخمسين (ص ١: ١٥) ومنهم ثلاثة آلاف آمنوا يوم الخمسين (ص ٢: ٤١) فهذا النمو السريع برهان حضور الروح القدس وقوته.
٥ «وَحَدَثَ فِي ٱلْغَدِ أَنَّ رُؤَسَاءَهُمْ وَشُيُوخَهُمْ وَكَتَبَتَهُمُ ٱجْتَمَعُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ».
رُؤَسَاءَهُمْ وَشُيُوخَهُمْ وَكَتَبَتَهُمُ هم الفرق الثلاث التي تألف منها مجمع السبعين فالرؤساء هم الكهنة والشيوخ هم رؤساء العشائر والكتبة هم علماء الشعب ومعلموه. وهذا المجلس حكم أعضاؤه على المسيح بالموت بدعوى أنه مجدف وأقنعوا بيلاطس أن يقتلوه فظنوا أنهم لاشوا تعليم يسوع بقتلهم إياه ولكنه بعد ثلاثة أيام من موته هالهم أولاً أنباء جندهم بقيامته فغطوا الخبر بالرشوة وهالهم ثانياً على ما لا ريب فيه نبأ ما حدث يوم الخمسين وهالهم ثالثاً خبر تلك المعجزة وما بُني عليها من الوعظ فرأوا من الواجب أن ينهضوا لمنع تأثيرها فدعوا إليها.
إِلَى أُورُشَلِيمَ حيث المجلس الذي يجتمعون فيه عادة وفي الكلام ما يدل على أن بعض الأعضاء لم يكونوا من سكان أروشليم.
٦ «مَعَ حَنَّانَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ وَقَيَافَا وَيُوحَنَّا وَٱلإِسْكَنْدَرِ، وَجَمِيعِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ عَشِيرَةِ رُؤَسَاءِ ٱلْكَهَنَة».
لوقا ٣: ٢ ويوحنا ١١: ٤٩ و١٨: ١٣
حَنَّانَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ انظر شرح (يوحنا ١١: ٤٩). كان حنان هو رئيس الأحبار القانوني منذ السنة السابعة للميلاد إلى الخامسة عشرة ثم نُقلت عنه لكن بقي له الاسم والسلطان فذُكر هنا أولاً نظراً إلى سنه وشرفه وبراعته.
قَيَافَا انظر شرح (يوحنا ١٨: ١٣) تولى رئاسة الكهنة من سنة ٢٤ ب. م إلى سنة ٣٦ ب. م وكان حنّان وقيافا مجتهدين في محاكمة يسوع فلا عجب من اجتهادهما في تسكيت اثنين من رسله ومنه انتشار تعليمهما في الشعب لأن إثبات دعوى يسوع إثبات لإثمهما في حكمهما عليه.
يُوحَنَّا وَٱلإِسْكَنْدَرِ لا نعلم من أمرهما شيئاً سوى أنهما من أقرباء حنّان وقيافا على الأرجح وعضوان من أعضاء المجلس الكبير فلزم من ذلك أنهما كانا من أرباب الاعتبار في أورشليم.
عَشِيرَةِ رُؤَسَاءِ ٱلْكَهَنَةِ مما يدل على أهمية هذه العشيرة ما ذكره يوسيفوس من أن خمسة منها تولى رئاسة الكهنة.
٧ «وَلَمَّا أَقَامُوهُمَا فِي ٱلْوَسَطِ، جَعَلُوا يَسْأَلُونَهُمَا: بِأَيَّةِ قُوَّةٍ وَبِأَيِّ ٱسْمٍ صَنَعْتُمَا أَنْتُمَا هٰذَا؟».
خروج ٢: ١٤ ومتّى ٢١: ٢٣ وص ٧: ٢٧
فِي ٱلْوَسَطِ أي وسط أعضاء المجلس ولعلهم ظنوا أن سجن الرسولين ليلة يخيفهما ويخضعهما للمجلس.
بِأَيَّةِ قُوَّةٍ قد سألوا المسيح قبلاً مثل هذه السؤال (متّى ٢١: ٢٣). لم ينكروا على الرسولين حقيقة الشفاء لأن الإنسان الذي شُفي كان حاضراً (ع ٩).
وَبِأَيِّ ٱسْمٍ أي بسلطان من. لم يسألوهما ذلك بغية الوقوف على الحق إذ لا بد من أنهم سمعوا ممن شاهدوا المعجزة أنهما صنعاها باسم يسوع المسيح (ص ٣: ٦) ورأوا أن كونهما خادعين من الأمور المسلمة عند الجميع ولم يخطر على بالهم أن يبحثوا عن أن ما فعلاه بيّنة على أنهما رسولا الله. والأرجح أنهم قصدوا بسؤالهم تخويف الرسولين لظنهم أنهم لا يتجاسران على الاعتراف بأنهما تلميذا من حُكم عليه وصُلب فينكران اسمه. وإن قالا أنهما فعلا المعجزة باسم يسوع حكموا عليهما بالتجديف أو السحر أو عصيان حكم الرؤساء.
٨ «حِينَئِذٍ ٱمْتَلأَ بُطْرُسُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَقَالَ لَهُمْ: يَا رُؤَسَاءَ ٱلشَّعْبِ وَشُيُوخَ إِسْرَائِيلَ».
مرقس ١٣: ١١ ولوقا ١٣: ١١ و١٢ و٢١: ١٤ و١٦ وع ٣١ وص ١٣: ٩
ٱمْتَلأَ بُطْرُسُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ راجع شرح (ص ٢: ٤). كان هذا الامتلاء تقوية له للمحاماة عن الحق أمام المجلس على وفق وعد المسيح وهو قوله «فَمَتَى أَسْلَمُوكُمْ فَلاَ تَهْتَمُّوا كَيْفَ أَوْ بِمَا تَتَكَلَّمُونَ، لأَنَّكُمْ تُعْطَوْنَ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَا تَتَكَلَّمُونَ بِهِ، لأَنْ لَسْتُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ بَلْ رُوحُ أَبِيكُمُ ٱلَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيكُمْ» (متّى ١٠: ١٩ و٢٠) قابل ذلك بما في (مرقس ١٣: ١١ ولوقا ٢١: ١٤ و١٥).
كان ما فعله رؤساء الكهنة والصدوقيون وسيلة إلى تمهيد السبيل لمناداة بطرس بأن يسوع قد قام أمام المجلس الذي حكم عليه كما أنه قد نادى في الهيكل أمام الشعب. ولا ريب في أن بطرس ذكر حينئذ إنكاره ليسوع ثلاث مرات أمام خدم ذلك المجلس فرغب في أنه يصلح ما أفسد على قدر الإمكان بالاعتراف به علانية.
يَا رُؤَسَاءَ ٱلشَّعْبِ خاطبهم بكل احترام كما أمر الإنجيل (متّى ٢٢: ٢١ ورومية ١٣: ٧ و١بطرس ٣: ١٥ - ١٧).
٩، ١٠ «٩ إِنْ كُنَّا نُفْحَصُ ٱلْيَوْمَ عَنْ إِحْسَانٍ إِلَى إِنْسَانٍ سَقِيمٍ، بِمَاذَا شُفِيَ هٰذَا، ١٠ فَلْيَكُنْ مَعْلُوماً عِنْدَ جَمِيعِكُمْ وَجَمِيعِ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ، أَنَّهُ بِٱسْمِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلنَّاصِرِيِّ، ٱلَّذِي صَلَبْتُمُوهُ أَنْتُمُ، ٱلَّذِي أَقَامَهُ ٱللّٰهُ مِنَ ٱلأَمْوَاتِ، بِذَاكَ وَقَفَ هٰذَا أَمَامَكُمْ صَحِيحاً».
ص ٣: ٦ و١٦ ص ٢: ٤٢
كان خطر عظيم على بطرس من إقراره بالحق وشهادته ليسوع في المجلس فكان سهلاً عليه أن يتخلص من ذلك الخطر بأجوبة ملتبسة لكنه لم يفعل ذلك بل صرح بالحق بشجاعة وأظهر أنه مستحق أن يلقب ببطرس أي صخر كما لقبه المسيح (متّى ١٦: ١٧ و١٨ ويوحنا ١: ٤٢). كان بطرس منذ مدة قصيرة كثير الجبانة أنكر المسيح خوفاً فما كان يمكن أن يحصل على هذا التغير لو لم يشاهد الرب عياناً قد قام ويتحقق صحة دعواه. فلو لم يكن المسيح قد قام ما كان من داع إلى اعتراف بطرس به واستحال أن يعرض نفسه للخسارة والعار والاضطهاد والموت فاحتماله ذلك يظهر أنه كان على يقين من أمر يسوع.
عَنْ إِحْسَانٍ أي شفاء المقعد. أشار المجلس إلى ذلك بقولهم «هذا» فذكره الرسول بما يستحقه. والعادة أن يفحص أرباب المجالس عن الإساءة لا عن الإحسان فأشار بطرس إلى أن ما فعلوه خلاف العادة.
هٰذَا يتضح من هذا أن الذي شُفي كان في الحضرة شاهداً أو مشاهداً.
بِٱسْمِ أي بقوة وسلطان كما في (ص ٣: ٦).
يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ قرن أحد هذين الاسمين بالآخر من أعظم ما يكرهه ذلك المجلس لأنه أنكر أن يسوع هو المسيح وبطرس صرح بأنه هو هو وهذا لا يصدر إلا عن جسارة عظيمة جداً.
ٱلنَّاصِرِيِّ كما كُتب في عنوان صليبه. ونعته بذلك للتقرير ولدفع كل التباس فأبان أن الذي حصل الشفاء باسمه هو الناصري المهان.
ٱلَّذِي صَلَبْتُمُوهُ أَنْتُمُ وإن كان الذي حكم عليه بالموت بيلاطس لأنكم أنتم العلة أيها الرؤساء أرباب هذا المجلس. كان بطرس قد نسب صلبه إلى الشعب (ص ٢: ٢٣ و٣: ١٤ و١٥) ونسبته إلى المجلس أولى لأنه هو الذي حكم عليه بالموت أولاً ثم هيّج الشعب على طلبه من الحاكم الروماني. ولما حكم عليه أرباب ذلك المجلس لم يتوقعوا أن يسمعوا بعد قليل بيان ذنبهم بذلك.
ٱلَّذِي أَقَامَهُ ٱللّٰهُ الذي دانوه هم برره الله لأن إقامة الله إيّاه بيّنت فساد حكمهم. فإذا أعلن بطرس ثلاثة أمور هي على غاية الكراهة عندهم الأول أن يسوع هو المسيح والثاني أنهم قتلة المسيح والثالث أن الله أقامه.
بِذَاكَ أي المسيح.
وَقَفَ هٰذَا أَمَامَكُمْ وهذا دليل ثان على أن الذي شُفي كان في الحضرة منظوراً لأنه أشار إليه وأبان أنه واقف أمامهم.
صَحِيحاً أعلن بهذا أن يسوع فضلاً عن أنه قام حاضر يفعل المعجزات ويشفي كما كان يفعل وهو على الأرض في الجسد.
١١ «هٰذَا هُوَ ٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي ٱحْتَقَرْتُمُوهُ أَيُّهَا ٱلْبَنَّاؤُونَ، ٱلَّذِي صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ».
مزمور ١١٨: ٢٢ وإشعياء ٢٨: ١٦ ومتّى ٢١: ٤٢ و١بطرس ٢: ٦
هذه الآية من المزمور ١١٨: ٢٢ واقتبسها المسيح قبلاً وأوضح أنها قيلت فيه (متّى ٢١: ٤٢ ولوقا ٢٠: ١٧) راجع الشرح هناك وانظر أيضاً (إشعياء ٢٨: ١٦ ورومية ٩: ٣٣ وأفسس ٢: ٢٠).
ٱحْتَقَرْتُمُوهُ هذا على وفق الأصل معنىً لا لفظاً.
أَيُّهَا ٱلْبَنَّاؤُونَ أراد بهم رؤساء اليهود الذين صاروا بوظيفتهم حفظة بيت الله الروحي الذي هو كنيسة إسرائيل فكانوا لذلك بمنزلة البنائين لكنيسة الله فلهذا كان عليهم أن يكونوا أول الفاحصين عن صحة دعوى يسوع والمعترفين بأنه المسيح والمجتهدين في توطيد مملكته وتوسيعها لكنهم جاءوا خلاف ذلك ولكن الله تم مقاصده على رغمهم. وما قاله بطرس وقتئذ شفاهاً كرره كتابة بعد نحو ثلاثين سنة من ذلك (١بطرس ٢: ٦ - ٨).
رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ هي أهم ما يكون في البناء وأوضح بطرس في الآية التالية بأي معنىً كان المسيح رأس الزاوية في بناء الله الروحي وذلك أنه هو ركن الخلاص يبني عليه المؤمنون رجاءهم النجاة من جهنم ونوال السماء.
أثبت بطرس من الكتب الإلهية أن يسوع هو المسيح لأنها أنبأت بأن الرؤساء يفعلون بالمسيح عين ما فعلوه بيسوع فرفضهم إيّاه ثبت بصحة دعواه أنه مختار الله أو رأس الزاوية.
١٢ «وَلَيْسَ بِأَحَدٍ غَيْرِهِ ٱلْخَلاَصُ. لأَنْ لَيْسَ ٱسْمٌ آخَرُ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، قَدْ أُعْطِيَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ، بِهِ يَنْبَغِي أَنْ نَخْلُصَ».
متّى ١: ٢١ وص ١٠: ٤٣ و١تيموثاوس ٢: ٥ و٦
عدل بطرس من هنا عن الكلام في شفاء الأعرج إلى موضوع أسمى وهو بيان خلاص أعظم من خلاص الجسد من المرض وهو خلاص النفس من الخطيئة خلاصاً أبدياً وهو موضوع الإنجيل كله وغاية كل من العهدين. فما ذُكر في الآية السابقة على سبيل المجاز ذُكر على سبيل الحقيقة وزيد عليه أن يسوع هو المخلص الوحيد.
وَلَيْسَ بِأَحَدٍ غَيْرِهِ أي به وليس إلا به لا كما اعتقد اليهود أنهم يخلصون بتسلسلهم من إبراهيم أو بطاعتهم لشريعة موسى أو ببرهم الذاتي فإنهم بدون المسيح هالكون وبه الخلاص الكامل.
ٱلْخَلاَصُ من الخطيئة وعواقبها (متّى ١: ١٢ ولوقا ٤: ١٨ وأعمال ٥: ٣١ ورومية ٨: ٢١ وغلاطية ٥: ١). فبطرس بعدما أنذر أرباب المجلس على ما ارتكبوه ما صلب المسيح أخذ يبشرهم بالخلاص بواسطته.
لأَنْ لَيْسَ ٱسْمٌ آخَرُ الخ هذه العبارة تعليل الذي قبلها أي بيان سبب عدم الخلاص بغير المسيح والسبب أن الله لم يعدّ مخلصاً للخطاة غيره لأنه هو الذي أُعطي ولم يُعط آخر. ومعنى قوله «أعطي بين الناس» أنه أُعلن من السماء للبشر وعُرف بينهم. والمراد «بالاسم» هنا الذات التي يدل هو عليها. والخلاص الذي أعده الله للناس إنما أعده بابنه لا بملاك ولا بغيره من المخلوقات وهذا كقول بولس «لأَنَّهُ يُوجَدُ إِلٰهٌ وَاحِدٌ وَوَسِيطٌ وَاحِدٌ بَيْنَ ٱللّٰهِ وَٱلنَّاسِ: ٱلإِنْسَانُ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ» (١تيموثاوس ٢: ٥). وهذا الاسم كافٍ وإن يكن وحيداً لأنه يهب الرجاء والسرور للأثمة الآيسين ودمه فدية عن ديننا وتطهير لنا من الدنس وشفاعته تأتينا بالنعمة في هذه الدار والقبول والمجد في دار الآخرة حتى أن الأطفال الذين يموتون قبل أن يعرفوا هذا الاسم أو يستطيعوا لفظه به يخلصون. وأشار بقوله «ينبغي» إلى قضاء الله الذي عيّن ذلك الاسم للخلاص. وجعل بقوله «نخلص» الرسل والرؤساء والشيوخ بمنزلة واحدة في الحاجة إلى الخلاص وفي إمكان أن يجدوه بيسوع وحده فيسوع المصلوب كان مخلصاً لصالبيه كما كان مخلصاً لمن وقفوا تحت الصليب يبكونه.
١٣ «فَلَمَّا رَأَوْا مُجَاهَرَةَ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا، وَوَجَدُوا أَنَّهُمَا إِنْسَانَانِ عَدِيمَا ٱلْعِلْمِ وَعَامِّيَّانِ، تَعَجَّبُوا. فَعَرَفُوهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ يَسُوعَ».
متّى ١١: ٢٥ و١كورنثوس ١: ٢٧
فَلَمَّا رَأَوْا مُجَاهَرَةَ خاب رجاء المجلس في أنه يخيف الرسولين بوقوفهما أمامه وسؤالهم إيّاهما لينكرا ما فعلاه أو يقولا ما يوجب عليهما الحكم.
بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا لم يذكر الكاتب شيئاً من كلام يوحنا ولكن من المحتمل أن يوحنا صدّق كلام بطرس بالقول أو بشهادة إمارات وجهه فحكموا بمجاهرته كمجاهرة بطرس.
إِنْسَانَانِ عَدِيمَا ٱلْعِلْمِ لم يتعلما في المدارس اليهودية كالكتبة ولم يجلسا عند أقدام الربانيين لتعلم الشريعة.
وَعَامِّيَّانِ أي من سفلة الناس أصلاً وبلا رتبة حالاً واستنتجوا ذلك من هيئتهما ولهجتهما فكان كلامهما وجراءتهما مما لا يتوقع من أمثالهما. وكان معظم انتصار الإنجيل منذ أول عهده إلى اليوم على أيدي مثل ذينك الرجلين (١كورنثوس ١: ٢٧).
فَعَرَفُوهُمَا الخ ذكروا ما نسوه وهو أنهم عهدوهما من تلاميذ يسوع والذي نبههم على ذلك تعجبهم مما فعلاه. ولا بد من أن كثيرين من أولئك الرؤساء شاهدوا مراراً أعمال يسوع وسمعوا تعليمه حين كان تلاميذه معه (متّى ٢١: ٢٣ ولوقا ١٨: ١٨ ويوحنا ١٢: ٤٢) وقيل أن يوحنا كان معروفاً عند رئيس الكهنة (يوحنا ١٨: ١٥). فذانك الرسولان وإن لم يكونا قد تعلما من الربانيين كانا قد تعلما من الرب يسوع شفاهاً ومن الروح القدس إلهاماً وكانا أيضاً واثقين بما تكلما به فهذا جعل لكلامهما قوة عظيمة. والسامعون اقتصروا على التعجب فلم يستفيدوا سواه.
الذي تكلم في هذا اليوم هو الذي تكلم في مساء اليوم الذي قبله في الهيكل وأقام في هذا عين الأدلة التي أقامها في ذاك ولكن آمن في اليوم السابق ألفان ولم يؤمن في هذا اليوم أحد وعلة قبول الحق في الأول الاستعداد وعلة عدمهِ عدمهُ.
١٤ «وَلٰكِنْ إِذْ نَظَرُوا ٱلإِنْسَانَ ٱلَّذِي شُفِيَ وَاقِفاً مَعَهُمَا، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ يُنَاقِضُونَ بِهِ».
ص ٣: ١١
لم يمكنهم أن ينكروا حقيقة المعجزة ولا نفعها كما أنهم لم يستطيعوا إنكار أن يسوع فتح عيني الأعمى (يوحنا ٩: ٢٤) ولم يجدوا شيئاً يشتكون به على الرسولين ولا ريب في أنهم امتلأوا غيظاً من خطاب بطرس فلو وجدوا في كلامه علة لعاقبوهما على قدر ما يستطيعون لكن قوة الحق أفحمتهم فصار الشاكون مشكوّين والقضاة بمنزلة المتهمين واللذان أسكتا مجلس اليهود المتكبر صيادا سمك من الجليل.
١٥ «فَأَمَرُوهُمَا أَنْ يَخْرُجَا إِلَى خَارِجِ ٱلْمَجْمَعِ، وَتَآمَرُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ».
ٱلْمَجْمَعِ أي المجلس. وجدوا أنه لا يليق بشرفهم أن يعترفوا بمغلوبيتهم أمام الرسولين المتهمين ولا أن يبقوا ساكتين وأخرجوهما لكي يتحاوروا للتوصل إلى ما يتخلصون به من تعربسهم. ولا عجب من أن لوقا عرف ما حدث في المجلس بعد خروج الرسولين لأن كثيرين من الكهنة آمنوا بتعليمهما فيمكن أنهم أخبروا بما صار (ص ٦: ٧) إن لم يكن قد ألهمه الروح القدس بلا واسطة.
١٦ «قَائِلِينَ: مَاذَا نَفْعَلُ بِهٰذَيْنِ ٱلرَّجُلَيْنِ؟ لأَنَّهُ ظَاهِرٌ لِجَمِيعِ سُكَّانِ أُورُشَلِيمَ أَنَّ آيَةً مَعْلُومَةً قَدْ جَرَتْ بِأَيْدِيهِمَا، وَلاَ نَقْدِرُ أَنْ نُنْكِرَ».
يوحنا ١١: ٤٧ ص ٣: ٩ و١٠
مَاذَا نَفْعَلُ كان يجب عليهم أن يقروا بخطيئتهم بقتل يسوع ويتشاوروا في ما يمكنهم من الإصلاح ويتخلصوا من عاقبة معصيتهم لأن المعجزة كانت برهاناً قاطعاً على صحة ما قاله الرسولان. والظاهر أنه لا أحد من أعضاء المجلس السبعين انتصر للحق أو أقر ببطلان مقاومة يسوع إنما اتفقوا جميعاً على التخلص من لوم الناس ومنع الديانة الجديدة من الانتشار.
بِهٰذَيْنِ ٱلرَّجُلَيْنِ كان مجلسهم معيناً للحكم بمقتضى البراهين فكان عليهم أن يطلقوا الرسولين المتهمين ولكن سؤالهم لم يكن عما يجب عليهم عدلاً أن يفعلوه عما كان موافقاً لهم.
آيَةً مَعْلُومَةً لم يمكنهم أن ينكروا تلك الآية أي شفاء المقعد لظهورها للجميع ولعدم كل ريب في صحتها.
وَلاَ نَقْدِرُ أَنْ نُنْكِرَ أي لو كان لنا من سبيل إلى الإنكار أنكرنا ولو كذبنا كما فعلنا بإنكار قيامة يسوع برشوة العسكر (متّى ٢٨: ١٣).
١٧ «وَلٰكِنْ لِئَلاَّ تَشِيعَ أَكْثَرَ فِي ٱلشَّعْبِ، لِنُهَدِّدْهُمَا تَهْدِيداً أَنْ لاَ يُكَلِّمَا أَحَداً مِنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا بَعْدُ بِهٰذَا ٱلٱسْمِ».
لِئَلاَّ تَشِيعَ هذا الذي خافوه أكثر من كل شيء لأن بطرس قد قال لهم «... ليكن معلوماً عند ... جميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع الناصري الخ».
لِنُهَدِّدْهُمَ اعتاد أعداء الحق أن يسكتوا بالتهديدات والظلم من لم يستطيعوا أن يسكتوه بالبراهين واكتفوا حينئذ بالتهديد على رغمهم لأنهم خافوا من الشعب لميله إلى الرسولين.
بِهٰذَا ٱلٱسْمِ أنف أعضاء المجلس فيما بينهم أن يذكروا اسم يسوع.
١٨ «فَدَعَوْهُمَا وَأَوْصَوْهُمَا أَنْ لاَ يَنْطِقَا ٱلْبَتَّةَ، وَلاَ يُعَلِّمَا بِٱسْمِ يَسُوعَ».
ص ٥: ٤٠
هذا أمر المجلس على وفق الحكم الذي اتفقوا عليه وهو يتضمن التهديد إذا خالفوه.
١٩ «فَأَجَابَهُمْ بُطْرُسُ وَيُوحَنَّا: إِنْ كَانَ حَقّاً أَمَامَ ٱللّٰهِ أَنْ نَسْمَعَ لَكُمْ أَكْثَرَ مِنَ ٱللّٰهِ، فَٱحْكُمُوا».
ص ٥: ٢٩
أظهر بطرس ويوحنا في جوابهما المجاهرة التي أظهراها في الخطاب وتيقنهما صحة ما شاهداه وأنهما مكلفان بالشهادة. ثم سألا القضاة أنفسهم أن يحكموا بأن الحق معهما بعصيان أمرهم.
أَمَامَ ٱللّٰهِ قابل الرسولان حكم المجلس بحكم الله وأشار إلى أنه حكم الله هو الحق والطاعة له الأولى وأن السؤال المهم عندهما ما استصوبه الله لا ما استصوبه المجلس أو غيره من الناس وأن لا حق إلا ما كان أمام الله.
أَنْ نَسْمَعَ أي نطيعكم.
أَكْثَرَ مِنَ ٱللّٰهِ هذا يستلزم أنهما لم يتكلما بسلطانهما فكأنهما قالا أمرنا الله أن نتكلم وأنتم تأمروننا بأن نسكت فأيّ يجب أن نطيعه فلو كان أعضاء المجلس خالين من الهوى لحكموا بإطاعة الله لكنهم ادعوا أنهم هم نواب الله يتكلمون بسلطانه نظراً لرتبتهم. لكنه كان للرسولين برهان أنهما هما المتكلمان بسلطان الله وهو المعجزة.
هذا المثال الأول لما جرى كثيراً في الكنيسة المسيحية من الاختلاف بين أوامر الرؤساء دينيين وسياسيين وحرية الضمير. وجواب بطرس هنا كجوابه وسائر الرسل بعد قليل وهو قولهم «يَنْبَغِي أَنْ يُطَاعَ ٱللّٰهُ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنَّاسِ» (ص ٥: ٢٩).
والمبدأ الذي وضعه بطرس حينئذ هو أن كلام الله في الكتاب أو الضمير هو المعول عليه في الأمور الدينية فوق كل ما سواه فالإنسان مسؤول لله وحده في الإيمان فلا سلطان لأحد سواه على قلب الإنسان والداً كان أم كنيسة أم مجمعاً أم غير ذلك من المخلوقات. وهذا المبدأ هو ركن إصلاح الكنيسة في القرن السادس عشر. والخلاف الذي وقع بين الرسولين وأعضاء مجلس السبعين لا يزال إلى الآن فالله يأمر بشيء والناس يأمرون بما ينافيه.
٢٠ «لأَنَّنَا نَحْنُ لاَ يُمْكِنُنَا أَنْ لاَ نَتَكَلَّمَ بِمَا رَأَيْنَا وَسَمِعْنَا».
ص ١: ٨ و٢: ٣٢ و٢٢: ١٥ و١يوحنا ١: ١ و٣
لاَ يُمْكِنُنَا أَنْ لاَ نَتَكَلَّمَ لعدة أسباب وهي أنهما تيقنا حق ما تكلما به وأن محبة الحق تجبر صاحبها على المناداة به وأنهما أُمرا من الله أن يتكلما بما تحققا (مرقس ١٦: ١٥ وأعمال ١: ٨). وقولهما هنا كقول بولس لأهل كورنثوس «ٱلضَّرُورَةُ مَوْضُوعَةٌ عَلَيَّ، فَوَيْلٌ لِي إِنْ كُنْتُ لاَ أُبَشِّرُ» (١كورنثوس ٩: ١٦).
بِمَا رَأَيْنَا وَسَمِعْنَا من أفعال يسوع وأقواله ولا سيما قيامته.
٢١ «وَبَعْدَمَا هَدَّدُوهُمَا أَيْضاً أَطْلَقُوهُمَا، إِذْ لَمْ يَجِدُوا ٱلْبَتَّةَ كَيْفَ يُعَاقِبُونَهُمَا بِسَبَبِ ٱلشَّعْبِ، لأَنَّ ٱلْجَمِيعَ كَانُوا يُمَجِّدُونَ ٱللّٰهَ عَلَى مَا جَرَى».
متّى ٢١: ٢٦ ولوقا ٢٠: ٦ و١٩ و٢٢: ٢ وص ٥: ٢٦ ص ٣: ٧ و٨
كرروا التهديد الذي في ع ١٨ ولولا خوفهم من الشعب لعذبوهما ولو وجدوا علّة شرعية لعاقبوهما بالضرب أو السجن.
ٱلْجَمِيعَ أي الأكثر.
يُمَجِّدُونَ ٱللّٰهَ على ما جرى لأنهم تحققوا صحة الشفاء لمعرفتهم الذي شُفي منذ سنين أنه أعرج وأنه كان حينئذ أمامهم صحيحاً وأنهم اعتبروا شفاءه بقوة الله لا بالسحر وأنه كان نعمة للمصاب وإعلاناً لهم أن تعليم الرسولين حق وهذا كله كان تمجيداً لله.
٢٢ «لأَنَّ ٱلإِنْسَانَ ٱلَّذِي صَارَتْ فِيهِ آيَةُ ٱلشِّفَاءِ هٰذِهِ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً».
ذكر الكاتب ذلك إظهاراً لعظمة المعجزة لأنه كلما طال المرض عسر شفاؤه وأن الوسائط البشرية عاجزة عن شفاء مثله وأنه لا وسيلة في ذلك إلى الخداع.
نتيجة شفاء الأعرج ونمو الكنيسة ع ٢٣ إلى ٣٧
٢٣ «وَلَمَّا أُطْلِقَا أَتَيَا إِلَى رُفَقَائِهِمَا وَأَخْبَرَاهُمْ بِكُلِّ مَا قَالَهُ لَهُمَا رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُّيُوخ».
ص ١٢: ١٢
رُفَقَائِهِمَا أي الرسل وسائر المسيحيين (ص ٢: ٤٤ و٤٥).
أَخْبَرَاهُمْ لكي يبهجاهم بعجز المجلس عن أضرارهما وليتحدوا معهما في الصلاة لله بغية الثبات إلى النهاية.
رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُّيُوخُ أي أعضاء المجلس.
٢٤ «فَلَمَّا سَمِعُوا، رَفَعُوا بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ صَوْتاً إِلَى ٱللّٰهِ وَقَالُوا: أَيُّهَا ٱلسَّيِّدُ، أَنْتَ هُوَ ٱلإِلٰهُ ٱلصَّانِعُ ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَٱلْبَحْرَ وَكُلَّ مَا فِيهَا».
لوقا ٢: ٢٩ و٢ملوك ١٩: ١٥
رَفَعُوا بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ صَوْتاً في الصلاة وهذا خير ملجإ للمتهدّدين والمضطهدين. فيجب أن لا تهمل الصلاة مهما كان لنا من المساعدة البشرية. ونحن نلجأ إليه تعالى لقدرته ومحبته ومواعيده. وكانت تلك الصلاة كأنها خارجة من قلب واحد مملوء غيرة لله ومحبة لأخيه.
أَيُّهَا ٱلسَّيِّدُ الخ هذه العبارة من (مزمور ١٤٦: ٦) وفيها تعظيم لله باعتبار قدرته على كل شيء وحقه أن يتصرف بهم كما يشاء بدليل أنه خلق العالمين ولهذا جعلوا ذلك مقدمة لصلاتهم تقوية لإيمانهم به. فمقدمتهم في هذه الصلاة كمقدمة نحميا في صلاته (نحميا ٩: ٦) ومقدمة حزقيا في صلاته (٢ملوك ١٩: ١٥) ومقدمة إرميا في صلاته (إرميا ٣٢: ١٧). فكون قدرة الله غير محدودة يحقق لنا أنه يجري كل مقاصده ويتم كل مواعيده ويحقق أيضاً بطلان مقاومة الأشرار إيّاه وأن الذين مع الله والله معهم ينتصرون لا محالة.
٢٥ «ٱلْقَائِلُ بِفَمِ دَاوُدَ فَتَاكَ: لِمَاذَا ٱرْتَجَّتِ ٱلأُمَمُ وَتَفَكَّرَ ٱلشُّعُوبُ بِٱلْبَاطِلِ؟».
مزمور ٢: ١ و٢
هذا من (مزمور ٢: ١ و٢).
ٱلْقَائِلُ بِفَمِ دَاوُدَ هذا برهان على أن داود كاتب هذا المزمور وأنه تكلم به بالوحي. واتخاذهم هذا الكلام في صلاتهم دليل على ثقتهم أنهم ينجحون في تبشيرهم وينتصرون على مضطهديهم لأن غاية هذا المزمور إعلان نصرة الحق على كل أعدائه. وفيه طلب إلى الله أن يكمل ما وعد به فيه من نصر ملكوت ابنه.
لِمَاذَا ٱرْتَجَّتِ ٱلأُمَمُ على المسيح والاستفهام هنا لتعجّب المتكلم وتوبيخ المعتدين لأن ارتجاجهم عبث ومهلك إيّاهم. فكل اجتهاد أعداء المسيح كان باطلاً لأن الله قصد أن يقيم مملكة ابنه ويؤيدها وهو أقوى منهم وأحكم وقادر أن يجعل مقاومتهم له وسيلة إلى تقدمه.
وَتَفَكَّرَ ٱلشُّعُوبُ بِٱلْبَاطِلِ يعمّ الأمم والشعوب كل صنوف الناس يهوداً وغيرهم والأمر الذي تفكروا به بالباطل منع تقدّم المسيح.
٢٦ «قَامَتْ مُلُوكُ ٱلأَرْضِ، وَٱجْتَمَعَ ٱلرُّؤَسَاءُ مَعاً عَلَى ٱلرَّبِّ وَعَلَى مَسِيحِه».
ما أنبأ به داود من جهة مقاومة الملوك والرؤساء كان قد تم حينئذ بمقاومة رؤساء اليهود.
قَامَتْ أشار بذلك إلى استعدادهم لمقاومة دعوى المسيح بعنف.
عَلَى ٱلرَّبِّ أي الآب الذي أرسل المسيح على الوجه الذي اختاره وهو خلاف الفكر الذي أراده الرؤساء.
عَلَى مَسِيحِهِ أي ممسوحه لأن الروح القدس مسحه لعمل الفداء (لوقا ٤: ١٨). والمقاومة للمسيح هي مقاومة للآب واحد ولأن إهانة الرسول إهانة الرسول إهانة للمرسل.
٢٧ «لأَنَّهُ بِٱلْحَقِيقَةِ ٱجْتَمَعَ عَلَى فَتَاكَ ٱلْقُدُّوسِ يَسُوعَ، ٱلَّذِي مَسَحْتَهُ، هِيرُودُسُ وَبِيلاَطُسُ ٱلْبُنْطِيُّ مَعَ أُمَمٍ وَشُعُوبِ إِسْرَائِيلَ».
متّى ٢٦: ٣ ولوقا ٢٢: ٢ و٢٣: ١ و٨ لوقا ١: ٣٥ و٤: ١٨ ويوحنا ١٠: ٣٦
هذا بيان أن نبوءة داود تمت بالمسيح.
فَتَاكَ ٱلْقُدُّوسِ انظر شرح (ص ٣: ١٣ و٣٦).
هِيرُودُسُ انظر شرح (لوقا ٢٣: ١ - ١٢) وهو ملك من ملوك الذين قاموا على المسيح ونائب عن الباقين.
وَبِيلاَطُسُ ٱلْبُنْطِيُّ (متّى ٢٧: ٢٦ ولوقا ٢٣: ٢٤ ويوحنا ١٩: ١٦) وهو من الرؤساء المشار إليهم في النبؤة.
مَعَ أُمَمٍ أي العسكر الروماني الوثني الذي سخر بالمسيح وصلبه (متى ٢٧: ٢٧ - ٣٥).
وَشُعُوبِ إِسْرَائِيلَ (متّى ٢٧: ٢٠) وهم بعض الشعوب المشار إليهم في النبؤة ونواب عن سائر الشعوب.
٢٨ «لِيَفْعَلُوا كُلَّ مَا سَبَقَتْ فَعَيَّنَتْ يَدُكَ وَمَشُورَتُكَ أَنْ يَكُونَ».
ص ٢: ٢٣ و٣: ١٨
انظر شرح (ص ٢: ٢٣ و٣: ١٨).
لِيَفْعَلُوا أي ليقتلوا المسيح وذلك غاية اجتماعهم لكنهم لم يريدوا أو يقصدوا أن يتمموا مشورة الله بل أرادوا وقصدوا خلافه ففعلوا ما فعلوه حسداً وبغضاً وإجابة لإلحاح البعض وأتوا ذلك اختياراً ولهذا أجرموا وإن كانوا قد أنفذوا ما عيّنه الله.
يَدُكَ أي قوتك في إقامة ملكوت المسيح.
مَشُورَتُكَ أي حكمتك في عمل الفداء (ص ٣: ١٨).
٢٩ «وَٱلآنَ يَا رَبُّ، ٱنْظُرْ إِلَى تَهْدِيدَاتِهِمْ، وَٱمْنَحْ عَبِيدَكَ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِكَلاَمِكَ بِكُلِّ مُجَاهَرَةٍ».
ع ١٣ و٣١ وص ٩: ٢٧ و١٣: ٤٦ و١٤: ٣ و١٩: ٨ و٢٦: ٢٦ و٢٨: ٣١ وأفسس ٦: ١٩
ٱنْظُرْ أي التفت. اقتصروا على هذا الطلب وتركوا الفعل لإرادته وحكمته ولم يطلبوا إهلاك أعدائهم ولا الحماية مما هددوهم به.
وَٱمْنَحْ عَبِيدَكَ أي امنحنا نحن عبيدك نعمة وشجاعة.
أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِكَلاَمِكَ قصدوا أن يتكلموا بدون التفات إلى تهديدات الناس وتوقعوا الخطر في ذلك السبيل ولم يسألوا الحماية بل النعمة والجرأة. نعم كان لهم شيء من الشجاعة ع ١٣ لكنهم أرادوا زيادتها ودوامها لأنهم عرفوا ضعف طبيعتهم.
٣٠ «بِمَدِّ يَدِكَ لِلشِّفَاءِ، وَلْتُجْرَ آيَاتٌ وَعَجَائِبُ بِٱسْمِ فَتَاكَ ٱلْقُدُّوسِ يَسُوعَ».
ص ٢: ٤٣ و٥: ١٢ ص ٣: ٦ و١٦ وع ٢٧
بِمَدِّ يَدِكَ لِلشِّفَاءِ هذا أمر ثان مما طلبوه ومعنى «مد اليد» هنا إعلان القوة. وسألوه قوة عمل المعجزات لا للوقاية من أعدائهم بل لخدمة المسيح ولتكون بيّنة على صحة تعليمهم ووسيلة لإقناع الناس بأن يسوع هو المسيح.
آيَاتٌ وَعَجَائِبُ كشفاء الأعرج.
بِٱسْمِ... يَسُوعَ ذلك الاسم الذي نهاهم الرؤساء عن التلفظ به (ع ١٩) وقصدوا هم أن ينادوا به.
٣١ «وَلَمَّا صَلَّوْا تَزَعْزَعَ ٱلْمَكَانُ ٱلَّذِي كَانُوا مُجْتَمِعِينَ فِيهِ، وَٱمْتَلأَ ٱلْجَمِيعُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ، وَكَانُوا يَتَكَلَّمُونَ بِكَلاَمِ ٱللّٰهِ بِمُجَاهَرَة».
ص ٢: ٢ و٤ و١٦: ٢٦ ع ٢٩
تَزَعْزَعَ ٱلْمَكَانُ كان ذلك علامة حسية لإجابة الله صلاتهم ولم يكن ذلك اتفاقاً لأنه حدث عند نهاية الصلاة. وما ذُكر دليل على فاعلية الصلاة باتحاد وحرارة. سألوا الله إعلان قوته فأعلنها بهز المكان وذلك مما لا يستطيعه إلا الله. وحدث مثل هذا يوم كان بولس وسيلا يترنمان ويصليان (ص ١٦: ٢٦).
وَٱمْتَلأَ ٱلْجَمِيعُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ سألوا الله المجاهرة بدينه فوهب لهم علة المجاهرة والفصاحة وكل الفضائل.
وَكَانُوا يَتَكَلَّمُونَ... بِمُجَاهَرَةٍ كما طلبوا وهذا نتيجة امتلائهم من الروح القدس. وما أتوه في أورشليم بعد ذلك على رغم تهديدات الرؤساء وأوامرهم دليل على أن تلك المجاهرة دامت لهم إجابة لتلك الصلاة.
٣٢ «وَكَانَ لِجُمْهُورِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَلْبٌ وَاحِدٌ وَنَفْسٌ وَاحِدَةٌ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّ شَيْئاً مِنْ أَمْوَالِهِ لَهُ، بَلْ كَانَ عِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مُشْتَرَكا».
ص ٥: ١٢ ورومية ١٥: ٥ و٦ و٢كورنثوس ١٣: ١١ وفيلبي ١: ٢٧ و٢: ٢ و١بطرس ٣: ١٨ ص ٢: ٤٤
لِجُمْهُورِ زاد عدد المؤمنين كثيراً وكانوا قبل ذلك نحو خمسة آلاف ع ٤ وما قيل فيهم سابقاً لم يزل جارياً فعلاً (ص ٢: ٤١ و٤٢ و٤٤).
قَلْبٌ وَاحِدٌ وَنَفْسٌ وَاحِدَةٌ أي كانوا كثيراً وكانوا قبل ذلك نحو خمسة آلاف كذلك إلا أن يقال «كان لهم قلب واحد ونفس واحدة». ودليل ذلك الاتحاد مواظبتهم على سمع تعليم الرسل والصلاة معاً وإظهار السخاء وعدم الانشغاف وطلب الترأوس.
وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقُولُ الخ أي ما دام غيره محتاجاً فأنكروا حب الذات قولاً وفعلاً وحسبوا ما لهم لنفع الجميع لا نفع صاحب المال خاصة أنظر شرح (ص ٢: ٤٤). والمحتاجون في الكنيسة دائماً فيجب عليها أن تعتني بهم بسخاء وإنكار الذات كما كان في الكنيسة الأولى.
٣٣ «وَبِقُوَّةٍ عَظِيمَةٍ كَانَ ٱلرُّسُلُ يُؤَدُّونَ ٱلشَّهَادَةَ بِقِيَامَةِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ، وَنِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ كَانَتْ عَلَى جَمِيعِهِمْ».
ص ١: ٨ و٢٢ و٢: ٤٧
هذا على وفق وعد المسيح للرسل بقوله «لكنكم ستنالون قوة» (ص ١: ٨). وكانت لهم قوة على قلوب الناس للإقناع بواسطة كلامهم والمعجزات التي صنعوها لإثباته ونالوا تلك القوة من الروح القدس.
ٱلشَّهَادَةَ بِقِيَامَةِ ٱلرَّبِّ قيامة الرب هو جوهر شهادتهم لبيان أن يسوع هو المسيح ولإرشاد الناس إلى الإيمان به لخلاص نفوسهم.
وَنِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ الخ أي نعمة الله وهي رضاه عنهم وهذه النعمة مصدر تأثير كلامهم في غيرهم لا لفصاحتهم أو بلاغتهم. وهي تشتمل أيضاً على مسرة الناس بهم كما في (ص ٢: ٤٧) والأول علة للثاني لأن رضى الله عنهم قدرهم على فعل المعجزة لمنفعة الشعب فأكسبهم النعمة لديه. وتلك النعمة جذبت قلوب الناس إليهم على وفق قول الحكيم «إِذَا أَرْضَتِ ٱلرَّبَّ طُرُقُ إِنْسَانٍ جَعَلَ أَعْدَاءَهُ أَيْضاً يُسَالِمُونَهُ» (أمثال ١٦: ٧). ونوال تلك النعمة نتيجة الاتحاد والمحبة على ما سلف ذكره.
٣٤ «إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدٌ مُحْتَاجاً، لأَنَّ كُلَّ ٱلَّذِينَ كَانُوا أَصْحَابَ حُقُولٍ أَوْ بُيُوتٍ كَانُوا يَبِيعُونَهَا، وَيَأْتُونَ بِأَثْمَانِ ٱلْمَبِيعَاتِ».
ص ٢: ٤٥
ما ذُكر هنا آية تلك النعمة.
لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدٌ مُحْتَاجاً لأن الأغنياء منهم قاموا بحاجات الفقراء الذين لا بد من وجود مثلهم في مثل ذلك الجمهور.
لأَنَّ كُلَّ ٱلَّذِينَ كَانُوا أَصْحَابَ حُقُولٍ الخ هذا علة أنه لم يبق المحتاجون منهم في احتياجهم. فكانت محبتهم للمسيح وللإخوة لأجله فوق حب المال. ولا يلزم مما قيل هنا أن أصحاب المال باعوا كل مقتنياتهم ولعل بعضهم فعل كذلك ولكن كلاً منهم فعل على قدر الحاجة وكان مستعداً أن ينفق كل ما له إذا اقتضت الحال انظر شرح (ص ٢: ٤٥). ولنا من هذا أن ديانة المسيح تعلم الإنسان السخاء وتنزع من قلبه حب المال الطبيعي المهلك وتجعل المؤمنين أهل بيت واحد وتحمل الإنسان على رحمة الفقراء والمصابين اقتداء برئيسها الذي «افتقر لأجلنا وهو الغني».
٣٥ «وَيَضَعُونَهَا عِنْدَ أَرْجُلِ ٱلرُّسُلِ، فَكَانَ يُوزَّعُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ كَمَا يَكُونُ لَهُ ٱحْتِيَاجٌ».
ع ٣٧ وص ٥: ٢ ص ٢: ٤٥ و٦: ١
وَيَضَعُونَهَا عِنْدَ أَرْجُلِ ٱلرُّسُلِ هذا مجاز والحقيقة أنهم كانوا يعطون الرسل أثمان ما باعوه لكي ينفقوا على المحتاجين في الكنيسة فاستطاع الرسل على القيام بذلك مدة كانت الكنيسة صغيرة لكنهم لما كبرت ثقل الحمل عليهم حتى لم يستطيعوا أن يحملوه (ص ٦: ١ و٢).
فَكَانَ يُوزَّعُ... كَمَا يَكُونُ لَهُ ٱحْتِيَاجٌ يتضح من هذا أنهم لم يجروا القسمة العامة دفعة ولم يشتركوا في كل الأموال بل أنفق الأغنياء على الفقراء على قدر الحاجة.
٣٦ «وَيُوسُفُ ٱلَّذِي دُعِيَ مِنَ ٱلرُّسُلِ بَرْنَابَا، ٱلَّذِي يُتَرْجَمُ ٱبْنَ ٱلْوَعْظِ، وَهُوَ لاَوِيٌّ قُبْرُسِيُّ ٱلْجِنْسِ».
ص ١١: ٢٣
أُورد يوسف مثلاً لما ذُكر من الموزعين ولعل تخصيصه بالذكر لأنه أجنبي الوطن ولأنه فاق غيره بالسخاء ولأنه اشتهر بعد ذلك بأنه مبشر.
ص ١١: ٢٢ و٢٤ و٣٠ و١٢: ٢٥ و١٣: ١ و٢ و٥٠ و١٤: ١٢ و١٥: ١٢ و١كورنثوس ٩: ٦ وغلاطية ٢: ١ و٩
دُعِيَ نظراً لما ظهر من صفاته كما دُعي أندراوس ويوحنا بابني الرعد (مرقس ٣: ١٧) وكما دُعي سمعان بطرس أي صخراً (يوحنا ١: ٤٢).
ٱبْنَ ٱلْوَعْظ ينتج من هذا أنه كان فصيح اللسان بليغاً قوي الحجة يعجب السامعين.
لاَوِيٌّ أي من سبط لاوي المعيّن من الله للخدمة الدينية وكان رجاله كهنة ولاويين فالكهنة هرون ونسله وسائرهم لاويون يساعدون الكهنة (عدد ص ٣ وتثنية ١٢: ١٨ و١٩ و١٨: ٦ - ٨ و١ايام ٢٣: ٢٤). ولم يكن لهذا السبط نصيب في أرض الميعاد كبقية الأسباط (عدد ١٨: ٢٠) لكن لم يُمنعوا من اشتراء أرضٍ إذا شاؤوا كما فعل إرميا وهو لاوي (إرميا ٣٢: ٧ - ١٢) وأخت برنابا كان لها بيت في أورشليم (أعمال ١٢: ٢٥) وكان التلاميذ يجتمعون فيه للصلاة (ص ١٢: ٢٥).
قُبْرُسِيُّ أي من قبرس وهي جزيرة كبيرة مخصبة في بحر الروم غربي سورية وسُميت قديماً كتّيم (تكوين ١٠: ٤ و٥ وعدد ٢٤: ٢٤) وكان فيها كثير من اليهود في عصر الرسل.
٣٧ «إِذْ كَانَ لَهُ حَقْلٌ بَاعَهُ، وَأَتَى بِٱلدَّرَاهِمِ وَوَضَعَهَا عِنْدَ أَرْجُلِ ٱلرُّسُلِ».
ع ٣٤ و٣٥ وص ٥: ١ و٢
أعلن ما أظهره من السخاء وإنكار الذات أهليته لأن يكون مبشراً بالإنجيل.
الأصحاح الخامس
خبر حنانيا وسفيرة ع ١ إلى ١١
١ «وَرَجُلٌ ٱسْمُهُ حَنَانِيَّا، وَٱمْرَأَتُهُ سَفِّيرَةُ، بَاعَ مُلْكا».
النبأ الآتي استثناء لما قيل في (ص ٤: ٣٢ و٣٤) وبيان أن وسائط النعمة لا تحقق صلاح الذين يحصلون عليها. ولا عجب من وجود بعض المرائين بين الكثيرين الذين اعترفوا بالدين المسيحي فإن الرسل لم يزيدوا على الاثني عشر وكان احدهم خائناً. وأنبأ المسيح بمثل ذلك بمثل الزوان والقمح (متّى ص ١٣) وفيه بيان أن التجارب أصابت الكنيسة من الداخل من طمع بعض أعضائها كما كانت قد أصابتها من الخارج من اضطهاد اليهود.
حَنَانِيَّا كيوحنا في الاشتقاق ومعنى حنانيا حنو الرب ومعنى يوحنا الرب حنّان.
سَفِّيرَةُ أي مضيئة أو جميلة. وسفيرة وحنانيا اسمان لم يليقا بصفات مسمّييهما.
بَاعَ مُلْكاً حقلاً ع ٣ كغيره من أغنياء الكنيسة (ص ٤: ٣٤) بدعوى أنه فعل ذلك لنفع فقراء الكنيسة محبة للمسيح. وجاء هذا برأي امرأته واتفاقها معه (ع ٢ و٩) فلهذا كانت شريكة له في ما أتاه في ذلك من الإثم.
٢ «وَٱخْتَلَسَ مِنَ ٱلثَّمَنِ، وَٱمْرَأَتُهُ لَهَا خَبَرُ ذٰلِكَ، وَأَتَى بِجُزْءٍ وَوَضَعَهُ عِنْدَ أَرْجُلِ ٱلرُّسُلِ».
ص ٤: ٣٧
وَٱخْتَلَسَ مِنَ ٱلثَّمَنِ أي أبقى بعض الثمن لنفسه وتظاهر أن ما وهبه منه هو الكل. ولم يكن عليه شيء من الإثم بما أبقاه لو أنبأ بأن ما قدمه هو جزء الثمن لا كله لأن العطاء اختياري لا اضطراري.
وَٱمْرَأَتُهُ لَهَا خَبَرُ أي أنها عرفت أن ما أُعطي جزء ثمن المبيع فشاركت زوجها في قصد الخداع والكذب.
وَأَتَى بِجُزْءٍ مدعياً أنه الثمن كله كما يظهر من قول بطرس له «أَنْتَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى ٱلنَّاسِ بَلْ عَلَى ٱللّٰهِ» (ع ٣ و٤).
وكانت خطيئته أولاً الكذب وثانياً الرياء لأنه ابتغى أن يعتبره الناس كريماً منكراً ذاته وثالثاً الطمع لأنه أحب المال حتى خبّأ بعضه وادّعى إعطاء الكل رغبة في نوال المدح.
٣ «فَقَالَ بُطْرُسُ: يَا حَنَانِيَّا، لِمَاذَا مَلأَ ٱلشَّيْطَانُ قَلْبَكَ لِتَكْذِبَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَتَخْتَلِسَ مِنْ ثَمَنِ ٱلْحَقْلِ؟».
عدد ٣٠: ٢ وتثنية ٢٣: ٢١ جامعة ٥: ٤ ولوقا ٢٢: ٣ وع ٩
فَقَالَ بُطْرُسُ لا ريب في أن حنانيا توقع أن يمدحه بطرس على سخائه أمام كل الجمهور ولم يعلم بطرس كذب حنانيا إلا بالوحي فالله أعلمه بذلك لكي تُعلن خطيئة الكاذب ويعاقب عليها.
لِمَاذَا مَلأَ ٱلشَّيْطَانُ قَلْبَكَ نسب بطرس أصل هذه الخطيئة إلى تجربة الشيطان وهذا مثل ما في (لوقا ٢٢: ٣ ويوحنا ١٣: ٢٧) وسُمّي الشيطان «أبا الكذاب» (يوحنا ٨: ٤٤ انظر أيضاً تكوين ٣: ١ - ٥).
وتجربة الشيطان ليست بعذر لحنانيا لأنه خطئ بتسليمه لتجربته ولم يستطع الشيطان إغواءه لو لم يجد فيه استعداداً للغواية لما فيه من الطمع وعدم الاكتراث بالصدق. وقوله «لماذا» الخ دليل على أنه غير مجبر على إطاعة وأنه كان قادراً على أن يقاومه وواجباً عليه أن يدفعه. وأشار بقوله «ملأ قلبه» إلى أنه ارتكب ذلك الإثم بكل اجتهاد ومسرة بعدما أسكت ضميره كل الإسكات.
لِتَكْذِبَ بتقديم بعض ثمن الحقل بدعوة أنه الثمن كله.
عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ الأقنوم الثالث من اللاهوت. فحنانيا قصد أن يخدع الرسل وسائر الكنيسة فقط لكن خطيئته كانت أعظم مما ظن لأن الرسل فعلوا ما فعلوه بتأثير الروح القدس وبه علموا التعليم وصنعوا المعجزات واستطاعوا معرفة الغيب فالكذب على الرسل القدس شر من كل الخطايا (متّى ١٢: ٣١ و٣٢ ومرقس ٣: ٢٨ و٢٩). وفيما ذُكر برهان على التمييز بين الأقانيم اللاهوتية إذ أوضح هنا أن الروح القدس أقنوم لا صفة إلهية لأن حنانيا لا يستطيع أن يكذب على صفة. وفيه برهان آخر على أن الروح القدس إله لأنه كذا سمي في الآية الرابعة ولأنه قادر على فحص القلوب والتمييز بين المرائين والمخلصين وهذا لا يقدر عليه إلا الله (١أيام ٢٨: ٩ وإرميا ١٧: ١٠ و١كورنثوس ٢: ١٠ ورؤيا ٢: ٢٣).
٤ «أَلَيْسَ وَهُوَ بَاقٍ كَانَ يَبْقَى لَكَ؟ وَلَمَّا بِيعَ، أَلَمْ يَكُنْ فِي سُلْطَانِكَ؟ فَمَا بَالُكَ وَضَعْتَ فِي قَلْبِكَ هٰذَا ٱلأَمْرَ؟ أَنْتَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى ٱلنَّاسِ بَلْ عَلَى ٱللّٰهِ».
وَهُوَ بَاقٍ أي لم يُبع.
كَانَ يَبْقَى لَكَ هذا دليل قاطع على أنه لم يكن مجبراً على البيع وكذلك غيره ممن باعوا.
وَلَمَّا بِيعَ، أَلَمْ يَكُنْ فِي سُلْطَانِكَ أي ألم يكن الثمن لكي تتصرف به كيف شئت تعطيه أم تبقيه فأنت خطئت لغير موجب لا خوفاً من اللوم ولا رهبة من العقاب فلو لم تُعط شيئاً أو أعطيت جزءاً علناً لم يعتب أحدٌ عليك لكنك اجتهدت في أن تعبد الله والمال وتكسب الصيت بالكرم والتقوى وتجري في سبيل طمعك.
فَمَا بَالُكَ وَضَعْتَ فِي قَلْبِكَ فالفكر فكرك والفعل فعلك وإن كان الشيطان قد ملأ قلبك لأن الشيطان لا يقدر أن يجبر أحداً على الخطيئة (يعقوب ٤: ٧). ومعنى «الوضع في القلب» النيّة والعزم. وعزمه على الاختلاس زاد إثمه فظاعة وكذا جعْله امرأته تشاركه في ذلك.
أَنْتَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى ٱلنَّاسِ فقط.
بَلْ عَلَى ٱللّٰهِ أي على الروح القدس ع ٣ وهذا شر الخطايا فالإساءة إلى الناس ليست شيئاً بالنسبة إلى الإساءة إلى الله. فإن داود أخطأ إلى الله وإلى أوريا ومع ذلك قال «إليك وحدك أخطأت» (مزمور ٥١: ٤). أما إخطاؤه إلى الله فادعاؤه أنه وقف كل الثمن له تعالى على يد الرسل وتظاهره بأن الروح القدس حثّه على تلك التقدمة وعزمه على الخداع يستلزم أنه حسب أن العالم كل شيء لا يعلم خداعه ورياءه.
٥ «فَلَمَّا سَمِعَ حَنَانِيَّا هٰذَا ٱلْكَلاَمَ وَقَعَ وَمَاتَ. وَصَارَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى جَمِيعِ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا بِذَلِك».
ع ١٠ و١١
عرف حنانيا من كلام بطرس أن خداعه ظهر وعرف فظاعة إثمه.
وَقَعَ وَمَاتَ ولنا من هذا خمسة أمور:
- الاول: أن ذلك قصاص الله رأساً لحنانيا على خطيئته لا نتيجة خجله أو ندامته (وإن كانا في غاية الشدة) ولا نتيجة قصد بطرس أو قوله.
- الثاني: أنه شهادة الله بفظاعة الكذب والرياء والطمع والاستخفاف بروح الله ولا سيما الأول لأنه تعالى يكرهه كل الكراهة.
- الثالث: أن مثل شدة العقاب المعلوم كما ذُكر كان ضرورياً في أول أمر الكنيسة الجديدة اتقاء من ذلك الرياء. وكذلك كان أول ما وضع الله الشريعة الموسوية فإنه لما تعداها ناداب وأبيهو ولدا هرون أماتهما (لاويين ١٠: ١٢) وكذلك شُدد العقاب على الإسرائيليين في أول دخولهم أرض الميعاد وتعديهم أوامره (يشوع ص ٧). فأظهر الله شفاء الأعرج وشدة نقمته بأمانة المرائي على الأثر.
- الرابع: أن الله يهتم بمنع ضرر الكنيسة من داخل كما يهتم بمنعه من خارج (ص ٥: ١٩ و١٢: ٧).
- الخامس: أن الله قصد بذلك أن يثبت سلطان الرسل وأنهم رسله. ومثل هذا ضربة عليم الساحر إثباتاً لرسولية بولس وبرنابا (ص ١٣: ٨ - ١١).
خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى جَمِيعِ الخ أي الذين سمعوا خطاب بطرس في المحفل (ع ٦) ثم ذاع نبأ ذلك في القرب والبعد فخافوا من إغاظة الله ومن نقمته.
٦ «فَنَهَضَ ٱلأَحْدَاثُ وَلَفُّوهُ وَحَمَلُوهُ خَارِجاً وَدَفَنُوه».
يوحنا ١٩: ٤٠
أتوا ذلك على وفق العادة العامة ويقوم بهذه الخدمة طبعاً الأحداث دون الشيوخ.
خَارِجاً من المجتمع ومن المدينة لأنه لم يكونوا يدفنون في مدينة أورشليم غير الملوك والشرفاء.
٧ «ثُمَّ حَدَثَ بَعْدَ مُدَّةِ نَحْوِ ثَلاَثِ سَاعَاتٍ أَنَّ ٱمْرَأَتَهُ دَخَلَتْ، وَلَيْسَ لَهَا خَبَرُ مَا جَرَى».
يظهر من هذا ان جماعة المؤمنين استمروا مجتمعين مدة الساعات الثلاث التي غاب فيها الأحداث للدفن.
أَنَّ ٱمْرَأَتَهُ دَخَلَتْ المحفل.
وَلَيْسَ لَهَا خَبَرُ مَا جَرَى من أمر زوجها ولا بد من أنها كانت تظن أن الخداع قد نجح ولأنها كانت شريكة لزوجها في الخداع لاق أن تكون شريكته في العقاب.
٨ «فَسَأَلَهَا بُطْرُسُ: قُولِي لِي، أَبِهٰذَا ٱلْمِقْدَارِ بِعْتُمَا ٱلْحَقْلَ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ بِهٰذَا ٱلْمِقْدَارِ».
لم يعطها بطرس فرصة للاستفهام عما جرى بل خاطبها في الحال.
أَبِهٰذَا ٱلْمِقْدَارِ بِعْتُمَا ٱلْحَقْل بلا زيادة. والأرجح أن ذلك المقدار كان أمامه وأشار إليه عند خطابه المرأة وأنه عيّنه ولوقا لم يفصّل. فلو اعترفت بالحق لخلصت لا محالة لكنها أصرت على النفاق الذي اتفقت عليه مع زوجها.
٩ «فَقَالَ لَهَا بُطْرُسُ: مَا بَالُكُمَا ٱتَّفَقْتُمَا عَلَى تَجْرِبَةِ رُوحِ ٱلرَّبِّ؟ هُوَذَا أَرْجُلُ ٱلَّذِينَ دَفَنُوا رَجُلَكِ عَلَى ٱلْبَابِ، وَسَيَحْمِلُونَكِ خَارِجا».
متّى ٤: ٧ وع ٣
ٱتَّفَقْتُمَا اتفاقها مع زوحها جعلها مذنبة مثله.
عَلَى تَجْرِبَةِ رُوحِ ٱلرَّبِّ هما قصدا خداع الرسل لكنهما امتحنا بذلك أنه هل يقدر روح الرب الساكن فيهم على كشف الخداع أو لا.
هُوَذَا أَرْجُلُ... عَلَى ٱلْبَابِ أي على وشك الوصول. ولا عجب أن شغل الأحداث نحو ثلاث ساعات بحمل حنانيا إلى خارج المدينة وبتهيئة المدفن له وبرجوعهم إلى حيث كانوا. وبما قاله بطرس أنبأها بخيبة مسعاها بتجربة روح الرب وبموت زوجها.
وَسَيَحْمِلُونَكِ خَارِجاً أخبرها أن موتها قريب. علم بطرس بوحي الله أن نصيبها كنصيب زوجها في المصاب ووقوع الموت على أثر الخطيئة أبان أنه نتيجتها وعلامة غيظ الله.
١٠ «فَوَقَعَتْ فِي ٱلْحَالِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَمَاتَتْ. فَدَخَلَ ٱلشَّبَابُ وَوَجَدُوهَا مَيْتَةً، فَحَمَلُوهَا خَارِجاً وَدَفَنُوهَا بِجَانِبِ رَجُلِهَا».
ع ٥
كان موتها سريعاً كما أنبأ بطرس وكان في وسط المحفل. وأسباب شدة العقاب هذا مرّ ذكرها في شرح ع ٥. ونرى غالباً أن العقاب يتأخر عن الإثم لا يقع على أثره ولكن من المحقق أن الله لا بد من أن يعاقب على الخطيئة عاجلاً أو آجلاً ما لم تُمح بالتوبة ولا سيما الكذب والرياء (أيوب ٨: ١٣ و٣٦: ١٣ وأمثال ٦: ١٧ و١٢: ٢٢ و١٩: ٩ ولوقا ١٢: ١ و٢ ورؤيا ٢١: ٨).فبين معجزات الرحمة الكثيرة لم يكن سوى معجزة واحدة من معجزات النقمة وذلك في وقت الاحتياج إليها للتعليم والإنذار فأعلن الله بها أنه إله العدل والحق كما أعلن بغيرها أنه إله المحبة والرحمة.
١١ «فَصَارَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى جَمِيعِ ٱلْكَنِيسَةِ وَعَلَى جَمِيعِ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا بِذَلِكَ».
ص ٢: ٤٣ وع ٥ وص ١٩: ١٧
خَوْفٌ عَظِيمٌ من الله باعتبار أنه إله العدل والنقمة وأنه رقيب أعمال العباد ومثل هذا الخوف ينشأ طبعاً عند مشاهدة قرب الله من الإنسان وإجراء قضائه ونتيجة مثل هذا الخوف فحص القلوب وامتحان النفس والسهر والصلاة لكي لا يقع أحد في مثل إثم حنانيا وامرأته ولا شك في أن تأثير ذلك الحادث بقي وقتاً طويلاً في الكنيسة ولم يزل إلى اليوم لمن يقرأون نبأه ويتأملون.
ٱلْكَنِيسَةِ جماعة المؤمنين وهذا أول ذكر لهذا الاسم في أعمال الرسل وذكره المسيح مرتين (متّى ١٦: ١٨ و١٨: ١٧).
ٱلَّذِينَ سَمِعُوا ممن ليسوا من الكنيسة فإن تأثير موت الزوجين بغتة أثر في كل من بلغه النبأ من غير المسيحيين حتى امتنع المراؤون من الالتصاق بهم.
نمو الكنيسة وآيات الرسل ع ١٢ إلى ع ١٦
١٢ «وَجَرَتْ عَلَى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ آيَاتٌ وَعَجَائِبُ كَثِيرَةٌ فِي ٱلشَّعْبِ. وَكَانَ ٱلْجَمِيعُ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ فِي رِوَاقِ سُلَيْمَانَ».
ص ٢: ٤٣ و١٤: ٣ و١٩: ١١ ورومية ١٥: ١٩ و٢كورنثوس ١٢: ١٢ وعبرانيين ٢: ٤ ص ٣: ١١ و٤: ٣٢
الجملة الأولى من هذه الآية متعلقة بالآية الخامسة عشرة وما بينهما كلام معترض وهو تكرار القول في (ص ٤: ٣٣) وشرح له.
آيَاتٌ وَعَجَائِبُ انظر شرح ص ٢: ٤٣ وهذا جواب صلاة المؤمنين التي ذُكرت في (ص ٤: ٣٠).
وَكَانَ ٱلْجَمِيعُ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ أي كان أعضاء الكنيسة متحدين في المحبة والصلاة والعبادة.
فِي رِوَاقِ سُلَيْمَانَ انظر شرح (ص ٣: ١١ ومتّى ٢١: ١٢ ويوحنا ١٠: ٢٣) وكان ذلك الرواق مجتمعاً لعامة الناس وخاصتهم فاتخذه الرسل محل مخاطباتهم للشعب وهذا مضاد كل المضادة لنهي مجلس اليهود الرسولين عن أن ينطقا أو يعلما باسم يسوع (ص ٤: ١٨).
١٣ «وَأَمَّا ٱلآخَرُونَ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَجْسُرُ أَنْ يَلْتَصِقَ بِهِمْ، لٰكِنْ كَانَ ٱلشَّعْبُ يُعَظِّمُهُمْ».
ع ١٤ ص ٢: ٤٧ و٤: ٢١
وَأَمَّا ٱلآخَرُونَ أي المراؤون كحنانيا لا المؤمنون الحقيقيون.
ٱلشَّعْبُ يُعَظِّمُهُمْ أي اعتبرهم وأكرمهم واعتقد أنهم عبيد الله المخلصون ورسله. فكان اعتباره إيّاهم مضاداً لميل الرؤساء الذين كانوا يكرهونهم ولكنهم غضوا النظر حينئذ عن المقاومة علانية وقتاً قصيراً.
١٤ «وَكَانَ مُؤْمِنُونَ يَنْضَمُّونَ لِلرَّبِّ أَكْثَرَ، جَمَاهِيرُ مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاء».
مُؤْمِنُونَ هذا الاسم الذي عُرف به رسل المسيح أولاً وذلك لأن الإيمان بأن يسوع هو المسيح جوهر معتقدهم.
يَنْضَمُّونَ لِلرَّبِّ أي لم يلتصق بالرب سوى المؤمنين وأما المراؤون فامتنعوا خوفاً (ع ١٣). وذكر هنا إحدى طرق تعظيم الشعب إيّاهم وهو الانحياز إليهم على رغم تهديد الرؤساء ومقاومتهم. ومعنى «الرب» هنا يسوع المسيح» ومما يستحق الملاحظة هنا أن الوحي قال أنهم «انضموا للرب» لا للكنيسة لأن الانضمام لها عبث إن لم يكن أولاً للرب وسبيل ذلك الانضمام الإيمان بالمسيح وهو الذي يجعل الناس أغصاناً حية في الكرمة الحقيقية (يوحنا ١٥: ١ و٥).
رِجَالٍ وَنِسَاءٍ عدل هنا عن بيان عددهم لكثرتهم. فذكره حين كانوا «مئة وعشرين» (ص ١: ٥٠) وحين صاروا «ثلاثة آلاف» (ص ٢: ٤١) وحين بلغوا «خمسة آلاف» (ص ٤: ٤) ولا يلزم من ذكر النساء هنا على خلاف ما ذُكر هنالك أنه لم تكن النساء بين الأولين. فالديانة المسيحية هي الديانة الوحيدة التي تطلب ترقية النساء كما تطلب ترقية الرجال وخلاصهنّ كخلاصهم.
١٥ «حَتَّى إِنَّهُمْ كَانُوا يَحْمِلُونَ ٱلْمَرْضَى خَارِجاً فِي ٱلشَّوَارِعِ وَيَضَعُونَهُمْ عَلَى فُرُشٍ وَأَسِرَّةٍ، حَتَّى إِذَا جَاءَ بُطْرُسُ يُخَيِّمُ وَلَوْ ظِلُّهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ».
متّى ٩: ٢١ و١٤: ٣٦ وص ١٩: ١٢
هذا متعلق بالجملة الأولى من الآية الثانية عشرة وما بينهما معترض.
كَانُوا يَحْمِلُونَ أي الأصدقاء والأصحاب.
ٱلشَّوَارِعِ أي أزقة أورشليم المؤدية إلى الهيكل.
فُرُشٍ وَأَسِرَّ هذا دليل على أن المصابين الذين حُملوا كانوا مختلفي الطبقات فالفرش للأغنياء والأسرة للفقراء.
يُخَيِّمُ وَلَوْ ظِلُّهُ يُستنتج من ذلك أن الشعب ازدحم على بطرس حتى صعب على كل أن يقترب إليه ويلتمس منه الشفاء. والكتاب لا يقول انتفعوا بذلك ولا ينفي الانتفاع به والأرجح أنهم انتفعوا لثلاثة أسباب:
- الأول: أن فعلهم يدل على قوة إيمانهم. وهذا الشرط الجوهري لنوال الشفاء (والله قادر على أن يشفي بالوسائط وبدونها ولا فرق عنده بأن تكون الواسطة خيالاً أو لمساً أو كلاماً).
- الثاني: أن الحادث هنا يشبه ما نُسب إلى بولس وقد حُقِّق الشفاء فيه وهو قول الكتاب «حَتَّى كَانَ يُؤْتَى عَنْ جَسَدِهِ بِمَنَادِيلَ أَوْ مَآزِرَ إِلَى ٱلْمَرْضَى، فَتَزُولُ عَنْهُمُ ٱلأَمْرَاضُ» (ص ١٩: ١٢).
- الثالث: أنه لو كان الذي حملهم على ذلك وهماً لا يأتي بنفع لم يكن من وجه لذكر لوقا إياه. والظاهر من الآية الثانية عشر أن الشفاء من جميع الرسل على السواء ولكن الشعب نسب قوة خاصة إلى بطرس لكونه المتقدم في الكلام والعمل.
١٦ «وَٱجْتَمَعَ جُمْهُورُ ٱلْمُدُنِ ٱلْمُحِيطَةِ إِلَى أُورُشَلِيمَ حَامِلِينَ مَرْضَى وَمُعَذَّبِينَ مِنْ أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ، وَكَانُوا يُبْرَأُونَ جَمِيعُهُمْ».
مرقس ١٦: ١٧ و١٨ ويوحنا ١٤: ١٢
الذين ذُكروا في ع ١٥ كانوا من مدينة أورشليم عينها وذُكر في هذه الآية ما نتج عن شيوع الخبر في البلاد المجاورة لها.
أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ انظر شرح (متّى ٤: ٢٣ و٢٤) والنجاسة هنا أدبية. وذكر الكاتب الأمراض الجسديّة ثم الجسديّة والروحيّة.
كَانُوا يُبْرَأُونَ جَمِيعُهُمْ عسر على الرسل قبل صعود المسيح إخراج بعض الأرواح النجسة وبعد ذلك لم يعسر عليهم شيء من الإبراء (متّى ١٧: ١٦ و١٩).
سجن الرسل وإطلاق الملاك إيّاهم ع ١٧ إلى ع ٢٤
١٧ «فَقَامَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ مَعَهُ، ٱلَّذِينَ هُمْ شِيعَةُ ٱلصَّدُّوقِيِّينَ، وَٱمْتَلأُوا غَيْرَةً».
ص ٤: ١ و٢ و٦
فَقَامَ هذا هياج ثانٍ على الرسل وهو أشد من الأول ولكن نتيجته كنتيجة الأول في تقدّم الإنجيل.
رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ لم يتضح أحنّان المقصود هنا أم قيافا ولكن العمل مما يميل إليه كلاهما لأنهما متشابهان في الانفعالات.
ٱلَّذِينَ مَعَهُ أي من شيعته.
صَّدُّوقِيِّينَ انظر شرح (متّى ٣: ٧ وص ٢٣: ٨). قال يوسيفوس كانت فرقة الصدوقيين قليلة العدد وكثيرة التأثير في الناس وأكثرها من الرؤساء والأغنياء. وكان أهم المبادئ عندهم «أن لا قيامة» ولكن أعظم مبادئ الفريسيين «القيامة» فكانوا يسرون بكل ما يحط اعتبار الصدوقيين وينافي تعليمهم فلذلك قلماً اضطهدوا الرسل لأنهم كانوا ينادون بالقيامة وذلك مما يسرهم.
غَيْرَةً لأن وعظ الرسل ينفي تعليمهم ويثبت تعليم الفريسيين ويحكم على الفريقين بقتل المسيح ولأنه خلاف أوامرهم (ص ٤: ١٨ - ٢١) وتأثير تعليم الرسل في الشعب وانتشار صيتهم بواسطة معجزاتهم هيّج حسدهم وغيرتهم.
١٨ «فَأَلْقَوْا أَيْدِيَهُمْ عَلَى ٱلرُّسُلِ وَوَضَعُوهُمْ فِي حَبْسِ ٱلْعَامَّةِ».
لوقا ٢١: ١٢
عَلَى ٱلرُّسُلِ أي جميعهم.
حَبْسِ ٱلْعَامَّةِ في أورشليم ولا ريب في أنه كان متيناً حتى يتبيّن أن لا سبيل إلى نجاتهم منه إلا بمعجزة ولا ريب في أنهم شغلوا مدة سجنهم بالصلاة.
١٩ «وَلٰكِنَّ مَلاَكَ ٱلرَّبِّ فِي ٱللَّيْلِ فَتَحَ أَبْوَابَ ٱلسِّجْنِ وَأَخْرَجَهُمْ وَقَالَ».
ص ١٢: ٧ و١٦: ٢٦
هذا أول مداخلة الله في حماية الرسل وذُكر مثل هذه المعجزة في (ص ١٢: ١٠) وحدث وقتئذ كما هنا بدون معرفة الحراس (ع ٢٣) وغاية هذه العجيبة ثلاثة أمور:
- الأول: تبكيت للرؤساء وإظهار بطلان مقاومتهم الحق.
- الثاني: تثبيت إيمان الرسل وتحقيق حماية الله إياهم.
- الثالث: إقامة برهان جديد للشعب على صحة تعليم الرسل وأنهم رُسل الله لأنه عُلم يقيناً أنهم سُجنوا مساء وشوهدوا صباحاً خارج السجن بلا واسطة بشرية.
٢٠ «ٱذْهَبُوا قِفُوا وَكَلِّمُوا ٱلشَّعْبَ فِي ٱلْهَيْكَلِ بِجَمِيعِ كَلاَمِ هٰذِهِ ٱلْحَيَاةِ».
يوحنا ٦: ٦٨ و١٧: ٣ و١يوحنا ٥: ١١
ٱذْهَبُوا قِفُوا لم يقل اذهبوا اختبئوا.
فِي ٱلْهَيْكَلِ في موضع هو أنسب مواضع المدينة لإعلانهم إذ يشاهدهم فيه الجميع ويسمعونهم والأرجح أنهم تكلموا في رواق سليمان.
كَلاَمِ هٰذِهِ ٱلْحَيَاةِ أي تعاليم يسوع المسيح. وهذا على وفق قول بطرس ليسوع «يَا رَبُّ، إِلَى مَنْ نَذْهَبُ؟ كَلاَمُ ٱلْحَيَاةِ ٱلأَبَدِيَّةِ عِنْدَكَ» (يوحنا ٦: ٦٨). والحياة المشار إليها هنا هي الحياة الأبدية المعلنة في الإنجيل وتتضمن النجاة من موت الخطيئة وجهنم ونوال القداسة والسعادة الدائمة وبداءتها معرفة الله وابنه يسوع المسيح (يوحنا ١٧: ٣). أخرجهم الله من السجن لا لمجرد وقايتهم من الخطر ولا لكي يجلسوا بطالين بل ليعرضوا أنفسهم أيضاً للأتعاب والمصائب والمخاطر والمقاومات لأجل الحق.
٢١ «فَلَمَّا سَمِعُوا دَخَلُوا ٱلْهَيْكَلَ نَحْوَ ٱلصُّبْحِ وَجَعَلُوا يُعَلِّمُونَ. ثُمَّ جَاءَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ، وَدَعَوُا ٱلْمَجْمَعَ وَكُلَّ مَشْيَخَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ٱلْحَبْسِ لِيُؤْتَى بِهِمْ».
ص ٤: ٥ و٦ وع ١٧
لم يبالوا براحتهم وأمتهم إنما أتوا ذلك إطاعة لأمر الله بواسطة الملاك.
نَحْوَ ٱلصُّبْحِ كما فعل المسيح (لوقا ٢٤: ١ ويوحنا ٨: ٢).
يُعَلِّمُونَ كان الشعب مجتمعاً صباحاً للصلاة كالعادة فأمكن الرسل أن يشاهدوه ويعلّموه.
وَٱلَّذِينَ مَعَهُ من فرقة الصدوقيين (ع ١٧).
دَعَوُا ٱلْمَجْمَعَ أي مجمع السبعين الشرعي ليحاكموا الرسل لعصيانهم أوامره.
كُلَّ مَشْيَخَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أي معتبري الشعب لتقدمهم في السن ولحكمتهم واختبارهم وهم ليسوا من أعضاء المجلس قانونياً بل كانوا يُدعون إلى المجلس للنظر في الأمور ذات الشأن. فينتج من ذلك أن الرؤساء استعظموا أمر الرسل وقصدوا ملاشاتهم بأحسن طريقة.
أَرْسَلُوا إِلَى ٱلْحَبْسِ لأنهم لم يعرفوا أن الرسل كانوا في تلك الساعة يعلّمون في الهيكل.
٢٢، ٢٣ «٢٢ وَلٰكِنَّ ٱلْخُدَّامَ لَمَّا جَاءُوا لَمْ يَجِدُوهُمْ فِي ٱلسِّجْنِ، فَرَجَعُوا وَأَخْبَرُوا ٢٣ قَائِلِينَ: إِنَّنَا وَجَدْنَا ٱلْحَبْسَ مُغْلَقاً بِكُلِّ حِرْصٍ، وَٱلْحُرَّاسَ وَاقِفِينَ خَارِجاً أَمَامَ ٱلأَبْوَابِ، وَلٰكِنْ لَمَّا فَتَحْنَا لَمْ نَجِدْ فِي ٱلدَّاخِلِ أَحَداً».
ص ٤: ١
ٱلْخُدَّامَ أي جند الهيكل (ص ٤: ١ ولوقا ٢٢: ٥٢). والأرجح أنهم هم الذين ذهبوا أمس بالرسل إلى السجن بأمر الرؤساء.
وَجَدْنَا ٱلْحَبْسَ مُغْلَقاً يلزم من هذا أن الملاك أغلق أبواب السجن بعد أن فتحها وأطلق الرسل (ع ١٩). ووجود الأبواب المغلقة والأقفال صحيحة وعدم معرفة الحراس بخروج الرسل واعتقادهم أن الرسل لم يزالوا في السجن أثبت أنهم لم يخرجوا بوسائط بشرية إنما خرجوا بمعجزة إلهية.
وقوف الرسل أمام المجمع وخطابهم ع ٢٤ إلى ع ٣٢
٢٤ «فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْكَاهِنُ وَقَائِدُ جُنْدِ ٱلْهَيْكَلِ وَرُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ هٰذِهِ ٱلأَقْوَالَ، ٱرْتَابُوا مِنْ جِهَتِهِمْ: مَا عَسَى أَنْ يَصِيرَ هٰذَا؟».
لوقا ٢٢: ٤ وص ٤: ١
قَائِدُ جُنْدِ ٱلْهَيْكَلِ انظر شرح (ص ٤: ١ ولوقا ٢٢: ٥٢).
ٱرْتَابُوا الخ علة ارتيابهم أولاً أنهم وجدوا أن لا تأثير لسلطانهم وأوامرهم بعدما كانوا قد اختبروا فاعليتها.
ثانياً: أنهم رأوا القصاص الذي أوقعوه على الرسل دفعته عنهم قوة سرية أعظم من قوتهم هم.
ثالثا: أنهم تيقنوا أن التعليم الذي سعوا في إبطاله زاد وعظم بين الشعب على رغمهم.
رابعاً: أنهم عجزوا عن مقاومة مساعد الرسل غير المنظور. والحق أنه لم يكن من داع لأن يرتابوا لأنه وضح أن الله كان مع الرسل وأن القوة التي كانت مع الإنجيل أعظم من التي كانت عليه أي قوتهم وتبيّن أنه لا بد من انتصار الإنجيل وانكسارهم.
٢٥ «ثُمَّ جَاءَ وَاحِدٌ وَأَخْبَرَهُمْ قَائِلاً: هُوَذَا ٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ وَضَعْتُمُوهُمْ فِي ٱلسِّجْنِ هُمْ فِي ٱلْهَيْكَلِ وَاقِفِينَ يُعَلِّمُونَ ٱلشَّعْبَ».
هذا أصعب ما يمكن أن يسمعوه فلو قيل أنهم هربوا واختبأوا لهان عليهم بالنسبة إلى هذا.
٢٦ «حِينَئِذٍ مَضَى قَائِدُ ٱلْجُنْدِ مَعَ ٱلْخُدَّامِ، فَأَحْضَرَهُمْ لاَ بِعُنْفٍ، لأَنَّهُمْ كَانُوا يَخَافُونَ ٱلشَّعْبَ لِئَلاَّ يُرْجَمُوا».
ع ٢٤ متّى ٢١: ٢٦
لو شاء التلاميذ الفتنة على الرؤساء لسهلت عليهم لأن الشعب مال إليهم لما فعلوا من الحسنات والمعجزات النافعة.
لاَ بِعُنْفٍ لم يكّتفوهم أو يضربوهم أو يقسوا عليهم.
٢٧ «فَلَمَّا أَحْضَرُوهُمْ أَوْقَفُوهُمْ فِي ٱلْمَجْمَعِ. فَسَأَلَهُمْ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ».
أتى الرسل طوعاً وكانوا يطيعون دائماً أوامر الرؤساء في كل ما لا يخالف أوامر الله.
٢٨ «أَمَا أَوْصَيْنَاكُمْ وَصِيَّةً أَنْ لاَ تُعَلِّمُوا بِهٰذَا ٱلٱسْمِ؟ وَهَا أَنْتُمْ قَدْ مَلأْتُمْ أُورُشَلِيمَ بِتَعْلِيمِكُمْ، وَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْلِبُوا عَلَيْنَا دَمَ هٰذَا ٱلإِنْسَانِ».
ص ٤: ١٨ متّى ٢٣: ٣٥ و٢٧: ٢٥ وص ٢: ٢٣ و٣٦ و٣: ١٥ و٧: ٥٢
لم يسألهم رئيس الكهنة لا تصريحاً ولا تلميحاً عن أمر خروجهم من السجن حذراً من إعلان المعجزة واقتصر على أن سألهم عن سبب مخالفتهم أوامر المجلس (ص ٤: ١٨).
بِهٰذَا ٱلٱسْمِ أبى أن يقول يسوع كرهاً وازدراء.
مَلأْتُمْ أُورُشَلِيمَ بِتَعْلِيمِكُمْ هذه شكواه الأولى عليهم وهي إقرارٌ بأمانتهم في التعليم وعظمة تأثيره في الشعب.
تَجْلِبُوا عَلَيْنَا دَمَ هذه شكواه الثانية عليهم وهي أنهم يقنعون الشعب بأن الرؤساء قتلوا برياً وأنهم اعتدوا على الله وعرّضوا أنفسهم لنقمته بقتلهم المسيح. فقولهم هنا يختلف كل الاختلاف عن قولهم أمام بيلاطس «دمه علينا وعلى أولادنا» (متّى ٢٧: ٢٥). والرسل لم يبتغوا بما علمونا أن يهيجوا الشعب على الرؤساء بدليل أنهم لما خاطبوا الشعب أبانوا له أن مذنب بقتله وأما ما قالوه على الرؤساء في هذا خاطبوهم به مواجهة (ص ٢: ٣٦ و٣: ١٣ و١٤ و٤: ١٠).
هٰذَا ٱلإِنْسَانِ أي يسوع ولم يذكره ادّعاء أنه لا يستحق أن يسمّى.
٢٩ «فَأَجَابَ بُطْرُسُ وَٱلرُّسُلُ: يَنْبَغِي أَنْ يُطَاعَ ٱللّٰهُ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنَّاسِ».
ص ٤: ١٩
أبان الرسل بجوابهم أولاً أن أمر الله فوق أمر المجلس كقول بطرس في (ص ٤: ١٩ و٢٠).
يُطَاعَ ٱللّٰهُ أي أمره بفم يسوع ثم بفم الملاك الذي أخرجهم من السجن.
ٱلنَّاسِ أي أنتم وإن كنتم أعضاء المجلس الكبير. وليس في ذلك إنكار لسلطان المجلس بل بيان أن سلطان الله أعظم. وهذا مبدأ الحرية المسيحية اعتمده كل شهداء الكنيسة وشهودها.
٣٠ «إِلٰهُ آبَائِنَا أَقَامَ يَسُوعَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُ مُعَلِّقِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةٍ».
ص ٣: ١٣ و١٥ و٢٢: ١٤ ص ١٠: ٣٩ و١٣: ٢٩ وغلاطية ٣: ١٣ و١بطرس ٢: ٢٤
إِلٰهُ آبَائِنَا إضافة إلى الآباء بياناً أنهم لم ينادوا بديانة جديدة تنافي الديانة القديمة لكن إله الإنجيل هو إله التوراة ودين المسيح وارث كل ما في دين الآباء والأنبياء وملوك العهد القديم.
أَقَامَ أي أحيا بعد الموت.
ٱلَّذِي أَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُ هذا قيد معين لمن أُقيم وبيان أنهم لم يرجعوا عما نسبوه إلى الرؤساء من قتل المسيح ولم يخافوا من قولهم «وَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْلِبُوا عَلَيْنَا دَمَ هٰذَا ٱلإِنْسَانِ» (ع ٢٨) ونسبوا ذلك القتل إليهم لأنهم علته. ومع أن الرسل أثبتوا على رؤساء اليهود أنهم قتلوا المسيح بشروهم في الآية التالية بالرحمة والغفران.
مُعَلِّقِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةٍ بتسليمكم إيّاه إلى بيلاطس ليصلبه. وتسمية الصليب «بالخشبة» مبنية على ما في (تثنية ٢١: ٢٣) وسماه بذلك بطرس في خطابه لكرنيليوس (ص ١٠: ٣٩) وبولس في (غلاطية ٣: ١٣).
٣١ «هٰذَا رَفَّعَهُ ٱللّٰهُ بِيَمِينِهِ رَئِيساً وَمُخَلِّصاً، لِيُعْطِيَ إِسْرَائِيلَ ٱلتَّوْبَةَ وَغُفْرَانَ ٱلْخَطَايَا».
ص ٢: ٣٣ و٣٦ وفيلبي ٢: ٩ وعبرانيين ٢: ١٠ و١٢: ٢ ص ٣: ١٥ متّى ١: ٢١ لوقا ٢٤: ٤٧ وص ٣: ٢٦ و١٣: ٣٨ وأفسس ١: ٧ وكولوسي ١: ١٤
رَفَّعَهُ ٱللّٰهُ انظر شرح (ص ٢: ٣٣) هذا عكس ما فعله الرؤساء فإنهم أهانوه إلى الغاية والله أكرمه كل الإكرام لا لتبرئته وتمجيده فقط بل ليقدره فوق ذلك على إجراء عمل الفداء.
بِيَمِينِهِ أي بقوته ويحتمل الأصل «إلى يمنيه» فيكون المعنى محل الشرف والسلطان.
رَئِيساً انظر شرح (ص ٣: ١٥) والمراد أنه جعله ملكاً لمملكته الروحية وهي كنيسته في الأرض والسماء. ويلزم من كونه كذلك أنه قادر وغنيٌ فتجب الطاعة له والثقة بأنه يستطيع أن يهب التوبة والمغفرة.
مُخَلِّصاً من الخطيئة وعاقبتها (متّى ١: ٢١) فيستحق أن يتكل عليه من يرغب في النجاة من الإثم. وما نسبه الرسل هنا إلى يسوع من الرئاسة والتخليص صفتان مختصتان بالمسيح الموعود به وبرهان على أن يسوع هو بعينه. والكلام هنا على شيء مضى لا على أمرٍ في المستقبل.
لِيُعْطِيَ إِسْرَائِيلَ ٱلتَّوْبَةَ معنى «إسرائيل» هنا أولاده أي اليهود. ونعمة التوبة التي وهبها الله للإسرائيليين وهبها للأمم أيضاً لكنه خصّ إسرائيل بالذكر لأن الإنجيل عُرض أولاً عليهم ولأن المخاطبين هنا يهود. وهذه النعمة من النعم التي يهبها المسيح بعد ارتفاعه. وكانت المناداة بالتوبة من تعاليم يوحنا المعمدان (متّى ٣: ٢) وتعاليم المسيح ورسله قبل الصلب ولكن بعد صعود المسيح وحلول الروح القدس أُعلنت المغفرة للتائبين أوضح إعلان ومُنحت النعمة للتوبة بوفرة.
وَغُفْرَانَ ٱلْخَطَايَا غاية الإنجيل بيان العلاقة بين التوبة والمغفرة وكلاهما برهان على إتمام عمل الفداء ويوضح ذلك ثلاثة أمور:
- الأول: أنه يلزم من ذلك أن الله قبل موت المسيح على الصليب كفارة كافية ففتح باب المغفرة للتائبين.
- الثاني: أنه يلزم منه أن المسيح أخذ كل سلطان في السماء والأرض لأن مغفرة الخطايا مما يختص بالله ونوالها من خواص الناس.
- الثالث: أن منح التوبة والمغفرة يدل على أن الروح القدس قد أُعطي وهذا من نتائج إتمام عمل الفداء.
وكون المسيح يهب المغفرة التي يختص منحها بالله دليل على أنه الله (مزمور ١٣٠: ٤ وإشعياء ٤٣: ٢٥ ودانيال ٩: ٩).
٣٢ «وَنَحْنُ شُهُودٌ لَهُ بِهٰذِهِ ٱلأُمُورِ، وَٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ أَيْضاً، ٱلَّذِي أَعْطَاهُ ٱللّٰهُ لِلَّذِينَ يُطِيعُونَه».
يوحنا ١٥: ٢٦ و٢٧ ص ٢: ٤ و١٠: ٤٤
وَنَحْنُ شُهُودٌ لَهُ عيننا الله للشهادة ولذلك لا نستطيع أن نسكت (ص ١: ٨ و٢١ و٢٢ و٢: ٣٢ و٣: ١٥ و٤: ٢٠ ولوقا ٢٤: ٤٨).
بِهٰذِهِ ٱلأُمُورِ وهي قيامته بعد موته على الصليب وصعوده إلى السماء وارتفاعه إلى يمين الله والمناداة بالخلاص وشروطه.
وَٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ أَيْضاً وهذا الشاهد أصدق من كل البشر لأنه الله وأعلن شهادته يوم الخمسين بآيات ظاهرة من الألسن النارية والتكلم بلغات مختلفة وصوت كهبوب ريح عاصفة (ص ٢: ١ - ٤) وأعلنها أيضاً بتأثيره في قلوب الناس بأن قادهم إلى التوبة والإيمان (ص ٢: ٤١ و٤: ٤ و٥: ١٤) وبالمعجزات التي أجراها على أيدي الرسل وهو فوق ذلك يشهد في قلوب المؤمنين (رومية ٨: ١٦ وغلاطية ٤: ٦ و١يوحنا ٣: ٢٤). وذلك كله دليل قاطع على أن المسيح غلب الموت وصعد إلى السماء وأرسل الروح القدس كما وعد.
لِلَّذِينَ يُطِيعُونَه بقبول شهادته أن يسوع هو المسيح وهذا يستلزم أن أولئك الصدوقيين المتكبرين القساة يمكنهم أن ينالوا البركات المذكورة إذا شاءوا.
نجاة الرسل بواسطة مشورة غمالائيل ع ٣٣ إلى ع ٤٢
٣٣ «فَلَمَّا سَمِعُوا حَنِقُوا، وَجَعَلُوا يَتَشَاوَرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ».
ص ٢: ٣٧ و٧: ٥٤
فَلَمَّا سَمِعُوا أي الصدوقيون كلام الرسل في تكرار الحكم عليهم بأنهم قتلة المسيح وفي بيان على أنهم لم يسكتوا على وفق أمرهم والوعظ بيسوع أمامهم.
حَنِقُوا اغتاظوا غيظاً شديداً وعلة غيظهم تطاول أولئك الصيادين عليهم وهم في المحاكمة متهمين بأن نسبوا إلى الرؤساء أفظع الآثام. وكان حنق الصدوقيين أعظم لأن تعليم الرسل سند اعتقاد الفريسيين القيامة.
يَتَشَاوَرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ عزموا على ذلك في قلوبهم بلا حكم مجلسي وأظهروا ذلك بالإمارات والأقوال وكان موضوع تشاورهم كيفية قتل الرسل.
وعلى ما ذُكر يتبين أن الكنيسة المسيحية الصغيرة كانت يومئذ في شديد الخطر لأن كل مدبريها كانوا بين أيدي أرباب المجلس الذين امتلأت قلوبهم حنقاً عليهم وعزموا على قتلهم والذي منعهم من ذلك أمر أعجب من إطلاق الملاك إيّاهم من السجن وهو محاماة غمالائيل عنهم.
٣٤ «فَقَامَ فِي ٱلْمَجْمَعِ رَجُلٌ فَرِّيسِيٌّ ٱسْمُهُ غَمَالاَئِيلُ، مُعَلِّمٌ لِلنَّامُوسِ، مُكَرَّمٌ عِنْدَ جَمِيعِ ٱلشَّعْبِ، وَأَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ ٱلرُّسُلُ قَلِيلاً».
ص ٢٢: ٣
فَقَامَ كعادتهم في الخطاب المجلسي.
فِي ٱلْمَجْمَعِ أي مجلس السبعين.
فَرِّيسِيٌّ انظر شرح (متّى ٢: ٧) وهو من فرقة تعتقد القيامة التي ينكرها الصدوقيون.
غَمَالاَئِيلُ اسم شائع بين اليهود. الظاهر أن هذا الرئيس كان مائلاً إلى الحرية الدينية أكثر من سائر أعضاء المجلس وأنه كان أحلم منهم يحب العدل والإنصاف لكن لا دليل على أنه تنصر بعد ذلك. وقيل أنه حفيد الرباني المشهور المسمّى هليل وأن خليفة هليل ابنه سمعان أبو غمالائيل وظن البعض أن سمعان هذا هو الشيخ الذي حمل المسيح على ذراعيه في الهيكل (لوقا ٢: ٣٢) ولكن ليس من دليل قاطع على صحة ذلك. والأرجح أن غمالائيل أحد مشاهير اليهود السبعة في تواريخهم. ولا بد من أنه سمع مشورة نيقوديموس في المجلس من جهة يسوع (يوحنا ٧: ٥٠ و٥١) ولعله كان كنيقوديموس ويوسف الرامي في أنهما لم يكونا موافقين لرأي الرؤساء وعملهم في قتل المسيح (لوقا ٢٣: ٥١).
مُعَلِّمٌ لِلنَّامُوسِ أي توراة موسى (متّى ١٥: ٣) وهو من الكتبة الذين يكتبون الكتاب ويفسرونه ويشرحون التقاليد ولشهرة هذا المعلم قصده شاول (أي بولس) من طرسوس ليأخذ العلم عنه (ص ٢٢: ٣).
مُكَرَّمٌ لعلمه وحكمته وتقواه وعلى ذلك يكون رأيه عندهم معتمداً.
أَنْ يُخْرَجَ ٱلرُّسُلُ كعادة المجالس عند المذاكرة (ص ٤: ١٥) لكي لا يسمع المشكو عليهم ما يتكلمون. ولعل غمالائيل أمر حينئذ بإخراجهم لمعرفته أن وجودهم في المجلس يهيج حنق الصدوقيين فلا يستطيعون أن يسمعوا مشورته ويتدبروها ولكي لا يطمع الرسل في معصية المجلس بناء على محاماته عنهم.
٣٥ «ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلإِسْرَائِيلِيُّونَ، ٱحْتَرِزُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ جِهَةِ هٰؤُلاَءِ ٱلنَّاسِ فِي مَا أَنْتُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ تَفْعَلُوا».
ٱحْتَرِزُوا لا تفعلوا شيئاً بالغيظ خوفاً من الجور على الناس ومن غضب الله عليكم.
فِي مَا أَنْتُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ تَفْعَلُوا أي في الحكم عليهم بالموت والتشاور في الوسائل إلى ذلك. واستنتج أن ذلك مقصودهم من إمارات وجوههم ومن أقوالهم.
٣٦ «لأَنَّهُ قَبْلَ هٰذِهِ ٱلأَيَّامِ قَامَ ثُودَاسُ قَائِلاً عَنْ نَفْسِهِ إِنَّهُ شَيْءٌ، ٱلَّذِي ٱلْتَصَقَ بِهِ عَدَدٌ مِنَ ٱلرِّجَالِ نَحْوُ أَرْبَعِمِئَةٍ، ٱلَّذِي قُتِلَ، وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ ٱنْقَادُوا إِلَيْهِ تَبَدَّدُوا وَصَارُوا لاَ شَيْءَ».
غاية غمالائيل أن يردهم عن عزمهم على قتل الرسل (ع ٣٨) وأورد لهم مثلين في (ع ٣٧ و٣٨) بياناً أنه إن كان الرسل خادعين تلاشت قوتهم بعد قليل ولم يبق لهم من أثر وإن كانوا صادقين فالمقاومة لهم عبث وأثم.
قَبْلَ هٰذِهِ ٱلأَيَّامِ المدة غير معينة.
قَامَ أي للثورة والعصيان.
ثُودَاسُ اسم شائع بين اليهود لم يُذكر في غير هذا الموضع ولكن ذكر يوسيفوس المؤرخ اليهودي إنساناً آخر بهذا الاسم عصى الدولة الرومانية لكنه كان بعد خمس عشرة سنة من تلك المحاكمة وتبعه ألوف لكن هذا لم يتبعه سوى أربع مئة.
قَائِلاً عَنْ نَفْسِهِ إِنَّهُ شَيْءٌ لعله ادعى أنه نبي أو أنه المسيح المنتظر لأن الذين ادعوا ذلك في تلك الأيام كانوا كثيرين.
ٱلْتَصَقَ بِهِ أي آمن به واتّبعه.
صَارُوا لاَ شَيْءَ فمع أن ذلك الرجل نجح في أول أمره كانت عاقبته الهوان والانكسار والموت. وغاية غمالائيل من هذه القصة التلميح إلى أنه تكون آخرة الرسل كآخرة ثوداس.
٣٧ «بَعْدَ هٰذَا قَامَ يَهُوذَا ٱلْجَلِيلِيُّ فِي أَيَّامِ ٱلٱكْتِتَابِ، وَأَزَاغَ وَرَاءَهُ شَعْباً غَفِيراً. فَذَاكَ أَيْضاً هَلَكَ، وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ ٱنْقَادُوا إِلَيْهِ تَشَتَّتُوا».
لوقا ٢: ١
ذكر يوسيفوس ثلاثة رجال اسم كل منهم يهوذا أثاروا الفتن مدة أربع سنين فخص بالذكر واحداً منهم وعيّنه بأنه جليلي كما في هذا الخطاب إلا أنه قال وُلد في جمالة وسكن في الجليل. فالأرجح أن هذا هو الذي ذكره غمالائيل.
أَيَّامِ ٱلٱكْتِتَابِ هذا ليس الاكتتاب الذي ذُكر في (لوقا ٢: ١) لأن ذلك كان عند ميلاد المسيح وأما هذا فبعده بنحو ست سنين أو سبع وفيه أمر أوغسطس قيصر أمبراطور الرومانيين بأخذ الجزية من كل اليهود فقاوم يهوذا ذلك وهيّج الشعب للمقاومة على أن تأدية الجزية لملك أرضي نفي معاهدتهم لله اللمك السماوي (متّى ٢٢: ١٧). قال يوسيفوس أن الثورة عُظمت يومئذ فأزالها الرومانيون بالقوة وقتلوا كثيرين من العصاة في الحرب وصلبوا كثيرين من الأسرى بعد ذلك. وغاية غمالائيل من هذا الخبر كغايته من الخبر الذي قبله.
٣٨ «وَٱلآنَ أَقُولُ لَكُمْ: تَنَحَّوْا عَنْ هٰؤُلاَءِ ٱلنَّاسِ وَٱتْرُكُوهُمْ! لأَنَّهُ إِنْ كَانَ هٰذَا ٱلرَّأْيُ أَوْ هٰذَا ٱلْعَمَلُ مِنَ ٱلنَّاسِ فَسَوْفَ يَنْتَقِضُ».
إشعياء ٨: ١٠ ومتّى ١٥: ١٣
تَنَحَّوْا عَنْ هٰؤُلاَءِ أي دعوهم وشأنهم ولا تقاوموهم لأن مقاومتهم إما لا داعي إليها وإما لا نفع منها. علم غمالائيل لنباهته أن المقاومة كثيراً ما تعظم الأمور الزهيدة الخلافية وأن تركها يؤول إلى فتور المقاومين وتوانيهم وإما إتيانها فيهيّج الغيرة والتعصب.
هٰذَا ٱلرَّأْيُ أي قصد الرسل أن يخدعوا ويكذبوا بأن يسوع قام من الأموات وأنه المسيح.
هٰذَا ٱلْعَمَلُ الذي أتاه الرسل ليثبتوا رأيهم.
مِنَ ٱلنَّاسِ دون الله.
يَنْتَقِضُ أي يبطل بدون اجتهادكم كما يتضح من المثالين اللذين أوردتهما لكم.
٣٩ «وَإِنْ كَانَ مِنَ ٱللّٰهِ فَلاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَنْقُضُوهُ، لِئَلاَّ تُوجَدُوا مُحَارِبِينَ لِلّٰهِ أَيْضاً».
أمثال ٢١: ٣٠ ولوقا ٢١: ١٥ و١كورنثوس ١: ٢٥ ص ٧: ٥١ و٩: ٥ و٢٣: ٩
وَإِنْ كَانَ مِنَ ٱللّٰهِ أي إن كان الله منشئه.
فَلاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَنْقُضُوهُ لأن الله غير متغير في رأيه وقادر على عمله. وقد ثبت بمقتضى هذا القانون الذي ذكره غمالائيل صحة الدين المسيحي لأن الناس استفرغوا المجهود في أن يلاشوه بهزئهم والسجون والسيف ولم يستطيعوا ملاشاته.
تُوجَدُوا مُحَارِبِينَ لِلّٰهِ بمقاومتكم الرسل الذين أرسلهم وتكون تلك المقاومة إثماً وعبثاً وعلى الفرضين يجب ترك المقاومة.
ومن العجب أن يكون هذا الإنسان مثل تلك الحكمة لتقديم مثل هذا النصح. ذهب بعضهم إلى أنه كان مسيحياً في القلب ولكن لا دليل على ذلك. والظاهر أنه إنسان نبيه يحب العدل والإنصاف استخدمه الله ليجري مقاصده ويحمي كنيسته من الإبادة ولكنه لم يتكلم بالوحي وكلامه ليس بقانون ديني لأنه ليس بقاعدة مطردة أن الضلالة لا تنجح لأنه قد نجحت أحياناً نجاحاً عظيماً ولكن لا بد للحق أخيراً من أن يغلب الباطل فلا يجوز لنا أن نجعل نجاح ديانة من الديانات دليلاً على صحتها وعدم نجاحها في الحال دليلاً على بطلانها. وإذا اعتقدنا بطلان أحد التعاليم وجب أن لا نتنحى عنه كل التنحي لكي يتلاشى من نفسه بل أن نبطله بالوسائط الأدبية لا بالوسائط السياسية. فقانون غمالائيل لم يستوف كل واجبات أعضاء المجلس لأنه كان يجب عليهم باعتبار أنهم رؤساء الشعب في الدين أن يبحثوا عن صحة دعوى الرسل ويسلموا بها بعد الإثبات لوفرة الوسائل إلى ذلك.
٤٠ «فَٱنْقَادُوا إِلَيْهِ. وَدَعَوْا ٱلرُّسُلَ وَجَلَدُوهُمْ، وَأَوْصَوْهُمْ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمُوا بِٱسْمِ يَسُوعَ، ثُمَّ أَطْلَقُوهُمْ».
تثنية ٢٥: ٢ ومتّى ١٠: ١٧ و٢٣: ٣٤ ومرقس ١٣: ٩ ص ٤: ١٨
فَٱنْقَادُوا إِلَيْهِ لما ظهر لهم من الحكمة في نصحه ولاعتبارهم إيّاه فعدلوا عن قصدهم قتل الرسل لكنهم لم ينقادوا إلى تركهم أبداً.
وَجَلَدُوهُمْ أربعين جلدة إلا جلدة كما جُلد بولس خمس مرات (٢كورنثوس ١١: ٢٤). وهذا إتمام لنبوءة يسوع (متّى ١٠: ١٧) وعلّة جلدهم إياهم خوفهم من سقوط اعتبارهم عند الشعب إذا صرفوهم بلا قصاص والأرجح أنهم أتوا ذلك أيضاً ليشفوا شيئاً من غيظهم. ولعلهم ظنوا أن الرسل يخجلون من الشعب لجلدهم علناً فيكفوا عن التعليم حياء. ولأن ذلك كان عندهم عاراً شديداً نهى الرومانيون عن جلد إنسان روماني.
وَأَوْصَوْهُمْ الخ كما غفلوا سابقاً مرتين بلا فائدة (ص ٤: ٨ و٥: ٢٨).
٤١ «وَأَمَّا هُمْ فَذَهَبُوا فَرِحِينَ مِنْ أَمَامِ ٱلْمَجْمَعِ، لأَنَّهُمْ حُسِبُوا مُسْتَأْهِلِينَ أَنْ يُهَانُوا مِنْ أَجْلِ ٱسْمِهِ».
متّى ٥: ١٢ ورومية ٥: ٣ و٢كورنثوس ١٢: ١٠ وفيلبي ١: ٢٩ وعبرانيين ١٠: ٣٤ ويعقوب ١: ٢ و١بطرس ٤: ١٣ و١٦
فَرِحِينَ لا خجلين كما توقّع المجلس أن يكون ولم تكن علة فرحهم ألم الضرب والإهانة بالضرورة بل خمسة أمور:
- الأول: أنهم قاسوا ذلك وهو يجرون إرادة الرب.
- الثاني: أنهم ماثلوا به سيدهم الذي تألم بمثله لأجلهم (قابل هذا بما في ٣: ١٠ وكولوسي ١: ٢٤ و١بطرس ٤: ١٣).
- الثالث: أنهم اتخذوا ما أصابهم دليلاً على أنهم أصدقاء المسيح وتابعوه على وفق قول بولس في نفسه «إَنِّي حَامِلٌ فِي جَسَدِي سِمَاتِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ» (غلاطية ٦: ١٧) وعلى وفق أنباء سيدهم بأنهم يُضطهدون من أجل اسمه (متّى ١٠: ١٧ و٢٢ انظر أيضاً ٢كورنثوس ١٢: ١٠ وفيلبي ١: ٢٩ ويعقوب ١: ٢).
- الرابع: معرفتهم أن احتمالهم الاضطهاد من جملة الوسائل إلى انتشار الإنجيل.
- الخامس: معرفتهم أنه أُعد لهم إكليل المجد إثابة لهم على شدائدهم وعلى هذا امتثلوا لأمر المسيح وهو قوله «اِفْرَحُوا وَتَهَلَّلُوا، لأَنَّ أَجْرَكُمْ عَظِيمٌ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ» (متّى ٥: ١٢).
لأَنَّهُمْ حُسِبُوا مُسْتَأْهِلِينَ أي عدّهم الله أهلاً لينوبوا عن المسيح في احتمال الشدائد كما عدهم أهلاً للنيابة عنه في التعليم فكانوا شهوداً بالحق كما كانوا شهداء فيه. وكذلك رؤساء اليهود حسبوهم نواباً عن المسيح فعاملوهم معاملتهم إيّاه.
أَنْ يُهَانُوا بالجلد. كان قصد الرؤساء إهانتهم بذلك وكذا اعتبره العامة وأما الرسل فاعتبروه شرفاً لما ذُكر في نهاية الآية.
مِنْ أَجْلِ ٱسْمِهِ اضطهد الرسل أعداؤهم لاعترافهم باسم يسوع وأما هم ففرحوا بما أُهينوا لأن ذلك الاسم تمجّد باحتمالهم الإهانة بالصبر. وما برح أهل العالم من ذلك الوقت إلى هذه الساعة يضطهدون الذين تسموا باسم المسيح فإنهم سجنوهم وجلدوهم واتهموهم بأفظع الجنايات وسلبوا أموالهم وعذبوهم وقتلوهم بالإحراق والسيف والصلب. وما برح المسيحيون من ذلك العهد إلى الآن يفرحون بالنوازل والأرزاء حباً لذلك الاسم المحبوب ويوقنون أنهم يُثابون قولاً وفعلاً (متّى ١٠: ٢٥ ويوحنا ١٥: ١٨ - ٢٠).
٤٢ «وَكَانُوا لاَ يَزَالُونَ كُلَّ يَوْمٍ فِي ٱلْهَيْكَلِ وَفِي ٱلْبُيُوتِ مُعَلِّمِينَ وَمُبَشِّرِينَ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ».
ص ٢: ٤٦ و٤: ٢٠ و٢٩
لاَ يَزَالُونَ لم يمكن تهديد الرؤساء أن يمنع الرسل من التكلم علانية بالإنجيل ولا ما لاقوا منهم من الاضطهاد.
كُلَّ يَوْمٍ فِي ٱلْهَيْكَلِ انظر شرح (ص ٢: ٤٦).
وَفِي ٱلْبُيُوتِ (٢تيموثاوس ٤: ٢). الوعظ على المنابر بفصاحة ليس كل ما يجب على الرعاة فعليهم أيضاً أن يزوروا الناس ويعلموهم في البيوت ويخاطبوا المرضى في مضاجعهم ويرشدوا الأولاد.
مُبَشِّرِينَ هذه أول مرة لورود التبشير في سفر الأعمال بمعنى الوعظ ويسمى أيضاً «كرازة» (ص ٨: ٥ و١٠: ٣٧) و «مناداة» (ص ٤: ٢ و١٧: ١٨) و «تعليماً» (ص ٢: ٤٢ و٤: ٢ و١٨) و «شهادة» (ص ٤: ٣٣ و٢٣: ١١).
الأصحاح السادس
تعيين الشمامسة وعلته ع ١ إلى ٨
١ «وَفِي تِلْكَ ٱلأَيَّامِ إِذْ تَكَاثَرَ ٱلتَّلاَمِيذُ، حَدَثَ تَذَمُّرٌ مِنَ ٱلْيُونَانِيِّينَ عَلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ أَنَّ أَرَامِلَهُمْ كُنَّ يُغْفَلُ عَنْهُنَّ فِي ٱلْخِدْمَةِ ٱلْيَوْمِيَّةِ».
ص ٢: ٤١ و٤: ٤ و٥: ١٤ وع ٧ ص ٩: ٢٩ و١١: ٢٠ ص ٤: ٣٥
فِي تِلْكَ ٱلأَيَّامِ لا دليل على طول المدة بين حوادث هذا الأصحاح وحوادث الأصحاح الذي قبله ولعله كان قد مر على الكنيسة ما بين ثلاث سنين وسبع سنين وهو تنمو وتزيد على رغم المضطهدين.
تَكَاثَرَ ٱلتَّلاَمِيذُ عدل لوقا عن تعيين عدد أعضاء الكنيسة منذ بلغوا خمسة آلاف (ص ٥: ١٤). وكانت كثرتهم علة التعسر على الرسل أن يتمموا كل الواجبات الزمنية والروحية للكنيسة حتى لا يُهمل واحدة منها.
حَدَثَ تَذَمُّرٌ أي أُظهر الغضب واللوم. أنه كان للتلاميذ في أول عهد الكنيسة «قلب واحد ونفس واحدة» (ص ٤: ٣٣) واستطاع الرسل أن يوزعوا على فقرائهم عطايا الأغنياء حتى لا يُترك أحد منهم في حاجة (ص ٤: ٣٤) ولكن بعدما كبرت الكنيسة لم يقدر الرسل أن يلتفتوا إلى كل فرد من المحتاجين. ولعله حدث ما يحمل على التذمر وربما تذمر البعض لسبب غير كاف لأن الشيطان مستعد أن يهيج الحسد والطمع في قلوبهم.
مِنَ ٱلْيُونَانِيِّينَ عَلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ وكلاهما من أعضاء الكنيسة ومن اليهود أصلاً ولكن اليونانيين امتازوا عن العبرانيين بسكنهم في غير اليهودية أي في البلاد الوثنية واتخذوا اللغة اليونانية بمنزلة العبرانية. وسُمي هؤلاء وأمثالهم «شتاتاً» (انظر شرح يوحنا ٧: ٣٥ وانظر يعقوب ١: ١ و١بطرس ١: ١). وأما العبرانيون فكانوا يسكنون اليهودية وبقوا على لغتهم الآرامية وهي العبرانية الممزوجة بالكلدانية. فاليهود العبرانيون اعتبروا أنفسهم أقدس من اليونانيين لأنهم بقوا في أرض الآباء والأنبياء وهي أرض الميعاد حيث الهيكل وممارسة كل الشعائر الدينية وأنهم تكلموا باللغة المقدسة. فالنصرانية لم تُزل كل أسباب الخلاف بينهم فلم يزل بين الفريقين الظنون والريب.
أَرَامِلَهُمْ كُنَّ يُغْفَلُ عَنْهُنَّ في توزيع إحسان الكنيسة الذي كان يُوزع على المحتاجين كل يوم (ص ٤: ٣٥) وكانت الكنيسة أكثر ما تعتني بالأرامل وكذا يجب (١تيموثاوس ٥: ٣ و٩ و١٠ و١٦ ويعقوب ١: ٢٧) ولا يلزم من ذلك أن التوزيع كان مقصوراً على الأرامل لكن لم ينشأ تذمر إلا من جهتين وكان موزعو الإحسان الرسل وهم عبرانيون (ص ٤: ٣٥) ولعلهم وكلوا ذلك إلى بعض أخصائهم والأرجح أنهم كانوا عبرانيين أيضاً. ولم يتضح من سياق الكلام هل كان لذلك التذمر من علة كافية أو لا. ومما لا ريب فيه أنه إن كان قد غُفل عن أولئك الأرامل فذلك ليس عن عمد بل عن سهو وقع لمقتضيات الأحوال ومنها كثرة المحتاجين وقلة الموزعين. ويحتمل أن الأرامل اليونانيات لم يكن معروفاً أنهن محتاجات لكونهنّ غريبات في اليهودية. وهذا خطر ثالث وقعت فيه الكنيسة في طفوليتها فكانت عرضة للانشقاق من الحسد بين الأعضاء المختلفي الجنس. وأنقذها الرسل بالحكمة والتدبير. وكان الخطر الأول من الاضطهاد من خارج ونجت الكنيسة منه بشجاعة الرسل وعناية الله ونصيحة غمالائيل. والثاني من دخول المرائين الطمعين في الكنيسة وهذا نجت منه بعقاب حنانيا وسفيرة.
٢ «فَدَعَا ٱلٱثْنَا عَشَرَ جُمْهُورَ ٱلتَّلاَمِيذِ وَقَالُوا: لاَ يُرْضِي أَنْ نَتْرُكَ نَحْنُ كَلِمَةَ ٱللّٰهِ وَنَخْدِمَ مَوَائِدَ».
لم يظهر أن الرسل استاءوا من تلك التهمة ولا أنهم اعتذروا إنما اقتدوا بموسى في تدبيره (خروج ١٨: ٢٥) فإنهم وكلوا إلى غيرهم بعض سلطانهم فخففوا عنهم العناء ودفعوا الظنون وأحسنوا العناية بالمحتاجين وأنقذوا الكنيسة من خطر الانشقاق.
جُمْهُورَ ٱلتَّلاَمِيذِ أي أعضاء الكنيسة. ولا يلزم من ذلك أنهم جمعوا كل أفراد المؤمنين الذين بلغ عددهم ألوفاً يومئذ لكنهم جمعوا كثيرين ممن تهمهم تلك المسئلة.
لاَ يُرْضِي أي لا يحسن عند العقلاء.
نَحْنُ أي الرسل.
كَلِمَةَ ٱللّٰهِ أي التبشير.
وَنَخْدِمَ مَوَائِدَ أي نوزع الإحسان على فقراء الكنيسة. «فخدمة الموائد» كناية عن ذلك إما لاستعمال الصيارفة إياها لوضع النقود عليها (متّى ٢١: ١٢ ويوحنا ٢: ١٥) وإما لاتخاذها موضعاً للطعام والشراب (متّى ١٥: ٢٨ ولوقا ٢٢: ٢١) ويتضح مما ذُكر أربعة أمور:
- الأول: أن المسيح لم يرتب نظاماً للكنيسة وكذلك الرسل في أول الأمر فتركوا ذلك لتنتظم حسب مقتضيات الحال بإرشاد الروح القدس. وكان في هذا الأمر فرق عظيم بين الكنيسة اليهودية في أول عهدها والكنيسة المسيحية فإن نظام تلك رتبه الله وأعلنه للشعب على يد موسى وكان واسعاً مدققاً.
- الثاني: أنه على الكنيسة أمران التعليم الديني والاعتناء بالفقراء وكل الأديان توجب الأول ولا يهتم بالثاني كما ينبغي سوى الدين المسيحي. فالكنيسة المسيحية علاوة على اجتهادها في التعليم تعتني كل الاعتناء بالفقراء فكم شادت من المستشفيات والمارستانات والملاجئ والمتصدقات.
- الثالث: أنه لا يستطيع أرباب رتبة واحدة من خدم الكنيسة القيام بالحاجات الروحية والجسدية فإن اعتنت الاعتناء الواجب بالتبشير لزم أن تعمل الاعتناء بتوزيع الإحسان وإن اعتنت كما يجب بالصدقات قصرت عن الواجبات الروحية.
- الرابع: أن الاعتناء بنفوس الناس مقدم على الاعتناء بأجسادهم فيجب على خدم الدين أن يبذلوا الجهد في الأول أكثر مما يبذلونه في الثاني فعلى راعي الكنيسة أن لا يرتبك بالجسديات وعلى الكنيسة أن لا تكلفه بها بل تمهد السبيل إلى ذلك بوسيلة أخرى.
٣ «فَٱنْتَخِبُوا أَيُّهَا ٱلإِخْوَةُ سَبْعَةَ رِجَالٍ مِنْكُمْ، مَشْهُوداً لَهُمْ وَمَمْلُوِّينَ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَحِكْمَةٍ، فَنُقِيمَهُمْ عَلَى هٰذِهِ ٱلْحَاجَةِ».
تثنية ١: ١٣ وص ١: ٢١ و١٦: ٢ و١تيموثاوس ٣: ٧
ٱنْتَخِبُوا أي أنتم. وأمروا الشعب بذلك لأمرين:
الأول: أن توزيع الإحسان مما يهمه فقط فلاق أن يعيّن هو الموزعين الذين يريدهم ولكن الرسل أبانوا الصفات الواجبة على الموزعين ورسموهم.
الثاني: تسكيت المتذمرين لأنهم إذا كانوا هم المنتخبين رضوا بتصرف المنتخبين بخلاف ما لو انتخبهم الرسل ولا يبقى بعد ذلك من داع للظنون والتذمر على الرسل.
سَبْعَةَ رِجَالٍ هذا عدد كاف للخدمة المطلوبة ولو زادوا على ذلك لوقع الارتباك. ومن المعلوم أن عدد السبعة من الأعداد المقدسة عند اليهود لكن لا دليل على أنهم اقتنعوا إلى ذلك هنا.
مِنْكُمْ أي الحزبين اليونانيين والعبرانيين.
مَشْهُوداً لَهُمْ بالاستقامة فيجب على كل صاحب رتبة أن يكون حسن الصيت كما هو حسن الصفات.
مَمْلُوِّينَ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وعلامة ذلك تقواهم وسيرتهم المقدسة لا فعل المعجزات.
وَحِكْمَةٍ في تدبير الأمور العالمية فالتقوى بلا حكمة لا تكفي أمين صندوق الحسنات. وصفات هؤلاء الخدم فُصلت في (١تيموثاوس ٣: ٨ - ١٠).
فَنُقِيمَهُمْ بوضع الأيادي والصلاة (ع ٦) وبهذا يحصلون على اعتبار الشعب وعلى سلطان من الرسل.
هٰذِهِ ٱلْحَاجَةِ أي توزيع الإحسان على الأرامل وسائر المحتاجين فلم يقيموهم للتبشير. فإذاً لم يكونوا من رتبة الإكليروس التي هي دون رتبة الرسل. ولأن الحاجة التي عيّنوا لها دائمة في الكنيسة دامت رتبتهم أيضاً.
٤ «وَأَمَّا نَحْنُ فَنُواظِبُ عَلَى ٱلصَّلاَةِ وَخِدْمَةِ ٱلْكَلِمَةِ».
ص ٢: ٤٢
هذان الأمران هما الضروريان في الأعمال الرسولية فلم يرد الرسل أن يعيقهم عنهما الأمور الجسدية.
ٱلصَّلاَةِ نستنتج بدلالة القرينة أن المقصود «بالصلاة» هنا الصلاة الجمهورية وهذا لا يمنع من الحكم بأن الرسل واظبوا على الصلاة الانفرادية لأن ذلك مما لا يستغني المسيحي عنه.
وَخِدْمَةِ ٱلْكَلِمَةِ أي التبشير بالإنجيل لأنه الواسطة التي عيّنها الله لإرشاد الناس إلى طريق الخلاص وتقديس نفوسهم. وشرط التبشير الصحيح أن يكون المبشر به كلمة الله وأن يكون المبشرون أناساً مختبرين قوتها. ولا فعل للتبشير إلا بقوة الروح القدس وتلك تُنال بواسطة الصلاة فلذلك ذُكر الأمران معاً فلا تكفي الصلاة بدون التبشير ولا التبشير بدون الصلاة.
٥ «فَحَسُنَ هٰذَا ٱلْقَوْلُ أَمَامَ كُلِّ ٱلْجُمْهُورِ، فَٱخْتَارُوا ٱسْتِفَانُوسَ، رَجُلاً مَمْلُوّاً مِنَ ٱلإِيمَانِ وَٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ، وَفِيلُبُّسَ، وَبُرُوخُورُسَ، وَنِيكَانُورَ، وَتِيمُونَ، وَبَرْمِينَاسَ، وَنِيقُولاَوُسَ دَخِيلاً أَنْطَاكِيّاً».
ص ١١: ٢٤ ص ٨: ٥ و٢٦ و٢١: ٨
ٱسْتِفَانُوسَ ذُكر أول السبعة لأنه اشتهر بعد قليل بأنه أول شهداء الكنيسة المسيحية.
رَجُلاً مَمْلُوّاً مِنَ ٱلإِيمَانِ وَٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ لا يلزم من هذا أن الستة الباقين وسائر أعضاء الكنيسة لم يكونوا كذلك لكنه امتاز على الجميع في التقوى والإيمان وتأثير الروح فيه.
فِيلُبُّسَ وهذا اشتهر بأنه مبشر السامرة (ص ٨: ٥ - ٢٥) ومبشر خصي كنداكة ملكة الحبش وذُكر أنه كان مبشراً في قيصرية بعد خمس وعشرين سنة من ذلك وأنه كان له أربع بنات يتنبأنَ (أعمال ٢١: ٨).
وَنِيقُولاَوُسَ دَخِيلاً أي أنه كان وثنياً أصلاً ثم هاد واختتن. واستثناؤه بذلك دون غيره يدل على أن الباقين يهود أصلاً. ولا داعي إلى ما ظنه البعض من أنه رئيس شيعة النيقولاويين المذكورة في (رؤيا ٢: ٦ و١٥). وأكثر أسماء السبعة يوناني وهذا لا يوجب قطعاً أنهم يونانيون لأنه كان لكثيرين من اليهود اسمان أحدهما يوناني والآخر عبراني والأرجح أن أكثرهم من اليهود اليونانيين لكي لا يبقى من سبيل إلى التذمر (ع ١).
أَنْطَاكِيّاً انظر شرح (ص ١٣: ١) ولا معرفة لنا بشيء من أمور الباقين من السبعة إذ لم يُذكر بعد هذا شيء منها ولا أسماؤهم.
٦ «ٱلَّذِينَ أَقَامُوهُمْ أَمَامَ ٱلرُّسُلِ، فَصَلُّوا وَوَضَعُوا عَلَيْهِمِ ٱلأَيَادِيَ».
ص ١: ٢٤ و٨: ١٧ و٩: ١٧ و١٣: ٣ و١تيموثاوس ٤: ١٤ و٥: ٢٢ و٢تيموثاوس ١: ٦
فَصَلُّوا أي طلبوا بركة الله عليهم.
وَوَضَعُوا عَلَيْهِمِ ٱلأَيَادِيَ ذُكر وضع اليد أولاً حين بارك يعقوب ابني يوسف (تكوين ٤٨: ١٣ - ٢٠) ثم حينما عيّن موسى يشوع خليفة له (عدد ٢٧: ١٨) وذُكر في الإنجيل عند منح الروح القدس (ص ٨: ١٧) وفي رسامة خدم الدين (ص ١٣: ٣ و١تيموثاوس ٥: ٢٢ وعبرانيين ٦: ٢) فهو مقترن بالصلاة أبداً وأتاه المصلي إشارة إلى أن البركة التي يطلبها تستقر على الذي وضع هو عليه يده فإذاً لم يقصد به أن البركة من المصلي نفسه.
والمراد بذلك الوضع في الرسامة بيان أن الذي وُضعت الأيدي عليه أخذ سلطاناً من الواضعين على ممارسة الخدمة الدينية. والشمامسة المذكورون هنا مختارون من الشعب لكنهم أخذوا سلطان الممارسة من الرسل. وهذه الإشارة بقيت للكنيسة من أول عهدها مع المعمودية والعشاء الرباني. وهؤلاء لم يُسموا في أعمال الرسل شمامسة بل «السبعة» وإنما ذُكر اسم الشماس وصفاته وعمله وما يجب عليه في الرسائل (١تيموثاوس ٣: ٨ - ١٢ وفيلبي ١: ١).
٧ «وَكَانَتْ كَلِمَةُ ٱللّٰهِ تَنْمُو، وَعَدَدُ ٱلتَّلاَمِيذِ يَتَكَاثَرُ جِدّاً فِي أُورُشَلِيمَ، وَجُمْهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْكَهَنَةِ يُطِيعُونَ ٱلإِيمَانَ».
ص ١٢: ٢٤ و١٩: ٢٠ وكولوسي ١: ٦ يوحنا ١٢: ٤٢
في هذه الآية بيان تقدم الكنيسة بعد تخلصها من خطر الانشقاق من تذمر البعض وذكر الكاتب مثل هذا التقدم على أثر تخلص الكنيسة من مخاطر أخرى (ص ٤: ٤ و٥: ١٤).
كَلِمَةُ ٱللّٰهِ أي مناداة الرسل بيسوع المسيح وإنجيله.
تَنْمُو أي الكنيسة بواسطة الكلمة.
جُمْهُورٌ كَثِيرٌ كان عدد الكهنة الذين رجعوا من بابل ٤٢٨٩ ولا بد من أنهم زادوا بعد ذلك.
مِنَ ٱلْكَهَنَةِ هذا أول ما سمعنا أن أحداً من الكهنة آمن بالمسيح وتبعه وهو برهان قاطع على انتصار الإنجيل لأن للكهنة دواعي كثيرة تحملهم على البقاء في الكنيسة اليهودية وممارسة رموزها والخضوع للرؤساء. ومن شأن منزلتهم أن تميل بهم إلى النخر والكبرياء فيكرهوا أن يسلموا بتعليم الجليليين ويقبلوا تعليم الصليب الوضيع. ولعل انشقاق حجاب الهيكل عند موت يسوع على الصليب أثر في قلوبهم فأعدهم لقبول تأثير غيره من الروحيات. وتنصّر أولئك الكهنة خسرهم مقامهم ورتبتهم وأسباب معاشهم.
يُطِيعُونَ ٱلإِيمَانَ أي آمنوا. ومعنى «الإيمان» هنا الدين المسيحي كما في (رومية ١: ٥ و١٦: ٢٦). وسمّي الدين بالإيمان لأن من مبادئه الجوهرية الإيمان بالمسيح غير المنظور وتفضيل الأمور الروحية التي لا ترى (مرقس ١٦: ١٦ ورومية ١٠: ١٦). فإيمان الكهنة بالمسيح رفع عن هذا الاسم العار اللازم عن قول الفريسيين «أَلَعَلَّ أَحَداً مِنَ ٱلرُّؤَسَاءِ أَوْ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ آمَنَ بِهِ؟» (يوحنا ٧: ٤٨).
٨ «وَأَمَّا ٱسْتِفَانُوسُ فَإِذْ كَانَ مَمْلُوّاً إِيمَاناً وَقُوَّةً، كَانَ يَصْنَعُ عَجَائِبَ وَآيَاتٍ عَظِيمَةً فِي ٱلشَّعْبِ».
موت استفانوس شهيداً بعد هذا وتأثيره العظيم حملا لوقا على ذكره وبيان أسباب قتله. وكان استفانوس ممن انتخبوا لخدمة الكنيسة في الزمنيات لكنه لم يقتصر عليها فبشّر بالكلمة.
مَمْلُوّاً إِيمَاناً أي كثير الثقة بصدق الإنجيل وصحة دعوى يسوع أنه المسيح ابن الله وثبوت مواعيده وهذا جعله غيوراً في المناداة وشجاعاً في تعريض نفسه للخطر ووصفه الكاتب كما وصف برنابا في (ص ١١: ٢٤).
وَقُوَّةً ظهرت في عمل المعجزات.
كَانَ يَصْنَعُ عَجَائِبَ الخ لم يقصر الله نعمته على الرسل ليبشّروا ويفعلوا الآيات.
مقاومة اليهود لاستفانوس ع ٩ إلى ١٥
٩ «فَنَهَضَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْمَجْمَعِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ مَجْمَعُ ٱللِّيبَرْتِينِيِّينَ وَٱلْقَيْرَوَانِيِّينَ وَٱلإِسْكَنْدَرِيِّينَ، وَمِنَ ٱلَّذِينَ مِنْ كِيلِيكِيَّةَ وَأَسِيَّا، يُحَاوِرُونَ ٱسْتِفَانُوسَ».
فَنَهَضَ لمقاومته فنجاح استفانوس العظيم هيّج ما كان قد سكن من اضطهاد المقاومين.
ٱلْمَجْمَعِ انظر الشرح (متّى ٤: ٢٣) قيل في كتب اليهود أنه كان في أورشليم أربع مئة وثمانون مجمعاً وإذا حكمنا على أن ذلك مبالغة فلا بد من الحامل عليها هو كثرة تلك المجامع لأنه كان لكل صنف من غرباء اليهود الذين كانوا يأتون من بلاد مختلفة لحضور الأعياد في أورشليم مجمع مخصوص أو أكثر.
ٱللِّيبَرْتِينِيِّينَ الأرجح أنهم يهود أصلاً أسرهم الرومانيون وأخذوهم إلى إيطاليا عبيداً ثم حررهم فسموا لذلك «بالليبرتينيين» أي المحرَّرين. وهم كثيرون لأن بمبيوس القائد الروماني لما استولى على اليهودية سنة ٦٣ ب. م. جلب ألوفاً معه إلى رومية.
ٱلْقَيْرَوَانِيِّينَ الذين من القيروان في أفريقية وكان سمعان الذي حمل صليب المسيح من هناك (انظر شرح متّى ٢٧: ٣٢) وهي مدينة كبيرة قال يوسيفوس أن ربع سكانها يهود أخذهم بطليموس لاغوس إلى هنالك. وكان بعضهم في أورشليم للاحتفال بيوم «الخمسين» (ص ٢: ١٠) وذُكروا أيضاً في (ص ١١: ٢٠ و١٣: ١).
وَٱلإِسْكَنْدَرِيِّينَ أي سكان الإسكندرية في مصر وكانت وقتئذ ثانية رومية في العظمة. وهي على مصب نهر النيل الغربي بناها اسكندر الكبير سنة ٣٣٢ قبل الميلاد وكان محيطها يومئذ خمسة عشر ميلاً وكان فيها ثلاث مئة ألف من الأحرار ومثلهم من العبيد. وكانت مركز علم اليونان وتمدنهم في أفريقية. وكثر اليهود في مصر منذ سبي باب وذلك نحو ست مئة سنة قبل الميلاد. وأخذ بطليموس الأول كثيرين من أسرى اليهود إلى الاسكندرية وأمر بترجمة العهد القديم من العبرانية إلى اليونانية في نحو سنة ٣٠٠ قبل الميلاد وسمّيت الترجمة بترجمة السبعين لظنهم أن الذين ترجموها كانوا نحو سبعين. وأعطى اسكندر اليهود ثلث الاسكندرية حين أكمل بناءها وجعلهم مساوين لليونانيين في الحقوق. وقيل أنه كان نحو خُمس سكان تلك المدينة في أيام المسيح من اليهود وبلغ عدد الإسرائيليين يومئذ في كل مصر نحو ألف ألف.
كِيلِيكِيَّةَ ولاية في آسيا الصغرى على الجنوب الشرقي منها شمالي قبرس وتُعرف اليوم ببر الأناضول وكانت قاعدتها طرسوس حيث وُلد شاول الذي هو بولس الرسول (ص ٩: ١١) ولا بد من أنه حضر ذلك المجمع لأنه من كيليكية ويُحتمل أنه جادل استفانوس هناك.
أَسِيَّا هي الجزء الغربي من آسيا الصغرى الذي كانت قاعدته أفسس (ص ٢: ٩) وكان يشتمل على ميسيا وكاريا وليديا.
يُحَاوِرُونَ ٱسْتِفَانُوسَ أي كان علماء تلك المجامع يناظرون استفانوس في أمر يسوع الذي صرح استفانوس أنه المسيح وأن تعليمه تعليم الله أُثبت بنبؤات العهد القديم وبما صنعه هو من المعجزات.
١٠ «وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُقَاوِمُوا ٱلْحِكْمَةَ وَٱلرُّوحَ ٱلَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِ».
خروج ٤: ١٦ وإشعياء ٥٤: ١٧ ولوقا ٢١: ١٥ وص ٥: ٣٩
وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُقَاوِمُوا أي أنهم لم يستطيعوا دفع حججه التي حجّهم بها من كتبهم وأثبتها بأدلته وأوضحها بفصاحة وعلم كأفضل علمائهم. ويمكننا معرفة ما أورده من الحجج من الجدول الآتي:
| قابل إشعياء ٤٠: ٣ |
مع مرقس ١: ٣ |
| ملاخي ٣: ١ |
مع متّى ١١: ١٠ |
| قابل إشعياء ٨: ١٤ و ٩: ١ |
مع متّى ٤: ١٤ |
| قابل إشعياء ٦١: ١ |
مع لوقا ٤: ١٨ |
| قابل مزمور ٧٨: ٢ |
مع متّى ١٣: ٣٥ |
| قابل مزمور ١١٨: ٢٢ |
مع لوقا ٢: ٣٤ وأعمال ٤: ١١ و١٣: ٤١ |
| قابل مزمور ٤١: ٩ وزكريا ١١: ١٢ |
مع يوحنا ١٣: ١٨ ومتّى ٢٦: ١٥ و٢٧: ٩ و١٠ |
| قابل زكريا ١٢: ١٠ |
مع يوحنا ١٩: ٣٧ |
| قابل إشعياء ٥٣: ٩ ومزمور ٦: ١٠ |
مع متّى ١٢: ٤٠ وأعمال ٢: ٢٧ |
| قابل مزمور ١١٠: ١ |
مع أعمال ٢: ٣٣ وعبرانيين ١: ١٣ |
ٱلْحِكْمَةَ أي معرفة كتب اليهود الدينية وتفاسيرها.
وَٱلرُّوحَ الخ المراد «بالروح» هنا النشاط والرغبة والإخلاص مما بيّن أنه كان متيقناً صحة ما تكلم به وأهميته. ولا ريب في أن ذلك الروح كان من مواهب الروح القدس.
١١ «حِينَئِذٍ دَسُّوا لِرِجَالٍ يَقُولُونَ: إِنَّنَا سَمِعْنَاهُ يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمِ تَجْدِيفٍ عَلَى مُوسَى وَعَلَى ٱللّٰهِ».
١ملوك ٢١: ١٠ و١٣ ومتّى ٢٦: ٥٩ و٦٠
لما عجزوا عن غلبة استفانوس بالحق لجأوا إلى الباطل وشرعوا يهيّجون الشعب المتعصب عليه وهيّجوا بذلك الرؤساء.
حِينَئِذٍ دَسُّوا لِرِجَالٍ أي علموهم سراً أن يسمعوا كلام استفانوس ويحرّفوه ليشهدوا عليه بالرديء كما فعلوا بالمسيح (متّى ٢٦: ٦٠ و٦١).
إِنَّنَا سَمِعْنَاهُ لم يبيّنوا متى سمعوا ذلك والأرجح أنه كان في محاورتهم له في المجامع.
بِكَلاَمِ تَجْدِيفٍ انظر شرح (متّى ٩: ٣) ولا بد من أن قولهم تهمة باطلة لأنه عظّم الله واحترم موسى لكن يمكننا أن نستنتج من دعواهم ما كان يقوله.
عَلَى مُوسَى لعل استفانوس قال أن يسوع مشترع أعظم من موسى وأن الذبائح والتطهيرات وسائر الرموز التي أمر بها قاصرة عن التكفير عن الخطيئة وتبرير الخاطئ وأنه لا بد من زوالها وأن العبادة الروحية القلبية تجوز في كل مكان وزمان ولكنهم حرّفوا كلامه ليجعلوه تجديفاً.
وَعَلَى ٱللّٰهِ لأنه قال أن يسوع ابن الله وهو عندهم تجديف. وما حسبوه تجديفاً على موسى حسبوه تجديفاً على الله الذي أرسله فإنهم لم يعرفوا أن الشريعة ليست سوى «ظل الخيرات العتيدة».
١٢ «وَهَيَّجُوا ٱلشَّعْبَ وَٱلشُّيُوخَ وَٱلْكَتَبَةَ، فَقَامُوا وَخَطَفُوهُ وَأَتَوْا بِهِ إِلَى ٱلْمَجْمَعِ».
وَهَيَّجُوا ٱلشَّعْبَ أتوا ذلك لمعرفتهم أن مقاومتهم له تكون عبثاً إذا كان الشعب معه لأن رضى الشعب عن الرسل منع الرؤساء سابقاً من البطش بهم (ص ٥: ٢٦) فأرسلوا الذين دسوا إليهم الكلام إلى الناس ليتكلموا معهم في المجامع أو البيوت ويقولوا لهم أن استفانوس أهان دينهم وجدّف على نبيّهم فهيّجوا بذلك بغضهم وتعصبهم عليه. وأتى مثل هذا رؤساء الكهنة على المسيح في آخر أسبوع من حياته على الأرض حتى أن الجموع الذين ترحبوا به عند دخوله إلى أورشليم بقولهم «أوصنا الخ» صرخوا بعد أربعة أيام قائلين «اصلبه اصلبه» (متّى ٢٦: ٦٥ و٢٧: ٢٠).
وَٱلشُّيُوخَ من أعضاء المجلس.
وَٱلْكَتَبَةَ انظر شرح (متّى ٢: ٤).
ٱلْمَجْمَعِ أي مجمع السبعين (متّى ٢: ٤) وكان لذلك المجمع حق الحكم في كل أمر من الأمور الدينية. وكان الصدوقيون من أولئك الأعضاء هم خصوم الرسل في أول الأمر لمناداتهم بالقيامة وأما هنا فهاج غضب الفريسيين أيضاً لغيرتهم على شريعة موسى والهيكل.
١٣، ١٤ «١٣ وَأَقَامُوا شُهُوداً كَذَبَةً يَقُولُونَ: هٰذَا ٱلرَّجُلُ لاَ يَفْتُرُ عَنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ تَجْدِيفاً ضِدَّ هٰذَا ٱلْمَوْضِعِ ٱلْمُقَدَّسِ وَٱلنَّامُوسِ، ١٤ لأَنَّنَا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ: إِنَّ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ هٰذَا سَيَنْقُضُ هٰذَا ٱلْمَوْضِعَ، وَيُغَيِّرُ ٱلْعَوَائِدَ ٱلَّتِي سَلَّمَنَا إِيَّاهَا مُوسَى».
ص ٢٥: ٨ دانيال ٩: ٢٦
شُهُوداً كَذَبَةً هم الذين أُعدوا (ع ١١) ليحرّفوا كلام استفانوس ولذلك التحريف دعاهم الكاتب «كذبة».
ضِدَّ هٰذَا ٱلْمَوْضِعِ ٱلْمُقَدَّسِ أي الهيكل والظاهر من هذا أنهم كانوا مجتمعين حينئذ في إحدى أدور الهيكل.
وَٱلنَّامُوسِ أي شريعة موسى.
ٱلنَّاصِرِيَّ نعتوه بذلك للإهانة.
سَيَنْقُضُ هٰذَا ٱلْمَوْضِعَ سمى لوقا أولئك الشهود «كذبة» فلا برهان على أن استفانوس قال ما اتهموه به لأن المسيح نفسه لم يقله. لكنه ربما ذكر قول المسيح «أَنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ، لاَ فِي هٰذَا ٱلْجَبَلِ (أي جرزيم)، وَلاَ فِي أُورُشَلِيمَ تَسْجُدُونَ لِلآبِ» (يوحنا ٤: ٢١). ولعله أشار إلى ما أنبأ به المسيح من أن الأمم ستهدم الهيكل (متّى ص ٢٤) فنسبوا إليه ما أسنده في أنبائه إلى الأمم.
وَيُغَيِّرُ ٱلْعَوَائِدَ لا نظن استفانوس قال ذلك لأن الرسل لم يصدقوا حينئذ ذلك التغيير وما اعتقدوه إلا على مرور الزمان وبعد الرؤى السماوية وتعليم الروح القدس واجتماعهم للمشورة (ص ١٠: ١٤ و١١: ٢ و١٥: ٢٠ و٢١: ٢٠). ولا يُظن فضلاً عن أن ذلك لم يكن اعتقاده أن إنساناً مثله «مملوءاً من الحكمة والروح» يعبر عن الحق بأسلوب يهيّج غضب الناس عليه ويمنعهم من قبول التعليم. والمراد «بالعوائد» هنا الذبائح والأصوام والأعياد اليهودية والتمييز بين الأطعمة وتغييرها إما أن يكون بإلغائها أو بإبدالها بغيرها. ولعل اتهامهم إياه بذلك كله مبنيّ على قول المسيح «ٱنْقُضُوا هٰذَا ٱلْهَيْكَلَ وَفِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أُقِيمُهُ» (يوحنا ٢: ١٩) وقوله «إِنَّهُ لاَ يُتْرَكُ هٰهُنَا حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ لاَ يُنْقَضُ» (متّى ٢٤: ٢) ونحو ذلك مما نقله استفانوس عن المسيح.
١٥ «فَشَخَصَ إِلَيْهِ جَمِيعُ ٱلْجَالِسِينَ فِي ٱلْمَجْمَعِ، وَرَأَوْا وَجْهَهُ كَأَنَّهُ وَجْهُ مَلاَكٍ».
وَجْهَهُ كَأَنَّهُ وَجْهُ مَلاَكٍ عبّر العهد القديم بمثل هذا التشبيه عن أرباب الحكمة السامية (تكوين ٣٣: ١٠ و٢صموئيل ١٤: ١٧ و١٩: ٢٧) والأرجح أن المعنى هنا أنه لم يظهر على وجهه شيء من إمارات الخوف أو الغضب أو الكبرياء بل ظهرت عليه علامات الاطمئنان والحلم والرضى والبراءة لأن إحساسات قلبه قد طُبعت على وجهه وسرّ بأنه شهد للحق وامتلأ قلبه رجاء بالسعادة الأبدية وإن عُرف أنه سيقتل في سبيل المسيح.
وذهب البعض أن وجهه كان يلمع كما لمع وجه موسى عندما نزل من جبل سينا (خروج ٣٤: ٢٩ و٣٠ و٢كورنثوس ٣: ٧ و١٣) والأرجح أنه لم يكن شيء من المعجزات في منظره.
الأصحاح السابع
احتجاج استفانوس ١ إلى ٥٣
١ «فَسَأَلَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ: أَتُرَى هٰذِهِ ٱلأُمُورُ هٰكَذَا هِيَ؟».
متّى ٢٦: ٦٢
لعله كان قد مرّ على الكنيسة منذ موت المسيح إلى ما حدث هنا نحو سبع سنين.
فَسَأَلَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ لأن ذلك مما يختص به باعتبار أنه رئيس المجلس.
أَتُرَى هٰذِهِ ٱلأُمُورُ هٰكَذَا هِيَ أي أمذنب أنت بما أُشتكي عليك أم بريء منه هل جدفت على موسى وعلى الله أو لا.
٢ «فَأَجَابَ: أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلإِخْوَةُ وَٱلآبَاءُ، ٱسْمَعُوا. ظَهَرَ إِلٰهُ ٱلْمَجْدِ لأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ فِي مَا بَيْنَ ٱلنَّهْرَيْنِ، قَبْلَمَا سَكَنَ فِي حَارَانَ».
ص ٢٢: ١ تكوين ١١: ٣١
علينا أن نلاحظ في خطاب استفانوس أربعة أمور:
- الأول: أن ذلك الخطاب غير كامل لأن صراخ السامعين قطعه.
- الثاني: أن بولس على ما يرجح سمع ذلك الخطاب وأنبأ به لوقا لأن لوقا كان رفيقه في أسفاره ولشدة المشابهة بين ما قاله استفانوس في خطابه وما كتبه بولس في رسائله (قابل ع ٥٣ مع غلاطية ٣: ٩ وع ٤٨ مع ص ١٧: ٢٤).
- الثالث: أن خطاب استفانوس كأنه مختصر الرسالة إلى العبرانيين في إعلان نسبة الديانة اليهودية إلى الديانة المسيحية.
- الرابع: أن غاية هذا الخطاب ثلاثة أمور:
- الأول: تبرئته نفسه مما اتهموه به وهو التجديف على الله وموسى وأتى ذلك بإقامة البراهين على أن ظهور الله غير مقصور على أورشليم لأنه ظهر لإبراهيم ما بين النهرين وليوسف في مصر ولموسى في البرية وفي طور سينا وفي خيمة الشهادة قبل بناء الهيكل. وأبان من قول موسى نفسه أن العوائد الموسوية ليست بأبدية لأنه أنبا بمجيء نبي آخر فلزم من ذلك أن يكون تعليم آخر ما كان تعليم موسى سوى استعداد له.
- الثاني: بيان حقيقة ما نادى به.
- الثالث: إعلان أن اليهود برفضهم أن يسوع هو المسيح تمردوا على الله كما تمرد عليه آباؤهم في كل أيام تاريخ الأمة. ولا ريب في أنه لو تركوه يكمل خطابه لختمه بالمناداة بالمغفرة والمصالحة بواسطة دم يسوع الذي سفكوه كما ختم بطرس موعظته في (ص ٢ و٣). وسلك استفانوس في هذا الخطاب أحسن سبل الحكمة لبلوع الغاية.
أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلإِخْوَةُ وَٱلآبَاءُ هذا الخطاب مما اعتاد أن يخاطب به أعضاء المجلس فأظهر به الاحترام لهم ولرتبتهم.
إِلٰهُ ٱلْمَجْدِ أي الله المستحق كل المجد والإكرام وبهذا أظهر وفرة احترامه لإله إسرائيل ودفع عنه اتهامهم إيّاه بأنه جدف على الله. وفي هذه النسبة إشارة إلى الضياء اللامع الذي ظهر الله به في السحابة النيّرة وفي قبة العهد والهيكل (خروج ٢٤: ١٦ و٣٣: ١٨ و٤٠: ٣٤ ولاويين ٩: ٢٣ وعدد ١٤: ١٠ وتثنية ٥: ٢٤).
لأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ افتخر اليهود بنسبتهم إلى إبراهيم (متّى ٣: ٩) فصرّح استفانوس بها هنا استعطافاً لهم.
وَهُوَ فِي مَا بَيْنَ ٱلنَّهْرَيْنِ في أور الكلدانيين حيث سكن إبراهيم أولاً (تكوين ١١: ٢٨) وهي واقعة بين نهري دجلة والفرات. وما قاله استفانوس هنا من مصدرين تواريخ اليهود الشائعة بينهم سوى الكتاب المقدس وترجمة السبعين التي تختلف في بعض الأمور عن الأصل العبراني.
قَبْلَمَا سَكَنَ فِي حَارَانَ حاران موضع غربي الفرات حيث مات تارح (تكوين ١١: ٣٢) وهرب يعقوب إليه من عيسو أخيه (تكوين ٢٧: ٤٣). ولا منافاة بين ما قيل هنا وما قيل في (تكوين ١١: ٣١ و١٢: ١) ما يتبين منه أن الله ظهر لإبراهيم في حاران بعدما ترك أُور الكلدانيين لأنه دعاه مرتين كما يتضح من قوله تعالى «أَنَا ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أُورِ ٱلْكِلْدَانِيِّينَ لِيُعْطِيَكَ هٰذِهِ ٱلأَرْضَ لِتَرِثَهَا» (تكوين ١٥: ٧ ويشوع ٢٤: ٣ ونحميا ٩: ٧). وذكر فيلو المؤرخ اليهودي في تاريخه أن الله دعا إبراهيم مرتين فكلم الله إبراهم في أور وفي حاران ومعاهدته هنالك برهان قاطع على أن ظهور الله للناس غير مقصور على هيكل أورشليم وأن عبادته ليست محصورة فيه وأنه هو لم يجدف بما قاله في هذا المعنى.
٣ «وَقَالَ لَهُ: ٱخْرُجْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ، وَهَلُمَّ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي أُرِيكَ».
تكوين ١٢: ١
مِنْ عَشِيرَتِكَ نفهم من ذلك أن الله أنبأه بأنه ينفصل عن أهله وأقربائه نعم أن أباه تارح رافقه في جزء من الطريق لكنه لم يجاوز حاران.
إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي أُرِيكَ دعاه الله بهذا إلى الاتكال على حكمته تعالى ومحبته وصدق مواعيده وإلى الطاعة لأوامره وإنكار نفسه ودعوته إلى ذلك تشبه دعوة الإنسان إلى أن يكون مسيحياً (متّى ٢٨: ٢٧ و٢٩ ولوقا ١٤: ٣٣).
٤ «فَخَرَجَ حِينَئِذٍ مِنْ أَرْضِ ٱلْكِلْدَانِيِّينَ وَسَكَنَ فِي حَارَانَ. وَمِنْ هُنَاكَ نَقَلَهُ، بَعْدَ مَا مَاتَ أَبُوهُ، إِلَى هٰذِهِ ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي أَنْتُمُ ٱلآنَ سَاكِنُونَ فِيهَا».
تكوين ١١: ٣١ و١٢: ٤ و٥
بَعْدَ مَا مَاتَ أَبُوهُ قيل في تكوين ١١: ٢٦ «وَعَاشَ تَارَحُ سَبْعِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ أَبْرَامَ وَنَاحُورَ وَهَارَانَ» وقيل في تكوين ١٢: ٤ «وَكَانَ أَبْرَامُ ٱبْنَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً لَمَّا خَرَجَ مِنْ حَارَانَ». لو لم يكن لنا سوى هذين النبأين لاستنتجنا أن تارح بلغ سن المئة والخامسة والأربعين لما خرج إبراهيم من حاران. وعلى ما قال استفانوس هنا أن إبراهيم لم يبارح حاران إلا بعد موت أبيه. فلنا منه ومما قبله أن تارح لم يتجاوز سن المئة والخامسة والأربعين لكن جاء في تكوين ١١: ٣٢ ما نصّه «وَكَانَتْ أَيَّامُ تَارَحَ مِئَتَيْنِ وَخَمْسَ سِنِينَ. وَمَاتَ تَارَحُ فِي حَارَانَ». فالفرق بين هذا وما استنتجناه ستون سنة وتُدفع شبهة الاختلاف بأن معنى ما قيل في تكوين ١١: ٢٦ أنه لم يولد لتارح ولد قبل سن السبعين وولد له بعد ذلك ثلاثة بنين بدون تعيين زمن الولادة ويبعد عن الظن أن الثلاثة وُلدوا في يوم واحد أو سنة واحدة وأن إبراهيم أصغر الثلاثة وذكره أولاً لا يمنع من ذلك سام قبل يافث مع أن ساماً هو الأصغر (قابل ما في تكوين ٥: ٣٢ بما في تكوين ١٠: ٢١). ومما يؤيد هذا القول أن إسحاق ابن إبراهيم تزوج حفيدة ناحور بنت بتوئيل وهو أصغر بني ناحور وهم ثمانية (تكوين ٢٢: ٢٢ و٢٣). وعلى ذلك يكون حاران وُلد لتارح وتارح في سن السبعين حسب الكتاب ووُلد له إبراهيم وهو في سن المئة والثلاثين ولما بلغ المئتين والخامسة ومات كان إبراهيم قد بلغ الخامسة والسبعين وخرج من حاران.
لا ريب في أن استفانوس تكلم في ذلك حسب اعتقاد اليهود وإلا اعترضوا عليه ولم ينقل لوقا الغلط لأنهم كانوا جميعاً يعرفون تاريخ إبراهيم.
مِنْ أَرْضِ ٱلْكِلْدَانِيِّينَ أي من أُور (تكوين ١١: ٣١).
٥ «وَلَمْ يُعْطِهِ فِيهَا مِيرَاثاً وَلاَ وَطْأَةَ قَدَمٍ، وَلٰكِنْ وَعَدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مُلْكاً لَهُ وَلِنَسْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدُ وَلَدٌ».
تكوين ١٢: ٧ و١٣: ١٥ و١٥: ٣ و١٨ و١٧: ٨ و٢٦: ٣
لَمْ يُعْطِهِ فِيهَا مِيرَاثاً فعاش فيها عيشة الرحّل في انتقاله من مكان إلى مكان ولا مسكن دائم له ولا ملك يقيم به والدليل على ذلك افتقاره إلى أن يشتري قبراً من أهل البلاد (ع ١٦) ولا ينافي ذلك شراؤه مدفناً في حبرون من أولاد حثّ لأن ذلك لا يُعتبر ميراثاً للسكن.
وَلاَ وَطْأَةَ قَدَمٍ أي لا شيء والكلام جارٍ مجرى المثل (تثنية ٢: ٥).
وَلٰكِنْ وَعَدَ ومعنى ذلك الوعد أن تلك الأرض تكون لسلالته إكراماً له (تكوين ١٥: ٥).
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدُ وَلَدٌ ولا رجاء أن يكون له (تكوين ١٥: ٢٣ و١٨: ١١ و١٢) وذكر بولس تصديق إبراهيم وعد الله في تلك الأحوال دليل قاطع على قوة إيمانه (رومية ٤: ١٨).
٦ «وَتَكَلَّمَ ٱللّٰهُ هٰكَذَا: أَنْ يَكُونَ نَسْلُهُ مُتَغَرِّباً فِي أَرْضٍ غَرِيبَةٍ فَيَسْتَعْبِدُوهُ وَيُسِيئُوا إِلَيْهِ أَرْبَعَ مِئَةِ سَنَةٍ».
تكوين ١٥: ١٣ و١٦ خروج ١٢: ٤٠ وغلاطية ٣: ١٧
وَتَكَلَّمَ ٱللّٰهُ (تكوين ١٥: ١٣) والقول هنا منقول عن ترجمة السبعين وفيه وعد وبيان المدة التي تمر قبل إنجازه.
يَكُونَ نَسْلُهُ مُتَغَرِّباً ساكناً وقتياً كضيف وأجنبي.
فِي أَرْضٍ غَرِيبَةٍ بعضها أرض كنعان وأكثرها أرض مصر.
فَيَسْتَعْبِدُوهُ خروج ١: ١١.
وَيُسِيئُوا إِلَيْهِ أي يظلموه ويعذبوه.
أَرْبَعَ مِئَةِ سَنَةٍ بناء على قوله تعالى في (تكوين ١٥: ١٣). نحتاج إلى تفسير شيئين في هذا القول:
الأول: أنه جاء في خروج ١٢: ٤٠ إن مدة الغربة ٤٣٠ سنة وقال بولس في غلاطية ٣: ١٧ أن المدة من وقت الوعد لإبراهيم إلى إعطاء الشريعة في سيناء ٤٣٠ سنة فيظهر أن بين القول الأول والقولين بعده خلافاً وتدفع هذه الشبهة بأن موسى واستفانوس قالا «أربع مئة سنة» أي نحو أربع مئة باعتبار أنها أربعة قرون كاملة وغضّا النظر عن الكسر من القرن وهذا شائع لفظاً وكتابة للتقريب.
الثاني: تعيين الوقت الذي بداءة المدة المذكورة فظاهر الكلام هنا وفي خروج ١٢: ٤٠ أن الغربة والعبودية في تلك المدة كلها تكون في مصر والواقع ليس كذلك لأن الوقت من ولادة إسحاق إلى الخروج من مصر ٤٠٠ سنة والوقت من الوعد لإبراهيم ثلاثون سنة قبل ميلاد إسحاق وبيان ذلك ما يأتي:
فنفرض أن المدة بين وعد الله له وخروجه من حاران خمس سنين وأنه بقي في أرض كنعان قبل أن وُلد له إسماعيل ١١ سنة ومن ولادة إسماعيل إلى ميلاد إسحاق ١٤ سنة فالمجموع ثلاثون ومن ميلاد إسحاق إلى ميلاد يعقوب ٦٠ سنة ومن ميلاد يعقوب إلى ميلاد يوسف ٩٠ سنة ومن ميلاد يوسف إلى موته ١١٠ سنين ومن موت يوسف إلى ميلاد موسى ٦٠ سنة ومن ميلاد موسى إلى الخروج من مصر ٨٠ سنة فالجملة أربع مئة ومجموع المجموعين ٤٣٠ سنة. والذي يؤكد أن مدة العبودية في مصر لم تبلغ تلك المدة ما جاء في تكوين ٤٦: ٨ و١١ أن قهات وُلد قبلما نزل يعقوب إلى مصر وعاش ١٣٣ سنة (خروج ٦: ١٨) وعاش ابنه عمرام ١٣٧ سنة وكان عمر موسى ٨٠ سنة حين وقف أمام فرعون (خروج ٧: ٧) ومجموع حياتي قهات وعمرام ٢٧٠ سنة فإذا طرحنا من ذلك ٥٥ سنة وفرضناها ما عاشاه بعد ما وُلد لهما بقي ١٢٥ سنة. فعلينا أن نحسب الوقت من وعد الله لإبراهيم إلى الخروج من مصر الذي هو ٤٣٠ سنة وقت عبودية لأن إبراهيم ونسله كانوا فيه غرباء ونزلاء في أرض ليست لهم كما حسب بولس في (غلاطية ٣: ١٧) وأن استفانوس ذكر تلك المدة تقريباً.
٧ «وَٱلأُمَّةُ ٱلَّتِي يُسْتَعْبَدُونَ لَهَا سَأَدِينُهَا أَنَا، يَقُولُ ٱللّٰهُ. وَبَعْدَ ذٰلِكَ يَخْرُجُونَ وَيَعْبُدُونَنِي فِي هٰذَا ٱلْمَكَانِ».
خروج ٣: ١٢
فِي هٰذَا ٱلْمَكَانِ أي في أرض كنعان حيث كان الله يتكلم معه وهذا برهان على أن ظهور الله غير مقصور على الهيكل في أورشليم فما جرى في الماضي يمكن أن يجري في المستقبل فإذاً لم يجدف استفانوس إن كان قد قال ما يفيد ذلك. وعبّر استفانوس عن تبليغ الله لإبراهيم في وعده بما قاله تعالى لموسى حين ظهر له في العليقة ففي كلامه تلميح حسن إلى ظهور الله مرة أخرى في غير الهيكل.
٨ «وَأَعْطَاهُ عَهْدَ ٱلْخِتَانِ، وَهٰكَذَا وَلَدَ إِسْحَاقَ وَخَتَنَهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّامِنِ. وَإِسْحَاقُ وَلَدَ يَعْقُوبَ، وَيَعْقُوبُ وَلَدَ رُؤَسَاءَ ٱلآبَاءِ ٱلٱثْنَيْ عَشَرَ».
تكوين ١٧: ٩ الخ تكوين ٢١: ٢ الخ و٢٥: ٢٦ و٢٩: ٣١ الخ و٣٠: ٥ الخ و٣٥: ١٨ و٢٣ إلى ٢٦
وَأَعْطَاهُ عَهْدَ ٱلْخِتَانِ أي العهد الذي كان الختان علامته وختمه وذلك العهد هو أن يجعله أمة عظيمة وأن يكون أباً لأمم كثيرة وأن يكون الله إلهاً له ولنسله وأنه بنسله تتبارك كل قبائل الأرض (تكوين ١٧: ٩ - ١٣). وبهذه العلامة امتاز بنو إسرائيل عن سائر الشعوب وعرفوا أنهم شعب الله الخاص وورثة الوعد لإبراهيم.
وَهٰكَذَا أي بعدما أخذ العهد وعلامته.
وَلَدَ إِسْحَاقَ لم يذكر ولادة إسماعيل لأنه وُلد قبل العهد.
رُؤَسَاءَ ٱلآبَاءِ ٱلٱثْنَيْ عَشَرَ وهم أسلاف الأمة اليهودية وسماهم كذلك اعتباراً لهم كما في (عبرانيين ٧: ٤) ولأن كل واحد منهم رئيس عشيرة من الإسرائيليين.
٩ «وَرُؤَسَاءُ ٱلآبَاءِ حَسَدُوا يُوسُفَ وَبَاعُوهُ إِلَى مِصْرَ، وَكَانَ ٱللّٰهُ مَعَهُ».
تكوين ٣٧: ٤ و١١ و٢٨ ومزمور ١٠٥: ١٧ تكوين ٣٩: ٢ و٢١ و٢٣
حَسَدُوا يُوسُفَ لأن أباهم أظهر حبه له أكثر مما أظهره لهم (تكوين ٣٧: ٣ - ١١).
وَبَاعُوهُ إِلَى مِصْرَ كما قال يوسف لهم (تكوين ٤٥: ٥) أما هم فباعوه للاسماعيليين ليأخذوه إلى مصر اتباعاً لمشورة يهوذا لكي لا يقتلوه (تكوين ٣٧: ٢٥ - ٢٨).
ولعل استفانوس أراد أن يشير إلى معاملة إخوة يوسف ليوسف كانت مثل معاملة الرؤساء ليسوع الذي كان يوسف رمزاً له لأن كليهما اسلمه إخوته حسداً (تكوين ٣٧: ٢٨ ومتّى ٢٧: ١٨) وأن كليهما رفضه الناس واختاره الله وأن كليهما رُفع بعد إلى يمين العظمة وأن كلاً منهما أنقذ شعبه.
كان الله معه وحماه من الخطر وفرج عليه في الضيق ورقاه إلى الشرف وجعله واسطة خير عظيم.
١٠ «وَأَنْقَذَهُ مِنْ جَمِيعِ ضِيقَاتِهِ، وَأَعْطَاهُ نِعْمَةً وَحِكْمَةً أَمَامَ فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ، فَأَقَامَهُ مُدَبِّراً عَلَى مِصْرَ وَعَلَى كُلِّ بَيْتِهِ».
تكوين ٤١: ٣٧ و٤٢: ٦
مِنْ جَمِيعِ ضِيقَاتِهِ أي من العبودية والعار.
نِعْمَةً أي وجاهة.
وَحِكْمَةً أي قوة على تفسير أحلام الملك (تكوين ص ٤١).
فِرْعَوْنَ هو علم لكل ملك من ملوك مصر قديماً كما كان بطليموس بعد ذلك في تلك البلاد وقيصر في رومية وفي بعض ممالك أوربا اليوم.
مُدَبِّراً وزيراً ومشيراً (تكوين ٤١: ٤٠ - ٤٣).
بَيْتِهِ أي على بلاط الملك الذي تصدر منه الأوامر الملكية فإذاً كان يوسف الصدر الأعظم عند فرعون.
١١ «ثُمَّ أَتَى جُوعٌ عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ وَكَنْعَانَ، وَضِيقٌ عَظِيمٌ، فَكَانَ آبَاؤُنَا لاَ يَجِدُونَ قُوتاً».
تكوين ٤١: ٥٤
كما جاء في (تكوين ٤١: ٥٤).
وَكَنْعَان حيث يسكن يعقوب وعشيرته.
قُوتاً أي طعاماً لهم ولبهائهم.
١٢ «وَلَمَّا سَمِعَ يَعْقُوبُ أَنَّ فِي مِصْرَ قَمْحاً، أَرْسَلَ آبَاءَنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ».
تكوين ٤٢: ١
آبَاءَنَا أي عشرة من أبنائه وهم غير يوسف وبنيامين (خروج ٤١).
فِي مِصْرَ قَمْحاً كانت تلك الأرض قديماً شونة العالم لخصب وادي النيل حتى أن الرومانيين كانوا في أيام الرسل يجلبون القمح من مصر (أعمال ٢٧: ٦ و٣٨).
أَوَّلَ مَرَّةٍ (تكوين ٤٥: ٤).
١٣ «وَفِي ٱلْمَرَّةِ ٱلثَّانِيَةِ ٱسْتَعْرَفَ يُوسُفُ إِلَى إِخْوَتِهِ، وَٱسْتَعْلَنَتْ عَشِيرَةُ يُوسُفَ لِفِرْعَوْنَ».
تكوين ٤٥: ٤ و١٦
ٱلْمَرَّةِ ٱلثَّانِيَةِ (تكوين ٤٥: ١٦).
وَٱسْتَعْلَنَتْ عَشِيرَةُ يُوسُفَ لِفِرْعَوْنَ عرف فرعون سابقاً أن يوسف عبراني (تكوين ٤١: ١٢) وعرف حينئذ وصول بعض عشيرته ثم تعرّف بها أخيراً (تكوين ٤٧: ٢).
١٤ «فَأَرْسَلَ يُوسُفُ وَٱسْتَدْعَى أَبَاهُ يَعْقُوبَ وَجَمِيعَ عَشِيرَتِهِ، خَمْسَةً وَسَبْعِينَ نَفْساً».
تكوين ٤٥: ٩ و٢٧ و٤٦: ٢٧ وتثنية ١٠: ٢٢
(تكوين ٤٥: ١٧ و١٨ و٤٦: ١ - ٢٦).
خَمْسَةً وَسَبْعِينَ نَفْساً تبع استفانوس في ذلك ترجمة السبعين التي كانت شائعة بين اليهود يومئذ شيوع اللغة اليونانية. وجاء في هذه النسخة أن النفوس المختصة بيوسف في مصر كانوا تسعة وأن كل عشيرة يعقوب التي كانت مع يعقوب هنالك خمسة وسبعين وفي الأصل العبراني في (تكوين ٤٦: ٢٦ وخروج ١: ٥ وتثنية ١٠: ٢٢) أنهم كانوا سبعين وفي (تكوين ٤٦: ٢٦ وخروج ١: ٥ وتثنية ١٠: ٢٢ أنهم كانوا سبعين وفي تكوين ٤٦: ٢٩٠ في النسختين أن عدد النفوس الحقيقي الذي أتى مع يعقوب ستة وستون وزاد على هؤلاء في العبرانية أربعة يعقوب ويوسف وابنيه أفرايم ومنسى فكانوا سبعين. وأما ترجمة السبعين فزادت على هؤلاء خمسة أولاد أفرايم ومنسى المذكورة أسماؤهم في (١أيام ٧: ١٤ - ٢١). ولا نعلم لماذا زاد المترجمون أولئك الخمسة إنما نعلم أن ذلك هو الواقع وأن استفانوس ذكر كما قرأ وهذا يوافق قول يعقوب ليوسف «وَٱلآنَ ٱبْنَاكَ ٱلْمَوْلُودَانِ لَكَ فِي أَرْضِ مِصْرَ قَبْلَمَا أَتَيْتُ إِلَيْكَ إِلَى مِصْرَ هُمَا لِي. أَفْرَايِمُ وَمَنَسَّى كَرَأُوبَيْنَ وَشَمْعُونَ يَكُونَانِ لِي» (تكوين ٤٨: ٥). وقوله «استدعى تلك النفوس مع أن الذين استدعاهم أقل من ذلك اصطلاح للعبرانيين لأنهم كانوا يحسبون نسل الإنسان كأنه فيه» (عبرانيين ٧: ٩ و١٠). وغرض استفانوس ليس تعيين العدد تماماً بل إظهار أن الذين كانوا في أول أمرهم شرذمة صغيرة صاروا ببركة الله بعد زمن ليس بطويل أمة عظيمة كما في (تثنية ١٠: ٢٢).
١٥، ١٦ «١٥ فَنَزَلَ يَعْقُوبُ إِلَى مِصْرَ وَمَاتَ هُوَ وَآبَاؤُنَا، ١٦ وَنُقِلُوا إِلَى شَكِيمَ وَوُضِعُوا فِي ٱلْقَبْرِ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ إِبْرَاهِيمُ بِثَمَنٍ فِضَّةٍ مِنْ بَنِي حَمُورَ أَبِي شَكِيمَ».
تكوين ٤٦: ٥ و٤٩: ٣٣ وخروج ١: ٦ و١٣: ١٩ ويشوع ٢٤: ٣٢ ويوحنا ٤: ٥ تكوين ٢٣: ١٦ و٣٥: ١٩ تكوين ٣٤: ٢ و٦
وَمَاتَ (تكوين ٤٩: ٣٣) وكل بني يعقوب ماتوا قبل الخروج من مصر.
وَنُقِلُوا أي كل الآباء ما عدا يعقوب أباهم الذي دٌفن في حبرون (تكوين ٥٠: ١٣).
شَكِيمَ وهي التي تسمى نابلوس اليوم وهي شمالي أورشليم وعلى أمد أربعين ميلاً منها انظر شرح (يوحنا ٤: ٥). وقيل في العهد القديم «أن عظام يوسف دُفنت في شكيم» (يشوع ٢٤: ٣٢) ولم يذكر شيئاً من أمر عظام الآخرين والأرجح أنهم فعلوا بعظامهم كما فعلوا بعظامه ولا ريب أن استفانوس تكلم حسب اعتقاد اليهود بناء على ما سطر في تواريخهم.
ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ إِبْرَاهِيمُ ظن البعض أن بعض النسّاخ بدل اسم يعقوب باسم إبراهيم سهواً لأن ما كُتب في (تكوين ٣٣: ١٩ ويشوع ٢٤: ٣٢) أن يعقوب هو الذي اشتراه من أولاد حمور وأما الذي اشتراه إبراهيم فهو مغارة في حبرون اشتراها من اولاد حثّ وهذا أقرب احتمالاً من أن استفانوس غلط قدّام رؤساء المجلس وأن لوقا كتب كلامه بلا إصلاح ولا يبعد ذلك عن الناسخ لأنه لم يوح إليه ولم يكن من المعصومين. وظن آخرون أن إبراهيم اشترى أرضاً في شكيم وإن لم يُذكر نبأ ذلك في سفر التكوين لأنه قيل في تكوين ١٢: ٦ و٧ أن الله ظهر لإبراهيم في شكيم وبنى هناك مذبحاً للرب ولو لم يكن قد اشترى تلك الأرض لم يحق له أن يبني المذبح فيها فإن يعقوب حين أتى إلى هنالك وبنى مذبحاً اشترى قطعة الأرض لبنائه فيها (تكوين ٣٣: ١٨ - ٢٠) ولا عجب من وجود بيت حمور في أيام إبراهيم وأيام يعقوب لأننا عرفنا أن ذلك البيت كان باقياً خمس مئة سنة بعد ذلك (قضاة ٩: ٢٨) وظن غيرهم أن استفانوس لتكلّمه ارتجالاً في أمور معلومة عند الجميع اختار الاختصار فقال ما ذكر بدلاً من أن يقول نُقلوا إلى حبرون وشكيم ووُضع بعضهم (أي يعقوب) في القبر الذي اشتراه إبراهيم من أولاد حثّ وبعضهم في القبر الذي اشتراه يعقوب الخ.
١٧ «وَكَمَا كَانَ يَقْرُبُ وَقْتُ ٱلْمَوْعِدِ ٱلَّذِي أَقْسَمَ ٱللّٰهُ عَلَيْهِ لإِبْرَاهِيمَ، كَانَ ٱلشَّعْبُ يَنْمُو وَيَكْثُرُ فِي مِصْرَ».
تكوين ١٥: ١٣ وع ٦ خروج ١: ٧ الخ ومزمور ١٠٥: ٢٤ و٢٥
وَقْتُ ٱلْمَوْعِدِ أي وقت إنجاز الموعد.
كَانَ ٱلشَّعْبُ يَنْمُو (خروج ١: ٧ - ٩) ولما كان يتكاثر هذا الشعب عدداً وقوة خاف رؤساء المصريين من أن يقوى عليه في المستقبل.
١٨ «إِلَى أَنْ قَامَ مَلِكٌ آخَرُ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ يُوسُفَ».
قَامَ مَلِكٌ آخَرُ كما قيل في (خروج ١: ١٨). والأرجح أنه هو رعمسيس الثاني.
لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ يُوسُفَ أي لم يذكر إحسانه ولم يشكره أو يشعر بأنه مديون لعشيرته ونسله ومن المحال أنه لم يعرف شيئاً من أمر يوسف.
١٩ «فَٱحْتَالَ هٰذَا عَلَى جِنْسِنَا وَأَسَاءَ إِلَى آبَائِنَا، حَتَّى جَعَلُوا أَطْفَالَهُمْ مَنْبُوذِينَ لِكَيْ لاَ يَعِيشُوا».
خروج ١: ١٠ و٢٢
فَٱحْتَالَ هٰذَا أشار بهذا إلى ما فعله هذا الملك بغية تقليل عدد الإسرائيليين بقتل الذكور من مواليدهم (خروج ١: ٢٢).
أَسَاءَ إِلَى آبَائِنَا الخ ظاهر المعنى أن الملك أراد أن يغصب الآباء أن يطرحوا أولادهم ليموتوا وذلك أنه ضيّق على الآباء حتى فضلوا إماتة أولادهم على أن يعيشوا لعذاب كعذابهم. ويحتمل أنه بلغ مراده من بعض الآباء ولعله أمر الشرط أن يخطفوا الصبيان ويطرحوهم في النيل.
٢٠ «وَفِي ذٰلِكَ ٱلْوَقْتِ وُلِدَ مُوسَى وَكَانَ جَمِيلاً جِدّاً، فَرُبِّيَ هٰذَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فِي بَيْتِ أَبِيهِ».
خروج ٢: ٢ عبرانيين ١١: ٢٣
فِي ذٰلِكَ ٱلْوَقْتِ أي زمن الشدة والظلم (خروج ٢: ٢).
جَمِيلاً جِدّاً كذا قيل في (خروج ٢: ٢) قابل ذلك بما في (عبرانيين ١١: ٢٣) ونستنتج من هذا الكلام أنه نُبذ كثيرون من أطفال الإسرائيليين وأن جمال موسى كان علّة بقائه.
أَبِيهِ عمرام (خروج ٦: ٢٠).
٢١ «وَلَمَّا نُبِذَ، ٱتَّخَذَتْهُ ٱبْنَةُ فِرْعَوْنَ وَرَبَّتْهُ لِنَفْسِهَا ٱبْناً».
خروج ٢: ٣ الخ
نُبِذَ أي طُرح على شاطئ النيل (خروج ٢: ٣).
ٱبْنَةُ فِرْعَوْنَ قال يوسيفوس المؤرخ اليهودي أن اسمها ثرموتيس.
وَرَبَّتْهُ لِنَفْسِهَا أي تبنته (خروج ٢: ١٠) فنما وتعلّم في صرح فرعون فكان له أفضل الوسائط الموصلة إلى العلوم في مصر.
٢٢ «فَتَهَذَّبَ مُوسَى بِكُلِّ حِكْمَةِ ٱلْمِصْرِيِّينَ، وَكَانَ مُقْتَدِراً فِي ٱلأَقْوَالِ وَٱلأَعْمَالِ».
لوقا ٢٤: ١٩
حِكْمَةِ ٱلْمِصْرِيِّينَ اشتهرت مصر في الأزمنة القديمة بالعلوم كما جاء في (١ملوك ٤: ٣٠ وإشعياء ١٩: ١١ و١٢) ولذلك قصدها طلبة العلم من كل الأقطار حتى قصدها فلاسفة اليونان وكانوا أكثر ما يعتنون بالطبيعيّات والرياضيّات كعلم الطب والفلك والحساب والتنجيم وتفسير الأحلام وأسرار الدين المصري وكان معظم الأساتدة من الكهنة.
مُقْتَدِراً فِي ٱلأَقْوَالِ وَٱلأَعْمَالِ كان كذلك قبل أن خرج الإسرائيليون من مصر وقبلما هرب إلى مديان. وقال استفانوس ذلك بناء على ما عرفه من التاريخ وزاد على ما قاله استفانوس أن موسى كان رئيس جيش المصريين وأنه غلب الجيش عندما كانوا زاحفين إلى مصر. وأما شهادة موسى على نفسه بقوله «أَنَا ثَقِيلُ ٱلْفَمِ وَٱللِّسَانِ» (خروج ٤: ١٠) لا ينفي كونه مقتدراً في الأقوال لأن تلك الشهادة من باب التواضع والاستعفاء من الشروع في ما دعاه الله إليه.
٢٣ «وَلَمَّا كَمَلَتْ لَهُ مُدَّةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، خَطَرَ عَلَى بَالِهِ أَنْ يَفْتَقِدَ إِخْوَتَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ».
خروج ٢: ١١ الخ
أَرْبَعِينَ سَنَةً لم يرد ذكر لذلك في العهد القديم لكن اليهود اعتقدوا بناء على ما في تواريخهم أنه عاش أربعين سنة في مصر وأربعين سنة في مديان وأربعين سنة في البرية وهو يقود الإسرائيليين.
خَطَرَ عَلَى بَالِهِ لا ريب أن علة هذا الخطور روح الله الذي هو على كل فكر صالح.
أَنْ يَفْتَقِدَ أي يزورهم بغية إنقاذهم من العبودية ع ٢٥ ونستدل من ذلك على أن الإسرائيليين كانوا منفصلين عن المصريين وأن موسى لم يكن يخالطهم وهو في صرح فرعون ولم يرض أن يتنعم ويتعظم في ذلك الصرح الملكي وإخوته في الضيقة ولم يكتف بما فعله من أنباء ضيقهم فأراد أن يشاهد أحوالهم بنفسه.
٢٤ «وَإِذْ رَأَى وَاحِداً مَظْلُوماً حَامَى عَنْهُ، وَأَنْصَفَ ٱلْمَغْلُوبَ إِذْ قَتَلَ ٱلْمِصْرِيَّ».
وَاحِداً مَظْلُوماً أي إسرائيلياً ضربه مصري (خروج ٢: ١١ و١٢) ولعل ذلك الإنسان من المسخرين الذين كانوا يعينون أعمال بني إسرائيل في البناء.
٢٥ «فَظَنَّ أَنَّ إِخْوَتَهُ يَفْهَمُونَ أَنَّ ٱللّٰهَ عَلَى يَدِهِ يُعْطِيهِمْ نَجَاةً، وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَفْهَمُوا».
ع ٥١
ظن أن الإسرائيليين يفهمون من محاماته عن واحد منهم أنه مستعد أن يحامي عن الجميع وأن يتخذوه منقذاً لهم نظراً لسمو مرتبته وكونه منهم. وكلامه هنا يدل على أنه صار كلام بينه وبين شيوخ الشعب وأنهم رفضوا مداخلته في إنقاذهم من عبودية مصر كذلك رفض رؤساء اليهود مداخلة يسوع المسيح في إنقاذهم من عبودية الخطيئة والموت.
٢٦ «وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّانِي ظَهَرَ لَهُمْ وَهُمْ يَتَخَاصَمُونَ، فَسَاقَهُمْ إِلَى ٱلسَّلاَمَةِ قَائِلاً: أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ، أَنْتُمْ إِخْوَةٌ. لِمَاذَا تَظْلِمُونَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً؟».
خروج ٢: ١٣ الخ
ذكر هذا بياناً لرفضهم توسط موسى (خروج ٢: ١٣).
ظَهَرَ أي أتى بغتة.
وَهُمْ يَتَخَاصَمُونَ كان المتخاصمون جميعاً من العبرانيين فأراد موسى فض الخصام بالوعظ لا بالضرب كما فعل في أمر المصري.
أَنْتُمْ إِخْوَةٌ أي من أمة واحدة وشركاء في المصاب فيجب أن يحب بعضكم بعضاً ويساعد أحدكم الآخر لا أن يخاصمه. وكثيراً ما نرى أن الخصومة بين الإخوة والأقرباء على غاية شدتها والواجب أن تكون على خلاف ذلك.
٢٧ «فَٱلَّذِي كَانَ يَظْلِمُ قَرِيبَهُ دَفَعَهُ قَائِلاً: مَنْ أَقَامَكَ رَئِيساً وَقَاضِياً عَلَيْنَا؟».
لوقا ١٢: ١٤ وص ٤: ٧
قَرِيبَهُ أي يهودياً مثله.
دَفَعَهُ أي دفع موسى. ويغلب أن الظالم يكون أبعد عن الصلح من المظلوم لأنه لم يرتكب الظلم إلا لشدة حقده أو فرط طمعه فيرفض كل ما يعيقه عن نوال غرضه.
مَنْ أَقَامَكَ رَئِيساً الخ هذا استفهام إنكاري أي لم يقمك أحد الخ فترفض رئاستك. ومن كلمات واحد من الشعب نستدل على أفكار سائره وكان هذا الاستفهام شائعاً على ألسنة الظالمين عند رفضهم النصح. وأورد استفانوس هذا الكلام إيماء إلى أن آبائهم فعلوا ذلك بموسى كما فعلوا هم مثله بالمسيح وأنهم منذ أول عهدهم رفضوا رسل الله على أسلوب واحد.
٢٨ «أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ أَمْسَ ٱلْمِصْرِيَّ؟».
لم يظهر كيف عرف بقتل المصري ولعل الذي أُنقذ منه أخبر أصدقاءه (خروج ٢: ١١ و١٢).
٢٩ «فَهَرَبَ مُوسَى بِسَبَبِ هٰذِهِ ٱلْكَلِمَةِ وَصَارَ غَرِيباً فِي أَرْضِ مَدْيَانَ، حَيْثُ وَلَدَ ٱبْنَيْنِ».
خروج ٢: ١٥ و٢٢ و٤: ٢٠ و١٨: ٣ و٤
فَهَرَبَ لظنه أن الذي عرفه واحد يعرفه كثيرون وأن الخبر يبلغ فرعون فتكون حياته في خطر. وأصاب في ظنه لأنه قيل «فَسَمِعَ فِرْعَوْنُ هٰذَا ٱلأَمْرَ، فَطَلَبَ أَنْ يَقْتُلَ مُوسَى» (خروج ٢: ١٥).
وَصَارَ غَرِيباً لم يهرب إلى مديان للاستيطان فيها بل قصد أن ينزلها وقتياً.
فِي أَرْضِ مَدْيَانَ هي جزء من بلاد العرب شرقي البحر الأحمر ممتد من جبال حوريب إلى أرض موآب شمالاً وتلك الأرض برية يسكن أهلها غالباً الخيام وحلها موسى آمناً. والمديانيون سلالة إبراهيم من قطورة (خروج ٢٥: ٢ وأيوب ١: ٣٢).
وَلَدَ ٱبْنَيْنِ تزوج سفورة بنت كاهن مديان وكان له اسمان رعوئيل ويثرون (خروج ٢: ١٨ و٣: ١ وعدد ١٠: ٢٩) واسما ولدي موسى جرشون وأليعازر.
٣٠ «وَلَمَّا كَمَلَتْ أَرْبَعُونَ سَنَةً ظَهَرَ لَهُ مَلاَكُ ٱلرَّبِّ فِي بَرِّيَّةِ جَبَلِ سِينَاءَ فِي لَهِيبِ نَارِ عُلَّيْقَةٍ».
خروج ٣: ١ و٢ الخ
وَلَمَّا كَمَلَتْ أَرْبَعُونَ سَنَةً فبلغ موسى حينئذ سن الثمانين على ما في تواريخ اليهود. قيل في (خروج ٢: ٢٣) أن ملك مصر كان قد مات وهو رعمسيس الثاني.
مَلاَكُ ٱلرَّبِّ معنى «ملاك» رسول والأرجح أنه الأقنوم الثاني أي كلمة الله الأزلي كما يتضح من أماكن كثيرة في العهد القديم. وقد سمى «الرب» (ع ٣١ وخروج ٣: ٤ قابل ذلك بما في إشعياء ٦٣: ٩).
فِي بَرِّيَّةِ جَبَلِ سِينَاءَ أي البرية المجاورة ذلك الجبل. وسمي في (خروج ٣: ١) «جبل حوريب» وليس في ذلك من منافاة بين قول استفانوس وموسى وذلك إما لأنهما رأسان في جبل واحد ونُسبت البرية تارة إلى أحدهما وتارة إلى الآخر وأما هو الأرجح أن اسم السلسلة كلها حوريب وهي تشتمل على رؤوس كثيرة أشهرها سيناء.
فِي لَهِيبِ نَارِ ذكر استفانوس ذلك كما ظهر لموسى. وكثيراً ما يعبر الكتاب المقدس عن مظاهر الله بمثل هذا المنظر لما فيه من البهاء والمجد انظر (لوقا ٢: ٩ ومتّى ١٧: ١ - ٥ وأعمال ٩: ٣ و١٢: ٧) وبهذه الصورة ظهر لبني إسرائيل في البرية إذ كانت سحابة نيّرة تظللهم ليلاً وكان يظهر مثلها في قدس الأقداس في قبة الشهادة وفي هيكل سليمان. فبرهن استفانوس بذلك ما برهنه سابقاً بظهور الله لإبراهيم في أُور وحاران أن حضوره غير مقصور على الهيكل في أورشليم وعبادته ليست مقيدة بخدمة الكهنة وتقديم الذبائح وممارسة الطقوس.
٣١ «فَلَمَّا رَأَى مُوسَى ذٰلِكَ تَعَجَّبَ مِنَ ٱلْمَنْظَرِ. وَفِيمَا هُوَ يَتَقَدَّمُ لِيَتَطَلَّعَ، صَارَ إِلَيْهِ صَوْتُ ٱلرَّبِّ».
تَعَجَّبَ علة تعجبه أنه «َنَظَرَ وَإِذَا ٱلْعُلَّيْقَةُ تَتَوَقَّدُ بِٱلنَّارِ، وَٱلْعُلَّيْقَةُ لَمْ تَكُنْ تَحْتَرِقُ» بما يقتضيه طبع النار (خروج ٣: ٢ و٣).
صَوْتُ ٱلرَّبِّ لم ير موسى هيئة ما إنما سمع صوت الله يكلّمه كأنه يكلّمه من وسط العليقة المتوقدة.
٣٢ «أَنَا إِلٰهُ آبَائِكَ، إِلٰهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلٰهُ إِسْحَاقَ وَإِلٰهُ يَعْقُوبَ. فَٱرْتَعَدَ مُوسَى وَلَمْ يَجْسُرْ أَنْ يَتَطَلَّعَ».
متّى ٢٢: ٣٢ وعبرانيين ١١: ١٦
إِلٰهُ آبَائِكَ هم الذين ذكرهم بعد. ومعنى العبارة بين في شرح (متّى ٢٢: ٣٢). ونسبة الله إلى الآباء إشارة إلى أنه يحبهم ويذكر عهده لهم بأن يكون إلهاً لهم ولنسلهم بعدهم. وعلة تسمية نفسه بذلك لموسى كونه مزمعاً أن ينجز في ذلك الوقت مواعيد الآباء للبنين.
فَٱرْتَعَدَ مُوسَى قيل في (خروج ٣: ٦) أنه غطى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله.
٣٣ «فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ: ٱخْلَعْ نَعْلَ رِجْلَيْكَ، لأَنَّ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي أَنْتَ وَاقِفٌ عَلَيْهِ أَرْضٌ مُقَدَّسَةٌ».
خروج ٣: ٥ ويشوع ٥: ١٥
هذا مأخوذ بلفظه من (خروج ٣: ٥ - ٨).
ٱخْلَعْ نَعْلَ رِجْلَيْكَ كان ذلك علامة الاحترام وقتئذ كما هو في الشرق اليوم (يشوع ٥: ١٥) وكان الكهنة يخدمون في الخيمة وفي الهيكل حفاة.
أَرْضٌ مُقَدَّسَةٌ صارت كذلك بحضور الله وظهوره فيها. وينتج من ذلك أن الله يطلب علامات الاحترام علاوة عن الشعور به في القلب. وذكر استفانوس ذلك برهاناً على أن الله لم يحصر حضوره في الهيكل وأنه يوجد غيره من الأماكن المقدسة. وأن القول بذلك ليس بتجديف لأن ذلك المحل في البرية تقدس بحضور الله فيه منذ خمس مئة سنة قبل بناء الهيكل حيث لا كاهن ولا مذبح ولا ذبيحة. وهذا مثل قوله تعالى «ٱلسَّمَاوَاتُ كُرْسِيِّي وَٱلأَرْضُ مَوْطِئُ قَدَمَيَّ. أَيْنَ ٱلْبَيْتُ ٱلَّذِي تَبْنُونَ لِي، وَأَيْنَ مَكَانُ رَاحَتِي» (إشعياء ٦٦: ١).
٣٤ «إِنِّي رَأَيْتُ مَشَقَّةَ شَعْبِي ٱلَّذِينَ فِي مِصْرَ، وَسَمِعْتُ أَنِينَهُمْ وَنَزَلْتُ لأُنْقِذَهُمْ. فَهَلُمَّ ٱلآنَ أُرْسِلُكَ إِلَى مِصْرَ».
خروج ٣: ٧
رَأَيْتُ مَشَقَّةَ شَعْبِي أي التفت إليه لكي أزيل مشقته.
أَنِينَهُمْ من ثقل تلك المشقة.
وَنَزَلْتُ من العرش السماوي. كلم الله الناس بلغتهم لطفاً وتنازلاً والمعنى أنه مزمع أن ينجيهم.
أُرْسِلُكَ هذا مختصر ما في (خروج ٣: ٧ - ١٠).
٣٥ «هٰذَا مُوسَى ٱلَّذِي أَنْكَرُوهُ قَائِلِينَ: مَنْ أَقَامَكَ رَئِيساً وَقَاضِياً؟ هٰذَا أَرْسَلَهُ ٱللّٰهُ رَئِيساً وَفَادِياً بِيَدِ ٱلْمَلاَكِ ٱلَّذِي ظَهَرَ لَهُ فِي ٱلْعُلَّيْقَةِ».
خروج ١٤: ١٩ وعدد ٢٠: ١٦
ٱلَّذِي أَنْكَرُوهُ في بدء إرساله إليهم أي منذ أربعين سنة (خروج ٢: ١٣ و١٤).
مَنْ أَقَامَكَ هذا مكرر قول استفانوس في (ع ٢٧) ذكره بياناً للمشابهة بين موسى (وهو نبي مرفوض من الناس مكرم من الله منقذ لشعبه في مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية) ويسوع المسيح وهو نبي أعظم من موسى ومنقذ من عبودية أردأ من عبودية مصر. فأثبت استفانوس على اليهود في أمر موسى ما أثبته عليهم سابقاًً في أمر يوسف والغاية واحدة وهو المشابهة بين معاملتهم لذينك ومعاملتهم ليسوع.
بِيَدِ ٱلْمَلاَكِ أن الملاك هو كلمة الله (ع ٣٨) ومعنى «يد الملاك» هنا إرشاده ومعونته.
٣٦ «هٰذَا أَخْرَجَهُمْ صَانِعاً عَجَائِبَ وَآيَاتٍ فِي أَرْضِ مِصْرَ، وَفِي ٱلْبَحْرِ ٱلأَحْمَرِ، وَفِي ٱلْبَرِّيَّةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً».
خروج ١٢: ٤١ و٣٣: ١ وص ٧ إلى ص ١٤ ومزمور ١٠٥: ٢٧ وخروج ١٤: ٢١ و٢٧ الخ و١٦: ١ و٢٥
عَجَائِبَ وَآيَاتٍ العجائب والآيات بمعنى واحد وهو المعجزات والاختلاف اعتباري. فسميّت «عجائب» لتهيجيها الحيرة والعجب في نفس المشاهد. وسميت «آيات» لأنه علامات الإعلان. ونسب استفانوس تلك العجائب والآيات إلى موسى دليلاً على أنه لم يرد أن يهين موسى بل أن يكرمه أحسن إكرام يليق بالإنسان.
فِي أَرْضِ مِصْرَ العجائب التي صنعها فيها هي المعروفة بالضربات العشر.
وَفِي ٱلْبَحْرِ ٱلأَحْمَرِ (خروج ص ١٤) وهذا البحر بين مصر وبلاد العرب ويسمى أحياناً في الكتاب «البحر» بلا نعت (خروج ١٤: ٢ ويشوع ٢٤: ٦) و «بحر سوف» (خروج ١٠: ١٩ و١٣: ١٨) وسمي «البحر الأحمر» في هذه الآية وفي (عبرانيين ١١: ٢٩) جرياً على ترجمة السبعين. وعلة تسميته بـ «الأحمر» مجهولة ولكن ظن بعضهم أنها الأعشاب الحمراء في مائه وما يطرحه منها على شاطئه أو الرمل الأحمر هناك أو المرجان الأحمر الذي فيه أو لون الجبال التي على ساحله الغربي.
٣٧ «هٰذَا هُوَ مُوسَى ٱلَّذِي قَالَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: نَبِيّاً مِثْلِي سَيُقِيمُ لَكُمُ ٱلرَّبُّ إِلٰهُكُمْ مِنْ إِخْوَتِكُمْ. لَهُ تَسْمَعُونَ».
تثنية ١٨: ١٥ و١٨ ومتّى ١٧: ٥ وص ٣: ٢٢
علم موسى الإسرائيليين أن رئاسته إلى حين إذ أنبأهم بظهور نبي آخر يجب عليهم أن يطيعوه.
نَبِيّاً مِثْلِي (تثنية ١٨: ١٥ و١٨). قال بطرس مثل ذلك حين وعظ الشعب في الهيكل انظر شرح (ص ٣: ٢١).
لَهُ تَسْمَعُونَ ذكرهم وجوب أن يطيعوا هذا النبي يسوع المسيح الذي كان كموسى في صفاته وكونه مرفوضاً أولاً من إخوته. وأنهم برفضهم إياه أهانوا موسى الذي أنبأهم به وأمرهم بإطاعته فارتكبوا الإثم الذي اتهموا استفانوس به. وكيف يمكنه أن يجدف على موسى وهو يعتبره رمزاً إلى المسيح وشيهاً له.
٣٨ «هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلْكَنِيسَةِ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ، مَعَ ٱلْمَلاَكِ ٱلَّذِي كَانَ يُكَلِّمُهُ فِي جَبَلِ سِينَاءَ، وَمَعَ آبَائِنَا. ٱلَّذِي قَبِلَ أَقْوَالاً حَيَّةً لِيُعْطِيَنَا إِيَّاهَا».
خروج ١٩: ٣ و١٧ إشعياء ٦٣: ٩ وغلاطية ٣: ١٩ وعبرانيين ٢: ٢ خروج ٢١: ١ وتثنية ٥: ٢٧ و٣١ و٣٣: ٤ ويوحنا ١: ١٧ ورومية ٣: ٢
ٱلْكَنِيسَةِ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ «الكنيسة» هنا بمعنى جماعة الله وهي هنا الإسرائيليين وقيّدها بأنها في «البرية» إشارة إلى أنها لم تُحصر في اليهودية التي اعتبرها رؤساؤهم مظهر الله الوحيد إذ كلمهم نبيهم العظيم في البرية ومات هو وأكثرهم قبل أن يدخلوا الأرض المقدسة.
مَعَ ٱلْمَلاَكِ أي المسيح وهو «يهوه» الذي اختار إسرائيل شعبه الخاص وكان موسى معه حين أعطاه الشريعة على طور سينا. وهذه الآية تبرهن ألوهية الملاك لأن المتكلم حينئذ قال عن نفسه «أنا الرب إلهك» الخ.
مَعَ آبَائِنَا (خروج ٢٠: ٢ و٢١).
أَقْوَالاً حَيَّةً وقال بولس أنها «أقوال الله» أي ناموسه الذي أعلنه لموسى (رومية ٣: ٢). ووصفها بأنها حية بالنظر إلى غايتها وفاعليتها فهي تنبه ضمير الخاطئ وتبكته على الخطيئة وتمنعه من ارتكابها وتقوده إلى التوبة والقداسة. وعدم هبة الناموس الحياة ليس للناس من نقص فيه بل من ضعف الطبيعة البشرية وقوة الخطيئة عليها.
فذكر استفانوس في هذا الخطاب ثلاثة أمور ذات شأن أكرم الله بها موسى الذي رفضه شعبه في أول أمره وهي أنه رمز إلى المسيح وأن الله كلمه وجهاً لوجه وأنه أنزل عليه الشريعة.
٣٩، ٤٠ «٣٩ ٱلَّذِي لَمْ يَشَأْ آبَاؤُنَا أَنْ يَكُونُوا طَائِعِينَ لَهُ، بَلْ دَفَعُوهُ وَرَجَعُوا بِقُلُوبِهِمْ إِلَى مِصْرَ ٤٠ قَائِلِينَ لِهَارُونَ: ٱعْمَلْ لَنَا آلِهَةً تَتَقَدَّمُ أَمَامَنَا، لأَنَّ هٰذَا مُوسَى ٱلَّذِي أَخْرَجَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لاَ نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَهُ».
خروج ٣٢: ١
كان هذا وموسى على الطور (خروج ٣٢: ١ و٢٣).
رَجَعُوا بِقُلُوبِهِمْ يحتمل أنهم أرادوا الرجوع إلى مصر حقيقة وندموا على الخروج منها (عدد ١١: ٥). والأرجح أن المعنى أنهم عدلوا عن الله إلى آلهة المصريين ومالت قلوبهم إلى عوائدهم وشهواتهم وأوثانهم وكرهوا حدود الله المقدسة وعبادته الروحية.
آلِهَةً تَتَقَدَّمُ أَمَامَنَا أي أوثاناً تُحمل قدامه كعادة الوثنيين يومئذ في أسفارهم وحروبهم للوقاية والنجاح بدلاً من «يهوه» الذي تقدمه في السحابة و «عمود النار» في البحر الأحمر والبرية.
هٰذَا مُوسَى الإشارة للاستخفاف فخانوه كما خانوا الله.
مَاذَا أَصَابَهُ أهلك أم تركنا. لأنه بقي أربعين يوماً على الجبل فلم تبق فيهم من ثقة بموسى ولا بإلهه.
٤١ «فَعَمِلُوا عِجْلاً فِي تِلْكَ ٱلأَيَّامِ وَأَصْعَدُوا ذَبِيحَةً لِلصَّنَمِ، وَفَرِحُوا بِأَعْمَالِ أَيْدِيهِمْ».
تثنية ٩: ١٦ ومزمور ١٠٦: ١٩
فَعَمِلُوا عِجْلاً من الحلي الذي أتوا به من مصر (خروج ٣٢: ٢ - ٤). والأرجح أن ذلك العجل كان على صورة الثور الذي عبده المصريون وسموه في ممفيس أبيس وفي هليوبوليس نيفيس فمال الإسرائيليون بعد ذلك إلى اتخاذه رمزاً إلى الله لأن الأسباط العشرة عبدوا عجلي الذهب اللذان نصبها يربعام في بيت إيل ودان. وذكر استفانوس هذا إشارة إلى شدة ميل الأمة الإسرائيلية إلى رفض الله والسقوط في الخطيئة.
وَفَرِحُوا كان ذلك في احتفالهم المذكور في (خروج ٣٢: ٦).
بِأَعْمَالِ أَيْدِيهِمْ أي صنمهم وجمع العمل لاشتراك كثيرين فيه أو لعله جمع مع الصنم توابع الذبيحة.
٤٢ «فَرَجَعَ ٱللّٰهُ وَأَسْلَمَهُمْ لِيَعْبُدُوا جُنْدَ ٱلسَّمَاءِ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ ٱلأَنْبِيَاءِ: هَلْ قَرَّبْتُمْ لِي ذَبَائِحَ وَقَرَابِينَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي ٱلْبَرِّيَّةِ يَا بَيْتَ إِسْرَائِيلَ؟».
مزمور ٨١: ١٢ وخروج ٢٠: ٢٥ و٣٩ ورومية ١: ٢٤ و٢تسالونيكي ٢: ١١ تثنية ٤: ١٩ و١٧: ٣ و٢ملوك ١٧: ١٦ و٢١: ٣ وإرميا ١٩: ١٣ عاموس ٥: ٢٥ و٢٦
فَرَجَعَ ٱللّٰهُ رجعت قلوبهم عن الله فرجع الله عن إظهار رضاه عنهم وبركته عليهم ولم يحفظهم بعد ذلك من نتائج شرورهم.
وَأَسْلَمَهُمْ أي عدل عن حفظه إياهم بعد ذلك من تهافتهم على شهواتهم. ولا مصاب أعظم من هذا على بني البشر وهو أن ينزع الله روحه القدوس من قلوبهم ويتركهم يفعلون بمقتضى شهواتهم وأهوائهم.
جُنْدَ ٱلسَّمَاءِ أي الشمس والقمر والنجوم. وذلك عاقبة ترك الله إياهم. وأخذوا تلك العبادة عن الفينيقيين وكان إلههم الأعظم الشمس وسموها بالبعل وسقط فيها الإسرائيليون كثيراً بعد ذلك.
كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ استشهد استفانوس بما هو مكتوب في (عاموس ٥: ٢٥ و٢٦) وذكره معنى لا لفظاً جرياً على ترجمة السبعين.
فِي كِتَابِ ٱلأَنْبِيَاءِ جمع اليهود النبوءات الاثتني عشرة القصيرة في كتاب واحد سموه «كتاب الأنبياء».
هَلْ قَرَّبْتُمْ لِي ذَبَائِحَ أي هل قدمتم ذلك لي وحدي فالاستفهام إنكاري أي أنكم لم تقربوا الخ. نعم أنهم عبدوا الله أحياناً لا دائماً وعبدوه ظاهراً لا باطناً وكانوا في الوقت الذي يعبدونه فيه يحملون خيمة مولوك فأشركوه بالله فصارت عبادتهم إياه كلا شيء.
٤٣ «بَلْ حَمَلْتُمْ خَيْمَةَ مُولُوكَ، وَنَجْمَ إِلٰهِكُمْ رَمْفَانَ، ٱلتَّمَاثِيلَ ٱلَّتِي صَنَعْتُمُوهَا لِتَسْجُدُوا لَهَا. فَأَنْقُلُكُمْ إِلَى مَا وَرَاءَ بَابِلَ».
١ملوك ١١: ٥ و٢ملوك ٢٣: ١٣ وإرميا ٣٢: ٣٥
هذا جواب الله لسؤال الله نفسه في ع ٦ والمعنى أنكم «لم تقربوا» الخ «بل حملتم» الخ.
خَيْمَةَ هذا إما خيمة حقيقية لذلك الصنم وإما عُلب مركبة كهيئة خيمة وفي تلك العلب تماثيل صغار لمولوك وهو الأرجح. فهي كالهياكل الفضية لأرطاميس إلاهة الأفسسيين (أعمال ١٩: ٢٤). ولا ريب في أن خيمة مولوك كانت كهيئة خيمة الاشتراع اتخذوها بمنزلة الأحراز وكانوا يحملونها إما في أسفارهم كسائر أمتعتهم وإما في احتفالاتهم الدينية إكراماً لمولوك وبذلك تركوا الله وسحابته النيرة فوق رؤوسهم لإرشادهم وهو يمطر المن عليهم يوماًً فيوماً.
مُولُوكَ هذا حسب ترجمة السبعين وفي الأصل العبراني «ملكوم» لا مولوك وكلاهما مشتقان من أصل واحد وهو ملك فهو إله العمونيين وكانوا يقربون له الذبائح البشرية. وموسى نهى الإسرائيليين عن تقريب أولادهم لمولوك وأنذر من خالف بالموت (لاويين ١٨: ٢١ و٢٠: ٢ - ٥) وبنى سليمان هيكلاً لمولوك على جبل الزيتون (١ملوك ١١: ٧). ومنسى ملك يهوذا «عبر ابنه في النار» إكراماً له (٢ملوك ٢١: ٣ - ٦). قال الربانيون في بعض مؤلفاتهم أن تمثاله من النحاس أجوف كبير جداً على هيئة إنسان ماد يديه إلى أمام وكانوا يوقدون النار في جوفه ومتى حمي كثيراً وضعوا الطفل على يديه فمات سريعاً. وكانت التماثيل التي حملها الإسرائيليون في البرية صغاراً على هيئته. ولم يتحقق أي الأجرام السماوية هو مولوك والمرجح أنه الشمس كبعل عند الفينيقيين.
وَنَجْمَ إِلٰهِكُمْ أي صنم إلهكم المصنوع كهيئة النجم.
رَمْفَانَ وهو في العبراني «كيوان» وهما اسمان لمسمى واحد وهو نجم من النجوم السيّارة يسمى في العربية زُحل ويسمى كيوان أيضاً كما في العبرانية. فالسبعون بدلوا كيوان برمفان لأنه هو اسم زُحل في القبطية ونقله استفانوس عن ترجمتهم.
ٱلتَّمَاثِيلَ جمع ليعم الصنم وخيمته وأدواتها.
فَأَنْقُلُكُمْ مسبيين عقاباً على عبادتكم الأوثان.
مَا وَرَاءَ بَابِلَ هذا كما في ترجمة السبعين وفي العبرانية «ما وراء دمشق» والمعنى أنقلكم مسبيين إلى خارج أرضكم ودمشق في الطريق إلى بابل وهم سُبوا إلى ما وراء بابل (٢ملوك ١٧: ٦).
٤٤ «وَأَمَّا خَيْمَةُ ٱلشَّهَادَةِ فَكَانَتْ مَعَ آبَائِنَا فِي ٱلْبَرِّيَّةِ، كَمَا أَمَرَ ٱلَّذِي كَلَّمَ مُوسَى أَنْ يَعْمَلَهَا عَلَى ٱلْمِثَالِ ٱلَّذِي كَانَ قَدْ رَآه».
عدد ٩: ١٥ و١٧: ٢٣ خروج ٢٥: ٤٠ و٢٦: ٣٠ وعبرانيين ٨: ٥
بعد ما تكلم استفانوس على عصيان بني إسرائيل وعبادتهم الأصنام أخذ يتكلم على محل العبادة الحقيقي.
خَيْمَةُ ٱلشَّهَادَةِ كذا سُميت في (عدد ١٧: ٨) لأنه وُضع فيها لوحا الشريعة التي كانت تشهد بمشيئة الله ولأنها كانت هي نفسها تشهد بحضور الله فيها بين الكروبين (خروج ٢٥: ٢٢).
يَعْمَلَهَا عَلَى ٱلْمِثَالِ ذكر هنا استفانوس أن نظام الخيمة والهيكل كان بأمر إلهي دفعاً لتهمتهم أنه جدف على الهيكل. وأمر الله لموسى بذلك في (خروج ٢٥: ٤٩). والظاهر أن مراده من هذا الكلام أنه يمكن أن يرضى الله عبادته في غير الهيكل بعده كما رضي أن يعبد في الخيمة قبله. وذكره بذكر «المثال» أن الخيمة الأرضية ليست سوى رمز إلى حقيقة سماوية تتم بالمسيح في عهد أفضل كما قيل في (عبرانيين ٨: ٢ و٥) وما صح على الخيمة يصح على الهيكل فهو أيضاً ليس إلا رمزاً إلى ما هو أعظم منه وأفضل.
٤٥ «ٱلَّتِي أَدْخَلَهَا أَيْضاً آبَاؤُنَا إِذْ تَخَلَّفُوا عَلَيْهَا مَعَ يَشُوعَ فِي مُلْكِ ٱلأُمَمِ ٱلَّذِينَ طَرَدَهُمُ ٱللّٰهُ مِنْ وَجْهِ آبَائِنَا، إِلَى أَيَّامِ دَاوُدَ».
يشوع ٣: ١٤ نحميا ٩: ٢٤ ومزمور ٤٤: ٢ و٧٨: ٥٥ وص ١٣: ١٩
ٱلَّتِي أَدْخَلَهَا أي الخيمة التي أدخلها الآباء إلى أرض الميعاد.
إِذْ تَخَلَّفُوا عَلَيْهَا أي أخذوها بالوراثة لأنه مات الجيل الأول الذي خرج من مصر وقام خلَفه وأخذ الخيمة وأدخلها إلى الأرض المقدسة.
مَعَ يَشُوعَ قائدهم بعد موسى.
فِي مُلْكِ ٱلأُمَمِ أي البلاد التي سكنها الأمم في أرض كنعان.
إِلَى أَيَّامِ دَاوُدَ هذا إما متعلق بقوله «أدخلها» وإما بقوله «طردهم» والأرجح الأول لأنهم حفظوا الخيمة وعبدوا الله فيها إلى أيام داود حين طرد اليبوسيين من أورشليم فتكون مدة الخيمة نحو خمس مئة سنة أيام موسى إلى نهاية ملك داود.
٤٦، ٤٧ «٤٦ ٱلَّذِي وَجَدَ نِعْمَةً أَمَامَ ٱللّٰهِ، وَٱلْتَمَسَ أَنْ يَجِدَ مَسْكَناً لإِلٰهِ يَعْقُوبَ. ٤٧ وَلٰكِنَّ سُلَيْمَانَ بَنَى لَهُ بَيْتاً».
١صموئيل ١٦: ١ و٢صموئيل ٧: ١ ومزمور ٨٩: ١٩ وص ١٣: ٢٢ و١ملوك ٨: ١٧ و١أيام ٢٢: ٧ ومزمور ١٣٢: ٤ و٥ و١ملوك ٦: ١ و٨: ٢٠ و١أيام ١٧: ١٢ و٢أيام ٣: ١
وَجَدَ نِعْمَةً بأن نجح في أعماله وانتصر على أعدائه وثبت في ملكه ومع ذلك كله لم يؤذن له أن يبني له بيتاً. وغاية استفانوس من ذلك بنيان الهيكل ليس عند الله بأمر جوهري وإلا لسمح لداود ببنائه.
ٱلْتَمَسَ أَنْ يَجِدَ مَسْكَناً لم يذكر العهد القديم هذا الالتماس لكنه لمح إليه في (٢صموئيل ٧: ٤ الخ و١أيام ٢٢: ٧). فالمسكن الذي التمس أن يبنيه هو معبد ثابت لعبادة الله وحفظ تابوته وسائر الرموز فيه.
لإِلٰهِ يَعْقُوبَ كما ذكر داود في (مزمور ١٣٢: ٥).
وَلٰكِنَّ سُلَيْمَانَ بَنَى أذن الله لسليمان في ما لم يأذن فيه لداود (٢أيام ٦: ٧ و٨) وعلة ذلك أن داود كان رجل حرب سفك دماء كثيرة (١ايام ٢٢: ٨) لكن داود أعد كل لوازم البناء (١ملوك ص ٦ و١أيام ص ٢٢). ويظهر من هذا أن الإسرائيليين بقوا بلا هيكل نحو خمس مئة سنة. فإذا كانت الخيمة التي صُنعت على المثال الذي أراه الله لموسى وكان فيها تابوت العهد وسائر المواد المقدسة أُزيلت وقام الهيكل مقامها فأي تجديف في أن يُقال يُحتمل أن الهيكل أيضاً يزول ويقوم غيره مقامه.
٤٨ «لٰكِنَّ ٱلْعَلِيَّ لاَ يَسْكُنُ فِي هَيَاكِلَ مَصْنُوعَةٍ بِٱلأَيَادِي، كَمَا يَقُولُ ٱلنَّبِيُّ».
١ملوك ٨: ٢٧ و٢أيام ٢: ٦ و٦: ١٨ وص ١٧: ٢٤
لٰكِنَّ ٱلْعَلِيَّ لاَ يَسْكُنُ فِي هَيَاكِلَ أي أنه لا ينحصر فيها لأنه العلي المالئ الكون. وهذا جوهر ما قاله سليمان (١ملوك ٨: ٢٧) وما قاله المسيح للمرأة السامرية (يوحنا ٤: ٢١ - ٢٣). وما قاله بولس في أثينا (ص ١٧: ٢٤). قصد استفانوس بإيراد هذا أن يزيل مغالاة اليهود بالهيكل وأن يفسر ما قاله فيه وهم حرفوا معناه.
كَمَا يَقُولُ ٱلنَّبِيُّ أي إشعياء (إشعياء ٦٦: ١ و٢) وما ذكره استفانوس بمعنى ذلك دون لفظه.
٤٩ «ٱلسَّمَاءُ كُرْسِيٌّ لِي، وَٱلأَرْضُ مَوْطِئٌ لِقَدَمَيَّ. أَيَّ بَيْتٍ تَبْنُونَ لِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَأَيٌّ هُوَ مَكَانُ رَاحَتِي؟».
إشعياء ٦٦: ١ و٢ ومتّى ٥: ٣٤ و٣٥ و٢٣: ٢٢
كُرْسِيٌّ... مَوْطِئٌ لِقَدَمَيَّ انظر شرح (متّى ٥: ٣٤ و٣٥).
أَيَّ بَيْتٍ تَبْنُونَ لِي أي لا يمكن أن يُنبى بيت يسع الله غير المحدود أو يليق بعظمته.
مَكَانُ رَاحَتِي أي مسكني الدائم على الأرض كما في (مزمور ٩٥: ١١).
٥٠ «أَلَيْسَتْ يَدِي صَنَعَتْ هٰذِهِ ٱلأَشْيَاءَ كُلَّهَا؟».
كُلَّهَا أي السموات والأرض فيستحيل أن صانع هذه كلها يُحصر في موضع من الأرض. فالنتيجة أن استفانوس لم يرتكب شيئاً من التجديف أن كان قد قال يجوز أن يُعبد الله عبادة روحية في كل مكان لأنه يوجد في كل مكان.
٥١ «يَا قُسَاةَ ٱلرِّقَابِ، وَغَيْرَ ٱلْمَخْتُونِينَ بِٱلْقُلُوبِ وَٱلآذَانِ، أَنْتُمْ دَائِماً تُقَاوِمُونَ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ. كَمَا كَانَ آبَاؤُكُمْ كَذٰلِكَ أَنْتُم».
خروج ٣٢: ٩ و٣٣: ٣ وإشعياء ٤٨: ٤ لاويين ٢٦: ٤٢ وتثنية ١٠: ١٦ وإرميا ٤: ٤ و٦: ١٠ و٩: ٢٦ وحزقيال ٤٤: ٩
ذهب أكثر المفسرين إلى أن استفانوس غيّر هنا مجرى الخطاب لملاحظته أن السامعين أبوا أن يأذنوا له في إكماله على النسق الأول. وعرف ذلك إمّا من إمارات وجوههم أو من تذمرهم وصهصهتهم به فلم يبق له من فرصة لسوى أن يقول بعض الكلمات ليبيّن لهم أنهم جروا على سنن آبائهم في العناد والتمرد.
يَا قُسَاةَ ٱلرِّقَابِ أي يا أهل العناد والعصيان وهو مستعار من عمل الثيران غير الخاضعة للنير والحراثة. وهذا كثير الاستعمال في العهد القديم (خروج ٣٢: ٩ و٣٣: ٣ و٥ و٣٤: ٩ وتثنية ٩: ٦ و١٣ و١٠: ١٦).
وَغَيْرَ ٱلْمَخْتُونِينَ بِٱلْقُلُوبِ وَٱلآذَانِ افتخر اليهود بكونهم مختونين وحسبوا الختان كافياً ليحميهم من غضب الله أما استفانوس فأبان أنهم غلف في عيني الله لأنهم اتخذوا العلامة الخارجية للطاعة والتطهير دون الحقيقة وهذا ليس بختان بدليل قول موسى «فَٱخْتِنُوا غُرْلَةَ قُلُوبِكُمْ، وَلاَ تُصَلِّبُوا رِقَابَكُمْ بَعْدُ» (تثنية ١٠: ١٦). وغرلة القلوب ما فيها من المعصية لشريعة الله ومن الشهوات الفاسدة والأهواء الخبيثة وغرلة الآذان رفض سمع صوت الله (لاويين ٢٦: ٤١ وإرميا ٩: ٢٦).
دَائِماً تُقَاوِمُونَ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ لأنكم رفضتم ما أوحي به الروح القدس إلى موسى والأنبياء ويسوع المسيح ورسله فمقاومة من تكلموا بالروح القدس هي عين المقاومة لذلك الروح (متّى ١٠: ٤٠).
كَمَا كَانَ آبَاؤُكُمْ الخ وذلك حسب ما أوُضح في (ع ٢٧ وع ٣٥ و٣٩ - ٤٣).
٥٢ «أَيُّ ٱلأَنْبِيَاءِ لَمْ يَضْطَهِدْهُ آبَاؤُكُمْ، وَقَدْ قَتَلُوا ٱلَّذِينَ سَبَقُوا فَأَنْبَأُوا بِمَجِيءِ ٱلْبَارِّ، ٱلَّذِي أَنْتُمُ ٱلآنَ صِرْتُمْ مُسَلِّمِيهِ وَقَاتِلِيهِ».
٢أيام ٣٦: ١٦ ومتّى ٢١: ٣٥ و٢٣: ٣٤ و٣٧ و١تسالونيكي ٢: ١٥ ص ٣: ١٤
هذا السؤال يتضمن أن آباءهم اضطهدوا كل الأنبياء وهذا يصدق عليهم باعتبار كونهم أمة وكذا وقال المسيح في (متى ٢١: ٣٣ - ٤٠ و٢٣: ٢٩ - ٣٥).
ٱلَّذِينَ سَبَقُوا فَأَنْبَأُوا وهذا زاد فظاعة إثمهم لأنهم قتلوا الأنبياء الذي معظم أنبائهم التبشير بمجيء المسيح الذي هو أعظم بركات الله على الأمة.
ٱلْبَارِّ اي المسيح انظر شرح (ص ٣: ١٤). ولعلّ هذا اللقب مأخوذ من (إشعياء ١١: ٤ و٥ و٥٣: ١٢) وسماه استفانوس «البار» أمام المجلس الذي حكم عليه بالموت كمذنب وهذا مثل قول بيلاطس في (متّى ٢٧: ١٩) وقول يعقوب في (يعقوب ٥: ٦) وقول يوحنا في (١يوحنا ٢: ١).
ٱلَّذِي أَنْتُمُ ٱلآنَ قال سابقاً «كما كان آباؤكم كذلك أنتم» فإنهم قتلوا الأنبياء الذين انبأوا بمجيء المسيح وأنتم اقتديتم بهم وزدتم عليهم بأن قتلتم المسيح نفسه.
مُسَلِّمِيهِ وَقَاتِلِيهِ لأنهم استأجروا يهوذا الاسخريوطي ليسلمه إليهم واستأجروا شهود زور شهدوا عليه فحكموا عليه ظلماً وسلموه إلى بيلاطس ليقتله وأجبروه على صلبه فأسندوا الفعل إلى علته أو مسببه وهم اليهود الذين يخاطبهم. فاستفانوس المتهم بالتجديف أتهم بما قال المجمع بأفظع الآثام فصار المتهم متهماً.
٥٣ «ٱلَّذِينَ أَخَذْتُمُ ٱلنَّامُوسَ بِتَرْتِيبِ مَلاَئِكَةٍ وَلَمْ تَحْفَظُوهُ؟».
خروج ٢٠: ١ وغلاطية ٣: ١٩ وعبرانيين ٢: ٢
ٱلنَّامُوسَ أي شريعة موسى المعطاة على طور سينا.
بِتَرْتِيبِ مَلاَئِكَةٍ هذا وفق ما جاء في ترجمة السبعين في (تثنية ٣٣: ٢ ومزمور ٦٨: ١٧) ووفق الرأي العام عند اليهود. والقول بأن «الناموس بترتيب ملائكة» يزيده شرفاً ووقاراً والذين يخالفونه إثماً وعقاباً. وهذا التعليم لم يوضحه العهد القديم لكنه أوضح هنا وفي (غلاطية ٣: ١٩ وعبرانيين ٢: ١) ولعل المعنى أن الملائكة حضروا أجواقاً عند إعطاء الناموس وكانوا شهوداً بذلك وأنهم وسائل أو آلات لما ظهر من الآيات عند إعطائه كصوت البوق والنار والدخان والرعود والزلازل فهنا يظهر أنهم لم يسمحوا لاستفانوس أن يتفوه بكلمة بعد وإلا لبشرهم بالرحمة والمغفرة بشرط التوبة والإيمان.
موت استفانوس ع ٥٤ إلى ص ٨: ٣
٥٤ «فَلَمَّا سَمِعُوا هٰذَا حَنِقُوا بِقُلُوبِهِمْ وَصَرُّوا بِأَسْنَانِهِمْ عَلَيْهِ».
ص ٥: ٣٣
وَصَرُّوا بِأَسْنَانِهِمْ علامة شدة غيظهم وحنقهم (أيوب ١٦: ٩ ومزمور ٣٥: ٦ و٣٧: ١٢).
٥٥ «وَأَمَّا هُوَ فَشَخَصَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهُوَ مُمْتَلِئٌ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ، فَرَأَى مَجْدَ ٱللّٰهِ، وَيَسُوعَ قَائِماً عَنْ يَمِينِ ٱللّٰهِ».
ص ٦: ٥
شَخَصَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ كأنه يرفع دعواه إلى الله إذ لم يجد في ذلك المجلس من رحمة ولا عدل وسأل الله الحماية والتبرئة.
مُمْتَلِئٌ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ انظر شرح (ص ٢: ٤) وكان كذلك قبلاً (ص ٦: ٥) فكان عند الموت كما كان وقت الحماية فألهمه الروح القدس حينئذ ليعزيه ويشجعه على أن يشهد للحق في موته كما شهد له في حياته.
فَرَأَى رؤيا سماوية أنعم الله عليه بها إجابة لاستغاثته به لما شخص إلى السماء فحوّل نظره عن كل ما حوله في أورشليم السماوية ورأى مجلس السماء والديّان العادل الذي لأجله مزمع أن يموت شهيداً.
مَجْدَ ٱللّٰهِ نوراً ساطعاً إلى حضور الله متّى ١٦: ٢٧ و٢٤: ٣٠ ولوقا ٢: ٩).
عَنْ يَمِينِ ٱللّٰهِ محل الشرف والسلطة (ص ٢: ٢٥ ومرقس ٢٦: ٦٤).
٥٦ «فَقَالَ: هَا أَنَا أَنْظُرُ ٱلسَّمَاوَاتِ مَفْتُوحَةً، وَٱبْنَ ٱلإِنْسَانِ قَائِماً عَنْ يَمِينِ ٱللّٰهِ».
حزقيال ١: ١ ومتّى ٣: ١٦ وص ١٠: ١١ دانيال ٧: ١٣
ٱلسَّمَاوَاتِ مَفْتُوحَةً هذا مجاز انظر (حزقيال ١: ١) والمعنى كأنه نظر الجو مفتوحاً فوق رأسه وما وراء ظاهراً لعينيه. وهذه الرؤيا مُنحت له تقوية لرجائه وتحقيقاً لقرب المسيح منه وعنايته به وتصديقاً لكل ما قرره ولإفادة كل المضطهدين لأجل المسيح أنهم غير متروكين.
وَٱبْنَ ٱلإِنْسَانِ كثيراً ما دعا المسيح نفسه بهذا الاسم ولم يدعه غيره به سوى استفانوس هنا ويوحنا في رؤياه السماوية (رؤيا ١: ١٣ و١٤: ١٤) والأرجح أن على ذلك أنه رآه في هيئة الإنسان.
قَائِماً ذُكر في عدة أماكن أنه «جَالس عَنْ يَمِينِ ٱللّٰهِ» (مرقس ١٦: ١٩ وأفسس ١: ٢٠ ومزمور ١١٠: ١) وذلك بالنظر إلى كونه دياناً. وذُكر هنا أنه «قائم» وذلك بالنظر إلى استعداده لإعانة عبده واستقباله.
٥٧ «فَصَاحُوا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَسَدُّوا آذَانَهُمْ، وَهَجَمُوا عَلَيْهِ بِنَفْسٍ وَاحِدَة».
صَاحُوا لم يُذكر ماذا قالوا والأرجح أن بعضهم قال «جدف» وبعضهم «خذوه» وبعضهم «أخرس» وما أشبه ذلك (ص ١٩: ٣٢ ومتّى ٢٧: ٢٣ ويوحنا ١٩: ١٢).
وَسَدُّوا آذَانَهُمْ إشارة إلى أنهم أنفوا من فظاعة تجديفه على رأيهم بشهادته بمجد يسوع وجلاله وبما يلزم عن ذلك من الحكم عليهم بالظلم.
هَجَمُوا عَلَيْهِ لعل أعضاء المجلس سبقوا إلى ذلك وتبعهم كثيرون من الشعب الذين كانوا يسمعون ويشعرون شعورهم.
٥٨ «وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ وَرَجَمُوهُ. وَٱلشُّهُودُ خَلَعُوا ثِيَابَهُمْ عِنْدَ رِجْلَيْ شَابٍّ يُقَالُ لَهُ شَاوُلُ».
١ملوك ٢١: ١٣ ولوقا ٤: ٢٩ وعبرانيين ١٣: ١٢ لاويين ٢٤: ١٦ تثنية ١٣: ٩ و١٠ و١٧: ٧ وص ٨: ١ و٢٢: ٢٠
هذا ليس بمقتضى أمر شرعي إذ لم يكن لليهود وقتئذ من سلطان على قتل أحد انظر شرح (يوحنا ١٨: ٣١) وكان شغب الشعب بدون حق. وغض الوالي نظره عنه لأنه لم يضر بسلطانه. وربما كان ذلك كما ظن البعض على أثر عزل بيلاطس قبل أن أتى غيره وكان ذلك في سنة ٣٦ للميلاد.
وَأَخْرَجُوهُ على وفق عادة اليهود بناء على قوله تعالى لموسى «أَخْرِجِ ٱلَّذِي سَبَّ إِلَى خَارِجِ ٱلْمَحَلَّةِ» (لاويين ٢٤: ١٤) وبعد دخول الإسرائيليين أرض الميعاد وإقامتهم بالمدن اعتبروا كل مدينة بمنزلة المحلة وأخرجوا المحكوم عليهم بالرجم أو غيره من أنواع القتل منها كما فعلوا بنابوت (١ملوك ٢١: ١٣) وكما فعلوا بيسوع في الناصرة حين أرادوا قتله طرحاً (لوقا ٤: ٢٩).
وَرَجَمُوهُ هذا هو القصاص المعيّن على التجديف وغيره من أفظع الذنوب (لاويين ٢٤: ١٦ وخروج ١٩: ١٣ وتثنية ١٧: ٥ ويشوع ٧: ٢٥ انظر شرح يوحنا ١٠: ٣١).
وَٱلشُّهُودُ أي الشهود الكذبة الذين ذُكروا في (ص ٦: ١٣).
خَلَعُوا ثِيَابَهُمْ تسهيلاً لرميه بالحجارة وجرياً على عادة الذين يباشرون عملاً شاقاً انظر شرح (متّى ٥: ٤٠). وقد أمرت الشريعة أن «الشهود يرمون بالحجارة أولاً» (تثنية ١٣: ٩ و١٠ و١٧: ٧) والغاية من ذلك تحقيق صدق الشهود لأن معرفة الشاهد أنه يبتدئ في قتل البريء مما يمنعه من شهادة الزور. فنرى أن اليهود مع حكمهم على استفانوس ظلماً ومخالفتهم لشريعة العدل والشريعة اليهودية في الأمور الجوهرية حافظوا بكل اعتناء على العرضيات كإخراج المتهم ورجمه وابتداء الشهود في الرجم.
عِنْدَ رِجْلَيْ شَابٍّ الخ هذا أول ذكر شاول الطرسوسي وعلى ذكره هنا أنه اشتهر بعد هذا باضطهاده الكنيسة وبمصيره رسولاً ليسوع المسيح. فحضوره مع الراجمين وحفظه أثوابهم علامة أنه رضي ما عملوه واشترك معهم فيه كما قال عن نفسه في (ص ٢٢: ٢٠) وكان من مجمع الكيليكيين فلا بد أنه سمع جدال استفانوس وصدّق أنه مبتدع وعدو لتقاليد اليهود وتعاليمهم ودينهم وأنه مستحق الموت. ونعته «بالشاب» يدل على أنه ما بين سن الثلاثين وسن الأربعين. وما قاله في (ص ٢٦: ١٠) يشير إلى أنه كان من أعضاء المجلس الكبير فاقتضى أن يكون فوق سن الثلاثين وستأتي ترجمته في (ص ٨: ٣).
٥٩ «فَكَانُوا يَرْجُمُونَ ٱسْتِفَانُوسَ وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ: أَيُّهَا ٱلرَّبُّ يَسُوعُ ٱقْبَلْ رُوحِي».
ص ٩: ١٤ مزمور ٣١: ٥ ولوقا ٢٣: ٤٦
فَكَانُوا يَرْجُمُونَ ذكر ذلك في (ع ٥٨) ثم تكريره هنا يشير إلى أنهم شغلوا وقتاً طويلاً برجمه.
وَهُوَ يَدْعُو صلى استفانوس صلاتين الأولى عن نفسه وذلك لا لحماية جسده من الموت أو من آلامه بل لأجل بركات روحية وأدبية عن قاتليه. فاقتدى بالمسيح في الصلاتين إلا أن المسيح صلى أولاً عن قاتليه ثم عن نفسه وسبب ذلك أن نفس المسيح لا تحتاج إلى شيء.
أَيُّهَا ٱلرَّبُّ يَسُوعُ وجه استفانوس صلاته إلى يسوع عند ساعة الموت باعتبار أن يسوع سامع الدعاء ومساو للآب وكان حينئذ مملوءاً من الروح القدس. ومنحه الله أن يرى رؤيا مجد فتحقق أنه يسوغ أن نصلي للمسيح كما نصلي لله وأن نستودعه أنفسنا عند الموت. ولوقا كتب ما أوحي الله به فيذكر ذلك بلا لوم أو تخطئة مع أنه عرف أن ما أتاه استفانوس يكون مثالاً لغيره.
ٱقْبَلْ رُوحِي هكذا قال المسيح على الصليب لأبيه (لوقا ٢٣: ٤٦). ومعنى قوله «اقبل روحي» أي لتكن معك في السماء وهذا أحسن صلاة عند الموت. والنفس التي يستودعها الإنسان في يدي المسيح هي في الأمن التام فلا يمكن أن يُقال ذلك على من يستودع نفسه يدي مخلوق.
٦٠ «ثُمَّ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَصَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ: يَا رَبُّ، لاَ تُقِمْ لَهُمْ هٰذِهِ ٱلْخَطِيَّةَ. وَإِذْ قَالَ هٰذَا رَقَدَ».
ص ٩: ٤٠ و٢٠: ٣٦ و٢١: ٥ متّى ٥: ٤٤ ولوقا ٦: ٢٨ و٢٣: ٣٤ متّى ٢٧: ٥٢
جَثَا أتى ذلك اختياراً لا إجباراً مما ألم به من ألم الرجم وجثا اعتباراً للوضع في الصلاة الحارة بتواضع ولأنه استحسن أن يموت وهو يصلي هكذا.
يَا رَبُّ أي يا يسوع ربي (ص ١: ٢٤).
لاَ تُقِمْ لَهُمْ هٰذِهِ ٱلْخَطِيَّةَ أي إثم القتل كذا صلى المسيح من أجل قاتليه (لوقا ٢٣: ٣٤). ولا ديانة غير الديانة المسيحية تعلم الإنسان مثل هذه الصلاة فإنه بدلاً أن يسأل الله عقابه على قاتليه سأله أن يغفر لهم إثم مقاومتهم ليسوع وقتل واحد من تلاميذه. ولا نعلم كم من أولئك الحاضرين وجد الرحمة إجابة لتلك الصلاة إنما نعلم أنه وجدها واحد منهم وهو شاول أي بولس فصدق من قال لولا صلاة استفانوس ما ربحت الكنيسة بولس.
وَإِذْ قَالَ هٰذَا رَقَدَ أتاه الموت وهو جاث على ركبتيه يصلي. ونسبة الرقاد إلى استفانوس بدل الموت في مثل تلك الأحوال في أثناء هيجان الناس وصراخهم وظلمهم مما لا نتوقعه فهي تشير إلى هدوء قلبه وسلام نفسه واطمئنانه حتى لم يؤثر فيه شيء من أعظم الأهوال الخارجية. ووجه الشبه بين موت المسيحي والرقاد هو أن الرقاد يسبقه التعب والمسيحي قبل موته يتعب من خطاياه ومقاومة العالم والشيطان والخدمة الشاقة. وأن الرقاد تعقبه الراحة والذي يموت بالإيمان يستريح على وفق قوله تعالى «طُوبَى لِلأَمْوَاتِ ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ فِي ٱلرَّبِّ مُنْذُ ٱلآنَ نَعَمْ يَقُولُ ٱلرُّوحُ، لِكَيْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ أَتْعَابِهِمْ، وَأَعْمَالُهُمْ تَتْبَعُهُمْ» (رؤيا ١٤: ١٣). وأن الرقاد تعقبه اليقظة والذين يموتون في المسيح تقوم أجسادهم في صباح يوم القيامة وتشارك النفس في السعادة انظر شرح (يوحنا ١١: ١١ و١٢ وانظر أيضاً ١كورنثوس ١١: ٣٠ و١٥: ١٨ و٥١ و١تسالونيكي ٤: ١٣ و١٤ و٥: ١٠).
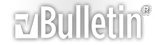




 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس