الأصحاح العاشر
مثل الراعي الصالح ع ١ إلى ٤٢
١ «ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ ٱلَّذِي لاَ يَدْخُلُ مِنَ ٱلْبَابِ إِلَى حَظِيرَةِ ٱلْخِرَافِ، بَلْ يَطْلَعُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ، فَذَاكَ سَارِقٌ وَلِصٌّ».
إرميا ٢٣: ١ إلى ٤ وحزقيال ٣٤ وزكريا ١١: ٤ إلى ١٧
لم يتحقق هل من علاقة بين هذا الأصحاح والذي قبله أولاً. وإن كان هنالك علاقة فهي أن المسيح وصف الفريسيين الذين هم رؤساء الشعب بأنهم «قادة عميان» في الأصحاح التاسع. وأخذ يصفهم في هذا الأصحاح بأنهم رعاة لرعية الله يهملون واجباتهم ويظلمون الرعية. ولا يبعد عن الظن أن المسيح تكلم بذلك وهو خارج أورشليم وأمامه حظيرة غنم والرعاة. ولا يلزم أن هذا الفرض هو الداعي إلى ضرب المثل لأنه كثيراً ما عبر في العهد القديم عن الله وشبعه بالراعي والغنم وعن رؤساء إسرائيل بالرعاة. وكان أعظم مشهوري الإسرائيليين وأبطالهم رعاة كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود (انظر مزمور ٢٣ وإشعياء ٤٠: ١١ الخ).
ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ ذكر الحق مكرراً كذلك في هذه البشارة أربعاً وعشرين مرة وقصد بها دائماً بيان أهمية الكلام وتأكيده.
ٱلَّذِي لاَ يَدْخُلُ مِنَ ٱلْبَابِ إِلَى حَظِيرَةِ ٱلْخِرَافِ الخ المقصود «بالحظيرة» هنا كنيسة الله المنظورة وكانت يومئذ الشعب اليهودي. كما يظهر من (إرميا ٢٣: ١ - ٤ وحزقيال ٣٤: ١ - ١٩ و٣٧: ٢٤ وزكريا ١١: ٤ - ١٧). والذين لم يدخلوا من الباب بل طلعوا من مكان آخر هم رؤساء الكهنة والفريسيون الذين استولوا يومئذ على شعب الله ولم يتصرفوا بسلطانهم كما يقتضيه خير الشعب. دعوا أنفسهم رعاة وأدخلوا إلى الحظيرة من أرادوا وطردوا منها من شاؤوا وادعوا انهم مفسروا كلام الله وأنهم يغذون به رعية الله لكنهم كانوا بالحقيقة متكبرين محبين لأنفسهم لا يسألون عن حاجات الشعب. فأظهروا حقيقتهم بمعاملتهم الأعمى الذي شفاه المسيح بأن طردوه من المجمع (ص ٩: ٣٤) فوجد المسيح هذا الخروف الضال واعتنى به.
فَذَاكَ سَارِقٌ وَلِصٌّ قصد المسيح بذلك الفريسيين لأن أعمالهم في رعية الله كانت أعمال سراق ولصوص في حظيرة الغنم. والفرق بين السارق واللص هنا أن الأول يدخل الحظيرة بالمكر خفية والآخر يدخل إجباراً وعلانية. وكان أولئك الرؤساء يشبهون الاثنين وهم لا يستحقون وظائفهم مضرون ظالمون أهل خداع وجور. وليس مقصود المسيح أن ينكر عليهم حق الرئاسة بناء على أن الكهنة منهم لم يكونوا من أولاد هارون الذين عينهم الله كهنة وعلى أنه ليس للفريسيين منهم حقوق سياسية لكنه قصد أن صفاتهم لا تؤهلهم لأن يكونوا مرشدي الشعب الروحيين ومعلميهم ورؤسائهم. والمقصود هنا «بالموضع الآخر» غير باب الحظيرة الذي يدخل منه الراعي وهو ما فوق الجدران. والمقصود بالذي يطلع من ذلك «الموضع الآخر» هو من لم يدع دعوة روحية إلى أن يرأس الشعب إنما اتخذ الرئاسة بالميراث أو حباً بالربح والسلطان والكرامة والراحة.
٢ «وَأَمَّا ٱلَّذِي يَدْخُلُ مِنَ ٱلْبَابِ فَهُوَ رَاعِي ٱلْخِرَافِ».
وَأَمَّا ٱلَّذِي يَدْخُلُ مِنَ ٱلْبَابِ ظن بعضهم أن المقصود «بالذي يدخل من الباب» المسيح نفسه لكن المسيح قال «أنا هو الباب» ع ٩ فلنا من ذلك أن المقصود بذلك الداخل المعلم الصادق الأمين. وإيمانه بالمسيح ومحبته إياه وطاعته له وحده تؤهله لوظيفته فمثل هذا يدعوه المسيح إلى وظيفته ويعينه ويُعده لممارستها.
فَهُوَ رَاعِي ٱلْخِرَافِ هذه إحدى العلامات التي يُميز بها الراعي عن السارق واللص.
٣ «لِهٰذَا يَفْتَحُ ٱلْبَوَّابُ، وَٱلْخِرَافُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ، فَيَدْعُو خِرَافَهُ ٱلْخَاصَّةَ بِأَسْمَاءٍ وَيُخْرِجُهَا».
أعمال ١٤: ٢٧ و١٦: ٦ و٧ و ١كورنثوس ١٦: ٩ و٢كورنثوس ٢: ١٢ وكولوسي ٤: ٣ ورؤيا ٣: ٨
لِهٰذَا يَفْتَحُ ٱلْبَوَّابُ بواب الحظيرة إما أحد الرعاة الذين يرعون الغنم نهاراً ويحرسونها ليلاً في نوبتهم أو مستأجر لتلك الخدمة خاصة. فهو يعرف الراعي عند قدومه ويُدخله. وعلى ذلك يكون البواب ليس من ضروريات المثل إنما هو تكملة له لكونه الواقع. والدليل على ذلك أن المسيح لم يتكلم بعد على البواب كما تكلم على الباب والراعي. وذكر «البواب» هنا لأنه من جملة المميزات للراعي الحقيقي أنه لا يحتاج إلى دخول الحظيرة مكراً أو إجباراً بل أنه صديق وله حق أن يدخل. وفسر بعضهم «البواب» بالروح القدس الذي يدعو الرعاة الحقيقيين ويفتح قلوب الناس لقبول تعليمهم كما جاء في (أعمال ١٧: ٢٧ و٢كورنثوس ٢: ١٢) وفسره بعضهم بالآب.
وَٱلْخِرَافُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ عندما يدعوها للخروج إلى المرعى وللرجوع منه إلى الحظيرة. والمعنى الروحي أن الشعب يقبلونه معلماً روحياً أميناً لاعتبارهم أن تعليمه من الله وأنه موافق لحاجاتهم وأنه محب لنفوسهم وأنه أمينٌ في وكالته. ويتضمن سمع صوته الإصغاء والطاعة.
فَيَدْعُو خِرَافَهُ ٱلْخَاصَّةَ بِأَسْمَاءٍ هذا دليل على أنه هو الراعي لأنه لو لم يكن كذلك ما عرف تلك الأسماء. والمعنى الروحي أن المعلم الديني يعرف كل الشعب الذي هو راعيه واحتياجاته المخصوصة لكي ينصحه أو يوبخه أو يعزيه أو يأتي غير ذلك مما تقتضيه الأحوال. وأشار بقوله «الخاصة» إلى الحصة الموكل بإرشادها من رعية المسيح الجامعة.
وَيُخْرِجُهَا إلى المرعى والماء على وفق الراعي الحقيقي في (حزقيال ٣: ١) وعلى وفق الراعي الروحي في (مزمور ٢٣: ٢). والمراد «بالإخراج» هنا فعل المعلم بغية نفع جماعته بتحصيلها المعرفة الدينية والبركة السماوية. وما قيل هنا من صفات الراعي الأمين يوافق ما قاله موسى للرب «لِيُوَكِّلِ ٱلرَّبُّ إِلٰهُ أَرْوَاحِ جَمِيعِ ٱلْبَشَرِ رَجُلاً عَلَى ٱلْجَمَاعَةِ يَخْرُجُ أَمَامَهُمْ وَيَدْخُلُ أَمَامَهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ، لِكَيْلاَ تَكُونَ جَمَاعَةُ ٱلرَّبِّ كَٱلْغَنَمِ ٱلَّتِي لاَ رَاعِيَ لَهَا» (عدد ٢٧: ١٦ و١٧ انظر أيضاً ١صموئيل ١٧: ٣٤ - ٣٧ و٢صموئيل ١٢: ٣).
٤ «وَمَتَى أَخْرَجَ خِرَافَهُ ٱلْخَاصَّةَ يَذْهَبُ أَمَامَهَا، وَٱلْخِرَافُ تَتْبَعُهُ، لأَنَّهَا تَعْرِفُ صَوْتَه».
وَمَتَى أَخْرَجَ خِرَافَهُ إما بصوته وإما بيده كل ما لم يسمع صوته منها.
يَذْهَبُ أَمَامَهَا هذا عمل الراعي الحقيقي دائماً وهو يقود الغنم إلى المرعى. كذلك رعاة النفوس الأمناء يقودون النفوس إلى المسيح وإلى كلامه لإفادتهم وذلك بواسطة تعليمه إياهم وكونه قدوة لهم. ويتمثل بذلك بالمسيح الراعي العظيم الذي ذهب أمام شعبه في طريق التواضع وإنكار الذات والطاعة لأبيه وبجولانه يعمل خيراً وفي حمل صليبه ودخوله القبر ثم صعوده إلى السماء.
وَٱلْخِرَافُ تَتْبَعُهُ أي يثق الشعب بتعليمه ويعتقد صحة تفسيره لكلام الله وأنه شاهد أمين بكل مشورة الله.
لأَنَّهَا تَعْرِفُ صَوْتَهُ هذا زيادة على ما قيل قبلاً أنها تسمع صوته ع ٣ وفي ذلك إشارة إلى اختبار الخراف لأمانته.
٥ «وَأَمَّا ٱلْغَرِيبُ فَلاَ تَتْبَعُهُ بَلْ تَهْرُبُ مِنْهُ، لأَنَّهَا لاَ تَعْرِفُ صَوْتَ ٱلْغُرَبَاء».
ع ١
وَأَمَّا ٱلْغَرِيبُ أي المعلم الخادع. ولا فرق بينه وبين السارق واللص المذكورين (آنفاً ع ١) إلا في درجات الضرر.
فَلاَ تَتْبَعُهُ هذا عادة الغنم بالطبع كما نعلم ذلك بالاختبار. والمعنى أن رعية المسيح المتعلمة بكلامه وروحه تميز غالباً المرشد الحقيقي من المرشد المحتال. وذلك وفق قول الرسول «وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَكُمْ مَسْحَةٌ مِنَ ٱلْقُدُّوسِ وَتَعْلَمُونَ كُلَّ شَيْءٍ» (١يوحنا ٢: ٢٠).
بَلْ تَهْرُبُ مِنْهُ أي لا تصغي إلى قوله خوفاً من الضلال لتحققها أن قصده بدعوتها قصد اللص في الليل.
لأَنَّهَا لاَ تَعْرِفُ صَوْتَ ٱلْغُرَبَاءِ أي لا تعتبر صوتهم صوت الأصحاب. وقصد المسيح «بالغرباء» هنا الفريسيين المتكبرين محبي الذات غير المحبين للحق فإنه كان للفريسيين أتباع كثيرة من أمثالهم لكنهم لم يكونوا من خراف المسيح.
٦ «هٰذَا ٱلْمَثَلُ قَالَهُ لَهُمْ يَسُوعُ، وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَفْهَمُوا مَا هُوَ ٱلَّذِي كَانَ يُكَلِّمُهُمْ بِهِ».
هٰذَا ٱلْمَثَلُ الكلام هنا غير جار على سنن المثل تماماً. وإنما سمي مثلاً لأنه مستعار لمعنى روحي.
فَلَمْ يَفْهَمُوا الخ كلامه في الرعاة والخراف واضح في نفسه والذين لم يفهموه منه أنه قصدهم «بالسارق» و «اللص» و «الغرباء» لظنهم أنه ما ساقه إلى ذلك إلا ما يحدث عادة للرعاة والخراف فإن كبرياءهم أعمت أذهانهم عن إدراك معناه.
٧ «فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضاً: ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنِّي أَنَا بَابُ ٱلْخِرَاف».
فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضا لأن هذا القول مكرر القول السابق وأبسط إيضاح لما لم يفهموه منه وأظهر بذلك طول أناته وتنازله.
إِنِّي أَنَا بَابُ ٱلْخِرَافِ معنى المسيح بذلك أن الإيمان به واسطة دخول الكنيسة الحقيقية لمعلمي الديانة واتباعها كما أن باب الحظيرة واسطة دخول الخراف والرعاة إليها. وقوله هنا يتضمن أنه الوسيط بين الله والناس بناء على استحقاقه وعمله وشفاعته وتعيين الله إياه. وسترى شرح ذلك أيضاً في ع ٩.
٨ «جَمِيعُ ٱلَّذِينَ أَتَوْا قَبْلِي هُمْ سُرَّاقٌ وَلُصُوصٌ، وَلٰكِنَّ ٱلْخِرَافَ لَمْ تَسْمَعْ لَهُمْ».
ص ٨: ٤٤
جَمِيعُ ٱلَّذِينَ أَتَوْا قَبْلِي هُمْ سُرَّاقٌ وَلُصُوصٌ ليس معناه أن كل الأنبياء والمعلمين من إبراهيم وموسى إلى يوحنا المعمدان هم كذلك بل أن أولئك هم الذين أتوا قبله معلمين في الدين وادعوا أنهم باب الخراف ولم يدخلوا بواسطته كالفريسيين وأمثالهم من رؤساء الشعب. ووصفهم بالسرقة واللصوصية لأن غايتهم أن يمجدوا أنفسهم ويظلموا الشعب. جلسوا على كرسي موسى ليبطلوا وصية الله بتقاليدهم ومنعوا الشعب من قبول يسوع المسيح الذي هو غاية الناموس فصدق عليهم قوله تعالى «وَيْلٌ لِلرُّعَاةِ ٱلَّذِينَ يُهْلِكُونَ وَيُبَدِّدُونَ غَنَمَ رَعِيَّتِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ الخ» (إرميا ٢٣: ١ - ٤). وقوله «وَيْلٌ لِرُعَاةِ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَرْعَوْنَ أَنْفُسَهُمْ. أَلاَ يَرْعَى ٱلرُّعَاةُ ٱلْغَنَمَ؟ تَأْكُلُونَ ٱلشَّحْمَ وَتَلْبِسُونَ ٱلصُّوفَ وَتَذْبَحُونَ ٱلسَّمِينَ وَلاَ تَرعَوْنَ ٱلْغَنَمَ الخ» (حزقيال ٣٤: ٢ - ٦).
ويشمل قوله «الذين أتوا قبلي» كل من ادعى أنه المسيح.
ٱلْخِرَافَ أي شعب الله من الأتقياء المتواضعين كسمعان الشيخ وحنة النبية ووالدي المعمدان نعم إن أكثر الشعب كان قد فسد لكن بقي منه بقية من الأمناء (رومية ١١: ٣ و٤) وجه الشبه بين المسيحيين والخراف بيّن في شرح (ع ٢٧).
لَمْ تَسْمَعْ لَهُمْ أي لم تقبل تعليم أولئك المرائين ولم تسلك بمقتضى أوامرهم ولا يلزم من ذلك أن الضلال لا يدخل الكنيسة أو أن شعب الله لا يسقط وقتاً بخداع الرؤساء بل أنه إذا ضل أو سقط يرجع إلى الحق. فكما أن الولد يعرف صوت أبيه كذلك أولاد الله يعرفون صوت الله الذي يخاطبهم بروحه وبكلامه ويخدم دينه ويميّز بين المدعين منهم كذباً أنهم يتكلمون باسم الرب والأمناء الصادقين.
٩ «أَنَا هُوَ ٱلْبَابُ. إِنْ دَخَلَ بِي أَحَدٌ فَيَخْلُصُ وَيَدْخُلُ وَيَخْرُجُ وَيَجِدُ مَرْعى».
ص ١٤: ٦ وأفسس ٢: ١٨ عدد ٢٧: ١٦ و١٧
أَنَا هُوَ ٱلْبَابُ هذا كقوله «أنا نور العالم» «وأنا خبز الحياة» و «أنا الطريق والحق والحياة» وهو من معلنات المسيح العظيمة من جهة نفسه قصد به على الخصوص أن الرعاة الصادقين يدخلون كنيسته بواسطته وحده ويقامون للخدمة الدينية فيختارون ذلك محبة له ويخدمون الرعية إكراماً له بالروح الذي هو خدمها به فيسألونه دائماً الإرشاد في أعمالهم.
ويتضمن قوله هذا أن المسيح هو الواسطة الوحيدة التي بها يستطيع الخطأة أن يأتوا إلى الله والسماء وينالوا الأمن والراحة وكل ما يحتاجون إليه.
إِنْ دَخَلَ بِي أَحَدٌ بسمعه صوتي الذي يدعوه وتأثير روحي القدس في قلبه وبحفظه تعليمي وباقتدائه بي وباتكاله على بري وفدائه بدمي. وهذا وفق قول الرسول «لأَنَّ بِهِ لَنَا كِلَيْنَا قُدُوماً فِي رُوحٍ وَاحِدٍ إِلَى ٱلآبِ» (أفسس ٢: ١٨).
فَيَخْلُصُ انظر ٥: ٢٤.
وَيَدْخُلُ وَيَخْرُجُ غاية الخراف في الدخول إلى الحظيرة الأمن من الخطر خارجاً وغايتها في الخروج المرعى. ومعنى الفعلين كلهيما الحصول على الأمن والتمتع بالحرية والشبع. والمعنى الروحي أن شعب الله يجد في كنيسة الله الاتحاد بالمسيح والتمتع بمحبته والصيانة من أعداء النفس والحصول على الحرية الدينية والاطمئنان وبالإجمال النجاة من كل نتائج الخطيئة.
وَيَجِدُ مَرْعىً أي تعليماً روحياً وتعزية وتقوية إيمان وفقاً لقول النبي «ٱلرَّبُّ رَاعِيَّ فَلاَ يُعْوِزُنِي شَيْءٌ. فِي مَرَاعٍ خُضْرٍ يُرْبِضُنِي. إِلَى مِيَاهِ ٱلرَّاحَةِ يُورِدُنِي الخ» (مزمور ٢٣: ١ - ٤).
وما قاله المسيح هنا في خدمته للكنيسة لا يزال يأتيه الآن بواسطة روحه القدوس ورعاتها القسوس الذين يرسلهم. فيجب عليهم أن يتمثلوا به لأنه هو الراعي الصالح.
١٠ «ٱلسَّارِقُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ لِيَسْرِقَ وَيَذْبَحَ وَيُهْلِكَ، وَأَمَّا أَنَا فَقَدْ أَتَيْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْضَلُ».
لِيَسْرِقَ وَيَذْبَحَ وَيُهْلِكَ وصف المسيح الفريسيين سابقاً بأنهم سراق ولصوص وأوضح هنا مقصودهم في الترأس على الشعب وهو نفع أنفسهم وتسلطهم وتحصيل الكرامة والغنى فيضرون بذلك الشعب لأن سيرتهم وتعليمهم من مهلكات نفوس الرعية وأشبهوا بأعمالهم الشيطان اللص الكبير الذي دخل فردوس الله خفية وسرق من الإنسان قداسته وحياته وتركه عرضة للخطيئة والموت.
وَأَمَّا أَنَا فَقَدْ أَتَيْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ أظهر المسيح الفرق العظيم بينه وبين رؤساء الدين عند اليهود بمقابلة مقصوده من مجيئه إلى العالم بمقصودهم من ترأسهم على الشعب. فهم أتوا ليميتوا الناس وهو أتى ليحييهم. والحياة التي منحها للعالم هي الحياة الروحية على هذه الأرض والحياة الأبدية في السماء (ص ٥: ٢٤ وص ٦: ٥٠ و٥١). وأكمل يسوع ذلك المقصود بأربعة أمور:
- الأول: إعلانه أن الحياة التي أتى ليمنحها حياة روحية وأن الناس في أشد الاحتياج إليها.
- الثاني: اشتراؤه تلك الحياة للناس بموته على الصليب.
- الثالث: دعوته الناس إلى الإتيان إليه وقبول الحياة منه.
- الرابع: هبته تلك الحياة للمؤمنين به.
وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْضَلُ هذا كقوله «مِنْ مِلْئِهِ نَحْنُ جَمِيعاً أَخَذْنَا، وَنِعْمَةً فَوْقَ نِعْمَةٍ» (ص ١: ١٦). ومعنى الجملة أن المسيح لا يكتفي بأن يهب لنا ما هو ضروري للنجاة من جهنم والحصول على الحياة الأبدية بل يعطينا ما يجعل تلك الحياة في أعلى درجات السعادة ويتضمن ذلك راحة الضمير التامة وتأكيد مغفرة الخطايا ومصالحة الله والتبرير التام والوقاية من السقوط بالتجربة والتقديس الذي يُقبل عند بلوغ السماء.
فالحياة الروحية التي وهبها المسيح للمؤمنين به أفضل من الحياة التي وهبها قبل مجيئه للأتقياء كإبراهيم وموسى وداود وأمثالهم وأفضل من الحياة التي فقدها آدم بمعصيته لانها كانت قابلة الفقدان. وأما الحياة التي وهبها المسيح فأبدية لا تُفقد ولأن الحياة التي ينالها المؤمن بإيمانه بالمسيح أعظم من الحياة التي ينالها باستحقاقه لو استطاع أن يثبت في القداسة الأصلية.
١١ «أَنَا هُوَ ٱلرَّاعِي ٱلصَّالِحُ، وَٱلرَّاعِي ٱلصَّالِحُ يَبْذِلُ نَفْسَهُ عَنِ ٱلْخِرَافِ».
إشعياء ٤٠: ١١ وحزقيال ٣٤: ١٢ و٢٣ و٣٧: ٢٤ وعبرانيين ١٣: ٢٠ و١بطرس ٢: ٢٥ و٥: ٤
أَنَا هُوَ ٱلرَّاعِي ٱلصَّالِحُ أي لي كل الصفات المختصة بالراعي الصالح فأحب رعيتي وأنا مستعد أن أفعل كل شيء تحتاج إليه من الخير والصيانة وأنا رئيس كل الرعاة الروحيين الأمناء فيجب عليهم أن يقتدوا بي. وأكد المسيح أنه يكون لشعبه كما يكون الراعي الأمين لخرافه وهذا يتضمن ثلاثة أشياء:
- الأول: أنه يعتني بإعداد كل ما يحتاج إليه.
- الثاني: أنه حنون وشفوق بسياسته لها.
- الثالث: أنه حريص على حمايتها ووقايتها من الخطر.
يَبْذِلُ نَفْسَهُ عَنِ ٱلْخِرَافِ هذه العلامة المميزة للراعي الصالح من غيره وهي أنه مستعد أن يخاطر بحياته لكي يحمي غنمه كما فعل داود في وقاية خرافه من الدب والأسد (١صموئيل ١٧: ٣٤ و٣٥). وكما قال يفتاح في خدمته لشعب إسرائيل «لَمَّا رَأَيْتُ أَنَّكُمْ لاَ تُخَلِّصُونَ، وَضَعْتُ نَفْسِي فِي يَدِي وَعَبَرْتُ الخ» (قضاة ١٢: ٣). فالمسيح قال أنه أتى لكي ينجي رعيته الروحية من الموت الأبدي بوضع حياته من أجلها ع ١٥ وبذلك أكمل النبوءة القائلة «أَمَّا ٱلرَّبُّ فَسُرَّ بِأَنْ يَسْحَقَهُ بِٱلْحُزْنِ. إِنْ جَعَلَ نَفْسَهُ ذَبِيحَةَ إِثْمٍ» (إشعياء ٥٣: ١٠). وقال المسيح مثل قوله هنا في (ع ١٥ و١٧ و١٨ وص ١٣: ٣٧ و٣٨ وص ١٥: ١٣).
١٢، ١٣ «١٢ وَأَمَّا ٱلَّذِي هُوَ أَجِيرٌ، وَلَيْسَ رَاعِياً، ٱلَّذِي لَيْسَتِ ٱلْخِرَافُ لَهُ، فَيَرَى ٱلذِّئْبَ مُقْبِلاً وَيَتْرُكُ ٱلْخِرَافَ وَيَهْرُبُ، فَيَخْطُفُ ٱلذِّئْبُ ٱلْخِرَافَ وَيُبَدِّدُهَا. ١٣ وَٱلأَجِيرُ يَهْرُبُ لأَنَّهُ أَجِيرٌ، وَلاَ يُبَالِي بِٱلْخِرَافِ.
زكريا ١١: ١٦ و١٧
قابل المسيح في هاتين الآيتين عمل الراعي الذي يرعى الغنم بالأجرة بعمل الذي يرعاها وهي له. فالأجير لا ينفق شيئاً على الرعية إنما يعتني بها لمجرد أجرته وإن فقد منها شيء لا يخسر فإذا أتى ذئب ليخطف لا يعرض نفسه للخطر بمقابلته بل يهرب خوفاً من الموت ورغبة في الحياة ويترك الغنم تتبدد وتُفترس. وهذا الوصف يصدق على أكثر الأجراء وأما يعقوب وإن كان أجيراً فحفظ خراف لابان بكل أمانة واعتناء (تكوين ٣١: ٣٨ - ٤٠). والمعنى أن الذين يرعون شعب الله بغية الربح الدنيوي ليسوا بمستعدين أن ينكروا أنفسهم ويخاطروا بوظائفهم وراحتهم وصيتهم وكسبهم وحياتهم لحفظ الكنائس من أعدائها الروحية. فأمثال هؤلاء لم يدعهم الروح القدس إلى خدمة كنيسته ولم يخدموا الرعية حباً أن يخلصوا نفوسهم فأزمنة الخطر تمتحنهم وتظهر جبنهم.
وكان الفريسيون ورؤساء الكهنة كالأجراء رغبوا في نفع أنفسهم فقط ولم يبالوا بنفوس الشعب ولم يريدوا أن يحموها من تجارب إبليس وغيرها من الأخطار الروحية فلذلك كان الشعب الإسرائيلي عند مجيء المسيح كرعية بلا راع (مرقس ٦: ٣٤). فإن قيل ما الفرق بين الأجير في هذه الآية والسارق واللص في الآية الأولى قلنا الفرق في درجة الشر والمراد بكليهما الفريسيون فإن بعض الفريسيين بمنزلة الأجير يحبون أنفسهم فيخدمون الشعب للربح الدنيوي وهم جبناء زمن الخطر وبعضهم بمنزلة السارق واللص في أنهم مضرون محتالون ظالمون.
فَيَرَى ٱلذِّئْبَ مُقْبِلاً اقتصر على ذكر الذئب دون سائر المفترسات لأنه العدو المشهور للغنم. واستُعير هنا لكل الأعداء الروحيين الذين يضرون النفوس بتعاليمهم الفاسدة ويهلكونها. وصف المسيح الأنبياء الكذبة بأنهم كذئاب خاطفة (متّى ٧: ١٥). وقال في الأثني عشر «هَا أَنَا أُرْسِلُكُمْ كَغَنَمٍ فِي وَسَطِ ذِئَابٍ» (متّى ١٠: ١٦) وقال في الرسل السبعين «هَا أَنَا أُرْسِلُكُمْ مِثْلَ حُمْلاَنٍ بَيْنَ ذِئَابٍ» (لوقا ١٠: ٣). وقال بولس لقسوس كنيسة أفسس «إَنِّي أَعْلَمُ هٰذَا: أَنَّهُ بَعْدَ ذَهَابِي سَيَدْخُلُ بَيْنَكُمْ ذِئَابٌ خَاطِفَةٌ لاَ تُشْفِقُ عَلَى ٱلرَّعِيَّةِ» (أعمال ٢٠: ٢٩). ولا يلزم من قول المسيح هنا أنه لا يجوز قط للراعي الروحي أن يهرب لحفظ حياته لأنه قد يجب عليه ذلك في بعض الأوقات فإن المسيح قال لرسله «مَتَى طَرَدُوكُمْ فِي هٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ فَٱهْرُبُوا إِلَى ٱلأُخْرَى» (متّى ١٠: ٢٣). وبولس هرب من دمشق خفية (أعمال ٩: ٢٥) وهرب هو وبرنابا من أيقونية (أعمال ١٤: ٦). ولكن يجب على الراعي الأمين أن يستعد لاحتمال الخطر إذا كان ذلك ضرورياً لخير الرعية. وهذا كان من صفات بولس وبرنابا بشهادة كنيسة أورشليم وهي قولها «مَعَ حَبِيبَيْنَا بَرْنَابَا وَبُولُسَ رَجُلَيْنِ قَدْ بَذَلاَ نَفْسَيْهِمَا لأَجْلِ ٱسْمِ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ» (أعمال ١٥: ٢٥ و٢٦).
فَيَخْطُفُ ٱلذِّئْبُ ٱلْخِرَافَ وَيُبَدِّدُهَا أي يخطف البعض ويفرق الباقي.
١٤ «أَمَّا أَنَا فَإِنِّي ٱلرَّاعِي ٱلصَّالِحُ، وَأَعْرِفُ خَاصَّتِي وَخَاصَّتِي تَعْرِفُنِي».
٢تيموثاوس ٢: ١٩
أَمَّا أَنَا فَإِنِّي ٱلرَّاعِي ٱلصَّالِحُ هذا مكرر ما قيل في الآية الحادية عشرة بياناً لأهمية وظيفة المسيح الراعوية مع ذكر شيء من الأعمال المختصة بها مما لم يذكره قبلاً وزيادة إيضاح الفرق بينه وبين الفريسيين رعاة الشعب الطالحين.
أَعْرِفُ خَاصَّتِي من صفات الراعي الأمين أن يعرف كل فرد من غنمه كذلك المسيح يعرف كل شخص من شعبه. وفي كلامه هنا دلالة على كمال اتحاده برعيته بناء على محبته واتخاذه طبيعة بشرية كطبيعتهم فإنه يعرف المؤمنين به أصدقاء ويعرف ضيقاتهم وتجاربهم وضعفهم وقصدهم اتباعه واحتياجاتهم كل يوم إلى مساعدته لهم على القيام بما يجب عليهم وعلى احتمال مصائبهم. وهذا وفق ما قاله المسيح لكل من كنائس آسيا السبع (رؤيا ص ٢ و٣). وهذا خلاف ما يقوله لمن ليسوا من خاصته فإنه يقول لهم «إني لم أعرفكم قط» (متّى ٧: ٢٣).
وَخَاصَّتِي تَعْرِفُنِي المؤمنون بالمسيح يعرفون المسيح صديقاً ومخلصاً ويعرفون احتياجهم إليه ورأفته عليهم بناء على اختبارهم عنايته وحمايته وسمعه صلواتهم وعلى هذا الاختبار قال بولس الرسول «إَنَّنِي عَالِمٌ بِمَنْ آمَنْتُ، وَمُوقِنٌ أَنَّهُ قَادِرٌ أَنْ يَحْفَظَ وَدِيعَتِي» (٢تيموثاوس ١: ١٢).
١٥ «كَمَا أَنَّ ٱلآبَ يَعْرِفُنِي وَأَنَا أَعْرِفُ ٱلآبَ. وَأَنَا أَضَعُ نَفْسِي عَنِ ٱلْخِرَافِ».
متّى ١١: ٢٧ ص ١٥: ١٣
كَمَا أَنَّ ٱلآبَ يَعْرِفُنِي وَأَنَا أَعْرِفُ ٱلآبَ هذا تفسير لما قيل في ع ١٤ وتقرير له. قابل المسيح معرفته بالمؤمنين ومعرفة المؤمنين به بمعرفته بالآب ومعرفة الآب به. وقوله هنا بمعنى ما قال في (متّى ١١: ٢٧ ولوقا ١٠: ٢٢). وهذه الحقيقة من الحقائق التي لا يستطيع العقل البشري إدراك كنهها.
وَأَنَا أَضَعُ نَفْسِي عَنِ ٱلْخِرَافِ لكي تنجو من الموت. هذه صفة أخرى من صفات المسيح باعتبار راعويته فإنه علاوة على معرفته المؤمنين به مستعد أن يموت عنهم فلذلك أتى إلى العالم وهو على وشك أن يأتي ذلك حينئذ. وأشار بقوله هنا إلى عزمه على أن يسفك دمه على الصليب كفارة عن الناس وفداء لهم من الخطيئة والموت وذلك أعظم برهان على محبته لهم بدليل قوله «لَيْسَ لأَحَدٍ حُبٌّ أَعْظَمُ مِنْ هٰذَا أَنْ يَضَعَ أَحَدٌ نَفْسَهُ لأَجْلِ أَحِبَّائِهِ» (ص ١٥: ١٣).
١٦ «وَلِي خِرَافٌ أُخَرُ لَيْسَتْ مِنْ هٰذِهِ ٱلْحَظِيرَةِ، يَنْبَغِي أَنْ آتِيَ بِتِلْكَ أَيْضاً فَتَسْمَعُ صَوْتِي، وَتَكُونُ رَعِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَرَاعٍ وَاحِد».
إشعياء ٥٦: ٨ وص ١١: ٥٢ وأعمال ١٨: ١٠ حزقيال ٢٧: ٢٢ وأفسس ٢: ١٤ وعبرانيين ١٣: ٢٠ و١بطرس ٢: ٢٥
وَلِي خِرَافٌ أُخَرُ أي الذين هم أعضاء كنيستي وأصدقائي وشعبي. قال المسيح أن أولئك الخراف له لأن الآب أعطاه إياها منذ الأزل في عهد الفداء فهو يحسبها له وإن لم تكن قد آمنت به أو سمعت باسمه وهي تعبد الأوثان حينما تكلم المسيح. وبهذا المعنى قول المسيح لبولس في أمر أهل كورنثوس وهم لم يزالوا وثنيين «إَنَّ لِي شَعْباً كَثِيراً فِي هٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ» (أعمال ١٨: ١٠).
لَيْسَتْ مِنْ هٰذِهِ ٱلْحَظِيرَةِ أي ليست من اليهود. وأشار بذلك إلى من قصد خلاصهم من الأمم. وهذه الحظيرة الثانية أكبر من الحظيرة الأولى كثيراً. وقد جاءت النبوءة بدعوة الأمم في بعض أسفار العهد القديم (إشعياء ٥٣: ١٣ وميخا ٤: ٢). وتمت هذه النبوءة بإيمان ألوف وربوات من الأمم منذ يوم قوله ذلك إلى هذه الساعة.
يَنْبَغِي أَنْ آتِيَ بِتِلْكَ أَيْضاً قال «ينبغي» لوجوب أن يتمم مقاصد الآب ونبوءات العهد القديم ويدرك رغبة قلبه في ذلك. ويأتي بتلك الخراف إلى كنيسته على الأرض ثم إلى ملكوته في السماء. ولا يأتي بها بتبشيره بنفسه بل بواسطة رسله ومبشريه وسائر خدم دينه وبإنجيله وروحه.
يمكننا أن نتخذ كلام المسيح هنا جواباً لقول اليهود «إِلَى أَيْنَ هٰذَا مُزْمِعٌ أَنْ يَذْهَبَ... أَلَعَلَّهُ مُزْمِعٌ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى شَتَاتِ ٱلْيُونَانِيِّينَ» (ص ٧: ٣٥).
فَتَسْمَعُ صَوْتِي هذا نبوءة بإيمان الوثنيين به وتتلمذهم له. إن اليهود وهم في الحظيرة أبوا أن يسمعوا المسيح ويتبعوه (متّى ٨: ١١ ورومية ١١: ١٧) فهل تتوقع من الوثنيين أن يتركوا أوثانهم ويسمعوا كلام المسيح في الإنجيل ويؤمنوا به ومع ذلك أكد المسيح أنهم سوف يسمعون ويؤمنون ويطيعون. وهذه النبوءة تمت فعلاً وهو وعد ايضاً يُشجع به المبشرين بالإنجيل للأمم بأن تعبهم لا يكون عبثاً لأن الله بينهم شعباً وللمسيح خرافاً خاصة تسمع وتؤمن.
تَكُونُ رَعِيَّةٌ وَاحِدَةٌ اي أن الحقوق التي خُصت أولاً باليهود باعتبار كونهم شعب الله الخاص تعم المؤمنين من كل أمم الأرض ويُبطل التمييز بين اليهود وغيرهم من الناس وفقاً لقول الرسول «لأَنَّهُ هُوَ سَلاَمُنَا، ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلاَثْنَيْنِ وَاحِداً، وَنَقَضَ حَائِطَ ٱلسِّيَاجِ ٱلْمُتَوَسِّطَ» (أفسس ٢: ١٤ انظر أيضاً رومية ١٠: ١٢).
وَرَاعٍ وَاحِدٌ أي الرب يسوع المسيح الذي يعترف به المؤمنون في كل أرض رباً ومخلصاً. فحسب قول المسيح أن المؤمنين به في كل زمان ومكان ليسوا سوى كنيسة واحدة تُظهر للناس أن حظيرة الرب مقسومة إلى حظائر صغيرة كثيرة لأن لها أسماء مختلفة وطقوساً متنوعة وسياسات شتى وبعضها لا يعرف بعضاً وتنكر هذه أن تلك للمسيح. وأما المسيح فيحسب ما في جميعها قطيعاً واحداً. فوحدة الكنيسة قائمة بأن رأسها واحد هو المسيح وحياة كل فرد في تلك الكنيسة من مصدر واحد هو يسوع الذي اسمه «الحياة» ولها شريعة واحدة هي الكتاب المقدس ولها غاية واحدة هي أن تتبع المسيح وتخدمه وموضوع رجاء واحد هو موت المسيح على الصليب وقيامته فكان يجب أن يكون أعضاؤها في رأي واحد وحس واحد.
وتظهر وحدة رعية المسيح المذكورة هنا عند مجيئه الثاني لا محالة وهل يتم ذلك قبله أولاً ذلك لا نعلمه لكن يجب أن نجتهد جميعنا في ذلك لأن ظهور تلك الوحدة من أعظم أسباب مجد المسيح ونفع العالم ولأن لا شيء يعوق الإنجيل أكثر من انقسام المسيحيين.
١٧ «لِهٰذَا يُحِبُّنِي ٱلآبُ، لأَنِّي أَضَعُ نَفْسِي لآخُذَهَا أَيْضاً».
إشعياء ٥٣: ٧ و٨ و١١٢ وفيلبي ٢: ٨ و٩ وعبرانيين ٢: ٩
لِهٰذَا يُحِبُّنِي ٱلآبُ أحب الله ابنه منذ الأزل وما ذُكر هنا من جملة الأسباب الكثيرة التي أحب بها الآب ابنه وهو رضاه أن يتجسد ويأتي إلى هذا العالم ليموت عن البشر. ونرى من ذلك رغبة الله في خلاص الخطأة لأنه أحب ابنه كل هذه المحبة الخاصة لموته من أجل الأثمة. وعلامة هذه المحبة قول الآب في الابن «هٰذَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ ٱلَّذِي بِهِ سُرِرْتُ» (متّى ٣: ١٧). وإثابته له على اتضاعه (فيلبي ٢: ٩ وإشعياء ٥٣: ١٢).
لأَنِّي أَضَعُ نَفْسِي أي حياتي الجسدية كفارة عن شعبي وبدلاً من موتهم وإنشاء لسبيل خلاصهم.
لآخُذَهَا أي لأقوم من الموت لا لأتركها إلى الأبد. وأخذ المسيح حياته البشرية بعد الموت ذُكر هنا من أسباب زيادة محبة الآب له كأنه إنكار المسيح لذاته. وهذا بخلاف ما يصدق عليه لو كان إنساناً فقط لأن وضع الإنسان حياته وقتاً قصيراً مما يخفف مرارة الموت. وأما المسيح فلو ترك حياته الجسدية إلى الأبد وعاد إلى كونه إلهاً محضاً لكان ذلك أشرف له لكنه ما اكتفى بأن يأخذ الطبيعة البشرية إلى أن يوفي بها دين الناس لله حتى أخذها أيضاً. ولا يزال متسربلاً بها إلى الأبد لكي يهب لشعبه كل فوائد موته (رومية ٤: ٢٥ و١٤: ٩ وعبرانيين ٧: ٢٥ ورؤيا ٧: ١٧). وبهذا امتاز المسيح على أفضل الرعاة لأن خدمتهم للرعية تنتهي عند موتهم.
١٨ «لَيْسَ أَحَدٌ يَأْخُذُهَا مِنِّي، بَلْ أَضَعُهَا أَنَا مِنْ ذَاتِي. لِي سُلْطَانٌ أَنْ أَضَعَهَا وَلِي سُلْطَانٌ أَنْ آخُذَهَا أَيْضاً. هٰذِهِ ٱلْوَصِيَّةُ قَبِلْتُهَا مِنْ أَبِي».
لوقا ٢٣: ٤٦ وص ٢: ١٩ ص ٦: ٣٨ و١٢: ٤٩ و١٥: ١ وأعمال ٢: ٢٤ و٣٢
لَيْسَ أَحَدٌ يَأْخُذُهَا مِنِّي أي لا أحد يغتصبها مني أو يجبرني على وضعها إنما أنا اخترت أن أضعها. فإن كل مؤامرة الفريسيين عليه ذهبت عبثاً حتى أتت ساعة موته. وأنه أخبر بيلاطس بأنه ليس له عليه من سلطان إلا بإذن الله (ص ١٩: ١١) وأن الجنود الذين أتوا ليمسكوه وقعوا في أول الأمر على الأرض (ص ١٨: ٦).
أَضَعُهَا أَنَا مِنْ ذَاتِي من أجل خلاص العالم. أبان يسوع بذلك أن محبته للخطاة علة موته لا قوة رؤساء اليهود ولا جند بيلاطس. وكان له حق أن يضع نفسه لأنه الله. وكون موت يسوع اختياراً نفى نسبة كل ظلم إلى الله في قبوله موت البار بدلاً من الأثمة.
مما يوجب علينا شدة المحبة للمسيح أنه بذل نفسه عنا مجاناً واختار أشد الميتات عاراً وألماً.
لِي سُلْطَانٌ أَنْ أَضَعَهَا باعتبار كوني المسيح المتجسد لما لي من السلطان الذاتي أي القوة وللسلطان الذي أخذته من أبي. فإن المسيح لعدم كونه خاطئاً لم يكن مُجبراً على أن يموت بحكم الله وحين كان بين أعدائه لو طلب نجدة الآب لأرسل إليه ربوات من الملائكة تنقذه من أيديهم.
لِي سُلْطَانٌ أَنْ آخُذَهَا أَيْضاً بعد الموت. وهذا يظهر أنه إله إذ ليس لبشر مثل هذه القوة وهي أن يقيم نفسه وهو ميت فهي قوة مختصة بالله.
نُسبت قيامة المسيح هنا وفي ص ٢: ١٩ إلى الابن نفسه ونُسبت إلى الآب في أعمال ٢: ٢٤ و٣٢ ونُسبت إلى الروح القدس في ١بطرس ٣: ١٨ ونتيجة كل هذه الشواهد أن الأقانيم الثلاثة كانت تعمل معاً في قيامته.
هٰذِهِ ٱلْوَصِيَّةُ قَبِلْتُهَا مِنْ أَبِي حين شرعت في عمل الفداء. وهذه الوصية هي إذن الآب للمسيح في أن يموت ويقوم من تلقاء إرادته أي قول الله الآب له لما دخل العالم «لك أن تموت كمشيئتك». وسماه المسيح «وصية» تواضعاً لأنه لم يكن بالحقيقة سوى إذن. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالوصية كل ما ذكره المسيح في هذا الخطاب بالنظر إلى كونه راعياً ووضع حياته من أجل الخراف وإدخال خراف أُخر إلى الحظيرة لكي تكون رعية واحدة وراع واحد. ولا شيء في أخذ الابن وصية من الآب ينفي مساواة الأقنوم الثاني للأقنوم الأول لأنه كان جزءاً من عمل الفداء تنازل إليه يسوع لينقذ الإنسان من الخطيئة وعقابها.
١٩ «فَحَدَثَ أَيْضاً ٱنْشِقَاقٌ بَيْنَ ٱلْيَهُودِ بِسَبَبِ هٰذَا ٱلْكَلاَمِ».
ص ٧: ٤٣ و٩: ١٦
كانت نتيجة خطابه هنا كسائر نتائج خطبه (ص ٧: ١٢ و٣٠ و٣١ و٤٠ و٤١ و٤٣ وص ٩: ٨ و٩ و١٦). وهذا وفق البنوءة القائلة أنه يكون علّة انقسام (إشعياء ٨: ١٤ ولوقا ٢: ٣٤).
٢٠ «فَقَالَ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ: بِهِ شَيْطَانٌ وَهُوَ يَهْذِي. لِمَاذَا تَسْتَمِعُونَ لَهُ؟».
ص ٧: ٢٠ و٨: ٤٨ و٥٢
هذا كلام أعدائه من الجمع الذين غضبوا من تأثير كلامه على الباقين. وقولهم مثل ما قيل في ص ٧: ٢٠ و٨: ٤٨ والمعنى أنه مختل العقل لا معنى لكلامه ولا علاقة لبعضه ببعض. وحسبوا دعوى ذلك الجليلي الأمي أنه الراعي الصالح لشعب إسرائيل وأن له سلطاناً أن يضع حياته وأن يأخذها هذياناً.
٢١ «آخَرُونَ قَالُوا: لَيْسَ هٰذَا كَلاَمَ مَنْ بِهِ شَيْطَانٌ. أَلَعَلَّ شَيْطَاناً يَقْدِرُ أَنْ يَفْتَحَ أَعْيُنَ ٱلْعُمْيَانِ؟».
خروج ٤: ١١ ومزمور ٩٤: ٩ و١٤٦: ٨ وص ٩: ٦ و٧ و٣٢ و٢٣
هذا كلام بعض الذين مالوا إلى يسوع من الفريسيين ولعله كلام غمالائيل ونيقوديموس ويوسف الرامي وأمثالهم. ودافعوا عن المسيح بشهادة كلامه وأعماله.
هٰذَا كَلاَمَ مَنْ بِهِ شَيْطَانٌ لأنه كلام ذو شأن وتقىً وحكمة.
أَلَعَلَّ شَيْطَاناً يَقْدِرُ أَنْ يَفْتَحَ الخ هذا مبني على المبدإ المشهور وهو أن صفة العمل تبين مصدره. فالشيطان لا يريد الأعمال الخيرية لأنه لا يقصد سوى الضرر. فمن شأن الشيطان أن يعمي البصير لا أن يفتح عيني الأعمى.
٢٢ « وَكَانَ عِيدُ ٱلتَّجْدِيدِ فِي أُورُشَلِيمَ، وَكَانَ شِتَاء».
الأرجح أنه مضى نحو شهرين بين زمن المخاطبة السابقة في هذا الأصحاح والوقت المذكور في هذه الآية فكانت تلك المخاطبة في عيد المظال الذي يقع في منتصف تشرين الأول وعيد التجديد المذكور هنا كان في منتصف كانون الأول. والأرجح أن المسيح لم يبق تلك المدة في أورشليم لأن اليهود كانوا يطلبون قتله بل رجع إلى الجليل وشرع يجول من هناك في بيرية كما ذُكر في (متّى ١٩: ١ ومرقس ١٠: ١ ولوقا ٩: ٥١ - ص ١٨: ١٨).
عِيدُ ٱلتَّجْدِيدِ عيّن هذا العيد يهوذا المكابي سنة ١٦١ ق. م تذكاراً لتطهير الهيكل بعد أن نجسه أنطيخوس أبيفانس سنة ١٦٤ ق .م فإن أنطيخوس أخذ أورشليم وأخربها وقتل أربعين ألفاً من أهلها وباع أربعين ألفاً من الأسرى وذبح خنزيرة على مذبح الهيكل. وكانت بداءة ذلك العيد في ١٥ كانون الأول وكانت أيامه ثمانية تحتفل فيها المدينة كما تحتفل في عيد المظال بكل علامات الفرح من الأغاني والرقص وما شاكل ذلك. وسُمي أيضاً «بعيد الأنوار» لكثرة المصابيح التي كانوا يوقدونها في تلك الأيام. وكان حضور ذلك العيد اختيارياً لا فرضاً.
٢٣ «وَكَانَ يَسُوعُ يَتَمَشَّى فِي ٱلْهَيْكَلِ فِي رِوَاقِ سُلَيْمَانَ».
أعمال ٣: ١١ و٥: ١٢
الأرجح أن إقامة يسوع في أورشليم وقتئذ قصيرة جداً بعد أن أرسل السبعين أمامه في بيرية (لوقا ١٠: ١). ولعله زار حينئذ بيت عنيا كما ذُكر (لوقا ١٠: ٣٨ - ٤٢).
فِي ٱلْهَيْكَلِ أي في إحدى أدوره.
فِي رِوَاقِ سُلَيْمَانَ هو ممشى مسقوف على جانب الهيكل الشرقي يشرف على وادي يهوشافاط (أعمال ٣: ١١ و٥: ١٢ وانظر شرح متّى ٢١: ١٢). قال يوسيفوس المؤرخ أنه هو الجزء الوحيد الباقي مما بناه سليمان. ولا بد من أن زربابل وهيرودس الكبير أصلحاه وبنيا عليه. وعلة ذكر تمشيه في الرواق ما ذُكر في ع ٢٢ وهو أنه كان شتاء أي وقت البرد والمطر.
٢٤ «فَٱحْتَاطَ بِهِ ٱلْيَهُودُ وَقَالُوا لَهُ: إِلَى مَتَى تُعَلِّقُ أَنْفُسَنَا؟ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمَسِيحَ فَقُلْ لَنَا جَهْراً».
فَٱحْتَاطَ بِهِ ٱلْيَهُودُ أي أعداؤه ع ٣١.
إِلَى مَتَى تُعَلِّقُ أَنْفُسَنَا أي تتركنا في الريب. وأشاروا بذلك إلى أنه ادعى دعاوي سامية ولم يزل علة الشك فيها. فمن ذلك تسمية نفسه «راعياً» فالنتيجة أنه ادعى أنه المسيح. وهو صنع بعض الآيات وهذا من الأدلة المصدقة لدعواه ولكنهم مع ذلك لم يقتنعوا لأنه من الجليل والمسيح الموعود به ليس كذلك (ص ٧: ٥٢) وأنه فقير مهان وهذا خلاف ما توقعه اليهود لأنهم انتظروه ملكاً مجيداً وناصراً جليلاً. وعلى الجملة أنه هيّج آمال الأمة أنه المنقذ المنتظر ولكنه لم يأت أمراً مجيداً يليق بدعواه.
إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمَسِيحَ الخ المرجّح أنهم لم يقولوا ذلك عن إخلاص لأن يسوع كان قد أوضح أنه هو المسيح ولم يترك في ذلك مدخلاً للشك ولأنهم اعتمدوا أن لا يقبلوه مسيحاً فكان غرضهم أن يقول أنه هو المسيح صريحاً لكي يشتكوا عليه بأنه مجدف. وسألوا مثل هذا السؤال في لوقا ٢٢: ٦٧ لذلك الغرض أو الخداع عينه.
٢٥ «أَجَابَهُمْ يَسُوعُ: إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ وَلَسْتُمْ تُؤْمِنُونَ. ٱلأَعْمَالُ ٱلَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا بِٱسْمِ أَبِي هِيَ تَشْهَدُ لِي».
ص ٥: ١٩ و٨: ٣٦ و٥٦ و٥٨ ص ٣: ٢ و٥: ٣٦ وع ٣٨
لم يجبهم المسيح على ذلك تصريحاً كما أجاب المرأة السامرية والإنسان المولود أعمى لأنهما سألاه بإخلاص بل أجابهم ضمناً كما في ص ٨: ٢٥. فلو قال أنا المسيح لأنكر عليه ذلك بعضهم وجعل كلامه موضوعاً للهزء وعلى الشكاية إلى الرؤساء. وحمل البعض كلامه على غير مقصوده لأن معنى «المسيح» عندهم ناصر أرضي وملك دنيوي وهو ليس كذلك. ولو أنكر أنه المسيح الذي هم انتظروه لاستنتجوا أنه ليس هو المسيح الذي أنبأ به الأنبياء وأنه ليس برسول الله ولا بالمنقذ الروحي مع أنه هو كذلك.
إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ أي أنبأتكم بما سألتموني عنه. وأنبأهم بذلك تلميحاً كافياً للإفهام لو أرادوا (انظر ص ٥: ١٩ و٨: ٣٦ و٥٦). وسمى نفسه «نور العالم» «والراعي الصالح» وكثيراً ما قال أنه «ابن الله» وعلموا أنه قصد بذلك بيان أنه المسيح.
وَلَسْتُمْ تُؤْمِنُونَ ادعوا أنهم بين الشك واليقين أما هو فحقق لهم أنهم ليسوا كذلك إنما هم منكرون.
ٱلأَعْمَالُ ٱلَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا أشار إلى معجزاته وأنها دليل كاف على أنه المسيح بدعوى أن الله لا يهب للخادع قوة على فعل المعجزات أي أن الله لا يثبت الكذب. وأورد مثل هذا البرهان في (ص ٣: ٢ و٥: ٣٦ و٧: ٣١ و٩: ٣٣ و٣٤).
بِٱسْمِ أَبِي اي بسلطانه وبكوني رسوله. وذكر اليهود بأنه لا يفعل شيئاً مستقلاً عن الآب.
٢٦ «وَلٰكِنَّكُمْ لَسْتُمْ تُؤْمِنُونَ لأَنَّكُمْ لَسْتُمْ مِنْ خِرَافِي، كَمَا قُلْتُ لَكُمْ».
ص ٨: ٤٧ و١يوحنا ٤: ٦
وَلٰكِنَّكُمْ لَسْتُمْ تُؤْمِنُونَ لا تؤمنون بأقوالي ولا بأعمالي.
لأَنَّكُمْ لَسْتُمْ مِنْ خِرَافِي من صفات الخراف أنها تعرف صوت راعيها فالذي لا تعرف صوته ليست من رعيته. فاليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح أظهروا أنهم ليسوا من شعبه. فخراف المسيح شعبه المتواضع المحب لتعاليمه والمصدق لها. وكبرياء اليهود وتعصبهم وسوء آرائهم في شأن المسيح المنتظر منعتهم من قبول أن يسوع هو المسيح كما شهدت بذلك أقواله وأعماله. ولم يريدوا أن يؤمنوا بأن مثل هذا الشخص الوديع يكون هو المسيح ولولا ذلك اقتنعوا بالبيّنات.
كَمَا قُلْتُ لَكُمْ ص ٨: ٤٧ وص ٣: ١٠
٢٧ «خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي».
ع ٤ و١٤
خِرَافِي أي شعبي الحقيقي. وأوجه الشبه بين المؤمنين بالمسيح حق الإيمان والخراف خمسة:
- الأول: عدم الأذى.
- الثاني: الوداعة.
- الثالث: الضعف والاحتياج إلى راعٍ والتعرض للضلال والعجز عن الرجوع ومقاومة الأعداء.
- الرابع: النفع.
- الخامس: الطاعة وقبول التعليم.
ونسبهم المسيح إليه بقوله «خرافي» لستة أسباب:
- الأول: محبته لهم.
- الثاني: أنهم عطية أبيه له.
- الثالث: أنه فداهم واشتراهم بموته.
- الرابع: أنه اختارهم ودعاهم.
- الخامس: أنه يرعاهم ويحميهم ويعتني بكل حاجاتهم.
- السادس: أنهم سلموا أنفسهم إليه طوعاً واختياراً.
تَسْمَعُ صَوْتِي كما جاء في ع ٣ و٤ وهذا من علامات الخراف. والصوت الذي تسمعه هو قوله «تعالوا إلي» و «توبوا عن خطاياكم» و «آمنوا بي» و «التجئوا إليّ» و «أنكروا أنفسكم» و «كونوا شهوداً لي» و «بشروا بإنجيلي» و «اقبلوا كلامي مصدقين أنه حق وأطيعوه». ولم نزل قادرين على سمع صوت المسيح بإنجيله وبروحه في قلوبنا.
وَأَنَا أَعْرِفُهَا كما جاء في ع ١٤ و١٥. وتتضمن هذه المعرفة رضاه إياهم ومحبته لهم وسروره بهم. وأنه يعلم رغبتهم في رضاه وطاعته ويعرف حاجاتهم وتجاربهم وأحزانهم وخطاياهم وجودة مقاصدهم. ومعرفته إياهم الآن تتضمن أنه يعترف بهم قدام أبيه في السماء. والذين يعرفهم المسيح لا يعرفهم العالم ولا يبالي بهم بل كثيراً ما يحتقرهم ويضطهدهم (١يوحنا ٣: ١).
فَتَتْبَعُنِي كما تتبع الخراف راعيها ع ٣. ويتبع المؤمنون المسيح معلماً لهم بأن يطيعوه ويتكلوا عليه ويسيروا في أثره. ويجدوا فيه قوتاً لنفوسهم. ويتبعوه للعمل في كرم الرب. ويتخذوه مخلصاً وقائداً من الظلمة إلى النور ومن الخطيئة إلى القداسة ومن الأرض إلى السماء.
٢٨ «وَأَنَا أُعْطِيهَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً، وَلَنْ تَهْلِكَ إِلَى ٱلأَبَدِ، وَلاَ يَخْطَفُهَا أَحَدٌ مِنْ يَدِي».
ص ٦: ٣٧ و١٧: ١١ و١٢ و١٨: ٩
وَأَنَا أُعْطِيهَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً تكلم في الآيات السابقات على صفات الخراف وتكلم هنا على حقوقها وامتيازاتها. وهبة الحياة الأبدية تتضمن المغفرة وراحة الضمير والمصالحة لله والسرور في هذه الدنيا وفي الآخرة مع المجد. وحصَّل تلك الحياة لهم بموته وشفاعته ويهبها لهم بروحه القدوس. وبيّن العلاقة بين أتباعه ونوال الحياة في (ص ٨: ١٢) وليس لأحد غير المسيح أن يقول «أنا أعطي الحياة الأبدية» وهذا من الأدلة على لاهوته ونعمته.
لَنْ تَهْلِكَ إِلَى ٱلأَبَدِ كما يهلك الأشرار في جهنم حيث يعاقبون على آثامهم (متّى ١٠: ٢٨ و١٨: ١٤ ويوحنا ٣: ١٥). وهذا الوعد توكيد للمسيحيين أنهم يكونون مصونين من الأخطار الداخلية كشهوات الجسد وفساد القلب وضعف الطبيعة ومن الأخطار الخارجية وهي تجارب الشيطان والعالم.
وَلاَ يَخْطَفُهَا أَحَدٌ مِنْ يَدِي أي لا يجذبها إلى خدمة الخطيئة وترك المسيح. ولا يقدر على ذلك إنسان بفصاحته وخداعه وقوته وتخويفه ولا يستطيع الشيطان ذلك بحيله واقتداره ومهارته في التجربة. والخطف إما أن يكون في الخفاء كما يفعل السارق وإما في العلانية كما يفعل اللص المغتصب. ولا خوف على نفس المؤمن التي في يد المسيح من شيء منهما.
وهذا الوعد من الأدلة على ثبوت المؤمنين في النعمة وهو أن كل من آمن الإيمان الحق لا يمكن أن يسقط من النعمة ويهلك (رومية ٨: ٣٨ و٣٩). وهو ليس بوعد لكل المعترفين بيسوع المسيح ولا لكل المعتمدين بل للذين يسمعون صوت المسيح ويتبعونه قلباً وسيرة. وهذه الصيانة ليست ناتجة عن قوة عزمهم على اتباع المسيح وشدة تمسكهم به بل عن مسك المسيح إيّاهم وقصده الأزلي في أمرهم. وعلتها محبة المسيح لهم وقد برهن ذلك بموته عنهم ولا يزال يبرهنه بحفظه إياهم. ولا يلزم مما قيل أن المؤمن لا يُجرب ولا يخطئ ولا يسقط مدة في ضلال بل المعنى أن الله لا يتركه في الضلال إلى أن يسقط في هاوية الهلاك.
وأسباب صيانة المؤمنين بالحق أربعة:
- الأول: كون الله أعطى يسوع إياهم.
- الثاني: تحصيل يسوع الحياة الأبدية لهم ومنحهم إياها.
- الثالث: تعهد الآب والابن معاً بوقايتهم من الهلاك.
- الرابع: أنه ليس من قوة في العالم تقاوم قوة الله ومقاصد يسوع الخيرية لهم.
وقد ذُكر ثلاثة أمور هنا لكل منها وافر البركات وهي معرفة المسيح لخرافه ومنحه إيّاها الحياة الأبدية وصيانته لها من الهلاك.
٢٩ «أَبِي ٱلَّذِي أَعْطَانِي إِيَّاهَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ ٱلْكُلِّ، وَلاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْطَفَ مِنْ يَدِ أَبِي».
ص ١٤: ٢٨ و١٧: ٢ و٦ الخ
غاية هذه الآية بيان أمن شعب المسيح.
أَبِي ٱلَّذِي أَعْطَانِي إِيَّاهَا (ص ٦: ٣٧). كان ذلك الإعطاء قبل تأسيس العالم (أفسس ١: ١٤). وهو من علل تسمية المؤمنين خرافه وما يؤكد لهم حفظه إياهم وعدم سماحه أن يخطفهم أحدٌ من يده.
هُوَ أَعْظَمُ مِنَ ٱلْكُلِّ أي كل من يريد أن يخطف خرافي من يدي من الناس والأبالسة. وكونه أعظم من الكل يمنع إمكان خطفها من يده فالله قادر أن يحفظها ويريد ذلك فالمؤمنون في أمان.
وَلاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْطَفَ مِنْ يَدِ أَبِي قال مثل هذا سابقاً في شأن يده هو فإذاً للمسيحيين سندان لأمنهم الأول عظمة محبة المسيح لهم والثاني عظمة قدرة الآب المحيطة بهم. وما ذُكر علة بقاء كنيسة المسيح كل تلك القرون مع شدة الاضطهادات التي وقعت عليها والضلالات الفظيعة التي طرأت فيها وكذا يكون في المستقبل.
ولعل في ما قاله المسيح هنا تلميحاً إلى الأعمى الذي أبرأه وهو أنه وإن كان اليهود قد أخرجوه من مجمعهم وحرموه حقوق الشعب اليهودي لم يُخطف من يد الله أي لم يستطيعوا أن يحرموه الخلاص.
٣٠ «أَنَا وَٱلآبُ وَاحِدٌ».
ص ٧: ١١ و٢٢
غاية المسيح من كلامه هنا أمن الخراف وإثباتاً لذلك قال أن الآب والابن واحد في القصد والمشيئة والشعور والفعل في شأن الخراف. فالآب يحفظ كل ما للابن والابن يحفظ كل ما للآب. وهذا يتضمن أن الآب والابن واحد في الجوهر والمجد والمقام والقوة. وكذا فهم اليهود معنى المسيح كما يظهر من قولهم في ع ٣٣ والمسيح لم يخطئهم على هذا الفهم. ووحدة الآب والابن لا تمنع من التمييز بينهما في الأقنومية والوظيفة. وما قيل في هذه الآية ينفي ضلال سباليوس في قوله ليس في اللاهوت سوى أقنوم واحد وينفي بدعة آريوس وهي قوله المسيح دون الآب لأنه يستحيل كونهما واحداً بدون المساواة.
وفي هذه الآية جواب لقول اليهود في ع ٢٤.
٣١ «فَتَنَاوَلَ ٱلْيَهُودُ أَيْضاً حِجَارَةً لِيَرْجُمُوهُ».
لاويين ٢٤: ١٠ الخ وص ٨: ٥٩
أَيْضاً أي كما فعلوا سابقاً لما قال يسوع «قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ أَنَا كَائِنٌ» (ص ٨: ٥٨) وفعلوا ذلك لأنهم حسبوا كلامه تجديفاً (ع ٣٣) وأرادوا أن يعاقبوه بمقتضى الناموس (لاويين ٢٤: ١٤ - ١٦ وعدد ١٥: ٣٦) ولم يقدروا أن يجروا ذلك شرعاً لمنع الرومانيين لهم لكنهم قصدوا أن يفعلوه على سبيل الهياج والشغب كما فعلوا باستفانوس (أعمال ٧: ٥٧ و٥٨).
٣٢ «فَقَالَ يَسُوعُ: أَعْمَالاً كَثِيرَةً حَسَنَةً أَرَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَبِي بِسَبَبِ أَيِّ عَمَلٍ مِنْهَا تَرْجُمُونَنِي؟».
مرقس ٧: ٢٧
فَقَالَ يَسُوعُ على فكرهم وقصدهم. والظاهر أن إجابته لهم أوقفتهم وقتاً عن رجمهم إياه. وخلاصة قوله أنه لا يجيز العقل ولا الشرع أن ترجموا أحداً قبل بيان ارتكابه الذنب الموجب لذلك.
أَعْمَالاً كَثِيرَةً حَسَنَةً أي نافعة جيدة. ولم يذكر يوحنا في إنجيله كثيراً من تلك الأعمال بل أشار إلى أنها كثيرة (ص ٢: ٢٣ و٣: ٢ و٥: ٣٦ و٢٠: ٣٠). ومن تلك الأعمال شفاء المرضى وفتح عيون العمي.
أَرَيْتُكُمْ أي فعلتها أمام عيونكم برهاناً على أني من الله.
مِنْ عِنْدِ أَبِي أي التي عيّنها الآب لكي أفعلها كما عيّن الأقوال التي قلتها وأقولها. علم المسيح أنهم اغتاظوا من كلامه فقال لهم ماذا وجدتم من الشر في أعمالي لأن القصد في كليهما واحد وهو بيان أنه المسيح ابن الله. فبيّن في هذه الآية أنه بريء من كل ذنب يوجب رجمهم إياه.
٣٣ «أَجَابَهُ ٱلْيَهُودُ: لَسْنَا نَرْجُمُكَ لأَجْلِ عَمَلٍ حَسَنٍ، بَلْ لأَجْلِ تَجْدِيفٍ، فَإِنَّكَ وَأَنْتَ إِنْسَانٌ تَجْعَلُ نَفْسَكَ إِلٰهاً».
ص ٥: ١٨
يظهر من هذا أن المسيح ادعى مساواته لله في ع ٣٠ بقوله «أنا والآب واحد» لأنه كذا فهم اليهود معناه والمسيح لم ينكر أنه عنى ذلك. وقد أعلنوا بجوابهم عجزهم عن أن يبينوا عملاً واحداً شريراً من كل أعمال يسوع مع أن المسيح دعاهم إلى ذلك وهذا مثل ما في (ص ٨: ٤٦).
لَسْنَا نَرْجُمُكَ أي ما عزمنا على رجمك.
بَلْ لأَجْلِ تَجْدِيفٍ انظر شرح (متّى ٩: ٣ ويوحنا ٥: ١٨). وهذا على وفق الشريعة في (لاويين ٢٩: ١٠ - ١٦). وفسروا في هذه الآية ما اعدوا أنه تجديف.
وَأَنْتَ إِنْسَانٌ نعم لو كان المسيح إنساناً فقط لكان كلامه تجديفاً واستحق أن يُرجم بموجب شريعتهم ولكنه مع كونه إنساناً هو الله فكان يستحق الإيمان به والسجود له. فما بقي في المسئلة إلا أحد الأمرين وهو إما أن يعبدوا يسوع إلهاً وإما أن يرجموه مجدفاً.
تَجْعَلُ نَفْسَكَ إِلٰهاً أي تدعي الألوهية. ادعى اليهود الغيرة العظيمة لله وأنهم مكلفون بالمحاماة عن مجد اسمه والحق أنه لم يحركهم إلى ذلك إلا الحسد والبغض.
٣٤ «أَجَابَهُمْ يَسُوعُ: أَلَيْسَ مَكْتُوباً فِي نَامُوسِكُمْ: أَنَا قُلْتُ إِنَّكُمْ آلِهَةٌ؟».
مزمور ٨٢: ٦
دفع المسيح اتهامهم إياه بالتجديف بوجهين:
الأول: أنه لو كان مجرد إنسان فتسميته نفسه ابن الله ليس بتجديف (ع ٣٤ - ٣٦).
الثاني: أن أعماله تبيّن أنه الله فله حق أن يعلن أنه كذلك بأسمى معناه (ع ٣٧ و٣٨).
فِي نَامُوسِكُمْ في كتبكم الإلهية. جاء الناموس في العهد الجديد بثلاثة معانٍ:
- الأول: أسفار موسى الخمسة (لوقا ٢٤: ٢٤).
- الثاني: العهد القديم سوى أسفار الأنبياء (متّى ٢٢: ٤٠).
- الثالث: كل العهد القديم كما في هذه الآية وفي (ص ٧: ٤٩ و١٢: ٣٤ و١٥: ٢٥ ورومية ٣: ١٩ و ١كورنثوس ١٤: ٢١).
ونُسب الناموس إليهم لاعتبارهم إياه مقدساً ليس فيه من تجديف.
أَنَا قُلْتُ إِنَّكُمْ آلِهَةٌ هذه الآية السادسة من المزمور الثاني والثمانين. والمتكلم هو الله قاضي القضاة. والمخاطبون هم القضاة ودعاهم الله آلهة لأنهم رؤساء الشعب ومنزلتهم أرفع من منزلة غيرهم من الناس وعليهم مسؤولية عظيمة في سياسة الشعب والله نفسه عيّنهم لوظيفتهم وهم أخذوا سلطانهم منه وقضوا بالنيابة عنه بدليل قول حزقيال «وَقَالَ لِلْقُضَاةِ: ٱنْظُرُوا مَا أَنْتُمْ فَاعِلُونَ لأَنَّكُمْ لاَ تَقْضُونَ لِلْإِنْسَانِ بَلْ لِلرَّبِّ، وَهُوَ مَعَكُمْ فِي أَمْرِ ٱلْقَضَاءِ» (٢أيام ١٩: ٦). وقول موسى «لاَ تَنْظُرُوا إِلَى ٱلْوُجُوهِ فِي ٱلْقَضَاءِ. لِلصَّغِيرِ كَٱلْكَبِيرِ تَسْمَعُونَ. لاَ تَهَابُوا وَجْهَ إِنْسَانٍ لأَنَّ ٱلْقَضَاءَ لِلّٰهِ» (تثنية ١: ١٧). وسمي الرئيس النائب عن الله إلهاً في (خروج ٤: ١٦ و٧: ١). وكان كل الذين سموا آلهة رموزاً إلى يسوع المسيح الذي هو إله وإنسان.
٣٥ «إِنْ قَالَ آلِهَةٌ لأُولٰئِكَ ٱلَّذِينَ صَارَتْ إِلَيْهِمْ كَلِمَةُ ٱللّٰهِ، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يُنْقَضَ ٱلْمَكْتُوب».
رومية ١٣: ١٠
إِنْ قَالَ آلِهَةٌ أي ناموسكم.
لأُولٰئِكَ أي الرؤساء أو القضاة وهم ليسوا سوى أناس عينهم الله نواباً عنه في سياسة الشعب.
ٱلَّذِينَ صَارَتْ إِلَيْهِمْ كَلِمَةُ ٱللّٰهِ أي الذين أعطاهم الله سلطاناً أن يأمروا باسمه ويقضوا.
وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يُنْقَضَ ٱلْمَكْتُوبُ انظر شرح (متّى ٥: ١٨). والمراد هنا بالمكتوب الناموس. ومعناه أنه ليس لأحد أن ينسخ الناموس أو يستهين به أو يذمه بل يجب على نفس كل إنسان أن تقبله باحترام وتحسبه قاطع كل جدال لأنه كلام الله كُتب بوحي الروح القدس. ومقصود المسيح بما اقتبسه هنا من المزامير أنه إذا كان الناموس سمى الرؤساء بالآلهة فذلك دليل قاطع على جواز تسميتهم بذلك وما جاز في كتاب الله ليس بتجديف وهذا دفع كاف لأتهامهم المسيح بالتجديف بما نسبه إلى نفسه.
وما عنى المسيح بذلك أنه مثل أحد أولئك الرؤساء المخلوقين إنما جاءه على سبيل الفرض.
٣٦ «فَٱلَّذِي قَدَّسَهُ ٱلآبُ وَأَرْسَلَهُ إِلَى ٱلْعَالَمِ، أَتَقُولُونَ لَهُ: إِنَّكَ تُجَدِّفُ، لأَنِّي قُلْتُ إِنِّي ٱبْنُ ٱللّٰهِ؟».
ص ٦: ٢٧ ص ٣: ١٧ و٥: ٣٦ و٣٧ و٨: ٤٢ ص ٥: ١٧ و١٨ و١: ٣٥ وص ٩: ٣٥ و٣٧
فَٱلَّذِي قَدَّسَهُ ٱلآبُ جاءت لفظة «قدس» في مواضع كثيرة من الكتاب بمعنى عيّن للخدمة الإلهية ومن ذلك ما جاء في (خروج ٢٨: ٤١ و٢٩: ١ و٤٤ ولاويين ٨: ٣٠) والمعنى هنا أن الله عيّن ابنه منذ الأزل مسيحاً. ومعنى التقديس هنا كمعنى الختم في (ص ٦: ٢٧).
وَأَرْسَلَهُ إِلَى ٱلْعَالَمِ كان في السماء فأرسله إلى الأرض ليخلص البشر. وفي هذا إشارة إلى تجسده (ص ٣: ١٧ وعبرانيين ٣: ١ و١يوحنا ٤: ١٤). واختلف المسيح بذلك عن الرؤساء الذين دعاهم آلهة لأنهم كانوا في الأرض وصارت إليهم كلمة الله.
لأَنِّي قُلْتُ إِنِّي ٱبْنُ ٱللّٰهِ لم يقبل ذلك صريحاً بل لزم عن قوله في (ع ٢٩ و٣٠)، واليهود فهموا ذلك بدلالة الالتزام ع ٣٣. فإذاً كان المسيح أولى منهم بالإنصاف بالألوهة وأن لا سبيل لهم إلى اتهامهم أياه بالتجديف وحجته عليهم لفظ ناموسهم بعينه.
٣٧ «إِنْ كُنْتُ لَسْتُ أَعْمَلُ أَعْمَالَ أَبِي فَلاَ تُؤْمِنُوا بِي».
ص ١٥: ٢٤
ما قاله المسيح آنفاً كاف لتبرئة نفسه من التجديف إذ أبان لهم أن ناموسهم نسب الألوهة إلى المخلوقات الذين هم دونه ولكنه لم يقتصر على التخلص من تهمة التجديف بل أراد أيضاً أن يبين لهم كل الحق في تسمية نفسه إلهاً بدليل أن ما فعله لا يستطيع فعله إلا الله.
أَعْمَالَ أَبِي أي أعمالاً مثل أعمال أبي (ص ٥: ١٧) وهي الأعمال التي لا يستطيع أن يعملها إلا الله. ومراد المسيح هنا أنه لعمله مثل أعمال الله أثبت لنفسه قوة كقوة الله. فإذاً هو مساوٍ له ويحق له أن يعلن ألوهته لفظاً فليس في كلامه شيء من التجديف.
فَلاَ تُؤْمِنُوا بِي أي فلا تصدقوا أني المسيح وأني ابن الله. لم يسألهم التسليم بدعواه بلا برهان بل سألهم أن يحكموا هل الأعمال التي عملها كأعمال الله أو لا فإذا كانت كأعمال الله وجب أن يؤمنوا به وإلا فتهمتهم صحيحة. وكلامه هنا وفق كلامه في (ع ٣٢ وص ٥: ١٧ و٣٦ و٩: ٣ و١٤: ١٠).
٣٨ «وَلٰكِنْ إِنْ كُنْتُ أَعْمَلُ، فَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا بِي فَآمِنُوا بِٱلأَعْمَالِ، لِكَيْ تَعْرِفُوا وَتُؤْمِنُوا أَنَّ ٱلآبَ فِيَّ وَأَنَا فِيه».
ص ٥: ٣٦ و١٤: ١٠ و١١ و١٧: ٢١
كان عليهم أن يقتنعوا بكلامه لما فيه من الأدلة على أنه تكلم بالحق وأن كلامه كلام الله ولكنهم إذ لم يقتنعوا بذلك أورد لهم شهادة أعماله بصحة دعواه كما أورده لرسولي يوحنا المعمدان إذ قال لهما «ٱذْهَبَا وَأَخْبِرَا يُوحَنَّا بِمَا تَسْمَعَانِ وَتَنْظُرَانِ: ٱلْعُمْيُ يُبْصِرُونَ، وَٱلْعُرْجُ يَمْشُونَ الخ» (متّى ١١: ٤ و٥). انظر شرح (ص ٥: ٣٦).
أَنَّ ٱلآبَ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ هذا كقوله «أَنَا وَٱلآبُ وَاحِدٌ» (ع ٣٠). وهو إيضاح للاتحاد الكلي بينه وبين الآب ومساواة أحدهما للآخر وأن تصريحه بذلك ليس بتجديف.
٣٩ «فَطَلَبُوا أَيْضاً أَنْ يُمْسِكُوهُ فَخَرَجَ مِنْ أَيْدِيهِمْ».
ص ٧: ٣٠ و٤٤ و٨: ٥٩
الظاهر أنهم لم يقتنعوا ببرهانه من ناموسهم ولا بشهادة معجزاته بل ظلوا مصرين على قصدهم قتله (ع ٣١ وص ٧: ٣٠ و٣٢ و٣٤). ولعلهم عدلوا عن قصدهم الأول وهو أن يرجموه في الهيكل (ع ٣١) وعزموا على ذلك في موضع آخر.
فَخَرَجَ مِنْ أَيْدِيهِمْ كان سهلاً عليه أن يفعل ذلك بدون معجزة ظاهرة إذ جعل كل اجتهادهم عبثاً كما فعل قبلاً (ص ٨: ٥٩ ولوقا ٤: ٣٠).
٤٠ «وَمَضَى أَيْضاً إِلَى عَبْرِ ٱلأُرْدُنِّ إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي كَانَ يُوحَنَّا يُعَمِّدُ فِيهِ أَوَّلاً وَمَكَثَ هُنَاكَ».
ص ١: ٢٨
وَمَضَى أَيْضاً إِلَى عَبْرِ ٱلأُرْدُنِّ أي إلى الشرق ذلك النهر إلى البلاد المسماة بيرية وشغل أكثر الستة الأشهر الأخيرة من زمن خدمته على الأرض هنالك.
إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي كَانَ يُوحَنَّا يُعَمِّدُ كما ذُكر في (ص ١: ٢٨) واسم المكان بيت عبرة. وقال مضى أيضاً لأنه عُمّد هنالك وابتدأ خدمته. ولم يذكر أنه عاد إليه غير هذه المرة في كل زمن خدمته على الأرض. ولا بد من أن مصيره إلى هنالك ذكر تلاميذه بشهادة يوحنا له في ذلك المكان.
وَمَكَثَ هُنَاكَ من عيد التجديد إلى عيد الفصح الذي صُلب فيه وما بينهما نحو أربعة أشهر. ولا يلزم من الكلام هنا أنه بقي في مكان واحد والأرجح أنه كان يجول في أرض بيرية. وذلك يوافق كلام لوقا في إنجيله على خدمة المسيح في بيرية.
٤١ «فَأَتَى إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وَقَالُوا: إِنَّ يُوحَنَّا لَمْ يَفْعَلْ آيَةً وَاحِدَةً، وَلٰكِنْ كُلُّ مَا قَالَهُ يُوحَنَّا عَنْ هٰذَا كَانَ حَقّاً».
ص ٣: ٣
فَأَتَى إِلَيْهِ كَثِيرُونَ ممن أرادوا الاستفادة من تعاليمه. وكان موضعه موافقاً لذلك إذ كان قريباً من أورشليم فهان على الناس أن يذهبوا إليه وكان بمعزل عن اضطهاد الفريسيين. ولا بد من أنه ذكرهم بمناداة يوحنا بالتوبة هنالك وشهادته للمسيح.
وَقَالُوا إِنَّ يُوحَنَّا لَمْ يَفْعَلْ آيَةً الخ في قولهم هنا شهادتان إحداهما ليوحنا والأخرى للمسيح. فصدقوا أولاً أن يوحنا كان نبياً بدون معجزة وتحققوا حينئذ أنه كذلك لأنه قد ثبت صدق نبوءته بشأن المسيح. وشهدوا ليسوع بأنه المسيح بناء على شهادة يوحنا بأن يسوع هو «الآتي» أي المسيح وبناء على اختبارهم بما شاهدوا وسمعوا من معجزاته وتعاليمه.
٤٢ «فَآمَنَ كَثِيرُونَ بِهِ هُنَاك».
ص ٨: ٣٠ و١١: ٤٥
هذا كما قيل في (ص ٨: ٣٠ و١١: ٤٥) ولا شيء يدل على أن إيمانهم لم يكن قلبياً ثابتاً. فمقاومة أهل أورشليم للمسيح كانت فائدة لأهل بيرية.
الأصحاح الحادي عشر
إقامة لعازر وتأثيرها في الرؤساء وفي الشعب (ع١–٥٧)
١ «وَكَانَ إِنْسَانٌ مَرِيضاً وَهُوَ لِعَازَرُ، مِنْ بَيْتِ عَنْيَا مِنْ قَرْيَةِ مَرْيَمَ وَمَرْثَا أُخْتِهَا».
لوقا ١٠: ٣٨، ٣٩
لا نعرف لماذا لم يذكر أحد من البشيرين هذه المعجزة سوى يوحنا، لكننا نعلم أن الروح القدس ألهم كل بشير أن يكتب ما كتبه، ونعلم أن البشيرين متّى ومرقس ولوقا سجلوا بالأكثر خدمة المسيح في الجليل وتركوا ما حدث في اليهودية، ويوحنا سجَّل ما حدث في اليهودية. وظن بعضهم أنهم لم يذكروا إقامة لعازر خوفاً من اضطهاد اليهود لبيت لعازر (ص ١٢: ١٠، ١١). وأما يوحنا فكتب بعد خراب أورشليم وقد زال كل خوف من وقوع مثل ذلك الاضطهاد. والأرجح أن ما ذُكر في هذا الأصحاح كان في آخر خدمة يسوع في بيرية.
لِعَازَرُ هو في اليونانية كذلك، ولكنه في العبرانية «ألعازر» ومعناه «الرب عون» ولا نعرف من أمره إلا أنه كان من بيت غني، ونستنتج ذلك من الوليمة التي أُعدت في بيته ليسوع (ص ١٢) ومن الطيب الذي أتت به أخته إلى المسيح فإنه لا يقدر على تقديم مثله سوى الأغنياء، ومن كثرة الأصحاب الذين أتوا ليعزوهم عن وفاة لعازر، وأن لعازر دُفن في قبر منحوت في الصخر.
مِنْ بَيْتِ عَنْيَا انظر شرح متّى ٢٦: ٢. وتسمى اليوم اللعازرية.
قَرْيَةِ مَرْيَمَ وَمَرْثَا أُخْتِهَا أي القرية التي كانتا تسكنان فيها (لوقا ١٠: ٢٨). والأرجح أن مرثا هي الكبرى (لوقا ١٠: ٣٨). وذُكرت مريم أولاً لأنها اشتهرت أكثر من مرثا لسبب دهنها جسد يسوع بالطيب.
٢ «وَكَانَتْ مَرْيَمُ، الَّتِي كَانَ لِعَازَرُ أَخُوهَا مَرِيضاً، هِيَ الَّتِي دَهَنَتِ الرَّبَّ بِطِيبٍ، وَمَسَحَتْ رِجْلَيْهِ بِشَعْرِهَا».
متّى ٢٦: ٧ ومرقس ١٤: ٣ ويوحنا ١٢: ٣
انظر شرح متّى ٢٦: ٦ - ١٣.
هِيَ الَّتِي دَهَنَتِ الرَّبَّ قيل ذلك لتمييزها عن غيرها من المريمات، إذ ذُكر أربع منهن في البشائر، وهن مريم أم يسوع، ومريم امرأة كلوبا، ومريم المجدلية، ومريم هذه. وميّزها يوحنا بدهنها جسد الرب لأنه كان أمراً مشهوراً، ذُكر أيضاً في يوحنا ١٢: ٣. ويجب أن نميّز بينها وبين المرأة المذكورة في لوقا ٧: ٣٧، لأن أخت لعازر دهنته في بيت عنيا، وتلك دهنته في الجليل، وأن أخت لعازر كانت تقية وشهد لها المسيح بأنها «اختارت النصيب الصالح» وأما تلك فكانت خاطئة.
٣ «فَأَرْسَلَتِ الأُخْتَانِ إِلَيْهِ قَائِلَتَيْنِ: يَا سَيِّدُ، هُوَذَا الَّذِي تُحِبُّهُ مَرِيضٌ».
فَأَرْسَلَتِ الأُخْتَانِ إِلَيْهِ كان يسوع حينئذٍ في عبر الأردن على نحو سفر يوم أو أكثر من بيت عنيا، وأرسلتا إليه بسبب ما كان بينهم من الصداقة، ولأن المسيح كان يتردد إلى بيتهما حين كان يأتي إلى أورشليم (لوقا ١٠: ٣٨ ويوحنا ١٢: ١، ٢).
هُوَذَا الَّذِي تُحِبُّهُ مَرِيضٌ لا بد من أن غايتها من ذلك مجيء المسيح ليشفي أخاهما، أو أن يشفيه بكلمة من على بُعد، كما شفى غيره. ولم تسألاه الشفاء بل اكتفتا بإخباره بالمرض، فأظهرتا بذلك التواضع والإيمان بقوته ومحبته. وما فعلته الأختان بواسطة إرسال الرسول يمكننا أن نفعله الآن بالصلاة عند مرض أحد أقربائنا أو أصحابنا، مع اتخاذ الوسائل البشرية النافعة. ولا يجوز أن نغفل عن أحد الأمرين.
٤ «فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ، قَالَ: هَذَا المَرَضُ لَيْسَ لِلمَوْتِ، بَل لأجْلِ مَجْدِ اللَّهِ، لِيَتَمَجَّدَ ابْنُ اللَّهِ بِهِ».
يوحنا ٩: ٣ ،٤٠
فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ، قَالَ الأرجح أن الرسول حمل الخبر إلى المسيح شفاهاً لا كتابة، وأجابه المسيح شفاهاً على مسمع من التلاميذ. ولم يوضح المسيح مراده تمام الإيضاح، بل قصد بجوابه تعزية الأختين وإنشاء الرجاء في قلبيهما.
هَذَا المَرَضُ لَيْسَ لِلمَوْتِ قال المسيح هذا بناءً على معرفته العاقبة، وعلى قصده أن يقيمه. فلم يقل إن لعازر لا يموت، بل إن عاقبة هذا المرض ليست للموت المعتاد المستمر. فكأنه قال: هذا المرض لموت وقتي، لا للموت العادي. فهو كقوله في بنت يايرس إنها لم تمت بل هي نائمة لأنه قصد أن يحييها.
بَل لأجْلِ مَجْدِ اللَّهِ أي لإظهار مجده. وتم ذلك الإظهار بإقامة لعازر. فإكرام يسوع بسبب ذلك، وإيمان الناس به، وزيادة إيمان لعازر وسائر بيته من وسائط إظهار مجد الله، لأنها حملت الناس على تمجيده بألسنتهم وقلوبهم. ويجب أن يكون موت كل مسيحي لمجد الله بالإيمان الذي يُظهره عند احتضاره، وبإيمان أقربائه وأصحابه وصبرهم على وفاته.
٥ «وَكَانَ يَسُوعُ يُحِبُّ مَرْثَا وَأُخْتَهَا وَلِعَازَرَ».
الحب هنا بمعنى الحنو وإرادة الخير على ما يفيد الأصل اليوناني، وهو ترجمة الكلمة التي تُرجم عنها حب الله العالم. وأما الحب في ع ٣ فهو ترجمة لفظة تفيد المحبة الشخصية الطاهرة. ويحسُن أن ننتبه لأن محبة يسوع للعازر لم تمنع عنه المرض والموت، ولم تمنع أختيه من الحزن على ذلك. فالمرض والموت ليسا دليلاً على غضب الله أو بغضه أو إهماله. وذكر يوحنا محبة المسيح لهؤلاء الأشخاص لئلا يتوهم القارئ أن إبطاء المسيح المذكور في الآية الآتية نتج عن عدم اكتراثه بهم.
٦ «فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّهُ مَرِيضٌ مَكَثَ حِينَئِذٍ فِي المَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ يَوْمَيْنِ».
يوحنا ١٠: ٤٠
مَكَثَ حِينَئِذٍ فِي المَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ أي في بيت عبرة في بيرية يوحنا ١: ٢٨ و١٠: ٤٠
يَوْمَيْنِ قصد المسيح أن يمكث هذين اليومين بدلاً من أن يسرع إلى بيت عنيا لأسباب اقتضتها حكمته. ولولا ذلك لشفاه بكلمة أو أدركه قبل أن يموت، ودفع عنه ألم الموت وعن أختيه مرارة الحزن، كما فعل بابن خادم الملك (يوحنا ٤: ٥٠). ومن تلك الأسباب أنه كان عليه عملٌ في بيرية لم يكن قد أجراه. وأنه لو أتى وشفاه ما حدثت تلك المعجزة التي هي أعظم معجزاته (ما عدا قيامته هو)، وما سمعنا منه هذا التعليم الذي ألقاه بمناسبة إحياء لعازر. فخسارة أهل ذلك البيت كانت ربحاً عظيماً لكل مسيحي. ولنا من خبر موت لعازر أن الله يسمح بالمصائب الجسدية للخيرات الروحية، وأن إبطاءه عن إجابة الصلاة ليس دليلاً على أنه يرفضها أو أنه لا يحب السائلين.
٧ «ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لِتلامِيذِهِ: لِنَذْهَبْ إِلَى اليَهُودِيَّةِ أَيْضاً».
ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أي بعد يومين من وصول الرسول إليه ورده الجواب. والمسافة بين بيت عنيا وبيت عبرة سفر يوم. فإذا فرضنا أن لعازر مات يوم مجيء الرسول إلى يسوع، فذلك اليوم مع اليومين اللذين مكث فيهما يسوع في بيت عبرة، واليوم الذي سار فيه مع تلاميذه إلى بيت عنيا أربعة أيام (ع ٣٩).
لِنَذْهَبْ إِلَى اليَهُودِيَّةِ قال هذا لأنه كان في بيرية (يوحنا ١٠: ٤٠) وبيت عنيا في اليهودية.
٨ «قَالَ لَهُ التّلامِيذُ: يَا مُعَلِّمُ، الآنَ كَانَ اليَهُودُ يَطْلُبُونَ أَنْ يَرْجُمُوكَ، وَتَذْهَبُ أَيْضاً إِلَى هُنَاكَ».
يوحنا ١٠: ٣١
كَانَ اليَهُودُ يَطْلُبُونَ أَنْ يَرْجُمُوكَ أشار التلاميذ بذلك إلى ما حدث في أورشليم يوم عيد التجديد منذ بضعة أسابيع حين طلب الكتبة والفريسيون أن يقتلوه (يوحنا ١٠: ٣١، ٣٩).
وَتَذْهَبُ أَيْضاً إِلَى هُنَاكَ أظهر التلاميذ بذلك تعجبهم من ذهاب المسيح إلى اليهودية وخوفهم على حياته وحياتهم، ورغبتهم في عدوله عن قصده.
٩، ١٠ «٩ أَجَابَ يَسُوعُ: أَلَيْسَتْ سَاعَاتُ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ؟ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَمْشِي فِي النَّهَارِ لا يَعْثُرُ لأنَّهُ يَنْظُرُ نُورَ هَذَا العَالَمِ. ١٠ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَمْشِي فِي اللَّيْلِ يَعْثُرُ، لأنَّ النُّورَ لَيْسَ فِيه».
يوحنا ٩: ٤ يوحنا ١٢: ٣٥
لم يشجع المسيح تلاميذه الخائفين بقوله: لا تخافوا، بل ضرب لهم مثلاً مناسباً لكل مسافر يستطيعون أن يستنتجوا منه ما يطمئن قلوبهم.
أَلَيْسَتْ سَاعَاتُ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أخذ اليهود قسمة النهار اثني عشر جزءاً عن البابليين أيام سبيهم إلى بابل، وظلوا على ذلك إلى يومنا هذا. والكلام هنا خبر بصورة الاستفهام، ومعناه أنتم تعلمون أن ساعات النهار إلخ.
لا يَعْثُرُ لأنَّهُ يَنْظُرُ نُورَ هَذَا العَالَمِ لأن النهار مدة إضاءة الشمس، فيكون فيه ما يكفي المسافر من الضوء ليرى طريقه ويتجنب العثرات، فيكون آمناً فيه. ولذلك لا داعي لخوفه. وسمى الشمس «بنور هذا العالم» لأنه يضيء بها.
ِإِنْ كَانَ أَحَدٌ يَمْشِي فِي اللَّيْل حال المسافر في الليل خلاف حاله في النهار، إذ لا نور في سبيله، فيكون عرضة للتعثر والسقوط، فلا بد من أن يخاف لأسباب وجيهة. وقد أشار المسيح «بساعات النهار الاثنتي عشرة» إلى كل زمن خدمته على الأرض الذي عيّنه الله (يوحنا ٩: ٤، ٥). وأن ذلك الوقت لم ينته بعد، ولذلك لا يخشى أن يؤذيه أحد حتى ينتهي نهاره وتأتي ساعة موته (يوحنا ٧: ٦، ٨ ،٣٠ و٨: ٢٠). وصرّح بأنه مثل مسافر في ضوء الشمس لا يخشى خطراً من عثرة أو سقوط، فطمأنهم بحفظه إياهم من الخطر. فحفظهم منه وهم معه وأنه يجب أن يُجري عمله حتى وسط الأعداء الذين يطلبون قتله. وفي ما ذُكر تلميح إلى أن زمن الأمن الذي عبر عنه «باثنتي عشرة ساعة» على وشك النهاية، وأن ليلة موته قريبة.
١١ «قَالَ هَذَا وَبَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَهُمْ: لِعَازَرُ حَبِيبُنَا قَدْ نَامَ. لَكِنِّي أَذْهَبُ لأُوقِظَهُ».
تثنية ٣١: ١٦ ودانيال ١٢: ٢ ومتّى ٩: ٢٤ وأعمال ٧: ٦٠ و١كورنثوس ١٥: ١٨، ٥١
هَذَا أي ما ذُكر من كلام على نهار الأمن وليل الخطر.
حَبِيبُنَا أشار بذلك إلى أن التلاميذ كانوا يحبون لعازر، كما كان هو يحبه. فكان يجب أن يُسروا بالذهاب إليه. وتسمية يسوع لعازر «حبيبه» يدل على محبته لكل مؤمن، إذ لم يكتف بتسميته تلميذاً أو عبداً. فخيرٌ للمؤمن أن يكون حبيباً للمسيح من أن يكون حبيباً لكل ملوك الأرض، لأنه يحبنا في الحياة والموت وبعد الموت وإلى الأبد.
نَامَ أشار بذلك إلى موت لعازر بأسلوب لطيف جداً. ومن صدَّق أن يسوع إله كما أنه إنسان لا يتعجب من معرفته وهو في بيت عبرة ما حدث في بيت عنيا. وكثيراً ما عبّر الكتاب المقدس عن الموت بالنوم أو الرقاد، ومن ذلك ما في تثنية ٣١: ١٦ ودانيال ١٢: ٢ ومتّى ٩: ٢٤ و٢٧: ٥٢ وأعمال ٧: ٦٠ و١٣: ٣٦ و ١كورنثوس ٧: ٣٩ و١١: ٣٠ و١٥: ٦ - ١٨، ٥١ و١تسالونيكي ٤: ١٣، ١٤ و٥: ١٠.
وأوجه الشبه بين الموت والنوم ثلاثة: (١) المنظر. (٢) رجاء قيام كل من الميت والنائم، فالموت ليس نهاية الإنسان لأنه لا بد من أن يستيقظ يوم القيامة. (٣) الراحة لأن في النوم راحة من أتعاب النهار، وفي الموت راحة من أتعاب الحياة.
أَذْهَبُ لأُوقِظَهُ لم يذكر غايته من الذهاب أولاً (ع ٧) إنما أعلنها هنا، وهي إقامة إنسان ميت. فالمخادع لا يعلن غايته لئلا ينتبه المشاهدون لكشف خداعه.
إن إيقاظ النائم العادي من أسهل الأمور، وأما إيقاظ الميت فيحتاج إلى قوة إلهية. وأظهر المسيح بهذه العبارة ثقته بسلطانه على تلك القوة الخارقة الطبيعة.
١٢ «فَقَالَ تلامِيذُهُ: يَا سَيِّدُ، إِنْ كَانَ قَدْ نَامَ فَهُوَ يُشْفَى».
لعل علة جهلهم ما قصده المسيح بكلامه في آية ٤ أنهم فهموا أن مرض لعازر ليس مميتاً، فاتخذوا المجاز حقيقة، وحكموا أن نوم لعازر عادي، وأنه علامة النقاهة بعد المرض. ولا عجب من خطئهم فإنه سبق لهم مثل ذلك في أمر الخميرة (متّى ١٦: ٦) وفي أمر السيف (لوقا ٢٢: ٣٨) وفي أمر الطعام (يوحنا ٤: ٣٢). ونتيجة زعمهم أنه لم تبق هناك حاجة للذهاب إلى بيت عنيا.
١٣ «وَكَانَ يَسُوعُ يَقُولُ عَنْ مَوْتِهِ، وَهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ يَقُولُ عَنْ رُقَادِ النَّوْمِ».
هذا تفسير يوحنا لكلام المسيح. كان يجب على التلاميذ أن يذكروا قول يسوع في بنت يايرس (وقد ماتت) «إنها نائمة» (متّى ٩: ٢٤).
١٤ «فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ حِينَئِذٍ علانِيَةً: لِعَازَرُ مَاتَ».
أعدّ قلوبهم بما قال من المجاز إلى الخبر الحقيقي. ولو لم يكن المسيح إلهاً يعلم كل شيء ما استطاع معرفة موت لعازر.
١٥ «وَأَنَا أَفْرَحُ لأجْلِكُمْ إِنِّي لَمْ أَكُنْ هُنَاكَ، لِتُؤْمِنُوا. وَلَكِنْ لِنَذْهَبْ إِلَيْهِ».
وَأَنَا أَفْرَحُ لأجْلِكُمْ إِنِّي لَمْ أَكُنْ هُنَاكَ، لِتُؤْمِنُوا في هذا تلميح إلى أنه لو كان في بيت عنيا عندما مرض لعازر لشفاه لا محالة. ولا شك أن التلاميذ استغربوا كلامه هذا إذ لم يتوقعوا إقامة لعازر، فكانوا يعتقدون أنه كان عليه أن يفرح لو كان هناك لينقذه من مرضه الشديد. ومعنى كلام المسيح هنا أن موت لعازر كان نتيجة غيابه من بيت عنيا، وأن المسيح سيقيمه لأنه مات، وأن تقوية إيمان تلاميذه بأنه المسيح من جملة فوائد تلك الإقامة.
ولم يقل المسيح إنه فرح بموت لعازر، بل قال إنه فرح بفوائد الإحياء الناتجة عن موته. فموت أصحابنا وإن كان محزناً في ذاته، ربما كان علة فرح لمن استفادوا منه استفادة روحية وآل إلى تمجيد الله.
ولنا من ذلك أن تقوية إيمان التلاميذ كانت من أعظم الأمور ذات الشأن عند المسيح، وإلا لما سمح بكل ذلك المصاب العظيم لأجلها.
لِنَذْهَبْ إِلَيْهِ لم يقل: لنذهب إلى حيث كان أو إلى قبره، بل «إليه». وهذا دليل على قصده إقامته، وإلا لم صحَّ ذهابهم إليه أو اجتماعهم به.
١٦ «فَقَالَ تُومَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ التَّوْأَمُ لِلتّلامِيذِ رُفَقَائِهِ: لِنَذْهَبْ نَحْنُ أَيْضاً لِكَيْ نَمُوتَ مَعَهُ».
تُومَا ذُكر أيضاً في يوحنا ١٤: ٥ و٢٠: ٢٤ - ٢٧ وما ذُكر من أمره يدل على أنه كان يميل إلى التساؤل والشك.
لِنَذْهَبْ نَحْنُ أَيْضاً لِكَيْ نَمُوتَ مَعَهُ أي مع المسيح لأنه لم يسمع لنصحنا أو توسلاتنا أن لا يذهب إلى اليهودية محل الخطر. فالظاهر من كلامه أن قول المسيح إنه يذهب ليوقظه لم يؤثر فيه شيئاً، ولم يتوقع أن المسيح سيقيم لعازر، وأنه ينتظر أن يقتل اليهود يسوع ويقتلوهم معه. ومع كل ذلك قصد لحبه إياه أن لا يتركوه، بل أن يُقْدم على الخطر معه. والأرجح أن كل التلاميذ شاركوا توما في أفكاره وعزمه.
١٧ «فَلَمَّا أَتَى يَسُوعُ وَجَدَ أَنَّهُ قَدْ صَارَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ فِي القَبْرِ».
فَلَمَّا أَتَى يَسُوعُ من بيت عبرة في بيرية (وهي في عبر الأردن) إلى بيت عنيا نحو مسيرة يوم. ولعل المسيح قضى في ذلك السفر أكثر من يوم، فبلغ بيت عنيا في غد اليوم التالي ليكون له وقت من النهار كافٍ لإقامة لعازر وما تعلق بها. ولم يدخل يسوع القرية عند وصوله إليها بل بقي خارجها (ع ٢٠، ٣٠). ولعل سبب ذلك أن اليهود الذين كانوا في بيت لعازر لم يكونوا من أصدقاء يسوع، وأنه لم يحب أن يشاهد مظاهر الحزن ويسمع الضجيج (مرقس ٥: ٤٠)، وأنه رغب في أن يرى أصحابه الحزانى بمعزل عن الجمع. والأرجح أنه أرسل إليهم نبأ وصوله.
لَهُ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ فِي القَبْرِ لو عرفنا الوقت الذي شغله الرسول بذهابه من بيت لعازر إلى حيث كان يسوع، وعرفنا الوقت الذي شغله يسوع بذهابه من بيت عبرة إلى بيت عنيا، لعرفنا الوقت الذي بقي فيه لعازر حياً بعد ذهاب الرسول من بيته إلى يسوع. فإن الرسول قد صرف يوماً بذلك الذهاب، وصرف يسوع يوماً بالمجيء، وكان موت لعازر في يوم انطلاق الرسول إلى يسوع، وجملة ذلك مع اليومين اللذين مكث فيهما يسوع أربعة أيام. والأرجح أن المسيح صرف ما يزيد على اليوم، وإلا ما بقي وقتٌ من النهار لإقامته، فيكون موت لعازر بعد يوم من انطلاق الرسول. ومرور أربعة أيام على لعازر في القبر يدفع توهّم أنه كان قد أُغمي عليه ولم يمت حقيقة. وقوله في هذه الآية «وجد أنه قد صار له الخ» لا ينفي معرفته ذلك قبلاً، فإنه كان قد أخبر تلاميذه بذلك قبل أن يجيء (ع ١٤). فالمعنى أن الناس هناك شهدوا له بذلك.
١٨ «وَكَانَتْ بَيْتُ عَنْيَا قَرِيبَةً مِنْ أُورُشَلِيمَ نَحْوَ خَمْسَ عَشَرَةَ غَلوَةً».
وَكَانَتْ قال «كانت» لأنه حين كتب إنجيله كانت أورشليم وكل القرى التي حولها خرباً.
قَرِيبَةً مِنْ أُورُشَلِيمَ وذكر ذلك دليل على أنه لم يكتب إنجيله لسكان الأرض المقدسة. وذكر هنا قرب بيت عنيا من أورشليم بياناً لمجيء المعزين من أورشليم إليها.
خَمْسَ عَشَرَةَ غَلوَةً أي نحو ميلين أو ثلثي ساعة (انظر شرح متّى ٢١: ١).
١٩ «وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ اليَهُودِ قَدْ جَاءُوا إِلَى مَرْثَا وَمَرْيَمَ لِيُعَزُّوهُمَا عَنْ أَخِيهِمَا».
كان من عوائد اليهود أن يعزوا أهل الميت سبعة أيام بعد موته. واعتاد يوحنا أن يعني باليهود رؤساء الشعب الذين كان أكثرهم من أعداء يسوع. ولا دليل أنه لم يقصد ذلك هنا. وأتوا لتعزية ذلك البيت إما لأنهم من أقربائه، أو لأن وظيفتهم اقتضت ذلك.
٢٠ «فَلَمَّا سَمِعَتْ مَرْثَا أَنَّ يَسُوعَ آتٍ لاقَتْهُ، وَأَمَّا مَرْيَمُ فَاسْتَمَرَّتْ جَالِسَةً فِي البَيْتِ».
لَمَّا سَمِعَتْ مَرْثَا الأرجح أن مرثا كانت أكبر من مريم، ومن المعلوم أنها كانت مدبرة البيت (لوقا ١٠: ٤٠) عرفت بقدوم المسيح إما من رسول أرسله يسوع، أو لأنها رأته من بعيد، فأسرعت إليه إلى خارج القرية. ولم تخبر أختها بما كان، وإلا لم تقل لأختها بعد ذلك «المعلم قد حضر» (ع ٢٨).
وَأَمَّا مَرْيَمُ فَاسْتَمَرَّتْ جَالِسَةً كأنها قد غرقت في الحزن (أيوب ٢: ٨ وحزقيال ٨: ١٤). وظهرت من الأختين الصفات التي ظهرت منهما يوم الوليمة التي ذُكرت في لوقا ١٠: ٣٩ - ٤٢، إذ كانت مريم جالسة عند قدميه، ومرثا مهتمة بأمور البيت.
٢١ «فَقَالَتْ مَرْثَا لِيَسُوعَ: يَا سَيِّدُ، لَوْ كُنْتَ هَهُنَا لَمْ يَمُتْ أَخِي».
لم تقصد مرثا أن تلوم المسيح على غيابه بل أن تظهر أسفها على ذلك. ولم تتعجب من أنه لم يشفِه بكلمة وإن كان غائباً، كما تعجب غيرها من المعزين. ويفيد كلامها أنها كانت تعتقد أن المسيح لو كان حاضراً عند مرض أخيها لشفاه، لأن محبته له كانت تمنعه من أن يسمح بموته، وأن رئيس الحياة لا يسمح للموت أن يفترس أحداً أمام عينيه. ويفيد أيضاً اعتقادها أنه قد مضت الفرصة النافعة للعازر، وأنه انقطع الأمل بانتهاء حياته. وأن حضور المسيح بشخصه كان ضرورياً لشفاء المريض ودفع الموت. وفي كلام مرثا دليل على ثقتها بمحبة المسيح وقوته الفائقة الطبيعة على شفاء المريض، بشرط حضوره قبل موته، وتمنيها عدم غيابه فكأنها قالت: يا ليتك كنت هنا!
٢٢ «لَكِنِّي الآنَ أَيْضاً أَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا تَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ يُعْطِيكَ اللَّهُ إِيَّاهُ».
يوحنا ٩: ٣١
كلامها هنا مبهم، لكنه أظهر أن مجيء المسيح نبَّه إيمانها وبشرها بالمعونة والبركة بطريق لم تعرفه، ومع ذلك لم تتوقع أن يُحيي أخاها كما يُستدل من أقوالها وأعمالها بعد ذلك. وقولها: «ما تطلب من الله يعطيك الله إياه» يدل على أنها لم تعتبر يسوع سوى نبي، لا قوة له من ذاته على المعجزات، إنما ينال القوة على ذلك من الله بصلواته كما نالها إيليا وأليشع، وأنها نسيت كيف فعل المسيح المعجزات سابقاً.
٢٣ «قَالَ لَهَا يَسُوعُ: سَيَقُومُ أَخُوكِ».
سَيَقُومُ أَخُوكِ لم يقل لها متّى ولا كيف يقوم، وكان هذا امتحاناً لقدر إيمانها به ليزيدها إيماناً. وهي لم تحسب كلامه وعداً بإقامته في الحال.
٢٤ «قَالَتْ لَهُ مَرْثَا: أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَقُومُ فِي القِيَامَةِ، فِي اليَوْمِ الأَخِيرِ».
لوقا ١٤: ١٤ ويوحنا ٥: ٢٩
كانت مرثا تعتقد بالقيامة العامة بناءً على أقوال التوراة إن الصالحين يقومون في يوم الدين، ففهمت من كلام المسيح تلك القيامة ولم تتوقع غيرها. وكان ذلك الانتظار في المستقبل البعيد تعزية قليلة في مثل ذلك الحزن الوافر.
٢٥ «قَالَ لَهَا يَسُوعُ: أَنَا هُوَ القِيَامَةُ وَالحَيَاةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا».
يوحنا ٥: ٢١ و٦: ٣٩، ٤٠، ٤٤ ويوحنا ١: ٤ و٦: ٣٥ و١٤: ٦ وكولوسي ٣: ٤ و١يوحنا ١: ١، ٢ و٥: ١١ ويوحنا ٣: ٣٦ و١يوحنا ٥: ١٠ الخ
علَّمها يسوع هنا ما لم تعلم من أمر عظمته وقوته، وهو أنه غير مفتقر إلى غيره، وليس محتاجاً أن يصلي للآب لينال قوة ليفعل ما يريد.
أَنَا هُوَ القِيَامَةُ أي أنا علة القيامة الجسدية والقيامة الروحية ومصدرهما، علاوة على أني مُعلنهما، فأنا غالب موت وكل نتائجه. والمسيح هو القيامة الآن، وليس فقط في اليوم الأخير، لأنه هو القيامة، فهي ممكنة حيث كان. فلا يلزم أن تتوقع مرثا قيام أخيها في اليوم الأخير فقط. ومثل وصف يسوع نفسه بكونه القيامة وصف الرسول إياه بأنه «صَارَ لَنَا حِكْمَةً مِنَ اللَّهِ وَبِرّاً وَقَدَاسَةً وَفِدَاءً» ( ١كورنثوس ١: ٣٠).
وَالحَيَاةُ انظر شرح يوحنا ١: ٤. أي هو ينبوع كل حياة جسدية وروحية، وهذا يتضمن أنه القيامة أيضاً لأن مُبدئ الحياة الذي يقدر أن يعيدها، فقد أبدع حياة المخلوقات الحية من العدم. وأن كل من نال الحياة الروحية من البشر إنما نالها منه. وهو يحفظها دائماً، وأن كل الذين يقومون من الموت إنما يقومون به، وأنه لا حياة لأحد من الناس بدونه. فالمسيح صرح هنا بأنه «القيامة والحياة» وأثبت ذلك بالمعجزة وهي إقامته لعازر، وفتح لنا سبيلاً إلى ذلك بموته وقيامته. وحياته عربون قيامتنا وحياتنا، وهو يُجري كل ذلك بقوته.
مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ كما مات لعازر. فالموت هنا موت جسدي فقط لأن إيمان المؤمن دليل على أنه حي بالحياة الروحية، فلا يمكن أن يكون الإنسان ميتاً بالروح ومؤمناً معاً. ولنا من ذلك أن انفصال الروح عن الجسد لا يؤثر شيئاً في حياة الروح، وأن المؤمنين لا بد من أن يقوموا من الموت ويحيوا فيشاركونه في تلك الحياة إلى الأبد. نعم إن المؤمن يموت كما مات لعازر ويُدفن جسده في القبر، لكن ذلك تسلط الموت على الجسد وقتياً. وأما نفسه فهي متحدة بالمسيح دائماً، فلن يتسلط الموت عليها. وما صحَّ على المسيح الذي هو الرأس يصح على جميع المؤمنين الذين هم أعضاء جسده، فإن الموت استولى عليه وقتياً وقام غالباً للموت، وكذلك كل المؤمنين به يقومون بواسطته. وفي كلامه هنا تسليم بأن الإيمان لا يقي الإنسان من الموت الجسدي، وفيه استخفافٌ بذلك الموت لأنه إلى حين وتليه حياة أبدية.
فَسَيَحْيَا أي تعود إليه الحياة الجسدية يوم القيامة. والموت للمؤمن باب للحياة الأبدية، ويوافق ما قيل في أعمال ٧: ٥٩ ورومية ١٤: ٨ و١تسالونيكي ٥: ١٠ و٢تيموثاوس ٤: ٨ و٢بطرس ١: ١١.
٢٦ «وَكُلُّ مَنْ كَانَ حَيّاً وَآمَنَ بِي فَلَنْ يَمُوتَ إِلَى الأَبَدِ. أَتُؤْمِنِينَ بِهَذَا؟».
وَكُلُّ مَنْ كَانَ حَيّاً بالجسد كما كانت مرثا حينئذ. فما أثبته المسيح للمؤمنين الموتى أثبته للمؤمنين الأحياء (يوحنا ٦: ٥٠، ٥١، ٥٤، ٥٨).
فَلَنْ يَمُوتَ إِلَى الأَبَدِ موتاً روحياً، فالموت الثاني لا سلطة له على المؤمن، والموت الجسدي لا يأتيه كعدو بل كصاحب لينقله من هذا العالم إلى عالم أفضل منه، لأن المسيح نزع شوكة الموت التي هي الخطية، وأنه يقيمه بعد قليل من القبر ويدخله إلى المجد، فلن يموت أيضاً لأنه يكون مثل المسيح «فَإِنْ كُنَّا قَدْ مُتْنَا مَعَ المَسِيحِ، نُؤْمِنُ أَنَّنَا سَنَحْيَا أَيْضاً مَعَهُ. عَالِمِينَ أَنَّ المَسِيحَ بَعْدَمَا أُقِيمَ مِنَ الأَمْوَاتِ لا يَمُوتُ أَيْضاً. لا يَسُودُ عَلَيْهِ المَوْتُ بَعْدُ» (رومية ٦: ٨، ٩). وهنا دليل قاطع على قوة الإيمان لأنه ينتصر على الموت.
أَتُؤْمِنِينَ بِهَذَا علاوة على إيمانك بأن أخاك يقوم في اليوم الأخير. فهل تصدقين أني علة القيامة وينبوع الحياة، وأن لي مفاتيح الموت والهاوية؟ فإن اقتصرتِ على تصديق أني نبي فذلك لا يكفي. فعلى كل مسيحي أن يسأل نفسه عن إيمانه بالمسيح، ليرى هل هو موافق لما قيل هنا؟ وإلا فليجتهد في إكماله بما شهد به المسيح لنفسه.
٢٧ «قَالَتْ لَهُ: نَعَمْ يَا سَيِّدُ. أَنَا قَدْ آمَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ المَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، الآتِي إِلَى العَالَمِ».
متّى ١٦: ١٦ ويوحنا ٤: ٤٢ و٦: ١٤، ٦٩
سلمت بمعنى قول المسيح على قدر إدراكها إياه. والنتيجة تدل على أنها لم تفهم كل مضمون قوله إنه هو القيامة والحياة. والظاهر أنها حسبت اعتقادها أنه المسيح فصدقت كل ما قاله.
آمَنْتُ قال الأعمى الذي شُفي «أومن يا سيد» (يوحنا ٩: ٣٨) لأن إيمانه كان في الحاضر. وقالت مرثا «آمنت» لإيمانها في الماضي وفي الحاضر أيضاً.
المَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، الآتِي إِلَى العَالَمِ في هذا الإقرار ثلاثة أمور: (١) أن يسوع هو المسيح أي الممسوح من الله ملكاً وكاهناً ونبياً. (٢) أنه ابن الله أي إله. (٣) أنه الفادي الموعود بمجيئه إلى العالم. فهذا مثل إقرار بطرس (متّى ١٦: ١٦) وأكمل منه.
٢٨ «وَلَمَّا قَالَتْ هَذَا مَضَتْ وَدَعَتْ مَرْيَمَ أُخْتَهَا سِرّاً، قَائِلَةً: المُعَلِّمُ قَدْ حَضَرَ، وَهُوَ يَدْعُوكِ».
مَضَتْ وَدَعَتْ مَرْيَمَ الأرجح أن يسوع أمرها بذلك بدليل قولها «وهو يدعوك». ولا بد من أن حبها لأختها حملها أيضاً على دعوتها إلى يسوع لتتعزى به كما تعزت هي بمشاهدته وبكلامه.
سِرّاً أي بدون أن تُعلم أحداً غيرها من اليهود الذين في بيتها. وعلة ذلك أنهم لم يكونوا من أصحابه، وأن اجتماع الناس يمنعهما من الحديث المفيد معه، وأن الحزانى يكرهون أن يشاهد الناس علامات حزنهم إذا كان حقيقياً.
المُعَلِّمُ اصطلح التلاميذ ومعارف يسوع أن يشيروا إليه بهذه اللفظة (متّى ٢٦: ١٨ ويوحنا ١٣: ١٣).
وَهُوَ يَدْعُوكِ هذا يدل على أن المسيح أمر مرثا بأن تدعو أختها وإن لم يُذكر ذلك.
٢٩ «أَمَّا تِلكَ فَلَمَّا سَمِعَتْ قَامَتْ سَرِيعاً وَجَاءَتْ إِلَيْهِ».
تركت المعزّين الكثيرين لتذهب إلى المعزي الحقيقي. كانت جالسة حزينة يائسة، فقيامها بسرعة يدل على نشوء الأمل في قلبها.
٣٠ «وَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ قَدْ جَاءَ إِلَى القَرْيَةِ، بَل كَانَ فِي المَكَانِ الَّذِي لاقَتْهُ فِيهِ مَرْثَا».
هذا كما استُدل عليه في آية ٢٠ بقوله «لاقته». وعلة بقائه خارج القرية أنه أتى ليقيم لعازر لا ليزور بيته (والأرجح أن القبور كانت خارج القرية) وأن اليهود الذين كانوا ينوحون معهما كانوا من أعدائه كما يُستدل من عمل بعضهم (ع ٤٦).
٣١ «ثُمَّ إِنَّ اليَهُودَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهَا فِي البَيْتِ يُعَزُّونَهَا، لَمَّا رَأَوْا مَرْيَمَ قَامَتْ عَاجِلاً وَخَرَجَتْ، تَبِعُوهَا قَائِلِينَ: إِنَّهَا تَذْهَبُ إِلَى القَبْرِ لِتَبْكِيَ هُنَاكَ».
ع ١٩
تَبِعُوهَا المرجح أنهم كانوا كثيرين، ولم يسمعوا دعوة مرثا لها، وخرجوا وراءها احتراماً لها ولأختها، وبياناً لمشاركتهم لهما في الحزن. ولم يتبعوا مرثا عند ذهابها لأن مريم كانت باقية، ولكن لما ذهبت الاثنتان تبعوهما كما أوجبت العادة.
إِنَّهَا تَذْهَبُ إِلَى القَبْرِ لِتَبْكِيَ هُنَاكَ جرياً على العادة اليهودية وغيرها ليمنعوها من الحزن الشديد المضر لجسمها، لأن مشاهدة القبر تهيج أسفها. وكانت نتيجة ذلك كثرة شهود المعجزة. ولعلهم لو عرفوا أن يسوع هناك ما خرجوا.
٣٢ «فَمَرْيَمُ لَمَّا أَتَتْ إِلَى حَيْثُ كَانَ يَسُوعُ وَرَأَتْهُ، خَرَّتْ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَائِلَةً لَهُ: يَا سَيِّدُ، لَوْ كُنْتَ هَهُنَا لَمْ يَمُتْ أَخِي».
ع ٢١
كان كلام مريم حين وصلت إلى يسوع مثل كلام مرثا (ع ٢١) مما يدل على أنهما كررتاه كثيراً بينهما في غيبة يسوع، وأن أمل مريم كان مثل أمل أختها، وهو أن المسيح لو كان حاضراً قبل موت أخيهما لشفاه، وأنه انقطع ذلك الأمر عند موته. وقيل فيها ما لم يُقل في مرثا وهو أنها «خرّت عند رجليه». وهذا دليل على أن الحزن قد اشتد عليها أكثر مما اشتد على مرثا، وأنه سحق روحها. وليس في كلامها مثل ما كان في كلام مرثا مما دل على نشوء الرجاء في قلبها بقدوم المسيح.
٣٣ «فَلَمَّا رَآهَا يَسُوعُ تَبْكِي، وَاليَهُودُ الَّذِينَ جَاءُوا مَعَهَا يَبْكُونَ، انْزَعَجَ بِالرُّوحِ وَاضْطَرَبَ».
يحقق لنا ما في هذه الآية ناسوت المسيح التام، كما حققت لنا معجزته لاهوته التام، وأنه يشارك المؤمنين به في أحزانهم. فمعلومٌ أن الإنسان إذا رأى كثيرين يبكون حوله مال إلى البكاء، وكذلك كان أمر يسوع. ولا سبب لبكائه سوى بكاء أولئك الناس، لأنه علم أن لعازر سيقوم. والمسيح لم يزل إلهاً وإنساناً في السماء، يشعر مع شعبه وهو على يمين الله في كل أحزانهم، وهو كرئيس كهنة شفوق يشفع عند الله فينا.
لم يكن على الأرض إنسان قلبه أرق من قلب المسيح، ولن يكون كذلك. فلا داعي لأن نلجأ إلى غيره بناءً على أنه لا يستطيع أن يشعر معنا. فيوحنا أثبت في الأصحاح الأول من إنجيله أزلية الكلمة، وأثبت في هذا الأصحاح حقيقة قوله «الكلمة صار جسداً».
انْزَعَجَ بِالرُّوحِ هذا يدل على انفعال شديد في قلبه عرفه البشير من دموعه وسائر إمارات الحزن على وجهه. وعلة هذا الانزعاج شعوره بحزنهم وحزنه، الذي لم يخلُ من الغيظ (كما تدل عليه الكلمة الأصلية في اليونانية). أما حزنه فللخطية التي هي العلة الأصلية لكل الحزن في العالم وللموت. ومثال ذلك هنا واحد من كثير لا يُحصى. وأما غيظه فلرياء بعض الحاضرين الذين تظاهروا بالحزن على وفاة لعازر وطلبوا بعد قليل أن يقتلوه (يوحنا ١٢: ١٠).
وَاضْطَرَبَ كحاله يوم أنبأ بخيانة يهوذا (يوحنا ١٣: ٢١) وربما هنالك أسباب أخرى لم نعرفها.
٣٤ «وَقَالَ: أَيْنَ وَضَعْتُمُوهُ؟ قَالُوا لَهُ: يَا سَيِّدُ، تَعَالَ وَانْظُرْ».
أيْنَ وَضَعْتُمُوهُ؟ تكلم بهذا باعتبار أنه إنسان، لأن الذي يستطيع أن يقيم الميت لا يحتاج إلى أن يدله أحد على قبره. فاختار أن يدله الحاضرون على القبر ليذهبوا معه ويشاهدوا المعجزة.
٣٥ «بَكَى يَسُوعُ».
لوقا ١٩: ٤١
هذه أقصر آية في الإنجيل لكنها ليست أقل أهمية من غيرها، لأنها دلت على ناسوت المسيح مع كونه إلهاً، وبيّنت رقة قلبه وفرط صداقته للمؤمنين. وفيها برهان على أنه يجوز للمسيحيين أن ينوحوا على موت أقربائهم وأصحابهم، وأن يُظهروا علامات الحزن التي لا تصل إلى درجة حزن الذين لا رجاء لهم، وأنه يجوز لنا أن نشارك غيرنا في حزنه.
٣٦ «فَقَالَ اليَهُودُ: انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ يُحِبُّهُ».
هذا يدل على تعجب بعض اليهود، ولا يخلو من الإشارة إلى استحسانهم. وهو أول ذِكْر لشيء قاله رؤساء اليهود غير المقاومة ليسوع. وكان استحسانهم استعداداً لإيمان بعضهم بعد ذلك (ع ٤٥).
٣٧ «وَقَالَ بَعْضٌ مِنْهُمْ: أَلَمْ يَقْدِرْ هَذَا الَّذِي فَتَحَ عَيْنَيِ الأَعْمَى أَنْ يَجْعَلَ هَذَا أَيْضاً لا يَمُوتُ؟».
يوحنا ٩: ٦
هذا كلام من يميل إلى التشكيك والقدح منهم، فكأنهم قالوا: إن صحَّ أنه فتح عيني الأعمى منذ أربعة أشهر (ص ٩) فلماذا لم يقدر أن ينقذ صديقه هذا من الموت؟ إن كان هو المسيح حقاً فلماذا لم يمنع ذلك المصاب عن لعازر وأختيه؟ أليس هذا برهاناً على أن قوته محدودة وأن الموت حدث رغماً عنه؟ وفي قولهم تلميح أنه لم يفتح عيني الأعمى حقيقة إنما فعله احتيالاً.
٣٨ «فَانْزَعَجَ يَسُوعُ أَيْضاً فِي نَفْسِهِ وَجَاءَ إِلَى القَبْرِ، وَكَانَ مَغَارَةً وَقَدْ وُضِعَ عَلَيْهِ حَجَرٌ».
فَانْزَعَجَ كما ذُكر في ع ٣٣ والعلل هي هي، وزيد عليها ما قالوه فيما بينهم (ع ٣٧). وعرفه هو بقوته الإلهية.
مَغَارَةً في الصخر، وهي إما طبيعية وإما صناعية. وكان الناس قد اعتادوا اتخاذ المغائر قبوراً (متّى ٨: ٢٨ ومرقس ١٦: ٢ - ٤ وتكوين ٢٣: ٩ وإشعياء ٢٢: ١٦ ومتّى ٢٧: ٦). ودُفن لعازر في مغارة لا في التراب من الأدلة على أنه من بيت ذي ثروة.
عَلَيْهِ حَجَرٌ أي على مدخله (انظر شرح متّى ٢٧: ٦٠).
٣٩ «قَالَ يَسُوعُ: ارْفَعُوا الحَجَرَ. قَالَتْ لَهُ مَرْثَا، أُخْتُ المَيْتِ: يَا سَيِّدُ، قَدْ أَنْتَنَ لأنَّ لَهُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ».
قَالَ يَسُوعُ ارْفَعُوا الحَجَرَ لم يرد يسوع أن يفعل بقوته الإلهية ما يستطيع الناس فعله، كما أمر الخدام أن يملأوا الأجران ماء في قانا، فكان الذين ملأوا تلك الأجران شهوداً بتحويله الماء خمراً. وهكذا كان الذين رفعوا الحجر عن القبر شهوداً بصحة إقامة لعازر.
قَالَتْ لَهُ مَرْثَا، أُخْتُ المَيْتِ ذكر البشير هنا نسبتها إلى لعازر بياناً لاعتراضها على فتح القبر دون غيرها.
قَدْ أَنْتَنَ يظهر من كلامها أن لا أمل لها ولا انتظار أن يقيم يسوع أخاها، لأنها حسبت ما سمعته من يسوع في شأن قيامته مجازاً يتحقق في المستقبل البعيد. وعلة اعتراضها على فتح القبر أنها لم ترد عرض جسد أخيها لأعين الناس بعد ابتداء الفساد فيه، وتعريض المسيح والحاضرين من الأصحاب لمنظر مقبِض ورائحة كريهة، ومعرفتها أن اقترابهم من الميت يدنسهم، وأن كل ذلك بلا نفع للميت.
ولنا من كلام مرثا هنا ثلاثة أمور: (١) ظنها أن قصد المسيح الوحيد في طلب رفع الحجر أن يرى وجه صديقه الميت، أو أنه لم يعرف كم مرّ على موته، أو أنه نسي ذلك. (٢) أن ما حدث للعازر ليس إغماءً بل هو موت حقيقي، لأن أخته التي حضرت موته شهدت أمام الجميع بذلك، وأن الوقت الذي مر عليه وهو في القبر كافٍ لبدء الفساد في جسده. (٣) أنه لا يوجد اتفاق بين المسيح وبين عائلة لعازر على خداع الشعب، لأنه لو كان هناك خداع بينهما ما اعترضت مرثا على فتح القبر.
أما الكلام على الأربعة الأيام فقد مر في شرح ع ١٧.
٤٠ «قَالَ لَهَا يَسُوعُ: أَلَمْ أَقُل لَكِ: إِنْ آمَنْتِ تَرَيْنَ مَجْدَ اللَّهِ؟».
ع ٤ ،٢٣
في كلام المسيح هنا توبيخ لطيف لمرثا على عدم إيمانها، كأنه نتج عن نسيانها كلامه. وفيه تشجيع لها، وتقوية لإيمانها الضعيف.
أَلَمْ أَقُل لَكِ؟ لم يتضح إلى أي أقواله أشار، والأرجح أنه للكلام الذي أرسله إليها وإلى أختها مع الرسول، وهو قوله «هَذَا المَرَضُ لَيْسَ لِلمَوْتِ، بَل لأجْلِ مَجْدِ اللَّهِ» (ع ٤). وظن بعضهم أنه أشار إلى ما قاله في حديثه معها عند وصوله (ع ٢١ - ٢٧).
إِنْ آمَنْتِ تكلم هنا كعادته في بيان ضرورة الإيمان لمن يريدون أن يشاهدوا أعماله المجيدة. ومن ذلك قوله «كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لِلمُؤْمِنِ» (مرقس ٩: ٢٣). ومثله قول البشير «وَلَمْ يَصْنَعْ هُنَاكَ (أي في الناصرة) قُوَّاتٍ كَثِيرَةً لِعَدَمِ إِيمَانِهِمْ» (متّى ١٣: ٥٨).
تَرَيْنَ مَجْدَ اللَّهِ بانتصاري على الموت وشفقتي على الحزانى. وهو بهذا يطلب منها أن تُظهر إيمانها بتسليمها بأمره بفتح القبر، وتعدل عن الاعتراض. ولا شك أنها سلمت بذلك.
وما يستحق النظر هنا أن طريق المسيح في الإيمان خلاف طريق الإنسان، لأن الإنسان يريد أن يرى ليؤمن، وأما المسيح فيريد أن نؤمن لنرى.
٤١ «فَرَفَعُوا الحَجَرَ حَيْثُ كَانَ المَيْتُ مَوْضُوعاً، وَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ إِلَى فَوْقُ، وَقَالَ: أَيُّهَا الآبُ، أَشْكُرُكَ لأنَّكَ سَمِعْتَ لِي».
فَرَفَعُوا الحَجَرَ توقفوا عن رفعه قبلاً لاعتراض مرثا صاحبة الحق في ذلك لأنها أخت الميت الكبرى، ولأنها قامت بكل أمور الدفن. ولما عدلت عن الاعتراض أطاعوا المسيح.
وَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ إِلَى فَوْقُ أي نظر إلى السماء، لمخاطبة الله. ووفقاً لاعتقاد الناس أن السماء موضع إظهار مجد الله الخاص. وقد فعل يسوع مثل ذلك في يوحنا ١٧: ١.
وَقَالَ ما قاله هنا ليس صلاة لله ليعينه على عمل المعجزة، إنما هو تقديم الحمد والشكر له، وبيان الاتحاد التام بينه وبين الآب في الفكر والقول.
أَشْكُرُكَ لأنَّكَ سَمِعْتَ لِي الآن وقبل الآن. ويُظهِر كلامه هذا أنه اعتبر كل ما يتعلق بلعازر من موته وأحوال ذلك الموت وإقامته إياه إجابةً لصلاة صلاها سابقاً، وشكر الله عليها. فكأن المسيح اعتبر لعازر قد قام. والمسيح كان يصلي دائماً لأبيه، ولا شك أنه جعل كل حادثة جرت له موضوعاً للصلاة.
٤٢ «وَأَنَا عَلِمْتُ أَنَّكَ فِي كُلِّ حِينٍ تَسْمَعُ لِي. وَلَكِنْ لأجْلِ هَذَا الجَمْعِ الوَاقِفِ قُلتُ، لِيُؤْمِنُوا أَنَّكَ أَرْسَلتَنِي».
يوحنا ١٢: ٣٠
وَأَنَا عَلِمْتُ أَنَّكَ فِي كُلِّ حِينٍ تَسْمَعُ لِي فشكري لك ليس لأنك سمعت لي الآن، بل لأنك تسمع لي دوماً.
وَلَكِنْ لأجْلِ هَذَا الجَمْعِ وهو جمع من يهود أورشليم، وتلاميذه، وكثيرين من أهل القرية.
لِيُؤْمِنُوا أَنَّكَ أَرْسَلتَنِي قال بعضهم «أنه ببعلزبول» يفعل معجزاته، وأما هو فقال «إن الله أرسله ليفعلها» فأراد أن تكون تلك المعجزة فاصلة بين الأمرين. وبرهن أنه صنع كل ما سبق له من المعجزات برضى الله والاتحاد به. وسمى الله «أباه» في هذه الصلاة فاستشهده بذلك لإثبات دعواه أنه هو ابنه وأنه هو المسيح.
وبين صلاة المسيح وصلاة إيليا عندما أقام الميت (١ملوك ١٧: ٢٠، ٢١) فرق بعيد، فصلاة إيليا فيها لجاجة وعلامات خوف من أن الله لا يستجيبه.
٤٣ «وَلَمَّا قَالَ هَذَا صَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ: لِعَازَرُ، هَلُمَّ خَارِجاً».
يوحنا ٥: ٢٥، ٢٨
صَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ ليسمع الجميع وينتبهوا أنه هو الذي أقام لعازر.
هَلُمَّ خَارِجاً أمره بالخروج بسلطان نفسه، ولم يأمره به باسم أبيه.
٤٤ «فَخَرَجَ المَيْتُ وَيَدَاهُ وَرِجْلاهُ مَرْبُوطَاتٌ بِأَقْمِطَةٍ، وَوَجْهُهُ مَلفُوفٌ بِمِنْدِيلٍ. فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: حُلُّوهُ وَدَعَوْهُ يَذْهَبْ».
يوحنا ٢٠: ٧
هذا رمز إلى ما يحدث في اليوم الأخير وفقاً لقوله «إِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ فِيهَا يَسْمَعُ جَمِيعُ الَّذِينَ فِي القُبُورِ صَوْتَهُ، فَيَخْرُجُ الخ» (يوحنا ٥: ٢٨، ٢٩ انظر ١تسالونيكي ٤: ١٦). وهذا أعظم معجزات المسيح ما عدا قيامته. ولا شك في أن إقامة لعازر معجزة لا يمكن إنكارها لأنها جرت أمام شهود كثيرين من الأصحاب والأعداء. ومعلوم أن لا قوة طبيعية أو بشرية تستطيع أن تجعل الميت يسمع الصوت ويقوم من الموت ويخرج من القبر.
أقام المسيح ثلاثة موتى، وكان برهان سلطانه على الموت يزيد قوة على التوالي، فأول ميت أقامه ابنة يايرس، وأقامها على أثر خروج روحها. والثاني ابن أرملة نايين وأقامه والناس يحملونه إلى القبر. والثالث لعازر وأقامه بعد دفنه بأربعة أيام.
فَخَرَجَ المَيْتُ وَيَدَاهُ وَرِجْلاهُ مَرْبُوطَاتٌ بِأَقْمِطَةٍ الأرجح أن تلك الأقمطة لم تكن مشدودة لدرجةٍ تمنعه من تحريك أعضائه. وكانت الغاية منها أن تحفظ أطياب التحنيط على جسده. ولما أُعيدت الحياة إليه لم تمنعه من المشي، إنما صعَّبته عليه وألجأته إلى المشي ببطء. فلا داعي لأن نحسب خروجه كما ذُكر معجزة، ولا مانع من أن ننسبه إلى قوته بعد إقامته.
وَوَجْهُهُ مَلفُوفٌ بِمِنْدِيلٍ كعادتهم يومئذ في تدبير الموتى (يوحنا ٢٠: ٧).
حُلُّوهُ وَدَعَوْهُ يَذْهَبْ ليتحقق الجميع أنه لعازر نفسه، وأنه حي، وليمكنه السير بسهولة إلى بيته. وأمرهم بحله كما أمرهم برفع الحجر، لأنه لم يكن يريد فعل المعجزة في ما يستطيعه البشر. ولم يزد البشير شيئاً على ما ذُكر من هذه القصة في ذلك الوقت لأن غايته لم تكن سوى إظهار مجد المسيح بإعلانه أنه القيامة والحياة.
إن إقامة لعازر كانت إثباتاً للتعليم أن يسوع يقيم الموتى في اليوم الأخير (دانيال ١٢: ٢ ويوحنا ٥: ٢١ - ٢٩ و٦: ٣٩ و١كورنثوس ١٥: ٢٦ و٥٤ و٢كورنثوس ٤: ١٤ وكولوسي ٣: ٤ و١تسالونيكي ٤: ١٤ - ١٧ ورؤيا ١: ١٨ و٢٠: ١٤). وهي أيضاً رمز إلى عمل يفعله أعظم من إقامة أجساد الموتى، وهو إحياؤه النفوس الميتة بالإثم ومنحها الحياة الأبدية.
٤٥ «فَكَثِيرُونَ مِنَ اليَهُودِ الَّذِينَ جَاءُوا إِلَى مَرْيَمَ، وَنَظَرُوا مَا فَعَلَ يَسُوعُ، آمَنُوا بِهِ».
يوحنا ٢: ٢٣ و١٠: ٤٢ و١٢: ١١، ١٨
لم يذكر البشير تأثير المعجزة في نفس لعازر وأختيه، وذكر تأثيرها في نفوس المشاهدين، وهو ما طلبه المسيح في صلاته (ع ٤٢).
الَّذِينَ جَاءُوا إِلَى مَرْيَمَ وبقوا معها وجاءوا كذلك إلى القبر، ولم يذكر أنهم جاءوا إلى مرثا أيضاً كما هو الواقع، لأن مريم كانت سبب مجيئهم إلى القبر ومشاهدتهم المعجزة.
٤٦ «وَأَمَّا قَوْمٌ مِنْهُمْ فَمَضَوْا إِلَى الفَرِّيسِيِّينَ وَقَالُوا لَهُمْ عَمَّا فَعَلَ يَسُوعُ».
وَأَمَّا قَوْمٌ مِنْهُمْ فَمَضَوْا الذي أنشأ إيمان بعض الجمع وقوى إيمان بعضهم زاد عداوة الآخرين من أعداء يسوع وجواسيس الرؤساء والكهنة. وغاية إبلاغهم الرؤساء هو إرضاؤهم، وإثارة غضبهم على يسوع، وحثهم إياهم على إتمام قصدهم بقتله.
إِلَى الفَرِّيسِيِّينَ أصحاب معظم القوة السياسية في الشعب، ولأنهم كانوا أشد عداوة ليسوع.
٤٧ «فَجَمَعَ رُؤَسَاءُ الكَهَنَةِ وَالفَرِّيسِيُّونَ مَجْمَعاً وَقَالُوا: مَاذَا نَصْنَعُ؟ فَإِنَّ هَذَا الإِنْسَانَ يَعْمَلُ آيَاتٍ كَثِيرَةً».
مزمور ٢: ٢ ومتّى ٢٦: ٣ ومرقس ١٤: ١ ولوقا ٢٢: ٢ ويوحنا ١٢: ١٩ وأعمال ٤: ١٦
مَجْمَعاً أي مجمع السبعين القانوني (انظر شرح يوحنا ١: ١٩).
وَقَالُوا بالنظر إلى الشهادة بإقامة لعازر. وكان يجب أن يؤمنوا أن يسوع هو المسيح، ولكن تلك الشهادة كانت سبباً للإسراع في قتله بدلاً من أن تكون سبباً لإيمانهم به. وفي ذلك إثبات لقوله «إِنْ كَانُوا لا يَسْمَعُونَ مِنْ مُوسَى وَالأَنْبِيَاءِ، ولا إِنْ قَامَ وَاحِدٌ مِنَ الأَمْوَاتِ يُصَدِّقُونَ» (لوقا ١٦: ٣١).
مَاذَا نَصْنَعُ؟ لنمنع تعليم يسوع، ونوقف إيمان الشعب به؟ وفي قولهم هذا توبيخ لأنفسهم على تقصيرهم في اتخاذ الوسائل إلى منعه، وبيان ضرورة اتخاذ وسائط أكثر فعالية لمقاومته.
هَذَا الإِنْسَانَ قالوا ذلك استخفافاً به لأنهم كانوا يعرفون اسمه.
يَعْمَلُ آيَاتٍ كَثِيرَةً هذا تسليم غريب منهم أن ما فعلوه أظهر عجزهم عن إنكار معجزاته. وكان عليهم بعد هذا التسليم أن يسلموا بصحة دعواه، ولكن كبرياءهم وقسوتهم وحسدهم منعتهم من ذلك.
٤٨ «إِنْ تَرَكْنَاهُ هَكَذَا يُؤْمِنُ الجَمِيعُ بِهِ، فَيَأْتِي الرُّومَانِيُّونَ وَيَأْخُذُونَ مَوْضِعَنَا وَأُمَّتَنَا».
إِنْ تَرَكْنَاهُ هَكَذَا حسبوا كل ما قاوموه به سابقاً ليس شيئاً لأنهم لم يقبضوا عليه، فإنهم حكموا عليه بالموت (يوحنا ٧: ٣٠) وأرسلوا العسكر ليمسكوه (يوحنا ٧: ٣٠) وحرموا تابعيه (يوحنا ٩: ٢٢).
يُؤْمِنُ الجَمِيعُ بِهِ أي شعب اليهود. ويكون موضوع إيمانهم أن يسوع هو المسيح، وأن تعليمه حق. وهذا معظم سبب خوفهم، لأن نتيجته زوال قوتهم وتأثير تعليمهم في الشعب. ويظهر من قولهم أن تأثير إقامته لعازر في الناس كان أعظم من تأثير سائر معجزاته. ويدل على هذا أيضاً ما قيل في يوحنا ١٢: ١٠، ١١ من تآمر الكهنة في قتل لعازر ولإزالة شهادته، وما قيل في يوحنا ١٢: ١٧، ١٨ من دخول المسيح بعدئذ باحتفال ومجد إلى أورشليم.
فَيَأْتِي الرُّومَانِيُّونَ لم يذكروا السبب الحقيقي لخوفهم من نجاح يسوع وهو زوال سلطانهم، بل ادّعوا أن ذلك النجاح يغيظ الرومان. وهذا ادعاء باطل، لأنه لو آمن به جميع اليهود لبقي هيكلهم ومدينتهم بعظمتها إلى اليوم. ولكنهم ادّعوا هنا أن يسوع مزمع أن ينادي بأنه ملك ثائر على الرومان لينشئ مملكة زمنية. وشكوا عليه بذلك لبيلاطس وقت محاكمته (لوقا ٢٣: ٣٢).
وَيَأْخُذُونَ مَوْضِعَنَا موضعهم هو مدينتهم أو هيكلهم، أو مقامهم بين الناس. نعم إن الرومان كانوا وقتئذٍ قد استولوا على أرضهم، لكنهم تركوا لهم كل حقوقهم الدينية وبعض الحقوق السياسية، فخافوا أن يخسروا هذا أيضاً.
وَأُمَّتَنَا أي الأمة اليهودية.
٤٩ «فَقَالَ لَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ قَيَافَا، كَانَ رَئِيساً لِلكَهَنَةِ فِي تِلكَ السَّنَةِ: أَنْتُمْ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَ شَيْئاً».
لوقا ٣: ٢ ويوحنا ١٨: ١٤ وأعمال ٤: ٦
قَيَافَا انظر شرح متّى ٢٦: ٣. كان قيافا قد تولى رئاسة الكهنة ١١ سنة، وصاهر حنّان، وبقيت تلك الرئاسة في بيت حنّان ٥٠ سنة. والرؤساء هو وأربعة أولاد له وصهر. وقد حكم قيافا بواسطتهم بعد أن عُزل. وكثيراً ما ذُكر في الإنجيل أن حنّان كان رئيس الكهنة في الوقت الذي كان غيره متولياً فيه الرئاسة.
أمر الله بأن يكون رئيس الكهنة من بيت هارون، وأن يبقى الرئيس رئيساً كل حياته. ولكن منذ أيام هيرودس الكبير زالت الرئاسة من ذلك البيت، وكان من أيام هيرودس هذا إلى خراب أورشليم ٢٥ رئيس كهنة في نحو ١٠٧ سنين.
لَسْتُمْ تَعْرِفُونَ شَيْئاً في الأمر الذي تنظرون فيه. وقال هذا إما للقليلين الذين مالوا إلى يسوع (يوحنا ٣: ١ و٧: ٥٠، ٥١ و١١: ٤٥ و١٢: ٤٢) توبيخاً لهم على عدم تسليمهم بعقابه، أو للفريسيين الذين قالوا في ع ٤٨ ما معناه «هذا الإنسان يُهلكنا إذا تركناه» تسفيهاً لرأيهم، لأنه كان يجب عليهم أن يُهلكوه بدلاً من أن يتركوه يُهلكهم.
٥٠ «ولا تُفَكِّرُونَ أَنَّهُ خَيْرٌ لَنَا أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ عَنِ الشَّعْبِ ولا تَهْلِكَ الأُمَّةُ كُلُّهَا».
يوحنا ١٨: ١٤
خَيْرٌ لَنَا أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ الخ أراد قيافا أن يصرف النظر عن أن يسوع مذنب أو بار، يستحق الموت أو لا. وأراد أن يركز على أن منفعة الأمة تقتضي قتله لأنه إذا قُتل فلا خوف من ثورة الشعب، ولا من انتقام الرومان على تلك الثورة. وخلاصة كلامه أن يسوع أقلق الراحة فيجب أن نقتله ونستريح منه.
ولا دلالة على أن قيافا قصد بما قال النبوة، ولا على أنه كان له قوة التنبؤ. نعم إن الحبر الأعظم كان قديماً قادراً على ذلك بواسطة «الأوريم والتميم» (خروج ٢٨: ٣٠ وتثنية ٢٧: ٢١ و١صموئيل ٣٠: ٧، ٨ وهوشع ٣: ٤) لكن ذلك زال عنه منذ قرون. ولم يقصد قيافا أن يتكلم على موت يسوع ذبيحة عن خطايا الشعب، لكن الله جعل لكلماته معنى غير الذي قصده وهو أن موت المسيح فداءٌ للعالم. وكذلك تنبأ بلعام على غير إرادته وقصده (عدد ٢٣).
٥١ «وَلَمْ يَقُل هَذَا مِنْ نَفْسِهِ، بَل إِذْ كَانَ رَئِيساً لِلكَهَنَةِ فِي تِلكَ السَّنَةِ، تَنَبَّأَ أَنَّ يَسُوعَ مُزْمِعٌ أَنْ يَمُوتَ عَنِ الأُمَّةِ».
وَلَمْ يَقُل هَذَا مِنْ نَفْسِهِ أي أنه لم يقصد النبوة بنتائج موت يسوع العظيمة، إنما قصد قتله لحفظ سلطة الكهنة ورؤساء الشعب. ولكن الله جعل كلامه كنبوة بتلك النتائج، واستخدمه كما استخدم بلعام قديماً.
رَئِيساً لِلكَهَنَةِ قال يوسيفوس المؤرخ إن مدة رئاسته كانت ١١ سنة، وهي كل مدة تولي بيلاطس.
فِي تِلكَ السَّنَةِ أي سنة موت المسيح.
تَنَبَّأَ لم يكن قيافا نبياً حقيقياً، ولم يلهمه الله أن يتنبأ حينئذ، وهو نفسه لم يعرف أن ما قاله نبوة. ولكن سماه البشير نبوة لأنه تم بقصد الله وتعيينه.
أَنَّ يَسُوعَ مُزْمِعٌ أَنْ يَمُوتَ عَنِ الأُمَّةِ لم يتم ذلك بحسب فكر قيافا، لأن فكره كان أن موت يسوع يكون واسطة لبقاء سلطة رؤساء الأمة، وبقاء الهيكل والمدينة. أما موت يسوع فكان سبب عكس ذلك، فإنه هيج غضب الله على تلك الأمة، فأرسل عليها الرومان ليهدموا مدينتها وهيكلها ويشتتها بين شعوب الأرض. أما الله فقصد أن يكون ذلك الموت واسطة لخلاص نفوس الأمة، وكان كذلك لبعضهم وللجميع لو تابوا وآمنوا به.
٥٢ «وَلَيْسَ عَنِ الأُمَّةِ فَقَطْ، بَل لِيَجْمَعَ أَبْنَاءَ اللَّهِ المُتَفَرِّقِينَ إِلَى وَاحِدٍ».
إشعياء ٤٩: ٦ و١يوحنا ٢: ٢ ويوحنا ١٠: ١٦ وأفسس ٢: ١٤ - ١٧
لَيْسَ عَنِ الأُمَّةِ فَقَطْ رأى أن موت يسوع يكون نفعاً زمنياً فقط وإنما لله قصد أن يكون ذلك الموت واسطة الحياة الأبدية للعالم كله، إن آمن به (يوحنا ٣: ١٦ ورومية ٥: ٦ - ٨).
لِيَجْمَعَ أَبْنَاءَ اللَّهِ الخ قصد «بأبناء الله» هنا المؤمنين به من اليهود والأمم (يوحنا ١٠: ١٦). وبيّن أن الإيمان بيسوع مصلوباً والخضوع له ملكاً يضمان كل شعبه إلى ملكوت واحد روحي (متّى ٨: ١١ ويوحنا ١٠: ١٦ و١٧: ٢٠ و٢١ وأفسس ٢: ١٦ - ١٨ وكولوسي ٣: ١١ ورؤيا ٥: ٩).
٥٣ «فَمِنْ ذَلِكَ اليَوْمِ تَشَاوَرُوا لِيَقْتُلُوهُ».
نفهم من هذا أن أكثر أعضاء المجلس وافق قيافا، وحكم بوجوب قتل يسوع. ومن ثمَّ بذل الفريسيون والصدوقيون معاً غاية الجهد في إجراء ذلك. ونرى نتيجة ذلك في متّى ٢٢: ١٥، ١٦، ٢٣ و٢٦: ٥ و٢٧: ١، ٢.
٥٤ «فَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ أَيْضاً يَمْشِي بَيْنَ اليَهُودِ علانِيَةً، بَل مَضَى مِنْ هُنَاكَ إِلَى الكُورَةِ القَرِيبَةِ مِنَ البَرِّيَّةِ، إِلَى مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا أَفْرَايِمُ، وَمَكَثَ هُنَاكَ مَعَ تلامِيذِهِ».
يوحنا ٤: ١، ٣ و٧: ١ و٢أيام ١٣: ١٩
لَمْ يَكُنْ يَسُوعُ أَيْضاً يَمْشِي بَيْنَ اليَهُودِ أعلن أعضاء المجلس قصدهم( ع ٥٧) ولم يرد يسوع أن يسمح لليهود بالقبض عليه قبل أن تأتي ساعته في الفصح الآتي، وكان قد اقترب.
علانِيَةً في أورشليم أو غيرها من مدن اليهودية.
الكُورَةِ القَرِيبَةِ مِنَ البَرِّيَّةِ تلك البرية غرب نهر الأردن وبحر لوط، وشرق أورشليم.
أَفْرَايِمُ موقع هذه المدينة مجهول اليوم، وظن أكثر المفسرين أنها التي سُميت عفرة (يشوع ١٨: ٢٣ و١صموئيل ١٣: ١٧ و٢أيام ١٣: ١٩) وتقع على بُعد عشرين ميلاً شمال شرق أورشليم. ولا نعرف كم بقي هناك، والمرجح أنه بقي قليلاً. ونعرف من بشارة لوقا أنه سار في القافلة التي أتت إلى أورشليم في عيد الفصح على طريق أريحا.
٥٥ «وَكَانَ فِصْحُ اليَهُودِ قَرِيباً. فَصَعِدَ كَثِيرُونَ مِنَ الكُوَرِ إِلَى أُورُشَلِيمَ قَبْلَ الفِصْحِ لِيُطَهِّرُوا أَنْفُسَهُم».
يوحنا ٢: ١٣ و٥: ١ و٦: ٤ عدد ٩: ١٠ و٢أيام ٣٠: ١٧ وأعمال ٢١: ٢٤
وَكَانَ فِصْحُ اليَهُودِ قَرِيباً (انظر شرح متّى ٢٦: ٢ ويوحنا ٢: ١٣ و٦: ٤). والمرجح أن هذا الفصح هو الفصح الرابع في مدة خدمة يسوع.
مِنَ الكُوَرِ كل أرض اليهود ما عدا أورشليم.
قَبْلَ الفِصْحِ لِيُطَهِّرُوا أَنْفُسَهُمْ لم يفرض في الشريعة الموسوية على جميع اليهود أن يأتوا إلى أورشليم قبل العيد للتطهير. لكن كثيرين منهم استحسنوا أن يأتوها مبكرين لزيادة التطهير وتقديم الذبائح المعينة، ولا سيما الذين تدنسوا بلمس ميت أو قبر أو غير ذلك من المدنسات. وكان وقت التطهير يوماً فأكثر إلى ستة أيام (تكوين ٣٥: ٢ وخروج ١٩: ١٠، ١١ ولاويين ٢٢: ١ - ٦ وعدد ٩: ١٠ و٢أيام ٣٠: ١٧، ١٨ وأعمال ٢١: ٢٤، ٢٦ و٢٤: ١٨).
٥٦ «فَكَانُوا يَطْلُبُونَ يَسُوعَ وَيَقُولُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَهُمْ وَاقِفُونَ فِي الهَيْكَلِ: مَاذَا تَظُنُّونَ؟ هَل هُوَ لا يَأْتِي إِلَى العِيدِ؟».
يوحنا ٧: ١١
المذكورون هنا ليسوا أعداء يسوع إنما هم من عامة الشعب، سمعوا خبره أو رأوه في الأعياد الماضية، ورغبوا في أن يشاهدوه ويسمعوه. وكانوا في شك من حضوره للعيد وفقاً للشريعة بسبب تهديدات الرؤساء. والكلام هنا يدل على أن الناس كانوا يفتشون دائماً عن يسوع ويتحدثون بأمره على توالي الأيام.
٥٧ «وَكَانَ أَيْضاً رُؤَسَاءُ الكَهَنَةِ وَالفَرِّيسِيُّونَ قَدْ أَصْدَرُوا أَمْراً أَنَّهُ إِنْ عَرَفَ أَحَدٌ أَيْنَ هُوَ فَليَدُلَّ عَلَيْهِ، لِكَيْ يُمْسِكُوهُ».
ذُكر هذا بياناً لسبب شكهم في مجيء يسوع إلى العيد. ولولا الخطر كان لا بد من مجيئه طوعاً لأمر الشريعة بحضور كل الذكور للعيد. وأمر الرؤساء هنا مبنيٌ على ما حكموا به في ع ٥٣.
الأصحاح الثاني عشر
العشاء في بيت عنيا ودهن مريم ليسوع (ع ١ - ١١)
١ «ثُمَّ قَبْلَ الفِصْحِ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ أَتَى يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا، حَيْثُ كَانَ لِعَازَرُ المَيْتُ الَّذِي أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَاتِ».
يوحنا ١١: ١، ٤٣
نعلم من أقوال البشائر الباقية أن يسوع التقى بالقافلة الآتية من بيرية إلى أورشليم لحضور العيد وسار معها إلى أريحا أولاً، وهنالك فتح عيون أعميين، وجدد قلب زكا، وتكلم بمثل «الشريف وعشرة الأمناء» (متّى ١٩: ١٧، ٢٩ ومزمور ١٠: ٣٢، ٤٦ ولوقا ١٨: ٣١، ٣٥ و١٩: ١).
سبق في شرح متّى ٢١: ١ جدول حوادث آخر أسبوع من حياة يسوع على الأرض.
قَبْلَ الفِصْحِ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ أي مساء يوم الخميس الثامن من أبريل (نيسان) وهو أول اليوم التاسع منه.
بَيْتِ عَنْيَا انظر شرح متّى ٢٦: ٦. ولعل يسوع قضى فيها مع تلاميذه كل يوم السبت.
٢ «فَصَنَعُوا لَهُ هُنَاكَ عَشَاءً. وَكَانَتْ مَرْثَا تَخْدِمُ وَأَمَّا لِعَازَرُ فَكَانَ أَحَدَ المُتَّكِئِينَ مَعَهُ».
متّى ٢٦: ٦ ومرقس ١٤: ٣
فَصَنَعُوا لَهُ هُنَاكَ عَشَاءً إكراماً له وإظهاراً لسرورهم بزيارته. وذكر متّى ومرقس أن ذلك العشاء كان في بيت سمعان الأبرص.
وَكَانَتْ مَرْثَا تَخْدِمُ كما فعلت منذ ستة أشهر حين تعشى يسوع في بيت عنيا (لوقا ١٠: ٣٨ - ٤٢).
وَأَمَّا لِعَازَرُ فَكَانَ أَحَدَ المُتَّكِئِينَ مَعَهُ ذكر البشير اتكاء لعازر مع يسوع تأكيداً لصحة قيامته وبياناً لبعض الدواعي التي حملت مريم على أن تدهن يسوع، وهو شكرها له على إقامة أخيها وإكرامها له.
٣ «فَأَخَذَتْ مَرْيَمُ مَناً مِنْ طِيبِ نَارِدِينٍ خَالِصٍ كَثِيرِ الثَّمَنِ، وَدَهَنَتْ قَدَمَيْ يَسُوعَ، وَمَسَحَتْ قَدَمَيْهِ بِشَعْرِهَا، فَامْتلأ البَيْتُ مِنْ رَائِحَةِ الطِّيبِ».
١ملوك ١٠: ١٧ وعزرا ٢: ٦٩ ونحميا ٧: ٧١، ٧٣ وحزقيال ٤٥: ١٢ لوقا ١٠: ٣٨، ٣٩ ويوحنا ١١: ٢
فَأَخَذَتْ مَرْيَمُ هي التي اقتصر متّى ومرقس على أنها امرأة. ولعل سبب ذلك خوفهما عليها من اليهود.
مَناً هو في اليونانية لتراً، وهو وزن يوناني وروماني يعادل نحو مئة درهم. وذكر متّى ومرقس قارورة بدل من «مناً».
نَارِدِين هو من الأطياب الثمينة التي تنافس بها القدماء (نشيد الأناشيد ١: ١٢ و٤: ١٣، ١٤).
وَدَهَنَتْ قَدَمَيْ يَسُوعَ قال متّى ومرقس إنها دهنت رأسه، وكان ذلك الغالب في الدهن بالطيب (مزمور ٢٣: ٥ ولوقا ٧: ٤٦). ونستفيد من رواية يوحنا أنها زادت على ما ذكراه أنها دهنت قدميه أيضاً، فأظهرت تواضعها كما أظهرت سخاءها ووفرة شكرها بوفرة الطيب الذي دهنته به.
فَامْتلأ البَيْتُ مِنْ رَائِحَةِ الطِّيبِ ذكر ذلك بياناً لحسن الطيب ووفرته.
٤، ٥ «٤ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ تلامِيذِهِ، وَهُوَ يَهُوذَا سِمْعَانُ الإِسْخَرْيُوطِيُّ، المُزْمِعُ أَنْ يُسَلِّمَهُ. ٥ لِمَاذَا لَمْ يُبَعْ هَذَا الطِّيبُ بِثلاثَمِئَةِ دِينَارٍ وَيُعْطَ لِلفُقَرَاءِ؟».
وَهُوَ يَهُوذَا سِمْعَانُ الإِسْخَرْيُوطِيُّ انظر شرح متّى ١٠: ٤. ذكر متّى ومرقس تذمر التلاميذ (متّى ٢٦: ٨ ومرقس ١٤: ٤) ولم يذكر أيّهم بدأ وهيّج الباقين. أما يوحنا فذكره وذكر أيضاً أن ذلك ما يتوقع من محب المال مثله.
ثلاثَمِئَةِ دِينَارٍ كان الدينار يومئذ أجرة الفاعل في اليوم (متّى ٢٠: ١٠) فتكون قيمة ذلك الطيب ما يعدل أجرة الفاعل في كل أيام العمل من السنة.
٦ «قَالَ هَذَا لَيْسَ لأنَّهُ كَانَ يُبَالِي بِالفُقَرَاءِ، بَل لأنَّهُ كَانَ سَارِقاً، وَكَانَ الصُّنْدُوقُ عِنْدَهُ، وَكَانَ يَحْمِلُ مَا يُلقَى فِيهِ».
هذا كلام يوحنا بعد اختباره أحوال يهوذا الإسخريوطي. والظاهر مما ذُكر هنا وفي يوحنا ١٣: ٢٩ أن يهوذا كان قد عُيّن أميناً للصندوق ليحفظ المال الزهيد الذي ليسوع وتلاميذه مما أكرمهم الناس به (لوقا ٨: ٣) وأنه كان خائناً. والأرجح أن التلاميذ لم يعرفوا خيانته إلا بعد ذلك، وإلا ما أبقوه في تلك الوظيفة. وأظهر يومئذ غيرته للفقراء رياءً، تغطية لما شعر به من الغيظ على أن يده لم تصل إلى ثمن ذلك الطيب ليختلس منه.
٧، ٨ «٧ فَقَالَ يَسُوعُ: اتْرُكُوهَا. إِنَّهَا لِيَوْمِ تَكْفِينِي قَدْ حَفِظَتْهُ. ٨ لأنَّ الفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ، وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ».
متّى ٢٦: ١١ ومرقس ١٤: ٧
انظر شرح متّى ٢٦: ١١، ١٢.
إِنَّهَا لِيَوْمِ تَكْفِينِي قَدْ حَفِظَتْهُ أي لتحنيطي ميتاً، وذلك بحسب احترام يسوع لعملها. أما هي ففعلت ذلك إكراماً له حياً. فلا شك أن كلامه حينئذ عن التكفين كان بالنسبة إليها وإلى التلاميذ وسائر الحاضرين لغزاً. ومخاطبة يسوع للجميع بقوله «اتركوها» يدل على أن التذمر كان من الكل، لا من يهوذا وحده.
وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ في الجسد، لأنه في الروح معنا في كل حين. فعلى الذين يقولون إن المسيح حاضر بناسوته ولاهوته في العشاء الرباني أن يوفِّقوا بين قولهم هذا وقوله: «أما أنا فلست معكم في كل حين». نعم إنّ الخبز والخمر في ذلك العشاء معنا في كل حين، ولكن ناسوت المسيح ليس كذلك.
٩ «فَعَلِمَ جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنَ اليَهُودِ أَنَّهُ هُنَاكَ، فَجَاءُوا لَيْسَ لأجْلِ يَسُوعَ فَقَطْ، بَل لِيَنْظُرُوا أَيْضاً لِعَازَرَ الَّذِي أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَات».
يوحنا ١١: ٤٣، ٤٤
فَعَلِمَ جَمْعٌ كَثِيرٌ أتى مع ألوف من الذين قدموا من أريحا إلى أورشليم ليحضروا العيد، وانفصل عنهم إلى بيت عنيا، وهؤلاء أخبروا الذين كانوا يطلبونه ويرغبون في مشاهدته عن مجيئه (يوحنا ١١: ٥٥).
مِنَ اليَهُودِ أشار يوحنا «باليهود» هنا وفي ع ١١ إلى أمة اليهود عامة، لا إلى أعداء يسوع خاصة.
فَجَاءُوا سهُل ذلك عليهم لقصر المسافة، لأنها كانت أقل من سفر ساعة. فازدحمت لأن بعضهم رغب في مشاهدة إنسان عاش بعد أن مكث أربعة أيام في القبر.
١٠ «فَتَشَاوَرَ رُؤَسَاءُ الكَهَنَةِ لِيَقْتُلُوا لِعَازَرَ أَيْضاً».
لوقا ٢٦: ٣١
رُؤَسَاءُ الكَهَنَةِ أكثر هؤلاء الرؤساء صدوقيون (أعمال ٥: ١٧) اتفقوا مع الفريسيين على يسوع (يوحنا ١١: ٤٧).
لِيَقْتُلُوا لِعَازَرَ هذا يدل على عظمة شرهم، فإنهم طلبوا قتل إنسان بريء للتخلص من شهادته بصحة دعوى يسوع أنه المسيح، لأنه ما دام لعازر حياً يتبين فساد تعليمهم في إنكار القيامة (أعمال ٢٣: ٨).
١١ «لأنَّ كَثِيرِينَ مِنَ اليَهُودِ كَانُوا بِسَبَبِهِ يَذْهَبُونَ وَيُؤْمِنُونَ بِيَسُوعَ».
يوحنا ١١: ٤٥ وع ١٨
يَذْهَبُون أي يعدلون عن الخضوع لرؤساء الكهنة كما كانوا يفعلون سابقاً، ولا يحترمون تعاليم الكتبة والفريسيين كما اعتادوا.
وَيُؤْمِنُونَ بِيَسُوعَ أنه هو المسيح. ونعتقد أن إيمانهم كان مجرد اقتناع عقلي، وأنه كان وقتياً، زال يوم قُبض على يسوع وحُكم عليه بالموت، وهو لم يفعل شيئاً بغية إنقاذ نفسه.
دخول يسوع باحتفال إلى أورشليم (ع ١٢ - ١٩)
١٢ «وَفِي الغَدِ سَمِعَ الجَمْعُ الكَثِيرُ الَّذِي جَاءَ إِلَى العِيدِ أَنَّ يَسُوعَ آتٍ إِلَى أُورُشَلِيمَ».
سبق الكلام على هذا الاحتفال في شرح (متّى ٢١: ١ - ١١ ومرقس ١١: ١ - ١١). فعل يسوع في ذلك اليوم غير كل ما فعله في كل أوقاته السابقة، فقد كان يأبى قبول إكرام الناس أو تنصيبه ملكاً (متّى ١٢: ١٩). ولكن لما أتت ساعة موته كفارة عن خطايا الشعب أراد أن يجذب إليه الجميع ليسألوه عن غاية موته، ثم يؤمنوا به مصلوباً.
فِي الغَدِ أي غد وصوله (ع ١) أي يوم الأحد.
الجَمْعُ الكَثِيرُ الَّذِي جَاءَ إِلَى العِيدِ من الجليل وبيرية حيث رأى يسوع وعرفه.
أَنَّ يَسُوعَ آتٍ سمع ذلك من اليهود الذين أتوا من بيت عنيا لينظروا يسوع ولعازر (ع ١٩) ومن القافلة التي صحبها من أريحا.
١٣ «فَأَخَذُوا سُعُوفَ النَّخْلِ وَخَرَجُوا لِلِقَائِهِ، وَكَانُوا يَصْرُخُونَ: أُوصَنَّا! مُبَارَكٌ الآتِي بِاسْمِ الرَّبِّ، مَلِكُ إِسْرَائِيلَ!».
متّى ٢١: ٨ ومرقس ١١: ٨ ولوقا ١٩: ٣٥ الخ مزمور ١١٨: ٢٥، ٢٦ ومتّى ٢١: ٩
فَأَخَذُوا سُعُوفَ النَّخْلِ إكراماً له باعتبار أنه نبي، وإشارة إلى سرورهم. وفوق هذا أن بعضهم خلعوا أثوابهم قدامه في الطريق (متّى ٢١: ١٨).
أُوصَنَّا! مُبَارَكٌ الآتِي الخ هذا مقتبس من مزمور ١١٨: ٢٥، ٢٦ واعتبر اليهود أن هذا المزمور يشير إلى المسيح، وكانوا يرتلونه جموعاً في عيدي المظال والفصح. ولا شك أن ترانيم المحتفلين كانت متنوعة. فلا عجب أن اختلفت شهادة البشيرين لفظاً، ولكن المعنى واحد. ولا يُستنتج أن كل ذلك الجمع اعتقد أن يسوع هو المسيح اعتقاداً حقيقياً كما تدل عليه كلمات الترنيمة الاحتفالية، ولكن لا شك أن بعضهم اعتقد ذلك، وأن البعض لم يحسبه سوى نبي يستحق الإكرام.
١٤ «وَوَجَدَ يَسُوعُ جَحْشاً فَجَلَسَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ».
متّى ٢١: ٧ زكريا ٩: ٩
لم يذكر يوحنا هذه الحادثة إلا لأنها إتمام نبوة، وذكرها بالإجمال، بينما ذكرها سائر البشيرين بالتفصيل.
وَجَدَ يَسُوعُ جَحْشاً لم يكن ذلك على سبيل الاتفاق لأنه أرسل سابقاً تلميذين ليُحضروه له (متّى ٢١: ٧).
١٥ «لا تَخَافِي يَا ابْنَةَ صِهْيَوْنَ. هُوَذَا مَلِكُكِ يَأْتِي جَالِساً عَلَى جَحْشِ أَتَانٍ».
انظر شرح متّى ٢٤: ٥. وهذه نبوة في زكريا ٩: ٩ نطق بها النبي قبل ذلك بنحو ٥٠٠ سنة. ولم يذكر يوحنا من كلام هذه البنوة ما ذكره متّى، لأنه اهتم بنقل المعنى أكثر من اهتمامه بنقل اللفظ.
١٦ «وَهَذِهِ الأُمُورُ لَمْ يَفْهَمْهَا تلامِيذُهُ أَوَّلاً، وَلَكِنْ لَمَّا تَمَجَّدَ يَسُوعُ حِينَئِذٍ تَذَكَّرُوا أَنَّ هَذِهِ كَانَتْ مَكْتُوبَةً عَنْهُ، وَأَنَّهُمْ صَنَعُوا هَذِهِ لَهُ».
لوقا ١٨: ٣٤ ويوحنا ٧: ٣٩ و١٧: ٥ ويوحنا ١٤: ٢٦
لَمْ يَفْهَمْهَا تلامِيذُهُ أَوَّلاً أي في وقت الاحتفال. والذي لم يفهموه هو أن دخول يسوع على ذلك المنوال كان إتماماً للنبوة، وأن ما قاله زكريا في المسيح وملكوته لم يدل على ما ظنوه من أنه ملك أرضي يملك مملكة زمنية، لكن كان هو روحياً وملكوته كذلك. فاعترف يوحنا بجهله وقتئذ معنى النبي.
لَمَّا تَمَجَّدَ يَسُوعُ أي قام من الموت وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب (انظر شرح يوحنا ٧: ٣٩).
تَذَكَّرُوا حل الروح القدس على التلاميذ ففهموا معنى النبوات المتعلقة بيسوع التي لم يفهموها قبلاً، وتذكروا ما كان يظهر لهم غير ذي شأن، فعلموا أنه إتمام نبوات مهمة.
١٧ «وَكَانَ الجَمْعُ الَّذِي مَعَهُ يَشْهَدُ أَنَّهُ دَعَا لِعَازَرَ مِنَ القَبْرِ وَأَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَاتِ».
متّى ٢١: ١٠ و١١ ولوقا ١٩: ٣٧، ٣٨
الجَمْعُ الَّذِي مَعَهُ أي يهود أورشليم الذين ذهبوا إلى بيت عنيا وشاهدوا إقامة لعازر (يوحنا ١١: ٣١، ٤٥) وربما كان منهم بعض أهل بيت عنيا الذين شاهدوا تلك الإقامة.
يَشْهَدُ بصحة المعجزة وبأن الذي صنعها هو يسوع الذي كان بينهم.
١٨ «لِهَذَا أَيْضاً لاقَاهُ الجَمْعُ، لأنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّهُ كَانَ قَدْ صَنَعَ هَذِهِ الآيَةَ».
ع ١١
لِهَذَا أي لشهادة أولئك الشهود التي شاعت بين الناس، ولِما ذُكر في آخر هذا العدد.
لاقَاهُ الجَمْعُ أي الناس الكثيرون الذين أتوا إلى أورشليم لحضور العيد وخرجوا لمشاهدة يسوع والترحيب به.
١٩ «فَقَالَ الفَرِّيسِيُّونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا! إِنَّكُمْ لا تَنْفَعُونَ شَيْئاً! هُوَذَا العَالَمُ قَدْ ذَهَبَ وَرَاءهُ!».
يوحنا ١١: ٤٧، ٤٨
هذا كلام المغتاظين المتحيرين الآسفين على أن العاقبة كانت غير ما قصدوا وتوقعوا، فكانوا مثل هامان إذ شاهد مردخاي مكرَّماً بعد بغضه إياه وسعيه في قتله (أستير ٦: ١١).
انْظُرُوا! إِنَّكُمْ لا تَنْفَعُونَ شَيْئاً لم ينجح تكليفهم للعسكر أن يقبضوا عليه (يوحنا ٧: ٣٢ ،٤٥ و٤٦) وكذلك حكمهم بقتله (يوحنا ١١: ٥٣) وإصدار أمرهم بأن كل من يعرف أين هو يدل عليه ليقبضوا عليه (يوحنا ١١: ٥٧). ومع ذلك كله أكرمه الشعب أحسن إكرام. وزاد خوفهم من هياج الشعب إذا شرعوا في القبض عليه.
هُوَذَا العَالَمُ قَدْ ذَهَبَ وَرَاءهُ في هذه الكلام مبالغة اعتاد المغتاظون أن يقولوها، لكن فيه إشارة إلى انتباه عظيم في المدينة، وأن جموعاً كثيرة احتفلوا به. وخاف الفريسيون أن يبتعد الجمهور عنهم بسبب ذلك وعدم رجوعهم إليهم.
طلب اليونانيين مشاهدة يسوع وكلامه المبني على ذلك (ع ٢٠ - ٣٦)
٢٠ «وَكَانَ أُنَاسٌ يُونَانِيُّونَ مِنَ الَّذِينَ صَعِدُوا لِيَسْجُدُوا فِي العِيدِ».
أعمال ١٧: ٤ ١ملوك ٨: ٤١، ٤٢ وأعمال ٨: ٢٧
يُونَانِيُّونَ جاءت هذه الكلمة في الإنجيل بثلاثة معانٍ: (١) اليهود الذين سكنوا في غير اليهودية وتكلموا باليونانية (أعمال ٦: ١ و٩: ٢٩). (٢) الوثنيون من اليونان الذين تهودوا وسُموا دخلاء (متّى ٢٣: ١٥). (٣) كل الوثنيين الذين يتكلم أكثرهم باليونانية (يوحنا ٧: ٣٥ وأعمال ١١: ٢٠ ورومية ١: ١٦ و٢: ٩ ،١٠ و٣: ٩). وكان بعض الوثنيين الذين يعبدون آلهة كثيرة يكرمون إله اليهود «يهوه» ويرسلون هدايا إلى هيكله ويأتون إلى أورشليم ليعبدوه كأحد الآلهة. ولذلك عُينت إحدى دور الهيكل لاجتماعهم منذ عهد سليمان وسُميت «دار الأمم» (١ملوك ٨: ٤١ - ٤٣ انظر شرح متّى ٢١: ١٢). والمرجح أن اليونانيين المذكورين هنا هم المتهودون من الوثنيين، كالوزير الحبشي (أعمال ٨: ٢٧) و «اليونانيين المتعبدين» (أعمال ١٧: ٤) وإلا لم يأتوا ليسجدوا في العيد.
ومما يستحق الذكر هنا أنه كما أتى بعض الأمم الكلدانيين من الشرق ليسجدوا ليسوع وقت ميلاده، جاء بعض الأمم اليونانيين من الغرب ليكرموه وهو على وشك أن يموت على الصليب.
٢١ «فَتَقَدَّمَ هَؤُلاءِ إِلَى فِيلُبُّسَ الَّذِي مِنْ بَيْتِ صَيْدَا الجَلِيلِ، وَسَأَلُوهُ: يَا سَيِّدُ، نُرِيدُ أَنْ نَرَى يَسُوعَ».
يوحنا ١: ٤٤
فَتَقَدَّمَ هَؤُلاءِ إِلَى فِيلُبُّسَ انظر شرح متّى ١٠: ٣. ولا نعرف سبب تقدمهم إلى فيلبس دون غيره من التلاميذ، ولعله كان حينئذ في دار الأمم، ويسوع وسائر التلاميذ في دار أخرى لا يجوز للأمم أن يدخلوها، فأتى اليونانيون إلى هناك ووجدوا فيلبس وسألوه.
مِنْ بَيْتِ صَيْدَا انظر شرح متّى ١١: ٢١.
لم يذكر البشير وقت ذلك السؤال ولا مكانه. ومن المعلوم أن يسوع أمضى الثلاثة الأيام الأولى من الأسبوع الأخير من حياته على الأرض يعلّم الشعب في الهيكل. والأرجح مما قيل في ع ٣٦ أنه كان مساء يوم الثلاثاء، آخر تلك الأيام الثلاثة. ولعل يسوع كان حيئنذٍ في دار الهيكل التي لا يجوز أن يدخلوها. ولم يذكر هذه الحادثة أحد من البشيرين سوى يوحنا. والدلائل واضحة على أنه ذكرها ليصل إلى ذكر الخطاب الذي بُني عليها. ولم يذكر يوحنا من كل الحوادث التي جرت منذ مجيء المسيح إلى أورشليم بالاحتفال يوم الأحد إلى أكله الفصح ليلة الجمعة سوى هذه الحادثة. ومما تركه من الحوادث: تطهير الهيكل وتيبيس التينة وضربه خمسة أمثال (هي مثل الابنين، ومثل رب الكرم، ومثل عرس ابن الملك، ومثل العشر العذارى، ومثل الوزنات) وإسكاته الفريسيين والصدوقيين الذين جربوه بالأسئلة، ونبوته بخراب أورشليم وبيوم الدين.
نُرِيدُ أَنْ نَرَى يَسُوعَ على انفراد لتكون لنا فرصة للحديث معه، وسماع تعليمه، ومعرفة حقيقة ملكوته. والأرجح أنهم شاهدوا دخوله بالاحتفال إلى أورشليم، وسمعوا ما قاله أعداؤه وأصدقاؤه، فمالوا كثيراً لأن يسمعوا منه عن أمره. ونحن نمدحهم، فكثيراً ما يكون مثل موقفهم وسيلة إلى خلاص الراغبين، كما كان من أمر زكا العشار (لوقا ١٩: ١ - ٩).
٢٢ «فَأَتَى فِيلُبُّسُ وَقَالَ لأنْدَرَاوُسَ، ثُمَّ قَالَ أَنْدَرَاوُسُ وَفِيلُبُّسُ لِيَسُوعَ».
لأنْدَرَاوُسَ انظر شرح متّى ١٠: ٢، وكان أندراوس من مدينة فيلبس (يوحنا ١: ٤٤) ولعل علة مجيئه إلى أندراوس أولاً ليشاوره شكه في رضى يسوع أن يواجه اليونانيين، لأن ربانيي اليهود كانوا يستنكفون تعليم الأمم الدين اليهودي، ولأن يسوع قال إنه لم يُرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة (متّى ١٥: ٢٤). وكانت نتيجة مشاورتهما اتفاقهما على إفادة يسوع بطلب أولئك الناس.
قَالَ.. لِيَسُوعَ لم يقل البشير هل قابل المسيح اليونانيين أو لا؟ والأرجح أنه قابلهم بسبب لطفه ورغبته في قبول جميع الذين يطلبونه.
٢٣ «وَأَمَّا يَسُوعُ فَأَجَابَهُمَا: قَدْ أَتَتِ السَّاعَةُ لِيَتَمَجَّدَ ابْنُ الإِنْسَانِ».
يوحنا ١٣: ٣٢ و١٧: ١
وَأَمَّا يَسُوعُ فَأَجَابَهُمَا وجه يسوع كلامه أولاً إلى التلميذين. والأرجح أن ذلك كان على مسمع من سائر التلاميذ واليونانيين أيضاً. ولعل جوابه كان لِما علمه من أفكارهم التي تيقظت بمناسبة دخوله أورشليم بالمجد والإكرام من الجميع، ومن إتيان هؤلاء اليونانيين ليطلبوه. واستنتجوا من ذلك أن يسوع على وشك أن يقيم ملكوتاً أرضياً مجيداً. أما هو فاتخذ تلك الفرصة لإصلاح أغلاطهم، وتذكيرهم بما قاله لهم مراراً من أنباء موته. وقد اتخذ مجيء أولئك الناس الأمميين إليه إمارة على قرب موته الذي هو سبب خلاص الأمم، وتمهيد السبيل إلى مجيئهم إليه.
قَدْ أَتَتِ السَّاعَةُ لتمجيدي، لكن بغير الطريق التي تظنونها. نعم إني عازم على الصعود إلى السماء والجلوس على يمين الآب في المجد، ولكن موتي استعداد لذلك. فأتت تلك الساعة التي عينها الله بقضائه. وعلامة إتيانها مجيء اليونانيين الأمم كما أعلنت النبوات، فإن الأمم هم الخراف الأخرى التي لأجل جمعها قبل الراعي أن يبذل حياته (يوحنا ١٠: ١٦ - ١٩). واليونانيون باكورة الحصاد العظيم لنفوس الأمم الذين يأتون إلى المسيح طلباً للخلاص.
لِيَتَمَجَّدَ ابْنُ الإِنْسَانِ يتمجد برجوعه إلى مجده الأول في السماء، ثم بامتداد ملكوته بين جميع قبائل الأرض، وقبولهم خلاصه (مزمور ٢: ٨ وإشعياء ٥٣: ١١). والتواضع هو وسيلة ذلك التمجيد، أولاً بالموت على الصليب والنزول إلى القبر، لا بجلوسه على كرسي داود الأرضي كما ظنوا. فأصابوا برأيهم أن يسوع يتمجد، وأخطأوا في كيفية ذلك (انظر شرح يوحنا ٧: ٣٩).
٢٤ «ٱلحَقَّ الحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَقَعْ حَبَّةُ الحِنْطَةِ فِي الأَرْضِ وَتَمُتْ فَهِيَ تَبْقَى وَحْدَهَا. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَتْ تَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيرٍ».
١كورنثوس ١٥: ٣٦
ٱلحَقَّ الحَقَّ هذا تمهيد وتنبيه لكلام ذي شأن كما ذُكر مراراً.
لَكُمْ التفت من مخاطبة التلميذين إلى مخاطبة الجميع من التلاميذ واليونانيين وغيرهم.
إِنْ لَمْ تَقَعْ حَبَّةُ الحِنْطَةِ فِي الأَرْضِ أي تُزرع في التربة وتُدفن لتأخذ منها الرطوبة الضرورية للنمو.
وَتَمُتْ عن صورتها وصفاتها الأصلية. ويُعبَّر بالموت عن التغيير العظيم الذي يحدث في الحبوب عندما تتحول من بزور إلى نبات.
تَبْقَى وَحْدَهَا أشار بذلك إلى أمر معلوم، وهو أن الحبة إن لم تُزرع بل حُفظت فوق الأرض حيث لا تصيبها رطوبة تبقى سالمة صحيحة، ولكن بلا منفعة ولا زيادة. أما إن زُرعت في الأرض ودُفنت في التربة ماتت من جهة صورتها الأولى وصفاتها الأصلية، وتنشأ حياة جديدة من موتها، تظهر في النبات ثم في السنبل ثم في القمح.
وَلَكِنْ إِنْ مَاتَتْ تَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيرٍ اتخذ المسيح مبدأ من عالم النبات إيضاحاً لمبدإ من عالم الروح، وهو أن الموت استعدادٌ لحياة أسمى من الأولى وأنفع منها. وقصد المسيح من ذلك أن موته وسيلة إلى حياة العالم. وكان التلاميذ يحزنون كلما أنبأهم بموته، ولم يريدوا التسليم بأن ذلك ممكن. أما هو فأكد لهم أنه إن لم يحدث ذلك بقي هو كحبة الحنطة غير المزروعة. وإن مات كقمحة مزروعة تعطي حصاد نفوس مفديَّة لا تُحصى. ويكون موت المسيح سبب تمجيده بخلاص شعبه المذكور هنا، وبإثابة الله إياه على موته كما وعده (أفسس ١: ٢٠ - ٢٣ وفيلبي ٢: ٨ ، ٩ وعبرانيين ٢: ٩ و١٢: ٢).
وتؤكد لنا هذه الآية أن موته كفارة عن الخطايا ينفع العالم، أكثر من سيرته الطاهرة ومعجزاته الباهرة وتعاليمه الصحيحة.
٢٥ «مَنْ يُحِبُّ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُبْغِضُ نَفْسَهُ فِي هَذَا العَالَمِ يَحْفَظُهَا إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ».
متّى ١٠: ٣٩ و١٦: ٢٥ ومرقس ٨: ٣٥ ولوقا ٩: ٢٤ و١٧: ٣٣
جاءت هذه الآية في متّى ١٠: ٣٩ فانظر شرحها هناك و١٦: ٢٥ ومرقس ٨: ٣٥ ولوقا ٩: ٢٤ و١٧: ٣٣.
نَفْسَهُ أي حياته، لأنه لما خلق الله الإنسان «وَنَفَخَ فِي أَنْفِهِ نَسَمَةَ حَيَاةٍ. فَصَارَ آدَمُ نَفْساً حَيَّةً» (تكوين ٢: ٧).
ما قاله يسوع في هذه الآية قاله أولاً لنفع تلاميذه السامعين، فإنهم توقعوا الخير الأعظم من الإثابة الزمنية والشرف والغنى الأرضيين في المملكة الدنيوية التي انتظروا كسائر اليهود أن المسيح ينشئها هنا. وقاله لنفع كل المسيحيين في كل عصر، ليعلّمهم أن الغاية العظمى هي نوال الحياة الأبدية، وأنه يجب عليهم أن يستعدوا لخسران كل شيء لأجلها، حتى حياتهم الجسدية إذا اقتضى الأمر، متمثّلين بسيدهم الإلهي الذي بذل حياته ليعد لهم حياة الأبد.
يُبْغِضُ نَفْسَهُ أي لا يعتبر حياته الجسدية شيئاً بالنسبة إلى فرط محبته للحياة الروحية، أو أنه يفعل ما يظهر أنه يبغض الحياة الجسدية إن خُيّر بينهما، أو أنه يبغضها حقيقة حين يكون شرط حفظها إنكار المسيح وفقدان الحياة الأبدية. وقليلون من الناس يبغضون أنفسهم، وأكثرهم يحبونها ولا يهتمون إلا بها، ولا يبالون بالحياة السماوية.
٢٦ «إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَخْدِمُنِي فَليَتْبَعْنِي، وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا هُنَاكَ أَيْضاً يَكُونُ خَادِمِي. وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ يَخْدِمُنِي يُكْرِمُهُ الآبُ».
يوحنا ١٤: ٣ و١٧: ٢٤ و١تسالونيكي ٤: ١٧
قال المسيح هذا لنفع اليونانيين أولاً ثم لكل من يريدون أن يكونوا له تلاميذ. لقد أتى أولئك اليونانيون ليروا يسوع ويسألوه عن شروط التتلمذ له، فأعلن لهم الشروط التي سبق وأعلنها لرسله حين دعاهم، وهي إنكار النفس، واتخاذ يسوع معلّماً ومخلّصاً، والاقتداء به. وهذا هو قانون خلاص اليهود والأمم.
إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَخْدِمُنِي أي إن أراد أن يكون مسيحياً حقيقياً وتلميذاً أميناً.
فَليَتْبَعْنِي في طريق إنكار الذات، وعدم الالتفات إلى شرف هذا العالم وغناه ومجده، متمثلاً بي. وهذا كقول الرسول «إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه» (انظر شرح متّى ١٦: ٢٤).
وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا هُنَاكَ أَيْضاً يَكُونُ خَادِمِي أول شيء وعد المسيح به تلميذه الذي يتبعه بأمانة على الأرض أنه يكون معه في ملكوت مجده، يشاركه في كل ما يناله من السعادة والإكرام (يوحنا ١٤: ٣ و١٧: ٢٤ و١تسالونيكي ٤: ١٧ ورؤيا ٣: ٢١). وفي هذا العدد تعزية وتنشيط للمسيحيين في أوقات الضيق والاضطهاد.
وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ يَخْدِمُنِي يُكْرِمُهُ الآبُ إكراماً لابنه وإنجازاً لوعده. وهذا الأمر الثاني الذي وعد به المسيح تلميذه الأمين، وهذا مما لا يستطيع اللسان أن يعبر عنه، وهو لمن لم ينالوا الإكرام من الناس. ويوافق هؤلاء أن يخسروا الإكرام العالمي الوقتي القليل القدر لينالوا الإكرام السماوي غير المحدود قدراً وزماناً. فكان المسيح كلما قطع رجاء تلاميذه في الخير الأرضي من خدمتهم له قوَّى أملهم في المجد السماوي إثابة على كل ما يخسرونه في تلك الخدمة.
٢٧ «ٱلآنَ نَفْسِي قَدِ اضْطَرَبَتْ. وَمَاذَا أَقُولُ؟ أَيُّهَا الآبُ نَجِّنِي مِنْ هَذِهِ السَّاعَةِ. وَلَكِنْ لأجْلِ هَذَا أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ السَّاعَة».
متّى ٢٦: ٣٨، ٣٩ ولوقا ١٢: ٥٠ ويوحنا ١٣: ٢١ لوقا ٢٢: ٥٢ ويوحنا ١٨: ٣٧
ٱلآنَ نَفْسِي قَدِ اضْطَرَبَتْ معنى النفس هنا مركز الانفعالات. لم يستطع المسيح أن يفتكر في تمجيده دون أن يفتكر في الموصِّل إليه، وهو احتمال عقاب عالم الإثم بموته على الصليب. واضطراب نفسه هنا كاضطرابها في بستان جثسيماني في الليلة التي أُسلم فيها، والصلاة التي قدمها هنا كالصلاة التي قدمها وقتئذ، والنتيجة واحدة هي التسليم إلى مشيئة الآب (لوقا ٢٢: ٣٩ - ٤٤ فانظر الشرح هناك). وأشار الرسول إلى ذلك الاضطراب في عبرانيين ٢: ١٨ و٤: ١٥ و٥: ٧، لأن المسيح إنسان حقيقي كما أنه إله حقيقي، نفرت طبيعته البشرية من ألم نفسه المقدسة لحلوله محل الخطاة واحتماله الموت وعقاب الإثم عنهم. وكما بيّن هذا الاضطراب ناسوت المسيح، برهن أيضاً عظمة ثقل الحمل الذي حمله للكفارة.
وَمَاذَا أَقُولُ؟ خاطب يسوع نفسه بذلك ودلّ به على شدة اضطرابه، فكأنه قال: بماذا أعبر عن خوفي من الألم الروحي ورغبتي في طاعة إرادة أبي؟ فتنازعه أمران: غرائزه الطبيعية، ورغبته الروحية.
أَيُّهَا الآبُ نَجِّنِي مِنْ هَذِهِ السَّاعَةِ أي ساعة الألم (مرقس ١٤: ٣٥). هذه الكلمات تابعة للسؤال السابق غير مستقلة عنه. فكأن المسيح قال: ماذا أقول؟ هل أقول أيها الآب الخ؟ فلو طلب ذلك لاستجاب الله له ونجّاه من الموت، وكانت عاقبة نجاته من الموت هلاك البشر إلى الأبد (متّى ٢٦: ٥٣، ٥٤).
وَلَكِنْ لأجْلِ هَذَا أي لتمجيد أبي بخلاص البشر الذي لا يكون إلا بآلامي وموتي. ولم يرد يسوع أن يطلب إلى الآب النجاة من تلك الساعة، لأن تلك النجاة تنافي غاية مجيئه إلى العالم، فإنه قدم نفسه باختياره ليحتمل لعنة الإثم عن الأثمة، لأن خلاص العالم متوقف على موته (لوقا ٢٤: ٢٦). فهنيئاً لنا بأن المسيح لم يسأل أباه النجاة من تلك الساعة.
أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ السَّاعَةِ من السماء إلى الأرض، ومن المذود في بيت لحم إلى الصليب على تل الجلجثة. ويضارع هذا قول لوقا في سَفَر يسوع الأخير من الجليل إلى أورشليم منذ ستة أشهر حين تمت الأيام لارتفاعه «ثبَّت وجهه لينطلق إلى أورشليم» (لوقا ٩: ٥١).
٢٨ «أَيُّهَا الآبُ مَجِّدِ اسْمَكَ. فَجَاءَ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ: مَجَّدْتُ، وَأُمَجِّدُ أَيْضاً».
متّى ٣: ١٧ و١٦: ١٦، ١٧
مَجِّدِ اسْمَكَ بموتي وكل الآلام المحتومة عليّ بإرادتك لأني أريد أن يتمجد اسمك مهما لحقني من ألم (متّى ٢٦: ٣٩). فهذه الصلاة تدل على تسليم يسوع كل شيء إلى مشيئة الآب في وقت كان ينتظر فيه أشد الضيق. لقد كان تمجيد الآب غاية المسيح العظمى، ويجب أن تكون هذه غايتنا.
فَجَاءَ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ وهو قولٌ فهم بعضهم معناه وبعضهم لم يفهمه. قيل في الإنجيل إن الله تكلم من السماء بصوت مسموع على الأرض ثلاث مرات: (١) في معمودية يسوع (متّى ٣: ١٧) و(٢) حين التجلي (متّى ١٧: ٥) و(٣) هنا، وهي قرب زمان صلبه.
مَجَّدْتُ بما مضى من خدمتك قولاً وفعلاً. هذه شهادة الآب بمسرته بعمل ابنه وهي ختم له. ويمكننا أن نقصر هذه الشهادة على عمل المسيح في الأرض من تجسده واحتماله التجربة وصنعه المعجزات وتعليمه، كما يمكننا أن نطلقها على كل عمل الفداء منذ سقوط آدم. فمجَّد الله اسمه بإعلاناته للآباء القدماء، ولأنبياء العهد القديم، وبكل ذبائح الشريعة الموسوية ورسومها وشعائرها في خيمة الاجتماع والهيكل. نعم أن اسم الله تمجد قبل إتيان المسيح بالجسد في كل حوادث الكنيسة الإسرائيلية، لكنه تمجد أكثر بعد مجيئه.
وَأُمَجِّدُ أَيْضاً ذلك بموت المسيح، وقيامته، وسكب الروح القدس بناءً على ذلك، وبتأسيس الكنيسة المسيحية ودخول الأمم إليها.
٢٩ «فَالجَمْعُ الَّذِي كَانَ وَاقِفاً وَسَمِعَ، قَالَ: قَدْ حَدَثَ رَعْدٌ. وَآخَرُونَ قَالُوا: قَدْ كَلَّمَهُ ملاكٌ».
اتفق كل السامعين على أنهم سمعوا صوتاً غريباً عالياً من السماء، بدليل ظن بعضهم أنه رعد. واختلفوا في حقيقته لاختلافهم في القرب والبعد من المكان الذي فيه يسوع وتلاميذه، ولاختلاف انتباههم له واهتمامهم بأمور متنوعة، وباختلاف استعدادهم لقبول التأثيرات السماوية. ومثل ذلك أن بعض الناس الذين سمعوا الرسل يتكلمون بألسنة يوم الخمسين حسبوهم سكارى، وأن آخرين قالوا إنهم يتكلمون بعظائم الله. ولعل اليونانيين ظنوا ذلك الصوت رعداً لأنهم لم يفهموا اللغة العبرانية الذي كان الكلام بها.
٣٠ «أَجَابَ يَسُوعُ: لَيْسَ مِنْ أَجْلِي صَارَ هَذَا الصَّوْتُ، بَل مِنْ أَجْلِكُمْ».
يوحنا ١١: ٤٢
لَيْسَ مِنْ أَجْلِي صَارَ هَذَا الصَّوْتُ لم يكن ذلك الصوت لتعزية المسيح وإزالة شكوكه في مسرة الله به، لأنه متيقن من ذلك (يوحنا ١١: ٤١، ٤٢).
بَل مِنْ أَجْلِكُمْ إن الله علم أفكارهم وكلامهم، فكان ذلك الصوت لتعليمهم وإزالة شكوكهم ليقنعهم أن يسوع رسول الله، والله سُرّ به. فإن كانوا لم يستفيدوا كل الاستفادة من ذلك الصوت وقتئذٍ فلهم أن يستفيدوا كذلك بعدئذ عندما يذكرونه
٣١ «ٱلآنَ دَيْنُونَةُ هَذَا العَالَمِ. ٱلآنَ يُطْرَحُ رَئِيسُ هَذَا العَالَمِ خَارِجاً».
متّى ١٢: ٢٩ ولوقا ١٠: ١٨ ويوحنا ١٤: ٣٠ و١٦: ١١ وأعمال ٢٦: ١٨ و٢كورنثوس ٤: ٤ وأفسس ٢: ٢ و٦: ١٢
ٱلآنَ أي زمن حدوث ثلاثة أمور هي: مجيء اليونانيين، والصوت من السماء، وموته. ولذلك ثلاث نتائج ذكرها على الأثر، وهي: دينونة العالم، وطرح رئيسه، وجذب المسيح للجميع.
دَيْنُونَةُ هَذَا العَالَمِ (يوحنا ٣: ١٧ - ١٩). العالم هنا عموم الناس على الأرض، وقد دِين العالم لأنه ملكوت الشيطان فإن «العالم كله قد وُضع في الشرير» (١يوحنا ٥: ٩)، ولأنه صلب رب المجد. والدينونة هنا ليست حساب اليوم الأخير، بل إعلان الله أن العالم أثيم، وأنه أخذ في إزالة كل ما يغيظه فيه، ولا سيما عبادة الأوثان، وما طرأ على الدين اليهودي من الفساد والرياء، واستيلاء الشيطان على قلوب الناس. وأعظم مغضبات الله رفض العالم لابنه. وأظهر الله هذا الحكم في العالم بعد موت ابنه أكثر مما أظهره قبلاً بما فعله من دعوة الأمم من الأوثان إلى الخلاص بابنه.
ٱلآنَ يُطْرَحُ رَئِيسُ هَذَا العَالَمِ أي الشيطان، وسُمي رئيس هذا العالم لخضوع أكثر العالم له وطاعته إياه. وحيث تسود الخطية يملك الشيطان (يوحنا ١٤: ٣٠ و١٦: ١١ و٢كورنثوس ٤: ٤ وأفسس ٦: ١٢). فطُرح رئيس العالم على أثر دينونة العالم. وتقييد طرحه «الآن» لأن موت المسيح هو علة خراب مملكته «إِذْ جَرَّدَ الرِّيَاسَاتِ وَالسّلاطِينَ أَشْهَرَهُمْ جِهَاراً، ظَافِراً بِهِمْ فِيهِ» (كولوسي ٢: ١٥). وفي ذلك إتمام للنبوة الأولى بالمسيح ونصها «هُوَ يَسْحَقُ رَأْسَكِ، وَأَنْتِ تَسْحَقِينَ عَقِبَهُ» (تكوين ٣: ١٥ انظر شرح لوقا ١٠: ١٨ وأعمال ٢٦: ١٨ ورومية ١٦: ٢٠ و١بطرس ٥: ٨ ورؤيا ١٢: ٧ - ١٢ و٢٠: ٢). وهذه النتيجة لا تحصل دفعة بل تدريجياً.
٣٢ «وَأَنَا إِنِ ارْتَفَعْتُ عَنِ الأَرْضِ أَجْذِبُ إِلَيَّ الجَمِيعَ».
يوحنا ٣: ١٤ و٨: ٢٨ رومية ٥: ١٨ وعبرانيين ٢: ٩
وَأَنَا إِنِ ارْتَفَعْتُ عَنِ الأَرْضِ على الصليب لأموت كفارة عن خطايا العالم، وقد فُسر ذلك في الآية التالية. وبمثل ذلك عبّر عن موته لنيقوديموس (يوحنا ٣: ١٥) ولليهود (يوحنا ٨: ٢٥). ونتيجة ارتفاع يسوع على الصليب ارتفاعه إلى عرش المجد، واستيلاؤه على كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وارتقاؤه إلى يمين الله شفيعاً لنا. ومن نتائجه أيضاً إتيان الأمم إليه بالإيمان، وهدم ملكوت الشيطان.
أَجْذِبُ إِلَيَّ الجَمِيعَ أي الذين يطيعون جذبي ويرضون بالخلاص على يديَّ، لا كل إنسان مطلقاً، بل بشرط الإيمان. ويتضمن قوله «الجميع» كل صنوف البشر من يهود وأمم في كل عصر وبلاد. وهؤلاء اليونانيون هم باكورة حصاد الأمم. وقوله «أجذب» يفيد أنه لا يجبرهم على المجيء بجيوش من الملائكة أو من الناس، بل إنه يقنعهم بالبراهين المقنعة لأذهانهم وضمائرهم، ويضع أمامهم أفراح السماء تشويقاً لهم إليها وأهوال جهنم ترهيباً لهم منها. والجاذب الأعظم لهم تأثير روحه القدوس فيهم.
فالجاذب هو يسوع المسيح، مرتفعاً على الصليب، لا لكونه معلماً ومثالاً لنا. وجذب موته أشد من كل ما سواه من المؤثرات الروحية لما فيه من إظهار المحبة والحنو الإلهي، وهو أن المحب مات من أجل أحبائه، وإظهار جسامة جرم الخطية التي لا يمكن رفعها إلا بموت ابن الله. وهذا ينشئ في قلوبنا الشكر للمسيح. وموت المسيح كان سبب إرساله الروح القدس إلينا.
وبرهان أن ذلك الجاذب هو المسيح بعد صلبه تأثير التبشير به يوم الخمسين، وذلك بعد صلبه. فإن الذين آمنوا في ذلك اليوم وحده زادوا على كل من آمنوا بالمسيح بتعليمه ومشاهدة معجزاته كل مدة حياته على الأرض.
وأشار بقوله «إليَّ» إلى أنه قصد جذب قلوب الناس إليه في كل الزمن المستقبل، لا في الساعات القليلة التي كان معلقاً فيها على الصليب. وذلك يستلزم أن المسيح يكون حياً بعد الموت، وحاضراً بروحه بين شعبه رئيساً له. وفيه تصريح أنه يجذب الجميع إلى نفسه، لا إلى دينه، ولا إلى كنيسته، ولا إلى رسله أو إلى أي مخلوق آخر.
٣٣ «قَالَ هَذَا مُشِيراً إِلَى أَيَّةِ مِيتَةٍ كَانَ مُزْمِعاً أَنْ يَمُوتَ».
يوحنا ١٨: ٣٢
هذا تفسير يوحنا لقول المسيح «ارتفعتُ» بياناً لنوع موت المسيح، وهو الصلب (يوحنا ١٨: ٣٢). وهذا لا يمنع من أن المقصود ارتفاعه إلى السماء بعد موته، وارتفاعه باحترام الناس له بإيمانهم به وعبادتهم له.
٣٤ «فَأَجَابَهُ الجَمْعُ: نَحْنُ سَمِعْنَا مِنَ النَّامُوسِ أَنَّ المَسِيحَ يَبْقَى إِلَى الأَبَدِ، فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَفِعَ ابْنُ الإِنْسَانِ؟ مَنْ هُوَ هَذَا ابْنُ الإِنْسَانِ؟».
مزمور ٨٩: ٣٦ و١١٠: ٤ وإشعياء ٩: ٧ و٥٣: ٨ وحزقيال ٣٧: ٢٥ ودانيال ٢: ٤٤ و٧: ١٤، ٢٧ وميخا ٤: ٧ ويوحنا ٣: ١٤
مضمون هذا الاعتراض أن يسوع ادعى أنه المسيح، وما قاله على نفسه هنا منافٍ لقول النبوات في المسيح الموعود به.
نَحْنُ سَمِعْنَا أي نحن الذين نعرف الناموس ونفسره لغيرنا.
النَّامُوسِ أي العهد القديم كما في (يوحنا ١٠: ٣٤).
أَنَّ المَسِيحَ يَبْقَى إِلَى الأَبَدِ هذا حق باعتبار ملكه الروحي، وسند قولهم ما جاء في مزمور ٨٩: ٢٩، ٣٦، ٣٧ و١١٠: ٤ وإشعياء ٩: ٧ وحزقيال ٢٧: ٢٥ ودانيال ٧: ١٣، ١٤ وميخا ٤: ٧. ولكنهم أخطأوا من وجهين: الأول أنهم حسبوا ملكه زمنياً، وأنه يملك على الأرض إلى الأبد ملكاً منظوراً مجيداً يحرر بني إسرائيل من عبودية الرومان، وينشئ فردوساً أرضياً لا نهاية له. والثاني أنه يملك ولا يموت، والحق أنه يتواضع أولاً بالموت ثم يرتفع بالملك الروحي.
كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَفِعَ يظهر من هذا أنهم فهموا بالارتفاع الآلام والموت، وأنه قصد نفسه بقوله «ابن الإنسان» بناءً على قوله قبلاً (ع ٢٣ وكثير من المواضع) وفهموا أن كلامه منافٍ للنبوات كقول دانيال «كُنْتُ أَرَى فِي رُؤَى اللَّيْلِ وَإِذَا مَعَ سُحُبِ السَّمَاءِ مِثْلُ ابْنِ إِنْسَانٍ أَتَى وَجَاءَ إِلَى القَدِيمِ الأَيَّامِ، فَقَرَّبُوهُ قُدَّامَهُ. فَأُعْطِيَ سُلطَاناً وَمَجْداً وَمَلَكُوتاً لِتَتَعَبَّدَ لَهُ كُلُّ الشُّعُوبِ وَالأُمَمِ وَالأَلسِنَةِ. سُلطَانُهُ سُلطَانٌ أَبَدِيٌّ مَا لَنْ يَزُولَ، وَمَلَكُوتُهُ مَا لا يَنْقَرِضُ» (دانيال ٧: ١٣، ١٤) وأنهم لم يعتبروا ولم يفهموا النبوات الأخرى التي بيّنت أن المسيح يكون مرذولاً ومتألماً مثل قول إشعياء «ظُلِمَ أَمَّا هُوَ فَتَذَلَّلَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ، كَشَاةٍ تُسَاقُ إِلَى الذَّبْحِ» (إشعياء ٥٣: ٧ ومثله دانيال ٩: ٢٦). ولم يدركوا ما تشير إليه ذبائح العهد القديم. وخلاصة ذلك أنهم سمعوا بأبدية المسيح وهو يقول بموته.
مَنْ هُوَ هَذَا ابْنُ الإِنْسَانِ أي من هو هذا الذي يموت؟ إنه ليس مسيح النبوات، فهذا نعرفه وهو مجيد يحيا إلى الأبد، وهذا هو الذي نعتقده ونحتاج إليه. وأما الذي ذكرته فلا نعرفه ولا نريده. وفي كلامهم استغراب وإنكار. فالذين قالوا يوم الأحد «أوصنا! مبارك الآتي باسم الرب» قالوا يوم الثلاثاء «من هو هذا ابن الإنسان؟» وقالوا يوم الجمعة «اصلبه! اصلبه!». وقالوا القول الأول حين افتكروا في معجزاته. وقالوا الثاني حين ظهر لهم ما في قوله من المنافاة لأقوال الأنبياء. وقالوا الثالث حين سمعوا اتهام الفريسيين له.
٣٥ «فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: النُّورُ مَعَكُمْ زَمَاناً قَلِيلاً بَعْدُ، فَسِيرُوا مَا دَامَ لَكُمُ النُّورُ لِئلا يُدْرِكَكُمُ الظّلامُ. وَالَّذِي يَسِيرُ فِي الظّلامِ لا يَعْلَمُ إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُ».
يوحنا ١: ٩ و٨: ١٢ و٩: ٥، ٤٦ إرميا ١٣: ١٦ وأفسس ٥: ٨ ويوحنا ١١: ١٠ و١يوحنا ٢: ١١
لم يجب يسوع على سؤالهم بالتصريح، إنما أنذرهم من فوات الفرصة لنوال الخلاص، وفي هذا إجابة ضمنية لسؤالهم، وهو أنهم إذا استناروا بنور الحق أدركوا معنى النبوات المتعلقة بالمسيح حق الإدراك، وخلصوا من خطاياهم. وكلامه هنا جار مجرى المثل، وقد بُني على أمر معلوم، وهو أن الذي يقصد السفر يجب أن يسير في النهار. والمعنى أن الوقت الحاضر أهم الأوقات لنجاتهم ونجاة سائر أمتهم من أشد المصائب، ونوال أعظم البركات.
النُّورُ مَعَكُمْ زَمَاناً قَلِيلاً بَعْدُ قصد بالنور هنا نفسه لأنه نور العالم (يوحنا ١: ٤ و٨: ١٢ و٩: ٤). وأشار بقوله «معكم زماناً قليلاً» إلى قرب موته (يوحنا ٩: ٤). وإذ كان نور العالم على وشك الغروب كان يوم خلاص اليهود على وشك الانتهاء.
فَسِيرُوا مَا دَامَ لَكُمُ النُّورُمعنى هذا كمعنى قوله في يوحنا ٨: ١٢ وهو وجوب اغتنام الفرصة لمعرفة الحق ونوال الخلاص ما دام هو بينهم يرشدهم إلى طريق الحياة.
لِئلا يُدْرِكَكُمُ الظّلامُ أي لئلا ينزع الله نعمته منكم ووسائط معرفة الحق ويترككم إلى جهالتكم وعماكم وشقائكم (يوحنا ٨: ١٢ ورومية ١: ٢١ و١يوحنا ٢: ١١). وتم ذلك على أكثر اليهود، إذ هُدمت مدينتهم وتبدد شملهم وبقيت قلوبهم قاسية مظلمة. ويصيب ما أصابهم كل الخطاة الذين يرفضون الإنجيل. وهذا الظلام يدرك بعض رافضي الحق في هذا العالم، ويدرك البعض الآخر في العالم الآتي، وهم الأكثر.
لا يَعْلَمُ إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُ ظن اليهود أنهم ذاهبون إلى السماء، وجهلوا أنهم برفضهم المسيح عرضوا أنفسهم لخطر السقوط في جهنّم التي لا يعرف أحد شدة ما فيها من الظلام واليأس والشقاء. وما قاله المسيح هنا نبوة إلى ما صار إليه اليهود من ذلك الوقت إلى الآن، فإنهم تائهون في الظلام بلا مرشد ولا غاية.
٣٦ «مَا دَامَ لَكُمُ النُّورُ آمِنُوا بِالنُّورِ لِتَصِيرُوا أَبْنَاءَ النُّورِ. تَكَلَّمَ يَسُوعُ بِهَذَا ثُمَّ مَضَى وَاخْتَفَى عَنْهُمْ».
لوقا ١٦: ٨ وأفسس ٥: ٨ و١تسالونيكي ٥: ٥ و١يوحنا ٢: ٩ الخ لوقا ٢١: ٣٧ ويوحنا ٨: ٥٩ و١١: ٥٤
هذه الدعوة المملوءة رقة وشفقة ومحبة، كقوله «تعالوا إليّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم». وهي نصيحة من أفضل الأصدقاء المخلصين لكل إنسان: أن يستفيد من الوسائط التي وهبها الله له لينال منه أعظم منها. وتلك الوسائط هي نور الضمير، وكلام الله، وإنارة الروح القدس. وكلها من مصدر واحد هو المسيح.
مَا دَامَ لَكُمُ النُّورُ هذا يتضمن أمرين: (١) أن يسوع هو النور. (٢) أنه على وشك تركهم. ومعناه بالنظر إلى اليهود يومئذ أن وقت وجود المسيح بينهم وقت النعمة لهم. ومعناه بالنظر إلينا أن زمن حياتنا على الأرض هو وقت نعمتنا. وفي هذه الآية جواب لليهود على قولهم «من هو هذا ابن الإنسان؟» (ع ٣٤) وهو أنه نور العالم.
آمِنُوا بِالنُّورِ هذا كقوله آنفاً: سيروا في النور، أي اتكلوا عليّ مرشداً ومخلّصاً، فذلك الإيمان يجعلكم أبناء النور. وهو ليس النظر إليَّ مرة بل دائماً، إذ لم يقل: انظروا النور، بل قال: سيروا فيه، وذلك كما سار أخنوخ ونوح مع الله.
أَبْنَاءَ النُّورِ (انظر شرح لوقا ١٦: ٨). قصد المسيح بذلك أن يكونوا مثله، لأنه هو النور، وأن يتعلموا منه لأن النور هو كل علم حق، وأن يكونوا مخلصين لا مرائين لأن النور لا غش فيه، وأطهاراً لأن النور طاهر، ومنيرين لغيرهم لأن النور مضيء وهو صفة مملكة النور وورثتها (أفسس ٥: ٨).
مَضَى وَاخْتَفَى سبب ذلك معرفته أنهم يبغضونه ويقصدون به الشر، وأن وقته لم يأت بعد إذ هو في عيد الفصح، وكان اختفاؤه في يوحنا ٨: ٥٩. والأرجح أنه ذهب إلى بيرية (انظر شرح لوقا ٢١: ٣٧). ثم أتى أيضاً وعلّم في أورشليم ما سيأتي. وظن بعضهم أنه اعتزل الجمع الذي كان حوله وذهب إلى موضع آخر من المدينة وخاطب آخرين.
كفر اليهود وسببه (ع ٣٧ - ٤٣)
٣٧ «وَمَعَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ صَنَعَ أَمَامَهُمْ آيَاتٍ هَذَا عَدَدُهَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ».
الآيات ٣٧ - ٤٣ كلام يوحنا على قساوة قلوب اليهود، ورفضهم أوضح البراهين على لاهوت يسوع وأنه المسيح.
أَمَامَهُمْ أي أمام جمهور اليهود.
آيَاتٍ هَذَا عَدَدُهَا أي كثيرة، ويحتمل الأصل اليوناني أنها عظيمة أيضا،ً ويدل هذا على أن يسوع صنع معجزات كثيرة لم يذكر يوحنا سوى سبع منها (وهي تحويل الماء خمراً، وشفاء ابن خادم الملك، وإبراء المقعد، وإشباع خمسة آلاف بخمسة أرغفة، والمشي على الماء، وتفتيح عيني الأكمه، وإقامة لعازر) لكنه أشار إلى كثير منها (يوحنا ٢: ٢٣ و٧: ٣ و٩: ١٦ و١١: ٤٧ و١٦: ٢٤). وفي هذا العدد إشارة إلى أن تلك المعجزات كانت برهاناً كافياً لإثبات دعوى يسوع، وصُنعت أمام عيونهم، فكان يجب على اليهود أن يقتنعوا به.
لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أي اليهود إجمالاً. ذكر يسوع كفرهم في معرض الاستغراب لقوة البراهين من كثرة المعجزات وعظمتها. وجمع في هذا العدد نتائج كل خدمة يسوع مدة ثلاث سنين ونصف سنة من أولها إلى آخرها فكانت وفق قوله «إِلَى خَاصَّتِهِ جَاءَ، وَخَاصَّتُهُ لَمْ تَقْبَله» (يوحنا ١: ١١).
٣٨ «لِيَتِمَّ قَوْلُ إِشَعْيَاءَ النَّبِيِّ: يَا رَبُّ، مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا، وَلِمَنِ اسْتُعْلِنَتْ ذِرَاعُ الرَّبِّ؟».
إشعياء ٥٣: ١ ورومية ١٠: ١٦
لِيَتِمَّ أي كان كفرهم على وفق نبوة إشعياء، فليست النبوة سببه، لكنها سبب عدول البشير عن الاستغراب، فإن الله أنبأ بذلك منذ القديم. وتمت تلك النبوة على اليهود في أيام إشعياء كما تمت عليهم في أيام المسيح.
يَا رَبُّ، مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا تكلم إشعياء عن نفسه وعن غيره من المنادين بكلمة الله في أيامه وفي الأيام الآتية. وهذا الكلام بدء أصحاح ٥٣ من نبوته. ومعناه: لم يصدِّق خبرنا أحد. والمقصود بالخبر هنا شهادته بآلام المسيح فداءً لشعبه.
اسْتُعْلِنَتْ ذِرَاعُ الرَّبِّ ذراع الرب كناية عن قوته بإقامة فادٍ لشعبه، وإعداد خلاصهم على يده. وظهرت ذراع الرب في أعمال يسوع ومعجزاته وتعليمه وقيامته وصعوده، ولم يرها أحد (إشعياء ٥١: ٩ و٥٢: ١٠).
٣٩ «لِهَذَا لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُؤْمِنُوا. لأنَّ إِشَعْيَاءَ قَالَ أَيْضاً».
إشعياء ٦: ٩، ١٠ ومتّى ١٣: ١٤
لِهَذَا لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُؤْمِنُوا أي لعلة ستُذكر في الآية التالية، وهي عمى بصيرتهم وغلاظة قلوبهم، فإن من هذا حاله يتعذَّر عليه الإيمان. فمعنى عدم القدرة هنا كمعناه في قوله «ولم يقدر (أي يسوع) أن يصنع هناك (في الناصرة) ولا قوة واحدة لعدم إيمانهم» (مرقس ٦: ٥). وعلة كفرهم ليست قضاء الله، ولا نبوة إشعياء، بل إرادتهم واختيارهم، فلم يقدروا أن يؤمنوا لأنهم لم يريدوا. وبهذا المعنى قوله «لَمْ يَسْتَطِيعُوا (أي إخوة يوسف) أَنْ يُكَلِّمُوهُ (أي يوسف) بِسلامٍ» (تكوين ٣٧: ٤) وقوله «لا يَقْدِرُ العَالَمُ أَنْ يُبْغِضَكُمْ» (يوحنا ٧: ٧). وقوله «لَنْ يَقْدِرَ (أي الله) أَنْ يُنْكِرَ نَفْسَهُ» (٢تيموثاوس ٢: ١٣).
٤٠ «قَدْ أَعْمَى عُيُونَهُمْ، وَأَغْلَظَ قُلُوبَهُمْ، لِئلا يُبْصِرُوا بِعُيُونِهِمْ، وَيَشْعُرُوا بِقُلُوبِهِمْ، وَيَرْجِعُوا فَأَشْفِيَهُمْ».
هذا من نبوة إشعياء ٦: ١٠ ونُقلت هذه العبارة في العهد الجديد ست مرات بياناً لرفض اليهود أن يسوع هو المسيح (متّى ١٣: ١٤ و١٥ ومرقس ٤: ١٢ ولوقا ٨: ١٠ وأعمال ٢٨: ٢٦، ٢٧، ٢٨ ورومية ١١: ٨). فراجِع تفسيرها في بشارتي متّى ومرقس. واقتُبست بشيء من التصرف مع حفظ المعنى. فجاء في بعض المقتبسات نسبة الأغلاط إلى الناس أنفسهم كما في بشارة متّى، وفي بعضها إلى الله كما في هذه الآية، وهو في الأصل منسوب إلى إشعياء نفسه. والحقيقة أنه فِعل الناس أنفسهم لأنهم أغمضوا عيونهم عن الحق وقسوا قلوبهم عن قبوله بإرادتهم واختيارهم، وأن الله قضى أن يتركهم في الحالة التي اختاروها اتباعاً لشهواتهم، كعقاب على ما فعلوه، ولم يمنعهم بروحه القدوس من إغماض عيونهم، ولم يليّن قلوبهم ليحملهم على الإيمان والتوبة. ونُسب ذلك إلى النبي لأن الله بيّن قضاءه بفمه بناء على قساوتهم.
قَدْ أَعْمَى عُيُونَهُمْ، وَأَغْلَظَ قُلُوبَهُمْ لكي لا تدرك عقولهم الحق ولا تشعر قلوبهم بقوته. وهذا نتيجة مناداة إشعياء ووعظ المسيح لا غايتهما (رومية ٧: ٨ - ١١ و٢كورنثوس ٢: ١٥، ١٦).
٤١ «قَالَ إِشَعْيَاءُ هَذَا حِينَ رَأَى مَجْدَهُ وَتَكَلَّمَ عَنْهُ».
إشعياء ٦: ١
قَالَ إِشَعْيَاءُ هَذَا أي ما ذُكر من شهادة ونبوة.
حِينَ رَأَى مَجْدَهُ أشار بذلك إلى ما جاء في إشعياء ٦، الذي هو علة النبوة، وهو أنه رأى السرافيم يعبدون الله هاتفين «قدوس قدوس قدوس رب الجنود» والضمير في «مجده» يعود إلى المسيح. وهذا من أوضح البراهين على أن يسوع هو الله، لأن يوحنا الرسول وهو يتكلم بالوحي صرح أن «السيد» الإلهي الذي رأى إشعياء مجده وقال فيه «لأن عينيَّ قد رأتا الملك رب الجنود» هو يسوع المسيح. وهذا على وفق قول بولس أن الذي قاد إسرائيل بالسحاب في البرية هو يسوع ( ١كورنثوس ١٠: ٤). ومن الضرورة أن الذي رآه إشعياء هو الأقنوم الثاني، لأن «الله الآب لم يره أحد قط» (يوحنا ١: ١٨) و «لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ولا يَقْدِرُ أَنْ يَرَاهُ» (١تيموثاوس ٦: ١٦). فإشعياء رأى منذ ٧٠٠ سنة قبل إتيان المسيح الذي لم يره اليهود مع كونه متجسداً بينهم.
٤٢ «وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ آمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ مِنَ الرُّؤَسَاءِ أَيْضاً، غَيْرَ أَنَّهُمْ لِسَبَبِ الفَرِّيسِيِّينَ لَمْ يَعْتَرِفُوا بِهِ، لِئلا يَصِيرُوا خَارِجَ المَجْمَعِ».
يوحنا ٧: ١٣ و٩: ٢٢
أراد يوحنا أن يبيّن لقراء إنجيله أن ما قاله، وإن صدق على اليهود إجمالاً، لا يصدق على كل فرد منهم.
آمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ أي اقتنعوا اقتناعاً عقلياً بأن يسوع هو المسيح، ولم يكونوا عمياناً غلاظ القلوب كسائر اليهود. ولا يلزم من ذلك أن إيمانهم كان قلبياً حقيقياً خالصاً، وإلا لظهر بإقرارهم، لكنه كان استعداداً للإيمان الصحيح، كما كان من أمر نيقوديموس ويوسف الرامي، فإنهما أظهراً بعدئذ علامات صحة إيمانهما بأعمالهما (يوحنا ١٩: ٣٨، ٣٩ ومرقس ١٥: ٤٣ ولوقا ٢٣: ٥٠، ٥١).
لِسَبَبِ الفَرِّيسِيِّينَ أقوى أعداء يسوع وأشدهم بغضاً، الذين خافهم الرؤساء أنفسهم.
لَمْ يَعْتَرِفُوا بِهِ خوفاً من الاضطهاد. إن الإيمان المجرد عن الاعتراف غير كافٍ للخلاص بدليل ما جاء في رومية ١٠: ١٠.
لِئلا يَصِيرُوا خَارِجَ المَجْمَعِ وهذا الحرمان عندهم مصيبة كالموت، فكان الذي يخرجونه من المجمع يُحرم من كل الحقوق الدينية والشخصية وأكثر الحقوق المدنية (راجع شرح يوحنا ٩: ٢٢).
٤٣ «لأنَّهُمْ أَحَبُّوا مَجْدَ النَّاسِ أَكْثَرَ مِنْ مَجْدِ اللَّهِ».
يوحنا ٥: ٤٤
هذا وصف حال أكثر اليهود، وهو سبب جبنهم عن الاعتراف بالإيمان (يوحنا ٥: ٤٤). ومعنى مجد الناس هنا مدحهم ورضاهم. فأولئك الرؤساء طلبوا مدح الناس أكثر مما يجب ومدح الله أقل مما يستحق، وخالفوا أحكام عقولهم، وشهادات ضمائرهم، وأغاظوا الله، وأهلكوا نفوسهم إن كانوا قد بقوا على تلك الحال، وفعلوا كل ذلك إرضاءً للبشر أمثالهم. ولم يزل حب مجد الناس سبب هلاك كثيرين. وينجو الإنسان من هذا إن تأمل الإنسان في من هو الله، وفي عظمة البركات الناتجة من رضاه، وشدة الهول من غضبه (١يوحنا ٥: ٤).
إثم اليهود لعدم إيمانهم (ع ٤٤ - ٥٠)
٤٤ «فَنَادَى يَسُوعُ: الَّذِي يُؤْمِنُ بِي لَيْسَ يُؤْمِنُ بِي بَل بِالَّذِي أَرْسَلَنِي».
مرقس ٩: ٣٧ و١بطرس ١: ٢١
فَنَادَى يَسُوعُ أشار البشير إلى أن يسوع رفع صوته لينبه كل الحاضرين ليسمعوا ما يقول، ولم يذكر يوحنا أين ولا متى كان ذلك. ولعله ألقى أول خطابه (ع ٣٠ - ٣٦) في مكان، وبقيته في مكان آخر (ع ٤٤ - ٥٠). وما قيل في هذا الفصل يكرر باختصار ما قاله يسوع سابقاً.
الَّذِي يُؤْمِنُ بِي جاء مثل هذا في يوحنا ٥: ٣٦ و٧: ١٦، ٢٩ و٨: ١٩ و١٠: ٣٥.
لَيْسَ يُؤْمِنُ بِي أي وحدي. ذلك كقول الله لصموئيل «اسْمَعْ لِصَوْتِ الشَّعْبِ.. لأنَّهُمْ لَمْ يَرْفُضُوكَ أَنْتَ» (١صموئيل ٨: ٧). ومعناه أنهم لم يرفضوه وحده (قارن بما في متّى ١٠: ٢٠ ومرقس ٩: ٣٧).
بَل بِالَّذِي أَرْسَلَنِي هذا تصريح بأن الإيمان بالمسيح يتضمن الإيمان بالله الآب، وذلك دليل على الاتحاد التام بين المسيح وأبيه حتى لا يمكن لأحد أن يؤمن بأحدهما دون الآخر. ويجب أن يؤمن بهما معاً لأنهما يعملان عملاً واحداً (يوحنا ٥: ١٦، ٢٠، ٣٦ و١٠: ٢٥، ٣٧) ويعلّمان تعليماً واحداً (يوحنا ٨: ٣٨ و١بطرس ١: ٢١).
٤٥ «وَالَّذِي يَرَانِي يَرَى الَّذِي أَرْسَلَنِي».
يوحنا ١٤: ٩
هذا دليل واضح على مساواة الابن للآب. ولو كان بينهما فرق في الجوهر لما ساغ القول به لأنه يستحيل أن يصدق على ملاك أو إنسان. فلو قاله موسى أو إشعياء على نفسه كان تجديفاً فظيعاً، ولكن يسوع كان يقوله مراراً كثيرة (يوحنا ٥: ١٧). وليس المعنى أن الذي يرى المسيح بعين الجسد يرى الآب كذلك، فهذا مُحال (١تيموثاوس ٦: ١٦) بل المراد أن الذي يرى يسوع يرى كل ما يمكن من معلنات الآب، لأنه «بَهَاءُ مَجْدِهِ، وَرَسْمُ جَوْهَرِهِ» (عبرانيين ١: ٣). وغاية هذه الآية وما قبلها تقوية إيمان تلاميذه به وتقرير تعليمه اتحاده بالآب.
٤٦ «أَنَا قَدْ جِئْتُ نُوراً إِلَى العَالَمِ، حَتَّى كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِي لا يَمْكُثُ فِي الظُّلمَةِ».
يوحنا ٣: ١٩ و٨: ١٢ و٩: ٥، ٣٩ وع ٣٥، ٣٦
انظر شرح يوحنا ٨: ١٢ وانظر أيضاً يوحنا ١: ٩ و٣: ١٩.
ولنا في هذا العدد: (١) بيان غاية تجسد المسيح وموته لإنقاذ الناس من سلطة الظلمة ونقلهم إلى ملكوته (كولوسي ١: ١٣). (٢) أن يسوع لنفوس الناس بمنزلة الشمس لأجسادهم، فهو أصل التنوير والبركة والسعادة، وطريق الوقاية من الخطر. (٣) عظمة المسيح وسمو مقامه. (٤) عموم بركة الإنجيل.
لا يَمْكُثُ فِي الظُّلمَةِ أي الجهالة والضلالات المهلكة والشقاء الناتج عن ذلك. والذي لا يمكث في الظلمة يقوده المسيح إلى الله والحق والسماء (يوحنا ٣: ١٩ وإشعياء ٨: ٢٢ و٥٩: ٩ ويوحنا ٢: ٢٢ و١يوحنا ١: ٥).
وفي هذه الآية خمس حقائق ذات شأن: (١) أن العالم في الظلمة. (٢) أن المسيح نور العالم الوحيد. (٣) أن الإيمان هو الوسيلة الوحيدة إلى الاستفادة من المسيح. (٤) أن للمؤمن نوراً روحياً. (٥) أن غير المؤمن يبقى في ظلمة الضلال التي هي مقدمة لظلمة جهنم.
٤٧ «وَإِنْ سَمِعَ أَحَدٌ كلامِي وَلَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لا أَدِينُهُ، لأنِّي لَمْ آتِ لأدِينَ العَالَمَ بَل لأُخَلِّصَ العَالَمَ».
يوحنا ٥: ٤٥ و٨: ١٥، ٢٦ ويوحنا ٣: ١٧
انظر شرح يوحنا ٨: ١٥. تكلم يسوع سابقاً عن امتيازات المؤمنين، وتكلم هنا على خطر الكفرة.
فَأَنَا لا أَدِينُهُ أي الآن، لأن الدينونة ليست من غرضي في مجيئي الأول، إنما هي من أغراضي في المجيء الثاني. قال ذلك إصلاحاً لأخطاء اليهود، كقولهم إن المسيح يأتي ليدين أعداءه وأعداء شعبه وينتقم منهم ويسحقهم.
بَل لأُخَلِّصَ العَالَمَ أي لأجهز الخلاص للجميع، وأدعوهم لقبوله. ولكن لا يستفيد منه سوى المؤمنين «لأنَّهُ لَمْ يُرْسِلِ اللَّهُ ابْنَهُ إِلَى العَالَمِ لِيَدِينَ العَالَمَ، بَل لِيَخْلُصَ بِهِ العَالَمُ» (يوحنا ٣: ١٧).
٤٨ «مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَل كلامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. ٱلكلامُ الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي اليَوْمِ الأَخِيرِ».
لوقا ١٠: ١٦ تثنية ١٨: ١٩ ومرقس ١٦: ١٦
مَنْ رَذَلَنِي انظر شرح لوقا ١٠: ١٦. ومعنى «رذلني» أهانني برفضه أني المسيح والمخلص والفادي، بعد كل ما أوردته من البراهين.
فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ انظر شرح يوحنا ٣: ١٨ و٥: ٤٥ و٨: ٣٠. هذا يفيد أن غير المؤمن يُدان، وإن لم يدنه المسيح وقتئذ، والشاهد عليه حاضر ليشهد ويدين أيضاً لكنهم جهلوه.
ٱلكلامُ الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ هذا لا ينفي أن المسيح يدينه كما قيل في (يوحنا ٥: ٢٥ - ٢٧). إنما يبين أن الدينونة تكون بمقتضى الكلام الذي تكلم به المسيح سابقاً، واعتراف المحكوم عليه بأنه سمعه، فيقارن سلوكه به ويدين نفسه، ويشهد بعدل الله الديّان.
فِي اليَوْمِ الأَخِيرِ يذكر الخاطئ في اليوم الأخير وهو أمام عرش الدينونة كلمات الحكمة والحق والرحمة والإنذار. ويكون الحكم الإلهي وضمير الخاطئ على وفاق في الحكم على الخاطئ لرفضه المسيح، فيصمت ولا ينطق بكلمة.
٤٩ «لأنِّي لَمْ أَتَكَلَّمْ مِنْ نَفْسِي، لَكِنَّ الآبَ الَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ أَعْطَانِي وَصِيَّةً: مَاذَا أَقُولُ وَبِمَاذَا أَتَكَلَّمُ».
يوحنا ٨: ٣٨ و١٤: ١٠ تثنية ١٨: ١٨
لأنِّي لَمْ أَتَكَلَّمْ مِنْ نَفْسِي أي وحدي. انظر شرح يوحنا ٥: ٣٠ و٧: ١٦ - ١٨، ٢٨، ٢٩ و٨: ٢٦ ، ٢٨ ، ٣٨. هذا علة قوله في الآية السابقة إن كلامه هو الذي يدين، لأن كلامه كلام الله نفسه.
لَكِنَّ الآبَ الَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ أَعْطَانِي وَصِيَّةً انظر شرح يوحنا ١٠: ٨. إن الذين رفضوا كلام المسيح كأنهم رفضوا كلام الله لا كلام إنسان أو نبي. وليس في ذلك ما يشين لاهوت المسيح أو يدل على عدم مساواته للآب، لأن المسيح تكلم هنا بمنزلة فادٍ ووسيط رضي بمقتضى عهد الفداء أن يكون «رسولاً يأخذ وصية من الآب».
مَاذَا أَقُولُ وَبِمَاذَا أَتَكَلَّمُ أي المعنى وكيفية التعبير عنه.
٥٠ «وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ وَصِيَّتَهُ هِيَ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ. فَمَا أَتَكَلَّمُ أَنَا بِهِ، فَكَمَا قَالَ لِي الآبُ هَكَذَا أَتَكَلَّمُ».
وَأَنَا أَعْلَمُ علماً ذاتياً وعلماً اختبارياً من مشاهدة نتائج تأثير وصية الآب.
أَنَّ وَصِيَّتَهُ هِيَ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ وصية الله في كتابه المقدس وهي جوهر الدين المسيحي، وعُبر عنها «بالحياة الأبدية» لأنها مصدر تلك الحياة لكل من يقبلها ويطيعها، وأن غايتها إرشاد الناس إليها بإعلان حقيقتها ووسائط تحصيلها. فكما أن الكتب العلمية تبين شرائع عالم المادة يبين كتاب الله شرائع عالم الروح. وهذا كقول بطرس «إِلَى مَنْ نَذْهَبُ؟ كلامُ الحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ عِنْدَكَ» (يوحنا ٦: ٦٨). وقول المسيح نفسه «ٱلكلامُ الَّذِي أُكَلِّمُكُمْ بِهِ هُوَ رُوحٌ وَحَيَاةٌ» (يوحنا ٦: ٦٣ و١يوحنا ٣: ٢٢). وما قيل يبين اجتهاد المسيح في حثّ الناس على فهم كلامه وطاعته، لأن حياتهم الأبدية متوقفة عليه. ولذلك نادى به حتى وهو معرَّض للهزء والاضطهاد وخطر الموت. فيجب على المبشرين الآن أن يكونوا أمناء في تعليم الناس بكل مشورة الله، وعلى كل مسيحي أن يكون كذلك لرفاقه وجيرانه.
فَكَمَا قَالَ لِي الآبُ سبق تفسير هذا في يوحنا ٧: ١٦ - ١٩ وخلاصة معنى هذه الآية مثل ما في يوحنا ١: ١ وهو أن المسيح كلمة الله. فاليهود الذين رفضوا كلام المسيح إنما رفضوا كلام إله آبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
هذا نهاية ما ذكره يوحنا من تعليم المسيح للناس عموماً، وكان ذلك يوم الثلاثاء الثاني عشر من أبريل نيسان. ثم رجع إلى بيت عنيا وقضى هناك ليلتين ويوم الأربعاء كله، وأتى إلى أورشليم يوم الخميس بعد الظهر ليأكل الفصح مع تلاميذه.
وما سيأتي من التعليم هو ما خاطبهم به يسوع وهو متكئ معهم للعشاء.
الأصحاح الثالث عشر
غسل المسيح أرجل الرسل (ع ١ - ١٧)
١ «أَمَّا يَسُوعُ قَبْلَ عِيدِ الفِصْحِ، وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّ سَاعَتَهُ قَدْ جَاءَتْ لِيَنْتَقِلَ مِنْ هَذَا العَالَمِ إِلَى الآبِ، إِذْ كَانَ قَدْ أَحَبَّ خَاصَّتَهُ الَّذِينَ فِي العَالَمِ، أَحَبَّهُمْ إِلَى المُنْتَهَى».
متّى ٢٦: ٢ ويوحنا ١٢: ٢٣ و١٧: ١، ١١
لم يذكر يوحنا رسم العشاء الرباني الذي ذكره سائر الإنجيليين، ولعل سببه أنه كان معروفاً وقد مارسته الكنيسة نحو أربعين سنة أو خمسين سنة قبل أن يكتب يوحنا بشارته. ولكنه هو وحده ذكر كلمات يسوع الأخيرة للرسل (يوحنا ١٣ - ١٦) وصلاته الشفاعية (يوحنا ١٧).
قَبْلَ عِيدِ الفِصْحِ في مساء يوم الخميس في أول يوم الجمعة الخامس عشر من أبريل نيسان. وقصد بقوله «قبل» الوقت ما بين استعدادهم وأكلهم الفصح وهم على وشك أن يبدأوا في أكله كما يظهر من ع ٢. وقد مرَّ الكلام على الفصح (في شرح متّى ٢٦: ٢، ١٧). وذكر كل البشيرين أن موت المسيح كان في أيام الفصح. وعيّن الله أن يكون ذلك لأمرين: (١) أن خروف الفصح كان يرمز للمسيح. (٢) اشتهار صلبه بذلك، فقد شاهدته جموع كثيرة وأشاعوا أمره في كل الأرض. وحدث موته حينئذ على خلاف قصد رؤساء اليهود، بدليل قولهم «ليس في العيد» (مرقس ١٤: ٢).
وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّ سَاعَتَهُ قَدْ جَاءَتْ أي الساعة التي عيّنها الله لموته (يوحنا ١٢: ٢٧)، وكان قد قال مراراً إن ساعته لم تأتِ بعد (يوحنا ٢: ٤ و٧: ٦ و١١: ٩) وحقق الآن أنها قد أتت. ولا يعلن الله للناس وقت موتهم شفقة عليهم، ولكن يسوع عرف وقت موته ونوعه، فزادت معرفته ذلك الموت مرارة.
لِيَنْتَقِلَ مِنْ هَذَا العَالَمِ إِلَى الآبِ عبّر المسيح عن الموت هنا بالانتقال، كأنه سفر من مكان إلى مكان آخر، لأن موته كان رجوعاً إلى بيت أبيه بعد إكماله العمل الذي لأجله أتى إلى هذه الأرض. والموت للمؤمن بالمسيح ذهاب إلى وطنه الأبدي في بيت أبيه السماوي، فهو مدخل الحياة الأبدية.
إِذْ كَانَ قَدْ أَحَبَّ خَاصَّتَهُ قدَّم المسيح براهين كثيرة على حبه لتلاميذه في ثلاث سنين ونصف سنة قضاها معهم، ودعاهم ورثة الحياة الأبدية، و «خاصته» إعلاناً لمحبته الخاصة لهم، وأن الآب أعطاهم له، وقد تبعوه تاركين كل شيء لأجله (يوحنا ١: ١١، ١٢).
أَحَبَّهُمْ إِلَى المُنْتَهَى المنتهى هنا: إما نهاية الوقت، أو غاية المقدار. فيكون المعنى الأول أنه لا يزال يُظهر حبه لهم إلى آخر ساعة من حياته على الأرض، وبرهان ذلك أنه قبل موته بأقل من ٢٤ ساعة غسل أرجلهم. وهذا دليل على أن حبه لم يفتر ولو في انتظاره الموت السريع وأنهم جميعاً سيتركونه ويهربون.. ويكون المعنى على الثاني أنه أحبهم الحب الكامل، وبرهان ذلك ما ذُكر هنا. وما قيل هنا في محبته لرسله «إلى المنتهى» يُقال أيضاً في محبته للمؤمنين به الآن، لأنه «هُوَ هُوَ أَمْساً وَاليَوْمَ وَإِلَى الأَبَدِ» (عبرانيين ١٣: ٨).
٢ «فَحِينَ كَانَ العَشَاءُ، وَقَدْ أَلقَى الشَّيْطَانُ فِي قَلبِ يَهُوذَا سِمْعَانَ الإِسْخَرْيُوطِيِّ أَنْ يُسَلِّمَهُ».
لوقا ٢٢: ٣ وع ٢٧
فَحِينَ كَانَ العَشَاءُ أي عشاء الفصح (لا العشاء الرباني) وقت ما أُعد وقد اتكأوا للأكل، لكنهم لم يكلموه (ع ١٢). ومن قوله «واتكأ أيضاً» ومن ع ٢٦ أيضاً، حيث ذكر أن المسيح أعطى يهوذا اللقمة.
أَلقَى الشَّيْطَانُ فِي قَلبِ يَهُوذَا أي حركه ليتمم قصده وهو تسليم سيده يسوع حسبما وعد الرؤساء (متّى ٢٦: ١٤). ولا يلزم مما قيل هنا أن هذه أول مرة دخل الشيطان قلب يهوذا، لأن المسيح قال قبل ذلك بمدة ليست بقصيرة «أَلَيْسَ أَنِّي أَنَا اخْتَرْتُكُمْ، الاثْنَيْ عَشَرَ؟ وَوَاحِدٌ مِنْكُمْ شَيْطَانٌ!» (يوحنا ٦: ٧٠ ،٧١). لا يستطيع الشيطان أن يخدع الإنسان بفعل الشر إلا إن كان في القلب شهوة رديئة. والأرجح أن الشر في قلب يهوذا سهل على الشيطان تحريكه ليرتكب أفظع الشرور وهو الطمع أو حب المال. ومعنى قوله «ألقى الشيطان» أن الشيطان يطرح في قلوب الناس بزور الشرور، ويسمح لها الأشرار أن تتأصل فيهم وتنمو وتأتي بأثمارها التي هي أفعالهم الشريرة.
سِمْعَانَ الإِسْخَرْيُوطِيِّ (انظر شرح متّى ١٠: ٤). ونُسب هنا إلى سمعان تمييزاً له عن يهوذا بن حلفي.
أَنْ يُسَلِّمَهُ (انظر شرح متّى ٢٦: ١٤ - ١٦). ذكر هذا بياناً لفرط المحبة التي أظهرها المسيح لتلاميذه بغسله أرجلهم، مع أن واحداً منهم خائن. ذُكر في الآيتين ٢، ٣ ثلاثة أمور هي كمقدمة لسائر الأصحاح: (١) أن يسوع وتلاميذه كانوا وقتئذ متكئين يتعشون. (٢) قصد يهوذا الشرير تسليم يسوع. (٣) معرفة يسوع الكاملة بما سيحدث.
٣ «يَسُوعُ وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّ الآبَ قَدْ دَفَعَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَى يَدَيْهِ، وَأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَرَجَ، وَإِلَى اللَّهِ يَمْضِي».
متّى ١١: ٢٧ و٢٨: ١٨ ويوحنا ٣: ٣٥ و١٧: ٢ وأعمال ٢: ٢٦ و ١كورنثوس ١٥: ٢٧ وعبرانيين ٢: ٨ ويوحنا ٨: ٤٢ و١٦: ٢٨
يَسُوعُ وَهُوَ عَالِمٌ من العلاقة لذكر علم المسيح بذكر غسله أرجل التلاميذ بيان ما في علمه من التنازل العجيب والتواضع الغريب ووفرة محبته لتلاميذه، فإنه خدمهم خدمة لا يتنازل إليها إلا أدنى العبيد، مع كل علمه وشعوره بأصله الإلهي ومجد نفسه ووقارها وسمو وظيفته الملكية التي هو على وشك تحقيقها. ومن تلك العلاقة أن المسيح وهو عالم بانتقاله أراد أن يترك لتلاميذه علامة خاصة لحبه لهم قبل أن يفارقهم.
دَفَعَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَى يَدَيْهِ انظر شرح متّى ٢٨: ١٨.
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَرَجَ انظر شرح يوحنا ٨: ٤٢.
وَإِلَى اللَّهِ يَمْضِي أي يرجع إلى السماء (يوحنا ٦: ٦١، ٦٢). أتي المسيح من عند الله الذي لم يتركه، ومضى إلى الله ولكنه لم يتركنا.
٤ «قَامَ عَنِ العَشَاءِ، وَخَلَعَ ثِيَابَهُ، وَأَخَذَ مِنْشَفَةً وَاتَّزَرَ بِهَا».
لوقا ٢٢: ٢٧ وفيلبي ٢: ٧، ٨
مرَّ الكلام على ماهية الاتكاء على المائدة في شرح متّى ٢٣: ٦.
وَخَلَعَ ثِيَابَهُ أي الخارجية من رداء ونحوه.
وَاتَّزَرَ بِهَا أي تمنطق بجانب منها وأرسل الباقي إلى رجليه. كل ما ذُكر هنا من الأعمال هو مما اعتاده الخدم في خدمتهم.
٥ «ثُمَّ صَبَّ مَاءً فِي مِغْسَلٍ، وَابْتَدَأَ يَغْسِلُ أَرْجُلَ التّلامِيذِ وَيَمْسَحُهَا بِالمِنْشَفَةِ الَّتِي كَانَ مُتَّزِراً بِهَا».
ثُمَّ صَبَّ مَاءً فِي مِغْسَلٍ كان الماء والمغسل موجودين حسب سُنة اليهود في التطهير. وكانوا يغتسلون بصب الماء.
وَابْتَدَأَ يَغْسِلُ أَرْجُلَ التّلامِيذِ هذا عمل مختص بالعبيد (١صموئيل ٢٥: ٤١). وكان نوع الاتكاء على المائدة مما سهل على يسوع غسل أقدام التلاميذ.
٦ «فَجَاءَ إِلَى سِمْعَانَ بُطْرُسَ. فَقَالَ لَهُ ذَاكَ: يَا سَيِّدُ، أَنْتَ تَغْسِلُ رِجْلَيَّ!».
متّى ٣: ١٤
لا شك أن كل التلاميذ خجلوا وتعجبوا مما فعله سيدهم من خدمته لهم، ولكن لم يجسر أحد أن يعترضه سوى بطرس عندما دنا منه ليغسل رجليه، لأنه كان صريحاً لا يكتم شيئاً من أفكاره.
أَنْتَ تَغْسِلُ رِجْلَيَّ قال ذلك إظهاراً لتعجبه وعدم استحسانه ذلك الغسل. ومعناه: هل يليق أنك أنت ابن الله تغسل رجليَّ أنا الإنسان الخاطئ؟ ومثل هذه الهيبة حمله على أن يقول للمسيح حين صنع معجزة صيد السمك: «اخْرُجْ مِنْ سَفِينَتِي يَا رَبُّ، لأنِّي رَجُلٌ خَاطِئٌ» (لوقا ٥: ٨). ومثلها جعل يوحنا المعمدان يمتنع من تعميد المسيح قائلاً «أَنَا مُحْتَاجٌ أَنْ أَعْتَمِدَ مِنْكَ، وَأَنْتَ تَأْتِي إِلَيَّ» (متّى ٣: ١٤). وفي قول بطرس تلميح إلى أن يسوع لا يعلم أن عمله مما لا يليق به، وأنه لا يليق أن اليدين اللتين فتحتا عيون العمي وشفتا المرضى وأقامتا الموتى تتنازلان إلى غسل رجليّ خاطئ.
وفي اعتراض بطرس هذا بعض ما يستحق المدح، من الإحساس بالتواضع وإكرام المسيح والمحبة له. وفيه بعض ما يستحق الذم، وهو أنه يقدم النصح للمسيح!
٧ «أَجَابَ يَسُوعُ: لَسْتَ تَعْلَمُ أَنْتَ الآنَ مَا أَنَا أَصْنَعُ، وَلَكِنَّكَ سَتَفْهَمُ فِيمَا بَعْدُ».
ع ١٢
لَسْتَ تَعْلَمُ أَنْتَ الآنَ مَا أَنَا أَصْنَعُ كأنه قال: يا بطرس ظننتني جاهلاً بما فعلته، وأنت الجاهل لا أنا. وفي هذا توبيخ لبطرس إذ نظر إلى العمل دون المقصود منه.
وَلَكِنَّكَ سَتَفْهَمُ فِيمَا بَعْدُ أشار بذلك إلى بيان بعض قصده من الغسل (ع ١٣ - ١٧) وهو تقديم مثل للتواضع والمحبة في الخدمة التي يجب أن يُظهرها تلاميذه لبعضهم. وأشار به أيضاً إلى معنى الغسل الرمزي، وهو تطهير نفس بطرس بدم المسيح (ع ٩، ١٠). وكل ما فعله المسيح من الأعمال حينئذ رمز إلى ما فعله حباً للبشر، إذ خلع عنه مجده السماوي، وترك عرشه هناك، وصار في صورة عبد ليطهرهم من كل خطية. وأسلوب الكلام هنا كأسلوب الكلام في قول الرسول «فَإِنَّنَا نَنْظُرُ الآنَ فِي مِرْآةٍ فِي لُغْزٍ، لَكِنْ حِينَئِذٍ وَجْهاً لِوَجْهٍ» (١كورنثوس ١٣: ١٢).
وكثيراً ما تظهر لنا معاملات الله في هذا العالم ألغازاً فيخيِّب رجاءنا ويسمح لنا بالضيقات ويأخذ منا الصحة والمال والأقربين والأصدقاء، ولا نعلم علّة ذلك، ولكننا سنفهم فيما بعد في السماء، فيجب أن نسلم بأحكام الله بلا شك ولا تذمر.
٨ «قَالَ لَهُ بُطْرُسُ: لَنْ تَغْسِلَ رِجْلَيَّ أَبَداً! أَجَابَهُ يَسُوعُ: إِنْ كُنْتُ لا أَغْسِلُكَ فَلَيْسَ لَكَ مَعِي نَصِيبٌ».
يوحنا ٣: ٥ و١كورنثوس ٦: ١١ وأفسس ٥: ٢٦ وتيطس ٣: ٥ وعبرانيين ١٠: ٢٢
لم يُرد بطرس أن يصبر على المسيح حتى يبيّن له الدافع على عمله، فأبى أن يسمح له بغسل رجليه ما لم يعلم قصده من ذلك. نعم إنه قصد إظهار الاحترام للمسيح بما فعل، لكنه أخطأ لأنه كان يجب أن يطيع.
إِنْ كُنْتُ لا أَغْسِلُكَ كأن المسيح قال لبطرس: إن لم تخضع لي في هذا الأمر فلست من تلاميذي، لأن التلميذ الحقيقي يخضع لمشيئة سيده حتى لو لم يعرف قصده. فما فعلته ليس تواضعاً صحيحاً بل شبه تواضع.
وقد اعتاد يسوع أن يشير إلى الروحيات بالجسديات، ولذلك أشار بالغسل المذكور إلى التطهير الروحي، وأراد أن يعلّم بطرس أنه يجب أن يغسله ويطهره ليكون له معه نصيب. واستُعير الغسل لهذا المعنى في ١كورنثوس ٦: ١١ وتيطس ٣: ٥، ٦. والمعمودية إشارة إلى ذلك التطهير.
فَلَيْسَ لَكَ مَعِي نَصِيبٌ أي شركة في محبتي وملكوتي ومجدي. وعظمة ذلك النصيب تظهر مما قيل في يوحنا ١٧: ٢٢ - ٢٦ ورؤيا ٢٠: ٦. ولنا في هذه الآية ثلاث فوائد: (١) أنه لا خلاص لأحد ما لم يتطهَّر من خطاياه بدم المسيح. فالذي يريد أن يستحق الخلاص بأعماله الصالحة يفشل، لأن شرط الخلاص هو التطهير بدم المسيح مجاناً. (٢) إنّ التطهير بالماء ولو بيد المسيح نفسه غير كافٍ، فقد غسل المسيح يهوذا ومع ذلك هلك. (٣) الذي خلَّصنا هو تنازل يسوع إلى مقام العبد لا رياسته الملكية، فعلينا أن نقبل الخلاص بأنه وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب.
٩ «قَالَ لَهُ سِمْعَانُ بُطْرُسُ: يَا سَيِّدُ، لَيْسَ رِجْلَيَّ فَقَطْ بَل أَيْضاً يَدَيَّ وَرَأْسِي».
لم يدرك بطرس قصد المسيح تمام الإدراك، لكنه فهم منه أن مشاركته للمسيح تتوقف على قبوله لأن يغسله، فرضي بل رغب فيه، ليس إلى الحد الذي عرضه عليه المسيح بل إلى ما هو أكثر! وأظهر بهذا محبة وغيرة وافرة ومعرفة قليلة. ولعله أدرك بعض المعنى الروحي من كلمات المسيح، وأحب أن يطهّره المسيح تطهيراً كاملاً. وكل مسيحي حقيقي يود أن يقدس المسيح عقله ومشيئته وعواطفه وذاكرته، وأن تكون كل قوات جسده وروحه مقدسة لله (٢كورنثوس ١٠: ٥ و١تسالونيكي ٥: ٢٣).
١٠ «قَالَ لَهُ يَسُوعُ: الَّذِي قَدِ اغْتَسَلَ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إلا إِلَى غَسْلِ رِجْلَيْهِ، بَل هُوَ طَاهِرٌ كُلُّهُ. وَأَنْتُمْ طَاهِرُونَ وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّكُمْ».
يوحنا ١٥: ٣
الذي يغتسل في الحمام العام بعد أن يرجع إلى بيته لا يحتاج إلا لأن يغسل رجليه بسبب غبار الطريق. وما قاله بطرس في ع ٩ يتضمن أنه لم يحصل على شيء من التطهير، فيحتاج إلى التجديد من أصله. وما قاله المسيح هنا أن الأمر ليس كما قال بطرس، بل إنه وسائر الرسل قد تطهروا بقوته وبتعليمه، حسب قوله «أَنْتُمُ الآنَ أَنْقِيَاءُ لِسَبَبِ الكلامِ الَّذِي كَلَّمْتُكُمْ بِهِ» (يوحنا ١٥: ٣). فالله غفر لهم خطاياهم، وبررهم أمامه، وذلك لا يغنيهم عن وجوب طلب المغفرة اليومية والتطهير على الدوام من الخطايا التي يرتكبونها يوماً فيوماً، كما صلى داود «اغْسِلنِي كَثِيراً مِنْ إِثْمِي وَمِنْ خَطِيَّتِي طَهِّرْنِي» (مزمور ٥١: ٢). (راجع أعمال ١٥: ٨، ٩ و٢كورنثوس ٧: ١ ويعقوب ١: ٢١ و١يوحنا ١: ٨، ٩).
الَّذِي قَدِ اغْتَسَلَ أي تحرر من الخطية باعتبارها سائدة، وتطهَّر من دنسها ونال المغفرة. ويكون ذلك عند تجديد القلب.
إلا إِلَى غَسْلِ رِجْلَيْهِ المراد بذلك التطهير من خطايا خاصة يرتكبها الإنسان بعد التوبة والتجديد. والغسل الأول هو التبرير، ويكون دفعة واحدة، والغسل الثاني هو التقديس ويكون تدريجياً إلى أن يكمل في السماء. وأشار المسيح إلى كل منهما (يوحنا ١٥: ٢، ٣) بقوله في الغسل الأول «أنتم الآن أنقياء» وبقوله في الثاني «كل ما يأتي بثمر ينقيه».
رأى بعض المفسرين أن التطهير المشار إليه هنا يكون بالتعليم، وأن ما سبق منه كان كافياً إلا قليلاً، فاحتاج التلاميذ إلى مثال واحد أيضاً، وهو ما فعله من غسل أرجلهم ليعلمهم التواضع ووجوب القيام بالخدمة.
وَأَنْتُمْ طَاهِرُونَ أي متبررون ومغفورة لكم خطاياكم. والطهارة هنا طهارة قلب التلاميذ ومقاصدهم وغاياتهم، فصاروا بها ذبيحة مرضية لله كالذبائح الطاهرة في العهد القديم.
وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّكُمْ الذي استثناه من ذلك واحد ممن علَّمهم، ولكنه لم يستفد شيئاً من التعليم ولا تطهر قلبه بكلام الرب ونعمته، ولم يتحرر من الخطية بل ظل متدنِّساً بها. وفي قول المسيح هنا تنبيه ليهوذا، وبيان أنه مستعد لغسل قلبه كغسل رجليه.
١١ «لأنَّهُ عَرَفَ مُسَلِّمَهُ، لِذَلِكَ قَالَ: لَسْتُمْ كُلُّكُمْ طَاهِرِينَ».
يوحنا ٦: ٦٤
هذا تفسير يوحنا أبان به أن المسيح قصد بكلامه يهوذا مسلمه (انظر شرح متّى ٢٦: ٤٨ ويوحنا ١٨: ٢)
١٢ «فَلَمَّا كَانَ قَدْ غَسَلَ أَرْجُلَهُمْ وَأَخَذَ ثِيَابَهُ وَاتَّكَأَ أَيْضاً، قَالَ لَهُمْ: أَتَفْهَمُونَ مَا قَدْ صَنَعْتُ بِكُمْ؟».
فَلَمَّا كَانَ قَدْ غَسَلَ الظاهر أنه أكمل الغسل ولم يعترضه أحد ثانية.
وَاتَّكَأَ أَيْضاً على المائدة. وهذا يدل على أنهم لم يكونوا قد تعشوا.
أَتَفْهَمُونَ الخ الأرجح أنهم سكتوا وعجبوا ولم يفهموا.
١٣ «أَنْتُمْ تَدْعُونَنِي مُعَلِّماً وَسَيِّداً، وَحَسَناً تَقُولُونَ، لأنِّي أَنَا كَذَلِكَ».
متّى ٢٣: ٨ ، ١٠ ولوقا ٦: ٤٦ و ١كورنثوس ٨: ٦ و١٢: ٣ وفيلبي ٢: ١١
تَدْعُونَنِي مُعَلِّماً وَسَيِّداً هذه علاقته بهم، فيجب أن يسلكوا على مثاله ويطيعوا وصيته.
أَنَا كَذَلِك (متّى ٢٣: ٨، ١٠). ذكر المسيح ذلك بياناً للتلاميذ أنه لم ينس بغسله أرجلهم سموه عليهم في طبيعته ووظيفته، ولم يتخل عن ذلك.
١٤ «فَإِنْ كُنْتُ وَأَنَا السَّيِّدُ وَالمُعَلِّمُ قَدْ غَسَلتُ أَرْجُلَكُمْ، فَأَنْتُمْ يَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَغْسِلَ بَعْضُكُمْ أَرْجُلَ بَعْضٍ».
لوقا ٢٢: ٢٧ رومية ١٢: ١٠ وغلاطية ٦: ١، ٢ و١بطرس ٥: ٥
فَإِنْ كُنْتُ وَأَنَا أراد بذلك أنه إذا تنازل رب المجد إلى خدمة الناس بهذا الأسلوب، وجب على الناس أن يخدموا بعضهم بعضاً ليظهروا محبتهم.
يَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَغْسِلَ يجب إظهار التواضع وإنكار الذات في سبيل نفع الغير، فلا يجوز أن يتكبروا ويطلبوا السبق والشرف والسلطة، بل يجب أن يكونوا مستعدين لخدمة بعضهم بعضاً. وذلك مما يجب على المسيحيين عامة، ولا سيما خدام الإنجيل في كل عصر لأنهم قدوة لجميع الناس. وهذا لا يستلزم أن غسل الأرجل فرض دائم في الكنيسة كالعشاء الرباني، لأن الإنجيل لم يأمر بممارسته، كما أن الكنيسة في العصور الأولى لم تمارسه. ولو كان المسيح قد أمر به ما أهملته الكنيسة. ولكن غسل الأرجل كان شائعاً بين اليهود من واجبات الضيافة، وذُكر على هذا السبيل في ١تيموثاوس ٥: ١٠.
١٥ «لأنِّي أَعْطَيْتُكُمْ مِثَالا، حَتَّى كَمَا صَنَعْتُ أَنَا بِكُمْ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ أَيْضاً».
متّى ١١: ٢٩ وفيلبي ٢: ٥ و١بطرس ٢: ٢١ و١يوحنا ٢: ٦
أَعْطَيْتُكُمْ مِثَالا أي علمهم بما فعله وجوب التواضع والخدمة، وذلك أن رب السماوات والأرض اتخذ منزلة خادم الخدام. وفي ما أتاه توبيخ للراغبين في الرئاسة والمتخاصمين عليها. فيجب أن نتواضع قلبياً، لأنه يمكننا أن نغسل أرجل غيرنا ونحن في كبرياء.
كانت خدمة المسيح للناس غاية كل حياته على الأرض، فيجب أن تكون خدمة إخوتنا البشر غاية كل حياتنا أيضاً. وكما أن المسيح لم يحسب تلك الخدمة عاراً بل مجداً، كذلك يجب أن نحسبها نحن.
١٦ «اَلحَقَّ الحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَعْظَمَ مِنْ سَيِّدِهِ، ولا رَسُولٌ أَعْظَمَ مِنْ مُرْسِلِهِ».
متّى ١٠: ٢٤ ولوقا ٦: ٤٠ ويوحنا ١٥: ٢٠
هذا قانون عام يصدق عليهم، فهم ليسوا أعظم من المسيح. فلا يأنف التلميذ مما رضيه المعلم، ولا يتوقع أن يعامله الناس بأحسن مما عاملوا معلمه به.
اَلحَقَّ الحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ انظر شرح متّى ١٠: ٢٤، ٢٥. هذا بيان لأهمية الكلام بعده، ودليل على معرفة المسيح أن التلاميذ في خطر الوقوع في الكبرياء الروحية، ولذلك قاله هنا وكرره في يوحنا ١٥: ٢٠. لقد عرف التلاميذ أن يسوع على وشك أن ينشئ ملكوتاً، فاشتهوا أعظم المناصب فيه، فعلمهم بغسله أرجلهم أن العظمة الحقيقية في ملكوته لمن هو أكثر تواضعاً ونفعاً.
١٧ «إِنْ عَلِمْتُمْ هَذَا فَطُوبَاكُمْ إِنْ عَمِلتُمُوهُ».
يعقوب ١: ٢٥
لعل التلاميذ قالوا في أنفسهم: سمعنا هذا قبلاً وعرفناه، فقال يسوع ما معناه إن العلم وحده لا يكفي، إنما يجب أن يمارس الإنسان ما يعرفه، ومن لا يعمل يخطئ ويُدان. والغبطة لمن يعلّم ويعمل. وقوله إن «علمتم هذا» يدل على أن في إدراكه شيئاً من الصعوبة، وذلك يستلزم أن المسيح لم يقصد بما فعله مجرد الغسل الظاهر، لأن إدراكه سهل جداً. فبقي أنه قصد به الخدمة بالتواضع. فطوبى لمن شغلوا زمن حياتهم بأعمال تشبه أعمال «الذي أتى ليس ليُخدم بل ليَخدم» (متّى ٢٠: ٢٨).
إنباؤه بخيانة يهوذا (ع ١٨ - ٣٠)
١٨ «لَسْتُ أَقُولُ عَنْ جَمِيعِكُمْ. أَنَا أَعْلَمُ الَّذِينَ اخْتَرْتُهُمْ. لَكِنْ لِيَتِمَّ الكِتَابُ: اَلَّذِي يَأْكُلُ مَعِي الخُبْزَ رَفَعَ عَلَيَّ عَقِبَهُ».
مزمور ٤١: ٩ ومتّى ٢٦: ٢٣، ٣١
لَسْتُ أَقُولُ عَنْ جَمِيعِكُمْ أي لستم كلكم مغسولين قلباً ومطوّبين.
الَّذِينَ اخْتَرْتُهُمْ تلاميذ لي ليكونوا أنقياء القلب وورثة الحياة الأبدية. ويترتب على ذلك أن واحداً منهم (هو يهوذا) يختلف عن الأحد عشر الباقين. وهذا لا يناقض قوله «أَلَيْسَ أَنِّي أَنَا اخْتَرْتُكُمْ، الاثْنَيْ عَشَرَ؟» (يوحنا ٦: ٧٠) لأن الاختيار هنا للتلمذة الحقيقية الأبدية، وهناك للوظيفة الرسولية الوقتية.
لَكِنْ لِيَتِمَّ الكِتَابُ أي النبوة في مزمور ٤١: ٩. ولم تكن علة هلاك يهوذا هذه النبوة، بل خيانته. وعلة خيانته حبه المال. وكانت الخيانة على وفق تلك النبوة.
اَلَّذِي يَأْكُلُ مَعِي الخُبْزَ رَفَعَ عَلَيَّ عَقِبَهُ قيل هذا أولاً على معاملة أخيتوفل لداود (٢صموئيل ١٥: ٣١ و١٦: ٢٣). وصحَّ على معاملة من هو أشر من أخيتوفل لمن هو أعظم وأقدس من داود. فكانت خيانة أخيتوفل رمزاً لخيانة يهوذا. ويُحسب أكل الناس الخبز معاً علامة صداقة وعهد (تكوين ٤٣: ٣٢ و٢صموئيل ٩: ١١ ومتّى ٩: ١١). ورفع العقب استعارة للشروع في الإضرار المباغت ممن يُنتظر منه النفع، تشبيهاً له برفس البغل أو الفرس لصاحبه وهو يطعمه.
١٩ «أَقُولُ لَكُمُ الآنَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ، حَتَّى مَتَى كَانَ تُؤْمِنُونَ أَنِّي أَنَا هُوَ».
يوحنا ١٤: ٢٩ و١٦: ٤
قَبْلَ أَنْ يَكُونَ ما أنبأت به من خيانة يهوذا.
حَتَّى مَتَى كَانَ تسليمه إيّاي.
تُؤْمِنُونَ هذا لا يعني أنهم لم يؤمنوا به، بل لدفع الشك الذي يطرأ على قلوبهم من تسليم يهوذا إيّاه كأنه مجرد إنسان ضعيف يمكن أن يُخدع.
أَنِّي أَنَا هُوَ أني المسيح كما أعلنت لكم، فأنا نبي أعرف ما يكون في المستقبل، وأن تسليم يهوذا إيّاي لم يقع لعدم معرفتي به، أو لعجزي عن منعه. فهو يشجع الرسل الأحد عشر ويقوي إيمانهم، وهذا لا يمنع من أن تكون غايته أيضاً تنبيه ضمير يهوذا ليعدل عما قصده من الشر. وقد مر الكلام على قوله «أنا هو» في شرح يوحنا ٨: ٥٨.
٢٠ «اَلحَقَّ الحَقَّ أَقُولُ لَكُمُ: الَّذِي يَقْبَلُ مَنْ أُرْسِلُهُ يَقْبَلُنِي، وَالَّذِي يَقْبَلُنِي يَقْبَلُ الَّذِي أَرْسَلَنِي».
متّى ١٠: ٤٠ و٢٥: ٤٠ ولوقا ١٠: ١٦
هذا كقوله للتلاميذ حين عينهم رسلاً (انظر شرح متّى ١٠: ٢٠). ولعله كرره الآن بياناً لشدة الاتحاد بين الآب والمسيح والرسل وكل الذين قبلوه. وأن الرسل كنواب عن الله، وأن الله يحسب كل تعد عليهم تعدياً عليه. وفي ذلك عزاء لهم زمن الاضطهاد. وكذلك حسبوه بعد إذ قيل «وَأَمَّا هُمْ فَذَهَبُوا فَرِحِينَ مِنْ أَمَامِ المَجْمَعِ، لأنَّهُمْ حُسِبُوا مُسْتَأْهِلِينَ أَنْ يُهَانُوا مِنْ أَجْلِ اسْمِهِ» (أعمال ٥: ٤١) وفيه أيضاً بيان فظاعة ما ارتكبه يهوذا بتسليمه يسوع، فإنه تعدى بذلك على الله نفسه وعلى كل جماعة المؤمنين.
٢١ «لَمَّا قَالَ يَسُوعُ هَذَا اضْطَرَبَ بِالرُّوحِ، وَشَهِدَ وَقَالَ: الحَقَّ الحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ وَاحِداً مِنْكُمْ سَيُسَلِّمُنِي».
متّى ٢٦: ٢١ ومرقس ١٤: ١٨ ولوقا ٢٢: ٢١ ويوحنا ١٢: ٢٧ وأعمال ١: ١٧ و١يوحنا ٢: ١٩
هَذَا أي ما سبق من إنبائه بتسليم أحد التلاميذ إيّاه. وورد ذكر النبوة بخيانة يهوذا في كل البشائر (متّى ٢٦: ٢١ - ٢٥ ومرقس ١٤: ١٨ - ٢١ ولوقا ٢٢: ٢١ - ٢٣). راجع شرح بشارة متّى. ولم يذكر يوحنا ما ذكره متّى من أن يهوذا سأل المسيح «هل أنا هو؟» وأن المسيح أجابه «أنت قلت». وذكر ما لم يذكره غيره من الإنجيليين، وهو أن يهوذا خرج من بينهم بعدما أخذ اللقمة ولم يعلم أحد منهم ذلك.
اضْطَرَبَ بِالرُّوحِ (يوحنا ١١: ٣٣ و٢: ٢٧). علة هذا الاضطراب تأمله في خيانة يهوذا التي شرع في الكلام عليها وما فيها من الكفر بالنعمة وسماع التعليم باطلاً، وإضرار للخائن نفسه، وفظاعة خطيته التي جعلت طبيعة المسيح المقدسة تقشعر من التأمل فيها وقرب الخائن منه.
علم المسيح أن كل التلاميذ سيتركونه في تلك الليلة ويهربون، وأن أحدهم ينكره بحلف وأقسام. لكنه لم يضطرب من التأمل في ذلك كما اضطرب من التأمل في خيانة يهوذا، لأن إثمه أعظم، وهو الوحيد بين تلاميذه الذي لم يسأل المغفرة فهلك في خطيته.
الحَقَّ الحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ هذا بيان لصدق الكلام مع ظهوره للتلاميذ بعيداً عن الاحتمال.
إِنَّ وَاحِداً مِنْكُمْ سَيُسَلِّمُنِي ذكر قبلاً أنه يُسلَّم (متّى ١٧: ٢٢ و٢٠: ١٨ و٢٦: ٢). وأخبرهم هنا أول مرة بأن المسلِّم واحد منهم.
٢٢ «فَكَانَ التّلامِيذُ يَنْظُرُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَهُمْ مُحْتَارُونَ فِي مَنْ قَالَ عَنْهُ».
يَنْظُرُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ كان أول تأثير لكلام المسيح سكوت التلاميذ من الدهشة، ونظر بعضهم إلى بعض علامة الحيرة، وتوقعهم أن الجاني لا بد أن تظهر على وجهه إمارات الخزي والخجل لظهور شره.
وَهُمْ مُحْتَارُونَ الخ لم يشكوا في أن واحداً منهم سيسلمه، إنما احتاروا في أي منهم يقدم على هذه الجناية الفظيعة. وبعد أن سكتوا وقتاً ونظر كل إلى غيره «ابْتَدَأُوا يَتَسَاءَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: مَنْ تَرَى مِنْهُمْ هُوَ المُزْمِعُ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا؟» (لوقا ٢٢: ٢٣). وبعد هذا سأل كل واحد منهم يسوع «هل أنا هو يا رب؟» (متّى ٢٦: ٢٢ ومرقس ١٤: ١٩). ولم يتهم أحد منهم غيره إنما نفسه في الحال. ويهوذا نفسه فعل ذلك دفعاً للظن فيه، وسمع الجواب من المسيح سراً. ومن العجب أن يهوذا استطاع أن يكتم شره عن سائر التلاميذ في كل تلك المدة حتى لم يظن أحد منهم أنه مراءٍ.
٢٣ «وَكَانَ مُتَّكِئاً فِي حِضْنِ يَسُوعَ وَاحِدٌ مِنْ تلامِيذِهِ، كَانَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ».
يوحنا ١٩: ٢٦ و٢٠: ٢ و٢١: ٧، ٢٠، ٢٤
أمر موسى بني إسرائيل أن يأكلوا الفصح بعجلة وأحقاؤهم مشدودة وأحذيتهم في أرجلهم وعصيهم في أيديهم (خروج ١٢: ١١). وعدل رؤساء اليهود عن ذلك لرأيهم أن ذلك كان موافقاً لحال بني إسرائيل وهم يرحلون في البرية، وأنهم بعد ما استراحوا في أرض الميعاد لم تبقَ حاجة لهذا. وقد أخذوا الاتكاء عند الأكل عن البابليين وقت كانوا مسبيين في بابل، وكان ذلك من عادات اليونانيين والرومان. وسبق الكلام على كيفية ذلك الاتكاء في شرح متّى ٢٣: ٦ و٢٦: ٢٠. وفيه يكون الواحد متكئاً أمام الآخر مستنداً على يده اليسرى، وهو يأكل باليمنى، ورجلاه ممدودتان إلى الوراء. ويُستدل من القرينة أن يوحنا كان على يمين يسوع أمامه، أي تجاه حضنه. ولعل يهوذا كان على يساره، بدليل أنه كلمه سراً وهو على المائدة، وأنه ناوله اللقمة فتناولها.
كَانَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ لا ريب أن هذا المحبوب هو يوحنا الإنجيلي ولم يذكر اسمه تواضعاً، ولكنه أشار إلى نفسه بهذه العبارة خمس مرات في بشارته (يوحنا ١٣: ٢٣ و١٩: ٢٦ و٢٠: ٢ و٢١: ٧، ٢٠ - ٢٣). ولم يدّع بذلك الفضل على سائر التلاميذ بل أشار إلى تنازل يسوع إلى محبته وهو يشعر بعدم استحقاقه لتلك المحبة. ومما يثبت محبة المسيح الخاصة لهذا التلميذ أنه كان أحد الثلاثة الذين أدخلهم معه إلى مخدع ابنة يايرس يوم إقامتها من الموت، والذين شاهدوا تجليه على الجبل، والذين انفرد بهم في بستان جثسيماني، وأنه اتكأ على حضن المسيح في العشاء الأخير، وأن المسيح وكل إليه أمّه وهو على الصليب (متّى ١٧: ١ و٢٦: ٣٧ ويوحنا ١٣: ٢٣ و١٩: ٢٦، ٢٧). ولعل سبب ذلك أنه كان يشبه المسيح في الصفات أكثر من سواه من التلاميذ. وأعظم إكرام يمكن الإنسان نواله أن يحبه المسيح. واشتهر إبراهيم بمثل ذلك بأن سُمي «خليل الله» (٢أيام ٢٠: ٨ وإشعياء ٤١: ٨).
٢٤ «فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنْ يَسْأَلَ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ الَّذِي قَالَ عَنْهُ».
نستنتج من ذلك أن بطرس كان بعيداً عن المسيح حتى لم يستطع أن يسأله سراً، فأشار إلى يوحنا بوجهه أو بيده دون أن يراه أحد غيره إلى أن يسأل المسيح عمَّن يكون الخائن.
٢٥ «فَاتَّكَأَ ذَاكَ عَلَى صَدْرِ يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ: يَا سَيِّدُ، مَنْ هُوَ؟».
الاتكاء هنا في الأصل غير الاتكاء الذي ذُكر في ع ٢٣ فإن ذلك عام يشغل مدة العشاء، وهذا خاص وقتي، وهو ميل رأس يوحنا إلى أن يقرب من رأس يسوع ليستطيع أن يحادثه سراً.
٢٦ «أَجَابَ يَسُوعُ: هُوَ ذَاكَ الَّذِي أَغْمِسُ أَنَا اللُّقْمَةَ وَأُعْطِيهِ. فَغَمَسَ اللُّقْمَةَ وَأَعْطَاهَا لِيَهُوذَا سِمْعَانَ الإِسْخَرْيُوطِيِّ».
أبان المسيح ليوحنا المسؤول عنه بعلامة بدلاً من التصريح باسمه، ولم يفهم المقصود من تلك العلامة حينئذ سوى يوحنا.
الَّذِي أَغْمِسُ أَنَا اللُّقْمَةَ وَأُعْطِيهِ من عادة أهل الشرق قديماً وحديثاً أن رب البيت يكرم الضيف وهو على المائدة بأن يناوله بيده بعض اللقم. ويغلب ذلك في عيد الفصح، فإن رئيس المتكإ يأخذ لقمة خبزٍ أو لحم ويغمسها بخليط من تمر وزبيب ولوز في خل أو خمر ويعطيها لأحد المتكئين معه (انظر الكلام على الفصح في شرح متّى ٢٦: ٢). والأرجح أن المسيح أعطى مثل ذلك لغير يهوذا قبلاً، وكان على وشك أن يعطي يهوذا عندما سأله يوحنا فجعله له علامة معينة للمسؤول عنه.
لِيَهُوذَا سِمْعَانَ الخ انظر شرح يوحنا ٦: ٧١. إعطاء يسوع اللقمة ليهوذا كان آخر علامات محبة المسيح وصداقته ورحمته له، وهي كدعوة له للتوبة، فأخذ اللقمة بدون انسحاق قلب ولا تغيير، فأغلق دونه باب الرجاء إلى الأبد، وفتح قلبه للشيطان ليمكث فيه إلى النهاية.
٢٧ «فَبَعْدَ اللُّقْمَةِ دَخَلَهُ الشَّيْطَانُ. فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: مَا أَنْتَ تَعْمَلُهُ فَاعْمَلهُ بِأَكْثَرِ سُرْعَةٍ».
لوقا ٢٢: ٣ ويوحنا ٦: ٧٠
دَخَلَهُ الشَّيْطَانُ هذا علاوة على ما قيل في ع ٢ من أنه «قد ألقى الشيطان في قلب يهوذا». والمعنى أنه سلم نفسه للشيطان طوعاً واختياراً ليستخدمها كما شاء. وذكر لوقا أن الشيطان دخل يهوذا قبل ذلك (لوقا ٢٢: ٣). ولنا من هذا أن لدخول الشيطان وتسلطه على نفس الإنسان درجات متنوعة.
فَاعْمَلهُ بِأَكْثَرِ سُرْعَةٍ علم يسوع قصد يهوذا أنه أسلم نفسه إلى الشر، ورغب في الذهاب لأقل حجة. والمسيح أحب أن يتكلم بكل وضوح مع أصدقائه المخلصين، ولم يشأ أن يفعل ذلك أمام الخائن فأذن له في الذهاب. فكأنه قال: لا تكن مرائياً بعد. نفِّذ قصدك بتسليمي متى شئت فإني مستعد. فهذا الإذن يشبه إذن الله لبلعام في الذهاب مع رسل بالاق (عدد ٢٢: ٢٠) ويشبه قول المسيح للفريسيين (متّى ٢٣: ٣٢).
٢٨ «وَأَمَّا هَذَا فَلَمْ يَفْهَمْ أَحَدٌ مِنَ المُتَّكِئِينَ لِمَاذَا كَلَّمَهُ بِهِ».
لم يعلم أحد من التلاميذ يومئذ ما قصد يسوع بهذا الكلام. نعم إن يوحنا علم أن الخائن هو يهوذا، لكنه لم يعرف أن ما قاله يسوع متعلق بالخيانة.
٢٩ «لأنَّ قَوْماً، إِذْ كَانَ الصُّنْدُوقُ مَعَ يَهُوذَا، ظَنُّوا أَنَّ يَسُوعَ قَالَ لَهُ: اشْتَرِ مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلعِيدِ، أَوْ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئاً لِلفُقَرَاءِ».
يوحنا ١٢: ٦
الصُّنْدُوقُ مَعَ يَهُوذَا كان يهوذا أمين الصندوق في لجنة الرسل (انظر شرح يوحنا ١٢: ٦).
اشْتَرِ مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلعِيدِ كانت مدة العيد أسبوعاً، وكان لكل يوم من ذلك الأسبوع حاجات. ولعله كان يصعب قضاء الحاجات في تلك الأيام لازدحام الناس في أورشليم. ولا يستلزم هذا أنه لم يكن قد حضر الخامس عشر من نسيان، ولا يوم أكل خروف الفصح. والذي يقوي الظن أن ذلك كان ليلة الجمعة تفسير الرسل لكلام المسيح، فإنه يدل على أنهم فهموا من قول المسيح أنه أراد أن يشتري يهوذا ما يحتاجون إليه للعيد في يوم الجمعة بسرعة قبل أن يحضر السبت الذي لا يجوز فيه الشراء.
أَنْ يُعْطِيَ شَيْئاً لِلفُقَرَاءِ يتضح من ذلك أن المسيح وتلاميذه اعتادوا التوزيع على الفقراء، مع فقرهم. وكان من عادات اليهود في الأعياد أن يكثروا الصدقات على المساكين.
٣٠ «فَذَاكَ لَمَّا أَخَذَ اللُّقْمَةَ خَرَجَ لِلوَقْتِ. وَكَانَ لَيْلاً».
لَمَّا أَخَذَ اللُّقْمَةَ خَرَجَ لِلوَقْتِ نستنتج من ذلك أن يهوذا لم يحضر العشاء الرباني، لأن تلك اللقمة كانت من عشاء الفصح، ورُسم العشاء الرباني بعده ( ١كورنثوس ١١: ٢٥). وخرج يهوذا فوراً ليتخلص من مشاهدة المسيح الذي كشف قصده الشرير، وفي أن يخبر الرؤساء ويأخذ أجرته.
وَكَانَ لَيْلاً أي كان خروجه في الليل. ذكر يوحنا ذلك بعد ما كان قد مرّ عليه نحو خمسين سنة دليل قاطع على أنه كان شاهد عيان. ولعله عندما كتب ذلك خطر على باله أن الليل مناسب للخيانة لأنها من أعمال الظلمة. وكانت الظلمة في قلب الخائن، وكانت خيانته من انتصارات الظلمة، فلاق أن يفعل ذلك في ظلمة الليل. وهذا وفق قول يسوع للذين قبضوا عليه «هَذِهِ سَاعَتُكُمْ وَسُلطَانُ الظُّلمَةِ» (لوقا ٢٢: ٥٣).
خطاب يسوع للتلاميذ بعد خروج يهوذا وإنباؤه بإنكار بطرس (ع ٣١ –٣٨)
٣١ «فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ يَسُوعُ: الآنَ تَمَجَّدَ ابْنُ الإِنْسَانِ وَتَمَجَّدَ اللَّهُ فِيهِ».
يوحنا ١٢: ٢٣ و١٤: ١٣ و١بطرس ٤: ١١
فَلَمَّا خَرَجَ الأرجح أنّ المسيح رسم العشاء الرباني على أثر هذا الخروج. قيل في ع ٢١ إن المسيح «اضطرب بالروح» عندما تأمل في خيانة يهوذا والخائن أمامه. ولكن كلمات المسيح بعد خروج الخائن المرائي دلّت على تخلصه من ذلك الاضطراب، وعلى انشراح صدره، وبأنه استطاع أن يُعلن لأصدقائه المخلصين كل ما في قلبه.
الآنَ تَمَجَّدَ ابْنُ الإِنْسَانِ هذا اللقب مأخوذ من نبوة دانيال ٧: ١٣، وهو فيها محمول على المسيح واعتاد اليهود تلقيبه بذلك (انظر شرح متّى ١٠: ٢٣). واستحسن المسيح إيراده هنا بياناً أنه لم يتمجد التمجيد المقصود هنا إلا بتواضعه باعتباره إنساناً خادماً للبشر. وأراد بقوله «الآن» أن وقت خدمته على الأرض على وشك الانتهاء بموته، لأن يهوذا قد ذهب ليأتي بالعسكر ليقبضوا عليه ويسلموه إلى قاتليه. وكان خروج يهوذا مقدمة أمور كثيرة، هي تسليمه وموته وقيامته وصعوده وجلوسه على يمين الله وسكبه الروح القدس. ونظر المسيح إلى تلك الحوادث المترابطة كأنها واحدة تمجّد هو بها. وقصد بقوله «تمجّد» ابتدأ يتمجّد لا كما ظن التلاميذ بتتويجه ملكاً زمنياً على أمة اليهود، بل بتواضعه إلى الغاية استعداداً لارتفاعه الأعظم، وبلبسه إكليلاً من الشوك استعداداً للبس إكليل المجد والعظمة ليكون ملك الملوك ورب الأرباب، وبتعليقه على الصليب استعداداً لجلوسه على عرش السلطة السماوي (انظر شرح يوحنا ١٢: ٢٨ ،٣٢). وقال ذلك لتلاميذه ليدفع عنهم اليأس الذي سينشأ من خيانة يهوذا له ومن موته، فيحسبون ذلك كسوفاً وقتياً لمجد شمس البر، واستعداداً للمعانه الكامل دائماً.
وَتَمَجَّدَ اللَّهُ فِيهِ هذا يدل على أنه كلما تمجّد الابن تمجّد الآب، وهو وفق تعليمه على الدوام أنه والآب واحد في القصد والعمل. وقد تمجّد الآب بموت الابن، لأن الابن خضع به لإرادة الآب كل الخضوع، وأعلن به قداسة الله وعدله وصدقه وبغضه للخطية ورحمته للخاطئ. وتمجّد أيضاً بنتائج هذا الموت لخلاص البشر لما يتضمن ذلك من طاعة المخلّصين له وإكرامهم وتسبيحهم إيّاه في الأرض والسماء.
كان تمجيد الله غاية المسيح العظمى من كل ما قال وعمل واحتمل، فيجب أن يكون ذلك غايتنا العظمى فيعطينا السعادة العظمى.
٣٢ «إِنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ تَمَجَّدَ فِيهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سَيُمَجِّدُهُ فِي ذَاتِهِ، وَيُمَجِّدُهُ سَرِيعاً».
يوحنا ١٧: ١ - ٦ ويوحنا ١٢: ٢٣
إِنْ كَانَ ليست «إن» هنا للشك بل للقطع والتأكيد، فالشرط مؤكد والجواب كذلك. ولا بد من أن يسوع بتواضعه وسيلة إلى تمجيد الله. ولا شك أنّ الله يمجّده أيضاً برفعه إيّاه في نهاية ذلك التواضع وشرائه الخلاص للبشر.
اللَّهُ قَدْ تَمَجَّدَ فِيهِ لأنّه «أَخْلَى نَفْسَهُ، آخِذاً صُورَةَ عَبْدٍ، صَائِراً فِي شِبْهِ النَّاسِ. وَإِذْ وُجِدَ فِي الهَيْئَةِ كَإِنْسَانٍ، وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتَّى المَوْتَ مَوْتَ الصَّلِيبِ» (فيلبي ٢: ٧، ٨).
اللَّهَ سَيُمَجِّدُهُ فِي ذَاتِهِ الحد بين تمجيد الابن للآب بتواضعه وتمجيد الآب للابن برفعه إيّاه هو موت الابن. فكانت نهاية اتضاع الابن بدء تمجيده. ومعظم تمجيده يكون أمام عرش أبيه في السماء. لكنه يتضمن قوله هنا «الله سيمجده» أن الله يكرمه بآيات عظيمة يظهرها عند موته بإقامته وبإصعاده إيّاه إلى السماء، وبقبوله شفاعته في شعبه، وبسكبه الروح القدس ويهبه القوة لرسله وبمنحه النجاح لإنجيله.
وَيُمَجِّدُهُ سَرِيعاً لأن كل وسائل التمجيد كانت متعلقة بموته وكان ذلك على وشك الحدوث.
٣٣ «يَا أَوْلادِي، أَنَا مَعَكُمْ زَمَاناً قَلِيلاً بَعْدُ. سَتَطْلُبُونَنِي، وَكَمَا قُلتُ لِليَهُودِ: حَيْثُ أَذْهَبُ أَنَا لا تَقْدِرُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُوا، أَقُولُ لَكُمْ أَنْتُمُ الآنَ».
غلاطية ٤: ١٩ ويوحنا ٧: ٣٤ و٨: ٢١
يَا أَوْلادِي هذا لقب يدل على محبة المسيح للتلاميذ وحنوه عليهم وعنايته بهم كالوالد بولده. وفي ذلك إشارة إلى ضعفهم وافتقارهم إلى إرشاده واهتمامه. وناداهم به لتعزيتهم على مفارقته إيّاهم، لأن رجوعه إلى مجده يستلزم تركه إيّاهم كاليتامى.
زَمَاناً قَلِيلاً بَعْدُ لم يُخفِ عنهم قرب مفارقته إيّاهم فودعهم بما في هذا أصحاحات ١٣ - ١٦ من كلام التعزية والنصح والإرشاد.
كَمَا قُلتُ لِليَهُودِ (يوحنا ٧: ٣٣، ٣٤ و٨: ١٢).
لا تَقْدِرُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُوا منع لليهود من الإتيان إلى حيث ذهب المسيح عدم إيمانهم به، وهذا يمنع كل إنسان من أن يكون مع المسيح. والمانع للتلاميذ منه أنه كان عليهم أن يخدموا المسيح على الأرض وهو مانع وقتيّ متى انقضى وقته تبعوا المسيح (ع ٣٦ ويوحنا ١٤: ٣).
٣٤ «وَصِيَّةً جَدِيدَةً أَنَا أُعْطِيكُمْ: أَنْ تُحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضاً. كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ أَنَا تُحِبُّونَ أَنْتُمْ أَيْضاً بَعْضُكُمْ بَعْضاً».
لاويين ١٩: ١٨ ويوحنا ١٥: ١٢، ١٧ وأفسس ٥: ٢ و١تسالونيكي ٤: ٩ ويعقوب ٢: ٨ و١بطرس ١: ٢٢ و١يوحنا ٢: ٧ ، ٨ و٣: ١١، ٢٣ و٤: ٢١
جعل المسيح حب التلاميذ بعضهم لبعض علامة يتميزون بها عن غيرهم.
وَصِيَّةً جَدِيدَةً لم يقصد بكونها جديدة أن الله لم يوصِ بها شعبه قبلاً لأنها في سفر اللاويين ١٩: ١٨ بل حسبها جديدة لأربعة أسباب: (١) أن المسيح جعلها حينئذ علامة لتلاميذه يعرفهم الناس بها وعلامة تلمذتهم الحقيقية بالنظر إلى الله. امتاز اليهود شعب الله القديم برسوم الختان وتمييز الأطعمة والملبوسات، فأراد يسوع أن يمتاز تلاميذه بالمحبة، كقول الرسول «وَهَذِهِ هِيَ وَصِيَّتُهُ: أَنْ نُؤْمِنَ بِاسْمِ ابْنِهِ يَسُوعَ المَسِيحِ، وَنُحِبَّ بَعْضُنَا بَعْضاً كَمَا أَعْطَانَا وَصِيَّةً» (١يوحنا ٣: ٢٣ انظر أيضاً غلاطية ٦: ٢ و١تسالونيكي ٤: ٩ و٢تسالونيكي ١: ٣ و١بطرس ١: ٢٢ و٢بطرس ١: ٧). ويتكلَّف كل المسيحيين بهذه الوصية لأنهم مفديون مجاناً من عبودية واحدة للشيطان والخطية، بواسطة واحدة وهي دم يسوع الكريم، وكلهم أولاد أب واحد سماوي وإخوة أخٍ واحد هو يسوع الأخ الأكبر، وأهل إيمان واحد ومعمودية واحدة، ومسافرون إلى سماء واحدة. (٢) إن الدواعي إلى طاعتها جديدة. فالداعي إلى محبة الناس بعضهم لبعض أنهم خلق الله وأولاد أبٍ واحد هو آدم. كان الداعي إلى محبة اليهود بعضهم لبعض أنهم أمة واحدة من أب واحد هو إبراهيم. وأما الدواعي إلى محبة المسيحيين بعضهم لبعض فمنها علاقتهم بفادٍ واحد هو المسيح. وهم عشيرة واحدة بالإيمان به. ومنها أن المسيح كلفهم بها قبل موته وكانت آخر وصاياه لهم فالتزموا بها حباً وشكراً له. (٣) أن نموذجها جديد وهو محبة المسيح لنا. (٤) أن المسيح وسع نطاق المحبة. فإن المحبة كانت عند اليهود مقيدة بحب اليهودي لليهودي. أما المسيح فأوجبها على المؤمن لكل مؤمن من كل أمة في كل عصر ومكان.
كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ أي يجب أن تكون محبتكم بعضكم لبعض مثل محبتي لكم، مخصوصة شديدة مجانية، تقود إلى أعمال مثل أعمالي الناتجة عن محبتي. ومن أمثلة تلك الأعمال ما بُني عليه هذا الخطاب وهو غسله أرجلهم. وكانوا قبل ذلك قد أظهروا أن ليس لهم تلك المحبة فقد تخاصموا في من هو الأعظم منهم، وطلب بعضهم المقام الأسمى في ملكوته.
٣٥ «بِهَذَا يَعْرِفُ الجَمِيعُ أَنَّكُمْ تلامِيذِي: إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبٌّ بَعْضاً لِبَعْضٍ».
١يوحنا ٢: ٥ و٤: ٢٠
الجَمِيعُ أي كل الناس من أصحاب وأعداء.
أَنَّكُمْ تلامِيذِي تفرد المسيح بحبه العجيب فأراد أن يتصف تلاميذه بمثل حبه ليميزهم الناس عن غيرهم ويعرفوا أنهم مشابهون ليسوع، فيحكموا بأنهم تلاميذه، وأنه هو مصدر ذلك الحب، ويميلوا إلى اتخاذه معلماً لهم ويقبلوه مخلّصاً. وهذا ما فعله المسيحيون الأولون كما يتضح مما ذُكر في سفر أعمال الرسل وميزهم الناس بهذه الصفة. قال أحد الرومان الوثنيين: «انظر كيف يحب المسيحيون بعضهم بعضاً، فإن كلاً منهم مستعد أن يبذل حياته لأجل الآخر». وقال وثني آخر: «إنهم يحب أحدهم الآخر قبل أن يتعرف به». وشهد غيرهما من الوثنيين بأن معلم المسيحيين جعلهم يعتقدون أنهم كلهم إخوة. فإذاً تلك المحبة علامة واضحة لأولاد الله، فهي علامة للمحب يعرف بها نفسه (١يوحنا ٣: ١٤). وعلامة للناس يعرفونه بها (١يوحنا ٢: ١٠ و٤: ٧) وهي العلامة التي يميز بها الله أولاده (١يوحنا ٤: ٢٠).
٣٦ «قَالَ لَهُ سِمْعَانُ بُطْرُسُ: يَا سَيِّدُ، إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ؟ أَجَابَهُ يَسُوعُ: حَيْثُ أَذْهَبُ لا تَقْدِرُ الآنَ أَنْ تَتْبَعَنِي، وَلَكِنَّكَ سَتَتْبَعُنِي أَخِيراً».
يوحنا ٣١: ١٨ و٢بطرس ١: ١٤
إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ هذا السؤال مبني على قول المسيح «أنا معكم زماناً قليلاً بعد» (ع ٣٣) والمقصود منه منع مفارقة يسوع للتلاميذ إن أمكن. ولا بد من أن بطرس قال ذلك بالأصالة عن نفسه والنيابة عن سائر الرسل، وسبقهم في ذلك لأنه أكثرهم جسارة. وهذا السؤال يدل على أن التلاميذ لم يفهموا أن يسوع أشار بذهابه عنهم إلى صلبه وموته، لكنهم فهموا أنه عزم على الذهاب إلى موضع ما من الأرض.
لا تَقْدِرُ الآنَ أَنْ تَتْبَعَنِي أبان يسوع بعض معناه بقوله إن بطرس لا يقدر أن يتبعه حقيقة في الحال، لكنه سيفعل هذا في المستقبل. وقد تبع بطرس المسيح اتّباعاً روحياً، وجاهد في سبيل البشارة وإنكار الذات وبالاستشهاد. كما تبع المسيح بأن صُلب كما صُلب هو، وأشار إلى ذلك في (يوحنا ٢١: ١٨، ١٩). وتبعه إلى القبر ثم الارتفاع إلى السماء. وإنما لم يستطع بطرس أن يتبع المسيح في الحال لأربعة أسباب: (١) لم يشأ الله أن يموت أحد من الرسل مع سيده. (٢) لم يكن بطرس مستعداً للذهاب إلى السماء تمام الاستعداد (لوقا ٢٢: ٣٢). (٣) كان على بطرس أن يخدم المسيح على الأرض بتأسيس الكنيسة. (٤) لم يكن المسيح قد أعدّ له مكاناً (يوحنا ١٤: ٢).
سَتَتْبَعُنِي أَخِيراً إلى السماء والمجد.
٣٧ «قَالَ لَهُ بُطْرُسُ: يَا سَيِّدُ، لِمَاذَا لا أَقْدِرُ أَنْ أَتْبَعَكَ الآنَ؟ إِنِّي أَضَعُ نَفْسِي عَنْكَ».
متّى ٢٦: ٣٣ الخ ومرقس ١٤: ٢٩ الخ ولوقا ٢٢: ١٣، ١٤
لم يزل بطرس غير فاهم أن المسيح أشار بما سبق إلى قرب موته، إنما ظن أنه أشار إلى سيره في طريق الشدائد والأخطار المؤدية إلى الموت، وحسب أن المسيح ظن أن ليس له هو شجاعة كافية ليتبعه في تلك الطريق، فصرّح له أنه شجاع لا يهاب الموت من أجله بدليل قوله «إِنِّي مُسْتَعِدٌّ أَنْ أَمْضِيَ مَعَكَ حَتَّى إِلَى السِّجْنِ وَإِلَى المَوْتِ» (لوقا ٢٢: ٣٣). ولا شك أنه صدق بذلك لمطابقته لما في وجدانه، لكنه لم يعرف ضعف قلبه ولا قوة التجربة.
٣٨ «أَجَابَهُ يَسُوعُ: أَتَضَعُ نَفْسَكَ عَنِّي؟ اَلحَقَّ الحَقَّ أَقُولُ لَكَ: لا يَصِيحُ الدِّيكُ حَتَّى تُنْكِرَنِي ثلاثَ مَرَّاتٍ».
ذُكرت هذه النبوة في لوقا ٢٢: ٣٣، قالها يسوع على العشاء مع التلاميذ، وقالها ثانية وهم سائرون إلى بستان جثسيماني (متّى ٢٦: ٣٤ ومرقس ١٤: ٢٩) وسبق تفسير ذلك في شرح بشارة متّى.
أَتَضَعُ نَفْسَكَ عَنِّي؟ ذكر كلام بطرس بنفسه بطريق الاستفهام ليبيّن الفرق بين وعده وما سيقع منه، فبدل أن يضع نفسه عن المسيح لم يعترف به، بل أنكر معرفته به، ولم يفعل ذلك مرة أو مرتين فقط بل ثلاث مرات، وهذا لم يكن بعد زمن طويل من وعده بل قبل طلوع شمس الغد. والظاهر أن هذه النبوة أثرت في بطرس حتى صمت. ولم يجاوب المسيح على سؤال بطرس: «لماذا لا أقدر؟».
لا يَصِيحُ الدِّيكُ أراد المسيح بصياح الديك هنا هزيعاً من الليل (كما جاء في متّى ٢٦: ٣٤ ومرقس ١٣: ٣٥) بقطع النظر عن مرات صياح الديك. أما مرقس فنظر إلى ذلك (مرقس ١٤: ٧٢) فإن اليهود اصطلحوا على تسمية نصف الليل بصياح الديك الأول، والوقت الذي بعده بثلاث ساعات بصياح الديك الثاني، والصبح بصياح الديك الثالث. ووقت الإنكار كان الثاني على ما أفاده مرقس. وليس في معرفة المسيح سقوط بطرس قبل أن يكون ما نعجب منه، كعجبنا من حلمه وصبره على بطرس مع تلك المعرفة.
كلام المسيح في هذا الفصل تابع كلامه على ذهابه في ص ١٣ وقوله لبطرس: «ستتبعني أخيراً» (يوحنا ١٣: ٣٦) موجَّه إلى جميع الرسل الحاضرين، أكد لهم به اجتماعهم في المستقبل لأنه كان ذاهباً ليعد لهم مكاناً، وسوف يأتي ويأخذهم إليه (يوحنا ١٤: ٢، ٣).
الأصحاح الرابع عشر
الخطاب الوداعي. تعزية يسوع تلاميذه على مفارقته إيّاهم (ع ١ - ١٤)
١ «لا تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ. أَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَآمِنُوا بِي».
ع ٢٧ ويوحنا ١٦: ٢٢، ٢٣
لا تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ لا عجب من اضطراب قلوب التلاميذ حينئذ، لعدة أسباب توجبه، ولعل علاماته ظهرت على وجوههم وفي بعض أقوالهم. ومن تلك الأسباب كلامه عن ذهابه عنهم وهو أولها وأعظمها، بدليل قوله «لأنِّي قُلتُ لَكُمْ هَذَا قَدْ مَلأ الحُزْنُ قُلُوبَكُمْ» (يوحنا ١٦: ٥، ٦). ومن تلك الأسباب تركه إياهم كخراف بين ذئاب، وتعريفهم بأنه لا بد من وقوع الاضطهاد عليهم، وأخذ أملهم الملك الزمني في الضعف والزوال، وما ذكره في خطابه من أمر تسليم يهوذا الإسخريوطي إيّاه وإنكار بطرس له.
أَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَآمِنُوا بِي الوسيلة الأولى التي ذكرها يسوع لإزالة الاضطراب هي الإيمان بالله وبه. وكان للتلاميذ باعتبارهم يهوداً أتقياء ثقة بالله الآب بحضوره معهم ومحبته لهم، فأراد أن يكون لهم باعتبارهم تلاميذه مثل تلك الثقة عينها به، أي أن يؤمنوا بحضوره معهم وهو غير منظور كما يؤمنون بالآب كذلك. وهذا لا يستلزم أن إيمانهم بالله كان كاملاً لا يحتاجون معه إلى زيادة، بل وجوب أن يكون إيمانهم به كإيمانهم بالآب. ويلزم من قوله هنا أنه أمرهم باعتقاد مساواته للآب واتحاده به في القصد والعمل، وأن قدرته غير محدودة، وأن حضوره معهم واعتناءه بهم ليسا مقيدين بحضوره جسدياً كما اعتادوا أن يعتبروهما. وأنه لا يزال يعتني بهم ويهب لهم كل ما يحتاجون إليه في الحياة الحاضرة والمستقبلة. فكأنه قال: آمنوا بأني المسيح وإن رأيتموني على الصليب، وآمنوا أني حاضر بينكم وإن لم تروني، وليكن إيمانكم بي دائماً باعتبار أني مخلّص حي ورأس الكنيسة.
وهذا أول ما فعله المسيح ليعزيهم، وهو دواء لكل اضطرابات النفس لا مثيل له.
٢ «فِي بَيْتِ أَبِي مَنَازِلُ كَثِيرَةٌ، وَالا فَإِنِّي كُنْتُ قَدْ قُلتُ لَكُمْ. أَنَا أَمْضِي لأُعِدَّ لَكُمْ مَكَاناً».
مزمور ٣٣: ١٣، ١٤ وإشعياء ٦٣: ١٥ ويوحنا ١٣: ٣٣، ٣٦
فِي بَيْتِ أَبِي عبّر عن السماء بمسكن الله حيث يظهر مجده بأكثر البهاء والجلال. (راجع تثنية ٢٦: ١٥ و٢أيام ١٨: ١٨ ومزمور ٢: ٤ و٣٣: ١٣، ١٤ و٩١: ١٣ وإشعياء ٦٣: ١٥ وأعمال ٧: ٤٩ و٢كورنثوس ٥: ١). وفي الصلاة الربانية: «أبانا الذي في السماوات». فصرّح المسيح بذلك أنه ذاهب إلى السماء، وعزّاهم بوعده في ما يأتي أنهم يجتمعون به هناك. وهذا تعزية لنا جميعاً إذ نعلم منه أن السماء بيت أبينا، فإذاً هي وطننا.
مَنَازِلُ كَثِيرَةٌ هذا مجاز مبني على ما في قصور ملوك هذه الأرض من أماكن كثيرة لهم ولأولادهم ولأهل بلاطهم. وقصد المسيح بذلك بيان سعة السماء، وتأكيده لهم اجتماعهم به هناك لفرط سعتها، فإنها تسعهم هم وسائر المفديين مع كل جنود الملائكة. والسكن في قصر الملك يستلزم القرب منه والمشاركة له في الإكرام والسعادة والمحبة التي هي وافرة فيه.
وَإلا أي ولو كان انفصالنا أبدياً ولا يمكن أننا نجتمع في السماء ونسكن معاً في منازلها.
فَإِنِّي كُنْتُ قَدْ قُلتُ لَكُمْ ولم أترككم جاهلين ذلك، تتوقعون ما لا يوجد. والخلاصة أنه ليس في ما قاله أدنى شك.
أَنَا أَمْضِي لأُعِدَّ لَكُمْ مَكَاناً هذا مثل قول الرسول إن المسيح دخل السماء كسابق لأجلنا (عبرانيين ٦: ٢٠). قد أعدّ ذلك بموته على الصليب، وشفاعته لنا في السماء (عبرانيين ٩: ١٢). وقد حقق إيمان التلاميذ بالله أن لهم سماءً واسعة كثيرة المنازل، ويحقق إيمانهم بالمسيح أن لهم سبيلاً لدخول تلك المنازل (عبرانيين ٤: ١٤، ١٦ و٧: ٢٥ - ٢٧ و١٠: ١٢، ١٣، ١٩ - ٢٢).
٣ «وَإِنْ مَضَيْتُ وَأَعْدَدْتُ لَكُمْ مَكَاناً آتِي أَيْضاً وَآخُذُكُمْ إِلَيَّ، حَتَّى حَيْثُ أَكُونُ أَنَا تَكُونُونَ أَنْتُمْ أَيْضاً».
ع ١٨، ٢٨ وأعمال ١: ١١ ويوحنا ١٢: ٢٦ و١٧: ٢٤ و١تسالونيكي ٤: ١٧
آتِي أَيْضاً وَآخُذُكُمْ إِلَيَّ قال ذلك ليعزّي تلاميذه على ذهابه عنهم، فإنه وإن فارقهم سيرجع إليهم رجوعاً روحياً لا جسدياً عند موتهم ليجمعهم إليه. وقصد أيضاً إتيانه إليهم بالروح كل حين ليعزيهم ويعينهم ويعلمهم ويُعدهم للذهاب إليه. وقد «أتى أيضاً» لما قام من الموت رئيساً للحياة، ولما أرسل الروح القدس. وهو مع كنيسته بالروح كل حين ويأتي إلى كل مؤمن عند موته (فيلبي ١: ٢٣). وسوف يأتي بالمجد يوم مجيئه الثاني العظيم (١تسالونيكي ٤: ١٧).
حَتَّى حَيْثُ أَكُونُ أَنَا تَكُونُونَ أَنْتُمْ أَيْضاً أكد بذلك لتلاميذه أنهم يكونون بعد موته حيث هو، فبالضرورة يكونون في الراحة والقداسة والسعادة الأبدية (فيلبي ١: ٢٣ و١تسالونيكي ٤: ١٧ وعبرانيين ٩: ٢٨).
أعظم مسرات المؤمنين أن يكونوا «كل حين مع الرب» فإذا ذكرنا ذهابنا من هذا العالم لا نتصور أن الموت سيلاشينا، بل نؤمن أن المسيح آت لإتمام خلاصنا، وأن نهاية حياتنا هنا بداية حياتنا فوق، وأن خسارتنا هنا ربحنا هناك، وأن مفارقة أصدقائنا على الأرض اجتماع بالأصدقاء في السماء. نعم إن الموت هائل لمن لا يعلم إلى أيّ مكان من عالم الظلام يذهب، لكنه ليس كذلك لمن يتحقق أنه يذهب إلى بيت أبيه السماوي ليكون مع يسوع أخيه الأكبر.
٤ «وَتَعْلَمُونَ حَيْثُ أَنَا أَذْهَبُ وَتَعْلَمُونَ الطَّرِيقَ».
عرف يسوع ما في قلوب تلاميذه من الشكوك وما في أذهانهم من التساؤلات، فأراد أن يبدد الشكوك، وكأنه قال لهم: ألا تعلمون حيث أنا أذهب؟
حَيْثُ أَنَا أَذْهَبُ أي السماء بيت أبي.
وَتَعْلَمُونَ الطَّرِيقَ لأني أخبرتكم بما فيه الكفاية إن كنتم قد انتبهتم لكلامي، وأنتم قادرون على معرفة الطريق إذا تذكرتم كلامي، فإني أنا ذلك الطريق. وأما التلاميذ فلم يعلموا ذلك حق العلم، لأن أذهانهم كانت مملوءة بالأفكار والآمال المتعلقة بالملك الأرضي لابن داود، فلم يدركوا قصد المسيح حين كان يكلمهم عن مملكته الروحية، بدليل أنهم سألوه بعد قيامته: «يَا رَبُّ، هَل فِي هَذَا الوَقْتِ تَرُدُّ المُلكَ إِلَى إِسْرَائِيلَ؟» (أعمال ١: ٦). ولم يدركوا حقيقة الأمر حتى أنار أذهانهم بروحه.
٥ «قَالَ لَهُ تُومَا: يَا سَيِّدُ، لَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ تَذْهَبُ، فَكَيْفَ نَقْدِرُ أَنْ نَعْرِفَ الطَّرِيقَ؟».
تُومَا انظر شرح متّى ١٠: ٣ وانظر أيضاً يوحنا ١١: ١٦ و٢٠: ٢٤ - ٢٩. كان هذا الرسول يحب المسيح، لكنه كان يميل إلى الشك واليأس.
لَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ تَذْهَبُ أقرّ أنه لم يفهم قول المسيح تمام الفهم، لأنه كيهودي كان يرفض فكرة موت المسيح.
فَكَيْفَ نَقْدِرُ أَنْ نَعْرِفَ الطَّرِيقَ؟ هذا السؤال لم ينتج عن شك في نفس توما كسؤال بيلاطس للمسيح: «ما هو الحق؟» بل عن رغبة في المعرفة.
٦ «قَالَ لَهُ يَسُوعُ: أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالحَقُّ وَالحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى الآبِ إلا بِي».
عبرانيين ٩: ٨ ويوحنا ١: ٤، ١٧ و٨: ٣٢ و١٠: ٩ و١١: ٢٥
كان يسوع قد قال: «أنا هو خبز الحياة» و «أنا نور العالم» و «أنا باب الخراف» و «أنا الراعي الصالح» وزاد قوله هذا ليوضح علاقته بطريق الخاطئ للسماء. وأهم كلمة في هذه الآية هي «أنا» فكأنه قال: أنا الطريق إلى الآب لأني أفتحه بموتي. كان الناس ضالين يجهلون الطريق فأنا «الحق» نور العالم لأُري الناس الطريق الذي فتحته لهم. وهم موتى بالخطية وأنا «الحياة» لأُحيي نفوسهم وأُقدرهم على أن يروا الطريق ويسيروا فيه.
الطَّرِيقُ التي فيها يسير الخاطئ من الأرض إلى السماء، ومن حال الخطية إلى حال القداسة، ومن العداوة لله إلى المصالحة معه. وفتح المسيح تلك الطريق بسفك دمه (عبرانيين ١٠: ٢٠). فالفاصل بين الإنسان والله ليس البُعد بين السماء والأرض بل إثم الأثيم. وأزال يسوع ذلك الفاصل حين عُلق على الصليب (إشعياء ٣٥: ٨ - ١٠). ولأن المسيح هو الطريق نجتاز به من الخطية والشقاء والموت إلى القداسة والسلام والسعادة والرجاء والراحة والحياة في السماء. والمسيح هو الدليل في تلك الطريق إلى الله، ينادينا دائماً: «اتبعوني».
الحَقُّ قال المسيح إنه الحق لأنه يعلن لنا بروحه وكلامه كل ما نحتاج إلى معرفته من أمر أنفسنا، وما لله، وما يجب علينا، والطريق إلى السماء. ولأنه يعلم كل الحقائق تمام العلم، ويعلن ما يعلنه منها أكمل إعلان، ولأنه المرموز إليه بذبائح العهد القديم وسائر رموزه التي هي ظل الحقيقة. كانت أقوال الفلاسفة بالله وبالسماء وبآخرة الأخيار والأشرار ظنوناً، وأما أقوال يسوع بذلك فكانت يقينيات. وما أتى به الأنبياء والرسل من التعليم الحق لم يكن إلا منه (متّى ١١: ٢٧ ويوحنا ١: ١ و٢: ١٤، ١٧ و١٠: ٣٠ و١٧: ٣ وفيلبي ٢: ١٦ وكولوسي ٢: ٩ وعبرانيين ١: ٢). ولم يقصد المسيح بقوله إنه الحق تعليم الناس كل العلوم، وإنما أن يعلمهم ما يوصلهم إلى السماء.
الحَيَاةُ انظر شرح يوحنا ١١: ٢٥، فالمسيح مصدر كل حياة روحية. وهو الذي يعلمنا حقيقة تلك الحياة واحتياجنا إليها، وهو الذي اشتراها لنا بموته، ويهبها لنا بروحه (يوحنا ٦: ٥٧ و١٠: ١٠) ولا يزال يهبها لنا وسيظل إلى أبد الآبدين، وهو يهب فوق ذلك الحياة للجسد يوم القيامة.
إِلَى الآبِ الذي يجد الآب يجد السماء التي هي بيته.
إلا بِي أي بموتي وشفاعتي لا غير ذلك، لأني أنا وحدي الطريق والحق والحياة. فالله أبٌ للذين يأتون إليه بابنه يسوع. ولا نقدر أن نأتي إلى الآب بالصلاة التي يستجيبها إلا بالمسيح. ولا نستطيع دخول السماء إلا به (١تيموثاوس ٢: ٥) لأن الله جعل ابنه الوسيلة الوحيدة لينال الخطاة المغفرة والمصالحة والخلاص. فالذين يدخلون السماء إنما يدخلونها بكفارته. فلنأتِ إلى الآب عندما نتكل على المسيح وحده لأجل الخلاص، وعندما نطيع أوامره ووصاياه. وفي ذلك جواب لسؤال توما: «أين تذهب؟» وهو أنه ذاهب إلى الآب، وسؤاله عن الطريق وهو قوله «بي».
٧ «لَوْ كُنْتُمْ قَدْ عَرَفْتُمُونِي لَعَرَفْتُمْ أَبِي أَيْضاً. وَمِنَ الآنَ تَعْرِفُونَهُ وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ».
يوحنا ٨: ١٩
قال في آية ٦ إنه هو واسطة إتيان الناس إلى الآب، وفي هذه الآية إنه هو واسطة معرفتهم إياه لأنه كلمة الله أي الذي يعلنه (يوحنا ١: ١) ولأنه هو والآب واحد (يوحنا ١٠: ٣٠ انظر شرح يوحنا ٨: ١٩).
لَوْ كُنْتُمْ قَدْ عَرَفْتُمُونِي لم يقصد أن ينكر عليهم كل معرفة الآب، بل قصد أن معرفتهم إياه قاصرة بسبب سوء آرائهم اليهودية في شأن المسيح.
لَعَرَفْتُمْ أَبِي أَيْضاً على قدر ما يستطيع الإنسان أن يعرف من صفاته الحسنة ومقاصده، ولا سيما ما قصده بموت المسيح وقيامته وفتح طريق السماء به.
وَمِنَ الآنَ تَعْرِفُونَهُ أي من الوقت الذي أخذ يتمجد فيه (يوحنا ١٣: ٣١) وهو وقت حديثه هذا، وعرفوه بما قاله لهم في ع ٦، ٩ وزادت معرفتهم بالآب عند موت المسيح وقيامته وحلول الروح القدس. ومعنى قوله «تعرفونه» أخذتم تقتربون من كمال معرفته.
وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ لأنهم رأوا المسيح وهو صورة الله (فيلبي ٢: ٦) وبهاء مجده ورسم جوهره (عبرانيين ١: ٣). وهذه الرؤية روحية فاق بها الرسل البسطاء علماء اليهود الذين لم يعرفوا الابن ولا الآب (يوحنا ٨: ١٩).
٨ «قَالَ لَهُ فِيلُبُّسُ: يَا سَيِّدُ، أَرِنَا الآبَ وَكَفَانَا».
فِيلُبُّسُ (انظر شرح متّى ١٠: ٣٠) وتُعرف صفاته من يوحنا ١: ٤٤، ٤٥ و٦: ٥ - ٧ و١٢: ١٢، ٢٢. مرّ أن توما لم يفهم قصد المسيح بالذهاب والطريق، وهنا يُظهر فيلبس أنه لم يفهم معنى قوله: «قد رأيتموه» فظنه يعني رؤية صورة حسية، أي هيئة تراها عيون الجسد كالتي رآها موسى في جبل سيناء وإشعياء في رؤياه. والظاهر من كلامه أنه حسب رؤية الله أعظم الخيرات كما حسبها موسى (خروج ٣٣: ١٨)، وأنه لم يعرف ظهور الله له بالمسيح وبمعجزاته وسيرته وتعليمه، وأنه لو حصل على رؤية الله بالعين الجسدية لأزال ذلك كل شكوكه وأشبع كل أشواقه. فأصاب بالاشتياق، وأخطأ بعدم إدراكه أن الله قد استجاب طلبه في طريق أفضل مما أرادها. ولو ظهر الله له كما أراد لأعلن له مجرد قوته، ولكنه بالمسيح أبان كل صفاته.
٩ «قَالَ لَهُ يَسُوعُ: أَنَا مَعَكُمْ زَمَاناً هَذِهِ مُدَّتُهُ وَلَمْ تَعْرِفْنِي يَا فِيلُبُّسُ! اَلَّذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى الآبَ، فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ أَرِنَا الآبَ؟».
يوحنا ١٢: ٤٥ وكولوسي ١: ١٥ وعبرانيين ١: ٣
في هذا ما يدل على حزن المتكلم وعتابه للمخاطب، لأن غاية مجيئه إلى العالم إعلان الآب. وكان ذلك الإعلان غرضه من كل خدمته، وقد بلغ حينئذ نهايتها، فإذا به يرى أن معظم تعبه كان عبثاً، لأن تلميذه فيلبس لم يستفد شيئاً من الإعلان المذكور.
زَمَاناً هَذِهِ مُدَّتُهُ كانت تلك المدة نحو ثلاث سنين ونصف سنة، والمسيح لم يفتر في تلك المدة عن التعليم، وكان فيلبس من أول التلاميذ.
اَلَّذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى الآبَ على قدر ما يستطيعه الإنسان المحدود من إدراك الله غير المحدود. (انظر شرح يوحنا ١: ١٨، ١٢، ٤٤، ٤٥ وانظر كولوسي ١: ١٥ و١تيموثاوس ٦: ١٦ وعبرانيين ١: ٣). والتلاميذ لم يروا جوهر الآب لأنه ليس من المرئيات فإن «الله لم يره أحد قط» لكن المسيح قد أظهر صفاته وإرادته ومقاصده. فهم رأوا المعجزات الدالة على قدرته ورحمته، وشاهدوا تواضعه وقداسة سيرته وحنوه على المصابين ورغبته في خلاص الهالكين، وتحققوا بذلك شفقة الآب على الخطاة ومحبته للتائبين والمؤمنين وطول أناته وقداسته وحفظه للعهود، لأن المسيح قال إنه مُرسَل من الله ليعلن الله للناس، ولأن الابن متحد بالآب اتحاداً كاملاً حتى أن الذي يعرف أحدهما يعرف الآخر (يوحنا ٥: ١٧، ١٩، ٣٦ و١٠: ٣٠) وموت المسيح كفارة عن خطايا العالم وطوعاً لإرادة الله أظهر صفاته أحسن إظهار. والذي رأى يسوع معلقاً على الصليب وفهم القصد من ذلك رأى ما لم يُعلن لمخلوق قبلاً من كل ملء اللاهوت. ونحن مديونون ديْناً أبدياً للمسيح، لأنه أعلن الله لنا أباً فوق معرفتنا إياه خالقاً، وعرفنا به مُحباً لنا علاوة على كونه ديّاناً.
فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟ في هذا توبيخ لفيلبس الذي جهل الآب بسبب غفلته عن البيّنات التي أوردها المسيح له، وتأكيده أنه لو ذكر تلك البينات وتأمل فيها لآمن بأنه قد رأى الآب.
١٠ «أَلَسْتَ تُؤْمِنُ أَنِّي أَنَا فِي الآبِ وَالآبَ فِيَّ؟ الكلامُ الَّذِي أُكَلِّمُكُمْ بِهِ لَسْتُ أَتَكَلَّمُ بِهِ مِنْ نَفْسِي، لَكِنَّ الآبَ الحَالَّ فِيَّ هُوَ يَعْمَلُ الأَعْمَالَ».
يوحنا ١٠: ٣٨ وع ٢٠ ويوحنا ١٧: ٢١، ٢٣ ويوحنا ٥: ١٩ و٧: ١٦ و٨: ٢٨ و١٢: ٤٩
أَلَسْتَ تُؤْمِنُ أَنِّي أَنَا فِي الآبِ وَالآبَ فِيَّ؟ هذا يدل على أن رؤية الله الآب بالمسيح ممكنة فقط لعين الإيمان، وأن الآب والابن أقنومان متميزان لأنه قال «أنا في الآب» لا «أنا الآب». وأن الاتحاد بين الأقنومين تام في القصد والعمل، وأن الفصل بينهما محال، وأنهما متساويان في الجوهر. وقول المسيح لفيلبس: «ألست تؤمن؟» يفيد أنه كان يجب أن يؤمن ويتيقن ذلك.
الكلامُ الَّذِي أُكَلِّمُكُمْ بِهِ ذكر المسيح أمرين أعلنهما الآب كان على فيلبس أن يعرف بهما أن يسوع في الآب والآب فيه، وهما: كلامه، وأعماله. وأراد بالكلام هنا كل ما علَّمه لتلاميذه. وأنه لم يقُل شيئاً مستقلاً عن الآب، بل بالنظر إلى أنه أتى به من عند الله، وأن الآب تكلم به، وأن غاية كل تعليمه إعلان ذلك الآب الذي طلب فيلبس أن يراه.
الحَالَّ فِيَّ أي المتحد بي دائماً. فلو كان المسيح نبياً فقط لقال: الآب الذي أرسلني. فقوله ذلك دليل على أنه الله لا نبي كسائر الأنبياء (يوحنا ٥: ١٧، ١٩، ٣٦ و١٠: ٣٠).
هُوَ يَعْمَلُ الأَعْمَالَ هذا هو الأمر الثاني الذي كان على فيلبس أن يعرف به الآب، والمقصود بالأعمال هنا المعجزات التي صنعها المسيح، وقد بينت محبة يسوع وقوته، كما بينت محبة الآب وقوته لأنه حال في الابن ويعمل به (انظر شرح يوحنا ٨: ٢٨). وخلاصة هذه الآية أن الذي سمع صوت الابن سمع صوت الآب أيضاً، والذي رأى أعمال الابن رأى أعمال الآب كذلك.
١١ «صَدِّقُونِي أَنِّي فِي الآبِ وَالآبَ فِيَّ، وَإلا فَصَدِّقُونِي لِسَبَبِ الأَعْمَالِ نَفْسِهَا».
يوحنا ٥: ٣٦ و١٠: ٣٨
صَدِّقُونِي أَنِّي فِي الآبِ وَالآبَ فِيَّ خاطب المسيح بهذا كل التلاميذ لا فيلبس فقط، وهو دعوة للجميع إلى الانتباه لما عاتب المسيح فيلبس على غفلته عنه، فكأنه قال: اسمعوا كلكم، وأنا أكرر لكم ما قلته في شأن كمال الاتحاد بيني وبين الآب.
وَإلا فَصَدِّقُونِي لِسَبَبِ الأَعْمَالِ أي إن لم تقتنعوا بمجرد كلامي على الاتحاد بيني وبين الآب فاقتنعوا بشهادة ما صنعتُه من المعجزات، فلا أحد يقدر أن يفعل مثل هذه الأفعال ما لم يكن الله معه. وقال المسيح قبلاً مثل هذا القول لليهود (يوحنا ٥: ١٩، ٢٠ و١٠: ٣٧، ٣٨).
١٢ «اَلحَقَّ الحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: مَنْ يُؤْمِنُ بِي فَالأَعْمَالُ الَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا يَعْمَلُهَا هُوَ أَيْضاً، وَيَعْمَلُ أَعْظَمَ مِنْهَا، لأنِّي مَاضٍ إِلَى أَبِي».
متّى ٢١: ٢١ ومرقس ١٦: ١٧ ولوقا ١٠: ١٧
هذا وعد ثان للتلاميذ وعدهم المسيح به ليعزيهم على مفارقته لهم. وكان الوعد الأول أن يجتمعوا به في السماء. والوعد الثاني مضمونه أن قوة فعل المعجزات لا تنتهي عند ذهابه، وأن الله يقدّرهم على صنعها برهاناً لحضوره معهم وإثباتاً لصحة تعاليمهم.
اَلحَقَّ الحَقَّ هذا توكيد للوعد.
مَنْ يُؤْمِنُ الإيمان شرط نوال ما وعدهم به لأنهم يتحدون به مع الآب والابن، ويكونون وسيلة توصيل نعمة الله إلى سائر الناس.
فَالأَعْمَالُ الَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا يَعْمَلُهَا هُوَ كشفاء المرضى وإقامة الموتى (أعمال ٥: ١٥، ١٦ و١٣: ١١ و١٩: ١٢).
وَيَعْمَلُ أَعْظَمَ مِنْهَا عملوا أعظم منها من وجهين: (١) أن تأثير معجزاتهم في عالم المادة كان أشد من تأثير معجزات المسيح، فإن مشاهدي معجزاتهم كانوا أكثر عدداً من مشاهدي معجزاته، واقتنع الناس بواسطة معجزاتهم أكثر مما اقتنعوا بواسطة معجزاته فآمنوا بأعداد أكثر. (٢) أن أكثر المعجزات التي صنعها الرسل كانت في عالم الروح، وذلك أسمى من المعجزات في عالم المادة، فقد فتحوا القلوب العمياء وأخضعوا إرادة المعاندين لله، وأحيوا النفوس الميتة. فقد آمن ثلاثة آلاف في يوم الخمسين بتبشيرهم، وآمن الملايين في البلاد المختلفة نتيجة تبشيرهم. على أن الرسل لم يستطيعوا ذلك من قِبل أنفسهم، إنما فعلوه بقوة المسيح العامل بهم.
ويصح قول المسيح نوعاً ما على نجاح الكنيسة في كل قرن، وانتصار المسيحية على الأديان الفاسدة. وهو يصح كلما ذهب المرسلون وبشروا بالإنجيل في البلاد الوثنية. وانتشار الإنجيل بعد صعود المسيح فاق كثيراً انتشاره قبل صعوده، فهو زرع والآخرون حصدوا.
لأنِّي مَاضٍ إِلَى أَبِي كان ذهابه خيراً لهم لثلاثة أمور: (١) استيلاؤه على كل سلطان في السماء وعلى الأرض (متّى ٢٨: ١٨) وذلك لأجل الكنيسة (أفسس ١: ٢٢ وفيلبي ٢: ٩ - ١١). (٢) شفاعته في تلاميذه وفائدة ذلك زيادة إيمانهم وغيرتهم في التبشير وتأثيرهم في غيرهم. (٣) إرساله الروح القدس ليمكث معهم ويجعل تبشيرهم مؤثراً في قلوب الناس (ع ٢٦، ٣٨ ويوحنا ١٦: ٧ - ١٤ وأفسس ٤: ٨).
١٣ «وَمَهْمَا سَأَلتُمْ بِاسْمِي فَذَلِكَ أَفْعَلُهُ لِيَتَمَجَّدَ الآبُ بِالابْنِ».
متّى ٧: ٧ و٢١: ٢٢ ويوحنا ١٥: ٧، ١٦ و١٦: ٢٣، ٢٤ ويعقوب ١: ٥ و١يوحنا ٣: ٢٢ و٥: ١٤
هذا وعد ثالث وعده المسيح تعزيةً لتلاميذه.
مَهْمَا سَأَلتُمْ وعد تلاميذه بذلك باعتبارهم نوابه على الأرض، وخدامه الذين يُجرون أعماله فيها، وروحه ماكث معهم. وقصد بقوله «مهما» كل ما هو ضروري لهم في التبشير بإنجيله من إرشاد ومعونة وهبة القوة على صنع المعجزات، وذلك كله لا ينالونه إلا بالصلاة. فهذا الوعد وإن كان للرسل خاصة يصح لكل المسيحيين إذا طلبوا بإيمان ما يوافق مشيئة الله (يعقوب ١: ٦ و١يوحنا ٥: ١٤) وهذا دليل على قوة الصلاة.
بِاسْمِي أي بكرامتي على الله، وباتكالكم على استحقاقي وموتي وشفاعتي ومواعيدي. فالآب مسرور بالابن دائماً، ومستعد لأجله أن يستجيبنا لأننا له (متّى ٣: ١٧). فإننا لا نستحق خيراً، ولكن المسيح يستحق كل خير فيحبنا الله ويستجيبنا من أجل ابنه. وشرط كون الصلاة باسم المسيح يُثبت قول المسيح «ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي» (ع ٦).
فَذَلِكَ أَفْعَلُهُ هو قادر على ذلك لأن له كل سلطان (متّى ٢٨: ١٨) ونعلم أنه يريد ذلك لوعده به. وهذا وفق قوله في ع ١ «فآمنوا بي».
لِيَتَمَجَّدَ الآبُ بِالابْنِ انظر شرح يوحنا ١٢: ٢٨ و١٣: ٣١. لم يقِم المسيح مملكته لمجرد تمجيد نفسه، ومجد الابن في كل انتصارات تلك المملكة هو مجد الآب أيضاً.
١٤ «إِنْ سَأَلتُمْ شَيْئاً بِاسْمِي فَإِنِّي أَفْعَلُهُ».
هذا تكرار للوعد في الآية السابقة، وكرره لأربعة أمور: (١) التأكيد. كأنه صعب عليهم تصديق ذلك الوعد لعظمته. (٢) اتساع الوعد. فإن قوله «مهما» لا حد له. (٣) النوال لا يكون إلا بشرط السؤال باسمه، والصلاة هي الصلة الكاملة بين المؤمن على الأرض والمسيح في السماء. (٤) المجيب هو المسيح.
وقد جاء مثل هذا الوعد في يوحنا ١٥: ١٦ و١٦: ٢٣، لكن المجيب فيه الآب، وهما متفقان لأن الآب والابن واحد في الجوهر والقصد والعمل.
١٥ «إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَصَايَايَ».
ع ٢١، ٢٣ ويوحنا ١٥: ١٠، ١٤ و١يوحنا ٥: ٣
أراد المسيح أن يُظهر تلاميذه محبتهم له بعد أن يفارقهم، بطاعتهم له، لا بمجرد أقوالهم. فالإقرار بالدين ليس دليلاً على المحبة، بل الطاعة القلبية. فمحبتنا له تقودنا إلى طاعة كل أوامره، فنحب بعضنا بعضاً، وننكر ذواتنا ونحمل صليبنا ونتبعه «في مجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن». فطاعة الأولاد لوالديهم برهان محبتهم لهم، وقد طلب المسيح مثل هذا البرهان من تلاميذه (١يوحنا ٥: ٣).
١٦ «وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّياً آخَرَ لِيَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى الأَبَدِ».
يوحنا ١٥: ٢٦ و١٦: ٧ ورومية ٨: ١٥، ٢٦
هذا وعد رابع لتعزية التلاميذ وتشجيعهم، وهو مقترن بحفظ وصاياه كشرط ضروري لنواله.
وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الآبِ بعد موتي وصعودي وممارستي وظيفة الشفاعة عند الآب (رومية ٨: ٣٤ وعبرانيين ٣: ١٤، ١٥ و٧: ٢٥). فرئيس الكهنة في العهد القديم كان بعد أن يقدم الذبيحة يدخل بدمها إلى قدس الأقداس ليشفع في بني إسرائيل، وكان ذلك رمزاً إلى ما يفعله يسوع في السماء وهو رئيس كهنة لنا، فبشفاعته تُغفر خطايانا وتستجاب صلواتنا وننال كل بركاتنا.
فَيُعْطِيكُمْ أي الآب كما عُيّن في عهد الفداء منذ الأزل. ولأن مجيء الروح القدس توقف على موت المسيح وشفاعته حقّ للمسيح أن يقول إنه هو يرسله أيضاً (يوحنا ١٥: ٢٦). ويصحّ أن يُنسب إلى كل من الآب والابن لأنهما واحد.
مُعَزِّياً آخَرَ قال «آخر» لأنه هو المعزي الأول مدة وجوده معهم بالجسد (لوقا ٢: ٢٥). والمعزي هنا ترجمة «فارقليط» في اليونانية، ولا توجد في العربية كلمة تنقل المعنى اليوناني تماماً، فإن معناها معزٍّ، ومعين، وشفيع معاً. وجاءت في الإنجيل خمس مرات، نُسبت في أربع منها إلى الروح القدس (يوحنا ١٤: ١٦ و٢٦: ١٥: ٢٦ و١٦: ٧) وفي واحدة للمسيح (١يوحنا ٢: ١). والمراد «بالمعزي» هنا الروح القدس الأقنوم الثالث في اللاهوت، المعيّن لينوب عن المسيح بعد صعوده إلى السماء في تقديم النصح والإرشاد والصداقة والعون في الضيق. قال المسيح إن هذا الروح يقدِّر التلاميذ على معرفة كل الحق (ع ٢٦، ٢٧ ويوحنا ١٥: ٢٦) «وأنه يبكت العالم على الخطية» (يوحنا ١٦: ٨ - ١٠). وأنه يعين الرسل في التبشير وهداية الناس إلى التوبة والإيمان. ولا يستلزم هذا أن الروح القدس لم يكن في العالم سابقاً، لأنه كان حاضراً في قلوب كل أتقياء الله يقدرهم على تقديم العبادة المقبولة. وكان يوحنا المعمدان مملوءاً من الروح القدس (لوقا ١: ١٥). فالمعنى أن الروح القدس يُطهر قبلاً ويُظهر ذلك بطريق جديدة.
لِيَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى الأَبَدِ لا مدة قصيرة كإقامتي معكم بالجسد، فهو يبقى مع كل واحد منكم إلى نهاية حياته، ومع الكنيسة دائماً. وفي هذه الآية دليل على الثالوث، إذ ذُكر فيها الثلاثة الأقانيم: الابن الطالب، والآب المجيب، والروح القدس المُرسَل والمعزّي.
١٧ «رُوحُ الحَقِّ الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ العَالَمُ أَنْ يَقْبَلَهُ، لأنَّهُ لا يَرَاهُ ولا يَعْرِفُهُ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَعْرِفُونَهُ لأنَّهُ مَاكِثٌ مَعَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُمْ».
يوحنا ١٦: ١٣ و١كورنثوس ٢: ١٤ و١يوحنا ٢: ٢٧
رُوحُ الحَقِّ سُمي بذلك لأنه هو الحق (١يوحنا ٥: ٦) ولأنه علّم تلاميذ المسيح الحق وحفظهم من الباطل (يوحنا ١٦: ١٣). ولأنه يقود الناس إلى المسيح الذي هو الطريق والحق ويشهد له (١يوحنا ٥: ٦). ولأن الحق آلته في تجديد الإنسان وتقديسه.
الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ العَالَمُ أَنْ يَقْبَلَهُ المقصود «بالعالم» هنا الناس الدنيويون الذين اتخذوا هذا العالم نصيباً لهم، والمتكبرون الطماعون. فهؤلاء لا يستطيعون قبول الروح القدس معزيّاً لهم ومنيراً ومقدساً، لأنهم غير مستعدين لقبول ما هو لله، كقول الرسول «وَلَكِنَّ الإِنْسَانَ الطَّبِيعِيَّ لا يَقْبَلُ مَا لِرُوحِ اللَّهِ لأنَّهُ عِنْدَهُ جَهَالَةٌ، ولا يَقْدِرُ أَنْ يَعْرِفَهُ لأنَّهُ إِنَّمَا يُحْكَمُ فِيهِ رُوحِيّاً» ( ١كورنثوس ٢: ١٤ انظر أيضاً يوحنا ١٢: ٣١ و ١كورنثوس ١: ٢١ و٢كورنثوس ٤: ٤).
لأنَّهُ لا يَرَاهُ الدنيوي لا يرى سوى المحسوس فلا يسر بالروحيات ولا يشعر بحقيقتها، ويحسب الروحيين من أهل الأوهام لأنهم يتكلمون عن أمور لا تراها إلا عين الإيمان.
ولا يَعْرِفُهُ أي لا يدركه لكي يُسرّ به. «فالمعرفة» هنا تشتمل على الإدراك والسرور، وقد جاءت بهذا المعنى في مزمور ١: ٦ و٢٨: ٦ و٣٧: ١٨ وناحوم ١: ٧ و٢تيموثاوس ٢: ١٩. وعدم مسرة الدنيويين بالروح القدس علّة عدم استطاعتهم قبوله.
وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَعْرِفُونَهُ لأن تعليمي إيّاكم وقبولكم إيّاه وسيلة رؤيته ومعرفته، لأن الروح القدس يجعل كلامه يؤثر في قلوبهم وهم لا يشعرون بحضوره فيهم، فأزال عماهم الطبيعي وليّن قلوبهم ومال بها إلى قبول تعليم يسوع.
لأنَّهُ مَاكِثٌ فِيكُمْ ليهب لهم مؤثرات النعمة على الدوام فيُغيّر قلوبهم ويُقدسها، ويُقدرهم على الإتيان بأثمار الروح، ويملأ قلوبهم سروراً لأنه يمكث معهم (يوحنا ٥: ١٠ و١يوحنا ٣: ٢٤).
وما قيل هنا في شأن الروح القدس أربع حقائق: (١) أنه أقنوم. (٢) أنه روح الحق لأنه يرشد الناس إلى معرفة الحق. (٣) أن العالم لا يعرفه ليحصل به على التوبة والإيمان والرجاء والمحبة. (٤) أنه يسكن في المؤمنين ويعرفونه باختبارهم.
١٨ «لا أَتْرُكُكُمْ يَتَامَى. إِنِّي آتِي إِلَيْكُمْ».
متّى ٢٨: ٢٠ وع ٣
لا أَتْرُكُكُمْ يَتَامَى لو لم يرسل المسيح المعزي إليهم لكانوا بعد موته كيتامى لا أب لهم، يحتاجون إلى المعونة والتعزية، لا يعتني أحد بهم أو يحميهم.
إِنِّي آتِي إِلَيْكُمْ بالروح القدس الذي أرسله نائباً عني، لأن تأثيره فيكم كتأثير حضوري معكم (ع ٢٦)، وبروحي عند موتكم لآخذكم إليّ، وبمجيئي نفساً وجسداً في نهاية العالم.
١٩ «بَعْدَ قَلِيلٍ لا يَرَانِي العَالَمُ أَيْضاً، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَرَوْنَنِي. إِنِّي أَنَا حَيٌّ فَأَنْتُمْ سَتَحْيَوْنَ».
يوحنا ١٦: ١٦ و ١كورنثوس ١٥: ٢٠
بَعْدَ قَلِيلٍ أقل من يوم لأنه قال ذلك ليلة النهار الذي مات فيه.
لا يَرَانِي العَالَمُ أَيْضاً لا بعيني الجسد، ولا بعيني الإيمان، حتى آتي ثانية للدينونة. والمقصود «بالعالم» هنا ما قُصد به في ع ١٧.
وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَرَوْنَنِي شاهده التلاميذ على الأرض أربعين يوماً بعد قيامته (أعمال ١٠: ٤١). وهذا بعض ما قصده المسيح هنا، لأنه قصد أن المؤمنين يرونه بعين الإيمان، وبإعلان الروح إيّاه في قلوبهم، فإننا «نَحْنُ جَمِيعاً نَاظِرِينَ مَجْدَ الرَّبِّ بِوَجْهٍ مَكْشُوفٍ، كَمَا فِي مِرْآةٍ» (٢كورنثوس ٣: ١٨) وأنهم سوف يرونه ممجداً في السماء. ورؤية المسيح بالإيمان مصدر كل قوتنا في محاربتنا للعالم وللشهوة وللشيطان.
إِنِّي أَنَا حَيٌّ أي لا يزال حياً باعتبار لاهوته لأنه منذ الأزل وإلى الأبد هو الله الحي. فالموت الذي اعترى جسده وقتياً لم يؤثر شيئاً في لاهوته، وقام حالاً من ذلك الموت وسيطاً لنا لا يذوق الموت ثانية، و «قد ابتُلع الموت (بقيامته) إلى غلبة» وكونه حياً مكنهم من رؤيتهم إياه دائماً.
فَأَنْتُمْ سَتَحْيَوْنَ في الروح هنا وإلى الأبد في السماء. وهذا يحقق لنا أمرين: (١) أن حياة المسيحي تتوقف على حياة المسيح وعلى الاتحاد به، وأنه لا حياة روحية هنا ولا حياة أبدية هناك للمنفصل عن المسيح. (٢) إن حياة المسيح عربون حياة شعبه وتأكيد لها، كما أن حياة الكرمة تأكيد لحياة أغصانها الثابتة فيها، وحياة الرأس تأكيد لحياة الأعضاء.
٢٠ «فِي ذَلِكَ اليَوْمِ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا فِي أَبِي، وَأَنْتُمْ فِيَّ، وَأَنَا فِيكُمْ».
يوحنا ١٠: ٣٨ وع ١٠ ويوحنا ١٧: ٢١ ،٢٣ ،٢٦
فِي ذَلِكَ اليَوْمِ هو إما يوم قيامته لما ظهر لتلاميذه حياً مراراً في أماكن مختلفة، وإما يوم الخمسين حين أرسل الروح القدس وأظهر حياته بمنحه الحياة لألوف، وإما يوم مجيئه الثاني حين يعلن تمام الإعلان ما أشار إليه هنا.
تَعْلَمُونَ تختبرون بسكنى قلوبكم، وبإنارة الروح القدس إيّاكم التي تقدِّركم على تمييز الحقائق الروحية.
أَنِّي أَنَا فِي أَبِي أي متّحد معه تمام الاتحاد (انظر شرح يوحنا ١٠: ٣٨) وتحقيق ذلك يؤكد صحة دعوى يسوع أنه رسول الله والمسيح المنتظر.
وَأَنْتُمْ فِيَّ متحدون بي حتى لا يمكن انفصالكم عني (يوحنا ١٥: ١ - ٧ ورومية ٨: ٣٨، ٣٩). واتحادهم به يحقق لهم الأمن، وقبول الآب إيّاهم، وقداستهم، وسعادتهم، وحياتهم الأبدية.
وَأَنَا فِيكُمْ حالٌّ فيكم بروحي لأهب لكم النعمة والقوة والشجاعة لتشهدوا لي أمام العالم الذي يضطهدكم، ولأجعل كلامكم مؤثراً في قلوب الناس، ولأصنع على يدكم معجزات تثبت شهادتكم لي. حين أدرك الرسل هذا لم يعودوا يحتاجون إلى طلبهم رؤية الآب كما طلبوا في ع ٨.
والحقائق الثلاث المذكورة هنا: وهي أن المسيح في الآب، وأنهم في المسيح، وأن المسيح فيهم، أسرار لا ندركها حق الإدراك، إنما ندرك منها ما هو ثمين للمؤمنين، وهي من «عظائم الله» التي تكلم الرسل بها في يوم الخمسين (أعمال ٢: ١١).
٢١ «اَلَّذِي عِنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَحْفَظُهَا فَهُوَ الَّذِي يُحِبُّنِي، وَالَّذِي يُحِبُّنِي يُحِبُّهُ أَبِي، وَأَنَا أُحِبُّهُ، وَأُظْهِرُ لَهُ ذَاتِي».
ع ١٥: ٢٣ و١يوحنا ٢: ٥ و٥: ٣
في هذه الآية بيان الوسائل التي يتوصل بها التلاميذ إلى المعرفة التي وُعدوا بها في آية ٢٠، وهي أربع يتعلق بعضها ببعض كحلقات سلسلة: (١) أن محبتهم للمسيح تنشئ فيهم طاعته. (٢) أن تلك الطاعة تجعلهم أحباء الآب. (٣) أنها تزيد حب المسيح لهم. (٤) أن نتيجة ما ذُكر إعلان المسيح نفسه لهم وحصولهم على العلم الذي وُعدوا به في ع ٢٠.
اَلَّذِي عِنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَحْفَظُهَا هذا مثل قوله في ع ١٥ إلا أن هذا موجَّه لكل المؤمنين، وذاك وُجه إلى الأحد عشر. وقصد المسيح بالذي عنده وصاياه الذي يعترف جهراً بأنه تلميذه. وصرّح بأن طاعة أوامره هي علامة أن المعترف مسيحي حقاً، لا مجرد اعترافه ولا دموعه ولا نذوره (لوقا ١١: ٢٨).
الَّذِي يُحِبُّنِي يُحِبُّهُ أَبِي هذه المجازاة العظيمة للتلميذ المحب المطيع، ومحبة الآب له محبة مخصوصة تُنتج بركات مخصوصة، منها إرسال الروح القدس.
وَأَنَا أُحِبُّهُ، وَأُظْهِرُ لَهُ ذَاتِي هذه مجازاة أخرى للتلميذ المطيع. والإظهار هنا ليس للحواس الطبيعية بل للقوى الباطنية، وهذا ينشئ راحة الضمير والمسرّة ويقين الرجاء، وذلك يعزيهم على مفارقته إياهم، وهو أحسن وعد للإنسان على هذه الأرض.
٢٢ «قَالَ لَهُ يَهُوذَا لَيْسَ الإِسْخَرْيُوطِيَّ: يَا سَيِّدُ، مَاذَا حَدَثَ حَتَّى إِنَّكَ مُزْمِعٌ أَنْ تُظْهِرَ ذَاتَكَ لَنَا وَلَيْسَ لِلعَالَمِ؟».
لوقا ٦: ١٦
يَهُوذَا انظر شرح متّى ١٠: ٣. وسمّى هنالك لباوس وتداوس، وهو أخو يعقوب بن حلفى (لوقا ٦: ١٦) وكاتب الرسالة المنسوبة إليه، ولم يُذكر في البشائر باسمه سوى ثلاث مرات إحداها هنا والأخريان في جدولي أسماء الرسل. وكلامه يدل على أنه شارك سائر الرسل في أفكارهم اليهودية الدنيوية المتعلقة بالمسيح وملكوته.
لَيْسَ الإِسْخَرْيُوطِيَّ قال ذلك تمييزاً له عن الخائن الذي كان قد خرج (يوحنا ١٣: ٣٠).
مَاذَا حَدَثَ ظن يهوذا أن المسيح عازم على إنشاء مملكة ظاهرة زمنية مجيدة على هذه الأرض على وفق ما قيل في ملاخي ٣: ١، وقول إشعياء «فَتَسِيرُ الأُمَمُ فِي نُورِكِ، وَالمُلُوكُ فِي ضِيَاءِ إِشْرَاقِكِ» (إشعياء ٦٠: ٣). فلم يستطع يهوذا التوفيق بين تلك النبوة وقول المسيح إنه يعلن ذاته للتلاميذ دون غيرهم، واحتار في كيف يكون ظاهراً للبعض وغير ظاهر للآخر. ولعله قصد أن ينصح يسوع أن لا يكتفي بإعلان ذاته للرسل قليلي العدد، بل الأجدر به أن يعلنها لكل أهل العالم بأوضح طريق ملكاً منتصراً ليقتنع الجميع بدعواه ويسجدون له.
٢٣ «أَجَابَ يَسُوعُ: إِنْ أَحَبَّنِي أَحَدٌ يَحْفَظْ كلامِي، وَيُحِبُّهُ أَبِي، وَإِلَيْهِ نَأْتِي، وَعِنْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلاً».
ع ١٥ رومية ٨: ١٥ و١يوحنا ٢: ٢٤ ورؤيا ٣: ٢٠
جواب المسيح ليهوذا في هذه الآية والآية التي بعدها، وخلاصته أن العالم ليس مستعداً لرؤية الآب والابن، لأن الشرط الضروري لذلك هو المحبة التي تنشئ الطاعة.
إِنْ أَحَبَّنِي أَحَدٌ يَحْفَظْ كلامِي هذا كقوله في ع ١٥، ٢١، وفيه الشرط الضروري لإظهار ذاته، فالمؤمنون يقومون بالشرط ويرونه، أما العالم فلا يحبه ويرفض كلامه فلا يراه. وقصد المسيح «بكلامه» هنا كل تعاليمه أو وصاياه (ع ١٥). والمراد بحفظ كلامه هنا تخبئته في صميم القلب لا في الذاكرة فقط، لكي يتأصل ويأتي بأثمار السيرة الطاهرة النافعة للعالم التي تمجد الله. وليس المقصود من حفظ كلامه استظهار كل كلمة منه، بل العزم على ذلك والاجتهاد فيه.
إِلَيْهِ نَأْتِي أنا والآب.
وَعِنْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلاً هذا كناية عن الحضور الإلهي في قلب المؤمن دائماً لا وقتياً، ولا يشعر به إلا من يختبره في نفسه. سكن الله قديماً بين بني إسرائيل في الخيمة والهيكل (خروج ٢٥: ٨ و٢٩: ٤٥ ولاويين ٢٦: ١١ ،١٢ وحزقيال ٣٧: ٢٦). ولكنه يسكن الآن في قلب المؤمن جاعلاً إيّاها هيكلاً له (لوقا ١٧: ٢٠ و ١كورنثوس ٣: ١٦ و٦: ١٩ ورؤيا ٣: ٢٠). وهذا الوعد لأدنى الناس وأبسطهم كما أنه لأسماهم وأعلمهم، وهو ثواب المحبة والطاعة. فيجب أن لا يظن أحد أنه متروك بعد تنازل الآب والابن لضيافته لأنه يحصل بذلك على أعز الأصدقاء وأشرفهم. فمن اتخاذ الآب والابن قلبه منزلاً لهما نال النعمة والتعزية، وتيقن المغفرة وراحة الضمير ومعرفة الأمور الروحية والسرور بها والإرشاد والحماية. فالله سكن مع المؤمن على الأرض والمؤمن يسكن مع الله في السماء.
٢٤ «اَلَّذِي لا يُحِبُّنِي لا يَحْفَظُ كلامِي. وَالكلامُ الَّذِي تَسْمَعُونَهُ لَيْسَ لِي بَل لِلآبِ الَّذِي أَرْسَلَنِي».
يوحنا ٥: ١٩، ٣٨ و٧: ١٦ و٨: ٢٨ و١٢: ٤٩ وع ١٠
هذا الآية بمعنى التي قبلها إلا أنها في صورة السلب، لأنه لا طاعة حيث لا محبة، ولا مجازاة حيث لا طاعة. والمجازاة هنا محبة الآب وسكنه مع الابن في القلب، وإظهار المسيح ذاته. فالإقرار بالإيمان ومعرفة الحق وفصاحة المنطق وتقديم النذور وذرف الدموع إن كانت بلا طاعة فهي باطلة.
في ع ٢٣ رأينا جواب المسيح على سؤال يهوذا «كيف تظهر ذاتك لنا؟» وفي هذا العدد جوابه لسؤال «كيف لا تظهر ذاتك للعالم؟» لأن العالم الذي يرفض المسيح يوصد أبواب الاتصال بين الآب والقلوب.
لَيْسَ لِي قال ذلك ليبيّن للتلاميذ سلطان كلامه وأهميته. ولم ينكر المسيح بقوله «ليس لي» أنه كلامه، بل صرّح بأنه كلامه وكلام الآب معاً. فالذي يرفض كلام المسيح يهين الآب لأنه كلامه أيضاً. والذي يقبله يكرم الآب.
٢٥ «بِهَذَا كَلَّمْتُكُمْ وَأَنَا عِنْدَكُمْ».
قال هذا استعداداً لذهابه وتسليمه إيّاهم إلى معلم آخر، فإن كل ما كانوا قد حصلوا عليه من التعليم منذ أول أمره معهم إلى الآن كان من شفتيه، وهم نسوا بعض ما سمعوه، ووجدوا بعضه عسر الإدراك. ولعلهم كانوا مضطربين من كل ذلك، فقصد تعزيتهم بمن يقوم بكل حاجاتهم الروحية من التذكير والإيضاح والتعليم.
٢٦ «وَأَمَّا المُعَزِّي، الرُّوحُ القُدُسُ، الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي، فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلتُهُ لَكُمْ».
لوقا ٢٤: ٤٩ وع ١٦ ويوحنا ٢: ٢٢ و١٢: ١٦ و١٦: ١٣ ١٥: ٢٦ و١٧: ٧ و١يوحنا ٢: ٢٧
المُعَزِّي انظر شرح ع ١٦.
الرُّوحُ القُدُسُ هذا تفسير للمعزي وهو الأقنوم الثالث من اللاهوت، ووُصف بالقداسة لأن وظيفته تقديس قلوب الناس (فيلبي ٢: ١٢، ١٣ عبرانيين ١٣: ٢٠، ٢١) ووُصف في ع ١٧ بالحق لأن الحق آلته التي يقدس بها.
الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ في مواضع أخرى أن الابن يرسله، ونتيجة ذلك أنه رسول كليهما.
بِاسْمِي لأن عمل المسيح إعلان الآب، ويأتي الروح لإتمام ذلك. فمعنى قوله «اسمي» بسلطاني كما أني أتيت باسم الآب (يوحنا ٥: ٤٣). وأتى الروح باسم المسيح لأنه كان نائباً عنه (ع ١٣) ولأنه أتى إجابة لصلواته (ع ١٦) ولصلوات تلاميذه الطالبين اسمه.
فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ يتعلق بطريق الخلاص مما تحتاجون إلى معرفته وتستطيعون إدراكه، فليس المقصود أنه يعلمهم كل أنواع العلوم كالفلسفة وغيرها، فإن تعليم يسوع جهزهم لقبول أسمى تعاليم الروح القدس (يوحنا ١٦: ١٣).
وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلتُهُ لَكُمْ الذي يسمعه الإنسان ولا يدركه ينساه سريعاً. والتلاميذ سمعوا من يسوع أشياء كثيرة منعتهم آراؤهم اليهودية من إدراك معناها الروحي، ولم يستطيعوا ذلك إلا بعد إنارة الروح لهم. على أنهم نسوا كثيراً منها، فوعدهم يسوع بأن الروح سيذكرهم متى قدروا أن يدركوا معناه. ومن أمثلة ذلك ما في يوحنا ٢: ٢٢ و٧: ٣٨، ٣٩ و١٢: ١٦، فبشارة يوحنا كلها من تذكير الروح القدس لكاتبها لأنه كتب حوادثها ومحاوراتها وسائر تعاليمها بعد موت المسيح بنحو خمسين سنة. وفي هذه الآية وعدٌ بأمرين: (١) أهمية تعليم الروح. (٢) تذكيره إيّاهم قبلاً. وإنجاز الوعد بالأول في سفر أعمال الرسل، وإنجاز الوعد بالثاني في بشارة يوحنا التي كُتبت بعد خمسين سنة من صلب المسيح على ما فيها من التدقيق في ذكر الحوادث والمحاورات والتعاليم.. ومع أن الوعد بتعليم الروح القدس قد وُجِّه إلى التلاميذ خاصة، إلا أنه لا يقتصر عليهم، فهو لكل المؤمنين في كل مكان وزمان.. والوعد لتلاميذ المسيح يومئذ بتعليم الروح إيّاهم كل شيء برهان قاطع على كمال أسفار العهد الجديد التي هي تعليم الروح القدس بواسطة مؤلفيها، فلا محل لتعاليم جديدة في الدين في العصور التي بعد عصرهم.
ترك المسيح سلامه لتلاميذه (ع ٢٧ - ٣١)
٢٧ «سلاماً أَتْرُكُ لَكُمْ. سلامِي أُعْطِيكُمْ. لَيْسَ كَمَا يُعْطِي العَالَمُ أُعْطِيكُمْ أَنَا. لا تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ ولا تَرْهَبْ».
فيلبي ٤: ٧ وكولوسي ٣: ١٥ إرميا ٦: ١٤ وع ١
في هذه الآية تعزية خامسة للتلاميذ على مفارقة المسيح إيّاهم: (١) اجتماعه به في السماء (ع ٢، ٣). (٢) صنعهم أعمالاً أعظم من أعماله (ع ١٢). (٣) إجابة صلواتهم (ع ١٣، ١٤). (٤) مجيء المعزي (ع ١٦، ٢٦). وكلام المسيح هنا كلام وداع وبركة وتوصية.
سَلاماً شاع مثل هذا الكلام قديماً وحديثاً بين الأصحاب عند اللقاء وعند المفارقة (١صموئيل ١: ١٧ ومتّى ١٠: ١٣ ولوقا ٧: ٥٠ وأعمال ١٦: ٣٦ و١بطرس ٥: ١٤ و٣يوحنا ١٥). لما فارق يسوع هذا العالم ترك نفسه للآب، وجسده ليوسف الرامي، وثيابه للعسكر الذي صلبه، وأمّه ليوحنا. وأما تلاميذه فترك لهم السلام، لا المناصب ولا الغنى ولا الشرف. وعند ولادة المسيح ترنّم الملائكة قائلين «على الأرض السلام» وعند موته قال لتلاميذه «سلاماً أترك لكم».
سلامِي قال ذلك تمييزاً له عن تحيات الناس التي كثيراً ما تكون مجرد ألفاظ. ويمتاز سلام المسيح عن سلام البشر بستة أمور: (١) أنه لا يقدر أن يعطي هذا السلام أحدٌ غيره. (٢) أنه يشبه السلام الذي حصل عليه من تأكد من محبة الآب. (٣) أنه اشتراه لهم بدمه لأنه نتيجة المصالحة مع الله. (٤) أنه سلام الضمير، لأنه من نتائج تلك المصالحة. (٥) أنه مبني على تأكيد حماية المسيح لهم في وقت الاضطهاد. (٦) أنه دائم لا يضعفه المرض ولا يسلبه الفقر ولا يفنيه الموت (رومية ١: ٧ و٥: ١ و٨: ٦ و١٤: ٧ وغلاطية ٥: ٢٢ وأفسس ٢: ١٤ و١٧ و٦: ١٥ وفيلبي ٤: ٧ وكولوسي ٣: ١٥). وتأثير كل ما سبق من التعزيات هو هذا السلام بعينه، وبه سكَّن المسيح اضطراب قلوبهم على مفارقته إيّاهم.
لَيْسَ كَمَا يُعْطِي العَالَمُ لأن السلام عطية روحية وعطايا العالم ليست كذلك. وهو يمتاز عن سلام العالم بأربعة أمور: (١) مصدره: فإن مصدر سلام العالم اللذة والصيت والغنى والفلسفة، ومصدر سلام المسيح صليبه. (٢) كماله: فإن سلام العالم ناقص لما يخالطه من هموم وخوف ويأس، أما سلام المسيح فيسدد كل حاجات النفس. (٣) صدقه دائماً: لأن سلام العالم كثيراً ما يكون كاذباً ولا سيما سلام الذين يرجون الخلاص من أعمالهم أو أعمال غيرهم من البشر (إرميا ٦: ١٤). (٤) بقاؤه: فإن سلام العالم زائل ينتهي عند الموت.
لا تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ هذا مثل ما في ع ١، وكرره بناءً على التعزيات التي ذكرها لهم.
ولا تَرْهَبْ بانتظاركم الضيق والاضطهاد والموت، فصدِّقوا حضوري معكم، وأن سلامي لا يفارقكم.
أَنِّي قُلتُ لَكُمْ في يوحنا ١٣: ٣٣ - ٣٦ و١٤: ٢، ٣، ١٢، ١٩، ٢٠.
لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي لَكُنْتُمْ تَفْرَحُونَ ظاهر العبارة يدل على عدم محبتهم له، وهو ليس المراد لأنه عرف أنهم يحبونه. إنما أراد أنهم أظهروا بشدة حزنهم على فراقه أن محبتهم غير كاملة، لأنهم نظروا إلى خسارتهم ولم يلتفتوا إلى ربحه. فكأنه قال لهم: على قدر إخلاص محبتكم لي تفرحون بذهابي عنكم.
لأنِّي قُلتُ أَمْضِي إِلَى الآبِ أي إلى السماء حيث يُظهر الآب حضوره ومجده ليتمجد بعد تواضعه بعمل الفداء، وليكمل ذلك العمل بشفاعته في تلاميذه، وليرسل إليهم الروح القدس، وتمجيد المسيح يستلزم تمجيدهم متى صاروا إليه.
لأنَّ أَبِي أَعْظَمُ مِنِّي لا في الطبيعة لأنهما متساويان، لكن في الحال التي تكلم فيها بهذا الكلام، وهي حال تواضعه وألمه باعتباره فادي الخطاة، وفق قول يوحنا «الكلمة صار جسداً» (يوحنا ١: ١٤) وقول بولس «أخلى نفسه آخذاً صورة عبد» (فيلبي ٢: ٧). فبمقتضى عهد الفداء أرسل الآب ابنه والروح القدس وكل فوائد الخلاص، فكان أعظم من الابن في الوظيفة. وأعظمية الآب لم تكن دائمة بل وقتية (فيلبي ٢: ٩ - ١١). فكان على التلاميذ أن يفرحوا بذهابه عنهم، لأنه بذلك يرجع بعد تواضعه كعبد نحو ٣٣ سنة إلى حال السعادة والمجد التي كانت حاله مع الآب، لكي يُكلل ملكاً للملوك ورباً للأرباب، ولأن الروح القدس يحل عليهم بعد ذلك الذهاب فينجح التبشير بالإنجيل نجاحاً عظيماً (يوحنا ١٦: ٧ - ١٠).
٢٨ «سَمِعْتُمْ أَنِّي قُلتُ لَكُمْ أَنَا أَذْهَبُ ثُمَّ آتِي إِلَيْكُمْ. لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي لَكُنْتُمْ تَفْرَحُونَ لأنِّي قُلتُ أَمْضِي إِلَى الآبِ، لأنَّ أَبِي أَعْظَمُ مِنِّي».
ع ٣، ١٢، ١٨ ويوحنا ١٦: ١٦ و٢٠: ١٧ ويوحنا ٥: ١٨ و١٠: ٣٠ وفيلبي ٢: ٦ - ١١
سبق الكلام على معنى هذه الآية في شرح (ع ٢٧) فراجعه هناك.
٢٩ «وَقُلتُ لَكُمُ الآنَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ، حَتَّى مَتَى كَانَ تُؤْمِنُونَ».
يوحنا ١٣: ١٩ و١٦: ٤
قَبْلَ أَنْ يَكُونَ أي قبل موتي على الصليب ودفني.
تُؤْمِنُونَ أي تزيدون إيماناً بأني أنا المسيح حقاً رسول الآب لتيقنكم معرفتي بما في المستقبل. وهذا مثل ما قيل في يوحنا ١٣: ١٩. ولولا هذه النبوة لزادت شكوكهم كثيراً يوم رأوه مقبوضاً عليه ومصلوباً.
٣٠ «لا أَتَكَلَّمُ أَيْضاً مَعَكُمْ كَثِيراً، لأنَّ رَئِيسَ هَذَا العَالَمِ يَأْتِي وَلَيْسَ لَهُ فِيَّ شَيْءٌ».
يوحنا ١٢: ٣١ و١٦: ١١
لا أَتَكَلَّمُ أَيْضاً مَعَكُمْ كَثِيراً لم يكن قد بقي من حياته على الأرض إلا بضع ساعات من النهار.
رَئِيسَ هَذَا العَالَمِ أي الشيطان. انظر شرح يوحنا ١٢: ٣١. يأتي ليجربه في وقت آلامه وبواسطة تلك الآلام. ولعل كثيراً من ألمه في بستان جثسيماني كان من محاربته لعدو الله والناس بدليل قوله «هَذِهِ سَاعَتُكُمْ وَسُلطَانُ الظُّلمَةِ» (لوقا ٢٢: ٥٣) قارن هذا بالقول «وَلَمَّا أَكْمَلَ إِبْلِيسُ كُلَّ تَجْرِبَةٍ (أي في البرية) فَارَقَهُ إِلَى حِينٍ» (لوقا ٤: ١٣). وليهيج الناس عليه أيضاً بدخوله في يهوذا ليأتي بعد قليل ويسلمه، ويحرك العسكر ليقبضوا عليه، والفريسيين ورؤساء الكهنة ليشتكوا عليه، والرومان ليحكموا عليه ويصلبوه. واكتفى بذكر فعل الشيطان لأنه سبب كل الشر.
وَلَيْسَ لَهُ فِيَّ شَيْءٌ أي لا سبيل له إلى الانتصار عليه، فليس فيه شهوات جسدية ليثيرها، ولا أنانية ليرضيها. فكل مبتغاه أن يُرضي أباه، فلم يكن للشيطان ما يقوده به إلى الخطية. وهذه حجة قاطعة على كمال قداسة المسيح. وما قيل عليه لا يصح أن يقال على أطهر البشر.
٣١ «وَلَكِنْ لِيَفْهَمَ العَالَمُ أَنِّي أُحِبُّ الآبَ، وَكَمَا أَوْصَانِي الآبُ هَكَذَا أَفْعَلُ. قُومُوا نَنْطَلِقْ مِنْ هَهُنَا».
يوحنا ١٠: ١٨ وفيلبي ٢: ٨ وعبرانيين ٥: ٨
لِيَفْهَمَ العَالَمُ أَنِّي أُحِبُّ الآبَ أظهر المسيح محبته للآب باحتماله تجربة إبليس، وبانتصاره عليه إذ كان «مُجَرَّباً فِي كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُنَا، بِلا خَطِيَّةٍ» (عبرانيين ٤: ١٥). وكانت تجربته برهاناً على محبته للآب. ولا شك أن الشيطان بذل كل وقته ليجعل آدم الثاني يخطئ كما أخطأ آدم الأول، فكان كل اجتهاده عبثاً. ولعل كلامه غير مقصور على التجربة، بل يشتمل على كل ما فعله لفداء الخطاة طوعاً لإرادة أبيه، فهو البار الذي مات بدل الأثمة ليخلصهم.
كَمَا أَوْصَانِي الآبُ هَكَذَا أَفْعَلُ من أول الحياة إلى آخرها، وهذا يتضمن تجسده، ووضع نفسه تحت الناموس، وتكميله كل بر، واحتماله تجربة إبليس وعار الناس وبغضهم، وموته أخيراً كفارة عن العالم.
قُومُوا نَنْطَلِقْ مِنْ هَهُنَا الأرجح أن المسيح وتلاميذه قاموا عن المائدة لما قال ذلك، وأنه تكلم بما بقي من خطابه في يوحنا ١٥، ١٦، وبصلاته في يوحنا ١٧. وهم لم يزالوا واقفين في البيت إذ لا انقطاع في الكلام، ولأنه قيل في يوحنا ١٨: ١ «قَالَ يَسُوعُ هَذَا وَخَرَجَ مَعَ تلامِيذِهِ إِلَى عَبْرِ وَادِي قَدْرُونَ» ولكن ظن بعضهم أنه تكلم بذلك وهم سائرون في الطريق من البيت إلى بستان جثسيماني.
الأصحاح الخامس عشر
الخطاب الوداعي: مثَل الكرمة والأغصان (ع ١ - ١٧)
١ «أَنَا الكَرْمَةُ الحَقِيقِيَّةُ وَأَبِي الكَرَّامُ».
كانت غاية المسيح في أصحاح ١٤ تعزية تلاميذه، وغايته في هذا الأصحاح أن يعلمهم، فضرب لهم مثل الكرمة والأغصان ليبيّن أن العلاقة بينه وبينهم تبقى ثابتة بعد ذهابه عنهم لأنها روحية لا مادية، وأنه هو المصدر الوحيد لحياتهم وقوتهم ونفعهم لغيرهم، بشرط أن يتمسكوا به دائماً.
أَنَا الكَرْمَةُ الحَقِيقِيَّةُ هذا كقوله إنه النور الحقيقي (يوحنا ١: ٩) والخبز الحقيقي (يوحنا ٦: ٣٢) فارجع إلى الشرح هناك. والمعنى أن الكرمة رمز والمسيح هو المرموز إليه الحقيقي. فلم يتكلم على نفسه كإنسان على وشك أن يموت، بل باعتباره المسيح الحي إلى الأبد، الذي يحضر مع تلاميذه دائماً بروحه. وشبَّه نفسه بالكرمة ليبيّن كمال الاتحاد بينه وبين تلاميذه الاتحاد الضروري لحياتهم الروحية ونموهم وتقواهم. وقد شُبِّه هذا الاتحاد أيضاً بمثل الرأس والأعضاء ( ١كورنثوس ١٢: ١٢ وأفسس ٥: ٢٣، ٣٠ وكولوسي ٢: ١٩). فكما أن العُصارة تجري من الكرمة إلى الأغصان لتغذيها وتجعلها نامية ناضرة، كذلك المسيح مصدر حياة التلاميذ والقوة والنعمة والخصب الروحي. وكثيراً ما شبهت في العهد القديم العلاقة بين الله والناس بالعلاقة بين الكرم والكرّام (مزمور ٨٠: ٨ - ١٩ وإشعياء ٥: ١ - ٧ وإرميا ٢: ٢١ وحزقيال ١٩: ١٠ - ١٤ وهوشع ١٠: ١ ويوئيل ١: ٧). وربما قال المسيح إنه هو الكرمة الحقيقية للتمييز بينه وبين بني إسرائيل الذين سماهم الله كرمته قديماً، وكان على جميع الناس أن يكونوا أغصاناً في تلك الكرمة ليُحسبوا من شعبه، ولكن الله رفض أن يكونوا كرمته لعدم استحقاقهم، وعيّن يسوع الكرمة الحقيقية وأوجب على الكل الاتحاد به بالإيمان.
وَأَبِي الكَرَّامُ هذا يشير إلى أن الكرمة ملكه، وأنه مهتمٌّ بنموها وصيانتها وخصبها. فإن الله اختار يسوع أصل البركة للناس، وأن تجري النعمة منه إلى قلوب المؤمنين، ويسأل الله عن خيرهم ونفعهم لغيرهم وتمجيده بهم. وقد شُبّه الله بالكرام في متّى ٢١: ٣٣ ومرقس ١٢: ١ ولوقا ٢٠: ٩).
٢ «كُلُّ غُصْنٍ فِيَّ لا يَأْتِي بِثَمَرٍ يَنْزِعُهُ، وَكُلُّ مَا يَأْتِي بِثَمَرٍ يُنَقِّيهِ لِيَأْتِيَ بِثَمَرٍ أَكْثَرَ».
متّى ١٥: ١٣
كُلُّ غُصْنٍ فِيَّ أي كل من يعترف بأنه مسيحي.
لا يَأْتِي بِثَمَرٍ أي لا يظهر بأعماله حقيقة إيمانه.
يَنْزِعُهُ للكرّام الأرضي عملان: قطع العقيم من الأغصان، والتهذيب. ولله في كنيسته عملان يشبهانهما، الأول النزع: وهو أن يفصل عن شعبه الذين لا يفعلون ما يبرهن أنهم متحدون بالمسيح، ومثال هؤلاء يهوذا الإسخريوطي، وحنانيا وسفيرة، وديماس، وسيمون الساحر. وذكر العُقم أو عدم الإثمار علة للقطع، لأنه يبرهن عدل الله في ذلك القطع. نعم إن الله يعرف القلوب بغير حاجة إلى شهادة الأعمال، لكن ذكر ذلك يبين لنا أن عقابه عادل. ولم يذكر هنا كيف يفصل الله العقيم عن كرمته الروحية، لكنه يفعل ذلك بأحد خمس طُرق: (١) أن تُصدر الكنيسة حُكم القطع بإرشاد الروح القدس ( ١كورنثوس ٥: ٤، ٥، ١٢). (٢) أن يمتحن الله الإنسان بتركه للشهوات الجسدية وغرور هذا العالم. (٣) أن يمتحنه بالاضطهادات والضيقات. (٤) أن يعاقبه بضربات خاصة كما عاقب حنانيا سفيرة. (٥) أن يميته، وهو أعظم طرق النزع، ولو أن موت المؤمن ليس انفصالاً عن كرمة الله.
وَكُلُّ مَا يَأْتِي بِثَمَرٍ يُنَقِّيهِ كما يفعل الكرام الأرضي بالكرمة المثمرة ليزيدها إثماراً. وهذه التنقية هي العمل الثاني. وينقي الله شعبه غالباً بالمصائب والأمراض لتقوية نموهم الروحي وزيادة تقواهم ونفعهم لغيرهم (١كورنثوس ١١: ٣٠ - ٣٢). فإذا رأى الله أن المال يمنع المؤمن من الرغبة في الغنى الحقيقي حرمه ماله، وإن رأى أنه يحب أولاده أو غيرهم من الأقرباء والأصدقاء أكثر منه أخذهم منه، وإذا رآه متكلاً على نفسه لقوته سمح بمرضه. وفي هذا السبيل ينقي شعبه من الضلال والكبرياء ومحبة العالم وسرعة الغضب وشدة التعصب وأمثال ذلك مما يمنعهم من الإتيان بالثمار الروحية. وعلاوة على ما ذُكر ينقي عبيده بتأثيرات روحه القدوس في قلوبهم، وبإنذارات كتابه المقدس.
لِيَأْتِيَ بِثَمَرٍ أَكْثَرَ وتُعرف ماهية هذا الثمر من شرح متّى ٧: ١٦ - ٢٠ ومما في غلاطية ٥: ٢٢، ٢٣. وذلك الثمر هو الأعمال الصالحة، ولا سيما الأعمال التي يقود بها الناس إلى الإيمان بالمسيح وإلى القداسة والسعادة. ولنا من هذه الآية ست فوائد: (١) إمكان أن يظهر الإنسان مؤمناً أمام الناس وهو ليس كذلك عند الله. (٢) لا بد أن الله يقطع مثل هذا الإنسان ويدفعه إلى الهلاك الأبدي. (٣) استحالة أن يكون الإنسان مؤمناً حقيقياً ولا يُظهر ذلك بأعمال تمجِّد الله وتنفع الناس. (٤) ليست بلايا الصديقين دليلاً على أنهم أشرّ من غيرهم وأن الله قد غضب عليهم، بل هي علامة محبته لهم إذ أصابهم بها لينقيهم. (٥) لا يمكن أن ينفصل المؤمن الحقيقي عن الله إلى الأبد ولو حرمه كل البشر. (٦) يراقب الله كنيسته دوماً لينزع المرائين وينقّي الصالحين.
٣ «أَنْتُمُ الآنَ أَنْقِيَاءُ لِسَبَبِ الكلامِ الَّذِي كَلَّمْتُكُمْ بِهِ».
يوحنا ١٣: ١٩ و١٧: ١٧ وأفسس ٥: ٢٦ و١بطرس ١: ٢
أَنْتُمُ الآنَ أَنْقِيَاءُ أبان المسيح بذلك أن تلاميذه هم من الذين أخذ الله ينقيهم، لا من الذين قصد أن ينزعهم. وقوله إنهم أنقياء لا يعني أنهم بلغوا الكمال، بل يعني أنهم يتقدمون في الطهارة يوماً فيوماً تحت إرشاده (انظر شرح يوحنا ١٣: ١٠).
لِسَبَبِ الكلامِ الَّذِي كَلَّمْتُكُمْ بِهِ كانت تعاليم يسوع لهم واسطة تنقية فيها أصلح كثيراً من آرائهم الفاسدة في شأن المسيح الموعود به وفي أمر ملكوته. وبيّن لهم سوء الخصام على المراتب العالية. ورغَّبهم في ترك كل شيء لأجل اسمه. وأمرهم أن يأتـوا بعد موته بثمر لتمجيد اسمه بتبشيرهم اليهود والأمم باسمه. وهو لا يزال ينقي تلاميذه بكلامه حتى يكونوا كاملين في السماء (يوحنا ٥: ٢٤ و٨: ٣١، ٣٢ و١٢: ٤٨ و١٧: ١٠، ١٧ وأفسس ٥: ٢٦ ويعقوب ١: ١٨ و١بطرس ١: ٢٣). وقال لهم: أنتم أنقياء لسبب الكلام، فهو آلة الروح القدس لتنقية من يسمعه ويؤمن به. ولعل المسيح أشار إلى أن يهوذا الإسخريوطي نُزع منهم فتنقّوا بذلك.
٤ «اُثْبُتُوا فِيَّ وَأَنَا فِيكُمْ. كَمَا أَنَّ الغُصْنَ لا يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ بِثَمَرٍ مِنْ ذَاتِهِ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِي الكَرْمَةِ، كَذَلِكَ أَنْتُمْ أَيْضاً إِنْ لَمْ تَثْبُتُوا فِيَّ».
كولوسي ١: ٢٣ و١يوحنا ٢: ٦
اُثْبُتُوا فِيَّ شرط حياة الغصن ثبوته في كرمته، وكذلك شرط حياة المسيحي ثبوته في المسيح. وفي هذا ثلاثة أمور: (١) ترك الإنسان الاتكال على نفسه أو على قوة أحد المخلوقات من الملائكة أو البشر لأجل الحكمة والقوة والفضيلة والخلاص. (٢) اختياره المسيح نصيباً وتمسكه به بالإيمان للحياة الروحية. (٣) المواظبة على ذلك التمسك لأن احتياجه إلى المسيح دائم.
ذُكر في ما مرّ من هذا الأصحاح ثلاثة أعمال تتعلَّق بالكرمة: وهي نزع العقيم، وتنقية المثمر، وثبوت الغصن في كرمته. فالأول والثاني من أعمال الكرّام، والثالث من أعمال الغصن. لكن ليس للغصن في الكرمة الطبيعية قوة اختيارية للثبوت في الكرمة أو لعدمه. أما الإنسان المرموز إليه بالغصن فله تلك القوة، ولذلك قال المسيح لتلاميذه: اثبتوا أنتم، فجعل بذلك على المؤمن مسؤولية إن لم يقم بها لم ينفعه المسيح شيئاً. وسبق الكلام على الثبوت في شرح يوحنا ٦: ٥٦، وهو الاتحاد بالمسيح في الشعور والقصد والعمل (١يوحنا ٢: ٦ و٢٤ - ٢٨). والأمر الجوهري في الثبوت هو الإيمان الذي به نصير أغصاناً في الكرمة، وبه نثبت فيها، وبه نأتي بالأثمار.
وَأَنَا فِيكُمْ علاقة هذا الكلام بما قبله كعلاقة السبب بالنتيجة، لأنه إن لم يكن المسيح فيهم لا يثبتون فيه. على أن ثبوت المسيح فيهم يتوقف على إرادتهم، ولذلك جعل ثبوتهم فيه شرطاً لكونه فيهم. وهذا مثل قوله «إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ البَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي» (رؤيا ٣: ٢٠). وكون المسيح في التلاميذ يؤكد لهم تأثيرات الروح القدس لإنارتهم وتقديسهم وتعزيتهم، وحفظهم من السقوط، ووفرة نعمته (رومية ٨: ٩ و١يوحنا ٣: ٢٤ و٤: ١٣).
كَمَا أَنَّ الغُصْنَ لا يَقْدِرُ هذا تعليل وإيضاح لما ذُكر. فما قيل هنا في شأن الغصن الطبيعي بديهي، فالغصن لا يستقل بحياته، وهو يحيا وينمو ويثمر ما دام متصلاً بكرمته، وإن قُطع يذبل ويموت. والمسيح أكد لهم أن حياتهم الروحية كذلك بالنسبة إليه، فإن بدءها منه ونهايتها بالانفصال عنه. وجاء بهذا المعنى في صورة النفي، أي بقوله «إن لم تثبتوا» إنذاراً لهم من خطر الانفصال بالاتكال على النفس. وخلاصة ما في هذه الآية وجوب الاتصال التام الدائم بين المسيح وتلاميذه.
٥ «أَنَا الكَرْمَةُ وَأَنْتُمُ الأَغْصَانُ. الَّذِي يَثْبُتُ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ هَذَا يَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيرٍ، لأنَّكُمْ بِدُونِي لا تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئاً».
هوشع ١٤: ٨ وفيلبي ١: ١١ و٤: ١٣ أعمال ٤: ١٢
أَنَا الكَرْمَةُ هذا مثل قوله في العدد الأول كرره للتوكيد والتأثير.
وَأَنْتُمُ الأَغْصَانُ الكلمة المهمة في هذه الجملة «أنتم» فما قاله المسيح سابقاً في الأغصان عموماً خصصه هنا بالتلاميذ، ومعناه أنه يجب عليكم أن تبقوا بعد مفارقتي إيّاكم بالجسد متصلين بي اتصال الأغصان بالكرمة.
الَّذِي يَثْبُتُ.. يَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيرٍ هذا كقوله في الآية السابقة، إلا أن ذلك في صورة النفي وهذا في صورة الإيجاب، وفيه زيادة قوله «كثير». ونستنتج من هذه الزيادة أنه لا يجوز للمسيحي أن يكتفي بالإتيان بأثمار قليلة، وأنه يجب عليه الاجتهاد ليأتي بثمر وافر، تعبيراً عن شكره للمسيح على خلاصه العظيم، وتمجيداً للإله العظيم، ورغبة في إنقاذ الناس من الخطر العظيم. ويتوقف مقدار الإثمار على مقدار الاتحاد بالمسيح بالإيمان والمحبة، والتقرب منه بالصلاة، وطلب الإرشاد من كتابه كل يوم.
بِدُونِي لا تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئاً يحسبه الله ثمراً أي خدمة مقبولة. ولا حجة بذلك للمسيحي على الكسل، كأن يقول: أنا عاجز، والمسيح هو الذي يفعل كل ما يجب. لكن فيه داعياً إلى الاجتهاد بالاتكال على يسوع. وفي هذا خمسة أمور هامة: (١) التحذير من الاتكال على الذات، لأن المسيح لم يقل «بدوني لا تقدرون أن تفعلوا إلا قليلاً»، بل: «لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً» (٢كورنثوس ٣: ٥). (٢) توضيح احتياج المسيحي إلى المسيح مصدر الحياة (يوحنا ١: ٤) فيهبها لنا باعتباره خبز الحياة وماء الحياة. (٣) إظهار السبب في أن مسيحيين كثيرين لا يفيدون غيرهم لأنهم لم يطلبوا النعمة والقوة من المسيح. (٤) وجوب أن يعطي المسيحيون كل مجد للمسيح على ما لهم من صلاح، لأن أفكارهم الروحية وعواطفهم الحسنة وكلماتهم المفيدة وأعمالهم النافعة نتيجة لثبوته فيهم. (٥) المسيحي يستطيع كل شيء بالمسيح فيقول «أَسْتَطِيعُ كُلَّ شَيْءٍ فِي المَسِيحِ الَّذِي يُقَوِّينِي» (فيلبي ٤: ١٣).
٦ «إِنْ كَانَ أَحَدٌ لا يَثْبُتُ فِيَّ يُطْرَحُ خَارِجاً كَالغُصْنِ، فَيَجِفُّ وَيَجْمَعُونَهُ وَيَطْرَحُونَهُ فِي النَّارِ، فَيَحْتَرِقُ».
متّى ٣: ١٠ و٧: ١٩
تكلم المسيح في ع ٥ عن الأغصان المثمرة، وشرع يتكلم هنا عن غير المثمرة، فذكر ما يفعله الناس بالأغصان اليابسة مثالاً للعقاب الهائل المعد لكل تلميذ عقيم لم يثبت في المسيح. ويشتمل ذلك على خمسة أمور: العزل، والجفاف، والجمع، والطرح في النار، والاحتراق. وأمثلتها في الروحيات (١) إخراج العبد البطال بأمر الله من شعبه (متّى ٨: ١٢ و٢٢: ١٣). (٢) حال المسيحي حين يفارقه الروح القدس (١تسالونيكي ٥: ١٩). (٣) عمل الملائكة في اليوم الأخير، كما ذُكر في تفسير مثل الزوان والحنطة متّى ١٣: ٤١ ولوقا ١٢: ٢٠. (٤، ٥) دينونة اليوم الأخير والعقاب الذي يليها (متّى ١٣: ٤٣).
وهذا العقاب ليس مقصوراً على الفجار الذين يعصون الله ويكفرون به، بل يعم الذين يعترفون بأنهم مسيحيون ولا يثبتون في المسيح ولا يأتون بأثمار. فإذاً مجرد عدم الثبوت في المسيح يؤكد هلاك الإنسان، لأن الله عيّن لكل غصن في الكرمة إما الإثمار أو الإحراق (حزقيال ١٥: ٥). وقد قصد المسيح بهذه الآية التلميذ العقيم، ولكنّ كلامه صدق على الكنيسة اليهودية جملة، لأنه قطعها لعدم إثمارها.
٧ «إِنْ ثَبَتُّمْ فِيَّ وَثَبَتَ كلامِي فِيكُمْ تَطْلُبُونَ مَا تُرِيدُونَ فَيَكُونُ لَكُمْ».
يوحنا ١٤: ١٣، ١٤ وع ١٦ ويوحنا ١٦: ٢٣
إِنْ ثَبَتُّمْ فِيَّ وَثَبَتَ كلامِي فِيكُمْ ربط ثبوته فيهم بثبوت كلامه كذلك، فالثبوت لا يكون بدون الكلام الذي هو تعاليمه التي أعلنها لهم. ولم يُرد بثبوت كلامه فيهم مجرد بقائه في ذاكرتهم، بل تأثيره في قلوبهم وسلوكهم، وأنه موضوع تأملاتهم وأشواقهم الروحية، فينشئ فيهم غايات سماوية ويشجعهم على الصلاة.
تَطْلُبُونَ مَا تُرِيدُونَ فَيَكُونُ لَكُمْ مما هو ضروري لإثمارهم. هذا الوعد مثل الوعد الذي سبق في يوحنا ١٤: ١٣ ومتّى ٢١: ٢١، وهو للرسل خاصة، لكنه يصح لغيرهم من المسيحيين إن كانت أحوالهم وغاياتهم كأحوال الرسل وغاياتهم. وهذا موافق لقول الرسول «طِلبَةُ البَارِّ تَقْتَدِرُ كَثِيراً فِي فِعْلِهَا» (يعقوب ٥: ١٦). ويتضح من هذه الآية أنه لا حقَّ لأحد أن يتوقع إجابة طلباته إن لم يحي في طاعة المسيح، وإن لم يتحد به بالإيمان (مزمور ٦٦: ١٨). ولا تُستجاب طلبات كثيرة بسبب عدم ثبوت المصلّين في المسيح، وعدم ثبوت كلامه فيهم.
٨ «بِهَذَا يَتَمَجَّدُ أَبِي أَنْ تَأْتُوا بِثَمَرٍ كَثِيرٍ فَتَكُونُونَ تلامِيذِي».
متّى ٥: ١٦ وفيلبي ١: ١١ ويوحنا ٨: ٣١ و١٣: ٣٥
في هذه الآية بيان غايتين من ثبوت الرسل في المسيح وإتيانهم بأثمار البرّ.
يَتَمَجَّدُ أَبِي أولاهما تمجيد الآب، فكما أن وفرة ثمر الكرم الأرضي دليل على اجتهاد الكرام واعتنائه، كذلك تقوى المسيحيين وأمانتهم يمجِّدان الكرام السماوي. ويلزم عن ذلك ثلاثة أمور: (١) صلاح شريعة الله، لأنها سبب تلك التقوى والأمانة. (٢) قوة نعمته، لأنها جعلتهم يغلبون فساد طبيعتهم ويقدرون أن يفعلوا الصلاح. (٣) أن المسيحي التقي الأمين قد تجدد، فصار في صورة الله، وأظهر للناس بحُسن سيرته صفات الله الحسنة وفضله العظيم (متّى ٧: ٢٠ وفيلبي ٤: ٨).
أَنْ تَأْتُوا بِثَمَرٍ كَثِيرٍ أي أن تمارسوا الأعمال الصالحة بالأمانة والتواضع والاجتهاد «مكثرين في عمل الرب» (١كورنثوس ١٥: ٥٨).
فَتَكُونُونَ تلامِيذِي هذه هي الغاية الثانية، أي تُعرفون أنكم تلاميذي، فإتيان التلاميذ بالأثمار الوافرة يبرهن أنهم تلاميذ المسيح، فالثمر هو العلامة الوحيدة للتلميذ الحقيقي، ولا يكفي مجرد الاعتراف باللسان. ولا يلزم من قوله «فتكونون تلاميذي» أنهم لم يكونوا تلاميذه حينئذ، إنما أراد أنهم تلاميذه في الساعة نفسها، وأنهم سيبقون كذلك، وأنهم كلما زادوا أعمالاً صالحة زادت محبته ومجازاته لهم، فكأنه قال: إن كنتم كذلك فأنا أعترف بأنكم خاصتي، وأنتم تتحققون أنكم لي، والعالم يعرف أنكم كذلك لمشابهتكم لي.
قبل الرسل هذا الشرط على أنفسهم، وأتوا بثمر كثير بعد ذلك، إذ جالوا في كل العالم يبشرون بالإنجيل، واحتملوا الاضطهادات الشديدة، ومات أكثرهم شهداء في سبيله طاعةً لأمره، وتمجيداً له، ورغبة في خلاص النفوس.
٩ «كَمَا أَحَبَّنِي الآبُ كَذَلِكَ أَحْبَبْتُكُمْ أَنَا. اُثْبُتُوا فِي مَحَبَّتِي».
كَمَا أَحَبَّنِي الآبُ محبة الآب للابن أعظم صنوف المحبة، وهي مبنية على كمال الاتحاد بينهما في القصد والعمل (متّى ٣: ١٧ و١٧: ٥ ويوحنا ١٧: ٢٤).
كَذَلِكَ أَحْبَبْتُكُمْ أَنَا اتخذ الابن محبة الآب له مثالاً لمحبته تلاميذه، فكلتاهما غير محدودتين. ومحبة المسيح لتلاميذه كمحبة الآب له في النوع لا في المقدار. ووجه الشبه: الرّقة، والدوام، وتقديم ما يقوم بالحاجات، والوقاية من الخطر.
اُثْبُتُوا فِي مَحَبَّتِي أي محبتي لكم. وهذا الثبوت لا يكون إلا بطاعة كلامه (ع ٨). ويتضمن هذا الثبوت أمرين: (١) أن المسيحي يشتاق إلى محبة المسيح له ويقبلها ويُسر بها ويجتهد في أن يكون مستحقاً لها. (٢) أنه يعتزل كل مانع من دوام محبة المسيح له كعدم الأمانة والطاعة.
١٠ «إِنْ حَفِظْتُمْ وَصَايَايَ تَثْبُتُونَ فِي مَحَبَّتِي، كَمَا أَنِّي أَنَا قَدْ حَفِظْتُ وَصَايَا أَبِي وَأَثْبُتُ فِي مَحَبَّتِهِ».
يوحنا ١٤: ٩، ٢١، ٢٣
انظر شرح يوحنا ١٤: ٢٣، ٢٤. جعل المسيح طاعته للآب وثبوته بها في محبته قاعدة لتلاميذه يسلكون بموجبها في طاعتهم له وثبوتهم في محبته.
إِنْ حَفِظْتُمْ وَصَايَايَ جعل المسيح السيرة المقدسة شرطاً لحبه لهم وتيقنهم من ذلك الحب، ولنوال ما يتضمن ذلك من السعادة (١يوحنا ٢: ٣).
كَمَا أَنِّي أَنَا لم يطلب المسيح من تلاميذه شرطاً لثبوتهم في محبته لهم سوى الشرط الذي قبله على نفسه لثبوته في محبة الآب له (يوحنا ٨: ٢٩ و١٠: ١٧).
١١ «كَلَّمْتُكُمْ بِهَذَا لِكَيْ يَثْبُتَ فَرَحِي فِيكُمْ وَيُكْمَلَ فَرَحُكُمْ».
يوحنا ١٦: ٢٤ و١٧: ١٣ و١يوحنا ١: ٤
بِهَذَا أي ما ذُكر من أمر الطاعة في الآية السابقة، وربما أشار إلى كل ما ذكره في هذا الخطاب. وقصد من هذه الآية أن يبين أن طريق الطاعة هو طريق المسرة الكاملة الدائمة، لا طريق المشقة والعبودية، وأنه سُرّ بها وسيُسرون هم كذلك.
يَثْبُتَ فَرَحِي فِيكُمْ يحتمل قوله «فرحي» ثلاثة معانٍ: (١) فرح المسيح بتلاميذه حين يشاهد إيمانهم ومحبتهم وطاعتهم وثبوتهم. (٢) فرح التلاميذ فرحاً كفرح المسيح، لصدور الفرحين من مصدر واحد هو الطاعة للآب والثبوت في محبته (ع ٩، ١٠) وتيقن ذلك (يوحنا ١٧: ١٣ وعبرانيين ١٢: ٢). (٣) فرح التلاميذ الذي يهبه هو لهم، فقد أعطاهم سلامه (يوحنا ١٤: ٢٧) وزاد على ذلك فرحه، وهو أحد أثمار الروح القدس (رومية ١٤: ١٧ وغلاطية ٥: ٢٢).
وَيُكْمَلَ فَرَحُكُمْ يكون كمال فرحهم من تيقنهم أنهم يحبون الله، وأنه يحبهم. وهذا التأكيد يشفي غليل النفس، ويقيهم من الحزن على مفارقته إياهم. وينتج كمال الفرح عن كمال الطاعة كما اختبره الرسل بعد صعود المسيح (أعمال ٥: ٤١ و١٣: ٥٢ ورومية ١٤: ١٧ و٢كورنثوس ٢: ٢، ٣ و٧: ٤ وغلاطية ٥: ٢٢ وفيلبي ٢: ١٧، ١٨ و٤: ٤ و١تسالونيكي ١: ٦ و٢: ١٩، ٢٠ و٣: ٩ و١بطرس ١: ٨).
١٢ «هَذِهِ هِيَ وَصِيَّتِي أَنْ تُحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضاً كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ».
يوحنا ١٣: ٣٤ و١تسالونيكي ٤: ٩ و١بطرس ٤: ٨ و١يوحنا ٣: ١١ و٤: ٢١
ذكر المسيح في هذه الآية إحدى الوصايا التي ذكرها في ع ١٠، وجعل حفظها شرطاً للثبوت في محبته. ونبَّر على هذه الوصية لأنه فضلها على سائر الوصايا.
وَصِيَّتِي سماها وصية جديدة (يوحنا ١٣: ٣٤) لأسباب ذكرناها في شرح تلك الآية، وسمّاها وصيته لنفس تلك الأسباب. ويدل تكراره على أهميتها عنده.
كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ هذا بيان لدرجة المحبة المطلوبة، وترغيب لهم في الاقتداء به في تلك المحبة. فيجب أن تكون محبة بعضهم لبعض مثل محبته في الشدة والرأفة والحمل على نفع الغير في كل طريق ممكن، حتى إنكار الذات والموت إذا اقتضى الحال (١كورنثوس ١٣: ١ و١يوحنا ٣: ١٦).
١٣ «لَيْسَ لأحَدٍ حُبٌّ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا أَنْ يَضَعَ أَحَدٌ نَفْسَهُ لأجْلِ أَحِبَّائِهِ».
يوحنا ١٠: ١١، ١٥ ورومية ٥: ٧، ٨ وأفسس ٥: ٢ و١يوحنا ٣: ١٦
لا شك أن ذلك أعظم أنواع المحبة، وقد جعله مقياساً لحب بعض التلاميذ لبعض بناءً على مثاله.
أَنْ يَضَعَ أَحَدٌ نَفْسَهُ لأجْلِ أَحِبَّائِهِ أغلى ما يبذله الإنسان في سبيل الوطن والقريب هو حياته. وقد أظهر المسيح محبته لتلاميذه ببذل حياته (يوحنا ١٠: ١١، ١٧)، وليس لأجل أحبائه فقط بل لأجل أعدائه أيضاً (رومية ٥: ٦، ١٠ و١يوحنا ٤: ١٠). وأراد أن يكون تلاميذه مستعدين للتمثل به في ذلك إذا اقتضى الحال (١يوحنا ٣: ١٦).
١٤ «أَنْتُمْ أَحِبَّائِي إِنْ فَعَلتُمْ مَا أُوصِيكُمْ بِهِ».
متّى ١٢: ٥٠ ويوحنا ١٤: ١٥، ٢٣
معنى هذه الآية كمعنى ع ١٠ فارجع إلى شرحها. وذكرها هنا بياناً أنهم هم الأحباء الذين عزم على أن يقيم لهم ذلك البرهان القاطع على محبته لهم. وإيضاحاً أن شرط دوام الصداقة هو الطاعة. فالذي لا يطيع المسيح لا يحبه، وليس له أن يدَّعي صداقته.
١٥ «لا أَعُودُ أُسَمِّيكُمْ عَبِيداً، لأنَّ العَبْدَ لا يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ سَيِّدُهُ، لَكِنِّي قَدْ سَمَّيْتُكُمْ أَحِبَّاءَ لأنِّي أَعْلَمْتُكُمْ بِكُلِّ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي».
تكوين ١٨: ١٧ ويوحنا ١٧: ٢٦ وأعمال ٢٠: ٢٧
لا أَعُودُ أُسَمِّيكُمْ عَبِيداً أي لا أتخذكم مجرد عبيدٍ. وقد سماهم كذلك في يوحنا ١٢: ٢٦ و١٣: ١٨. وكان يحق له ذلك لأنه معلمهم، ولأنه الله. وهم ما زالوا بعد ذلك يسمون أنفسهم عبيداً (رومية ١: ١ ويعقوب ١: ١ و٢بطرس ١: ١ ورؤيا ١: ١) ويطيعون المسيح كما يطيع العبيد سادتهم، ولكن العبيد يطيعون إما خوفاً من العقاب أو طمعاً في الثواب، لكن تلاميذ المسيح يطيعونه من محبتهم له.
لأنَّ العَبْدَ لا يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ سَيِّدُهُ يعرف أوامره، لا الأسباب الموجبة لها.
سَمَّيْتُكُمْ أَحِبَّاءَ هذا يشير إلى محبته لهم، وتقريبه لهم، ونقلهم من منزلة العبيد إلى منزلة الأصدقاء. وسمى الله إبراهيم خليله مجازاة له على إيمانه وأمانته. وقد سمى المسيح تلاميذه بذلك الاسم (لوقا ١٢: ٤) ولقّب لعازر بالحبيب (يوحنا ١١: ١١). ولكنه حقق لهم هنا تلك العلاقة وبقاءها، وأشار بذلك إلى أنهم يكونون من ذلك الحين فصاعداً شركاءه في الأفراح والأحزان، وفي الأتعاب ونتائجها.
أَعْلَمْتُكُمْ بِكُلِّ مَا عاملهم معاملة الأحباء بإظهاره لهم أفكاره ومقاصده وكل ما يتعلق بعمل الفداء الذي هم قادرون على قبوله. وهذا لا ينافي ما قاله المسيح في يوحنا ١٦: ١٢، لأن المانع الوحيد من تعليمه إيّاهم كل شيء هو عدم استطاعتهم أن يدركوا منه أكثر مما علَّمهم.
سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي قصده أن يرسله إلى العالم، ومن جهة حقيقة الملكوت الذي سيقيمه على الأرض، وأن إقامة ذلك بموته وقيامته وشفاعته ومُلكه في السماء.
١٦ «لَيْسَ أَنْتُمُ اخْتَرْتُمُونِي بَل أَنَا اخْتَرْتُكُمْ، وَأَقَمْتُكُمْ لِتَذْهَبُوا وَتَأْتُوا بِثَمَرٍ، وَيَدُومَ ثَمَرُكُمْ، لِكَيْ يُعْطِيَكُمُ الآبُ كُلَّ مَا طَلَبْتُمْ بِاسْمِي».
يوحنا ٦: ٧٠ و١يوحنا ٤: ١٠، ١٩ ومتّى ٢٨: ١٩ ومرقس ١٦: ٥ وكولوسي ١: ٦ ويوحنا ١٤: ١٣ وع ٧
لَيْسَ أَنْتُمُ اخْتَرْتُمُونِي هذا من الأدلة على حبه إيّاهم (١يوحنا ٤: ١٠، ١٩ قارن بما في لوقا ٦: ١٣ - ١٦ ويوحنا ٦: ٧٠ و١٣: ١٨ وأفسس ٢: ٤، ٥). وذكر ذلك برهاناً على محبته لهم وجعله سبباً لحب بعضهم بعضاً (ع ١٧). واختارهم المسيح من الخطاة الهالكين ليكونوا ورثة الحياة الأبدية، ومن صيادي السمك ليكونوا رسلاً له، ومن العبيد ليكونوا أحباءه. وكل هذا لمجرد اختياره لهم، لا لاستحقاقهم.
أَقَمْتُكُمْ بواسطة الصلاة (لوقا ١٢: ١١)، والتعيين (لوقا ١٢: ١٣)، وتعليمه لهم نحو ثلاث سنين، وبهذا الخطاب الوداعي.
لِتَذْهَبُوا للتبشير بإنجيلي، وللشهادة بصحة دعواي. وكثيراً ما قُرن الذهاب بسرعة العمل والاجتهاد فيه كالقول «اذهبوا وافحصوا» (متّى ٢: ٨). والقول «اذهبوا وتعلموا» (متّى ٩: ١٣ و١٢: ٤٥ و٢٢: ٩، ١٥ و٢٥: ٩، ١٦).
وَتَأْتُوا بِثَمَرٍ قصد بالثمر هنا قداسة السيرة، والرغبة في بث بشرى الخلاص لينجو الهالكون من الخطية والشيطان والموت، فيكونوا شركاء الحياة الأبدية. فكل من يختاره المسيح تلميذاً إنما يختاره ليأتي بثمر القداسة. فليس لأحد أن يقول: إن اختارني الله خلصتُ مهما فعلت، لأن الاختيار مشروط بإتيان الشخص المختار بالثمر.
وَيَدُومَ ثَمَرُكُمْ أي نتيجة أعمالكم الروحية التي صُنعت بأمر المسيح ومساعدة الروح القدس، بخلاف الأعمال الأرضية التي غايتها نفع الأجساد. ومن ذلك الثمر تأسيس الكنيسة، وما كتبوه في الإنجيل لإرشاد الكنيسة إلى نهاية الزمان (يوحنا ٤: ٣٦ ورومية ١٤: ١٣) وما قيل في شأن الرسل يقال في شأن سائر المسيحيين، فالذين اختارهم الله للخلاص اختارهم لخدمة المسيح وكنيسته ليأتوا بثمر لمجده، ولنفع العالم، ولتدوم نتائج أعمالهم إلى الأبد.
لِكَيْ يُعْطِيَكُمُ الآبُ كُلَّ مَا طَلَبْتُمْ بِاسْمِي اختارهم المسيح لثلاثة أمور: (١) إتيانهم بثمر. (٢) نوال ما يسألونه في الصلاة وهو متوقف على الأول. فالمقتدر في الصلاة مقتدر في العمل (راجع شرح ع ٧، ٨). ويُستنتج من هذه الآية أن فوائد الاختيار لا تكون إلا بالصلاة، كما أنها لا تكون إلا بالعمل. (٣) سيأتي في الآية ١٩.
١٧ «بِهَذَا أُوصِيكُمْ حَتَّى تُحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضاً».
ع ١٢ ورومية ١٣: ٩، ١٠
هذه الآية نتيجة ما سبق. فقد أكد محبة الآب لهم، ومحبته هو لهم، وبتسميتهم أحباءه، وباختيارهم رُسلاً. وبنى على كل ذلك وجوب حب بعضهم بعضاً. وهذا تكرار ثالث لوصية المحبة في هذا الخطاب (رومية ١٣: ٨ - ١٠ وغلاطية ٥: ١٤ و١تيموثاوس ١: ٥).
سبب بغض العالم ليسوع وتلاميذه وشهادة الروح القدس (ع ١٨ - ٢٧)
١٨ «إِنْ كَانَ العَالَمُ يُبْغِضُكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ أَبْغَضَنِي قَبْلَكُمْ».
١بطرس ٤: ١٢، ١٣ و١يوحنا ٣: ١، ١٣
غاية المسيح من هذه الآية وما يليها تعزية تلاميذه وتشجيعهم على احتمال الاضطهاد الذي كان لا بد أن يأتي عليهم، فسبق وأعلمهم بحدوثه لكي لا يتعجبوا من وقوعه، وييأسوا به، ولا يتخذوه دليلاً على أنه أصابهم لأنهم يستحقونه، وعلى أن الله تركهم، وأن المسيح نسيهم.
إِنْ كَانَ العَالَمُ يُبْغِضُكُمْ أي متى أبغضكم العالم.
قَدْ أَبْغَضَنِي قَبْلَكُمْ هذه التعزية الأولى من تعزيات المسيح لهم في وقت الضيق، وخلاصتها أنه هو قد أصابه قبلهم ما سيصيبهم بعده. والشركة في الآلام توجب الشركة في المسرات (١بطرس ٤: ١٢، ١٣). واختبار المسيح للضيقات يؤكد لهم أنه يشعر معهم في آلامهم، وينقذهم منها، فيشتركون مع المسيح في الشدائد، بسبب علاقتهم الجديدة به. وقد كان المسيح مقدساً فكراً وقولاً وعملاً، وكان يجول يصنع خيراً، وأبغضه العالم أشد البغض. فمن المحال أن العالم يحب أتباعه.
١٩ «لَوْ كُنْتُمْ مِنَ العَالَمِ لَكَانَ العَالَمُ يُحِبُّ خَاصَّتَهُ. وَلَكِنْ لأنَّكُمْ لَسْتُمْ مِنَ العَالَمِ، بَل أَنَا اخْتَرْتُكُمْ مِنَ العَالَمِ، لِذَلِكَ يُبْغِضُكُمُ العَالَمُ».
يوحنا ١٧: ١٤ و١يوحنا ٤: ٥
في هذه الآية تعزية ثانية لهم في احتمالهم بغض العالم، لأن هذا البغض برهان على أن الله أحبهم واختارهم من العالم وفصلهم عنه. والقول هنا كالقول في متّى ٥: ١٢.
لَوْ كُنْتُمْ مِنَ العَالَمِ أي دنيويين يحبون لذّات العالم ومجده ويطلبون رضاه، ويشابهونه في مبادئه.
لَكَانَ العَالَمُ يُحِبُّ خَاصَّتَهُ أي المشابهين له في الصفات والأعمال. وعلة حبه لهم أن أقوالهم وأعمالهم لا تبكته على أقواله وأعماله، إنما تمدحه على ذلك وتريح ضميره.
لأنَّكُمْ لَسْتُمْ مِنَ العَالَمِ أي لا تستحسنون مبادئه وغاياته، وتبغضون ما يحبه وتحبون ما يبغضه، ولا شركة لكم معه في لذّاته ومقاصده، ولذلك يعتبركم أجنبيين وأعداء.
اخْتَرْتُكُمْ مِنَ العَالَمِ لكي تكونوا خراف رعيتي، تتبعون خطواتي وتطلبون تعليمي، وتكونون رعية مملكتي، وحَمَلة صليبي واسمي، مبشرين بإنجيلي (١يوحنا ٣: ١٣). وهنا ثالث الأمور التي اختارهم لأجلها (ع ١٦) وهو فصلهم عن العالم.
لِذَلِكَ يُبْغِضُكُمُ العَالَمُ لأن أقوالكم وأفعالكم تبكته على أقواله وأفعاله، ولأن الشيطان يحمله على أن يبغضكم.
٢٠ «اُذْكُرُوا الكلامَ الَّذِي قُلتُهُ لَكُمْ: لَيْسَ عَبْدٌ أَعْظَمَ مِنْ سَيِّدِهِ. إِنْ كَانُوا قَدِ اضْطَهَدُونِي فَسَيَضْطَهِدُونَكُمْ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ حَفِظُوا كلامِي فَسَيَحْفَظُونَ كلامَكُمْ».
متّى ١٠: ٢٤ و لوقا ٦: ٤٠ ويوحنا ١٣: ١٦ حزقيال ٣: ٧
اُذْكُرُوا الكلامَ الَّذِي قُلتُهُ (يوحنا ١٣: ١٦ ومتّى ١٠: ٢٤ ولوقا ٦: ٤٠). وذكَّرهم المسيح بمعاداة العالم لهم لأنه رآهم يميلون إلى توقع مصادقته، وأنهم عُرضة للعثرة واليأس عند وقوع خلاف ما توقعوا.
وَإِنْ كَانُوا قَدْ حَفِظُوا كلامِي فَسَيَحْفَظُونَ كلامَكُمْ لكنهم لم يحفظوه. وصدق هذا على أمة اليهود إجمالاً لأنها رفضت تعليم المسيح ورسله. أما الأفراد الذين حفظوا كلام المسيح فكثيرون، متحدون بالمسيح ويشابهونه في الصفات والتعليم، وينتسبون إليه كمسيحيين.
٢١ «لَكِنَّهُمْ إِنَّمَا يَفْعَلُونَ بِكُمْ هَذَا كُلَّهُ مِنْ أَجْلِ اسْمِي، لأنَّهُمْ لا يَعْرِفُونَ الَّذِي أَرْسَلَنِي».
متّى ١٠: ٢٢ و٢٤: ٩ ويوحنا ١٦: ٣
هذا تعزية ثالثة للرسل في مقاساتهم الشدائد.
هَذَا كُلَّهُ أي من بغض العالم واضطهاده لكم، ورفضه كلامكم.
مِنْ أَجْلِ اسْمِي أي بسببي، ولأنكم تعترفون باسمي وتشهدون بحقي وصحة دعواي. وقد تعزّى التلاميذ بذلك في أزمنة الاضطهاد (انظر أعمال ٥: ٤١ و٢كورنثوس ١٢: ١٠ وغلاطية ٦: ١٧ وكولوسي ١: ٢٤ وعبرانيين ١١: ٢٦).
لأنَّهُمْ لا يَعْرِفُونَ الَّذِي أَرْسَلَنِي جهل اليهود أن الله أرسل يسوع، وأنه هو المسيح الموعود به، ولهذا كفروا به وقاوموه هو ورسله بعد ذلك. فكما أنهم لم يعلموا أن الله أرسل يسوع، لم يعرفوا أن المسيح أرسل التلاميذ. وجهل اليهود أمر المسيح ورسله كان إثماً عظيماً لأنهم لم يريدوا أن يعرفوا الحق، وأغمضوا عيونهم عن الأدلة على صحة دعوى المسيح (أعمال ٣: ١٧ و١٣: ٢٧ و٢٨: ٢٠ و٢٥ - ٢٧ و ١كورنثوس ٢: ٨ و٢كورنثوس ٣: ١٤)
٢٢ «لَوْ لَمْ أَكُنْ قَدْ جِئْتُ وَكَلَّمْتُهُمْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ خَطِيَّةٌ، وَأَمَّا الآنَ فَلَيْسَ لَهُمْ عُذْرٌ فِي خَطِيَّتِهِمْ».
يوحنا ٩: ٤١ رومية ١: ٢٠ ويعقوب ٤: ١٧
هذا يبيّن أن جهل اليهود كان خطية عليهم لا عذراً لهم.
لَوْ لَمْ أَكُنْ قَدْ جِئْتُ وَكَلَّمْتُهُمْ أشار بذلك إلى تصريحه بأنه «مرسَلٌ من الله» وأنه «ابن الله» فهو المسيح. وثبت هذا بمعجزاته الكثيرة الواضحة، وبصلاح تعليمه وقداسة سيرته.
لَمْ تَكُنْ لَهُمْ خَطِيَّةٌ أي لم يرتكبوا تلك الخطية وهي رفض أن يسوع هو المسيح. وهذه الخطية كانت أعظم كل خطايا اليهود، وحسبها الله عصياناً له، وكانت سبب رفض الله أن يكونوا له شعباً وانتقامه منهم بإخراب مدينتهم وهيكلهم وتشتيتهم في العالم، علاوة على عقابهم في العالم الآتي (يوحنا ٩: ٤١ ومتّى ٢٣: ٣٤ - ٣٩ و٢٧: ٢٥). ولم يقصد المسيح أنه لو لم يأت لكان اليهود إبراراً، بل قصد أنهم كانوا أقل إثماً، لأن إثم الإنسان يزيد جرماً بزيادة معرفته (متّى ١١: ٢٠ - ٢٤ ولوقا ١٢: ٤٧، ٤٨).
فَلَيْسَ لَهُمْ عُذْرٌ فِي خَطِيَّتِهِمْ هذا مثل قوله سابقاً «هَذِهِ هِيَ الدَّيْنُونَةُ: إِنَّ النُّورَ قَدْ جَاءَ إِلَى العَالَمِ، وَأَحَبَّ النَّاسُ الظُّلمَةَ أَكْثَرَ مِنَ النُّورِ.. لأنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ السَّيِّآتِ يُبْغِضُ النُّورَ، ولا يَأْتِي إِلَى النُّورِ لِئلا تُوَبَّخَ أَعْمَالُهُ» (يوحنا ٣: ١٩، ٢٠).
٢٣ «اَلَّذِي يُبْغِضُنِي يُبْغِضُ أَبِي أَيْضاً».
مزمور ٦٩: ٩ ورومية ١٥: ٣ و١يوحنا ٢: ٢٣
(انظر شرح يوحنا ٥: ١٩ - ٢٦ و١٤: ٧، ٨). أظهر رفض اليهود للمسيح بغضهم إيّاه لا جهلهم فقط، وأظهر أيضاً بغضهم لأبيه الذي أرسله وتكلم بفمه. ومن المحال نظراً للاتحاد الكلي بين الآب والابن أن نحب الواحد ونكرمه دون الآخر، وأن نبغض الواحد ونستهين به دون الآخر.
٢٤ «لَوْ لَمْ أَكُنْ قَدْ عَمِلتُ بَيْنَهُمْ أَعْمَالاً لَمْ يَعْمَلهَا أَحَدٌ غَيْرِي لَمْ تَكُنْ لَهُمْ خَطِيَّةٌ، وَأَمَّا الآنَ فَقَدْ رَأَوْا وَأَبْغَضُونِي أَنَا وَأَبِي».
يوحنا ٣: ٢ و٧: ٣١ و٩: ٣٢
لَوْ لَمْ أَكُنْ قَدْ عَمِلتُ بَيْنَهُمْ أَعْمَالاً كان على اليهود أن يقتنعوا بكلام المسيح فلم يقتنعوا (ع ٢٢). وقد أجرى المسيح المعجزات بينهم ليقنعهم بصحة دعواه فلم يقتنعوا، فارتكبوا إثماً فوق إثم. وقد قال المسيح إن معجزاته تشهد له (يوحنا ٥: ٣٦ و٩: ٣، ٤، ٢٤ و١٠: ٢١، ٣٧ و١٤: ١٠) لكنهم رفضوها بدعوى أنه صنعها بقوة رئيس الشياطين (متّى ١٢: ٢٥) وأنه «خاطئ» (يوحنا ٩: ٢٤).
لَمْ يَعْمَلهَا أَحَدٌ غَيْرِي أي لم يأت نبي أو رسول بمثلها في الكثرة، وبالقوة الذاتية، وتوقفها على مجرد أمره بها، وفي أنها أحياناً على البُعد كما فعل المسيح. فليس معناه أن كل معجزة صنعها أعظم من كل معجزة صنعها موسى أو إيليا أو غيرهما من الأنبياء، فالفرق العظيم، وهو أن أولئك صنعوا المعجزات بقوة الله بينما صنعها المسيح بقوة نفسه.
رَأَوْا وَأَبْغَضُونِي أَنَا وَأَبِي في ع ٢٢، ٢٣ أظهر اليهود بغضهم للمسيح وللآب برفضهم كلامه. وأبان المسيح أنهم أظهروا مثل ذلك برفضهم شهادة أعماله.
٢٥ «لَكِنْ لِكَيْ تَتِمَّ الكَلِمَةُ المَكْتُوبَةُ فِي نَامُوسِهِمْ: إِنَّهُمْ أَبْغَضُونِي بِلا سَبَبٍ».
مزمور ٣٥: ١٩ و٦٩: ٤
قصد المسيح في هذه الآية أن لا عجب من رفض اليهود إيّاه لسبق الإنباء بذلك في الكتاب.
لِكَيْ تَتِمَّ الكَلِمَةُ ما قيل في المزامير عن داود الذي هو رمز إلى المسيح، تمَّ بالمسيح المرموز إليه. ولم يتضح المراد من هذا الاقتباس. فهل أراد به مضمون كل أقوال المزامير على داود والمسيح؟ أو هل أراد بذلك آيات بعينها مثل ما في مزمور ٣٥: ١٩ و٦٩: ٤؟
المَكْتُوبَةُ فِي نَامُوسِهِمْ أي العهد القديم. ونسب المسيح الناموس إلى اليهود لأنهم افتخروا به، وهو يشهد عليهم ويدينهم.
أَبْغَضُونِي بِلا سَبَبٍ لأنه لم يخالف الناموس قط، ولم يعتدِ على أحد من الناس، ولم يعصَ الحكومة، لكنه جال يفعل خيراً، وعلَّم الناس الأمور السماوية، واجتهد في أن ينفع الكل ويخلّص الكل، وفعل ما لا يُحصى مما يجعل الناس يحبونه ويكرمونه، ولم يفعل ما يبرر بغضته وإهانته. فالذين لا يكترثون اليوم بالمسيح الذي مات من أجلهم ويهملون دعواه ودعوته يشبهون اليهود الذين أبغضوه بلا سبب.
٢٦ «وَمَتَى جَاءَ المُعَزِّي الَّذِي سَأُرْسِلُهُ أَنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الآبِ، رُوحُ الحَقِّ، الَّذِي مِنْ عِنْدِ الآبِ يَنْبَثِقُ، فَهُوَ يَشْهَدُ لِي».
لوقا ٢٤: ٤٩ ويوحنا ١٤: ١٧، ٢٦ و١٦: ٧، ١٣ وأعمال ٢: ٣٣ ١يوحنا ٥: ٦
ما سبق من كلام المسيح عن عمى اليهود برفضهم شهادة كلامه وأعماله، جعل التلاميذ يحزنون وييأسون، فعزّاهم وأحيا رجاءهم بتبشيره بمجيء شاهد آخر يُبكم بعض المقاومين، ويقنع البعض (انظر شرح يوحنا ١٤: ١٦).
الَّذِي سَأُرْسِلُهُ أَنَا لا أحد ينال موهبة الروح القدس إلا بواسطة المسيح (يوحنا ١٤: ١٦).
رُوحُ الحَقِّ (انظر شرح يوحنا ١٤: ١٧).
الَّذِي مِنْ عِنْدِ الآبِ يَنْبَثِقُ أي يخرج، لأن الآب هو الأصل في عمل الفداء. وليس هذا بياناً لجوهر الروح القدس، بل بيان لوظيفته، وهي أنه خرج من الآب ليشهد للابن. فإذاً شهادته كشهادة الآب تستحق كل الثقة.
فَهُوَ يَشْهَدُ لِي هذا كما في ١يوحنا ٥: ٦. جرى ذلك أولاً في يوم الخمسين إذ شهد بصحة دعوى المسيح حتى آمن به ألوف. وكانت كل انتصارات الإنجيل بواسطة هذا الروح، منذ ذلك الوقت إلى الآن، وسيكون كذلك إلى أن تجثو باسم يسوع كل ركبة، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب. ويشهد الروح القدس للمسيح في قلب الإنسان ليجهزه لقبول شهادة المسيح (أعمال ٢: ٣٧) وكانت شهادته أيضاً بالمعجزات التي صنعها الرسل، وبالمواهب التي أعطاها لهم (أعمال ٢: ٤، ٤٣ و٤: ٣١ و٥: ١٢).
٢٧ «وَتَشْهَدُونَ أَنْتُمْ أَيْضاً لأنَّكُمْ مَعِي مِنَ الابْتِدَاءِ».
لوقا ٢٤: ٤٨ وأعمال ١: ٨، ٢١، ٢٢ و٢: ٣٢ و٣: ١٥ و٤: ٢٠، ٣٣ و٥: ٣٢ و١٠: ٣٩ و١٣: ٣١ و١بطرس ٥: ١ و٢بطرس ١: ١٦ لوقا ١: ٢ و١يوحنا ١: ١، ٢
وَتَشْهَدُونَ أَنْتُمْ أَيْضاً بأني أنا المسيح (لوقا ٢٤: ٤٨ ، ٤٩ وأعمال ١: ٨). وشهادتهم ليست غير شهادة الروح القدس، فالشهادتان واحدة، والاختلاف باعتبار الشاهد فقط. فالروح شاهد إلهي والرسل شهود بشريون. وبعض شهادتهم في أعمال ١ - ٧، ومنها القول «وَلَمَّا صَلَّوْا تَزَعْزَعَ المَكَانُ الَّذِي كَانُوا مُجْتَمِعِينَ فِيهِ، وَامْتلأ الجَمِيعُ مِنَ الرُّوحِ القُدُسِ، وَكَانُوا يَتَكَلَّمُونَ بِكلامِ اللَّهِ بِمُجَاهَرَةٍ. وَبِقُوَّةٍ عَظِيمَةٍ كَانَ الرُّسُلُ يُؤَدُّونَ الشَّهَادَةَ بِقِيَامَةِ الرَّبِّ يَسُوعَ» (أعمال ٤: ٣١، ٣٣). وقول الرسل «وَنَحْنُ شُهُودٌ لَهُ (أي للمسيح) بِهَذِهِ الأُمُورِ، وَالرُّوحُ القُدُسُ أَيْضاً» (أعمال ٥: ٣٢). وبعضها في سائر مواعظهم وكتاباتهم في البشائر والرسائل.
لأنَّكُمْ مَعِي مِنَ الابْتِدَاءِ أي من بدء خدمته (متّى ٤: ١٧ - ٢٢ وأعمال ١: ٢١، ٢٢). فإنه قضى معهم ما يزيد على ثلاث سنين يشاهدون سيرته الطاهرة ومعجزاته، ويسمعون تعليمه، ويستعدون للشهادة له بعد حلول الروح القدس عليهم. لكن رغم كل ما سمعوه من أحاديثه النفيسة وشاهدوه من أعماله العجيبة سكتوا وقت محاكمته، وكان يجب عليهم وقتئذ أن يشهدوا له. بل إن واحداً منهم أنكره. ولكن لما حل الروح القدس عليهم في يوم الخمسين وما بعده شهدوا له بأمانة وشجاعة.
وفي هذا الأصحاح بيان علاقة التلاميذ بالمسيح، وهي اتحادهم به كاتحاد الأغصان بالكرمة، وأنهم أحباؤه وشهود له. وفيه علاقة بعضهم ببعض، وهي أنهم يحبون بعضهم بعضاً. وعلاقتهم بالعالم وهي أنه يبغضهم.
الأصحاح السادس عشر
الخطاب الوداعي: إنباء يسوع تلاميذه بالاضطهاد وبإرساله الروح القدس وبقيامته وصعوده وإجابة طلباتهم
١ «قَدْ كَلَّمْتُكُمْ بِهَذَا لِكَيْ لا تَعْثُرُوا».
يوحنا ١٥: ١٨ - ٢٨ متّى ١١: ٦ و٢٤: ١٠ و٢٦: ٣١
بِهَذَا أي بُغض العالم لكم، ومجيء المعزي. وكرر ذلك هنا للتقرير والإيضاح.
لِكَيْ لا تَعْثُرُوا أي لئلا يضعف إيمانكم وتجزعوا عند حلول المصائب بكم. ويتبين من لوقا ٢٤: ٢١ أن النوازل تعرضهم للعثرات، فأنبأهم بوقوعها لكي لا تقع عليهم بغتة فتغلبهم. وتعريفه لهم بها يمنعهم من الشك فيه، ويؤكد لهم أنه إله يعرف الغيب. وأنبأهم بحلول الروح القدس لأنه أعظم واسطة لوقايتهم من السقوط.
٢ «سَيُخْرِجُونَكُمْ مِنَ المَجَامِعِ، بَل تَأْتِي سَاعَةٌ فِيهَا يَظُنُّ كُلُّ مَنْ يَقْتُلُكُمْ أَنَّهُ يُقَدِّمُ خِدْمَةً لِلَّهِ».
يوحنا ٩: ٢٢، ٣٤ و١٢: ٤٢ أعمال ٨: ١ و٩: ١ و٢٦: ٩
سَيُخْرِجُونَكُمْ مِنَ المَجَامِعِ خص ذلك بالذكر لأنه أعظم المصائب وقتئذ، وقد ذكرنا تلك الأهوال والنوازل في شرح يوحنا ٩: ٢٢. وذكر وقوعه في أعمال ٦: ١٣، ١٤ و٩: ٢٣، ٢٤ و١٧: ٥ و٢١: ٢٧ - ٣١. ومما زاد ذلك هولاً وشدة أنه لا يأتي عليهم من الوثنيين أو الكفرة، بل من رؤساء ديانتهم، وقد جرى هذا لمعلمهم، فلا عجب إن جرى معهم.
سَاعَةٌ أي وقت. ويعبّر في الكتاب بالساعة عن وقت قصير عينه الله أو أنبأ به.
يَظُنُّ كُلُّ مَنْ يَقْتُلُكُمْ لا بُغض كالبغض المبين على اختلاف الدين، ولا اضطهاد كالاضطهاد الذي يأتيه المضطهِد ظناً أنه من فروض الدين فيقسو قلبه حتى لا يشفق على المضطهَد، ويحسب نفسه نائب الله في الانتقام والمحاماة عن الحق. وعلى هذا اضطهد شاول الطرسوسي كنيسة المسيح بدليل قوله «فَأَنَا ارْتَأَيْتُ فِي نَفْسِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَصْنَعَ أُمُوراً كَثِيرَةً مُضَادَّةً لِاسْمِ يَسُوعَ النَّاصِرِيّ» (أعمال ٢٦: ٩ - ١١). وعليه اضطهد اليهود المسيحيين إذ حسبوا قولهم إن المسيح ابن الله تجديفاً وتعليمه منافياً لتعليم موسى ومهيناً للهيكل والعبادة فيه (أعمال ٦: ١٣، ١٤ و٢١: ٢٨ - ٣١). وما جاء في يوحنا ١٥ في هذا الشأن بيّن شدة بُغض المضطهِدين، وأظهر شدة آلام المضطهَدين.
٣ «وَسَيَفْعَلُونَ هَذَا بِكُمْ لأنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا الآبَ ولا عَرَفُونِي».
لوقا ٢٣: ٣٤ ويوحنا ١٥: ٢١ وأعمال ٣: ١٧ ورومية ١٠: ٢ و١كورنثوس ٢: ٨ و١تيموثاوس ١: ١٣
ذلك علة ما ارتكبوه من الاضطهاد، وقد سبق مثل ذلك في يوحنا ١٥: ٢١، فراجع الشرح هناك وانظر أيضاً لوقا ٢٣: ٣٤ وأعمال ٣: ١٧. وقال بولس عن نفسه إنه اضطهد المسيحيين لجهالته (١تيموثاوس ١: ١٣).
لأنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا الآبَ ولا عَرَفُونِي فلو عرفوا الآب حق المعرفة لعرفوا الابن أيضاً. وأن يسوع مرسَل منه، وأن تعليمه حق. ولو عرفوهما لعرفوا أن ما ارتكبوه من الاضطهاد كان مقاومة لكليهما، وأنه لا يُرضي الآب ولا الابن، وأنه مضاد لإرادتهما (لوقا ٩: ٥٤ - ٥٦).
٤ «لَكِنِّي قَدْ كَلَّمْتُكُمْ بِهَذَا حَتَّى إِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ تَذْكُرُونَ أَنِّي أَنَا قُلتُهُ لَكُمْ. وَلَمْ أَقُل لَكُمْ مِنَ البِدَايَةِ لأنِّي كُنْتُ مَعَكُمْ».
يوحنا ١٣: ١٩ و١٤: ٢٩ متّى ٩: ١٥ ويوحنا ١٨: ٨
غاية هذه الآية كغاية الآية الأولى، وهي وقاية التلاميذ من العثرات.
بِهَذَا أي وقوع الاضطهاد ومجيء المعزي.
تَذْكُرُونَ أَنِّي أَنَا قُلتُهُ لَكُمْ لأنهم لو خرجوا للتبشير بالمسيحية وانتظروا أن العالم يرحب بهم ويكرمهم لشكوا في صدق دعوى المسيح عند وقوع الاضطهاد. ولكن بذكرهم أن المسيح سبق وأنبأهم بذلك الاضطهاد يتقوى إيمانهم لأنه يعرف الغيب، ويذكرون بذلك مواعيد التعزية لهم (يوحنا ١٣: ١٩ و١٤: ٢٩).
وَلَمْ أَقُل لَكُمْ مِنَ البِدَايَةِ أي من بدء خدمته. نعم إنّه أخبرهم بشيء من تلك الاضطهادات في متّى ٥: ١٠ و٩: ١٥ و١٠: ١٦. ولكن لم يوضحه كما أوضحه هنا، ولم ينبئهم بها مع إنبائه بذهابه عنهم. وهذا مما زاد الاضطهاد هولاً. ولم يخبرهم من البدء بمجيء الروح القدس ليقويهم ويعزيهم.
لأنِّي كُنْتُ مَعَكُمْ المعنى أن المسيح لم يشغل وقته قبلاً بأن ينبئ الرسل بالاضطهادات وذهابه عنهم ومجيء الروح القدس، لأنهم كانوا محتاجين إلى ما هو أهم منه حينئذٍ، ولم يكونوا مستعدين لهذا، ولم تكن أحوالهم تقتضيه. فما دام معلمهم معهم يكونون غير محتاجين إلى أن يسمعوا نبأ مجيء معلم آخر، فهو معهم يعزيهم ويقويهم فلا يحتاجون إلى معزٍّ آخر.
٥ «وَأَمَّا الآنَ فَأَنَا مَاضٍ إِلَى الَّذِي أَرْسَلَنِي، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَسْأَلُنِي أَيْنَ تَمْضِي».
يوحنا ٧: ٣٣ و١٣: ٣ و١٤: ٢٨ وع ١٠، ١٦
قال له بطرس في أول الخطاب «يَا سَيِّدُ، إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ؟» (يوحنا ١٣: ٣٦). لكن المسيح لم يهتم بالإجابة، لأن بطرس أراد بسؤاله أن يقنعه بالعدول عن المضي، أو أن يأذن له في الذهاب معه. فلم يقصد معرفة المكان الذي قصد الذهاب إليه ليشارك المسيح في فرحه برجوعه إلى مجده. أو أنه قصد أنه لم يسأله أحد ذلك في الوقت الذي تكلم فيه بهذا.
٦ «لَكِنْ لأنِّي قُلتُ لَكُمْ هَذَا قَدْ ملَأ الحُزْنُ قُلُوبَكُمْ».
يوحنا ١٤: ١، ٢٢
انتبهوا لإنبائه بالذهاب عنهم وما يصيبهم من الخسارة بذلك، فاشتد عليهم الحزن ولم يلتفتوا إلى التعزية التي يستطيعون نوالها من معرفة المكان الذي هو ذاهب إليه، ومعرفة غايته من ذلك الذهاب. ولم يظنوا أنه ذاهب إلى حضرة أبيه في السماء ليتمجد بمجده الأصلي، وليرسل إليهم الروح القدس.
٧ «لَكِنِّي أَقُولُ لَكُمُ الحَقَّ، إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ أَنْطَلِقَ، لأنَّهُ إِنْ لَمْ أَنْطَلِقْ لا يَأْتِيكُمُ المُعَزِّي، وَلَكِنْ إِنْ ذَهَبْتُ أُرْسِلُهُ إِلَيْكُمْ».
يوحنا ٧: ٣٩ و١٤: ١٦، ٢٦ و١٥: ٢٦ أعمال ٢: ٣٣ وأفسس ٤: ٨
لَكِنِّي أَقُولُ لَكُمُ الحَقَّ هذا كقوله «الحق الحق أقول لكم» ليزيل الشكوك من قلوبهم ويجعل كلامه مؤثراً فيهم، وذلك ليبدِّل حزنهم على مفارقته إيّاهم بالفرح. وذكر وسيلة ذلك أمرين: (١) في آية ٧، و(٢) في آيات ٨ - ١١. وقد رأينا تأثيرهما بما نالوه بعد صعود المسيح إلى السماء، في القول أنهم «رَجَعُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ» (لوقا ٢٤: ٥٢).
خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ أَنْطَلِقَ وذلك لأمرين: (١) أن ذهابه ضروري لإتيان الروح القدس. (٢) أنه بواسطة ذهابه أي موته وتعليم الروح القدس في شأن ذلك يفهم التلاميذ ما لم يفهموه قبلاً من المقصود من مجيء المسيح وغاية ملكوته. والانطلاق المذكور هنا هو ذهابه إلى أبيه بموته وصعوده ليتمجد هناك (يوحنا ١٤: ٢، ٣، ١٢، ٢٨ ويوحنا ١٦: ٢٨).
لأنَّهُ إِنْ لَمْ أَنْطَلِقْ لا يَأْتِيكُمُ المُعَزِّي فما قاله هنا في علاقة تمجيده بمجيء الروح القدس مثل ما ذُكر في يوحنا ٧: ٣٩. فلا يلزم منه أن الروح القدس لم يأت الكنيسة قبلاً، فمراده أن ذلك الروح لم يكن قد وُهب بمقدار ما وُهب بعد موت المسيح وصعوده. فحلول الروح القدس بعد ذلك جعل للكنيسة عصراً جديداً. ووقت ذلك الحلول بدء «الأيام الأخيرة» التي أنبأ بها يوئيل النبي (يوئيل ٢: ٢٨ - ٣٠).
لم يبين المسيح أن ذهابه ضروري لإتيان المعزي، ولعلها مجرد إرادة الله الآب، أو لعلها أن العالم لا يكون مستعداً لقبول المعزي إلا بعد إتمام المسيح لعمل الفداء من تجسده وتعليمه وموته وصعوده. وأنه كان صعباً أن يرجع اليهود عن توقعهم أن المسيح يكون ملكاً أرضياً ما لم يمُت فييأسوا من ذلك. وكان حلول الروح القدس جزءاً عظيماً من تمجيد المسيح، وهذا لا يتم إلا بعد نهاية تواضعه وموته. وكان خيراً للتلاميذ أن يذهب المسيح عنهم، لأنه لو بقي معهم لظلوا متكلين على حضوره الظاهر وناسوته، فلا يتقدَّمون في سبيل الإيمان.
وخيرٌ لكل المسيحيين أن ينطلق المسيح لأنه لو لم ينطلق لم يكن حبرهم العظيم في السماء يشفع فيهم كما يشفع الآن.
وخيرٌ للكنيسة، لأنه لو بقي على الأرض إلى أن تتسع الكنيسة وتمتد إلى أقاصي الأرض لاحتاجت إلى حضوره بالجسد في كل من تلك الأقاصي في وقت واحد، وذلك محال. وأما الروح القدس فيمكنه ذلك لأنه ليس بمادة. والخلاصة أنه خير للكنيسة أن تنال حضور الروح القدس الذي هو في كل مكان غير منظور من أن يدوم المسيح معها متجسداً منظوراً، وأنه لا بد من إكمال عمل المسيح قبل أن يبدأ الروح القدس عمله المبني على ذلك.
٨ «وَمَتَى جَاءَ ذَاكَ يُبَكِّتُ العَالَمَ عَلَى خَطِيَّةٍ وَعَلَى بِرٍّ وَعَلَى دَيْنُونَةٍ».
في هذا العدد شرح لعمل الروح، وأن ذهاب المسيح خير من بقائه لأنه وسيلة لمجيء الروح.
مَتَى جَاءَ ذَاكَ لا يلزم من ذلك أنه لم يكن في العالم قبلاً، لأنه لا يتوب خاطئ ويؤمن إلا بواسطة تأثيره. لكنه حل بعد صعود المسيح بقوة أعظم من ذي قبل، وبعلامات ظاهرة كما كان في يوم الخمسين.
يُبَكِّتُ العَالَمَ أي أهل العالم المقاومين للمسيح (يوحنا ١: ١٠ و١٢: ٣١). وأشار بالعالم هنا إلى اليهود خاصة، لكنه صدق بعد ذلك على أكثر الأمم. ولم يُشر المسيح هنا إلى فعل الروح القدس في أفراد الناس، لأن ذلك فعله على الدوام. إنما أشار إلى تأثيره العظيم في الجماعات التي رفضت المسيح وقاومته. وهذا التأثير حجز مقاومة الأعداء والتخويف من عاقبة تلك المقاومة وتغيير آرائهم في أمر دعواه. وكان هذا التأثير علة نجاح الإنجيل بين اليهود أولاً، ثم بين الأمم، ويسجل لنا سفر أعمال الرسل تاريخ ذلك. ومعنى «يبكت» يوبخ أو يلوم، والمقصود منه أنه ينبه ضمائر الناس ويقنعهم بخطئهم في حكمهم على يسوع، ويحثهم على تغيير ذلك الحكم. وتكون نتيجة ذلك إيمان بعض الناس وخلاصهم، وقسوة قلوب بعضهم وكفرهم وهلاكهم (٢كورنثوس ٢: ١٥، ١٦).
عَلَى خَطِيَّةٍ وَعَلَى بِرٍّ وَعَلَى دَيْنُونَةٍ هذه ثلاثة أمور يبكت الروح القدس الناس عليها. ولا يستطيع أحد أن يحكم في هذه الأمور بالصواب إلا بواسطة فعل الروح القدس فيه. وأساس تبكيت الروح الناس عليها ما جرى في عمل الفداء.
٩ «أَمَّا عَلَى خَطِيَّةٍ فَلأنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ بِي».
أعمال ٢: ٢٢ - ٢٧ و١كورنثوس ١٢: ٣ و١يوحنا ٥: ١٠
أَمَّا عَلَى خَطِيَّةٍ فَلأنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ بِي أي أن الروح القدس يقنع الناس بأنهم ارتكبوا أعظم الخطايا برفضهم أن يسوع هو ابن الله. وهذه الخطية تتضمن سائر الخطايا لأنها رفض الآب الذي أرسله، ولأنها بيَّنت شر قلوبهم فإن رفضهم ليسوع رفضٌ لنور العالم وتفضيلٌ للظلمة على النور (مرقس ١٦: ١٦ ويوحنا ٣: ١٩، ٣٦ و١٢: ٤٤ و١يوحنا ٥: ١٠ - ١٢). وهذه الخطية أدت بهم إلى قتلهم مسيحهم، ووضعهم دم ابن الله على نفوسهم. وجعل الرسل هذه الخطية موضوع تعليمهم وتوبيخهم اليهود. واتخذها الروح القدس منخساً ينخس به قلوبهم، ووسيلة إلى توبة كثيرين منهم وفق القول «فَلَمَّا سَمِعُوا نُخِسُوا فِي قُلُوبِهِمْ، وَسَأَلُوا بُطْرُسَ وَسَائِرَ الرُّسُلِ: «مَاذَا نَصْنَعُ» (أعمال ٢: ٣٧ انظر أيضاً أعمال ٣: ١٣ - ١٥ و٤: ١٠، ٢٦ - ٢٨). وفي ذلك تحقيق النبوة في قوله «وَأُفِيضُ عَلَى بَيْتِ دَاوُدَ وَعَلَى سُكَّانِ أُورُشَلِيمَ رُوحَ النِّعْمَةِ وَالتَّضَرُّعَاتِ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيَّ، الَّذِي طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُونَ عَلَيْهِ» (زكريا ١٢: ١٠).
ولم يزل رفض المسيح أعظم الآثام على كل إنسان لأنه يمنعه من نوال مغفرة خطاياه، فالإيمان بالمسيح شرطُ كل مغفرة. ورفض المسيح كفر بالنعمة، يبطل كل ما فعله الآب والابن والروح القدس لأجل خلاص من يرفض.
وتبكيت الروح القدس للناس ضروري لإقناعهم بأن عدم إيمانهم بالمسيح خطية عظيمة لأنهم يحسبون تعدي إحدى الوصايا العشر إثماً فظيعاً يوجب الدينونة، وأما ذلك فيعدونه خطأ زهيداً لا يُعبأ به.
١٠ «وَأَمَّا عَلَى بِرٍّ فَلأنِّي ذَاهِبٌ إِلَى أَبِي ولا تَرَوْنَنِي أَيْضاً».
يوحنا ٣: ١٤ و٥: ٣٢ وأعمال ٢: ٣٢ ورومية ٣: ٢٥، ٢٦
وَأَمَّا عَلَى بِرٍّ أي سبب برّ يسوع المسيح. فإن اليهود اتهموه بأنه مخادع (يوحنا ٩: ٢٤). وحكموا عليه بأنه مجدف (مرقس ١٤: ٦٤). وشكوه إلى بيلاطس مدعين أنه مستوجب الموت (يوحنا ١٨: ٣٠، ٣١) فالروح القدس بكّتهم بعد صعود المسيح على برّه، كما بكتهم على خطيتهم. ولا شك أن الروح القدس كان يقنع اليهود أن البرّ الذي اتكلوا عليه (أي بر الناموس) غير كافٍ للخلاص، وهو يقنع جميع الناس أن تبريرهم بالأعمال الصالحة محال، وأن الجميع يهوداً وأُمماً يحتاجون إلى الإيمان ببرّ المسيح. ولكن هذا غير المقصود في هذه الآية. وقد أوضحه بولس الرسول في رومية ٣: ٢٠ - ٢٦ و٤: ١ - ٢٥.
فَلأنِّي ذَاهِبٌ إِلَى أَبِي قال المسيح إن الروح القدس يقنع اليهود ببره بعد ذهابه إلى أبيه في السماء. ونجد ذلك في المعجزات التي حدثت عند موته فجعلت القائد الروماني يقول «بِالحَقِيقَةِ كَانَ هَذَا الإِنْسَانُ بَارّاً!» (لوقا ٢٣: ٤٧). كما نجده في قيامته التي هي أعظم المعجزات، ونجده في المعجزات التي صنعها رسله إثباتاً لبره. ونجده في تأثيره في قلوب الذين سمعوا وعظ الرسل وهم يتكلمون عن بره وخطيتهم (أعمال ٢: ٢٢ - ٢٤ و٣: ١٤ و٧: ٥٢ و١٧: ٣١ ورومية ١: ٤ و١بطرس ٣: ١٨).
ولا تَرَوْنَنِي أَيْضاً لا يرونه ثانية على الأرض إلا يوم الدين عند مجيئه ثانيةً. وأما حضور الروح القدس فيقنع الناس بخطيتهم وبره أكثر مما يقنعهم المسيح بحضوره في الجسد وبتعليمه اللفظي.
١١ «وَأَمَّا عَلَى دَيْنُونَةٍ فَلأنَّ رَئِيسَ هَذَا العَالَمِ قَدْ دِينَ».
لوقا ١٠: ١٨ ويوحنا ١٢: ٣١ وأعمال ٢٦: ١٨ وأفسس ٢: ٢ وكولوسي ٢: ١٥ وعبرانيين ٢: ١٤.
الذي يوضح معنى هذا الكلام قول المسيح سابقاً «اَلآنَ دَيْنُونَةُ هَذَا العَالَمِ. اَلآنَ يُطْرَحُ رَئِيسُ هَذَا العَالَمِ خَارِجاً» (يوحنا ١٢: ٣١ انظر شرحها). كان الشيطان هو الذي يحث العالم على رفض المسيح وقتله (يوحنا ٨: ٤٠، ٤١) فتبرير المسيح دينونة الشيطان.
كان موت المسيح على الصليب واسطة فداء العالم وانقلاب مملكة الشيطان وإقامة ملكوت المسيح الروحي، لأن الروح القدس جعل التبشير بذلك الموت وسيلة إلى تلك الأعمال العظيمة. ونجاح الإنجيل منذ يوم الخمسين إلى الآن كان دينونة للشيطان وإبطالاً لقوته، وهو دينونة لكل من يشاركه في مقاومته للمسيح، وهو مقدمة الدينونة الأخيرة حين يُغلب الغلبة التامة.
وكل خاطئ يتوب ويؤمن بالمسيح يدين الشيطان بتركه خدمته. وكل صنم مكسور وكل هيكل وثني مهدوم شاهد بأن رئيس العالم قد دين.
١٢ «إِنَّ لِي أُمُوراً كَثِيرَةً أَيْضاً لأقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا الآنَ».
مرقس ٤: ٣٣ و١كورنثوس ٣: ٢ وعبرانيين ٥: ١٢
أُمُوراً كَثِيرَةً هي ما أشار إليه في الآية بقوله «جميع الحق». وكُتبت في أعمال الرسل وفي رسائلهم لأنها نتيجة تعليم الروح القدس إيّاهم المبني على أقوال المسيح نفسه، ولا سيما موعظته على الجبل. وأمثلة تلك الأمور التي لم يستطع الرسل أن يحتملوها في وقتها بإيقاف الذبائح الموسوية والكهنوت اللاوي، وإبدال السبت بالأحد، ورفض الله أمة اليهود أن تكون شعبه الخاص، وإدخال الأمم إلى المشاركة في حقوق الإنجيل. والأرجح أن المسيح جعل تلك الأمور وأمثالها موضوع تعليمه لرسله في الأربعين يوماً التي صرفها معهم بين صعوده وقيامته وهو «يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله».
لا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا الآنَ معظم علة ذلك آراؤهم اليهودية في شأن المسيح وملكوته التي لا يمكن استئصالها إلا بموته وصعوده عنهم، وسكبه الروح القدس عليهم. ويتضمن قوله «لا تستطيعون الآن» وعداً بأنهم يستطيعون ذلك بعد حلول الروح القدس الذي سيعلمهم كل ما هو ضروري للكنيسة في كل حين، فلا تبقى حاجة إلى تعليم جديد في عصورها الآتية ولا يُنتظر.
١٣ «وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الحَقِّ، لأنَّهُ لا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَل كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ».
يوحنا ١٤: ١٧ و١٥: ٢٦ ويوحنا ١٤: ٢٦ و١يوحنا ٢: ٢٠، ٢٧ رؤيا ١: ١ - ١٠ و٢٢: ١٦، ١٧
رُوحُ الحَقِّ (انظر شرح يوحنا ١٤: ١٧). المسيح هو «الحق» (يوحنا ١٤: ٦) فالروح القدس يأخذ مما للمسيح ويخبر الناس به (ع ١٤).
يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الحَقِّ المختص بدين المسيح مما يجب أن تقبلوه وتعلّموه لغيركم. وفي ذلك وعد لهم بأن يكونوا مُلهَمين ليؤسسوا كنيسته ويضعوا لها القوانين الضرورية لعقيدتها وأعمالها مما علمهم هو، فالروح القدس يقدرهم على أن يذكروها ويفهموها ويعلّموها. فإذاً لا حقَّ للكنيسة أن تتوقع تعليماً جديداً بعد الرسل لأنهم وُعدوا «بجميع الحق».
لأنَّهُ لا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ أي لا يأتي بتعليم ليس من تعليم الآب والابن، فإنه موافق لهما في الرأي والكلام. وكلام المسيح عن الروح ككلامه عن نفسه، أي لم يعلّم إلا ما علّمه الآب (يوحنا ٧: ١٦ و١٢: ٤٩ و١٤: ٢٤).
كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ السمع هنا كناية عن نقل الحديث، فالمعنى أن الروح يأخذ تعليمه من الآب والابن في ما يختص بعمل الفداء (انظر شرح يوحنا ٥: ٣٠).
وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ أي بما يحدث في الكنيسة بعد تعليمه لهم. ومن أمثلة ذلك أن الروح يبيِّن لهم الغاية من موت المسيح، وسبب التغييرات في الكنيسة اليهودية من إلغاء الذبائح وغيرها من الطقوس، ومن دعوة الأمم، وتشتّت اليهود (انظر أفسس ٤: ٧ - ١٦). وألهم الروح القدس الرسل علاوة على ذلك أن يتنبأوا بأمور مستقبليَّة تتعلق بالكنيسة والعالم (أعمال ١١: ٢٨ و٢٠: ٢٩ و٢١: ١١ و١تيموثاوس ٤: ١ - ٣ و٢تيموثاوس ٣: ١ - ١٣ وسفر الرؤيا كله).
١٤ «ذَاكَ يُمَجِّدُنِي، لأنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ».
٢كورنثوس ٣: ١٧، ١٨
ذَاكَ يُمَجِّدُنِي هذا وعد بعمل ثالث من أعمال الروح (الأول والثاني في ع ١٣). والتمجيد المقصود هنا هو تمجيد المسيح أمام عيون الناس على الأرض، لأن مجده في السماء ظاهر لا يحتاج إلى إظهار الروح إيّاه. والمعنى أن الروح القدس يبرئ اسم المسيح مما وقع عليه من العار والتهم الباطلة، ويرفع شأنه وصيته، وشأن تعليمه وعمله. فكل تعليم ديني لا يعظم يسوع بأنه مخلّص إلهي ووسيط وحيد ورئيس أحبار ليس من الروح القدس.
يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ هذا وعد بعمل رابع من أعمال الروح القدس. ومعنى قوله «مما لي» كلامي وعملي لفداء العالم. فكما أن الرسول يأخذ التعليم عن مرسِله، كذلك يأخذ الروح عن المسيح لإجراء مقاصد المسيح في سبيل الخلاص. وينتج من ذلك أن موضوع تعليم الروح القدس الخاص هو يسوع المسيح. فيجب على الواعظين أن يكون هو موضوع تعليمهم.
وَيُخْبِرُكُمْ أي يفهمكم معنى ما يأخذه عني ويجعله يؤثر فيكم، إذ يأخذ الروح القدس ما في إنجيل المسيح من مواعيد وإنذارات وتعاليم ويجعلها مؤثرة في قلوب الناس، تأتي بهم إلى الإيمان والتوبة والقداسة ( ١كورنثوس ١٢: ٣). وكان هذا الوعد للرسل وتحقق في يوم الخمسين، إذ اتسعت معرفتهم الروحية كثيراً. وهذا الوعد هو للمسيحيين في كل عصر، لأن الروح ينير عقولهم، ويقيهم من الضلال، ويقدِّرهم على معرفة الحق والتبشير به.
١٥ «كُلُّ مَا لِلآبِ هُوَ لِي. لِهَذَا قُلتُ إِنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ».
متّى ١١: ٢٧ ويوحنا ٣: ٣٥ و١٣: ٣ و١٧: ١٠
قال هذا تفسيراً لقوله «مما لي» في الآية السابقة وبياناً لاتفاقهما في التعليم، وأن كل ما للواحد هو للآخر، فكلاهما يأخذ من كنز الحق الواحد. ويصح أن يعني أن مجد الابن هو مجد الآب ومجد الآب هو مجد الابن، بحسب القول «لِمَعْرِفَةِ سِرِّ اللَّهِ الآبِ وَالمَسِيحِ، المُذَّخَرِ فِيهِ جَمِيعُ كُنُوزِ الحِكْمَةِ وَالعِلمِ» (كولوسي ٢: ٢، ٣ وأيضاً كولوسي ١: ١٢ ومتّى ١١: ٢٧). ولنا في هذه الآية ما يُثبت سر التثليث، وفيها أن الآب معلَنٌ بالابن، وأن الروح القدس يقدِّر الناس أن يفهموا ويقبلوا هذا الإعلان.
١٦ «بَعْدَ قَلِيلٍ لا تُبْصِرُونَنِي، ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ أَيْضاً تَرَوْنَنِي، لأنِّي ذَاهِبٌ إِلَى الآبِ».
يوحنا ٧: ٣٣ و١٣: ٣٣ و١٤: ١٩ وع ١٠، ٢٨ ويوحنا ١٣: ٣
بَعْدَ قَلِيلٍ أي بعد ساعات من يومٍ واحدٍ قبل موته (يوحنا ١٤: ١٩).
لا تُبْصِرُونَنِي لا بالعيون الجسدية ولا بعين الإيمان، لأني أُحجب عنكم في القبر ثلاثة أيام. وهذه المدة أشد ظلاماً من كل مدة في تاريخ العالم. وسبب عدم رؤيته بعين الإيمان وقتئذ أن إيمانهم ضعف حتى كان يفنى.
بَعْدَ قَلِيلٍ أَيْضاً تَرَوْنَنِي بدأت تلك الرؤية يوم قيامته وتدوم إلى الأبد، لأنه قام وظهر لعيونهم الجسدية أربعين يوماً. وبعد إتيان المعزي رأوه بعين الإيمان إذ كان حاضراً بالروح مع كنيسته، وسوف يرونه في مجيئه الثاني، ثم يرونه إلى الأبد في السماء (يوحنا ١٤: ١٩).
لأنِّي ذَاهِبٌ إِلَى الآبِ لكي أرسل إليكم المعزي كما قلت في الآية السابقة. وهذا يوضح كل الكلام عن ذهابه ورجوعه ونظرهم إيّاه واحتجابه عنهم. والأمر ذو الشأن هو ليس مطلق الذهاب، بل الذهاب إلى الآب.
١٧، ١٨ «١٧ فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ تلامِيذِهِ، بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا هُوَ هَذَا الَّذِي يَقُولُهُ لَنَا: بَعْدَ قَلِيلٍ لا تُبْصِرُونَنِي، ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ أَيْضاً تَرَوْنَنِي، وَلأنِّي ذَاهِبٌ إِلَى الآبِ؟. ١٨ فَتَسَاءَلُوا: مَا هُوَ هَذَا القَلِيلُ الَّذِي يَقُولُ عَنْهُ؟ لَسْنَا نَعْلَمُ بِمَاذَا يَتَكَلَّمُ».
كان صعباً على الرسل أن يفهموا ما قصده يسوع بسبب آرائهم اليهودية في أن المسيح يحيا إلى الأبد ويملك على الأرض. فمنعتهم هذه الآراء من فهم كلام المسيح، فظنوه لغزاً، وصعُب عليهم التوفيق بين قوله في ع ١٠ وع ١٦.
١٩ «فَعَلِمَ يَسُوعُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْأَلُوهُ، فَقَالَ لَهُمْ: أَعَنْ هَذَا تَتَسَاءَلُونَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، لأنِّي قُلتُ: بَعْدَ قَلِيلٍ لا تُبْصِرُونَنِي، ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ أَيْضاً تَرَوْنَنِي».
عَلِمَ يَسُوعُ باعتباره الله، وأفكار الناس مكشوفة لديه (يوحنا ٢: ٢٥ و٦: ٦).
٢٠ «اَلحَقَّ الحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ سَتَبْكُونَ وَتَنُوحُونَ وَالعَالَمُ يَفْرَحُ. أَنْتُمْ سَتَحْزَنُونَ، وَلَكِنَّ حُزْنَكُمْ يَتَحَوَّلُ إِلَى فَرَحٍ».
الكلام من هذه الآية إلى آية ٢٧ تفسير لقوله «بعد قليل تبصرونني» وقوله «ثم بعد قليل ترونني». وفي آية ٢٢ فسَّر قوله «إني ذاهب إلى الآب».
سَتَبْكُونَ وَتَنُوحُونَ حزنوا قبلاً حين أنبأهم بخيانة بعضهم وإنكار الآخرين إيّاه وبآلامه وموته والخطر الذي ينتظرهم، فقال إن ذلك الحزن سيزيد حين يرون ويختبرون ما أنبأهم به (يوحنا ١٠: ١١ ولوقا ٢٣: ٣٧). حزن عالي الكاهن ووقع ميتاً حين سمع أن الفلسطينيين أخذوا تابوت الرب، وأما الحزن الذي أصاب الرسل فأعظم من حزنه، لأن التابوت كان رمزاً للمسيح حين أهانه أعداؤه (وقد كللوه بالشوك وصلبوه بين لصيّن) إهانة أشد من إهانة الفلسطينيين للتابوت. وناحوا لأنهم لم ينتظروا أن يروه أيضاً بعد الموت.
وَالعَالَمُ يَفْرَحُ أي أهل العالم أعداؤه ولا سيما اليهود الذين طلبوا قتله وأظهروا فرحهم بالهزء به والتهكم عليه وهو على الصليب.
حُزْنَكُمْ يَتَحَوَّلُ إِلَى فَرَحٍ حين ترونني قائماً ممجداً. بل أنكم تفرحون بموتي أيضاً حين تتحققون نتائجه، وهي تمهيد السبيل لخلاص العالم ونوال النفوس الميتة الحياة الأبدية، وأن المسيح سبى سبياً واستولى على مفاتيح الموت والجحيم.
٢١، ٢٢ «٢١ اَلمَرْأَةُ وَهِيَ تَلِدُ تَحْزَنُ لأنَّ سَاعَتَهَا قَدْ جَاءَتْ، وَلَكِنْ مَتَى وَلَدَتِ الطِّفْلَ لا تَعُودُ تَذْكُرُ الشِّدَّةَ لِسَبَبِ الفَرَحِ، لأنَّهُ قَدْ وُلِدَ إِنْسَانٌ فِي العَالَمِ. ٢٢ فَأَنْتُمْ كَذَلِكَ، عِنْدَكُمُ الآنَ حُزْنٌ. وَلَكِنِّي سَأَرَاكُمْ أَيْضاً فَتَفْرَحُ قُلُوبُكُمْ، ولا يَنْزِعُ أَحَدٌ فَرَحَكُمْ مِنْكُمْ».
إشعياء ٢٦: ١٧ وع ٦ لوقا ٢٤: ٤١، ٥٢ ويوحنا ١٤: ١، ٢٧ و٢٠: ٢٠ وأعمال ٢: ٤٦ و١٣: ٥٢ و١بطرس ١: ٨
كثيراً ما استعمل أنبياء العهد القديم هذا المثل (إشعياء ٢١: ٣ و٢٦: ١٧، ١٨ و٦٦: ٧، ٨ وإرميا ٤: ٣١ و٢٢: ٢٣ و٣٠: ٦ وهوشع ١٢: ١٣، ١٤ وميخا ٤: ٩، ١٠). ووجه الشبه بين فرح المرأة بعد حزنها وفرح التلاميذ بعد حزنهم أن حزن كل منهما وقتي، يليه فرح دائم، وأن عظمة الفرح تنسيهم شدة الحزن الماضي. وفي ذلك تلميح إلى أنه كما أن حزن التلاميذ يتحول إلى فرح كذلك فرح أعداء المسيح يتحول إلى حزن.
عِنْدَكُمُ الآنَ حُزْنٌ لتوقعكم ذهابي.
سَأَرَاكُمْ أَيْضاً وهذا يستلزم أنهم سيرونه (ع ١٩). والمعنى أنهم سيجتمعون أيضاً حتى يراهم ويروه. وكان ذلك يوم قيامته جسدياً، وبعد صعوده إلى الأبد روحياً.
فَتَفْرَحُ قُلُوبُكُمْ على قدر حزنكم قبل ذلك، فيتجدد رجاؤكم، وتنالون قوة جديدة وشجاعة، وتدركون حقيقة طبيعتي وخدمتي وتحقيق النبوات فيّ.
ولا يَنْزِعُ أَحَدٌ فَرَحَكُمْ مِنْكُمْ فرح الرسل بحضور المسيح معهم، ونزع موته ذلك الفرح منهم. ولكن فرحهم الجديد لم يكن ليُنزع منهم، لتحققهم أن يسوع هو المسيح، وأنه حي إلى الأبد وباق معهم إلى انقضاء الدهر، وكل سلطان في يده حتى أن لا يسمح أن تسلب الشكوك فرحهم الداخلي، ولا التهديدات والاضطهادات الخارجية من الأعداء.
يمكن الناس أن يأخذوا منا المال الأرضي والصحة والحرية والأصحاب الأرضيين، لكنهم لا يستطيعون أن يأخذوا منا المسيح، ولا يقدرون أن ينزعوا فرحنا.
٢٣ «وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ لا تَسْأَلُونَنِي شَيْئاً. اَلحَقَّ الحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ مَا طَلَبْتُمْ مِنَ الآبِ بِاسْمِي يُعْطِيكُمْ».
متّى ٧: ٧ ويوحنا ١٤: ١٣ و١٥: ١٦
فِي ذَلِكَ اليَوْمِ أي حين إتيان الروح القدس وتعليمه إيّاهم كل شيء.
لا تَسْأَلُونَنِي شَيْئاً أي لا تحتاجون إلى أن تطلبوا مني تفسير كلامي كما احتجتم إلى ذلك سابقاً، وأن تطلبوا تكراره لنسيانكم إيّاه، لأن الروح القدس يوضح لكم كل ما غمض عليكم من كلامي، ويذكركم كل ما نسيتموه. وقول المسيح هنا مبني على قول البشير في ع ١٩ «كَانُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْأَلُوهُ، فَقَالَ لَهُمْ: أَعَنْ هَذَا تَتَسَاءَلُونَ فِيمَا بَيْنَكُمْ؟» وهو توطئة لقوله في ع ٢٥ وهما بمعنى واحد، إذ فيهما وعد بالإدراك التام لكل الحقائق التي كانت سابقاً كأمثال وألغاز. ونرى كيف تحقق هذا الوعد في خطاب بطرس وسائر الرسل يوم الخمسين بعد حلول الروح القدس، إذ أوضحوا الأمور المختصة بالمسيح وموته أحسن إيضاح.
كُلَّ مَا طَلَبْتُمْ هذا الوعد كالوعد في يوحنا ١٤: ١٣ و١٥: ١٦، فراجع شرحهما. وظاهر هذا الوعد أنه بلا قيد، والحق أنه مقيّد بأنه لا يتحقق إلا بعد حلول الروح القدس عليهم، ولا يطلبون بعد ذلك إلا ما يحتاجون إليه لنموهم الروحي ونفعهم لغيرهم، وبأن سؤالهم الشيء يكون باسم المسيح، وبالإيمان المستند على المواعيد التي تكلم هو بها.
٢٤ «إِلَى الآنَ لَمْ تَطْلُبُوا شَيْئاً بِاسْمِي. اُطْلُبُوا تَأْخُذُوا، لِيَكُونَ فَرَحُكُمْ كَامِلاً».
يوحنا ١٥: ١١ وأفسس ٢: ١٨
إِلَى الآنَ أي مدة خدمتي وأنا معكم.
لَمْ تَطْلُبُوا شَيْئاً بِاسْمِي اعتبر التلاميذ يسوع نبياً وسيداً ومعلماً وصديقاً، فسألوه الإرشاد والمعونة. لكنهم لم يكونوا قد تعودوا أن يصلّوا لله الآب باسمه، ولم يعتبروه الوسيط الوحيد بين الله والناس الذي به وحده يصلي الناس صلاة مقبولة، فينال الخطاة رحمة والصديقون نعمة (أفسس ٢: ١٨). نعم إن الله وهب كل مراحمه للناس إكراماً للمسيح، ولكن الرسل لم يعرفوا إلى ذلك الحين أنهم مديونون للمسيح بكل ما نالوه بالصلاة.
اُطْلُبُوا تَأْخُذُوا أي اطلبوا باسمي تُجابوا. فكأنه اعتبر الرسل شركاءه في كل حقوقه عند الآب. قال المسيح لتلاميذه في بدء خدمته «اطلبوا تجدوا» (متّى ٧: ٧). وهنا زاد على ذلك أن يكون الطلب باسمه. ولم يقل ذلك من أول الأمر لأن شرط الإجابة باسمه أن يموت عن العالم، وكانوا لا يستطيعون إدراك ذلك. وقوله «اطلبوا تأخذوا» أمر إلزامي علاوة على كونه شرطاً ووعداً، وهو عام لكل المسيحيين. وبناءً على ذلك أخذ المسيحيون جميعاً يختمون صلاتهم بقولهم «نسأل، أو هبْ لنا اللهم ذلك إكراماً للمسيح».
لِيَكُونَ فَرَحُكُمْ كَامِلاً المقصود بالفرح هنا الفرح الروحي. وشرط نوال هذا الفرح كاملاً أن نسأل الآب ما نريده باسم يسوع.
٢٥ «قَدْ كَلَّمْتُكُمْ بِهَذَا بِأَمْثَالٍ، وَلَكِنْ تَأْتِي سَاعَةٌ حِينَ لا أُكَلِّمُكُمْ أَيْضاً بِأَمْثَالٍ، بَل أُخْبِرُكُمْ عَنِ الآبِ علانِيَةً».
بِأَمْثَالٍ ذكر المسيح كثيراً من تعاليمه بطريق المجاز، فغمض على التلاميذ وعسر عليهم فهم بعض تعاليمه بسبب آرائهم اليهودية. وكان بعضها إنباء بالمستقبل، ومثل هذا صعب الفهم قبل تحقيقه. وكل تعليم لا يُدرك معناه يصلح أن يُسمى مثلاً، فالذبائح الموسوية والطقوس اليهودية والنبوات كانت كألغاز إلى ما بعد موت المسيح.
وَلَكِنْ تَأْتِي سَاعَةٌ بعد إرسالي الروح القدس.
لا أُكَلِّمُكُمْ أَيْضاً بِأَمْثَالٍ، بَل أُخْبِرُكُمْ اعتبر المسيح تعليم الروح القدس تعليمه لأنه هو أرسله ع ٧. فأنار هذا التعليم عقول الناس ليفهموا أقوال المسيح، وعمل على تجديد قلوبهم ليحبوا الأمور الروحية.
عَنِ الآبِ أي عن صفاته ومقاصده في إجراء عمل الفداء، ولا سيما تنظيم الكنيسة المسيحية، وانتشارها بين قبائل الأرض. أتى المسيح ليعلن الآب للعالم، لكن العالم لم يدرك إلا قليلاً من إعلانه، حتى رُفع يسوع على الصليب وحل عليهم الروح القدس. فأظهر المسيح بصلبه، مع إظهار الروح عدل الله وقداسته وحقه ورحمته ومحبته.
٢٦ «فِي ذَلِكَ اليَوْمِ تَطْلُبُونَ بِاسْمِي. وَلَسْتُ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي أَنَا أَسْأَلُ الآبَ مِنْ أَجْلِكُمْ».
ع ٢٣
لَسْتُ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي أَنَا أَسْأَلُ الآبَ مِنْ أَجْلِكُمْ أي لا داعي لأن أقول لكم ذلك إذ قلته سابقاً، وقد عرفتموه (يوحنا ١٤: ١٦). ولئلا تتوهموا أن ما قلته سابقاً أن الآب غير مكترث بهم، أو أنه لا يريد أن يستجيبهم، وهو ليس صحيحاً. وهذا لا يعني أن المسيح لا يسأل الآب من أجلهم، فأصحاح ١٧ كله صلاة للآب من أجلهم، ومضمون كل الإنجيل أن المسيح يشفع فينا في السماء، وننال بشفاعته المغفرة والسلام والقوة والمعونة والخلاص. وقد أوضح الرسول ذلك بقوله «هو حي في كل حين ليشفع» (عبرانيين ٧: ٢٥).
٢٧ «لأنَّ الآبَ نَفْسَهُ يُحِبُّكُمْ، لأنَّكُمْ قَدْ أَحْبَبْتُمُونِي، وَآمَنْتُمْ أَنِّي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَرَجْتُ».
يوحنا ١٤: ٢١، ٢٣ ويوحنا ٣: ١٣ وع ٣٠ ويوحنا ١٧: ٨
لأنَّ الآبَ نَفْسَهُ يُحِبُّكُمْ ذكر المسيح في هذه الآية سبباً آخر لقوله «لستُ أقول لكم إني أسأل الآب من أجلكم» وهذا يؤكد لهم أن طريق اقترابهم إلى الآب ممهدة مفتوحة.
لأنَّكُمْ قَدْ أَحْبَبْتُمُونِي، وَآمَنْتُمْ هذا مثل قوله قبلاً «الذي يحبني يحبه أبي» (يوحنا ١٤: ٢١، ٢٣) يعتبر الآب أصدقاء ابنه أصدقاءه، ويميل إلى إجابة طلباتهم. وذلك بفضل المسيح لأنهم أحبوه وآمنوا به، فالذين لا يحبون المسيح ولا يؤمنون به لا يحبهم الآب. وقرن المسيح المحبة بالإيمان لأنها تمهيد له، فإن الثقة بالمحبة سهلة.
٢٨ «خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ الآبِ، وَقَدْ أَتَيْتُ إِلَى العَالَمِ، وَأَيْضاً أَتْرُكُ العَالَمَ وَأَذْهَبُ إِلَى الآبِ».
يوحنا ١٣: ٣
هذا تصديق لما في ع ٢٧ مما آمنوا به، فكأنه قال إن ما آمنتم به حق.
خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ الآبِ أي أرسلني الآب لأفدي العالم (يوحنا ٥: ٣٦ و٧: ٢٩). ولم يقصد بهذا بيان أنه ابن الله، بل بيان ما عمل لخلاص البشر. وقيل مثل هذا في الروح القدس (يوحنا ١٥: ٢٦). آمن التلاميذ أن ذلك الرجل الفقير المهان من الناس هو ابن الله الذي نزل من السماء ليخلّص العالم. وقوله «خرجت» يشير إلى أن المسيح تنازل من تلقاء إرادته من المجد الأسنى فهو «إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ اللَّهِ، لَمْ يَحْسِبْ خُلسَةً أَنْ يَكُونَ مُعَادِلاً لِلَّهِ. لَكِنَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ، آخِذاً صُورَةَ عَبْدٍ» (فيلبي ٢: ٦، ٧).
وَقَدْ أَتَيْتُ إِلَى العَالَمِ أي أتيت إلى الأرض متجسداً (يوحنا ١: ١٤ و٣: ١٩ و٦: ١٤، ٦٢ و٩: ٣٩). وهذا لا يمنع أنه كان على هذه الأرض بالروح قبل ذلك (يوحنا ١: ١٠).
أَتْرُكُ العَالَمَ بالموت والصعود.
وَأَذْهَبُ إِلَى الآبِ راجعاً إلى مجدي الأصلي بالطبيعة البشرية التي أخذتها هنا. في هذه الآية أربع جمل تلخص ما عمله المسيح للفداء. الأولى: تبيّن تنازله من المجد الأسنى. والثانية: تبين تجسده. والثالثة: تبين موته. والرابعة: تبين رجوعه إلى مجده.
٢٩ «قَالَ لَهُ تلامِيذُهُ: هُوَذَا الآنَ تَتَكَلَّمُ علانِيَةً وَلَسْتَ تَقُولُ مَثَلاً وَاحِداً!».
أشاروا بذلك إلى حيرتهم السابقة بقوله في ع ١٦ «بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل ترونني» وإرادتهم أن يسألوه عن معنى ذلك (ع ١٩) ولكنهم فهموا ذلك لتفسيره إياه في ع ٢٨ بقوله «أترك العالم واذهب إلى الآب». وفيه إشارة أيضاً إلى إيمانهم القوي بالمسيح وأنه ثابت لا يتزعزع. ولا شك أنهم قالوا ذلك عن إخلاص ولم ينتبهوا لضعف قلوبهم.
٣٠ «اَلآنَ نَعْلَمُ أَنَّكَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَلَسْتَ تَحْتَاجُ أَنْ يَسْأَلَكَ أَحَدٌ. لِهَذَا نُؤْمِنُ أَنَّكَ مِنَ اللَّهِ خَرَجْتَ».
يوحنا ٢١: ١٧ ع ٩، ١٧ ويوحنا ١٧: ٨
اَلآنَ نَعْلَمُ أَنَّكَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ تحققوا أن علمه فائق الطبيعة لأنه عرف أفكارهم ومحاوراتهم الانفرادية، واقتنعوا من ذلك بصحة كل دعاويه، فكانت علة إيمانهم كعلة إيمان نثنائيل (يوحنا ١: ٤٨، ٤٩).
وَلَسْتَ تَحْتَاجُ أَنْ يَسْأَلَكَ أَحَدٌ لأنك تعرف أفكار الجميع وما وقعوا فيه من المشاكل، وأنت مستعد أن تحل المشاكل بدون سؤال.
أَنَّكَ مِنَ اللَّهِ خَرَجْتَ جمعوا كل عقائد إيمانهم به بهذه الجملة، لأنه إذا كان خرج من الله فهو ابنه، وهو المسيح مخلّص العالم. وهذا أصرح إقرار بالإيمان أجمع عليه الرسل.
٣١ «أَجَابَهُمْ يَسُوعُ: أَلآنَ تُؤْمِنُونَ؟»
هذا استفهام لا يلزم منه شك المسيح في إيمانهم، لكن فيه تلميحاً إلى أنه غير ثابت كما ظنوا، وهو دعوة لهم إلى امتحان قلوبهم ليعرفوا هل إيمانهم وطيد حتى لا يعثروا من الاضطهاد والضيق.
٣٢ «هُوَذَا تَأْتِي سَاعَةٌ، وَقَدْ أَتَتِ الآنَ، تَتَفَرَّقُونَ فِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى خَاصَّتِهِ، وَتَتْرُكُونَنِي وَحْدِي. وَأَنَا لَسْتُ وَحْدِي لأنَّ الآبَ مَعِي».
متّى ٢٦: ٣١ ومرقس ١٤: ٢٧ ويوحنا ٢٠: ١٠ ويوحنا ٨: ٢٩ و١٤: ١٠، ١١
هُوَذَا تَأْتِي سَاعَةٌ هي قبل شروق شمس الغد.
وَقَدْ أَتَتِ الآنَ أي اقتربت كثيراً.
تَتَفَرَّقُونَ فِيهَا كغنم بدّدتها الذئاب. تحقق هذا في متّى ٢٦: ٣١، ٥٦.
كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى خَاصَّتِهِ أي مبيته وأصحابه، أو إلى حيث يلجأ.
وَتَتْرُكُونَنِي وَحْدِي في هذا إشارة إلى الأسف والعتاب لتركهم إيّاه حين يؤخذ أسيراً إلى رؤساء الكهنة وبيلاطس، ولا يقف أحد منهم معه ليعضده. ترك التلاميذ من لم يتركه الآب، ومن ترك مجده في السماء رغبة في خلاصهم، وهو أعز أصدقائهم. فالذي في يمينه كل القدرة والحكمة والجودة والسعادة، الذي تجثو أمامه الملائكة ويترنمون بتمجيده تركوه خوفاً وخجلاً. وهذا الترك زاده حزناً في وقت ضيقته، لأنه احتاج باعتباره إنساناً أن يشعر معه الأصدقاء بأحزانه (متّى ٢٦: ٣٨) وتألم من حرمانه من ذلك (متّى ٢٦: ٤٠).
وَأَنَا لَسْتُ وَحْدِي تركه الناس لكن الله لم يتركه، وكان متيقناً من أن الآب معه ومن محبته له، وأنه زاد الحب له لبذله نفسه عن الخطاة، وأنه يسمع صلواته (متّى ٣: ١٧ و١٧: ٥ ويوحنا ٣: ٥٣ و٥: ٢٠ و٨: ٢٩ و١٠: ١٧ و١١: ٤٢).
نعم إن الله حجب وجهه عنه قليلاً وهو يكفر عن الإثم حتى صرخ «لماذا تركتني؟» (متّى ٢٧: ٤٦) لكنه ظل يناديه «إلهي إلهي» وسلم نفسه إليه بكل ثقة قائلاً «يَا أَبَتَاهُ، فِي يَدَيْكَ أَسْتَوْدِعُ رُوحِي» (لوقا ٢٣: ٤٦). ولكل مسيحي مثل تلك التعزية في وقت الاضطهاد والموت، لأنه وإن تركه الناس لا يتركه الله. ومعونة الله أفضل من كل معونة المخلوقات.
٣٣ «قَدْ كَلَّمْتُكُمْ بِهَذَا لِيَكُونَ لَكُمْ فِيَّ سلامٌ. فِي العَالَمِ سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ، وَلَكِنْ ثِقُوا: أَنَا قَدْ غَلَبْتُ العَالَمَ».
إشعياء ٩: ٦ ويوحنا ١٤: ٢٧ ورومية ٥: ١ وأفسس ٢: ١٤ وكولوسي ١: ٢٠ ويوحنا ١٥: ١٩ و٢تيموثاوس ٣: ١٢ ويوحنا ١٤: ١ رومية ٨: ٣٧ و١يوحنا ٤: ٤ و٥: ٤
قَدْ كَلَّمْتُكُمْ بِهَذَا أي بما مر من خطابه في يوحنا ١٣ - ١٦، ولا سيما في ما قاله في مجيء الروح القدس المعزي (يوحنا ١٦: ٧) وفي إجابة صلواتهم.
فِيَّ سلامٌ كما وعدهم في يوحنا ١٤: ٢٧. والذي يهب لهم هذا السلام إيمانهم في المسيح، وثقتهم بحضوره معهم، ومعونته لهم بواسطة الروح القدس. وهذا يتضمن أنهم يتشجعون زمان مقاومة الأعداء لهم، لتيقنهم من عنايته ومحبته. وهذا الوعد لم يتحقق إلا بعد اجتماعهم بعد تشتتهم.
فِي العَالَمِ أي بين أهل العالم.
سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ أي اضطهاد واضطراب وبلايا، فكان عليهم أن يتوقعوا ذلك من أهل العالم ما داموا في العالم. وذلك ليس نصيب الرسل فقط، بل نصيب كل المسيحيين في كل زمان ومكان على هذه الأرض.
وَلَكِنْ ثِقُوا لو نظروا إلى الضيق وحده ما أمكنهم الثقة، ولكنهم وثقوا لما نظروا إلى المسيح بالإيمان. شعب الله احتمل الضيق في كل عصر ووثق بالمسيح، ففرح في أشدّ الضيقات، ومات كثيرون منه شهداء واستشهدوا بسرور.
أَنَا قَدْ غَلَبْتُ العَالَمَ أي أهل العالم لأن أكثرهم خضع للشيطان رئيس هذا العالم وقاوم يسوع. وغلب المسيح العالم بموته (يوحنا ١٢: ٣١). وبانتصاره عليه انتصر كل المؤمنين به حتى لم يستطع العالم أن يغلبهم بشيء من التملّقات والاضطهادات. وغلبه بانتصاره على الشيطان الذي هو أعظم أعداء شعب المسيح (متّى ٤: ١ - ١١). وتعاليم المسيح من مواعيده وإنذاراته ومؤازرات روحه القدوس تقدِّر المؤمنين على هزيمة التجارب الداخلية من الشهوات والانفعالات الرديئة والميل إلى الشك. وقد عرَّف المسيح تلاميذه بعظمة أفراح السماء حتى تبدو أفراح العالم بالنسبة لها لا شيء، وأوضح لهم شدة أهوال جهنم حتى تبدو أهوال العالم بالنسبة لها لا شيء.
ومعظم انتصار المسيح على العالم كان بموته، فقد قال «غلبت العالم» قبل أن يموت فحسب أنه مات لفرط قرب موته وقتئذ (يوحنا ١٤: ١٩) ويوافق قوله هنا ما جاء في رومية ٨: ٣٤ - ٣٧ و ١كورنثوس ١٥: ٥٧ و٢كورنثوس ٢: ١٤ و١يوحنا ٤: ٤ و٥: ٤، ٥.
الأصحاح السابع عشر
صلاة المسيح الشفاعية طلبه تمجيده بالمجد الأصلي (ع ١ - ٥)
١ «تَكَلَّمَ يَسُوعُ بِهَذَا وَرَفَعَ عَيْنَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَ: أَيُّهَا الآبُ، قَدْ أَتَتِ السَّاعَةُ. مَجِّدِ ابْنَكَ لِيُمَجِّدَكَ ابْنُكَ أَيْضاً».
يوحنا ١٢: ٢٣ و١٣: ٣٢
هذه صلاة الأقنوم الثاني من اللاهوت للأقنوم الأول، وتفيدنا كيف كان المسيح يصلي وهو على الأرض، وكيف يصلي الآن في السماء بشفاعته فينا، والبركات التي يمكننا أن نسألها في الصلاة، والتي نتوقعها إجابة لصلاته وشفاعته. «لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان» ولم يصلِّ إنسان مثلما صلى. وصلى هذه الصلاة على مسمع من الأحد عشر رسولاً، والأرجح أنه قدمها واقفاً في البيت حيث تعشوا، بدلالة قول البشير بعد نهاية الصلاة «قال يسوع هذا وخرج» (يوحنا ١٨: ١).
وَرَفَعَ عَيْنَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ كعادة الناس في الصلاة لارتفاع النفس إلى الله حينئذ، وقد سبق الكلام على مثل ذلك في شرح يوحنا ١٤: ٣١ (قارن بهذا لوقا ١٨: ١٣).
أَيُّهَا الآبُ دعا الله «الآب» ست مرات في هذه الصلاة، وزاد على ذلك القدوس مرة (ع ١١) والبار مرة (ع ٢٥).
قَدْ أَتَتِ السَّاعَةُ أي الوقت الذي عيّنه الآب لموت ابنه عن الخطاة ثم لتمجيده (يوحنا ١٢: ٢٣، ٢٧ و١٣: ١، ٣١). وهذه الساعة التي وعد بها الله، وانتظرها الناس. قيل هذا القول منذ سقوط آدم إلى ذلك الوقت. وأشار الله إلى تلك الساعة في جنة عدن. ورآها إبراهيم بالإيمان حين منعه الله من ذبح إسحاق. وأُشير إليها برفع الحية النحاسية في البرية، وبذبيحة الحَمَل اليومية وسائر الذبائح في خيمة الاجتماع وفي الهيكل. وهي التي تكلم فيها موسى وإيليا وهما مع يسوع على جبل التجلي. وهي الساعة التي ظهرت فيها أمجاد اللاهوت ظهوراً لم يسبق له نظير، وتوقف عليها خلاص المفديين. ولأن هذه الساعة لم تأت قبلاً لم يستطع أعداؤه أن يضروه (يوحنا ٧: ٣٠ و٨: ٢٠) ولكنها إذ أتت سلم ذاته إليهم ليفعلوا ما أرادوا.
مَجِّدِ ابْنَكَ ابتدأ المسيح صلاته لأجل رسله وكنيسته بطلب تمجيد نفسه، لأنه أساس الكنيسة، وهي تحصل على كل بركة روحية وسماوية باستحقاقه. وغاية طلبه التمجيد لنفسه تمجيد كنيسته. وفسر معنى هذا في ع ٥. وهذا التمجيد لا يحصل عليه ما لم يجتز في طريق الألم والهوان والموت. وعرف المسيح ذلك وقدم نفسه للموت طوعاً، رغبة في أن يصعد بواسطة الموت إلى المجد. وطلب المسيح أن يشترك ناسوته في مجد لاهوته أيضاً.
لِيُمَجِّدَكَ ابْنُكَ أَيْضاً أي ليُظهر للكون، بموته على الصليب كفارة عن إثم البشر، قداسة الله وحكمته وعدله وحقه ورحمته، تمجيداً له، وليظهر ذلك بخلاص الخطاة الذين يشاركون المسيح في تمجيد الله بأقوالهم وأفعالهم، لأن كل خاطئ يؤمن يمجد الله. ويظهر ذلك المجد بإرسال الروح القدس ليجعل إنجيله ناجحاً في العالم. وقد تمجد الله بنجاح الإنجيل أكثر مما تمجد بغيره من طرق تمجيده في هذا العالم، وأبان المسيح (بما قاله من ع ٢ - ٤) أن الله تمجد بما ذُكر. فقول المسيح «مجدني لأمجدك» دليل على مساواته للآب، لأنه لا يمكن أن مخلوقاً يقول ذلك لخالقه، ودليل على أن تمجيد الله كان غاية يسوع العظمى، وأن الله لم يتمجد بشيء من أعمال المسيح كما تمجد بموته وقيامته وصعوده.
٢ «إِذْ أَعْطَيْتَهُ سُلطَاناً عَلَى كُلِّ جَسَدٍ لِيُعْطِيَ حَيَاةً أَبَدِيَّةً لِكُلِّ مَنْ أَعْطَيْتَهُ».
تكوين ٦: ٧، ١٣، ١٧ ودانيال ٧: ١٤ ومتّى ١١: ٢٧ و٢٨: ١٨ ويوحنا ٣: ٣٥ و٥: ٢٧ و ١كورنثوس ١٥: ٢٥، ٢٦ وفيلبي ٢: ١٠ وعبرانيين ٢: ٨ ويوحنا ٦: ٣٧ وع ٦، ٩، ٢٤
إِذْ أَعْطَيْتَهُ سُلطَاناً دفع الآب في عهد الفداء كل سلطانه للمسيح في السماء وعلى الأرض، أي على الملائكة والبشر وسائر المخلوقات، وعلاوة على ذلك أرسل الروح القدس لأن مجيئه كان ضرورياً لعمل الفداء. والمسيح وإن كان وقتئذ على وشك أن يموت موت الضعف والعار قبض على كل القوة الإلهية.
ذُكرت في هذه الآية عطيتان: الأولى السلطان المطلق، والثانية الحياة الأبدية. والأولى وسيلة إلى الثانية. وبناءً على أخذ المسيح ذلك السلطان أمر تلاميذه بعد قيامته أن يذهبوا إلى العالم أجمع ويكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها (متّى ٢٨: ١٨، ١٩ ومرقس ١٦: ١٥).
والعطاء هنا ليس من عالٍ لدون أو من كبير لصغير، بل من مساوٍ لمساوٍ بحسب ما اقتضى تقسيم عمل الفداء بين أقانيم اللاهوت. فالآب هو المرسِل، والابن رسوله، والروح القدس رسولهما.
كُلِّ جَسَدٍ أي جنس البشر (متّى ٢٥: ٢٢ ومرقس ١٣: ٢٠ ولوقا ٣: ٦ وأعمال ٢: ١٧ ورومية ٣: ٢٠). ولا يلزم من ذلك أن كل البشر يخلصون، بل أن للمسيح سلطاناً أن يهب الكل الحياة الأبدية، لأنه مات لأجل الجميع، ودعا الجميع إليه، وهو يخلّص كل من آمن به.
لِيُعْطِيَ حَيَاةً أَبَدِيَّةً (انظر شرح يوحنا ٦: ٤٠). ولهذا أخذ السلطان المطلق، ولم يعتبر ذلك السلطان شيئاً إلا لخلاص نفوس الناس. والحياة الأبدية المذكورة هنا تشتمل على كل نتائج الفداء من تبرير وتقديس وتمجيد في السماء. وهو وهب تلك الحياة للناس ببذله نفسه كفارة عن خطايا العالم، ومنحها لكل الذين يؤمنون.
لِكُلِّ مَنْ أَعْطَيْتَهُ (يوحنا ٦: ٣٧ - ٤٠) ويسمى هؤلاء الآخِذون أحياناً «مختارين» ولا يعرفون باختيارهم إلا بإتيانهم إلى المسيح بالتوبة والإيمان.
٣ «وَهَذِهِ هِيَ الحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ: أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْتَ الإِلَهَ الحَقِيقِيَّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ المَسِيحَ الَّذِي أَرْسَلتَهُ».
إشعياء ٥٣: ١١ وإرميا ٩: ٢٤ ١كورنثوس ٨: ٤ و١تسالونيكي ١: ٩ ويوحنا ٣: ٣٤ و٥: ٣٦ و٣٧ و٦: ٢٩، ٥٧ و٧: ٢٩ و١٠: ٣٦ و١١: ٤٢
وَهَذِهِ هِيَ الحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ تتضمن هذه الحياة النجاة من كل شر وتحصيل كل خير الآن وإلى الأبد. ويُعبَّر عن فوائد الفداء بالحياة الأبدية (يوحنا ٣: ١٥، ١٦، ٣٦ و٥: ٢٤، ٣٩ و٦: ٢٧، ٤٠، ٤٧، ٥٤، ٦٨ و١٠: ٢٨ و١٢: ٢٥، ٥٠).
أَنْ يَعْرِفُوكَ الطريق الوحيدة إلى نوال الناس الحياة الأبدية هي معرفة الإله الحقيقي بواسطة ابنه، وكل من لهم هذه المعرفة يتبررون ويتقدسون على الأرض ويتمجدون في السماء. والمعرفة المقصودة هنا ليست مجرد المعرفة العقلية، لأن للشيطان مثل تلك المعرفة. إنما المقصود المعرفة التي تغير القلب والسيرة، وتقترن بمحبة الله والمسرة به.
لما دخلت الخطية إلى العالم فقد الناس معرفة الله الحقيقية، فأتى المسيح ليرشدهم إليها، وعلَّمهم توحيد الله وصفاته ومقاصده، ومن ذلك قداسته وعدله ورحمته ورأفته وأبوّته.
أَنْتَ الإِلَهَ الحَقِيقِيَّ وَحْدَكَ الذي أنا أخاطبه أباً في هذه الصلاة، والذي قلت إنه أرسلني إلى العالم لأعلنه. ووصفه المسيح بأنه الإله الحقيقي الوحيد ليميز بينه وبين الآلهة الكثيرة الكاذبة، لا ليميز بينه وبين الابن، كأن الآب هو الإله الحق والابن ليس كذلك. لأن التمييز بين الآب والابن لا ينفي وحدانية الله، لأن من أهم تعاليم الإنجيل إثبات التوحيد والتثليث. ومما يثبت لنا أن المسيح لم يقصد التمييز بينه وبين الآب هنا كأنه دون الآب أنه من المحال القول بتعلق الحياة الأبدية بمعرفة خالق ومخلوق.
وَيَسُوعَ المَسِيحَ الَّذِي أَرْسَلتَهُ قيل إن المسيح يعطي الحياة الأبدية (ع ٢)، ويعطيها بإعطاء معرفة الله التي فيها تلك الحياة إعطاءً لا يستطيعه غيره. وأبان هنا أن ذلك يكون أيضاً بمعرفة أن يسوع هو المسيح، وأنه رسول الله وكلمته ليعلنه للناس، وأنه ممسوح منه نبياً وكاهناً وملكاً، وليظهر جلياً أن الله لفرط حبه للناس بذل ابنه الوحيد فداءً عنهم لينالوا الحياة الأبدية. فالمسيح اشترى تلك الحياة بموته ووهبها للناس بروحه.
عرف الناس بدون إرشاد المسيح وجوده وبعض صفاته ككونه خالقاً وملكاً ودياناً، لكن معرفتهم هذه أنشأت فيهم الخوف من الله ومنعتهم من الاقتراب إليه. ولكنهم عرفوا بالمسيح (الذي هو الكلمة متجسداً) المعرفة التامة التي ينالون بها الحياة الأبدية، لأنه علَّمهم أن الله إله الرحمة والمحبة والمغفرة، وأنه يصالح العالم لنفسه. وأعلن ذلك بأقواله وأفعاله ولا سيما بموته.
وهذه الآية هي الآية الوحيدة التي بها سمى ابن الله نفسه بيسوع المسيح.
٤ «أَنَا مَجَّدْتُكَ عَلَى الأَرْضِ. العَمَلَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي لأعْمَلَ قَدْ أَكْمَلتُهُ».
يوحنا ١٣: ٣١ ويوحنا ٤: ٣٤ و٥: ٣٦ و٩: ٣ و١٤: ٣١ و١٥: ١٠ و١٩: ٣٠
تكلم يسوع عن نفسه في ع ١ - ٣ بضمير الغائب، واستخدم هنا ضمير المتكلم.
مَجَّدْتُكَ عَلَى الأَرْضِ مجَّد المسيح الآب على الأرض في كل حياته، لا في السنين التي بشر فيها فقط. ومجده بإعلانه للناس، وبحفظه الناموس حفظاً كاملاً، فقام بذلك بالطاعة الكاملة عن الخاطئ، وتسليم التعليم الذي أخذه من الآب إلى الناس بالأمانة، وشهادته للحق بأقواله وأعماله وتواضعه وقداسته. ومجد الله أكثر من كل ذلك بالموت الذي كان على وشك أن يموته. والجملة الآتية تبيّن أن المسيح مجد الله بإكماله عمل الفداء.
العَمَلَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي.. أَكْمَلتُهُ أي عمل الخلاص الذي أعطاه الآب له ليعمله في عهد الفداء. وعبر عن موته وقيامته بالماضي لقربهما، وليقينه وقصده أن ذلك سيحدث.
مجد المسيح الآب منذ تجسده حتى وقت صعوده، بقداسته وطاعته لإرادة أبيه، وإنكاره نفسه، واحتماله الآلام لأجل الناس. فما قصَّر فيه آدم نائباً عن البشر من تمجيد الله أكمله يسوع إذ حفظ الناموس كله، وأوفى ما على الناس من الدَّين لشريعة الله، وصار سبب خلاص أبدي لكل المؤمنين (عبرانيين ٥: ٩). ولعله أشار إلى ما أنبأ به دانيال بقوله «سَبْعُونَ أُسْبُوعاً قُضِيَتْ عَلَى شَعْبِكَ وَعَلَى مَدِينَتِكَ المُقَدَّسَةِ لِتَكْمِيلِ المَعْصِيَةِ وَتَتْمِيمِ الخَطَايَا، وَلِكَفَّارَةِ الإِثْمِ، وَلِيُؤْتَى بِالبِرِّ الأَبَدِيِّ» (دانيال ٩: ٢٤).
٥ «وَالآنَ مَجِّدْنِي أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ عِنْدَ ذَاتِكَ بِالمَجْدِ الَّذِي كَانَ لِي عِنْدَكَ قَبْلَ كَوْنِ العَالَمِ».
يوحنا ١: ١، ٢ و١٠: ٣٠ و١٤: ٩ وفيلبي ٢: ٦ وكولوسي ١: ١٥ وعبرانيين ١: ٣، ١٠
وَالآنَ مَجِّدْنِي أَنْتَ كرر المسيح الطلبة التي ابتدأ بها الصلاة بعد أن أعطى حساب خدمته الأرضية فجعل إتمام ما عليه سبب طلبه أن الله يمجده.
عِنْدَ ذَاتِكَ قارن هذا بما في يوحنا ١٣: ٣١، ٣٢. وخلاصة ذلك أن المسيح مجد الآب على الأرض (ع ٤) فسأله مجازاة لذلك أن يمجده عند ذاته في السماء.
بِالمَجْدِ الَّذِي كَانَ لِي صرّح المسيح هنا أنه كان له مجد إلهي قبل تجسده، وسأل الآب أن يسمح له بترك حال التواضع الذي تنازل إليه اختياراً لفداء الخطاة، وأن يرجع إلى المقام الأسنى الذي كان له منذ الأزل، لأنه واحد من الأقانيم الثلاثة المتساوين في المجد والقدرة. ولم يسأل بذلك مجداً جديداً أعظم مما كان له، بل سأل رفع حجاب ناسوته الذي أخفى مجده لكي تنتشر أشعته. وسأل أن يشترك ناسوته على قدر الإمكان في مجد لاهوته.
تثبت هذه الآية أمرين: (١) وجود المسيح قبل تجسده (يوحنا ١: ١٨). (٢) أن الآب والابن ليسا أقنوماً واحداً بل هما أقنومان متساويان في المجد. وهذا الإثبات يستحق كل الاعتبار لأنه قول المسيح نفسه في صلاته للآب.
صلاة المسيح الشفاعية - طلبه من أجل رسله (ع ٦ - ١٩)
٦ «أَنَا أَظْهَرْتُ اسْمَكَ لِلنَّاسِ الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي مِنَ العَالَمِ. كَانُوا لَكَ وَأَعْطَيْتَهُمْ لِي، وَقَدْ حَفِظُوا كلامَكَ».
مزمور ٢٢: ٢٢ ويوحنا ٦: ٣٧، ٣٩ و١٠: ٢٩ و١٥: ١٩ وع ٢، ٩، ١١، ٢٦
أكمل المسيح عمله على الأرض أما تلاميذه فكانوا على وشك أن يبدأوا عملهم، فاحتاجوا إلى نعمة وقوة، فصلى المسيح من أجلهم.
أَنَا أَظْهَرْتُ اسْمَكَ لِلنَّاسِ بتعليمي أنك أنت الإله الحق، وبتمجيدي إيّاك على الأرض ( ع ٢، ٤). والمقصود باسم الله هنا صفاته (مزمور ٢٢: ٢٢ و٥٣: ٩ و١١٩: ٥٥ وإشعياء ٢٦: ٨ وأعمال ٩: ١٤). وقد سبق الكلام على ذلك في شرح متّى ٦: ٩. والاسم الذي أظهره المسيح للناس أعظم إظهار بتعليمه وعمله هو الآب، أي أنه أبونا. وكان إظهار أفكار الله وإرادته وصفاته غاية المسيح الأولى من تعليمه إيّاهم وهو على الأرض، ولا يزال يعلمهم ذلك عينه الآن بكلامه الذي في الإنجيل. فعلينا أن نبذل كل جهد في أن نتعلمه منه.
لِلنَّاسِ الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي مِنَ العَالَمِ وصف تلاميذه بذلك لأن الآب أعطاهم له (يوحنا ٦: ٣٧)، وأفرزهم من العالم (يوحنا ١٥: ١٩)، وهم مختاروه ورعيته التي وكلها الله إلى عنايته باعتباره الراعي الصالح. وكانوا من العالم كغيرهم من الناس أعطاهم الله له، لا لأنهم أفضل من سائر أهل العالم فيفتخرون، بل لحكمة عنده.
كَانُوا لَكَ أي بخلقك إيّاهم. فإذا كان له حق أن يعطيهم للمسيح لأنهم كانوا خدام الله قبل أن يصيروا تلاميذ المسيح، وبذلك كانوا مستعدين لقبول تعليم يسوع، فقبلوا تعليم الله الذي أرسله من موسى والأنبياء، واستعدوا لقبول التعليم الذي أعطاه لابنه (انظر شرح يوحنا ٥: ٤٦ و٦: ٣٧ و٨: ٤٧).
أَعْطَيْتَهُمْ لِي فإذاً هم معيّنون من الله ليكونوا للمسيح رسلاً لينادوا بإنجيله.
وَقَدْ حَفِظُوا كلامَكَ هذا وصف آخر للتلاميذ يميزهم عن سواهم، فيعرفهم به الناس. أما كونهم عطية الله للمسيح فصفة تجعلهم أهلاً لممارسة العمل الذي يكلفهم المسيح به. وقصد بكلام الآب تعليم إنجيله، ونسبه إلى الآب لأنه أرسله ليعلنه للناس. وكلام المسيح هو كلام الآب (يوحنا ٧: ١٦ و١٢: ٤٨، ٤٩). وقصد بالحفظ هنا الإصغاء إلى كلامه، وقبوله بالرضى والطاعة له اختياراً. فلنا من ذلك أن الطاعة للمسيح هي البرهان الأول والأعظم على أن الإنسان تلميذ المسيح. فطوبى لمن يشهد المسيح لهم أنهم حفظوا كلام الآب.
٧ «وَالآنَ عَلِمُوا أَنَّ كُلَّ مَا أَعْطَيْتَنِي هُوَ مِنْ عِنْدِكَ».
وَالآنَ عَلِمُوا هذا العلم نتيجة تعليم المسيح إيّاهم، وهو أساس زيادة علمهم حين يحل الروح القدس عليهم بعد هذا بقليل (يوحنا ١٦: ٣٠).
أَنَّ كُلَّ مَا أَعْطَيْتَنِي هُوَ مِنْ عِنْدِكَ علموا أن معلمهم ليس ابن نجار من الناصرة، ولا نبياً من الجليل، بل ابن الله من السماء، المسيح الموعود به، وأن كل ما تكلم به وفعله من أول خدمته إلى آخرها كان حسب إرادة الآب وتعليمه، وإعلان الآب للعالم لتسميته «كلمة الله». وذكر المسيح علمهم بذلك لا لمجرد مدحهم على أنهم تلاميذ نجباء، بل لبيان أنهم أهلٌ لأن يكونوا معلمين نافعين بالنيابة عن معلمهم يسوع.
٨ «لأنَّ الكلامَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي قَدْ أَعْطَيْتُهُمْ، وَهُمْ قَبِلُوا وَعَلِمُوا يَقِيناً أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ، وَآمَنُوا أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَلتَنِي».
يوحنا ٨: ٢٨ و١٢: ٤٩ و١٤: ١٠ ويوحنا ١٦: ٢٧، ٣٠ وع ٢٥
في هذه الآية بيان الطريق التي توصلوا بها إلى العلم المذكور في الآية السابقة، وهي أنه هو علمهم ما أخذه من الآب (يوحنا ١٢: ٤٩)، وتمم بذلك ما أنبأ به الله بفم موسى قائلاً «أُقِيمُ لَهُمْ نَبِيّاً مِنْ وَسَطِ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ، وَأَجْعَلُ كلامِي فِي فَمِهِ، فَيُكَلِّمُهُمْ بِكُلِّ مَا أُوصِيهِ بِهِ» (تثنية ١٨: ١٨).
الكلامَ أي الحقائق المتعلقة بالله وبخلاص البشر، وأعطاها الآب للابن في عهد الفداء ليعلنها للعالم، فذلك الكلام هو كلام الحكمة والتعزية والقوة والحياة، وكنز العلم الذي لا يزول ولو زالت السموات والأرض (متّى ٢٤: ٤٥). وما قاله المسيح هنا يثبت صحة ما كتبه الرسل في رسائلهم، ويبيّن أنه ليس كلامهم، بل إن الله الآب أعطاه للابن، وأعطاه الابن للرسل وألهمهم أن يعطوه للكنيسة.
وَهُمْ قَبِلُوا هذا القبول يعني قيام الرسل بالمسؤولية، أما غيرهم فسمع التعليم ولم يقبله. والفرق بين الفريقين لا يتوقف على التعليم ولا على العلم، بل على استعداد السامع للقبول (قارن يوحنا ١: ١ بيوحنا ١: ١٢).
ذكر المسيح هنا ثلاثة أمور في شأن تلاميذه: (١) أنهم قبلوا تعليمه باختيار وسرور. (٢) أنهم علموا واعترفوا أنه خرج من عند الآب. (٣) أنهم آمنوا بما سمعوا وتأكدوا منه. وأكثر اليهود أبوا قبوله وتصديقه. نعم إن معرفة التلاميذ كانت ناقصة، وكان إيمانهم ضعيفاً، لكن المسيح عرف أن الذي عرفوه كان كافياً لخلاصهم، وأن إيمانهم كان قلبياً خالصاً، فمدحهم للآب.
أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ انظر شرح يوحنا ٣: ٢ و١٦: ٣٠.
وَأَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَلتَنِي يزيد هذا على معنى الجملة التي قبله، أنه هو المسيح المنتظر (ع ٣) ومعنى تلك الجملة أنه أتى من السماء.
٩ «مِنْ أَجْلِهِمْ أَنَا أَسْأَلُ. لَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ العَالَمِ، بَل مِنْ أَجْلِ الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي لأنَّهُمْ لَكَ».
١يوحنا ٥: ١٩
مِنْ أَجْلِهِمْ أَنَا أَسْأَلُ بعد ما وصف المسيح رسله للآب أخذ يصلي من أجلهم. وكل ما صنعه المسيح على الأرض إنما صنعه من أجل تلاميذه المؤمنين به، فإنه أتى ومات وقام وصعد لأجلهم، ولم يزل يصلي من أجلهم. وطلب لهم في هذه الصلاة ست بركات: (١) أن يحفظهم الله أمناء. (٢) أن ينصرهم على الشيطان. (٣) أن يقدسهم. (٤) أن يملأهم سروراً. (٥) أن يقدِّرهم على تمجيده وتمجيد الآب. (٦) أن يكونوا معه في المجد.
لَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ العَالَمِ أي في هذه الطلبة إذ هي صلاة من أجل التلاميذ خاصة. فلا يلزم من ذلك أنه لا يصلي من أجل العالم، بدليل أنه صلى من أجله (ع ٢١) وصلى من أجل قاتليه (لوقا ٢٣: ٣٤). وصلاته من أجل شعبه تتضمن الصلاة من أجل العالم، لأن كل ما ناله المؤمنون من البركات والمواهب الروحية كان لهم وسيلة إلى إفادة العالم، بدليل قوله «مَنْ آمَنَ بِي كَمَا قَالَ الكِتَابُ تَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُ مَاءٍ حَيٍّ» (يوحنا ٧: ٣٨) وقوله «أنتم نور العالم» (متّى ٥: ١٤). فالمسيح وإن كان يصلي من أجل العالم لا بد أن يصلي من أجل شعبه باعتباره وسيطهم ورئيس كهنتهم (عبرانيين ٧: ٢٥).
بَل مِنْ أَجْلِ الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي بنى طلبه إلى الآب أن يعتني بتلاميذه على أنهم كانوا للآب قبل أن كانوا للمسيح (انظر شرح ع ٦).
لأنَّهُمْ لَكَ أي لم يزالوا لك بعد أن أعطيتهم لي، لأنه «كُلُّ مَا هُوَ لِي فَهُوَ لَكَ، وَمَا هُوَ لَكَ فَهُوَ لِي» (ع ١٠). فهم للآب بالتبني لكونهم إخوة المسيح فصاروا بذلك أعز إلى الآب.
١٠ «وَكُلُّ مَا هُوَ لِي فَهُوَ لَكَ، وَمَا هُوَ لَكَ فَهُوَ لِي، وَأَنَا مُمَجَّدٌ فِيهِمْ».
يوحنا ١٦: ١٥
هذا يعم كل المخلوقات من عقلاء وغيرهم (راجع شرح يوحنا ١٦: ١٥). وهذا دليل على لاهوت المسيح وإلا لاستحال أن يكون كذلك. وبناء على هذه الآية نُسب المؤمنون أحياناً إلى الآب وأحياناً إلى الابن.
وَأَنَا مُمَجَّدٌ فِيهِمْ هذه علة أخرى لصلاته من أجلهم خاصة، فهم مجدوه بحفظ كلامه ومحبتهم له وإيمانهم به حين رفضه سائر العالم وأبغضه (ع ٦ - ٨). ولكنهم سيمجدونه أكثر بعد ما يحل عليهم الروح القدس ويكونون شهوداً بأنه المسيح. ويتمجد المسيح بالمؤمنين كلما غلبوا شهواتهم الرديئة وعاشوا بالتقوى أمام العالم، وحملوا نير المسيح عليهم وتعلموا منه، وتمكنوا بواسطة الروح القدس من أن يعملوا أعمالاً أعظم من أعمال المسيح لإرشاد الخطاة إلى التوبة والإيمان.
١١ «وَلَسْتُ أَنَا بَعْدُ فِي العَالَمِ، وَأَمَّا هَؤُلاءِ فَهُمْ فِي العَالَمِ، وَأَنَا آتِي إِلَيْكَ. أَيُّهَا الآبُ القُدُّوسُ، احْفَظْهُمْ فِي اسْمِكَ. الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي، لِيَكُونُوا وَاحِداً كَمَا نَحْنُ».
يوحنا ١٣: ١ و١٦: ٢٨ و١بطرس ١: ٥ ويهوذا ١ ويوحنا ١٠: ٣ وع ٢١
وَلَسْتُ أَنَا بَعْدُ فِي العَالَمِ أكمل المسيح العمل الذي كان عليه (ع ٤) وحسب أنه ذاق الموت لفرط قربه منه.
وَأَمَّا هَؤُلاءِ فَهُمْ فِي العَالَمِ هذا ما حمله على الصلاة للآب من أجلهم، أي أنه تركهم فيه وهم ضعفاء مبغَضون ومضطهَدون، وعرضة للضيق والمصائب، ومحتاجون كاليتامى إلى الحماية والمساعدة، ومكلفون بأمر خطير هو أن يقوموا بالخدمة التي كان المسيح يقوم بها وينادوا للهالكين بالخلاص.
وَأَنَا آتِي إِلَيْكَ قارن حاله بحال التلاميذ، فهو أكمل أتعابه أما هم فبدأوا في أتعابهم. فلما كانوا معه كان يعزّيهم ويحميهم، ولكنه لقرب مفارقته لهم أخذ يهتم بهم ويستودعهم للآب.
أَيُّهَا الآبُ القُدُّوسُ، احْفَظْهُمْ كان تلاميذ المسيح على وشك أن يُتركوا في العالم الشرير وهم ليسوا منه (يوحنا ١٥: ١٩). وهم مدعوون ليكونوا قديسين كما أن الله قدوس. فاحتاجوا إلى نعمة من الله ليُحفظوا من شر العالم لكي لا يرتدوا عن الإيمان، ولا يكونوا فريسة لأعدائهم. فكأنه قال: يا إله القداسة، احفظ أولادك هؤلاء في قداستهم.
فِي اسْمِكَ انظر شرح ع ٦. اسم الله كناية عن قوته وحكمته ومحبته، فيكون المعنى أن يعينهم الآب على إظهار تلك الصفات للعالم بتعليمهم وعبادتهم، أي بأقوالهم وأعمالهم.
لِيَكُونُوا وَاحِداً أي متحداً بعضهم ببعض في القلب والعقل والغاية، بلا خصومة ولا انتقام، ورباط ذلك الاتحاد المحبة. ويتضح لنا سبب صلاة المسيح من أجل وحدة تلاميذه ما اختبرناه من شدة الأضرار التي حاقت بالكنيسة بما حدث فيها من انقسام.
كَمَا نَحْنُ انظر ع ٢١ - ٢٣. أراد المسيح أن يكون اتحاد بعض تلاميذه ببعض كاتحاده بالآب، لكن ذلك لا يمكن أن يكون كاملاً مثل هذا، إلا أن سكن الروح القدس في قلوب المؤمنين يحقق هذا الاتحاد.
١٢ «حِينَ كُنْتُ مَعَهُمْ فِي العَالَمِ كُنْتُ أَحْفَظُهُمْ فِي اسْمِكَ. الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي حَفِظْتُهُمْ، وَلَمْ يَهْلِكْ مِنْهُمْ أَحَدٌ إلا ابْنُ الهلاكِ لِيَتِمَّ الكِتَابُ».
يوحنا ٦: ٣٩، ٧٠ و١٠: ٢٨ و١٣: ٨ و١٨: ٩ وعبرانيين ٢: ١٣ و١يوحنا ٢: ١٩ وأعمال ١: ٢٠
حِينَ كُنْتُ مَعَهُمْ فِي العَالَمِ كان نحو ثلاث سنين ونصف سنة مرافقاً ومعلماً إياهم.
كُنْتُ أَحْفَظُهُمْ بتعليمي ونصائحي وسيرتي ومعجزاتي كراع يحفظ رعيته، فسأل الآب أن يحفظهم بعد أن يفارقهم كما حفظهم قبل ذلك. وأبان بذلك أنه مساوٍ لله لأن حفظ كلٍ منهما مساوٍ لحفظ الآخر.
فِي اسْمِكَ أي معرفتك وطاعتك بواسطة نعمتك وقوتك.
الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي كما جاء في ع ١١ ويوحنا ١٠: ٢٧ - ٢٩ حيث تكلم على خرافه الخاصة وتكررت هذه العبارة في يوحنا ١٨: ٩ بالمعنى نفسه.
حَفِظْتُهُمْ، وَلَمْ يَهْلِكْ مِنْهُمْ أَحَدٌ كلامه هنا عن الأحد عشر رسولاً الذين أعطاهم الآب له، وحفظهم هو بنعمته وقوته. ويصح هذا على كل الذين أعطاهم الآب له بدون استثناء.
إلا ابْنُ الهلاكِ أي يهوذا الإسخريوطي، وسماه ابن الهلاك لأنه سلم نفسه إلى الهلاك واستحقه. واصطلح الكتاب المقدس على مثل ذلك كثيراً كقوله «أبناء بليعال» و «أبناء النور» و «أبناء الظلمة» و «أبناء المعصية» و «أبناء السلام» مبالغة في الوصف (٢صموئيل ٢٦: ٥ ومزمور ٧٩: ١١ ومتّى ١١: ١٩ و١٣: ٣٨ و٢٣: ١٥ ولوقا ١٦: ٨) وغير ذلك. والاستثناء في هذه العبارة منقطع لأن يهوذا ليس من الذين أعطاهم الآب له، فكأنه قال: هلك واحد وهو يهوذا ابن الهلاك لأنك لم تعطه لي، فلم أحفظه، وقد قلت منذ زمان إنه شيطان (يوحنا ٦: ٧٠).
وقال بعض المفسرين إن معنى «الذين أعطيتني» الذين عيّنتهم رسلاً لي، فيصير المعنى أنه لم يهلك من الاثني عشر رسولاً الذين عيّنتهم لي سوى يهوذا.
لِيَتِمَّ الكِتَابُ اللام الداخلة على كلمة «يتم» هي لام العاقبة، لا لام التعليل. فيكون المعنى أن ذلك حدث بحسب ما قيل في الكتاب (مزمور ٤١: ٩ و١٠٩: ٨) وقد مرّ الكلام على مثل ذلك في يوحنا ١٣: ١٨ (انظر أيضاً أعمال ١: ٢٠). فقد هلك يهوذا بسبب فساد قلبه وآثامه التي جعلته ابن الهلاك وعدم توبته عنها. وليس في الكتاب المقدس علة أخرى لهلاك الإنسان. فمن المحال أن يكون تمام الكتاب علة هلاك يهوذا.
١٣ «أَمَّا الآنَ فَإِنِّي آتِي إِلَيْكَ. وَأَتَكَلَّمُ بِهَذَا فِي العَالَمِ لِيَكُونَ لَهُمْ فَرَحِي كَامِلاً فِيهِمْ».
يوحنا ١٥: ١١ و١٦: ٢٤ و١يوحنا ١: ٤
أَمَّا الآنَ فَإِنِّي آتِي إِلَيْكَ ذكر ذلك بياناً لعلة أنه استودع تلاميذه للآب، وأنه يترك حفظهم له.
أَتَكَلَّمُ بِهَذَا أي بهذه الصلاة وباستيداعي تلاميذي لك.
فِي العَالَمِ أي أتكلم بذلك على مسمع تلاميذي وأنا على الأرض قبل صلبي.
لِيَكُونَ فَرَحِي كَامِلاً فِيهِمْ عرف يسوع أنه يموت بعد قليل بألم شديد جداً، ومع ذلك أخذ يفتكر في فرح تلاميذه وتعزية المؤمنين في كل العصور المستقبلة، إذ عرف أن الذي سمعه تلاميذه سيقرأه غيرهم في إنجيله.
لِيَكُونَ لَهُمْ فَرَحِي كَامِلاً فِيهِمْ بسمعهم أني صليت هذه الصلاة من أجلهم واستودعتهم للآب. وينتج من قول المسيح هنا أن كنز الفرح كُنِز للمؤمنين. وقد سبق الكلام على فرح المسيح (يوحنا ١٥: ١١). وهذا الفرح نتيجة موته وقيامته وصعوده وشفاعته في السماء وإرساله الروح القدس. ومصدر هذا الفرح حضن الآب في السماء، فطلب المسيح من أجل تلاميذه في ضيقاتهم عين الفرح الذي كان له في ضيقاته، وهو الفرح الناتج من تحققه محبة الآب وعنايته.
١٤ «أَنَا قَدْ أَعْطَيْتُهُمْ كلامَكَ، وَالعَالَمُ أَبْغَضَهُمْ لأنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ العَالَمِ، كَمَا أَنِّي أَنَا لَسْتُ مِنَ العَالَم».
ع ٨ ويوحنا ١٥: ١٨، ١٩ و١يوحنا ٣: ١٣ ويوحنا ٨: ٢٣ وع ١٦
أَنَا قَدْ أَعْطَيْتُهُمْ كلامَكَ هذا تكرار ما قاله في آية ٨ ذكره هنا بياناً لما فعله لأجل حفظه إيّاهم. لقد وهب النظر للعميان والنطق للخرس والطعام للجياع والصحة للمرضى، أما تلاميذه فأعطاهم كلامه والنعمة لقبوله، حاسباً ذلك أعظم من سائر المواهب. وكل من يقبل كلام المسيح يقبل المسيح نفسه. ومنحهم المسيح كلامه لمنفعتهم ولينفعوا به غيرهم.
وَالعَالَمُ أَبْغَضَهُمْ ع ٦ ويوحنا ١٥: ١٨ - ٢١. وذكره هنا بياناً لاحتياجهم إلى حفظ الآب. إن أهل العالم أبغضوا كلام المسيح ورسل المسيح لتبشيرهم بذلك الكلام.
لأنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ العَالَمِ مرّ الكلام على هذا في شرح يوحنا ١٥: ١٩. وهو ليس طلبة بل يخبرنا أن الذين من العالم ليسوا للمسيح. ولا يقتضي أن يترك المسيحيون معاشرة الناس ويعيشوا منفردين، لأن المسيح عاشر كل صنوف البشر، ولكنه لم يفعل شيئاً أو يتكلم بشيء يجيز الخطأ في العوائد والمبادئ والغايات وطرق العبادة، ولم يتوقف عن التوبيخ على الضلال والشر ليشهد للحق. فعلى المسيحيين أيضاً أن يقتدوا به في ذلك ويكونوا أنواراً في العالم طاعة للقول «لِكَيْ تَكُونُوا بِلا لَوْمٍ، وَبُسَطَاءَ، أَوْلاداً لِلَّهِ بِلا عَيْبٍ فِي وَسَطِ جِيلٍ مُعَوَّجٍ وَمُلتَوٍ، تُضِيئُونَ بَيْنَهُمْ كَأَنْوَارٍ فِي العَالَمِ. مُتَمَسِّكِينَ بِكَلِمَةِ الحَيَاةِ» (فيلبي ٢: ١٥، ١٦).
١٥ «لَسْتُ أَسْأَلُ أَنْ تَأْخُذَهُمْ مِنَ العَالَمِ بَل أَنْ تَحْفَظَهُمْ مِنَ الشِّرِّيرِ».
متّى ٦: ١٣ وغلاطية ١: ٤ و٢تسالونيكي ٣: ٣ ويوحنا ٢: ١٣ و٥: ١٨
لعل الرسل ظنوا أن الطريق الفضلى لنجاتهم من شرور هذا العالم أن يأخذهم المسيح معه إلى السماء حين صعوده إليها، أما هو فلم يستحسن ذلك مع كثرة ما في العالم من التجارب للمسيحيين وشدة بغضه لهم. ولم يسأل المسيح الآب أن ينقل المؤمنين إلى السماء عند إيمانهم، بل اختار بقاءهم هنا مدة لفائدتهم لينموا في القداسة والاستعداد للسماء، ولفائدة غيرهم بتعليمهم وعملهم، وليمجدوا الله بذلك. وكان على الرسل أعمال لا بد من أن يعملوها، أما هو فقد عمل ما عليه ومجَّد الآب (ع ٤) فبقي عليهم أن يفعلوا مثل ذلك (ع ١٠).
لا يجوز للمسيحي أن يسأل الله أن يعفيه من التعب، بل أن يسأله قوة على عمل ما عليه. ولا أن يسأله الخلو من التجارب، بل النعمة ليقوى عليها. ولا أن يسأله عدم حلول المصائب، بل التعزية والفرح في ذلك بيقين محبة الآب له. ولا أن يسأله أن يرفعه من العالم، بل يقدِّره أن يفيد العالم مدة بقائه فيه.
بَل أَنْ تَحْفَظَهُمْ مِنَ الشِّرِّيرِ انظر شرح متّى ٦: ١٣. يطلق الشرير على ثلاثة من أعداء الإنسان، وهي العالم والشهوة والشيطان. وقد يُراد به الإثم كما في قوله «وَالعَالَمَ كُلَّهُ قَدْ وُضِعَ فِي الشِّرِّيرِ» (١يوحنا ٥: ١٩). ويراد به الشيطان كثيراً لأنه أصل كل الشرور (متّى ١٣: ١٩، ٣٩ و١يوحنا ٢: ١٣، ١٤ و٣: ١٢ و٥: ١٨).
١٦ «لَيْسُوا مِنَ العَالَمِ كَمَا أَنِّي أَنَا لَسْتُ مِنَ العَالَمِ».
ع ١٤
هذا كما قيل في ع ١٤. ذُكر هناك بياناً لسبب بغض العالم لهم، وطلبه حفظ الله وتقديسه لهم، وتجهيزهم للعمل الذي عليهم.
١٧ «قَدِّسْهُمْ فِي حَقِّكَ. كلامُكَ هُوَ حَقٌّ».
يوحنا ٨: ٤٠ و١٥: ٣ وأعمال ١٥: ٩ وأفسس ٥: ٢٦ و١بطرس ١: ٢٣ و٢صموئيل ٧: ٢٨ ومزمور ١١٩: ١٤٢، ١٥١
قَدِّسْهُمْ طلب حفظهم أولاً، ثم طلب تقديسهم. والمعنى: اجعلهم قديسين كما أنت قدوس (ع ١١) وعيّنهم لخدمتك كما عُينتُ أنا (ع ١٩) وقدِّرهم على مشابهتي في طهارة القلب والسيرة ( ١كورنثوس ٦: ١١ و١تسالونيكي ٥: ٢٣). قد نال الرسل بنعمة الله بعض القداسة، فطلب المسيح زيادتها. ولم يضع حداً لذلك إذ أراد أن يكونوا كاملين في القداسة، فاستعدوا بذلك لخدمة الله على الأرض، والتمتع بالحضور أمامه في السماء.
فِي حَقِّكَ أي بتأثير الحق في القلب والضمير. فالحق هو الآلة التي يقدس بها الروح القدس قلوب الناس. إن الخليقة تعلّم الإنسان حق الخالق وعنايته في تدبير العالم وإرسال المراحم والمصائب التي تعلمه الحقائق الآيلة لتقديسه. وأفضل وسائط التقديس ما يأتي:
كلامُكَ هُوَ حَقٌّ أي كلام الله في كتابه لما فيه من وصايا ومواعيد وإعلانات صفاته، وبيان طبيعة الإنسان، وما يتعلق بالموت والقيامة والدينونة وسعادة المفديين الأبدية من شقاء الهالكين ولا سيما نبأُ شهادته «بحَمَل الله الذي يرفع خطية العالم».
كلام الله لا يقدس القلب من تلقاء نفسه، ولا يستطيع إنسان أن يقدس قلباً بواسطته. إنما الله الذي يفعل ذلك بواسطة روحه القدوس.
والكلمة الهامة في هذه العبارة هي «كاف ضمير المخاطب» أضاف إليها الكلام تمييزاً له عن كلام الناس.
١٨ «كَمَا أَرْسَلتَنِي إِلَى العَالَمِ أَرْسَلتُهُمْ أَنَا إِلَى العَالَمِ».
يوحنا ٢٠: ٢١
كَمَا أَرْسَلتَنِي إِلَى العَالَمِ أشار إلى ذلك الإرسال في يوحنا ١٠: ٣٦.
أَرْسَلتُهُمْ أَنَا إِلَى العَالَمِ انظر شرح متّى ١٠: ٥ ولوقا ٦: ١٣. وتم إرسالهم في يوحنا ٢٠: ٢١. وأظهر المسيح أن إرساليتهم مثل إرساليته، فهُم يحتاجون إلى مثل تقديسه. ووجه الشبه بين المسيح ورسله باعتبار الإرسالية متعدد، وهو أن المسيح ليس من العالم بل هو مرسل إليه، والتلاميذ ليسوا من العالم بل هم مرسلون ليكونوا شهوداً للمسيح (يوحنا ١٥: ١٦). وأن الآب مسح المسيح لعمله، وأن الروح القدس مسح التلاميذ لعملهم (وتم هذا يوم الخمسين بقوة). وأن المسيح أرسله الله ليعلنه هو للعالم وليشهد للحق وليخلّص الهالكين، وأن الرسل أرسلهم المسيح ليفعلوا كذلك. وأن الله الآب أجاب صلاة المسيح واستجاب طلبات الرسل. وأن المسيح دخل السماء بالآلام، وأن الرسل دخلوها بضيقات كثيرة. وأن المسيح كان قدوساً بلا عيب منفصلاً عن الخطاة، وأن الرسل كانوا قديسين.
١٩ «وَلأجْلِهِمْ أُقَدِّسُ أَنَا ذَاتِي، لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضاً مُقَدَّسِينَ فِي الحَقِّ».
١كورنثوس ١: ٢ و٣٠ و١تسالونيكي ٤: ٧ وعبرانيين ٢: ١٠ و١٠: ١٠
وَلأجْلِهِمْ أُقَدِّسُ أَنَا ذَاتِي التقديس هنا بمعنى الوقف أو التخصيص (خروج ٤٠: ١٣ ولاويين ٢٢: ٢، ٣). والمعنى أن المسيح قدم نفسه لله ذبيحة إثم حسب القول «لَيْسَ بِدَمِ تُيُوسٍ وَعُجُولٍ، بَل بِدَمِ نَفْسِهِ، دَخَلَ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى الأَقْدَاسِ، فَوَجَدَ فِدَاءً أَبَدِيّاً» وقوله «فَكَمْ بِالحَرِيِّ يَكُونُ دَمُ المَسِيحِ، الَّذِي بِرُوحٍ أَزَلِيٍّ قَدَّمَ نَفْسَهُ لِلَّهِ بِلا عَيْبٍ» (عبرانيين ٩: ١٢ و١٤). ويقدس الله المؤمنين بالمسيح بواسطة الحق (ع ١٧) وأما المسيح فيقدس نفسه بلا واسطة. فيتضح من ذلك أن بين التقديسين فرقاً عظيماً، فمعنى تقديس المؤمنين تطهيرهم (أفسس ٥: ٢٦) ومعنى تقديس المسيح وقفه لخدمة معينة كقوله «الَّذِي قَدَّسَهُ الآبُ وَأَرْسَلَهُ إِلَى العَالَمِ» (يوحنا ١٠: ٣٦) وهو لا يحتاج إلى تطهير لأنه بلا خطية بدليل قول الرسول «الذي لم يفعل خطية ولا وُجد في فمه مكر» وقوله «الَّذِي لَمْ يَعْرِفْ خَطِيَّةً، خَطِيَّةً لأجْلِنَا» (٢كورنثوس ٥: ٢١ وعبرانيين ٤: ١٥).
وكون تقديس المسيح نفسه من أجل الرسل كما ذُكر لا ينفي أنه قدسها ذبيحة من أجل كل العالم. وقال المسيح «أقدس أنا ذاتي» لأنه قدّمها فدية وطوعاً واختياراً.
لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضاً مُقَدَّسِينَ فِي الحَقِّ أي ليتعلموا بواسطة الحق أن «يُقَدِّمُوا أَجْسَادَهُمْ ذَبِيحَةً حَيَّةً مُقَدَّسَةً مَرْضِيَّةً عِنْدَ اللَّهِ» (رومية ١٢: ١) كما فعل المسيح اختياراً متخذين إيّاه مثالاً، وليتقدسوا بذلك الدم الذي يطهر من كل خطيّة. فأمكنهم ذلك بواسطة تقديس المسيح نفسه ذبيحة إثم. ومعنى قوله «ليكونوا مقدسين في الحق» إما أن يكونوا مقدسين حقيقة، أو أن يكونوا كذلك بواسطة الحق. والمعنيان مفيدان.
صلاة المسيح لأجل كل المؤمنين (ع ٢ إلى ٢٦)
٢٠ «وَلَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ هَؤُلاءِ فَقَطْ، بَل أَيْضاً مِنْ أَجْلِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِي بِكلامِهِمْ».
وَلَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ هَؤُلاءِ فَقَطْ أي الأحد عشر.
بَل أَيْضاً مِنْ أَجْلِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِي أي كل الذين تتجدد قلوبهم بواسطة تبشير الإنجيل في كل زمان ومكان إلى نهاية الدهر، لأن للكل ضيقات وتجارب، وهُم في عالم شرير يضطهد أتباع المسيح ويبغضهم، وعليهم أن يشهدوا للحق، وهو عمل ذو شأن خطير، فيحتاجون دائماً إلى المعونة والتعزية. فإن كنا مؤمنين بالمسيح نتيقن أنه صلى من أجلنا حينئذ، ولا يزال يصلي كذلك.
بِكلامِهِمْ أي بشهادتهم للمسيح وخلاصه (يوحنا ١٥: ٢٧ ورومية ١٠: ١٤). ونتعلم من ذلك أن نشر كلام الله بواسطة الناس هو الوسيلة الضرورية إلى امتداد ديانة المسيح في العالم وإلى الإيمان به، وذلك مثل قول الرسول «إِذاً الإِيمَانُ بِالخَبَرِ، وَالخَبَرُ بِكَلِمَةِ اللَّهِ» (رومية ١٠: ١٧).
٢١ «لِيَكُونَ الجَمِيعُ وَاحِداً، كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ فِيَّ وَأَنَا فِيكَ، لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضاً وَاحِداً فِينَا، لِيُؤْمِنَ العَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلتَنِي».
يوحنا ١٠: ١٦ وع ١١، ٢٢، ٢٣ ورومية ١٢: ٥ وغلاطية ٣: ٢٨ ويوحنا ١٠: ٣٨ و١٤: ١١
لِيَكُونَ الجَمِيعُ وَاحِداً أي أن يكون المؤمنون جميعاً متحدين كإخوة، لأنهم مفديون بدم واحد، ومتساوون في الحاجات والأحزان والأفراح، وهُم عرضة لخطر واحد من الأعداء، ولأنهم مسافرون إلى سماء واحدة.
أراد المسيح أن تكون كنيسته على الأرض بمنزلة أهل بيت واحد مرتبطة بالمحبة للمسيح رئيسها وفاديها (أعمال ٤: ٣٢ - ٣٥ و١كورنثوس ٤: ١٢ - ٣١ وأفسس ٢: ٢٠ - ٢٢). واتحاد الناس بالله وبعضهم ببعض غاية تجسد المسيح وموته وإرساله الروح القدس.
كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ فِيَّ وَأَنَا فِيكَ انظر شرح يوحنا ١٠: ٣٠ و١٤: ١٠. لم ينتظر المسيح أن الاتحاد بين المؤمنين يماثل الاتحاد بين الآب والابن تمام المماثلة، بل أن يقرب من ذلك على قدر الإمكان، فيشترك المسيحيون في المقاصد والغايات والعواطف والشعور.
لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضاً وَاحِداً فِينَا أي متحدين بالآب والابن، وبعضهم ببعض. رغب المسيح أن تكون كنيسته متحدة، ورأى أن وسيلة ذلك أن يتحد كل عضو في الكنيسة به وبأبيه (أفسس ٤: ٤ - ٦).
لِيُؤْمِنَ العَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلتَنِي إذا رأى العالم علامات اتحاد الكنيسة يقتنع أن مصدرها من السماء، وأن المسيحية حق، وأن يسوع هو المسيح رسول الله. وينتج من ذلك أنه يتحول من كونه عدواً للحق إلى محب له مؤمن به.
قال المسيح في ع ٩ إنه لم يسأل وقتئذ من أجل العالم لأنه صلى لأجل المرسَلين إلى العالم، لكنه لم ينس العالم ولا غفل عن احتياجه، لأنه أتى ليخلصه. فالمسيح وإن كان العالم قد صلبه ورفضه توقع أن يرجع إليه بالتوبة ويخضع له.
٢٢ «وَأَنَا قَدْ أَعْطَيْتُهُمُ المَجْدَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي، لِيَكُونُوا وَاحِداً كَمَا أَنَّنَا نَحْنُ وَاحِدٌ».
رومية ٨: ٣٠ وأفسس ١: ١٨ و٢: ٦ ويوحنا ١٤: ٢٠ و١يوحنا ١: ٣ و٣: ٢٤
وَأَنَا قَدْ أَعْطَيْتُهُمُ المَجْدَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي تكلم المسيح في مجده المستقبل كأنه حاضر، وكذلك تكلم في مجد تلاميذه لأنهم لم يكونوا قد حصلوا إلا على الوعد به. والمجد المذكور هنا يسبقه التواضع في المعلم وفي التلاميذ، وهو قائم بأربعة أشياء: (١) إعلان مجد الله للناس. (٢) موهبة الروح القدس. (٣) مشاركتهم للمسيح في نشر بشرى الخلاص بعد إكماله عمل الفداء. (٤) مشاركتهم له في أفراح السماء حين يجلس على يمين الله، وصيرورتهم ورثة الله وارثين معه، ممجَّدين معه بعد ما تألموا معه (رومية ٨: ١٧، ٣٠ وأفسس ١: ١٨ و٢: ٦). متغيرين إلى صورته عينها من مجد إلى مجد (٢كورنثوس ٤: ١٨).
فمجد المسيحيين ليس مجد الرتب السامية، ولا إكرام الملوك والغنى، لكنه قائم بنوال النعمة ليحبوا إخوتهم من البشر، وينكروا أنفسهم من أجل الله، وهكذا يشتركون في مجد المسيح إن ساروا في الطريق التي سار فيها هو، وهي طريق التواضع وإنكار النفس.
لِيَكُونُوا وَاحِداً هذا غاية إعطائهم المجد الذي أعطاه له الآب.
٢٣ «أَنَا فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيَّ لِيَكُونُوا مُكَمَّلِينَ إِلَى وَاحِدٍ، وَلِيَعْلَمَ العَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلتَنِي، وَأَحْبَبْتَهُمْ كَمَا أَحْبَبْتَنِي».
كولوسي ٣: ١٤
هذه الآية تفسير للجملة الأخيرة من الآية السابقة، ذكرها ليصف الاتحاد بين الآب والابن والمؤمنين.
أَنَا فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيَّ يظهر من هذا أن اتحاد المسيحيين الذي رغب فيه المسيح قلبيٌ مبنيٌ على المحبة، ينتج عنه وحدة الإيمان، والسيرة المقدسة. وليست الغاية في المساواة في الطقوس وسياسة الكنيسة.
مُكَمَّلِينَ إِلَى وَاحِدٍ هذا دليل إن حال الانقسام في الكنيسة حال النقصان، وحال الاتحاد حال الكمال. فكلما نقص اتحاد الكنيسة قصرت عن الكمال الذي طلبه المسيح (١يوحنا ٢: ٥ و٤: ١٢، ١٧، ١٨).
وَلِيَعْلَمَ العَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلتَنِي كما قيل في ع ٢١ إلا أنه قيل هنالك «ليؤمن» وهنا «ليعلم». فالعلم مقترن بالإيمان والمحبة. قال المسيح إن العالم يقتنع باتحاد المسيحيين أن ديانتهم من الله، وأن معلمهم المسيح رسول الله والوسيط الوحيد والطريق والحق والحياة ورئيس السلام ورب المجد، وأنه يقبل بشارة الخلاص المرسَل إليهم من الآب. ولا يقتنع العالم بذلك إلا عندما يكون المؤمنون جيشاً واحداً تحت رئاسة رئيس واحد سماوي، متفقين في الرأي والعمل.
٢٤ «أَيُّهَا الآبُ أُرِيدُ أَنَّ هَؤُلاءِ الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي يَكُونُونَ مَعِي حَيْثُ أَكُونُ أَنَا، لِيَنْظُرُوا مَجْدِي الَّذِي أَعْطَيْتَنِي، لأنَّكَ أَحْبَبْتَنِي قَبْلَ إِنْشَاءِ العَالَمِ».
يوحنا ١٢: ٢٦ و١٤: ٣ و١تسالونيكي ٤: ١٧ رومية ٨: ١٧ و٢كورنثوس ٣: ١٨ و١يوحنا ٣: ٢ ع ٥
طلب المسيح قبلاً تقديس تلاميذه، واتحادهم به، واتحاد بعضهم ببعض. وسأل هنا سعادتهم الأبدية في السماء، وهي غاية ما طلبه قبلاً.
الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي هذه مرة سابعة وصف تلاميذه بذلك في هذه الصلاة، وهذا دليل على محبته أن ينظر إليهم عطية من الآب له.
يَكُونُونَ مَعِي حَيْثُ أَنَا أي في السماء (انظر شرح يوحنا ١٤: ٣). تتوقف أعظم سعادة القديسين في السماء على قبول هذه الطلبة، فلذلك لم يرد المسيح أن يرجع إلى الآب بدون تقديمها، وتركها مكتوبة لنقرأها ونعرف ما الذي يرغب فيه لشعبه، وهو أن يجلسوا معه في عرشه كما غلب هو وجلس مع أبيه في عرشه (رؤيا ٣: ٢١). وتتضمن هذه الطلبة أن الله يمنح للتلاميذ أيضاً كل الوسائط لنوال هذا المجد (لوقا ٢٣: ٤٣ وفيلبي ١: ٢٣ و١تسالونيكي ٤: ١٧).
لِيَنْظُرُوا مَجْدِي أي ليشتركوا فيه ويتمتعوا به لا مجرد مشاهدة العين (يوحنا ٣: ٣ ومتّى ٥: ٨ و٢كورنثوس ٣: ١٨ و١يوحنا ٣: ٢ ورؤيا ١٨: ٧).
لأنَّكَ أَحْبَبْتَنِي قَبْلَ إِنْشَاءِ العَالَمِ انظر شرح ع ٥. هذا من الأدلة القاطعة على أن المسيح كان قبل كل مخلوق. وذكره بياناً لعظمة مجده بأنه نتج عن محبة الآب منذ الأزل، بخلاف مجد القديسين الذي هو نتيجة أمانتهم مدة حياتهم على الأرض.
٢٥ «أَيُّهَا الآبُ البَارُّ، إِنَّ العَالَمَ لَمْ يَعْرِفْكَ، أَمَّا أَنَا فَعَرَفْتُكَ، وَهَؤُلاءِ عَرَفُوا أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَلتَنِي».
يوحنا ٧: ٢٩ و٨: ٥٥ و١٠: ١٥ و١٥: ٢١ و١٦: ٣، ٢٧ وع ٨
أَيُّهَا الآبُ البَارُّ وصف المسيح الآب بالبار لأنه يلتمس منه أن يهب تلاميذه أن يكونوا معه وينظروا مجده، وهذا ليس من الحق والعدل أن يُعطاه الأشرار الذين لم يعرفوا الآب، لكنه يليق بالذين أعدهم الآب لمشاهدة ذلك المجد مجازاة لهم على معرفتهم بالله وإيمانهم به ومحبتهم له.
أَمَّا أَنَا فَعَرَفْتُكَ كانت معرفة المسيح لأبيه كاملة بدليل قوله «كَمَا أَنَّ الآبَ يَعْرِفُنِي وَأَنَا أَعْرِفُ الآبَ» (يوحنا ١٠: ١٥). وهو قادر أن يعلن الآب للناس بدليل قول الرسول «الابْنُ الوَحِيدُ الَّذِي هُوَ فِي حِضْنِ الآبِ هُوَ خَبَّرَ» (يوحنا ١: ١٨) وقوله «لا أَحَدٌ يَعْرِفُ الآبَ إلا الابْنُ وَمَنْ أَرَادَ الابْنُ أَنْ يُعْلِنَ لَهُ» (متّى ١١: ٢٧).
وَهَؤُلاءِ عَرَفُوا بما علّمتهم (يوحنا ١٤: ٩، ١١). والوسيلة إلى معرفة الله هي الجلوس عند أقدام المسيح، وقبول تعاليمه بالإيمان.
٢٦ «وَعَرَّفْتُهُمُ اسْمَكَ وَسَأُعَرِّفُهُمْ، لِيَكُونَ فِيهِمُ الحُبُّ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي بِهِ، وَأَكُونَ أَنَا فِيهِمْ».
يوحنا ١٥: ٩، ١٥ وع ٦، ٢٣
وَعَرَّفْتُهُمُ اسْمَكَ اسم الله كناية عن صفاته، وأخص أسمائه المحبة. وكل تعليم المسيح وعمله إعلان تلك الصفات الحسنى.
سَأُعَرِّفُهُمْ بروحي القدوس الذي سأرسله. وعمل الروح هو الإرشاد إلى جميع الحق، وإعلان محبة الله «الفائقة المعرفة». ولا يزال المسيح يعرِّف الناس باسم أبيه بواسطة كتابه ومبشريه وروحه القدوس العامل فيهم وبهم.
لِيَكُونَ فِيهِمُ الحُبُّ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي بِهِ انظر شرح يوحنا ١٥: ٩. هذا نتيجة تلك المعرفة السماوية. ويشتمل الحب المذكور هنا على كل بركة. وهذه الطلبة كصلاة بولس من أجل كنيسة أفسس (أفسس ٣: ١٦ - ١٩). وهي تتضمن العناية والحماية من الأعداء على الأرض كما كان المسيح وكمال السعادة في السماء.
أتى المسيح إلى هذا العالم وعلَّم وتألم ومات من أجلنا لنصعد معه إلى المجد، ولتحل علينا محبة الآب وتملأ قلوبنا كما ملأت قلبه.
وَأَكُونَ أَنَا فِيهِمْ صرّح لهم بأنه ذاهب عنهم، وأنه مع ذلك باقٍ معهم بناسوته حاضراً بلاهوته. وهذا آخر صلاته الوداعية التي بدأت بكلمات تشير إلى المفارقة، وخُتمت بكلمات تشير إلى المجاورة والقربى، لأنه كان سابقاً ساكناً بينهم، وأما بعد صعوده فسكن في قلوبهم. والأساس الوحيد الذي يبني عليه المؤمنون رجاءهم هو محبة الآب لهم، وإجابته صلواتهم، لأن المسيح فيهم. وليس لفضلهم ولا لفضائلهم. ويدخل المسيح قلوبنا بالإيمان، ويمكث فينا بالإيمان، وهو «فينا رجاء المجد» وغاية القداسة والسعادة.
الأصحاح الثامن عشر
تسليم يسوع والقبض عليه (ع ١ - ١٢)
١ «قَالَ يَسُوعُ هَذَا وَخَرَجَ مَعَ تلامِيذِهِ إِلَى عَبْرِ وَادِي قَدْرُونَ، حَيْثُ كَانَ بُسْتَانٌ دَخَلَهُ هُوَ وَتلامِيذُهُ».
٢صموئيل ١٥: ٢٣ ومتّى ٢٦: ٣٦ ومرقس ١٤: ٣٢ ولوقا ٢٢: ٢٩
هَذَا أي الخطاب في يوحنا ١٤ - ١٦ والصلاة في يوحنا ١٧.
خَرَجَ مَعَ تلامِيذِهِ نستنتج أنه بقي إلى هذا الوقت مع تلاميذه في المدينة حيث أكل الفصح، والأرجح أنهم رتلوا قبل خروجهم (متّى ٢٦: ٣٠).
عَبْرِ وَادِي قَدْرُونَ كان هذا الوادي شرق أورشليم، بينها وبين جبل الزيتون (٢صموئيل ١٥: ١٣ و٢ملوك ٢٣: ١٢ و٢أيام ١٥: ١٦).
حَيْثُ كَانَ بُسْتَانٌ كان هذا البستان في سفح جبل الزيتون غرباً وسمّي «جثسيماني» (متّى ٢٦: ٣٦) والأرجح أن صاحب البستان كان من أصدقاء يسوع. ولم يذكر يوحنا صلاة المسيح وآلامه هناك. ولعل سبب ذلك أن الكنيسة كانت عارفة به عندما كتب يوحنا.
٢ «وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ يَعْرِفُ المَوْضِعَ، لأنَّ يَسُوعَ اجْتَمَعَ هُنَاكَ كَثِيراً مَعَ تلامِيذِهِ».
لوقا ٢١: ٣٧ و٢٢: ٣٩ ويوحنا ٨: ١
وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ يَعْرِفُ المَوْضِعَ لتردده إليه مع المسيح وغيره من التلاميذ. وذكره يوحنا لتأكد يهوذا أنه يجد المسيح هناك كما تحقق أعداء دانيال أنهم يجدونه يصلي وقت الصلاة في موضعه المعتاد (دانيال ٦: ١٠، ١١).
لأنَّ يَسُوعَ اجْتَمَعَ هُنَاكَ كَثِيراً مَعَ تلامِيذِهِ (لوقا ٢١: ٣٧ ومتّى ٢١: ١٧ ويوحنا ٨: ١). وقصد المسيح ذلك المكان على سفح جبل الزيتون للانفراد عن الجموع للصلاة، ولتعليم تلاميذه. واعتاد يهوذا أن يسمع هناك الصلاة والتعليم، ولكن ذلك لم يمنعه عن تسليم معلمه هناك.
٣ «فَأَخَذَ يَهُوذَا الجُنْدَ وَخُدَّاماً مِنْ عِنْدِ رُؤَسَاءِ الكَهَنَةِ وَالفَرِّيسِيِّينَ، وَجَاءَ إِلَى هُنَاكَ بِمَشَاعِلَ وَمَصَابِيحَ وَسِلاحٍ».
أعمال ٤: ١ متّى ٢٦: ٤٧ ومرقس ١٤: ٤٣ ولوقا ٢٢: ٤٧ وأعمال ١: ١٦
انظر شرح متّى ٢٦: ٤٧ ومرقس ١٤: ٤٣. لم يذكر يوحنا اتفاق يهوذا مع اليهود على أن يسلم يسوع إليهم بثلاثين قطعة فضة، لأن الذين جاءوا مع يهوذا كان بعضهم من جند الرومان والبعض من اللاويين حراس الهيكل وخدام الرؤساء، وكان منهم بعض رؤساء الكهنة للمراقبة. وكان الجمع كثيراً خوفاً من أن يقاومهم تلاميذ المسيح وأصحابه الجليليين. وأتوا بمشاعل ومصابيح والقمر بدر (لأنه كان الفصح) إما لأن السماء غامت، أو لظنهم أن المسيح يختبئ بين أشجار البستان أو في مكان مظلم.
٤ «فَخَرَجَ يَسُوعُ وَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُمْ: مَنْ تَطْلُبُونَ؟».
فَخَرَجَ يَسُوعُ كان أولاً داخل البستان يصلي مع ثلاثة من تلاميذه. ولما جاء الجنود لم يصبر إلى أن يطلبوه بل ذهب لملاقاتهم إما إلى مدخل البستان أو إلى خارجه.
وَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ عرف يسوع بسابق علمه كل ما سيحدث، فزادته معرفته بذلك ألماً. وكان يمكنه لو أراد بتلك المعرفة أن ينجو منهم بأن يترك البستان قبل وصولهم.
وَقَالَ لَهُمْ: مَنْ تَطْلُبُونَ؟ أظهر يسوع بذلك كل الهدوء والاطمئنان. وعرّض نفسه باختياره للقبض والتقييد والموت على خلاف ما فعل يوم أراد الناس أن يخطفوه ويقيموه ملكاً (يوحنا ٦: ١٥). وقصده بسؤاله إيّاهم ظاهر في ع ٦، ٧ وهو أن يجعل جوابه على سؤاله سبباً ليتركوا تلاميذه.
٥ «أَجَابُوهُ: يَسُوعَ النَّاصِرِيَّ. قَالَ لَهُمْ: أَنَا هُوَ. وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ أَيْضاً وَاقِفاً مَعَهُمْ».
أَجَابُوهُ: يَسُوعَ النَّاصِرِيَّ أن الذين أجابوه هم رؤساء العسكر الرومان، ولم يعرفوا أن الذي يكلمهم هو الذي يطلبونه. والظاهر أن يهوذا لم يكن قد أظهر لهم العلامة المتفق عليها، وهي القُبلة لأن المسيح تقدم إليهم بغتة. وتبيّن مما في متّى ٢٦: ٥٥ أن بعض القوم قد عرفه.
قَالَ لَهُمْ: أَنَا هُوَ لا بدّ من أنهم تعجبوا بهذا الإقرار لوضوحه وشجاعة قائله.
وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ أَيْضاً وَاقِفاً مَعَهُمْ لم تتضح غاية البشير من ذكره هذا، ولعلها بيان شر يهوذا وقساوة قلبه ووقاحته، فإن الذي وقف أكثر من ثلاث سنين مع تلاميذ المسيح لم يستحِ أن يقف حينئذ مع أعدائه. أو لعلها تبيّن أنه كان ليهوذا برهان آخر على عظمة المعلم الذي جاء ليسلمه، وهو ما ذكره في الآية الآتية.
٦ «فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ: إِنِّي أَنَا هُوَ رَجَعُوا إِلَى الوَرَاءِ وَسَقَطُوا عَلَى الأَرْضِ».
هذا نتيجة تأثير منظر المسيح وكلامه فيهم. وهذا مثل التأثير الذي منع باعة الهيكل من مقاومته لما طردهم منه (يوحنا ٢: ١٣ - ١٦) ومثل ما حدث مع جند الهيكل يوم أرسلهم الرؤساء ليقبضوا عليه (يوحنا ٧: ٤٥، ٤٦). ولو انتبه العسكر لذلك الأمر لاستنتجوا أنه لا قوة لهم على القبض عليه لو أراد هو أن يستعمل قوته لمنعهم.
٧ «فَسَأَلَهُمْ أَيْضاً: مَنْ تَطْلُبُونَ؟ فَقَالُوا: يَسُوعَ النَّاصِرِيَّ».
كرر يسوع السؤال وهم كرروا الجواب، والأرجح أن سقوط الناس حينئذ كان وقتياً، وأنهم قاموا خجلين من ارتعابهم بغتة، ولم يزالوا عازمين على تنفيذ قصدهم.
٨ «أَجَابَ: قَدْ قُلتُ لَكُمْ إِنِّي أَنَا هُوَ. فَإِنْ كُنْتُمْ تَطْلُبُونَنِي فَدَعُوْا هَؤُلاءِ يَذْهَبُونَ».
أظهر يسوع في ساعة الخطر الشديد حبه لتلاميذه وعنايته بهم. والأرجح أن العسكر كان وقتئذٍ محيطاً بتلاميذه ليمسكهم، ولم يُبقِ لهم يسوع حجة للقبض على تلاميذه، فقد سلم نفسه اختياراً، وسألهم: من تطلبون؟ فأجابوا أنهم لا يطلبون سواه، وطلب منهم أن يتركوا التلاميذ. وفي ذلك سمح المسيح للتلاميذ أن يمضوا إذا شاءوا.
٩ «لِيَتِمَّ القَوْلُ الَّذِي قَالَهُ: إِنَّ الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي لَمْ أُهْلِكْ مِنْهُمْ أَحَداً».
يوحنا ١٧: ١٢
رأى البشير في عمل المسيح المذكور مثالاً لما قاله في يوحنا ١٧: ١٢، على أن المسيح لم يقصد مجرد الحفظ الجسدي بل أراد الحفظ الروحي أيضاً. فلو سمح أن يمسكهم العسكر ويأتي بهم إلى حضرة قيافا وبيلاطس لكان ذلك علة لملاشاة إيمانهم، فمنع عنهم بذلك تجربة لا يستطيعون حملها لكي لا تهلك نفوسهم. والأرجح أنه في هذا الوقت أظهر لهم يهوذا العلامة المتفق عليها فقبّله بياناً أن الذي سلم نفسه هو الذي أتوا ليقبضوا عليه (متّى ٢٦: ٤٩).
١٠ «ثُمَّ إِنَّ سِمْعَانَ بُطْرُسَ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ، فَاسْتَلَّهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ الكَهَنَةِ، فَقَطَعَ أُذُنَهُ اليُمْنَى. وَكَانَ اسْمُ العَبْدِ مَلخُسَ».
متّى ٢٦: ٥١ ومرقس ١٤: ٤٧ ولوقا ٢٢: ٤٩، ٥٠
راجع تفسير متّى ٢٦: ٥١. وذكر يوحنا وحده اسم الضارب والمضروب. ولا شك أن كليهما كان قد مات قبل أن يكتب يوحنا بشارته بزمن طويل. وما فعله بطرس هنا وفق ما عُهد من أخلاقه وأعماله، لأنه كان سريعاً في الكلام والعمل بدون التأمل في العواقب، وسريع الانتقال من الشجاعة إلى الجبن. ولم يذكر شفاء ملخس إلا لوقا (لوقا ٢٢: ٥١).
١١ «فَقَالَ يَسُوعُ لِبُطْرُسَ: اجْعَل سَيْفَكَ فِي الغِمْدِ. الكَأْسُ الَّتِي أَعْطَانِي الآبُ ألا أَشْرَبُهَا؟».
متّى ٢٠: ٢٢ و٢٦: ٣٩، ٤٢
انظر شرح متّى ٢٦: ٥٢.
الكَأْسُ انظر شرح متّى ٢٠: ٢٢. أظهر المسيح بذلك استعداده لحمل الألم الذي يقتضيه خلاص البشر، واستعار له كأساً مرة، وكان قد صلى قائلاً «يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس». ثم قال مسلماً بقضائه «يَا أَبَتَاهُ، إِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ تَعْبُرَ عَنِّي هَذِهِ الكَأْسُ إلا أَنْ أَشْرَبَهَا فَلتَكُنْ مَشِيئَتُكَ» (متّى ٢٦: ٤٢). وأظهر هنا تمام رضاه أن يشربها. والكلام هنا متعلق بما سبق من صلاته في البستان، ولم يذكره يوحنا بناءً على أنه كان معلوماً عند قرّاء بشارته. وما في هذه الآية توبيخ لبطرس على مقاومته للعسكر، ومنع له عن الاستمرار في المقاومة.
١٢ «ثُمَّ إِنَّ الجُنْدَ وَالقَائِدَ وَخُدَّامَ اليَهُودِ قَبَضُوا عَلَى يَسُوعَ وَأَوْثَقُوهُ».
ع ٣ أعمال ٤: ١
انظر شرح متّى ٢٦: ٥٠. يظهر من هذا أن كل فرقة من فرق ذلك اللفيف اشتركت في تقييد يسوع، كأنهما حسبا إفلاته خطراً عظيماً يجب كل الحذر منه. ولم يظهر أدنى تأثير من معجزة شفاء ملخس فيهم.
محاكمة المسيح أمام حنان وإنكار بطرس (ع ١٣ - ٢٧)
١٣ «وَمَضَوْا بِهِ إِلَى حَنَّانَ أَوَّلا، لأنَّهُ كَانَ حَمَا قَيَافَا الَّذِي كَانَ رَئِيساً لِلكَهَنَةِ فِي تِلكَ السَّنَةِ».
متّى ٢٦: ٥٧ لوقا ٣: ٢ ع ٢٤
لم يذكر هذه المحاكمة أحد من كتبة البشائر سوى يوحنا.
حَنَّانَ انظر شرح يوحنا ١١: ٤٩ ومتّى ٢٦: ٣ ولوقا ٣: ٢.
أَوَّلاً قال ذلك تمييزاً لوقوفه ثانية أمام قيافا. وقد ذُكر في ع ٢٤ وفي سائر البشائر. قال يوسيفوس المؤرخ اليهودي إن سلطان رئيس الكهنة كان يبقى له بعد عزله. ولذلك كان يُسمى أحياناً برئيس الكهنة (أعمال ٤: ٦ ولوقا ٣: ٢). وكان حنّان شريكاً لصهره وسائر رؤساء الكهنة في مؤامراتهم على المسيح، وكان متقدماً في الشرف والسلطة حتى حق له أن يحاكم المسيح أولاً في الوقت الذي كان فيه قيافا يرسل رسله إلى سائر أعضاء المجلس يدعوهم للاجتماع إن لم يكونوا قد اجتمعوا. والأرجح أن حنّان كان ساكناً في جزء من قصر رئاسة الكهنة الذي كان يسكنه قيافا، وأن ساحة القصر كانت مشتركة.
١٤ «وَكَانَ قَيَافَا هُوَ الَّذِي أَشَارَ عَلَى اليَهُودِ أَنَّهُ خَيْرٌ أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ عَنِ الشَّعْبِ».
يوحنا ١١: ٥
انظر شرح يوحنا ١١: ٤٩، ٥٠. أشار يوحنا إلى ما قاله قيافا سابقاً بعد إقامة يسوع لعازر ليبيّن أن لا رجاء لحكم مثل ذلك القاضي بالعدل، إذ رأى قبلاً وجوب أن يموت المسيح لخدمة الأمة سواء كان بريئاً أو مذنباً.
١٥ - ١٨ «١٥ وَكَانَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَالتِّلمِيذُ الآخَرُ يَتْبَعَانِ يَسُوعَ، وَكَانَ ذَلِكَ التِّلمِيذُ مَعْرُوفاً عِنْدَ رَئِيسِ الكَهَنَةِ، فَدَخَلَ مَعَ يَسُوعَ إِلَى دَارِ رَئِيسِ الكَهَنَةِ. ١٦ وَأَمَّا بُطْرُسُ فَكَانَ وَاقِفاً عِنْدَ البَابِ خَارِجاً. فَخَرَجَ التِّلمِيذُ الآخَرُ الَّذِي كَانَ مَعْرُوفاً عِنْدَ رَئِيسِ الكَهَنَةِ، وَكَلَّمَ البَوَّابَةَ فَأَدْخَلَ بُطْرُسَ. ١٧ فَقَالَتِ الجَارِيَةُ البَوَّابَةُ لِبُطْرُسَ: أَلَسْتَ أَنْتَ أَيْضاً مِنْ تلامِيذِ هَذَا الإِنْسَانِ؟ قَالَ ذَاكَ: لَسْتُ أَنَا. ١٨ وَكَانَ العَبِيدُ وَالخُدَّامُ وَاقِفِينَ، وَهُمْ قَدْ أَضْرَمُوا جَمْراً لأنَّهُ كَانَ بَرْدٌ، وَكَانُوا يَصْطَلُونَ، وَكَانَ بُطْرُسُ وَاقِفاً مَعَهُمْ يَصْطَلِي».
متّى ٢٦: ٥٨، ٦٩ ومرقس ١٤: ٥٤، ٦٦ ولوقا ٢٢: ٥٤، ٥٥ ويوحنا ٢١: ٧ و٢٤
انظر شرح متّى ٢٦: ٥٧، ٥٨. ولم يذكر يوحنا أن الرسل هربوا جميعاً بعد القبض على يسوع، واقتصر على ذكر أنه هو وبطرس تبعاه ليعرفا ما سيجري له.
وَالتِّلمِيذُ الآخَرُ (ع ١٥) هذا التلميذ كان يوحنا وأشار إلى نفسه بمثل ذلك (يوحنا ٢٠: ٢، ٣، ٤، ٨).
مَعْرُوفاً عِنْدَ رَئِيسِ الكَهَنَةِ لا نعرف سبب تلك المعرفة. وذكر يوحنا ذلك ليبين سبب الإذن له في الدخول، وأن بطرس سُئل عن علاقته بيسوع، ولم يُسأل يوحنا عن ذلك.
عُرف يوحنا أنه تلميذ المسيح ولم يضره الخدام بشيء، فلو اعترف بطرس أنه من تلاميذه ربما ما كان يصيبه أدنى أذىً، لأن من سألوه ليسوا من أرباب السلطان.
أَلَسْتَ أَنْتَ أَيْضاً؟ أشارت بقولها أيضاً إلى أن يوحنا كان هناك، وأنها عرفت أنه من تلاميذ المسيح.
١٩ «فَسَأَلَ رَئِيسُ الكَهَنَةِ يَسُوعَ عَنْ تلامِيذِهِ وَعَنْ تَعْلِيمِهِ».
فَسَأَلَ رَئِيسُ الكَهَنَةِ هو حنان (انظر شرح ع ١٣). وكان هذا الفحص مقدمة للفحص أمام قيافا وأعضاء المجلس الذي ذكره متّى ومرقس. وكان القصد منه الوقوف على ما يشتكون به يسوع. ولعل حنان كان يأمل أن يستجوب يسوع قبل التئام المجلس بمحاورة بسيطة يحمله أثناءها على الإقرار بما يكون سبباً للشكوى عليه.
عَنْ تلامِيذِهِ أي عن عددهم ومقامهم وأسمائهم. ولعل بطرس سمع هذا السؤال فحمله على إنكار أنه من تلاميذ يسوع. وغاية حنان من هذا السؤال شكوى يسوع لبيلاطس، إذا أقر بكثرة تلاميذه بأنه يسعى للثورة على القيصر.
وَعَنْ تَعْلِيمِهِ ليعرف هل له تعاليم سرية تنافي شريعة موسى أو قوانين الدولة الرومانية، ليشكوه بالتجديف أو بالخيانة.
٢٠ «أَجَابَهُ يَسُوعُ: أَنَا كَلَّمْتُ العَالَمَ علانِيَةً. أَنَا عَلَّمْتُ كُلَّ حِينٍ فِي المَجْمَعِ وَفِي الهَيْكَلِ حَيْثُ يَجْتَمِعُ اليَهُودُ دَائِماً. وَفِي الخَفَاءِ لَمْ أَتَكَلَّمْ بِشَيْءٍ».
متّى ٢٦: ٥٥ ولوقا ٤: ١٥ ويوحنا ٧: ١٤، ٢٦، ٢٧، ٢٨ و٨: ٢ إشعياء ٤٥: ١٩ و٤٨: ١٦
خلاصة جواب المسيح أنه كان يعلّم دائماً جهاراً لا خفية، فلو كان في تعليمه منافاة للدين أو السياسة لعلّمه سراً. ولكن كل تعليمه وغاياته كانت معلنة للجميع.
٢١ «لِمَاذَا تَسْأَلُنِي أَنَا؟ اِسْأَلِ الَّذِينَ قَدْ سَمِعُوا مَاذَا كَلَّمْتُهُمْ. هُوَذَا هَؤُلاءِ يَعْرِفُونَ مَاذَا قُلتُ أَنَا».
أشار بذلك إلى أنه ليس من العدل أن يسأل القاضي المتهم عما يحمله به على الشكوى على نفسه، وأبان له أن لا حاجة له إلى أن يسأله عن تعليمه، لأن الذين سمعوه كثيرون ويشهدون عليه إن كان قد تكلم بما لا يليق.
٢٢ «وَلَمَّا قَالَ هَذَا لَطَمَ يَسُوعَ وَاحِدٌ مِنَ الخُدَّامِ كَانَ وَاقِفاً، قَائِلاً: أَهَكَذَا تُجَاوِبُ رَئِيسَ الكَهَنَةِ؟».
إرميا ٢٠: ٢ وأعمال ٢٣: ٢
وَاحِدٌ مِنَ الخُدَّامِ أي من خدام حنّان أو خدام الهيكل الذين أتوا لمراقبة يسوع. وكانت هذه الضربة أول لطمة لوجه ذلك البار من أيدي الأثمة.
أَهَكَذَا تُجَاوِبُ رَئِيسَ الكَهَنَةِ؟ اتهمه بالوقاحة لأنه بريء طلب حقه بجسارة.
٢٣ «أَجَابَهُ يَسُوعُ: إِنْ كُنْتُ قَدْ تَكَلَّمْتُ رَدِيّاً فَاشْهَدْ عَلَى الرَّدِيِّ، وَإِنْ حَسَناً فَلِمَاذَا تَضْرِبُنِي؟».
متّى ٥: ٣٩
إِنْ كُنْتُ قَدْ تَكَلَّمْتُ رَدِيّاً أي بغير الاحترام الواجب لرئيس الكهنة أو لمنزلته.
فَاشْهَدْ عَلَى الرَّدِيِّ لأعاقَب بمقتضى شريعة موسى (خروج ٢٢: ٢٨).
وَإِنْ حَسَناً فَلِمَاذَا تَضْرِبُنِي؟ وبَّخ المسيح ضاربه بهذا لأنه ضرب إنساناً لم يثبت عليه ذنب. وفي هذا بيان أن أمر المسيح في متّى ٥: ٣٩ لا يمنع من اعتراض المظلوم بلطف وحلم على الظالم.
٢٤ «وَكَانَ حَنَّانُ قَدْ أَرْسَلَهُ مُوثَقاً إِلَى قَيَافَا رَئِيسِ الكَهَنَةِ».
متّى ٢٦: ٥٧ وع ١٣
قارن هذه الآية بالآية الثالثة وبما في متّى ٢٦: ٥٧. علة ذكر يوحنا هذه الآية دفع توهّم القارئ أن يسوع لم يُحاكم عند اليهود إلا أمام حنّان. وأشار إلى المحاكمة الثانية بلا تفصيل، وقد فُصلت في متّى ٢٦: ٥٩ - ٦٦ ومرقس ١٤: ٥٥ - ٦٤.
مُوثَقاً أوثقه الذين قبضوا عليه (ع ١٢) فأرسله حنّان في وثاقه، أو أنه أوثقه بعد أن فكه. ولما بلغ حيث قيافا وسائر أعضاء المجلس فكوه، ثم أوثقوه حين أرسلوه إلى بيلاطس (متّى ٢٧: ٢ ومرقس ١٥: ١).
٢٥ - ٢٧ «٢٥ وَسِمْعَانُ بُطْرُسُ كَانَ وَاقِفاً يَصْطَلِي. فَقَالُوا لَهُ: أَلَسْتَ أَنْتَ أَيْضاً مِنْ تلامِيذِهِ؟ فَأَنْكَرَ ذَاكَ وَقَالَ: لَسْتُ أَنَا. ٢٦ قَالَ وَاحِدٌ مِنْ عَبِيدِ رَئِيسِ الكَهَنَةِ، وَهُوَ نَسِيبُ الَّذِي قَطَعَ بُطْرُسُ أُذُنَهُ: أَمَا رَأَيْتُكَ أَنَا مَعَهُ فِي البُسْتَانِ؟ ٢٧ فَأَنْكَرَ بُطْرُسُ أَيْضاً. وَلِلوَقْتِ صَاحَ الدِّيكُ».
متّى ٢٦: ٦٩، ٧١ ومرقس ١٤: ٦٩ ولوقا ٢٢: ٥٨ متّى ٢٦: ٧٤ ومرقس ١٤: ٧٢ ولوقا ٢٢: ٦٠ ويوحنا ١٣: ٣٨
انظر شرح متّى ٢٦: ٧٢ - ٧٤. الظاهر من أنباء البشائر أن إنكار بطرس ليسوع ثلاثاً كان في أثناء محاكمة يسوع أمام حنّان وأمام قيافا كما فصّل يوحنا. وأما متّى ومرقس فذكراه بعد نهاية المحاكمتين ليظل الكلام في المحاكمة متصلاً.
فَقَالُوا (ع ٢٥) لنا من خبر مرقس أن البوّابة أخبرت إحدى رفيقاتها بأمر بطرس. ولنا من خبر متّى أن تلك أخبرت سائر الخدام المجتمعين، فعيروا بطرس أنه من تلاميذ يسوع.
نَسِيبُ الَّذِي قَطَعَ بُطْرُسُ أُذُنَهُ (ع ٢٦) كلام هذا الإنسان علة إنكار بطرس لثالث مرة. ولنا من خبر متّى أن كلامه حمل غيره من القيام هناك على تعيير بطرس قائلاً «إن لغته تشهد عليه أنه جليلي» (متّى ٢٦: ٧٣). ولم يذكر يوحنا أقسام بطرس لينفي أنه تلميذ ليسوع، ولا نظر يسوع إليه، ولا خروجه من الدار وتوبته.
وقوف المسيح أمام بيلاطس (ع ٣٨ –٤٠)
٢٨ «ثُمَّ جَاءُوا بِيَسُوعَ مِنْ عِنْدِ قَيَافَا إِلَى دَارِ الوِلايَةِ، وَكَانَ صُبْحٌ. وَلَمْ يَدْخُلُوا هُمْ إِلَى دَارِ الوِلايَةِ لِكَيْ لا يَتَنَجَّسُوا، فَيَأْكُلُونَ الفِصْحَ».
متّى ٢٧: ٢ ومرقس ١٥: ١ ولوقا ٢٣: ١ أعمال ١٠: ٢٨ و١١: ٣
انظر شرح متّى ٢٧: ١، ٢، ١١ - ٢٦ ومرقس ١٥: ٢ - ١٥ ولوقا ٢٣: ٢ - ٢٥. ترك يوحنا تفاصيل محاكمة يسوع ليلاً أمام قيافا ومجلس السبعين، ونبأ محاكمته صباحاً أمام مجلس اليهود، وقد ذُكر في متّى ٢٨: ١ ومرقس ٥: ١ ولوقا ٢٢: ٦٦ - ٧١. وترك تصريح يسوع مرتين أمام ذلك المجلس بأنه المسيح ابن الله الذي به حكموا عليه بالتجديف واستحقاقه الموت، لأنها كانت حينئذ من الأمور المشهورة، ولكنه أطال الكلام على ما جرى أمام بيلاطس.
دَارِ الوِلايَةِ بنى هذه الدار هيرودس الكبير، وكانت منزلاً لولاة الرومان في أيام الأعياد، إذ كانوا يأتون إلى أورشليم من قيصرية مركز الولاية. وكانت تلك الدار مجاورة للهيكل.
حكم مجلس اليهود على يسوع بالموت (متّى ٢٦: ٦٦) ولكنهم أتوا به إلى بيلاطس لينفذ حكمهم، إذ لم يكن لهم سلطان أن ينفذوا الحكم.
وَكَانَ صُبْحٌ الأرجح أنه لم يكن قد مرّ أكثر من ساعة من شروق الشمس.
وَلَمْ يَدْخُلُوا.. لِكَيْ لا يَتَنَجَّسُوا حسب اليهود دخولهم بيوت الأمم تنجيساً لهم (أعمال ٩: ٢٨) واعتبروه كلمس جثة الميت (لاويين ٢٢: ٤ - ٦ وعدد ٥: ٢) وكانت دار الولاية من بيوت الأمم.
فَيَأْكُلُونَ الفِصْحَ ليس خروف الفصح المخصوص، لأن المسيح أكله مع تلاميذه في الليلة السابقة، وهي مساء ١٤ من نيسان، وهي الوقت المعيّن في شريعة موسى (خروج ١٢: ٦ ولاويين ٢٣: ٥). ولكن المقصود «بالفصح» في هذه الآية ما يأكله اليهود من الفطير وذبائح السلامة المفروضة في سبعة أيام العيد. كما أن «الفصح» يُطلق على مجموع تلك الأيام السبعة (عدد ٢٨: ١٦ - ٢٤ وتثنية ١٦: ٢، ٣ و٢أيام ٣٠: ٢٢ و٣٥: ٧ - ٩).
ومما ذُكر هنا يتبيّن أن رؤساء اليهود كانوا يفضلون الطهارة الجسدية على الطهارة الروحية، فلم يخافوا من تدنيس نفوسهم بقتل يسوع البار، وخافوا من تنجيس أجسادهم! احترسوا من أن يتدنسوا بدخولهم بيت غريب، ولم يلتفتوا إلى نجاسة قلوبهم بما فيها من إثم!
٢٩ «فَخَرَجَ بِيلاطُسُ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: أَيَّةَ شِكَايَةٍ تُقَدِّمُونَ عَلَى هَذَا الإِنْسَانِ؟».
فَخَرَجَ بِيلاطُسُ سبق الكلام على هذا الوالي الروماني في شرح متّى ٢٧: ٢. ذهب من الدار إلى ساحة أمامه حيث وقف اليهود احتراماً لعقائدهم، وتسليماً لإرادتهم.
أَيَّةَ شِكَايَةٍ؟ سألهم ذلك لعلمه أمورهم، أو لمشاهدته يسوع موثقاً بين يديه. وهذا السؤال مما اعتاد الحكام أن يسألوه لمن يأتون بمشكوٍّ عليه.
٣٠ «أَجَابُوا: لَوْ لَمْ يَكُنْ فَاعِلَ شَرٍّ لَمَا كُنَّا قَدْ سَلَّمْنَاهُ إِلَيْكَ!».
رفض رؤساء الكهنة أن يرفعوا الدعوى عليه، آملين أن بيلاطس يحكم عليه بالقتل لمجرد طلبة الرؤساء، فكأنهم قالوا: فحصناه فوجدناه مذنباً فحكمنا عليه بأنه مستوجب الموت، وأتينا به إليك لتجري حكمنا لا لتحاكمه. ولم يجيبوا بيلاطس بقولهم إن يسوع «مجدّف» خوفاً من أن يرفض كل دعاويهم كما فعل غاليون الوالي الروماني في كورنثوس (أعمال ١٨: ١٥، ١٦) لأن التجديف عند الرومان ليس جناية.
٣١ «فَقَالَ لَهُمْ بِيلاطُسُ: خُذُوهُ أَنْتُمْ وَاحْكُمُوا عَلَيْهِ حَسَبَ نَامُوسِكُمْ. فَقَالَ لَهُ اليَهُودُ: لا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَقْتُلَ أَحَدا».
رفض بيلاطس طلبهم أن يحكم على يسوع بدون فحص، لأن ذلك ينافي الشريعة الرومانية، فإنه إن كان قد ارتكب ذلك أكثر من مرة إرضاءً لليهود، لم يرد أن يفعل ذلك في هذه الدعوى. ويبين جوابه أنه لم يرد أن يدخل فيها، إذ علم أنها اضطهاد ديني، وأن شكواهم زور، إذ لم يتوقع من مجلس اليهود أن يسلموا إنساناً للموت لمجرد طلبه تحرير أمة اليهود من نير الرومان.
خُذُوهُ أَنْتُمْ وَاحْكُمُوا عَلَيْهِ أي بما أنكم حكمتم حسب شريعتكم. فكان لليهود سلطان أن يُخرجوا البعض من المجمع وإجراء بعض القصاص، دون الموت.
لا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَقْتُلَ أَحَداً انظر شرح متّى ٢٧: ٢. قتل اليهود بعض الناس في ثورة عامة على خلاف الشريعة كما فعلوا باستفانوس (أعمال ٧: ٥٩، ٦٠). والأرجح أن الذي منعهم من قتل يسوع الخوف من أن يحدث شغب في الشعب (متّى ٢٦: ٥). ومعنى قولهم «لا يجوز لنا»: لا نرضى عقاباً له سوى الموت، وهذا في سلطانك لا في سلطاننا، فلا نستطيع أن نفعل كما قلت. فاعترفوا بذلك أنهم تحت عبودية الرومان خلافاً لقولهم في يوحنا ٨: ٣٣، وشهدوا أنه أتى الوقت المعيّن في النبوات لمجيء المسيح، فقد قيل «لا يَزُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُوذَا وَمُشْتَرِعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ شِيلُونُ وَلَهُ يَكُونُ خُضُوعُ شُعُوبٍ» (تكوين ٤٩: ١٠).
٣٢ «لِيَتِمَّ قَوْلُ يَسُوعَ الَّذِي قَالَهُ مُشِيراً إِلَى أَيَّةِ مِيتَةٍ كَانَ مُزْمِعاً أَنْ يَمُوتَ».
متّى ٢٠: ١٩ ويوحنا ١٢: ٣٢، ٣٣
انظر متّى ٢٠: ١٩ ويوحنا ٣: ١٤ و١٢: ٣٢، ٣٣. لو قتل اليهود المسيح بغير واسطة الرومان لقتلوه رجماً (تثنية ١٣: ٩، ١٠ و١٧: ٥ - ٧). وأما الصلب فهو عقاب روماني، فنفَّذ اليهود مقاصد الله وما تكلم به يسوع في أمر موته، بإتيانهم بالمسيح إلى بيلاطس.
٣٣ «ثُمَّ دَخَلَ بِيلاطُسُ أَيْضاً إِلَى دَارِ الوِلايَةِ وَدَعَا يَسُوعَ، وَقَالَ لَهُ: أَأَنْتَ مَلِكُ اليَهُودِ؟».
متّى ٢٧: ١١
وَدَعَا يَسُوعَ، وَقَالَ لَهُ على انفراد.
ثُمَّ دَخَلَ بِيلاطُسُ أَيْضاً إِلَى دَارِ الوِلايَةِ كان قد خرج منها لاستقبال اليهود (ع ٢٨).
أَأَنْتَ مَلِكُ اليَهُودِ؟ هذا السؤال ناتج عن تهمة اليهود المذكورة في (لوقا ٢٣: ٢) وهي قولهم «وَجَدْنَا هَذَا يُفْسِدُ الأُمَّةَ، وَيَمْنَعُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ، قَائِلاً: إِنَّهُ هُوَ مَسِيحٌ مَلِكٌ» وجاءوا بهذه التهمة حين رفض بيلاطس طلبتهم الأولى أن يحكم عليه بدون فحص. والكلمة الهامة في هذه الجملة هي «أنت» ومعنى قوله «أنت»: هل يمكن أن تكون ملكاً وأنت ضعيف وديع مهان مشكو عليك؟
٣٤ «أَجَابَهُ يَسُوعُ: أَمِنْ ذَاتِكَ تَقُولُ هَذَا، أَمْ آخَرُونَ قَالُوا لَكَ عَنِّي؟».
لم يسأله يسوع عن ذلك لجهله إيّاه بل لينبّه ضميره، ويثبت بجواب بيلاطس نفسه براءته. ومعنى سؤاله: هل رأيت منّي في كل مدة حكمك شيئاً يحملك على أن تظنني أريد خيانة الدولة الرومانية أو عصيان قيصر؟ أو هل أخبرك بذلك آخرون؟ وحذره بهذا من أن يُخدَع ويصدّق دعوى الأعداء الكاذبة. وذكَّره به أنه لو كانت دعواهم صحيحة لعرف بها قبل ذلك.
أو لعل المسيح قصد بذلك السؤال أن يبيّن لبيلاطس مراده بلفظة «ملك» قبل أن يجاوبه على سؤاله، فكأن المسيح قال له «إن أردت بالمُلك ما يعنيه الرومان به، أي هل أنا ملك أرضي كقيصر؟ قلتُ لا! ولكن إن أردت به ما يقصده اليهود على ما في نبواتهم، فالجواب: نعم. واليهود عرفوا أن المسيح ادَّعى أنه ملك روحي، وأرادوا أن يفهم بيلاطس أنه ادّعى أنه ملك أرضي. ولم يكن بيلاطس محتاجاً لإبطال هذه الدعوى لأنه أرد معرفة مصدر الشكوى. فلو كان مصدرها قائداً رومانياً أو أحد جواسيسه لاستحقَّت أن ينظر فيها. لكنه كان يعلم أنه يستحيل أن يرفعها إليه اليهود بإخلاص لأن أعظم ما يرضيهم أن يقوم بينهم رجل يرفع عنهم نير الرومان!
٣٥ «أَجَابَهُ بِيلاطُسُ: أَلَعَلِّي أَنَا يَهُودِيٌّ؟ أُمَّتُكَ وَرُؤَسَاءُ الكَهَنَةِ أَسْلَمُوكَ إِلَيَّ. مَاذَا فَعَلتَ؟».
أَلَعَلِّي أَنَا يَهُودِيٌّ؟ أظهر بيلاطس شيئاً من الحدة والكبرياء في هذا الجواب، وأنكر أنه استعمل لفظة «ملك» بمعنى يهودي، وموضحاً أنه استعملها بمعنى روماني، أي أراد بها ملكاً أرضياً.
أُمَّتُكَ وَرُؤَسَاءُ الكَهَنَةِ أَسْلَمُوكَ إِلَيَّ هذا جواب بيلاطس للمسيح على قوله ما معناه: أنت المشتكي أم غيرك؟ فمعنى جواب بيلاطس أنه ليس المشتكي، وأنه لم يرَ شيئاً من علامات العصيان في ما فعله، وأن مصدر الدعوى يهودي.
مَاذَا فَعَلتَ؟ أي لماذا يتهمك شعبك بادعائك أنك ملك بلا سبب؟ دافع عن نفسك.
٣٦ «أَجَابَ يَسُوعُ: مَمْلَكَتِي لَيْسَتْ مِنْ هَذَا العَالَمِ. لَوْ كَانَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هَذَا العَالَمِ لَكَانَ خُدَّامِي يُجَاهِدُونَ لِكَيْ لا أُسَلَّمَ إِلَى اليَهُودِ. وَلَكِنِ الآنَ لَيْسَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هُنَا».
١تيموثاوس ٦: ١٣ دانيال ٢: ٤٤ و٧: ١٤ ولوقا ١٢: ١٤ ويوحنا ٦: ١٤ و٨: ١٥
مَمْلَكَتِي هذه الكلمة جواب لقول بيلاطس «أنت ملك اليهود» ومعناها: نعم، إني رئيس مملكة.
لَيْسَتْ مِنْ هَذَا العَالَمِ أي ليست كما ادعى اليهود، وليست أرضية مستندة على جيوش وأسلحة ماديّة، وليست لغاية دنيوية، ولا مستندة على وسائط عالمية، ولا قائمة بقوة إجبارية، ولا مقاومة فيها لمملكة قيصر ولا غيرها من ممالك الأرض. هذا مراده سلباً. أما مراده إيجاباً فهو أن أصل مملكتي روحي من السماء، وهي تسود على ضمائر الناس وقلوبهم طوعاً واختياراً، وسلطته روحية، ويقوم انتصارها بانتشار الحق. ويظهر أعظم مجدها في السماء.
هذه المملكة أُسست على موت المسيح، ويسوسها روح المسيح، وشريعتها إرادة الله، وغايتها مجد الله وخلاص الناس وسعادتهم الأبدية.
لَوْ كَانَتْ.. لَكَانَ خُدَّامِي يُجَاهِدُونَ ذكر المسيح أمراً واحداً إثباتاً لأن مملكته ليست من هذا العالم. ومن المعلوم أن أتباع المملكة الأرضية يحاربون عنها. أما المسيح فلم يأذن لأحد من الكثيرين الذين تبعوه أن يحامي عنه، وسلم نفسه بلا معارضة إلى من قبضوا عليه، كما أمكن بيلاطس أن يستعلم من جنود الرومان التي جاءت به.
الآنَ لَيْسَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هُنَا أي قد وضح الأمر أن مملكتي لا تختص بهذا العالم، فلذلك يجب أن لا تخاف منها. والبرهان على ذلك أني واقف أمامك موثقاً، فإنما سلّمت نفسي ومنعت خدامي عن المحاربة.
٣٧ «فَقَالَ لَهُ بِيلاطُسُ: أَفَأَنْتَ إِذاً مَلِكٌ؟ أَجَابَ يَسُوعُ: أَنْتَ تَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ. لِهَذَا قَدْ وُلِدْتُ أَنَا، وَلِهَذَا قَدْ أَتَيْتُ إِلَى العَالَمِ لأشْهَدَ لِلحَقِّ. كُلُّ مَنْ هُوَ مِنَ الحَقِّ يَسْمَعُ صَوْتِي».
يوحنا ١٧: ١٧، ١٩ ويوحنا ٨: ٤٧ و١يوحنا ٣: ١٩ و٤: ٦
أَفَأَنْتَ إِذاً مَلِكٌ؟ هذا هو سؤاله في ع ٣٣ بترك لفظة اليهود. لا يخلو سؤاله من شيء من التعجب، كأنه كان يتوقع أن يسوع ينكر أنه ملك. فكأن بيلاطس قال ليسوع: لقد اعترفت أنك ملك، وقلت إن مملكتك ليست من هذا العالم، فكيف يمكن ذلك؟
أَنْتَ تَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ أي نعم كما قلت. انظر شرح متّى ٢٧: ١١ و لوقا ٢٣: ٣.
لِهَذَا قَدْ وُلِدْتُ أَنَا، وَلِهَذَا قَدْ أَتَيْتُ إِلَى العَالَمِ لأشْهَدَ لِلحَقِّ هذا شرح لقوله إنه ملك وبيان الهدف من تجسده ومجيئه من السماء إلى الأرض، وهي إقامة مملكة الحق، وإعلان حق الله الأزلي للناس (يوحنا ١: ١٨). وكان شاهداً للحق بكلامه وعمله ولا سيما موته. وكانت شهادة المسيح للحق سلاحه الوحيد لتشييد مملكته. إذاً ليس هو مقاوماً لأحد من ملوك الأرض. وهو جواب مناسب يُجاوب به روماني، لأن فلاسفة الرومان ادّعوا أنهم أهل الحق الخالص العاري عن أوهام الناس وضلالاتهم. ولأن المسيح أتى إلى هذا العالم ليشهد للحق، وجب أن يكون الحق من أثمن الكنوز، وأن يجتهد في اقتنائه. والحق الخاص الذي أتى المسيح ليعلنه هو أن الإنسان خاطئ هالك، وأن الله رحيم أعدّ الخلاص مجاناً بواسطة ابنه لكل الذين يتوبون ويؤمنون.
كُلُّ مَنْ هُوَ مِنَ الحَقِّ يَسْمَعُ صَوْتِي أي الذي يحب الحق ويقبله ويطيعه هو من رعيتي أهل مملكتي. فإذاً عرشي الملكي في قلوب الناس (يوحنا ٣: ٢١ و٦: ٤٥ و٧: ١٧ و٨: ٤٧ و١٠: ١٦).. فيجب أن نتخذ المسيح معلماً وملكاً، ونطيع أوامره طاعة كاملة.
٣٨ «قَالَ لَهُ بِيلاطُسُ: مَا هُوَ الحَقُّ؟. وَلَمَّا قَالَ هَذَا خَرَجَ أَيْضاً إِلَى اليَهُودِ وَقَالَ لَهُمْ: أَنَا لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً وَاحِدَةً».
متّى ٢٧: ٢٤ ولوقا ٢٣: ٤ ويوحنا ١٩: ٤، ٦
مَا هُوَ الحَقُّ؟ هذا ليس سؤال محب للحق يطلب الإرشاد من رب الحق، بدليل أنه انصرف قبل أن يسمع الجواب، فكأنه قال: لا أحد يعرف حقيقة الحق أو يستطيع أن يوضحه، فكم بالحري أنت! ولا فائدة لك ولا لي من معرفة ذلك أو جهله. فإن أكثر علماء الرومان كانوا حينئذ قد فقدوا كل ثقة بديانتهم الوثنية، ولم يكونوا قد عرفوا الدين المسيحي، فتسلط عليهم الكفر بالدين.
خَرَجَ أَيْضاً إِلَى اليَهُودِ إلى الساحة حيث ترك رؤساء الكهنة وأخبرهم بنتيجة استجوابه ليسوع وهي أنه ملك مثل هذا ليس عدواً لقيصر، فهو بريءٌ.
أتى يسوع ليكون ذبيحة إثم، فاقتضى الأمر أن يكون «حملاً بلا عيب» وبرهان أنه كذلك شهادة بيلاطس الذي أسلمه إلى الموت، وهي قوله: «أنا لست أجد فيه علة واحدة». فكان يجب على بيلاطس أن يطلق يسوع في الحال، ولكنه لم يفعل ذلك خوفاً من اليهود لئلا يشتكوه لطيباريوس قيصر على ذنوب كثيرة كان قد ارتكبها في محاكمات سابقة. لكنه حاول أن يرفع عن نفسه مسؤولية الحكم على يسوع. واتخذ لذلك عدة وسائل: الأولى، ذكرها لوقا ولم يذكرها يوحنا، وهي أنه أرسله إلى هيرودس حاكم الجليل الذي كان قد أتى وقتئذ إلى أورشليم لأجل العيد، فلم يستفد من ذلك شيئاً، لأن هيرودس أبى أن يحمل المسؤولية، فردَّه بدون أن يحكم بأنه مذنب (لوقا ٢٣: ٦ - ١٢). والثانية ذكرها يوحنا بالاختصار في الآيتين الآتيتين.
٣٩، ٤٠ «٣٩ وَلَكُمْ عَادَةٌ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ وَاحِداً فِي الفِصْحِ. أَفَتُرِيدُونَ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ مَلِكَ اليَهُودِ؟. ٤٠ فَصَرَخُوا أَيْضاً جَمِيعُهُمْ: لَيْسَ هَذَا بَل بَارَابَاسَ. وَكَانَ بَارَابَاسُ لِصّاً».
متّى ٢٧: ١٥ ومرقس ١٥: ٦ ولوقا ٢٣: ١٧ أعمال ٣: ١٤ لوقا ٢٣: ١٩
انظر شرح مرقس ١٥: ٨ ولوقا ٢٣: ٦ - ١٢. أطال لوقا الكلام على ذلك أكثر من يوحنا. ونستنتج مما قيل في بشارة مرقس أن الشعب صرخ عندما خرج بيلاطس طالباً أن يُطلق لهم أسيراً كعادته في العيد. والظاهر أن بيلاطس ظن الشعب يطلبون إطلاق يسوع إذا خيّرهم بينه وبين باراباس، وترك لهم أن يحكموا بصلب أحدهما وإطلاق الآخر. وقصد بذلك أن ينجو من تلويم الرؤساء إذا أطلق يسوع بقوله إن الشعب أجبره على ذلك. ولعله سمع نبأ سرور الشعب بيسوع في أول ذلك الأسبوع يوم احتفلوا بدخوله إلى أورشليم، وكان قد عرف أن الرؤساء طلبوا قتل يسوع حسداً (متّى ٢٧: ١٨) وأن الشعب أحبه وأكرمه. ولعله رأى أن تنزيل يسوع منزلة المذنب كباراباس يشفي غليل رؤساء اليهود من جهته.
لَيْسَ هَذَا بَل بَارَابَاسَ مرّ الكلام على باراباس في شرح متّى ٢٦: ١٥ - ١٨. كان قاتلاً، فضلاً عن أنه لص (لوقا ٢٣: ١٩). ولا شك أن بيلاطس تعجب من هذا الصراخ والكلام، إذ كان يتوقع خلافه (راجع مرقس ١٥: ١١). والظاهر أن أصحاب المسيح كلهم سكتوا، وبذلك صدق على الشعب قول بطرس يوم الخمسين «يَسُوعَ، الَّذِي أَسْلَمْتُمُوهُ أَنْتُمْ وَأَنْكَرْتُمُوهُ أَمَامَ وَجْهِ بِيلاطُسَ، وَهُوَ حَاكِمٌ بِإِطْلاقِهِ. وَلَكِنْ أَنْتُمْ أَنْكَرْتُمُ القُدُّوسَ البَارَّ، وَطَلَبْتُمْ أَنْ يُوهَبَ لَكُمْ رَجُلٌ قَاتِلٌ» (أعمال ٣: ١٣، ١٤). فأظهروا أنهم أحبوا لصاً قاتلاً أكثر من يسوع المسيح البار. وفشلت هذه الوسيلة الثانية التي حاول بها بيلاطس أن يطلق يسوع. وزادت الأمر صعوبة، لأنه أظهر للرؤساء ضعفه، وأنه يخاف مقاومتهم لأنه لم يستطع أن يطلق يسوع باعتباره باراً، وسمح بأن يحسبه مذنباً، راجياً أن يطلب الشعب إطلاقه.
الأصحاح التاسع عشر
محاكمة يسوع أمام بيلاطس ع ١ - ١٦
١ - ٣ «١ فَحِينَئِذٍ أَخَذَ بِيلاطُسُ يَسُوعَ وَجَلَدَهُ. ٢ وَضَفَرَ العَسْكَرُ إِكْلِيلاً مِنْ شَوْكٍ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَأَلبَسُوهُ ثَوْبَ أُرْجُوانٍ، ٣ وَكَانُوا يَقُولُونَ: السّلامُ يَا مَلِكَ اليَهُود. وَكَانُوا يَلطِمُونَهُ».
متّى ٢٠: ١٩ و٢٧: ٢٦ ومرقس ١٥: ١٥ ولو ١٨: ٣٣
هذه وسيلة ثالثة اتخذها بيلاطس لإطلاق يسوع، وهي أن يجلده بشدة ويسلمه إلى جنود الرومان ليهزأوا به، أملاً أن يشفي بذلك بغض الرؤساء، ويحرك شفقة الشعب ليطلبوا إطلاقه. ودليل ذلك قوله «فأنا أؤدبه وأطلقه» (لوقا ٢٣: ١٦). فواضح أنه جبان قاس وظالم محتال. وقد سبق الكلام على الجلد والاستهزاء في شرح متّى ٢٧: ٢٧ ومرقس ١٥: ١٦. وذكر متّى ومرقس الجلد والحكم بالصلب معاً لأنهما كانا مقترنين، وأحدهما يستلزم الآخر. ولنا من رواية يوحنا أن الجلد سبق الصلب، ويظن بعض المفسرين أن يسوع جُلد مرتين، ولكن الموافقة بين البشيرين لا تقتضي ذلك. وقد جاءت النبوة في العهد القديم بذلك الجلد (إشعياء ٥٣: ٣) وأنبأ يسوع به (لوقا ١٨: ٣٣) وذكره بطرس في رسالته الأولى (١بطرس ٢: ٢٤).
٤ «فَخَرَجَ بِيلاطُسُ أَيْضاً خَارِجاً وَقَالَ لَهُمْ: هَا أَنَا أُخْرِجُهُ إِلَيْكُمْ لِتَعْلَمُوا أَنِّي لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً وَاحِدَةً».
يوحنا ١٨: ٣٨ وع ٦
لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً وَاحِدَةً ذكر يوحنا أن بيلاطس شهد بهذا ليسوع ثلاث مرات (يوحنا ١٨: ٣٨ و١٩: ٤، ٦) وفي هذه الشهادة تصريح بأن يسوع لم يهيّج فتنة، وليس ملكاً يقاوم قيصر.
٥ «فَخَرَجَ يَسُوعُ خَارِجاً وَهُوَ حَامِلٌ إِكْلِيلَ الشَّوْكِ وَثَوْبَ الأُرْجُوَانِ. فَقَالَ لَهُمْ بِيلاطُسُ: هُوَذَا الإِنْسَانُ».
فَخَرَجَ يَسُوعُ خَارِجاً كان داخل القصر وسبقه بيلاطس إلى الساحة حيث كان اليهود مجتمعين وكلمهم بما في ع ٤ ثم أخرج يسوع وأراه لهم.
وَهُوَ حَامِلٌ إِكْلِيلَ الشَّوْكِ وَثَوْبَ الأُرْجُوَانِ هذا مثل قول الرسول «أَنَّهُ مِنْ أَجْلِكُمُ افْتَقَرَ وَهُوَ غَنِيٌّ» (٢كورنثوس ٨: ٩) لأن رب المجد كلمة الله المتجسد الذي كان معبود الملائكة وقف عُرضة لهزء الناس وتعييرهم، لابساً ثوباً بالياً بدلاً من ثوب المجد والجلال، مجروحاً دامي الجبين، وعلى رأسه إكليل من الشوك بدلاً من تيجان العرش الأسمى.
هُوَذَا الإِنْسَانُ أي الرجل الذي تبغضونه واتهمتموه بالخيانة وسألتموني قتله، وقد علمت أنه بريءٌ وأخبرتكم بذلك، ولكني جلدته وأهنته إرضاءً لكم، فانظروه الآن واشفقوا عليه واكتفوا بما كان، وسلِّموا بإطلاقه. وجدير بالمسيح أن يُقال فيه «هوذا الإنسان» إذ لا نظير له في الكون كله، وهو ابن الإنسان، وابن الله، وسيطنا الوحيد، رافع خطايانا. وهو الرب برنا، ومخلصنا، وشفيعنا، وحبيبنا. طوبى لكل مؤمن يسجد له بالإيمان والطاعة والمحبة، وويل لمن يرفضه ويهمله.
٦ «فَلَمَّا رَآهُ رُؤَسَاءُ الكَهَنَةِ وَالخُدَّامُ صَرَخُوا: اصْلِبْهُ! اصْلِبْهُ! قَالَ لَهُمْ بِيلاطُسُ: خُذُوهُ أَنْتُمْ وَاصْلِبُوهُ، لأنِّي لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً».
أعمال ٣: ١٣
لم تنجح وسيلة بيلاطس الثالثة، كما لم تنجح الاثنتان السابقتان، فإن منظر يسوع لم يحرك شفقتهم بل كان وقيداً جديداً لنار غضب الرؤساء، وأوجب صراخهم على يسوع صراخ الجميع عليه.
الخُدَّامُ أي أتباع الكهنة وحراس الهيكل.
خُذُوهُ أَنْتُمْ وَاصْلِبُوهُ هذا كلام يدل على غيظ وخيبة، فكأنه قال: اقتلوه أنتم إذا أردتم، ولا تسألوني أن أشارككم في إثم قتله. ولتكن عليكم المسؤولية والعاقبة، لأنه ليس من شريعة ولا حق ولا عدل في الحكم عليه.
لأنِّي لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً هذه مرة ثالثة قال هذا القول عينه. وذهبت الوسائل الثلاث التي اتخذها لإطلاقه سدىً. (١) إرساله يسوع إلى هيرودس. (٢) تخيير الشعب بينه ويبن باراباس. (٣) جلده والهزء به.
٧ «أَجَابَهُ اليَهُودُ: لَنَا نَامُوسٌ، وَحَسَبَ نَامُوسِنَا يَجِبُ أَنْ يَمُوتَ، لأنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ ابْنَ اللَّهِ».
لاويين ٢٤: ١٦ متّى ٢٦: ٦٥ ويوحنا ٥: ١٨ و١٠: ٣٣
هذا هو الأمر الثالث مما اتفق اليهود عليه في طلبهم إلى بيلاطس قتل يسوع. وكان الأول الحكم عليه بالموت بلا فحص، فلم ينجحوا. والثاني أنه خائن للدولة الرومانية، ولم ينجحوا بهذا أيضاً، فأخذوا في الثالث، وهو أنه جدّف.
وَحَسَبَ نَامُوسِنَا يَجِبُ أَنْ يَمُوتَ هذا جوابهم على قول بيلاطس «لستُ أجد فيه علة» عدلوا عن اتهامهم إيّاه بجناية سياسية لأن بيلاطس قال إنه بريءٌ، واتهموه بالتجديف الذي حكم مجلس السبعين على يسوع به. وخلاصة شكواهم أنه إن لم يستحق الموت بتعديه على الدولة فهو يستحقه بتعديه على الدين والشريعة. والناموس الذي أشاروا إليه هو قوله «وَمَنْ جَدَّفَ عَلَى اسْمِ الرَّبِّ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ» (لاويين ٢٤: ١٦). فسألوا بيلاطس أن يُجري الحكم الذي يوجبه ناموسهم ودينهم.
جَعَلَ نَفْسَهُ ابْنَ اللَّهِ أي صرح بأنه إله. وفهم اليهود من قوله أنه ابن الله معادلته لله (يوحنا ٥: ١٨ و١٠: ٣٣).
٨ «َلَمَّا سَمِعَ بِيلاطُسُ هَذَا القَوْلَ ازْدَادَ خَوْفاً».
هَذَا القَوْلَ أي أن يسوع قال إنه ابن الله.
ازْدَادَ خَوْفاً من أن يحكم على المسيح لئلا يكون أعظم من سائر الناس، أي أن يكون أحد الآلهة ظهر في هيئة إنسان وسكن بين الناس على وفق ما كان اليونانيون والرومانيون يعتقدون (أعمال ١٤: ١١ و٢٨: ٦). ويشير قوله «ازداد» إلى أن ضميره كان يوبخه قبل ذلك على ظلمه لإنسان بارّ. وذُكر أن امرأته قد أرسلت إليه تحذره من الإساءة إلى يسوع (متّى ٢٧: ١٩). ولعله سمع بأعمال يسوع الغريبة وأقواله العجيبة، فلما سمع أنه ادعى الألوهية رأى أن ذلك ربما كان حقاً، وخشي الانتقام الإلهي إن لم يطلق يسوع.
٩ «فَدَخَلَ أَيْضاً إِلَى دَارِ الوِلايَةِ وَقَالَ لِيَسُوعَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ وَأَمَّا يَسُوعُ فَلَمْ يُعْطِهِ جَوَاباً».
إشعياء ٥٣: ٧ ومتّى ٧: ٦ و٢٧: ١٢، ١٤ ويوحنا ١٨: ٣٧
فَدَخَلَ أَيْضاً إِلَى دَارِ الوِلايَةِ آخذاً يسوع معه ليخاطبه على انفراد.
مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ أي: هل أنت من السماء؟ هل أنت أحد الآلهة؟ ولم يقصد بيلاطس معرفة وطن يسوع الأرضي أو عائلته، فقد كان يعلم أنه الجليل (لوقا ٢٣: ٦، ٧) وسؤاله هذا لا يفيده في شيء.
وَأَمَّا يَسُوعُ فَلَمْ يُعْطِهِ جَوَاباً لا نعلم علة سكوت المسيح عن ذلك، والأرجح أنه لم يجاوبه لأنه لا يستحق، فقد فسر له حقيقة مملكته، وأن غاية مجيئه ليشهد للحق. وعرف بيلاطس أنه بريء، وصرّح بذلك. ومع ذلك أمر بجلده والهزء به بدلاً من أن يطلقه، فدان يسوع بسكوته الرجل الذي دانه. على أن يسوع كان قد أجابه على هذا السؤال بقوله «أتيت إلى العالم» وهذا يلزم أنه ليس من العالم (يوحنا ١٨: ٣٧). قال المسيح «كل من هو من الحق يسمع صوتي» وواضح أن بيلاطس ليس من الذين يسمعون صوت المسيح، فليس من الحق أن يخاطبه المسيح بعد ذلك. وعلم يسوع أنه لا فائدة من الجواب، لأنه لم يسأل عن العدل ولا الحق، ولأنه لن يفهم ولن يؤمن لو صرّح له بأنه ابن الله.
١٠ «فَقَالَ لَهُ بِيلاطُسُ: أَمَا تُكَلِّمُنِي؟ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لِي سُلطَاناً أَنْ أَصْلِبَكَ وَسُلطَاناً أَنْ أُطْلِقَكَ؟».
غضب بيلاطس على يسوع لسكوته عن جوابه وحسب ذلك توبيخاً له، فرأى أن يخيفه ليجاوبه، فتباهى بسلطانه. نعم أنه كان قادراً أن يحكم على يسوع، لكن لم يكن له حق في ذلك الحكم. وكان بيلاطس عند افتخاره بسلطانه عبداً لليهود، لا يجسر ان يغيظهم بإطلاق يسوع. وكان سكوت يسوع تحقيقاً لنبوة إشعياء ٥٣: ٧.
١١ «أَجَابَ يَسُوعُ: لَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَيَّ سُلطَانٌ البَتَّةَ، لَوْ لَمْ تَكُنْ قَدْ أُعْطِيتَ مِنْ فَوْقُ. لِذَلِكَ الَّذِي أَسْلَمَنِي إِلَيْكَ لَهُ خَطِيَّةٌ أَعْظَمُ».
لوقا ٢٢: ٥٣ ويوحنا ٧: ٣٠
هذا جواب المسيح على قول بيلاطس مرتين «لي سلطان». فقال له يسوع: لا سلطان لك كما ادعيت، لأن كل سلطانك من الله، وهو عيّنك لهذه الوظيفة ووهب لك هذه السلطة (رومية ١٣: ١ ومزمور ٧٥: ٦ و٧ ودانيال ٢: ٢١).
عَلَيَّ لم يكن لبيلاطس سلطان على المسيح لو لم يُسلمه الآب لأجل خطايانا، ولو لم يسلم هو نفسه للموت (رومية ٩: ٣٢ وإشعياء ٥٣: ١٢). فكأنه قال: إني واقف هنا موثقاً لا طوعاً لمشيئة وسلطان إنسان، بل طوعاً لقصد الله ومشيئته. فإذاً لا أخاف شيئاً من سلطانك، ولا أرجو منه شيئاً.
لِذَلِكَ الَّذِي أَسْلَمَنِي إِلَيْكَ لم يقصد بذلك يهوذا لأنه سلم يسوع إلى اليهود لا إلى بيلاطس، إنما قصد به أعضاء مجلس السبعين الذين رئيسهم قيافا، واليهود الذين تبعوهم.
لَهُ خَطِيَّةٌ أَعْظَمُ تكلم عن الجميع كأنهم واحد لاتفاقهم على قتله. والمعنى أن خطية اليهود أعظم من خطية بيلاطس. فلم يبرر بيلاطس من الخطية، بل صرح بأن خطيته أصغر من خطية اليهود، لأنهم هيجوه ليستعمل السلطان الذي أعطاه الله له ليحكم بالحق باعتباره قاضياً ووالياً في عقاب البريء. فهم كانوا الجناة، وكان بيلاطس آلة في يدهم. وفضلاً عن ذلك كان بيلاطس وثنياً يجهل النبوات المتعلقة بالمسيح وتعاليم العهد القديم، وعرف قليلاً من أمر معجزات المسيح وتعليمه، ولم يُرد أن يسلم يسوع إلى الموت. إنما فعل ذلك إرضاءً لليهود. فكانت خطيته الجبن والضعف والجهل. وأما هم فكانوا يعرفون تلك النبوات وبراهين كثيرة على أنه أجرى المعجزات، ومع ذلك طلبوا قتله حسداً وبغضاً، فزاد إثمهم على قدر زيادة معرفتهم عن معرفة بيلاطس. والتماس المسيح العذر لبيلاطس يشبه صلاته من أجل قاتليه: «يَا أَبَتَاهُ، اغْفِرْ لَهُمْ، لأنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ» (لوقا ٢٣: ٣٤).
١٢ «مِنْ هَذَا الوَقْتِ كَانَ بِيلاطُسُ يَطْلُبُ أَنْ يُطْلِقَهُ، وَلَكِنَّ اليَهُودَ كَانُوا يَصْرُخُونَ: إِنْ أَطْلَقْتَ هَذَا فَلَسْتَ مُحِبّاً لِقَيْصَرَ. كُلُّ مَنْ يَجْعَلُ نَفْسَهُ مَلِكاً يُقَاوِمُ قَيْصَرَ».
لوقا ٢٣: ٢ أعمال ١٧: ٧
يَطْلُبُ أَنْ يُطْلِقَهُ كان قد طلب ذلك من تلك الساعة باجتهاد زائد بسبب تأثره من هيئة المسيح وكلامه. ولم يتضح هنا ماذا فعل ليُظهر اجتهاده. ونستنتج من قول اليهود أنه ترك يسوع داخلاً وخرج إليهم وأخبرهم أنه لم يحكم عليه بالموت لاتهامهم إياه بالتجديف، وأنه عزم على إطلاقه.
وَلَكِنَّ اليَهُودَ كَانُوا يَصْرُخُونَ ترك اليهود اتهامهم يسوع بالتجديف ورجعوا إلى اتهامهم له بالخيانة، وقالوا لبيلاطس ما مضمونه: إن أطلقته نشكوك إلى قيصر بأنك خائن لدولتك لأنك لم تعترض إنساناً صرّح بأنه ملك اليهود. وكان طيباريوس قيصر إمبراطور الرومان وقتئذ كثير الوساوس سريع الغضب ظالماً، كما يشهد المؤرخان الرومانيان تاسيتوس وسويتونيوس، فيصدِّق حالاً كل شكاوى كهذه تُرفع إليه. فخاف بيلاطس لمعرفته أن طيباريوس يصدقها.
وما أظهره اليهود هنا من الرغبة في المحاماة عن حقوق قيصر غاية في الرياء والمكر والدجل.
١٣ «فَلَمَّا سَمِعَ بِيلاطُسُ هَذَا القَوْلَ أَخْرَجَ يَسُوعَ، وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّ الوِلايَةِ فِي مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ «البلاطُ» وَبِالعِبْرَانِيَّةِ «جَبَّاثَا».
هَذَا أي قول اليهود في ع ١٢ وهو أنهم يشكونه إلى قيصر. فانتُزع من قلبه كل شفقة وكل احترام للعدل وللمسيح، ففضَّل أن يسلم يسوع البار إلى الموت على أن يخاطر بنفسه بتعريضها لشكاوى اليهود.
أَخْرَجَ يَسُوعَ لأنه كان داخل دار الولاية. والشريعة الرومانية تلزم الحاكم بأن لا يحكم على المتهم إلا وهو أمامه.
جَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّ الوِلايَةِ لعل هذا الكرسي كان كمنبر من المرمر قليل الارتفاع، يجلس عليه الحاكم عند المحاكمة في الساحة أمام دار الولاية.
يُقَالُ لَهُ البلاطُ لعله سمي بذلك لأنه كان مبلطاً بمرمر مختلف الألوان.
وَبِالعِبْرَانِيَّةِ «جَبَّاثَا»أي رابية أو مكاناً مرتفعاً. والمراد بالعبرانية هنا السريانية أي اللغة التي تكلم بها اليهود بعد رجوعهم من بابل، وكانت عبرانية ممزوجة بالكلدانية.
١٤ «وَكَانَ اسْتِعْدَادُ الفِصْحِ وَنَحْوُ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ. فَقَالَ لِليَهُودِ: هُوَذَا مَلِكُكُمْ».
متّى ٢٧: ٦٢ مرقس ١٥: ٢٥
وَكَانَ اسْتِعْدَادُ الفِصْحِ أي يوم الجمعة حسب اصطلاح اليهود لأنهم كانوا يطبخون فيه ما يحتاجون إليه من طعام يوم السبت (انظر شرح متّى ٢٧: ٦٢ وانظر أيضاً لوقا ٢٣: ٥٤) وقوله في مرقس ١٥: ٤١ «وَلَمَّا كَانَ المَسَاءُ، إِذْ كَانَ الاسْتِعْدَادُ - أَيْ مَا قَبْلَ السَّبْتِ» وكان ذلك اليوم استعداداً لأقدس سبوت السنة عندهم، لأنه السبت الذي في أسبوع الفصح.
وَنَحْوُ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ أي قرب الظهر (بعد الشروق بست ساعات) حسب اصطلاح اليهود وقتئذ (انظر شرح مرقس ١٥: ٢٥، وانظر متّى ٢٧: ٤٥ ولوقا ٢٣: ٤٤). وجاء في بعض النسخ «الثالثة» بدل السادسة. ومما يستحق الاعتبار فضلاً عما ذُكر أربعة أشياء: (١) أن متّى ومرقس ولوقا اتفقوا على أن الظلمة كانت من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة. وكان المسيح حينئذ على الصليب، وهذا موافق لقول يوحنا. (٢) أن يوحنا ميّز بين وقت جلد بيلاطس ليسوع ووقت صلبه بأن ذكر كليهما كحادثة معيّنة. أما متّى ومرقس فذكرا الحادثتين كأنهما واحدة، ولذلك حسبا وقت الجلد مع وقت الصلب. فإذا كان الجلد في الساعة الثالثة كما قال مرقس، فيحتمل أن يكون الصلب قد بقي إلى نحو الساعة التاسعة. (٣) أن يوحنا لم يعيّن وقت الصلب أنه كان الساعة السادسة بل قال إنه نحوها، ولم يكن يومئذ للناس وسائط لتعيين الساعة بالتدقيق كما في هذه الأيام، ولم يكونوا يبالون بذلك. (٤) أن اليهود قسموا اليوم إلى «هُزُع» كل هزيع ثلاث ساعات وندر أن يذكروا سوى الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة (متّى ٢٠: ٣، ٥) وحسبوا ما بين كل من تلك الساعات إما مع ما قبلها أو مع ما بعدها. والصلب حدث ما بين الساعة الثالثة والساعة السادسة، فنسبه متّى ومرقس إلى الوقت الأول منهما، ونسبه يوحنا إلى الثاني.
هُوَذَا مَلِكُكُمْ قصد بيلاطس بهذا تعيير اليهود والتهكم عليهم، كما قصد ذلك بالعنوان (متّى ٢٧: ٣٧). وكان حينئذ مغتاظاً منهم، فكأنه قال: هذا الأسير الضعيف الجريح المهان هو الذي خفتم منه وطلبتم قتله بحجة أنه ملك يقاوم قيصر.
١٥ «فَصَرَخُوا: خُذْهُ! خُذْهُ اصْلِبْهُ! قَالَ لَهُمْ بِيلاطُسُ: أَأَصْلِبُ مَلِكَكُمْ؟ أَجَابَ رُؤَسَاءُ الكَهَنَةِ: لَيْسَ لَنَا مَلِكٌ الا قَيْصَرُ».
تكوين ٤٩: ١٠ و١صموئيل ١٢: ١٢
خُذْهُ اصْلِبْهُ لم يكتفوا بشيء سوى قتله. وكانوا كلما رأوه أو سمعوا ذكره زادوا حنقاً ورغبة في إماتته، فتمت بذلك نبوتان هما إشعياء ٤٧: ٧ و٥٣: ٢.
قَالَ لَهُمْ بِيلاطُسُ: أَأَصْلِبُ مَلِكَكُمْ؟ أي: هل تريدون مني أنا الروماني أن أقتل ملككم أيها اليهود؟ وسبق مثل هذه القول من بيلاطس في ع ٥ وقصد وقتئذ تحريك شفقتهم عليه. وأما قصده هنا فتهييج غيرتهم الطائفية وكبرياءهم باعتبارهم أمة مستعبَدة.
لَيْسَ لَنَا مَلِكٌ إلا قَيْصَرُ في هذا إنكار لمبادئ ديانتهم أن الله وحده هو ملكهم (١صموئيل ١٢: ١٢) وإنكار لاعتقاد آبائهم، وآمالهم بتصريحهم أن قيصر هو ملكهم الوحيد، وارتكبوا ذلك من شدة بغضهم ليسوع، ومن رغبتهم في أن يجعلوا بيلاطس يحكم حسب مرامهم، فشهد بذلك للعالم أنه قد تمت النبوة بمجيء المسيح القائلة «لا يَزُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُوذَا وَمُشْتَرِعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ شِيلُونُ» (تكوين ٤٩: ١٠). والأرجح أنه كان حينئذ ما ذكره متّى من نبإ غسل بيلاطس يديه أمام الشعب (متّى ٢٧: ٢٤).
الصلب (ع ١٦ - ٣٧)
١٦، ١٧ «١٦ فَحِينَئِذٍ أَسْلَمَهُ إِلَيْهِمْ لِيُصْلَبَ. فَأَخَذُوا يَسُوعَ وَمَضَوْا بِهِ. ١٧ فَخَرَجَ وَهُوَ حَامِلٌ صَلِيبَهُ إِلَى المَوْضِعِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ «مَوْضِعُ الجُمْجُمَةِ» وَيُقَالُ لَهُ بِالعِبْرَانِيَّةِ «جُلجُثَةُ».
متّى ٢٧: ٢٦، ٣١، ٣٢ ومرقس ١٥: ١٥، ٢١، ٢٢ ولوقا ٢٣: ٢٤، ٢٦، ٣٣ وعدد ١٥: ٣٦ وعبرانيين ١٣: ١٢.
(انظر شرح متّى ٢٧: ٣١ - ٣٤ ومرقس ١٥: ٢٠ - ٢٣ ولوقا ٢٣: ٢٦ - ٣٣).
ظن البعض أن بيلاطس جلد يسوع ثانية حسب العادة الجارية في أمر الصلب (أي أنه يكون مقترناً بالجلد) للموافقة بين ما قاله يوحنا وما قاله متّى ومرقس، بناءً على أن جلده إيّاه أولاً كان لتحريك شفقة اليهود عليه ووسيلة إلى إطلاقه.
أَسْلَمَهُ إِلَيْهِمْ أي إلى رؤساء الكهنة، وأعطاهم أيضاً فرقة من جنود الرومان لتنفيذ الحكم (لوقا ٢٣: ٢٤، ٢٥). والمسيح أُسلم لأجل خطايانا بإرادته وإرادة أبيه، فضلاً عن أنه أُسلم بأمر بيلاطس ظلماً لأن الرب «لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ابْنِهِ، بَل بَذَلَهُ لأجْلِنَا أَجْمَعِينَ» (رومية ٤: ٢٥ و٨: ٣٢). فأُسلم ذلك للموت الوقتي لننجو من الموت الأبدي وننال الحياة الأبدية.
١٨ «حَيْثُ صَلَبُوهُ، وَصَلَبُوا اثْنَيْنِ آخَرَيْنِ مَعَهُ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا، وَيَسُوعُ فِي الوَسَطِ».
انظر شرح متّى ٢٧: ٣٨ ومرقس ١٥: ٢٧ ولوقا ٢٣: ٣٣، ٣٤. وكان ذلك تحقيقاً لنبوة إشعياء ٥٣: ١٢.
١٩ «وَكَتَبَ بِيلاطُسُ عُنْوَاناً وَوَضَعَهُ عَلَى الصَّلِيبِ. وَكَانَ مَكْتُوباً: يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ مَلِكُ اليَهُودِ».
عُنْوَاناً انظر شرح متّى ٢٧: ٣٧ ومرقس ١٥: ٢٦ ولوقا ٢٣: ٣٨. قصد بيلاطس بذلك إهانة اليهود وتذكيرهم أنهم أجبروه على صلب ملكهم، كما قصد تبرئة نفسه من تهمتهم أنه ليس محباً لقيصر.
٢٠ «فَقَرَأَ هَذَا العُنْوَانَ كَثِيرُونَ مِنَ اليَهُودِ، لأنَّ المَكَانَ الَّذِي صُلِبَ فِيهِ يَسُوعُ كَانَ قَرِيباً مِنَ المَدِينَةِ. وَكَانَ مَكْتُوباً بِالعِبْرَانِيَّةِ وَاليُونَانِيَّةِ وَاللاتِينِيَّةِ».
كَانَ قَرِيباً مِنَ المَدِينَةِ ذكر يوحنا ذلك بياناً لكثرة المشاهدين، فلو صُلب بعيداً عن المدينة لما كان كذلك.
بِالعِبْرَانِيَّةِ أي لغة اليهود وهي عبرانية ممزوجة بالكلدانية.
وَاليُونَانِيَّةِ وكانت لغة الأمم الساكنة في الأرض المقدسة وما جاورها من البلاد وسكان بلاد اليونان ومصر ولغة علماء اليهود.
وَاللاتِينِيَّةِ أي لغة الرومان وهي الدولة الحاكمة، وكانت اللغات الثلاث أشهر لغات الأرض في ذلك العصر. ولعل ما جاء من الفرق في لفظ العنوان في البشائر نتج عن أن الواحد ترجم ما كُتب في لغة، والآخر ترجم ما كُتب في لغة أخرى، أو لعل بعضهم نقل المعنى دون الحرف. وكان بيلاطس بما كتبه عنواناً شاهد حقٍ على غير قصد.
٢١ «فَقَالَ رُؤَسَاءُ كَهَنَةِ اليَهُودِ لِبِيلاطُسَ: لا تَكْتُبْ: مَلِكُ اليَهُودِ، بَل: إِنَّ ذَاكَ قَالَ أَنَا مَلِكُ اليَهُودِ».
لا شك أن رؤساء اليهود شعروا بأن بيلاطس قصد بذلك العنوان الهزء بهم، فأرادوا تغييره لأنهم لم يرضوا أن يُدعى رجل مصلوب ملكهم.
٢٢ «أَجَابَ بِيلاطُسُ: مَا كَتَبْتُ قَدْ كَتَبْتُ».
رفض بيلاطس طلب اليهود بهذا الجواب فلم يعد يخشى من أن يشكوه إلى قيصر. ورجع إلى عناده وكبريائه. ولم يخلُ جوابه من إظهار غيظه أنه خضع لهم في ما أرادوا.
٢٣، ٢٤ «٢٣ ثُمَّ إِنَّ العَسْكَرَ لَمَّا كَانُوا قَدْ صَلَبُوا يَسُوعَ، أَخَذُوا ثِيَابَهُ وَجَعَلُوهَا أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ، لِكُلِّ عَسْكَرِيٍّ قِسْماً. وَأَخَذُوا القَمِيصَ أَيْضاً. وَكَانَ القَمِيصُ بِغَيْرِ خِيَاطَةٍ، مَنْسُوجاً كُلُّهُ مِنْ فَوْقُ. ٢٤ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لا نَشُقُّهُ، بَل نَقْتَرِعُ عَلَيْهِ لِمَنْ يَكُونُ. لِيَتِمَّ الكِتَابُ القَائِلُ: اقْتَسَمُوا ثِيَابِي بَيْنَهُمْ وَعَلَى لِبَاسِي أَلقَوْا قُرْعَةً. هَذَا فَعَلَهُ العَسْكَرُ».
متّى ٢٧: ٣٥ ومرقس ١٥: ٢٤ ولوقا ٢٣: ٣٤ مزمور ٢٢: ١٨
انظر شرح قسمة ثياب يسوع في شرح متّى ٢٧: ٣٥. ونبأ يوحنا بذلك أوضح من غيره إذ ظهر منه أن الذين صلبوه كانوا أربعة، وأن الثياب كانت أربع قطع بالإضافة إلى القميص، فأخذ كل واحد قطعة، ولم يقسموا القميص بل اقترعوا عليه. وذلك تحقيقاً للنبوة «يَقْسِمُونَ ثِيَابِي بَيْنَهُمْ، وَعَلَى لِبَاسِي يَقْتَرِعُونَ» (مزمور ٢٢: ١٨). وكانت ثياب المصلوب عند الرومان من نصيب الصالبين.
٢٥ - ٢٧ «٢٥ وَكَانَتْ وَاقِفَاتٍ عِنْدَ صَلِيبِ يَسُوعَ، أُمُّهُ، وَأُخْتُ أُمِّهِ مَرْيَمُ زَوْجَةُ كِلُوبَا، وَمَرْيَمُ المَجْدَلِيَّةُ. ٢٦ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ أُمَّهُ، وَالتِّلمِيذَ الَّذِي كَانَ يُحِبُّهُ وَاقِفاً، قَالَ لأُمِّهِ: يَا امْرَأَةُ، هُوَذَا ابْنُكِ. ٢٧ ثُمَّ قَالَ لِلتِّلمِيذِ: هُوَذَا أُمُّكَ. وَمِنْ تِلكَ السَّاعَةِ أَخَذَهَا التِّلمِيذُ إِلَى خَاصَّتِهِ».
لوقا ٢٤: ١٨ متّى ٢٧: ٥٦ مرقس ١٥: ٤٠ ولوقا ٢٣: ٤٠ ويوحنا ١٣: ٢٣ و٢٠: ٢ و٢١: ٧، ٢٤ ويوحنا ٢: ٤ ويوحنا ١: ١١ و١٦: ٣٢
لم يذكر أحد من كتبة البشائر ما قيل في هذا الفصل سوى يوحنا.
أُمُّهُ أي مريم وكانت حينئذ في نحو الثامنة والأربعين.
وَأُخْتُ أُمِّهِ الأرجح أنها سالومي أم يوحنا الإنجيلي، لكنه لم يذكر اسمها كما امتنع عن ذكر اسمه في بشارته. والذي يقوي أرجحية أنها سالومي ذكر متّى أنها أم ابني زبدي (متّى ٢٧: ٥٦).
مَرْيَمُ زَوْجَةُ كِلُوبَا ويسمى حلفى أيضاً (متّى ١٠: ٣) وهي أم يعقوب الصغير ويوسي. أظهرت النساء الأربع محبتهن ليسوع وأمانتهن وشجاعتهن، لأنهن عرضن أنفسهن بحضورهن لإهانة اليهود وقساوة الرومان. وأظهروا ما لم يظهره سوى واحد من التلاميذ وهو يوحنا.
التِّلمِيذَ الَّذِي أي يوحنا (يوحنا ١٣: ٢٤).
هُوَذَا ابْنُكِ الإشارة إلى يوحنا وقصد أنه بمنزلة ابنها يعتني بها ويقوم بكل ما تحتاج إليه بناء على محبة يوحنا له. ونستنتج من ذلك أن يوسف خطيبها كان قد تُوفي منذ سنين. وعمل المسيح هذا نموذجٌ لكل الأبناء، يعلّمهم القيام بما يجب عليهم لوالديهم، لأنه لم يغفل مستقبل أمه، في وقت يحتمل فيه أشد الآلام، ويكفر عن خطايا العالم.
هُوَذَا أُمُّكَ أوصى أمه أن تعتبر يوحنا ابناً لها كما أوصى يوحنا أن يعتبرها أماً له، يعتني بها. وأظهر بذلك ثقته بيوحنا.
مِنْ تِلكَ السَّاعَةِ أي من ذلك الوقت إلى يوم وفاتها.
٢٨ - ٣٠ «٢٨ بَعْدَ هَذَا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ قَدْ كَمَلَ، فَلِكَيْ يَتِمَّ الكِتَابُ قَالَ: أَنَا عَطْشَانُ. ٢٩ وَكَانَ إِنَاءٌ مَوْضُوعاً مَمْلُوّاً خَلا، فَمَلأوا إِسْفِنْجَةً مِنَ الخَلِّ، وَوَضَعُوهَا عَلَى زُوفَا وَقَدَّمُوهَا إِلَى فَمِهِ. ٣٠ فَلَمَّا أَخَذَ يَسُوعُ الخَلَّ قَالَ: قَدْ أُكْمِلَ. وَنَكَّسَ رَأْسَهُ وَأَسْلَمَ الرُّوحَ».
مزمور ١٩: ٢١ خروج ١٢: ٢٢ ولاويين ١٤: ٤ ومزمور ٥١: ٧ متّى ٢٧: ٤٨ ويوحنا ١٧: ٤ ويوحنا ١٠: ١٨
انظر شرح متّى ٢٧: ٤٨.
بَعْدَ هَذَا أي بعد ثلاث ساعات الظلمة وسكوت المسيح، إذ لم يتكلم إلا بقوله لأبيه «إلهي إلهي، لماذا تركتني؟» (انظر متّى ٢٧: ٤٥ - ٥٠ ومرقس ١٥: ٣٣ - ٥١ ولوقا ٢٣: ٤٤ - ٥١). ثم نحو الساعة التاسعة زالت الظلمة وحدث ما ذكر في هذا الفصل.
رَأَى يَسُوعُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ قَدْ كَمَلَ أشار بهذا إلى كل حوادث حياته التي اقتضتها الكفارة عن خطايا العالم. وذكر البشير هذا مقدمةً لذكر موته. وكان موت المسيح باختياره وسلطانه حسب قوله «لي سلطان أن أضعها» (أي حياته) (يوحنا ١٠: ١٨) فلم يمت إلا بعد أن أكمل كل ما هو ضروري للفداء.
لِكَيْ يَتِمَّ الكِتَابُ أي كان ذلك على وفق ما قاله الكتاب.
قَالَ أَنَا عَطْشَانُ لم يقل ذلك على قصد أن يتم الكتاب، بل لأنه كان عطشان حقاً، لأن جسده كان كسائر أجساد البشر يتألم كغيره من المصلوبين. والمصلوب يعاني من حمى شديدة وعطش شديد. وبإظهاره عطشه وبشربه فعلاً تم الكتاب.
إِنَاءٌ مَوْضُوعاً مَمْلُوّاً خَلاً (ع ٢٩) الأرجح أن ذلك الإناء كان للعسكر، فيه شيء مما اعتادوا شربه وهو خمر حامض، ولذلك كانوا يسمونه «خلاً». ويجب التمييز بين هذا الخل والخل الذي أعطوه إيّاه في أول الصلب ممزوجاً بمرارة لتسكين الألم، وأبى أن يشربه (متّى ٢٧: ٣٤).
فَمَلأوا إِسْفِنْجَةً مِنَ الخَلِّ هذه أسهل طريقة إلى سقيه في تلك الحال.
قَالَ قَدْ أُكْمِلَ (ع ٣٠) انظر شرح متّى ٢٧: ٥٠. هذا قول المسيح السادس وهو معلق على الصليب. قارنه بقوله في (ع ٢٨) «رَأَى يَسُوعُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ قَدْ كَمَلَ» وبقوله للآب في (يوحنا ١٧: ٤) «العَمَلَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي لأعْمَلَ قَدْ أَكْمَلتُهُ».
والذي أُكمل سبعة أمور: (١) حياته الجسدية فإنه تجسد وقضى على الأرض نحو ٣٣ سنة، وكان حينئذ على وشك أن يترك العالم. (٢) عمل الفداء العظيم. وإلى هذا أشار النبي بقوله «سَبْعُونَ أُسْبُوعاً قُضِيَتْ.. لِتَكْمِيلِ المَعْصِيَةِ وَتَتْمِيمِ الخَطَايَا، وَلِكَفَّارَةِ الإِثْمِ، وَلِيُؤْتَى بِالبِرِّ الأَبَدِيِّ، وَلِخَتْمِ الرُّؤْيَا وَالنُّبُوَّةِ، وَلِمَسْحِ قُدُّوسِ القُدُّوسِينَ» (دانيال ٩: ٢٤). (٣) قصد الله الأزلي. (٤) إتمامه الشريعة نائباً عن الإنسان وطاعته إيّاها طاعة كاملة. وبذلك تم قول الكتاب أنه «يُعَظِّمُ الشَّرِيعَةَ وَيُكْرِمُهَا» (إشعياء ٤٢: ٢١) وبموته أمكن أن يظهر بر الآب، ويتبرر الخاطئ. (٥) كل رموز وشعائر النظام الموسوي. (٦) كل نبوات العهد القديم المتعلقة بالفداء من التكوين بخصوص نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية (تكوين ٣: ١٥)، ومجيء ملاك العهد القديم الذي تنبأ به ملاخي (ملاخي ٣: ١). (٧) كل آلام المسيح وعاره وتعبه.
نَكَّسَ رَأْسَهُ (ع ٣٠) هذه شهادة شاهد عيان أثر فيه ما شاهده، وبقي في ذاكرته فشهد به. وتنكيس الرأس من نتائج الموت الطبيعية للمصلوب، لأن الرأس يُنصب بالاختيار. ولكن متّى انتهت سلطة الإرادة على عضلات الجسد تتنكس رأس المصلوب.
أَسْلَمَ الرُّوحَ عبّر بهذا عن الموت لأنه انفصال الروح عن الجسد، ولأنه مات باختياره (يوحنا ١٠: ١٨). وأسلم روحه إلى يدي أبيه (لوقا ٢٣: ٤٦). وذكر لوقا حينئذ قول المسيح السابع والأخير على الصليب وهو «يا أبتاه، في يديك أستودع روحي».
فإن سُئل: إلى أين ذهبت نفس المسيح؟ قلنا: الفردوس (لوقا ٢٣: ٤٣). ولم يذكر يوحنا في بشارته الظلمة التي كانت من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة، ولا الزلزلة، ولا انشقاق حجاب الهيكل، لأسباب لا نعلمها.
طعن جنب المسيح (ع ٢١ - ٣٧)
٣١ «ثُمَّ إِذْ كَانَ اسْتِعْدَادٌ، فَلِكَيْ لا تَبْقَى الأَجْسَادُ عَلَى الصَّلِيبِ فِي السَّبْتِ، لأنَّ يَوْمَ ذَلِكَ السَّبْتِ كَانَ عَظِيماً، سَأَلَ اليَهُودُ بِيلاطُسَ أَنْ تُكْسَرَ سِيقَانُهُمْ وَيُرْفَعُوا».
مرقس ١٥: ٤٢ وع ٤٢ تثنية ٢١: ٢٣
اسْتِعْدَادٌ هو يوم الجمعة الذي كان اليهود يستعدون فيه للسبت.
فَلِكَيْ لا تَبْقَى الأَجْسَادُ عَلَى الصَّلِيبِ فِي السَّبْتِ كان الرومان يتركون المصلوبين على الصلبان حتى يموتوا ويفسدوا مهما استغرق هذا من وقت. وأما اليهود فحسبوا بقاء أجساد المصلوبين على صلبانهم بعد غروب الشمس تنجيساً لأرضهم، بحسب ما جاء في تثنية ٢١: ٢٢، ٢٣. فمنعاً لذلك سألوا بيلاطس أن يتخذ وسيلة لإماتة المصلوبين سريعاً حتى يمكن تنزيل أجسادهم قبل غروب الشمس.
لأنَّ يَوْمَ ذَلِكَ السَّبْتِ كَانَ عَظِيماً لأنه السبت الذي في أسبوع عيد الفصح وهو عندهم أقدس السبوت.
تُكْسَرَ سِيقَانُهُمْ ليموتوا سريعاً. وكان الرومان قد اعتادوا مثل هذه الوسيلة لتلك الغاية. وكانت أداة ذلك الكسر غالباً عصا ثقيلة. وكان سؤال اليهود ذلك واسطة لما لم يقصدوه، وهو إنجاز النبوة القائلة إن المسيح لا يرى فساداً (مزمور ١٦: ١٠).
٣٢ «فَأَتَى العَسْكَرُ وَكَسَرُوا سَاقَيِ الأَوَّلِ وَالآخَرِ المَصْلُوبَيْنِ مَعَهُ».
فَأَتَى العَسْكَرُ أي المعيّنون لهذه الخدمة فهم غير الحراس.
سَاقَيِ الأَوَّلِ وَالآخَرِ هذا يحتمل أن العسكر كانوا فرقتين أخذت إحداهما تكسر ساقي من على أحد جانبي المسيح وأخذت الأخرى تكسر ساقي من على الجانب الآخر حتى أتتا إلى يسوع أخيراً. وتم بذلك وعد المسيح لأحد اللصين بقوله «اليَوْمَ تَكُونُ مَعِي فِي الفِرْدَوْسِ» (لوقا ٢٣: ٤٣).
٣٣ «وَأَمَّا يَسُوعُ فَلَمَّا جَاءُوا إِلَيْهِ لَمْ يَكْسِرُوا سَاقَيْهِ، لأنَّهُمْ رَأَوْهُ قَدْ مَاتَ».
عرفوا ذلك من اصفرار لونه، وتنكيس رأسه، ولعلهم لمسوه أيضاً. ووثقوا بشهادة قائد الحراس أنه مات (متّى ٢٧: ٥٤). ولنا مما قيل هنا البرهان الأول على أن المسيح مات يقيناً.
٣٤ «لَكِنَّ وَاحِداً مِنَ العَسْكَرِ طَعَنَ جَنْبَهُ بِحَرْبَةٍ، وَلِلوَقْتِ خَرَجَ دَمٌ وَمَاءٌ».
يوحنا ٢٠: ٢٦ و١يوحنا ٥: ٦، ٨
في هذه الآية البرهان الثاني على موت المسيح يقيناً. كانت غاية الجندي الذي طعن جنب المسيح أن يتأكد من موته، وأن ما شاهده ليس إغماءً ولا خداعاً، فكأنه قال في نفسه: إن لم يكن قد مات فطعن جنبه كافٍ أن يذهب بباقي حياته. ونستنتج مما قيل في يوحنا ٢٠: ٢٧ أن الجرح كان واسعاً وعميقاً. ونستدل من خروج الدم والماء من جنبه أن الحربة بلغت شغاف قلبه. وانحلال الدم إلى ما ذُكر دليل قاطع على وقوع الموت، وأن علته انهيار القوة الجسدية. وكان ما فعله العسكر دفعاً لكل شك في حقيقة موت المسيح، ثم في حقيقة قيامته.
إن المؤمن بالله يرى للرب يداً في تحريك حربة ذلك الجندي الروماني، كما يرى له يداً في تحريك قلم يوحنا البشير في تسجيل خبر هذه الحادثة.
٣٥ «وَالَّذِي عَايَنَ شَهِدَ، وَشَهَادَتُهُ حَقٌّ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ الحَقَّ لِتُؤْمِنُوا أَنْتُمْ».
عبّر يوحنا هنا عن نفسه بضمير الغائب، وقد اعتاد في هذه البشارة أن لا يذكر اسمه. وقال هنا ثلاثة أمور شاهدها بعينه. (١) إن ساقَي المسيح لم تُكسرا. (٢) إن أحد جنود الرومان طعن جنبه. (٣) إنه خرج من جنبه دمٌ وماءٌ. وغايته من تقديم هذه الشهادة إثبات أن المسيح مات يقيناً، لأن عمل الفداء متوقِّف على موته، فقد مات كفارة عن الخطاة، وعليه تتوقف حقيقة القيامة وأكثر عقائد المسيحية. وغايته أيضاً إثبات أن يسوع هو المسيح، لأن النبوات تمّت بحوادث موته، فهو الموعود به فيها كما أوضح في ع ٣٦، ٣٧.
٣٦، ٣٧ «٣٦ لأنَّ هَذَا كَانَ لِيَتِمَّ الكِتَابُ القَائِلُ: عَظْمٌ لا يُكْسَرُ مِنْهُ. ٣٧ وَأَيْضاً يَقُولُ كِتَابٌ آخَرُ: سَيَنْظُرُونَ إِلَى الَّذِي طَعَنُوهُ».
خروج ١٢: ٤٦ وعدد ٩: ١٢ ومزمور ٢٢: ١٦، ١٧ و٣٤: ٢٠ و١كورنثوس ٥: ٧ وزكريا ١٢: ١٠ ورؤيا ١: ٧
سجل يوحنا هنا الأمور الثلاثة التي حققت ما يتعلق بالمسيح من رمز ونبوة.
عَظْمٌ لا يُكْسَرُ مِنْهُ هذا ما أمرت به الشريعة في شأن حمل الفصح (خروج ١٢: ٤٦ وعدد ٩: ١٢). وكان ذلك الحمل رمزاً ليسوع كما يظهر من قول يوحنا المعمدان (يوحنا ١: ٢٩) ومن قول بولس الرسول في (١كورنثوس ٥: ٧). وما صدق على الرمز صدق على المرموز إليه وتم ذلك بالعناية الإلهية.
سَيَنْظُرُونَ إِلَى الَّذِي طَعَنُوهُ هذا من نبوة زكريا (يوحنا ١٢: ١٠) والمقصود منه أن الذين ينظرونه ليسوا هم العسكر ويوحنا والذين كانوا وقوفاً حول الصليب فقط، بل اليهود كلهم الذين سيذكرون بعد ذلك أنهم كانوا العلة الحقيقية لطعنه (وإن كان الطاعن غيرهم) ويتوبون عن خطيتهم، أو ينوحون لذلك يأساً في يوم الدين (رؤيا ١: ٧).
والمقصود أيضاً من تلك النبوة أن المؤمنين في كل عصر ينظرون بالإيمان إلى جنب المسيح المجروح لأجلهم، برهاناً على محبته لهم محبة تفوق الوصف، وعلى كمال الفداء الذي أتى به لأجلهم.
الدفن (ع ٣٨ - ٤٢)
٣٨ «ثُمَّ إِنَّ يُوسُفَ الَّذِي مِنَ الرَّامَةِ، وَهُوَ تِلمِيذُ يَسُوعَ، وَلَكِنْ خُفْيَةً لِسَبَبِ الخَوْفِ مِنَ اليَهُودِ، سَأَلَ بِيلاطُسَ أَنْ يَأْخُذَ جَسَدَ يَسُوعَ، فَأَذِنَ بِيلاطُسُ. فَجَاءَ وَأَخَذَ جَسَدَ يَسُوعَ».
متّى ٢٧: ٥٧ ومرقس ١٥: ٤٣ ولوقا ٢٣: ٥٠ ويوحنا ٩: ٢٢ و١٢: ٤٢
سبق الكلام على دفن يسوع في شرح متّى ٢٧: ٥٧ - ٦١ ومرقس ١٥: ٤٢ - ٤٧.
يُوسُفَ كان رجلاً غنياً وتلميذاً للمسيح (متّى ٢٧: ٥٧) ومشيراً شريفاً ينتظر ملكوت الله (مرقس ١٥: ٤٣) وصالحاً باراً لم يوافق اليهود في رأيهم وعملهم (لوقا ٢٣: ٥٠، ٥١). وزاد يوحنا على ما قاله سائر البشيرين أنه كان تلميذ يسوع خفية.
سَأَلَ بِيلاطُسَ أظهر شجاعة ومحبة بهذا الفعل.
فَأَذِنَ بِيلاطُسُ بعد أن تحقق موت يسوع من القائد (مرقس ١٥: ٤٤، ٤٥).
٣٩ «وَجَاءَ أَيْضاً نِيقُودِيمُوسُ، الَّذِي أَتَى أَوّلا إِلَى يَسُوعَ لَيْلا، وَهُوَ حَامِلٌ مَزِيجَ مُرٍّ وَعُودٍ نَحْوَ مِئَةِ مَناً».
يوحنا ٣: ١ و٢ و٧: ٥٠ خروج ٣٠: ٢٣ وأستير ٢: ١٢ وأمثال ٧: ١٧ ونشيد الأنشاد ٣: ٦
نِيقُودِيمُوسُ انظر شرح يوحنا ٣: ١ و٧: ١٠. ولم يذكره ويذكر مشاركته ليوسف في دفن المسيح سوى يوحنا.
الَّذِي أَتَى أَوَّلاً أي في بدء خدمة المسيح (يوحنا ٣: ١).
مُرٍّ وَعُودٍ الأول راتينج والثاني خشب، وكلاهما طيّب الرائحة، غالي الثمن، يحنط بهما لمنع الفساد (مزمور ٤٥: ٨). وكانت طريقة استعمالهما في التحنيط أنهم يسحقونهما ويضعون مسحوقهما على جثة الميت ويلفونها بلفائف تحيط بالجسد كله (٢أيام ١٦: ١٤).
مِئَةِ مَناً أي لتراً (يوحنا ١٢: ٣) وهو وزن يوناني روماني يعدل نحو ١١٥ درهماً، فمبلغ المئة نحو تسع وعشرين أقّة.
٤٠ «فَأَخَذَا جَسَدَ يَسُوعَ، وَلَفَّاهُ بِأَكْفَانٍ مَعَ الأَطْيَابِ، كَمَا لِليَهُودِ عَادَةٌ أَنْ يُكَفِّنُوا».
أعمال ٥: ٦
لَفَّاهُ بِأَكْفَانٍ من كتّان اشتراه يوسف (مرقس ١٥: ٤٦ ولوقا ٢٣: ٥٣).
كَمَا لِليَهُودِ عَادَةٌ أَنْ يُكَفِّنُوا (يوحنا ١١: ٤٤). هذا من الأدلة على أن يوحنا كتب بشارته لكل أمة، وكثيرون منهم يجهلون عوائد اليهود.
قدم المجوس الهدايا من الذهب والأطياب الثمينة للمسيح ليكرموه عند ميلاده. وقدم له غني ومشير الكتان والأطياب والخدمة والقبر ليكرماه عند دفنه.
٤١ «وَكَانَ فِي المَوْضِعِ الَّذِي صُلِبَ فِيهِ بُسْتَانٌ، وَفِي البُسْتَانِ قَبْرٌ جَدِيدٌ لَمْ يُوضَعْ فِيهِ أَحَدٌ قَطُّ».
انظر شرح متّى ٢٧: ٦٠. اقتضت الحال أن يكون القبر قريباً لينتهوا من دفنه قبل المغرب، واقتضت أن يكون القبر لأحد المهتمين بدفنه ليحق لهم أن يدفنوه فيه. وبيّنت لنا بشارة يوحنا قرب القبر، وبيّن غيره من كاتبي البشائر أن القبر كان ليوسف. وزاد بعضهم أن القبر كان منحوتاً في صخرة (متّى ٢٨: ٦٠). فلم يكن له إلا مدخل واحد هو الباب الذي كان في حراسة الحراس.
قَبْرٌ جَدِيدٌ هذا يوافق قول لوقا «وَضَعَهُ فِي قَبْرٍ مَنْحُوتٍ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ وُضِعَ قَطُّ» (لوقا ٢٣: ٥٣). وهذا يمنع توهّم أن الذي قام غير يسوع. وهو يليق بمقام يسوع الملكي.
٤٢ «فَهُنَاكَ وَضَعَا يَسُوعَ لِسَبَبِ اسْتِعْدَادِ اليَهُودِ، لأنَّ القَبْرَ كَانَ قَرِيباً».
إشعياء ٥٣: ٩ ع ٣١
اسْتِعْدَادِ اليَهُودِ أي يوم الجمعة (انظر شرح ع ١٤، ٣١). ويلزم من هذا القول أن الدفن كان بسرعة، وأنه كان مقدمة لعمل آخر بعد مرور السبت (كما يتبيّن من مرقس ١٦: ١ ولوقا ٢٣: ٥٦). والدافع على تلك السرعة يتبيّن من اعتبارنا أن المسيح مات الساعة التاسعة، فاضطروا أن يكملوا دفنه قبل الساعة الثانية عشرة (السادسة مساءً بتوقيتنا) التي هي أول يوم السبت. فإذا عرفنا أن يوسف يحتاج أن يذهب إلى بيلاطس ويستأذنه في دفن يسوع، وأن يهيئ الكتان والأطياب مع نيقوديموس، ثم يُنزل الجسد ويلفه بالأكفان ويحمله إلى القبر، ويدحرج الحجر على بابه. وإذا رأينا أن الوقت كان قصيراً بالنظر إلى إتمام ذلك، فاقتضت الحال أن يسرعوا. كان دفن يسوع في القبر نهاية تواضعه الذي احتمله لأجلنا، وهذا تنازل عظيم ممن هو رب الحياة.
نزع مكث يسوع في القبر ظلمة القبر وهوله، لأنه وإن دخله أسيراً للموت فقد قام منه منتصراً على الموت انتصاراً ليس لنفسه فقط، بل لكل شعبه أيضاً (١كورنثوس ١٥: ٥٦).
الأصحاح العشرون
مجيء مريم المجدلية وبطرس ويوحنا إلى القبر بعد القيامة (ع ١ - ١٠)
١ «وَفِي أَوَّلِ الأُسْبُوعِ جَاءَتْ مَرْيَمُ المَجْدَلِيَّةُ إِلَى القَبْرِ بَاكِراً، وَالظّلامُ بَاقٍ. فَنَظَرَتِ الحَجَرَ مَرْفُوعاً عَنِ القَبْرِ».
متّى ٢٨: ١ ومرقس ١٦: ١ ولوقا ٢٤: ١
شغل يوحنا الأصحاحين الأخيرين من بشارته بظهور يسوع بعد قيامته، وذكر فيهما ما لم يذكره غيره من البشيرين. والقيامة من جوهريات المسيحية لأنها من أعظم البراهين على أن يسوع هو المسيح الموعود به في نبوات العهد القديم. وهي المعجزة التي أعطاها لليهود إثباتاً لصحة دعواه (متّى ١٢: ٣٩ ويوحنا ٢: ١٩ - ٢١) وهي تصديق الله على تلك الدعوى. وهي كمال عمل الفداء، والبرهان على أن كفارته للخطاة قُبلت، وعلى أنه أوفى الدَّين عنهم (رومية ٤: ٢٥ و١بطرس ١: ٣). وهي عربون قيامة المؤمنين. وسبق الكلام في البراهين على صحة قيامة المسيح وفي ظهوره عشر مرات لتلاميذه في شرح متّى ٢٨: ١٧.
فِي أَوَّلِ الأُسْبُوعِ أي يوم الأحد الذي اتخذه المسيحيون من ذلك الوقت يوم العبادة، تذكاراً لقيامة المسيح، وسُمي «يوم الرب» (رؤيا ١: ١٠) والأرجح أنهم فعلوا ذلك طاعةً لأمر المسيح.
مضى بين نهاية أصحاح ١٩ وبدء أصحاح ٢٠ ما حسبه الكتاب ثلاثة أيام، وهو يوم كامل وجزءان من يومين. وكان جسد المسيح في ذلك الوقت مضطجعاً في القبر والعسكر حارساً، والتلاميذ يائسين، واليهود مبتهجين إلى صباح اليوم الثالث. وترك يوحنا ذكر ختم القبر ووضع الحراس (متّى ٢٧: ٦٢ - ٦٦) والزلزلة وإتيان النساء ودحرجة الحجر وخوف الحراس (متّى ٢٨: ٢ - ٤).
جَاءَتْ مَرْيَمُ المَجْدَلِيَّةُ انظر شرح متّى ٢٨: ١. هي لم تأت وحدها بل أتت أيضاً مريم أم يوسي وسالومي ويونّا ونساء أُخر من الجليل، وكنّ واقفات قرب الصليب عند موته، والأرجح أنهنّ اتفقن على الاجتماع عند القبر بعد السبت لإكمال فرائض الدفن الذي لم يستطعنه يوم الجمعة. ولا يلزم افتراض أن أولئك النساء جئن معاً. وخص يوحنا مريم بالذكر لأنها معروفة أكثر من الباقيات، ولأن المسيح ظهر لها أولاً.
بَاكِراً، وَالظّلامُ بَاقٍ قال مرقس «إذ طلعت الشمس» فالأرجح أن بعضهن سبق بعضاً، وذكر يوحنا من سبق منهن.
فَنَظَرَتِ الحَجَرَ مَرْفُوعاً عَنِ القَبْرِ ذكر البشيرون الأربعة أن النساء وجدن الحجر مرفوعاً. والظاهر أن مريم والنساء الباقيات لم يكنَّ يعرفن وضع حراس هناك. ولو عرفن ذلك ما عزمن على الاجتماع عند القبر قبل طلوع الشمس. والأرجح أن مريم لم تبلغ عند القبر بل نظرت بابه مفتوحاً، واستنتجت أن جسد يسوع أُخذ منه فعدلت عن الاقتراب منه.
٢ «فَرَكَضَتْ وَجَاءَتْ إِلَى سِمْعَانَ بُطْرُسَ وَإِلَى التِّلمِيذِ الآخَرِ الَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ، وَقَالَتْ لَهُمَا: أَخَذُوا السَّيِّدَ مِنَ القَبْرِ وَلَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ».
يوحنا ١٣: ٢٣ و١٩: ٢٦ و٢١: ٢٠، ٢٤
فَرَكَضَتْ وَجَاءَتْ إِلَى سِمْعَانَ بُطْرُسَ وَإِلَى التِّلمِيذِ الآخَرِ أي رجعت مسرعة إلى المدينة تاركة رفيقاتها اللواتي لم يرجعن إلا بعد حين. والمقصود «بالتلميذ الآخر» يوحنا (يوحنا ١٣: ٢٢) وعلة ذهابها إلى بطرس ويوحنا دون غيرهما أنهما متقدمان بين الرسل في الغيرة والإيمان والمحبة، وأنهما أكثر اهتماماً بأمر يسوع من غيرهما. ولعل السبب أيضاً أن أم يسوع في بيت يوحنا، فرغبت في إخبارها.
أَخَذُوا السَّيِّدَ أي أناس مجهولون. وهي لم تستطع أن ترى علة لرفع الحجر سوى أخذ الجسد وإخفائه. واتضح من كلامها أنه لم يخطر على بالها أن المسيح قام، وأنها لم تنظر الملاك الذي ظهر لغيرها من أولئك النساء وقال «ليس هو ههنا لأنه قام» (متّى ٢٨: ٥، ٦).
وَلَسْنَا نَعْلَمُ هذا يدل على أنها لم تأت وحدها إلى القبر.
٣ «فَخَرَجَ بُطْرُسُ وَالتِّلمِيذُ الآخَرُ وَأَتَيَا إِلَى القَبْرِ».
لوقا ٢٤: ١٢
تأثر التلميذان من هذا الخبر فأسرعا يفحصان الأمر، لأنهما لا بد سألا مريم: هل نظرت ما بداخل القبر لتعلم هل أُخذ الجسد حقيقة؟ فقالت: لا، فجريا إلى القبر لإزالة كل شك.
٤ «وَكَانَ الاثْنَانِ يَرْكُضَانِ مَعاً. فَسَبَقَ التِّلمِيذُ الآخَرُ بُطْرُسَ وَجَاءَ أَوَّلا إِلَى القَبْرِ».
فَسَبَقَ التِّلمِيذُ الآخَرُ بُطْرُسَ الأرجح أن يوحنا كان أصغر سناً من بطرس ولذلك سبقه، فلا يلزم من سبقه أنه كان أكثر غيرة من بطرس، لأن بطرس خرج أولاً من البيت (ع ٣) وكان الأول في دخول القبر (ع ٦).
٥ «وَانْحَنَى فَنَظَرَ الأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَدْخُل».
يوحنا ١٩: ٤٠
وَانْحَنَى لأن الباب كان قصيراً، وقد جرت العادة أن تكون أبواب القبور كذلك لتسهيل سده بالحجر.
فَنَظَرَ الأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً فتحقق من ذلك أن الجسد ليس في القبر. ولا بد أنه تعجب من أن الذي أخذ الجسد لم يأخذ الأكفان معه اقتصاداً للوقت والتعب.
لَكِنَّهُ لَمْ يَدْخُل لخوفه أو احترامه أو شدة حزنه لفقدانه سيده، ولعله انتظر وصول رفيقه قبل أن يدخل.
٦، ٧ «٦ ثُمَّ جَاءَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَتْبَعُهُ، وَدَخَلَ القَبْرَ وَنَظَرَ الأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً، ٧ وَالمِنْدِيلَ الَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ لَيْسَ مَوْضُوعاً مَعَ الأَكْفَانِ، بَل مَلفُوفاً فِي مَوْضِعٍ وَحْدَهُ».
يوحنا ١١: ٤٤
وَدَخَلَ القَبْرَ عُرف بطرس بالسرعة والجسارة. فنظر ما لم يره يوحنا، وهو أن المنديل كان ملفوفاً موضوعاً على حدة، دلالة على أن الذي حدث في القبر كان بكل تأنٍ ونظام، وأنه لم يأخذه أصحابه، وإلا أخذوه بأكفانه، ولم يسرقه أعداؤه لأنهم لو سرقوه لأخذوا الأكفان أيضاً. أو لو تركوها ما طووها ووضعوها بالترتيب، كل كفن في مكان. فتحير بطرس من كل ما رأى.
٨ «فَحِينَئِذٍ دَخَلَ أَيْضاً التِّلمِيذُ الآخَرُ الَّذِي جَاءَ أَوَّلا إِلَى القَبْرِ، وَرَأَى فَآمَنَ».
شجع دخول بطرس القبر أولاً يوحنا ليفعل مثله، فعرف مما شاهده أن جسد الرب لم يُسرق.
وَرَأَى فَآمَنَ بأن يسوع قد قام، وأنه حيّ لا محالة، وأنه هو المسيح ابن الله. وزالت كل الشكوك التي اعترته مما شاهده من القبض على المسيح وصلبه ودفنه. واتضح مما ذُكر أن يوحنا كان أول من آمن من الناس بقيامة المسيح.
٩ «لأنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بَعْدُ يَعْرِفُونَ الكِتَابَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ مِنَ الأَمْوَاتِ».
مزمور ١٦: ١٠ وأعمال ٢: ٢٥ - ٣١ و١٣: ٣٤، ٣٥
قال البشير ذلك بياناً لعلة جهله وجهل سائر التلاميذ بنبوات الكتاب المقدس المتعلقة بقيامة المسيح.
لأنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بَعْدُ أي إلى وقت كونه في القبر قبل أن شاهد أحد المسيح بعد قيامته.
يَعْرِفُونَ الكِتَابَ أي النبوات المتعلقة بموت المسيح وقيامته، ومنها ما في مزمور ١٦: ١٠ وإشعياء ٥٣: ١٠. (انظر شرح لوقا ٢٤: ٢٨، ٤٨). ومنعهم جهلهم بمعنى تلك النبوات من فهم كلام المسيح يوم أنبأهم أنه يقوم في اليوم الثالث، ومنعهم من أن يتوقعوا قيامته حتى أنهم لم ينتبهوا حالاً لذلك لما رأوا القبر مفتوحاً ولم يروا جسده فيه. ولم ينبئنا البشير هل آمن بطرس مما رأى أو لا. الأرجح أنه لم يكن قد آمن، وإلا لذكر ذلك كما ذكر إيمان نفسه على أنه آمن بذلك بعد بضع ساعات من النهار عينه حين ظهر المسيح له (لوقا ٢٤: ٣٤ و١كورنثوس ١٥: ٥).
١٠ «فَمَضَى التِّلمِيذَانِ أَيْضاً إِلَى مَوْضِعِهِمَا».
رجعا معاً إلى مسكنهما في المدينة بعد ما تحققا بالمشاهدة ما أنبأتهما به مريم المجدلية من أن القبر مفتوح والجسد مأخوذ، ولم يريا من فائدة لبقائهما هناك. ولعلهما خافا من أن اليهود إذا وجدوهما عند القبر، وعرفوا أن جسد يسوع مأخوذ، يتهمونهما بسرقته. ولا بد أن الرسولين تحاورا على الطريق بما يمكن أن يكون قد حدث ليسوع، فقال يوحنا «إنه قام» وقال بطرس «لا بل أنه سُرق».
ظهور يسوع لمريم المجدلية (ع ١١ - ١٨)
١١ «أَمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتْ وَاقِفَةً عِنْدَ القَبْرِ خَارِجاً تَبْكِي. وَفِيمَا هِيَ تَبْكِي انْحَنَتْ إِلَى القَبْرِ».
مرقس ١٦: ٥
أَمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتْ وَاقِفَةً عِنْدَ القَبْرِ فإذاً لا بد أنها رجعت إلى القبر بعدما أخبرتهما في البيت (ع ٢) لكنها لم تستطع أن تجري، ولم تقتنع كما اقتنع يوحنا من مشاهدة الأكفان مطويّة والمنديل ملفوفاً وموضوعاً وحده. وبقيت تتوقع معرفة شيء آخر مما يتعلق بجسد المسيح، مع أنها انحنت ونظرت ما نظراه.
١٢ «فَنَظَرَتْ ملاكَيْنِ بِثِيَابٍ بِيضٍ جَالِسَيْنِ وَاحِداً عِنْدَ الرَّأْسِ وَالآخَرَ عِنْدَ الرِّجْلَيْنِ، حَيْثُ كَانَ جَسَدُ يَسُوعَ مَوْضُوعاً».
فَنَظَرَتْ ملاكَيْنِ هما ملاكان حقيقة، ولذلك دعاهما يوحنا كذلك. لكنهما ظهرا في صورة الناس ولذلك سماهما مرقس ولوقا «رجلين». ولا منافاة بين إنباء يوحنا بظهور ملاكين لمريم وإنباء متّى بظهور ملاك واحد لغيرها من النساء (متّى ٢٨: ٥) لأن ذلك حدث وهي غائبة لتنبئ الرسولين، وهذا بعد انصراف أولئك النساء. ومن العجيب أن مريم لم تستغرب رؤية الملاكين، ولم تخف منهما. وعلّة ذلك أن شدة حزنها ورغبتها في الفحص عن جسد المسيح شغلت كل أفكارها ومنعتها أن تنتبه لغرابة ذلك الأمر.
١٣ «فَقَالا لَهَا: يَا امْرَأَةُ، لِمَاذَا تَبْكِينَ؟ قَالَتْ لَهُمَا: إِنَّهُمْ أَخَذُوا سَيِّدِي وَلَسْتُ أَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ».
لِمَاذَا تَبْكِينَ لم يسألاها لجهلهما السبب بل لينبهاها على أن لا داعٍ للبكاء، وأنها يجب أن تفرح لمشاهدتها القبر مفتوحاً، لأنه دليل على قيامة من تبكيه. وكثيراً ما يحق للملائكة أن يسألونا: «لماذا تبكون؟» عندما يروننا ننوح على من نفقدهم من الأصدقاء وهم أحياء عند الله.
أَخَذُوا سَيِّدِي جوابها للملاكين كإنبائها للرسولين (ع ٢). فكل ما خطر على بالها أن الجسد أُخذ، وهي تريد أن تراه. والعجيب أن القيامة لم تخطر لها على بال.
١٤ «وَلَمَّا قَالَتْ هَذَا التَفَتَتْ إِلَى الوَرَاءِ، فَنَظَرَتْ يَسُوعَ وَاقِفاً، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ يَسُوعُ».
متّى ٢٨: ٩ ومرقس ١٦: ٩ ولوقا ٢٤: ١٦، ٢١ ويوحنا ٢١: ٤
التَفَتَتْ إِلَى الوَرَاءِ لم نعلم علة التفاتها وقطعها الحديث مع الملاكين، ولعلها يئست من الإفادة منهما، فاستدارت لتذهب.
وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ يَسُوعُ علة جهلها أنه يسوع عدم توقعها رؤيته، وما حدث من التغيّر في هيئته (مرقس ١٦: ١٢) أو لعل عينيها أُمسكتا عن معرفته، كما أُمسكت عيون المسافرَيْن إلى عمواس في آخر ذلك النهار (لوقا ٢٤: ١٦).
١٥ «قَالَ لَهَا يَسُوعُ: يَا امْرَأَةُ، لِمَاذَا تَبْكِينَ؟ مَنْ تَطْلُبِينَ؟ فَظَنَّتْ تِلكَ أَنَّهُ البُسْتَانِيُّ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا سَيِّدُ، إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ حَمَلتَهُ فَقُل لِي أَيْنَ وَضَعْتَهُ، وَأَنَا آخُذُهُ».
لِمَاذَا تَبْكِينَ؟ مَنْ تَطْلُبِينَ؟ لا يخلو هذا الكلام من التنبيه على خطئها بالبكاء، فكأنه قال لها «قد أخطأت بطلبك الحي بين الموتى، ونسيانك نبوته أنه سيقوم بعد ثلاثة أيام».
ظَنَّتْ تِلكَ أَنَّهُ البُسْتَانِيُّ علة ظنها ذلك اعتقادها أنه غريب عنها، وعدم تصورها علة وجود إنسان في البستان في مثل ذلك الوقت ما لم يكن هو البستاني. أو لعل الثياب التي اتخذها كانت تشبه ما يلبسه البستاني.
فَقُل لِي تصورت أن البستاني نقل جسد يسوع من مكانه إلى مكان آخر لغرض من الأغراض، ووعدت على فرض ذلك بما لا تستطيعه وحدها، وهو أن تأخذ جسده. والأرجح أنها قصدت أن تأتي بأصدقاء لينقلوه إلى قبر آخر. ولم تذكر اسم يسوع وهي تخاطب من ظنته البستاني، لكنها أشارت إليه بضمير الغائب في قولها «حملتَه» و «وضعته» و «أخذته» كأنه ليس في العالم إنسان سوى يسوع المفقود.
١٦ «قَالَ لَهَا يَسُوعُ: يَا مَرْيَمُ! فَالتَفَتَتْ تِلكَ وَقَالَتْ لَهُ: «رَبُّونِي» الَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا مُعَلِّمُ».
خاطبها يسوع بكلمة واحدة هي اسمها، ونطقه بلهجته المعهودة وهو يدعوها إلى تعليمه، فعرفت الصوت وعلمت في الحال أن المتكلم هو يسوع.
فَالتَفَتَتْ تِلكَ كأنها كانت مُطرِقة وهي تخاطبه قبل ذلك.
رَبُّونِي كلمة عبرانية معناها: يا معلم، أو يا سيدي (مرقس ١١: ٥١). أظهرت مريم بهذه الكلمة أنها عرفته وابتهجت به وأكرمته كل الإكرام.
١٧ «قَالَ لَهَا يَسُوعُ: لا تَلمِسِينِي لأنِّي لَمْ أَصْعَدْ بَعْدُ إِلَى أَبِي. وَلَكِنِ اذْهَبِي إِلَى إِخْوَتِي وَقُولِي لَهُمْ: إِنِّي أَصْعَدُ إِلَى أَبِي وَأَبِيكُمْ وَإِلَهِي وَإِلَهِكُمْ».
مزمور ٢٢: ٢٢ ومتّى ٢٨: ١٠ ورومية ٨: ٢٩ وعبرانيين ٢: ١١ ويوحنا ١٦: ٢٨ أفسس ١: ١٧
لا تَلمِسِينِي الأرجح أنها كانت عازمة على أن تمسك قدميه إظهاراً لابتهاجها وشكرها ورغبتها في أن تسجد له باعتباره مخلصها الذي قام من الموت، كما فعلت المرأتان المذكورتان في متّى ٢٨: ٩. ولا نعلم لماذا منعها يسوع من ذلك بينما سمح لتينك المرأتين. وأمر تلاميذه في تلك الليلة أن يلمسوه بقوله «جسوني» (لوقا ٢٤: ٣٨) وقوله لتوما بعد أسبوع «هَاتِ يَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنْبِي» (يوحنا ٢٠: ٢٧) ليزيل شكهم في قيامته، وليبرهن لهم أنه لحم وعظم لا روح، ولم يكن لمريم من حاجة إلى ذلك. ولعله قصد بقوله «لا تلمسيني»: لا تتعوقي بأن تمسكيني، بل اسرعي إلى تلاميذي ببشرى قيامتي. أو لا تمسكي بي متوهمة أن هذه الفرصة الوحيدة التي ترينني فيها قبل أن أرجع إلى أبي. وربما قصد أن يبيّن لها أنه بعد قيامته ليس كما كان قبلها، وأن الطريق لإكرام تلاميذه له تغيّرت، وأن مخالطته بعد ذلك لا تكون إلا روحية حسب قول الرسول «وَإِنْ كُنَّا قَدْ عَرَفْنَا المَسِيحَ حَسَبَ الجَسَدِ، لَكِنِ الآنَ لا نَعْرِفُهُ بَعْدُ» (٢كورنثوس ٥: ١٦).
لأنِّي لَمْ أَصْعَدْ بَعْدُ إِلَى أَبِي أي لن أصعد الآن من هذا العالم إلى أبي، إتماماً لكم قبل موتي. وقال ذلك لأنه سيبقى معهم أربعين يوماً قبل صعوده، ولهذا كان لها ولغيرها من التلاميذ وقت كافٍ لمشاهدته وإكرامه.
لَكِنِ اذْهَبِي بدلاً من أن تمسكيني.
إِلَى إِخْوَتِي سمّاهم قبلاً عبيداً، ثم سمّاهم تلاميذ، ثم أحباء، وزاد ذلك هنا أن سماهم «إخوة» فأظهر بذلك أن محبته لهم لا تزال شديدة، مع أنهم منذ أقل من ثلاثة أيام تركوه وهربوا وشكوا فيه، وأنه لم يزل بعد قيامته مشتركاً في طبيعتنا البشرية أخاً لنا وواحداً منا.
قُولِي لَهُمْ أول قصدٍ قصده بعد قيامته تعزية تلاميذه، وتجديد إيمانهم، وإحياء رجائهم. وأكرم يسوع مريم بأنه جعلها رسوله، فذهابها تبشر بقيامته خدمة للمسيح ولإخوته المؤمنين، وهما بركة أعظم من أن تقع على قدميه عبادة له، وأفضل طريق لإظهار محبتها له.
إِنِّي أَصْعَدُ إِلَى أَبِي أي سأصعد (ولم يقل إني قمت) لئلا تظن أنه عازم على البقاء في هذه الأرض. وأشار بصعوده إلى السماء أنه يسبقهم إلى هناك، وأنه يشفع فيهم رئيس أحبار لهم.
وَأَبِيكُمْ لأنكم إخوتي. أبوّة الله لهم ليست بمعنى أبوته للمسيح، وإلا لقال: أصعد إلى أبينا، لأن الله أبونا بالنعمة والتبني ولأننا إخوة للمسيح. والمسيح ليس كذلك، لأن الله أبوه لكونه ابن الله منذ الأزل. والله إلهه لأنه صار ابن الإنسان لخلاص البشر. وفي هذا تعزية عظيمة لتلاميذه لما فيه من بيان قوة الاتحاد بينه وبينهم، وهي أن أباه وأباهم واحد. فإذاً هم شركاء محبته وموعودون بالاجتماع في بيته السماوي.
١٨ «فَجَاءَتْ مَرْيَمُ المَجْدَلِيَّةُ وَأَخْبَرَتِ التّلامِيذَ أَنَّهَا رَأَتِ الرَّبَّ، وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هَذَا».
متّى ٢٨: ١٠ ولوقا ٢٤: ١٠
فَجَاءَتْ مَرْيَمُ المَجْدَلِيَّةُ وَأَخْبَرَتِ أطاعت مريم المسيح بدون اعتراض. ولا شك أن بشارتها ملأت قلوبهم عزاءً ورجاءً. والأرجح أن المسيح التقى بعد ذهابها بالمرأتين المذكورتين في متّى ٢٨: ٩.
ظهور يسوع لتلاميذه أولاً (ع ١٩ – ٢٥)
١٩ «وَلَمَّا كَانَتْ عَشِيَّةُ ذَلِكَ اليَوْمِ، وَهُوَ أَوَّلُ الأُسْبُوعِ، وَكَانَتِ الأَبْوَابُ مُغَلَّقَةً حَيْثُ كَانَ التّلامِيذُ مُجْتَمِعِينَ لِسَبَبِ الخَوْفِ مِنَ اليَهُودِ، جَاءَ يَسُوعُ وَوَقَفَ فِي الوَسَطِ، وَقَالَ لَهُمْ: سلامٌ لَكُمْ».
مرقس ١٦: ١٤ ولوقا ٢٤: ٣٦ و١كورنثوس ١٥: ٥
ذَلِكَ اليَوْمِ أي يوم الأحد (انظر شرح مرقس ١٤: ١٦ ولوقا ٢٤: ٣٣ - ٤٣). وهذا ظهور المسيح الأول لكل التلاميذ، لكنه الخامس بالنظر إلى ظهوره لبعضهم، وأولهم مريم المجدلية (ع ١٦). والثاني لرفيقتين لها (متّى ٢٨: ٩). والثالث لبطرس ( ١كورنثوس ١٥: ٥). والرابع للتلميذين الذاهبين إلى عمواس (لوقا ٢٤: ١٣). والخامس ما ذُكر هنا. وبين حوادث ع ١٨، ١٩ أمور لم يذكرها يوحنا، وهي رشوة الحراس (متّى ٢٨: ١١ - ١٥) وظهور المسيح لبطرس وللتلميذين المسافرين إلى عمواس.
وَكَانَتِ الأَبْوَابُ مُغَلَّقَةً خاف التلاميذ أن يعاملهم اليهود كما عاملوا يسوع بغضاً، ولذلك اجتمعوا سراً. ولعلهم سمعوا أن اليهود قالوا «بسرقة تلاميذه ليلاً» فخافوا أن تطلبهم الحكومة وتعاقبهم. وقد أنبأهم يسوع بأنهم يُضطهَدون ويكونون كغنم تتبدد بعد ضرب الراعي، فلا عجب من أنهم خافوا. ولم يذكر البشير سبب اجتماعهم، ولكن لا شك أنه كان ليتحاوروا في حوادث النهار، وفيما أُنبئوا به من أن القبر خلا من الجسد، ومن مشاهدة الملائكة، ومشاهدة بعضهم للمسيح. ولعلهم اجتمعوا للعبادة وسؤال الله الحماية والإرشاد. ولم يذكر البشير موضع اجتماعهم، لكن نعلم أنه كان في أورشليم. والأرجح أنه كان في العلية التي أكلوا فيها الفصح مع سيدهم (مرقس ١٤: ١٣ - ١٥) وكان المجتمعون عشرة رسل مع بعض المؤمنين (لوقا ٢٤: ٣٣).
جَاءَ يَسُوعُ وَوَقَفَ فِي الوَسَطِ انظر شرح لوقا ٢٤: ٣٦. لا يلزم من الكلام هنا أنه دخل بدون فتح الباب، فليس من عادته أن يفعل معجزة عظيمة جداً لغير ضرورة. وقصد أن يبرهن للتلاميذ أن له جسداً مادياً حقيقياً، لا مجرد روح، فدخوله دون أن يفتح الباب يخالف قصده. فيجب أن نفهم من هذا أنه دخل بغتة، إما بفتح الباب بسلطانه، أو بطلبه إليهم. والأرجح الأول. ولا نريد بذلك أنه لم يكن في ظهوره بغتة وباختفائه كذلك شيء من المعجزات.
سلامٌ لَكُمْ انظر شرح لوقا ٢٤: ٣٦. غاية المسيح من هذا أن يبيّن لهم محبته وغفرانه وشفقته عليهم، فلم يوبخهم على تركهم إيّاه وجبنهم وشكوكهم، بل وهب لهم الاطمئنان بتحية اعتادوها، كما فعل بمناداته مريم باسمها. وهو موافق لقوله لهم في خطابه الوداعي ليلة الجمعة «سلاماً أَتْرُكُ لَكُمْ. سلامِي أُعْطِيكُمْ» (يوحنا ١٤: ٢٧). لكن السلام الثاني أعظم من الأول، لأنه قاله بعد ما دخل القبر وغلب الموت لأجلهم، ورجع إليهم من عالم الأرواح حاملاً بشرى السلام لهم، فإنه صالح بموته العالم مع الله، ورجع إلى تلاميذه ببشارة المصالحة والسلام.
٢٠ «وَلَمَّا قَالَ هَذَا أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَجَنْبَهُ، فَفَرِحَ التّلامِيذُ إِذْ رَأَوُا الرَّبَّ».
يوحنا ١٦: ٢٢
أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَجَنْبَهُ ليبيّن لهم أنه هو يسوع الذي تألم ومات على الصليب، وأنه قام بجسده نفسه، وأنه ليس مجرد روح، وليس بجسد ممجد (انظر شرح لوقا ٢٤: ٣٩) وعدم ذكره الرِّجلين لا يعني أنهما لم يُسمرا، لأن لوقا ذكر أن يسوع أراهم رجليه.
فَفَرِحَ التّلامِيذُ تحقوا من مشاهدتهم الجروح أنه هو يسوع عينه، وأنه ليس روحاً، ففرحوا، وكان هذا تحقيقاً لوعده «سَأَرَاكُمْ أَيْضاً فَتَفْرَحُ قُلُوبُكُمْ» (يوحنا ١٦: ٢٢). فمشاهدته أنعشتهم وجددت آمالهم وعزت قلوبهم وبددت شكوكهم ومخاوفهم. وذكر يوحنا خطاب يسوع لتلاميذه وقتئذ ما يوافق غايته بإلهام الروح القدس. وذكر لوقا غير ما ذكره يوحنا من تلك المخاطبة (لوقا ٢٨: ٣٦ - ٤٣).
فإذا كانت مشاهدة المسيح على الأرض علة فرح كهذا، فكم يكون فرح المؤمنين بمشاهدتهم إيّاه في السماء.
٢١ «فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضاً: سلامٌ لَكُمْ. كَمَا أَرْسَلَنِي الآبُ أُرْسِلُكُمْ أَنَا».
متّى ٢٨: ١٨ ويوحنا ١٧: ١٨، ١٩ و٢تيموثاوس ٢: ٢ وعبرانيين ٣: ١، ٢
سلامٌ لَكُمْ كرر التحية لزيادة التأكيد. وهذا يشبه قول يوسف لفرعون «وَأَمَّا عَنْ تَكْرَارِ الحُلمِ عَلَى فِرْعَوْنَ مَرَّتَيْنِ، فَلأنَّ الأَمْرَ مُقَرَّرٌ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ» (تكوين ٤١: ٣٢).
كَمَا أَرْسَلَنِي الآبُ أُرْسِلُكُمْ أَنَا انظر شرح يوحنا ١٧: ١٨. يسوع هو رسول الله الوحيد لعمل الفداء (عبرانيين ٣: ١) وقد جعل تلاميذه سفراءه وشركاءه في المناداة ببشرى الخلاص (يوحنا ١٨: ٣٧ و٢كورنثوس ٥: ١٨). المسيح أخذ من الله كلمة المصالحة وأعطاها تلاميذه لينادوا بها (٢كورنثوس ٥: ٢٠) فصار عليهم أن يخبروا العالم بأن الله مستعد أن يقبلهم ويغفر لهم ويصالحهم. وكما أنه أرسلهم ليشهدوا كما شهد هو كان عليهم أن يحتملوا المشقات والاضطهاد كما احتملها هو. فإذاً لم يكن لهم أن يتوقعوا الراحة والأمن من رجوع سيدهم إليهم، لأنه عازم أن يتركهم ويرجع إلى أبيه، وهم ينوبون عنه في عمله على الأرض.
٢٢ «وَلَمَّا قَالَ هَذَا نَفَخَ وَقَالَ لَهُمُ: اقْبَلُوا الرُّوحَ القُدُسَ».
يليق بالذي يرسل رسلاً أن يعطيهم قوة لينشروا رسالته. والمسيح أعطى رسله القوة بهبته الروح القدس لهم.
نَفَخَ قرن الهبة بالإشارة الموافِقة، وقد أشار الكتاب المقدس «بالريح» إلى الروح القدس (حزقيال ٣٧: ٩ ويوحنا ٣: ٨ وأعمال ٢: ٢). ولعل المشابهة هنا مبنيّة على ما جاء في سفر التكوين وهو قوله «جَبَلَ الرَّبُّ الإِلَهُ آدَمَ تُرَاباً مِنَ الأَرْضِ، وَنَفَخَ فِي أَنْفِهِ نَسَمَةَ حَيَاةٍ. فَصَارَ آدَمُ نَفْساً حَيَّةً» (تكوين ٢: ٧) فكما كان النفخ في خلق آدم إشارة إلى هبة الحياة الجسدية كان هنا إشارة إلى هبة الحياة الروحية.
اقْبَلُوا الرُّوحَ القُدُسَ كأنه قال «أنا أعطيكم الروح القدس». فلا يلزم من ذلك أنهم لم ينالوا قبلاً شيئاً من تأثير ذلك الروح، وإلا ما أمكنهم أن يؤمنوا، إذ لا يقدر أحد أن يؤمن بدون روح الله.
ويجب أن لا نحكم من قوله إنهم نالوا إتمام وعد المسيح لهم بذلك الروح (يوحنا ٧: ٣٨، ٣٩ و١٦: ٧) لأنهم لم ينالوا ذلك إلا يوم الخمسين حين امتلأوا من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بألسنة مختلفة (أعمال ٢: ٤). لكنهم نالوا عربوناً واستعداداً لذلك الامتلاء. والذي نالوه حينئذ قوة الإدراك للأمور المختصة بالمسيح وملكوته، أي فهم النبوات المتعلقة به وضرورة موته وقيامته لإتمام عمل الفداء، وهذا حسب القول «حِينَئِذٍ فَتَحَ ذِهْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا الكُتُبَ. وَقَالَ لَهُمْ: هَكَذَا هُوَ مَكْتُوبٌ، وَهَكَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ المَسِيحَ يَتَأَلَّمُ وَيَقُومُ مِنَ الأَمْوَاتِ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ» (لوقا ٢٤: ٤٥ و٤٦). ونالوا علاوة على ذلك حكمة وقوة من الروح القدس ليضعوا للناس شروط مغفرة الخطايا، ولتمييز الذين قبلوا تلك الشروط واستناروا بالروح القدس ونجوا (ع ٢٣).
وهذه الآية من الآيات التي استند عليها القائلون بصدور الروح القدس من الابن كصدوره من الآب.
٢٣ «مَنْ غَفَرْتُمْ خَطَايَاهُ تُغْفَرُ لَهُ، وَمَنْ أَمْسَكْتُمْ خَطَايَاهُ أُمْسِكَتْ».
متّى ١٦: ١٩ و١٨: ١٨ وأعمال ٥: ١ - ١١ و٨: ٢١ و١٣: ٩
انظر شرح متّى ١٦: ١٩ و١٨: ١٨. تتضمن هذه الآية أمرين: (١) أن المسيح أوكل إلى تلاميذه بعد نوالهم الروح القدس أن يعيّنوا الشروط التي ينال بها الناس مغفرة خطاياهم، وأن يصرحوا لكل الذين قبلوا من قلوبهم تلك الشروط بالمغفرة التامة، وبرفض كل من يرفض تلك الشروط. (٢) أن يحكموا بإخلاص على من يعترفون بقبول الشروط المذكورة، ويصرحوا بمغفرة خطاياهم بالنيابة عن المسيح، وبناءً على اعتراف أولئك، ويقبلوهم أعضاء في كنيسة المسيح. كما يحكمون بدينونة الذين لا يتوبون. فسلطان الرسل في الروحيات كسلطان كهنة اليهود في مرض البَرَص، فكان لهم أن يحكموا بشفاء من شُفي وطهارته، وعدم شفاء من لم يُشفَ ونجاسته. ويشبه سلطان الرسل السلطان الذي أعطاه الله لإرميا النبي «اُنْظُرْ! قَدْ وَكَّلتُكَ هَذَا اليَوْمَ عَلَى الشُّعُوبِ وَعَلَى المَمَالِكِ، لِتَقْلَعَ وَتَهْدِمَ وَتُهْلِكَ وَتَنْقُضَ وَتَبْنِيَ وَتَغْرِس» (إرميا ١: ١٠). وهذا السلطان متعلق بإعلان المغفرة لا بالمغفرة عينها. فالمسيح لا يغفر للناس بناء على مغفرة الرسل لهم، لكن الرسل يصرحون بإرشادٍ من المسيح بالمغفرة للناس بناء على أنها مغفرته.
ولنا ثلاثة براهين على أن سلطان الرسل يقف عند إعلان المغفرة، لا منحها: (١) أن الكتاب المقدس قصر مغفرة الخطايا على الله وحده (إشعياء ٤٣: ٢٣). (٢) أنه لا دليل في سفر الأعمال أو الرسائل أن أحد الرسل ادّعى سلطان مغفرة الخطايا، أو أخذ على نفسه أن يغفر لأحد. لكنهم قالوا بسلطان إعلان ذلك (أعمال ١٠: ٤٣ و١٣: ٣٢، ٣٨ و١٦: ٣١). (٣) أن بولس الرسول بيّن في رسالتيه إلى تيموثاوس ورسالته إلى تيطس واجبات القسيس راعي الكنيسة وسلطانه، ولم يذكر قط أن له سلطاناً من نفسه على مغفرة الخطايا. وفسر لوقا معنى ذلك في كلامه على خطاب المسيح المذكور بقوله «وَأَنْ يُكْرَزَ بِاسْمِهِ بِالتَّوْبَةِ وَمَغْفِرَةِ الخَطَايَا لِجَمِيعِ الأُمَمِ» (لوقا ٢٤: ٤٧). وكل ما أعطاه المسيح لرسله من السلطان في كنيسته أعطاه لهم بالمساواة، ولم يرفع واحداً منهم على بقيتهم. وكان ذلك كله مشروطاً بنوالهم الروح القدس أولاً. وأما السلطان الذي وهبه المسيح لرعاة كنيسته فينحصر في أربعة أمور: (١) التبشير بالإنجيل لكل الناس. (٢) تعيين الشروط للقبول في عضوية الكنيسة بناء على كلام الله. (٣) إدخال الطالبين إلى شركة الكنيسة بناء على إقرارهم بإيمانهم بالمسيح. (٤) سياسة الكنيسة إدارياً.
٢٤ «أَمَّا تُومَا، أَحَدُ الاثْنَيْ عَشَرَ، الَّذِي يُقَالُ لَهُ التَّوْأَمُ، فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ جَاءَ يَسُوعُ».
يوحنا ١١: ١٦
تُومَا انظر شرح يوحنا ١١: ١٦.
فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ لا نعرف لماذا لم يكن معهم، لكننا نعرف أن المسيح لم يلمه على ذلك بل على عدم إيمانه فقط. وكان هذا التلميذ يميل إلى الشك والخوف واليأس (يوحنا ١١: ١٦). وغاية البشير من ذكر شك توما بيان أن الرسل لم يتوقعوا قيامة المسيح، ولا كانوا مستعدين أن يقتنعوا بحقيقتها بأدلة ضعيفة. لكنهم آمنوا بها بعد شك شديد، وبعد أقوى البراهين. شك توما لكي لا نشك نحن.
٢٥ «فَقَالَ لَهُ التّلامِيذُ الآخَرُونَ قَدْ رَأَيْنَا الرَّبّ. فَقَالَ لَهُمْ: إِنْ لَمْ أُبْصِرْ فِي يَدَيْهِ أَثَرَ المَسَامِيرِ، وَأَضَعْ إِصْبِعِي فِي أَثَرِ المَسَامِيرِ، وَأَضَعْ يَدِي فِي جَنْبِهِ، لا أُومِنْ».
قَدْ رَأَيْنَا الرَّبَّ هذه شهادة عشرة بما شاهدوه بعيونهم، فكان يجب على توما أن يكتفي بها لمعرفته أنهم صادقون، ولا غاية لهم من أن يخدعوه.
إِنْ لَمْ أُبْصِرْ.. لا أُومِنْ ادعى توما أنه يقدر أن يميِّز بين الحق والباطل أكثر من باقي التلاميذ، فوضع شروطاً لإيمانه تمنع إثبات شيء بشهادة الناس، فرفض تصديقهم وتعليمهم إلا إذا رأى بنفسه. وكلامه يدل على إعجابه بنفسه، وعناده، واستخفافه بإدراك إخوته التلاميذ وصدقهم. وليس لتوما عُذر في شكه، فقد سمع بأذنيه المسيح يقول «إنه يقوم بعد ثلاثة أيام» وكان قد شاهده منذ بضعة أسابيع يقيم لعازر من الموت. ولكنه رفض وسائل برهنة صحة القيامة، من قبر مفتوح، وأكفان ملفوفة، وظهوره لمريم المجدلية، وللمرأتين الأخريين، وللتلميذين على طريق عمواس، ولإخوته العشرة. ولا يستلزم قوله «أثر المسامير في يده» أن قدمي المسيح لم تُسمرا، فقصده أنه يكتفي بمشاهدة اليدين والجنب.
ظهوره لتلاميذه ثانية (ع ٢٦ - ٢٩)
٢٦ «وَبَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ كَانَ تلامِيذُهُ أَيْضاً دَاخِلاً وَتُومَا مَعَهُمْ. فَجَاءَ يَسُوعُ وَالأَبْوَابُ مُغَلَّقَةٌ، وَوَقَفَ فِي الوَسَطِ وَقَالَ: سلامٌ لَكُمْ».
بَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ أي بعد أسبوع كامل حسب اصطلاح اليهود، فكان ذلك اليوم الأحد. وهذا لا ينفي أن الرسل اجتمعوا في غيره من أيام الأسبوع الماضي، وإنما خصّه بالذكر لما حدث فيه. استعداداً لإبدال السبت بالأحد.
دَاخِلاً أي في بيت، والأرجح أنه هو البيت الذي كانوا مجتمعين فيه في أورشليم يوم الأحد السابق.
وَتُومَا مَعَهُمْ الظاهر من سياق الكلام أن المسيح أتى إليهم حينئذ ليظهر للتلاميذ وتوما معهم. وقبول التلاميذ توما معهم بعد تكذيبه إيّاهم وعناده وعدم إيمانه دليل على محبتهم له.
وَالأَبْوَابُ مُغَلَّقَةٌ كما كانت في الأحد السابق ودون أن يشعروا به.
وَقَفَ فِي الوَسَطِ دون أن يبنئهم بقدومه ودون أن يشعروا به.
سلامٌ لَكُمْ حيا الجميع بذلك كما سبق دون أن يستثني توما.
٢٧ «ثُمَّ قَالَ لِتُومَا: هَاتِ إِصْبِعَكَ إِلَى هُنَا وَأَبْصِرْ يَدَيَّ، وَهَاتِ يَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنْبِي، ولا تَكُنْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ بَل مُؤْمِناً».
١يوحنا ١: ١
هَاتِ إِصْبِعَكَ أظهر المسيح بهذا أنه عرف كل ما حدث بين توما وسائر التلاميذ (ع ٢٥) لأن قوله جواب مرتب على قول توما كلمةً بكلمة. وهذا برهان آخر على صحة دعوى المسيح أنه إله كما هو إنسان. ولا بد من أنه أخجل توما على عدم إيمانه وقساوة قلبه. وكما عرف المسيح يومئذ أفكار توما وكلامه يعرف الآن كل الأفكار والأقوال على هذه الأرض. ونستنتج مما قاله يسوع لتوما أن جروحه لم تكن قد شُفيت تماماً، وأن الجرح الذي في جنبه واسع حتى أنه يسع اليد.
ولا تَكُنْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ بَل مُؤْمِناً هذا غير مقصور على أمر توما بالإيمان بقيامة المسيح، بل عام لكل ما يطالب به. فكأن المسيح قال له «كن مؤمناً بدلاً من ميلك إلى الشكوك. سلِّم نفسك إلى الإيمان مصلحاً عيوب طبيعتك، فاتحاً قلبك لقبول البراهين الكافية للحق». ولم يكن توما حينئذ كافراً بل كان في خطر عظيم من الكفر، فحذره المسيح من ذلك الخطأ لأن طلبه شهادة حواسه قبل التسليم بشيء من الحقائق يناقض مبادئ المسيح ومنها أن «نسلك بالإيمان لا بالعيان».
٢٨ «أَجَابَ تُومَا: رَبِّي وَإِلَهِي».
أظهر توما بهاتين الكلمتين التعجب والسرور والتوبة واليقين والعبادة. ورأى أن الذي خاطبه هو الإنسان يسوع المسيح الذي مات وقام، وآمن أنه الله ظهر في الجسد.
رَبِّي وَإِلَهِي هذا إقرار بسيادة المسيح ولاهوته، وهو يوافق القول «وكان الكلمة الله» وهو خلاصة كل مضمونها، فيجب أن نتخذه من جملة البراهين القاطعة على لاهوت المسيح، لأن توما خاطبه معتبراً إيّاه إلهه في حضرة جميع الرسل، ولم يعترضه المسيح ولا أحد من الرسل على ذلك، بل مدحه المسيح عليه. فيحق لنا أن نسمي المسيح ربنا وإلهنا.
٢٩ «قَالَ لَهُ يَسُوعُ: لأنَّكَ رَأَيْتَنِي يَا تُومَا آمَنْتَ! طُوبَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَرَوْا».
٢كورنثوس ٥: ٧ و١بطرس ١: ٨
لأنَّكَ رَأَيْتَنِي أي أبصرت جسدي، ووقفت على البراهين أني أنا هو المصلوب. ويستنتج من هذا القول أنه لم يلمس المسيح. ولو كان ذلك لقال «لأنك رأيتني ولمستني».
آمَنْتَ مدحه المسيح على اقتناعه بقيامته بشهادة حواسه، وعلى اعترافه بأنه ربه وإلهه. ولكن إيمان توما المبني على شهادة حواسه هو من أدنى مراتب الإيمان، لهذا وبخه المسيح على أنه لم يحصل على إيمان قوي كإيمان غيره. نعم إن المسيح لم يكلف أحداً أن يؤمن بلا برهان، وإنما لام توما على قسوته وعناده، لأنه رفض براهين كافية لإقناع كل ذي نية صالحة.
طُوبَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَرَوْا أي هؤلاء السعداء يستحقون المدح الإلهي. ويلزم من ذلك أن الله كان يرضى عن توما أكثر لو أنه قبل شهادة إخوته الرسل منذ سبعة أيام وآمن بقيامة المسيح. والأرجح أن التوبيخ المذكور في بشارة مرقس للرسل وُجه بالأكثر إلى توما، وهو قوله «وَوَبَّخَ عَدَمَ إِيمَانِهِمْ وَقَسَاوَةَ قُلُوبِهِمْ، لأنَّهُمْ لَمْ يُصَدِّقُوا الَّذِينَ نَظَرُوهُ قَدْ قَامَ» (مرقس ١٦: ١٤). والذي قاله المسيح لتوما يومئذ يقوله لنا الآن إنه يجب أن نقبل كلامه ببساطة الإيمان كما يقبل الأولاد الصغار كلام والديهم. وذلك التطويب نصيب كل الذين صدقوا بشهادة الرسل الشفاهية والمكتوبة في الإنجيل. وهذا كقول الرسول في المسيح «ذَلِكَ وَإِنْ كُنْتُمْ لا تَرَوْنَهُ الآنَ لَكِنْ تُؤْمِنُونَ بِهِ، فَتَبْتَهِجُونَ بِفَرَحٍ لا يُنْطَقُ بِهِ وَمَجِيدٍ، نَائِلِينَ غَايَةَ إِيمَانِكُمْ خلاصَ النُّفُوسِ» (١بطرس ١: ٨، ٩).
هدف كتابة يوحنا (ع ٣٠، ٣١)
٣٠ «وَآيَاتٍ أُخَرَ كَثِيرَةً صَنَعَ يَسُوعُ قُدَّامَ تلامِيذِهِ لَمْ تُكْتَبْ فِي هَذَا الكِتَابِ».
يوحنا ٢١: ٢٥
ع ٣٠، ٣١ خاتمة ما في هذا الأصحاح.
آيَاتٍ أُخَرَ المقصود بعض ما صنعه من المعجزات قبل موته. فكأنه قال: لا تظنوا أن ما ذكرتُه من عجائب المسيح هو كل ما صنعه على الأرض بل هو قليل من كثير. ولا تظنوا أنه لم يظهر بعد قيامته سوى ثلاث مرات كما ذكرت، لأنه ظهر مراراً غيرها (أعمال ١: ٣). وذُكر بعض ذلك في سائر البشائر، وبعضه لم يذكره أحد من البشيرين.
قُدَّامَ تلامِيذِهِ أي رسله وفي هذا إشارة إلى أن يسوع اختار اثني عشر رسولاً ليرافقوه في التبشير، وليروا أعماله، ويسمعوا تعليمه لنفع أنفسهم أولاً، ولنفع العالم ثانية بشهادتهم بما للمسيح.
فِي هَذَا الكِتَابِ أي هذه البشارة.
٣١ «وَأَمَّا هَذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ لِتُؤْمِنُوا أَنَّ يَسُوعَ هُوَ المَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْتُمْ حَيَاةٌ بِاسْمِهِ».
لوقا ١: ٤ ويوحنا ١: ٤ ، ١٢ و٣: ١٥، ١٦، ٣٦ و٥: ٢٤ و١بطرس ١: ٨، ٩ و١يوحنا ٥: ١١
بيّن الرسول هنا أنه كتب ما في هذه البشارة كلها، أو ما في هذا الأصحاح من البراهين على صحة قيامة المسيح لغايتين: الأولى تثبيت إيمان المؤمنين، والثانية حصولهم على الحياة الأبدية. والأول شرط للثاني. وتفيدنا هذه الآية بأن يوحنا لم يقصد أن يكتب تاريخاً كاملاً لحياة المسيح على الأرض، بل اقتصر على ذكر بعض معجزاته ومحاوراته ومواعظه إظهاراً لمجد المسيح، وتقوية لإيمان المؤمنين به وتوطيد حياتهم الروحية. ولذلك ترك خبر ميلاد المسيح وتجربته وأكثر معجزاته وأمثاله وتجلّيه ورسمه العشاء الرباني وصعوده إلى السماء.
لِتُؤْمِنُوا أي ليثبت إيمانكم ويقوى ويزيد بالحقيقة الجوهرية في المسيحية وهي «أن يسوع هو المسيح ابن الله». وغايتا بشارة يوحنا هما غايتا كل كتاب الله من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا، لأن كل نبواته تُثبت مجد يسوع المسيح، وأنه مصدر الحياة الأبدية.
حَيَاةٌ هي الحياة الروحية التي شرطها الإيمان بالمسيح.
بِاسْمِهِ أي بصفات المسيح ووظائفه المعلنة بما سُمي به كيسوع أي مخلِّص، وعمانوئيل أي الله معنا، والملك والنبي والكاهن.
الأصحاح الحادي والعشرون
ظهور يسوع لتلاميذه على بحر طبرية (ع ١ - ١٤)
١ «بَعْدَ هَذَا أَظْهَرَ أَيْضاً يَسُوعُ نَفْسَهُ لِلتّلامِيذِ عَلَى بَحْرِ طَبَرِيَّةَ. ظَهَرَ هَكَذَا».
بَعْدَ هَذَا أي بعد الحوادث التي ذُكرت في أصحاح ٢٠، والوقت ما بين اليوم الثامن من قيامته واليوم الأربعين.
أَظْهَرَ أَيْضاً يَسُوعُ نَفْسَهُ قال «أظهر نفسه» ولم يقل أتى إليهم بسبب التغيير الذي حدث له بعد قيامته، فكان يظهر متى أراد ولمن أراد، ويختفي متى شاء. وقوله «أيضاً» يدل على أنه ظهر قبل ذلك للرسل. وهذا الظهور لم يذكره أحد من البشيرين غير يوحنا. إلا أنهم ذكروا وعد المسيح بالاجتماع في الجليل.
عَلَى بَحْرِ طَبَرِيَّةَ أي على الشاطئ (انظر شرح متّى ٤: ١٨). ويسمّى أيضاً بحر الجليل وبحر جنيسارت ولم يسمِّه أحد بحر طبرية غير يوحنا، نسبة إلى المدينة التي على شاطئه، والمدينة نفسها سميّت طبرية نسبة إلى طيباريوس قيصر الروماني.
٢ «كَانَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ، وَتُومَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ التَّوْأَمُ، وَنَثَنَائِيلُ الَّذِي مِنْ قَانَا الجَلِيلِ، وَابْنَا زَبْدِي، وَاثْنَانِ آخَرَانِ مِنْ تلامِيذِهِ مَعَ بَعْضِهِمْ».
يوحنا ١: ٥٥ متّى ٤: ٢١
تواجد هؤلاء السبعة في الجليل وطنهم، وقد عادوا إليه بعد عيد الفصح. ووعد المسيح أن يجتمع بهم هناك (متّى ٢٦: ٣٢ و٢٨: ١٠ ومرقس ١٤: ٢٨ و١٦: ٧) كما أمرهم الملاك بالذهاب إلى الجليل (متّى ٢٨: ٧). وكان المسيح قد قضى أكثر وقت خدمته الأرضية هناك، وكان أكثر تلاميذه من الجليل. فكان الاجتماع فيه أسهل عليهم من الاجتماع في أي مكان آخر، كما أنه أكثر أمناً لبعده عن تواجد رؤساء اليهود. وكان هذا الاجتماع استعداداً للاجتماع على الجبل الذي ذكره متّى (متّى ٢٨: ١٦) وحضره أكثر من خمس مئة أخ (١كورنثوس ١٥: ٦). وبعد هذا الاجتماع العظيم رجع الرسل إلى أورشليم بأمر المسيح، وشاهدوا صعوده. وكان قد أمرهم بأن لا يبرحوا بعد صعوده من أورشليم حتى يحل عليهم الروح القدس. وقد يثور سؤال: إن الملاك عند القبر أمرهم بالذهاب إلى الجليل، وبهذا أمرهم المسيح قبل موته، فلماذا بقوا ثمانية أيام في أورشليم؟ (يوحنا ٢٠: ٢٦) أجبنا: لم يكن من اللائق أن يتركوا أورشليم قبل نهاية أسبوع الفصح، ولعل من جملة ما عاقهم عن ذلك عدم إيمان توما.
نَثَنَائِيلُ المرجح أنه هو برثولماوس أي ابن ثولماوس (انظر شرح متّى ١٠: ٣). وذُكر هنا فقط أنه من قانا الجليل.
وَابْنَا زَبْدِي هما يعقوب ويوحنا، وذكر يوحنا هنا فقط اسم أبيه.
وَاثْنَانِ آخَرَانِ مِنْ تلامِيذِهِ لا نعرف من هما. وهل هما مِن الرسل، أو من غيرهم من المؤمنين.
٣ «قَالَ لَهُمْ سِمْعَانُ بُطْرُسُ: أَنَا أَذْهَبُ لأتَصَيَّدَ. قَالُوا لَهُ: نَذْهَبُ نَحْنُ أَيْضاً مَعَكَ. فَخَرَجُوا وَدَخَلُوا السَّفِينَةَ لِلوَقْتِ. وَفِي تِلكَ اللَّيْلَةِ لَمْ يُمْسِكُوا شَيْئاً».
قَالَ لَهُمْ سِمْعَانُ بُطْرُسُ كعادته في سبقه غيره في الكلام والعمل.
أَنَا أَذْهَبُ لأتَصَيَّدَ هذا يتضمن قوله «هل تذهبون معي؟».
نَذْهَبُ لا يدل رجوعهم إلى مهنتهم الأصلية على أنهم تركوا وظيفتهم الرسولية، كما أن اشتغال بولس أحياناً بصناعة الخيام لا يدل على أنه ترك التبشير. وإنما فعلوا ذلك وقتياً وهم يتوقعون مجيء المسيح إليهم ليشغلوا الوقت وليجهزّوا ما يحتاجون إليه.
فِي تِلكَ اللَّيْلَةِ لَمْ يُمْسِكُوا شَيْئاً رتب الله ذلك لتكون معجزة الصيد العظيم صباحاً أغرب وأعجب. ومثل هذا التعب الباطل حدث لبطرس وابني زبدي في تلك البحيرة قبل هذا بنحو ثلاث سنين (لوقا ٥: ٥).
٤ «وَلَمَّا كَانَ الصُّبْحُ، وَقَفَ يَسُوعُ عَلَى الشَّاطِئِ. وَلَكِنَّ التّلامِيذَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ يَسُوعُ».
يوحنا ٢٠: ١٤
وَقَفَ يَسُوعُ عَلَى الشَّاطِئِ الأرجح أن ظهوره كان بغتة كظهوره سابقاً في البيت (يوحنا ٢٠: ١٩، ٢٦).
وَلَكِنَّ التّلامِيذَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ وكذا لم تعلم مريم المجدلية (يوحنا ٢٠: ٢)، والتلميذان الذاهبان إلى عمواس (لوقا ٢٤: ١٦). وسببه التغيير في هيئته. ومن العجب أنهم لم يعرفوه من صوته.
٥ «فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: يَا غِلمَانُ أَلَعَلَّ عِنْدَكُمْ إِدَاماً؟. أَجَابُوهُ: لا!».
لوقا ٢٤: ٤١
عرف المسيح كل أمورهم لكنه سألهم ذلك لفتح الحديث، وليجعله مقدمة لما سيقوله، كما فعل مع المرأة السامرية بقوله «أعطيني لأشرب» (يوحنا ٤: ٧). وكان سؤال المسيح مما يتوقعه الصيادون من المارّة، لأن سؤاله يدل على رغبته في نجاحهم، أو في شراء شيء من السمك.
إِدَاماً هو ما يؤكل مع الخبز، والمراد به هنا السمك.
لا! اقتصروا على ذلك لصعوبة الحوار بسبب المسافة بينهم وبينه (ع ٨).
٦ «فَقَالَ لَهُمْ: أَلقُوا الشَّبَكَةَ إِلَى جَانِبِ السَّفِينَةِ الأَيْمَنِ فَتَجِدُوا. فَأَلقَوْا، وَلَمْ يَعُودُوا يَقْدِرُونَ أَنْ يَجْذِبُوهَا مِنْ كَثْرَةِ السَّمَكِ».
لوقا ٥: ٤، ٦، ٧
الظاهر أنهم كانوا قد يئسوا ورفعوا الشبكة ووضعوها في السفينة وشرعوا يرجعون، لكنهم قبلوا نصحه في الحال مع أنهم كانوا قد تعبوا الليل كله عبثاً.
٧ «فَقَالَ ذَلِكَ التِّلمِيذُ الَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ لِبُطْرُسَ: هُوَ الرَّبُّ. فَلَمَّا سَمِعَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنَّهُ الرَّبُّ، اتَّزَرَ بِثَوْبِهِ، لأنَّهُ كَانَ عُرْيَاناً، وَأَلقَى نَفْسَهُ فِي البَحْرِ».
يوحنا ١٣: ٢٣ و٢٠: ٢
فَقَالَ ذَلِكَ التِّلمِيذُ الَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ أي يوحنا كاتب هذه البشارة ولم يذكر اسمه كما تعوَّد.
هُوَ الرَّبُّلم يقل كيف عرفه. فإن قيل إن الصيد الكثير ليس دليلاً كافياً على أن ذلك هو المسيح، قلنا إن المعجزة أن المسيح عرف مكان كثرة السمك من بعيد، وهو ما لم يعرفه تلاميذه وهم على البحيرة! وهذا ما عرَّف يوحنا أن ذلك هو المسيح. ولعله تذكّر يوم دعاه يسوع ليكون تلميذاً له. وكان قد تعب هو ورفقاؤه كل الليل عبثاً، ثم ألقى الشبكة بأمر المسيح فصاد كثيراً. ولعل النجاح الذي كان طاعةً لنصح ذلك الرجل جعل يوحنا يمعن النظر فيه، فعرفه من هيئته.
فَلَمَّا سَمِعَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ كان يوحنا أسرع من بطرس في الإدراك (يوحنا ٢٠: ٨)، وكان بطرس أسرع منه في العمل المبني عليه، كما يظهر من هذه الآية ومن مشيه على البحر لملاقاة المسيح (متّى ١٤: ٢٩) ومن سلّه السيف والضرب به (يوحنا ١٨: ١٠).
اتَّزَرَ بِثَوْبِهِ أي شد وسطه به. وكان قد نزعه عنه وهو يصيد، فلبسه احتراماً للمسيح.
لأنَّهُ كَانَ عُرْيَاناً أي من بعض الثياب كالكساء وما شابهه مما تقتضي سهولة الصيد خلعه.
وَأَلقَى نَفْسَهُ فِي البَحْرِ ليصل إلى المسيح سريعاً. فمحبته لسيده ألجأته إلى ذلك، فلم يهتم بالسمك أو الشبكة أو السفينة أو الرفاق.
٨ «وَأَمَّا التّلامِيذُ الآخَرُونَ فَجَاءُوا بِالسَّفِينَةِ، لأنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بَعِيدِينَ عَنِ الأَرْضِ إلا نَحْوَ مِئَتَيْ ذِرَاعٍ، وَهُمْ يَجُرُّونَ شَبَكَةَ السَّمَكِ».
وَهُمْ يَجُرُّونَ شَبَكَةَ السَّمَكِ منعهم ثقل الشبكة لكثرة ما فيها من السمك أن يرفعوها إلى السفينة كعادتهم أحياناً (لوقا ٥: ٧). وذكر البشير قرب السفينة من الشاطئ بياناً لإمكان جر الشبكة وراءهم إليه.
٩ «فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى الأَرْضِ نَظَرُوا جَمْراً مَوْضُوعاً وَسَمَكاً مَوْضُوعاً عَلَيْهِ وَخُبْزاً».
لم يذكر يوحنا من أين أتى المسيح بالسمك والجمر والخبز. ولا نعجب من وجودها هناك بواسطة معجزية. فهذا يشبه إرسال الملاك بالطعام إلى إيليا في البرية (١ملوك ١٩: ٦). وغاية يسوع مما فعل أن يظهر لهم قوته على تهيئة حاجاتهم، واستعداده لذلك، ورغبته فيه.
١٠ «قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: قَدِّمُوا مِنَ السَّمَكِ الَّذِي أَمْسَكْتُمُ الآنَ».
الأرجح أن المسيح قصد بذلك أن يأتوا ببعض ما صادوه هم من السمك ليأكلوه مع ما أعدّه هو. ولعله قصد أن يأتي بالسمك ويريه لهم ليقتنعوا بوفرة الصيد، ويذكروا معجزة السمك التي صنعها حين دعاهم ليكونوا «صيادي الناس».
١١ «فَصَعِدَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَجَذَبَ الشَّبَكَةَ إِلَى الأَرْضِ، مُمْتَلِئَةً سَمَكاً كَبِيراً، مِئَةً وَثلاثاً وَخَمْسِينَ. وَمَعْ هَذِهِ الكَثْرَةِ لَمْ تَتَخَرَّقِ الشَّبَكَةُ».
الظاهر أن التلاميذ لما وقفوا على الشاطئ كانوا أمام المسيح يتوقعون أمره. ولما أمرهم بتقديم السمك أخذوا يجذبون الشبكة إلى الأرض. وقام بطرس بذلك وساعده الباقون لأنه هو الذي دعاهم إلى الصيد (ع ٣). ومن غرائب ذلك ثلاثة أشياء: كثرة السمك، وكبره، وعدم تخرق الشبكة، خلافاً لما كان في لوقا ٥: ٦. وذكر عدد السمك بياناً لعظمة المعجزة، كما ذكر أن الآكلين في معجزة بيت صيدا كانوا خمسة آلاف رجل، وأن الأرغفة خمسة والإدام سمكتان، وأن القفف اثنتا عشرة (يوحنا ٦: ٩، ١٠، ١٣).
١٢ «قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: هَلُمُّوا تَغَدَّوْا. وَلَمْ يَجْسُرْ أَحَدٌ مِنَ التّلامِيذِ أَنْ يَسْأَلَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ إِذْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الرَّبُّ».
أعمال ١٠: ٤١
هَلُمُّوا تَغَدَّوْا أعدّ المسيح الطعام ودعاهم إليه شفقة عليهم لأنه عرف أنهم قد تعبوا وجاعوا بعد ليلة طويلة من الجهد، وليبين أن مشاعره نحوهم لم تتغير. وإن كان قد مات وقام فقد ظل يحبهم ويعتني بهم كما كان في أول الأمر. ولا شك أنه أكل معهم كما قال بطرس (أعمال ١٠: ٤١) وحسبما أنبأ به (لوقا ٢٤: ٤٢، ٤٣) لأنه أراد أن يؤكد لهم صحة قيامته بالجسد، وأن يزيل خوفهم، ويجعلهم يعتبرونه حبيبهم وصديقهم.
وَلَمْ يَجْسُرْ أَحَدٌ لم يكن الرسل حينئذ محتاجين إلى شهادة المسيح بأنه هو، لأنهم تأكدوا من ذلك. لكنه كان يزيدهم تعزية لو سمعوه يقول «أنا هو» كما قال وهو آتٍ إليهم على البحر ليلاً (يوحنا ٦: ٢٠). لكنهم عدلوا عن السؤال خوفاً لما على هيئته من الهيبة والوقار، ومن أنه قد قام من الأموات، وأخذ يحضر ويغيب بطريق عجيبة، ومن المعجزتين اللتين صنعهما حينئذ.
١٣ «ثُمَّ جَاءَ يَسُوعُ وَأَخَذَ الخُبْزَ وَأَعْطَاهُمْ وَكَذَلِكَ السَّمَكَ».
ثُمَّ جَاءَ يَسُوعُ الظاهر أنهم خافوا أن يتقدموا إليه حتى اقترب منهم ليشجعهم.
وَأَخَذَ الخُبْزَ وَأَعْطَاهُمْ كما اعتاد أن يفعل معهم في السابق وهو رئيس المتكإ، ليذكروا الأوقات الكثيرة التي أكلوا فيها معه وحده، وليذكر المعجزتين اللتين أشبع فيهما الألوف من الخبز والسمك. فإن قيل: هل قصد المسيح بما فعله هنا أن يبرهن صحة قيامته ولاهوته وناسوته وصداقته للرسل وعنايته بهم؟ قلنا: لعله علَّمهم وقتئذ نفس ما علمهم يوم دعاهم ليكونوا رسلاً، وهو أنهم صاروا «صيادي الناس» وأن نجاحهم متوقف على حضوره بينهم بالروح وطاعتهم إرشاده. وقال بعضهم «إن في هذه الحادثة رمزاً إلى ما يحدث لكل تلاميذ الرب في نهاية أتعابهم، فيبلغون شاطئ السلام السماوي، ويجدون الرب هنالك يستقبلهم ويدعوهم إلى وليمة عظيمة أعدها لهم، فيتكئون معه ومع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوته». قلنا المشابهة ظاهرة حسنة، ولكن لا دليل على أن المسيح قصدها.
١٤ «هَذِهِ مَرَّةٌ ثَالِثَةٌ ظَهَرَ يَسُوعُ لِتلامِيذِهِ بَعْدَمَا قَامَ مِنَ الأَمْوَاتِ».
يوحنا ٢٠: ١٩، ٢٦
ذكر يوحنا هنا المرات التي ظهر فيها لجماعة من الرسل لا لغيرهم من الأفراد، وعلى هذا لم يحسب معها ظهوره لمريم المجدلية الذي ذكره في يوحنا ٢٠: ١٦، ولا ظهوره لبطرس ولا للتلميذين المسافرين إلى عمواس. ولعله نظر إلى الظهور باعتبار أيامه دون عدده، وباعتبار المشاهدين، فيكون ظهوره ثلاث مرات يوم القيامة مرة، مع أنه شاهده فيه كثيرون على التوالي في أماكن مختلفة، وبعد أسبوع مرة، وهذا اليوم مرة وهي الثالثة.
خطاب المسيح لبطرس (ع ١٥ - ٢٣)
١٥ «فَبَعْدَ مَا تَغَدَّوْا قَالَ يَسُوعُ لِسِمْعَانَ بُطْرُسَ: يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا، أَتُحِبُّنِي أَكْثَرَ مِنْ هَؤُلاءِ؟ قَالَ لَهُ: نَعَمْ يَا رَبُّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ. قَالَ لَهُ: ارْعَ خِرَافِي».
فَبَعْدَ مَا تَغَدَّوْا أي بعد ما أنسوا به وسكن اضطرابهم بأكله معهم كأحد الأصدقاء، أخذ يخاطبهم بأمور هامة تتعلق بأحوالهم وخدمتهم في المستقبل. ويجب أن لا نحسب أن ما ذُكر هنا من كلام المسيح هو كل ما خاطبهم به وقتئذ.
يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا خصّ يسوع بطرس بالكلام وخاطبه دون الستة الباقين، لأنه ادَّعى أنه يحب المسيح أكثر من سائر التلاميذ، وأنه أكثر ثباتاً منهم في الإيمان، مع أنه كان أقل ثباتاً من الجميع. وخاطبه المسيح ثلاث مرات باسمه الأول وكنيته، لا بالاسم الذي سماه به وهو «بطرس» أي الصخر، لأنه بإنكاره يسوع أعلن أنه لا يستحق أن يسمى بذلك، وناداه بذلك ثلاثاً لأنه أنكره ثلاثاً.
أَتُحِبُّنِي؟ في هذا شيء من اللوم لبطرس لأن إنكاره ليسوع شكَّك في محبته. وفيه تذكير له بذلك الإنكار، وفيه سؤال عن عواطف قلبه وقت السؤال. وسأله المسيح ذلك أمام الستة ليكونوا شهوداً بإقرار بطرس، وبمغفرة المسيح له، وقبوله رسولاً أيضاً. ولم يسأل المسيح بطرس عن إيمانه أو معرفته أو توبته أو مقاصده في المستقبل، إنما سأله عن محبته لأنها الشرط الضروري لقبول المسيح إيّاه ثانية، ولأنها تتضمن سائر الفضائل.
أَكْثَرَ مِنْ هَؤُلاءِ أي أكثر مما يحبني هؤلاء التلاميذ. وغاية المسيح من هذه الزيادة امتحانه ليظهر إن كان قد تواضع بعد سقوطه، فلا يعود يفتخر كما افتخر قبلاً بأن إيمانه به ومحبته له أعظم من إيمان سائر إخوته الرسل ومحبتهم، بقوله «وَإِنْ شَكَّ الجَمِيعُ فَأَنَا لا أَشُكُّ» (مرقس ١٤: ٢٩).
أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ أظهر بطرس بهذا الجواب المحبة والتواضع، لأنه صرّح بمحبته دون أن يدّعي زيادتها على محبة سائر إخوته له، واستشهد بعِلم المسيح بذلك. فكأنه قال: نعم، إن عملي يدل على أني لا أحبك، لكنك أنت تعلم ما في قلبي من المحبة لك. وأظهر تواضعه بأمرين: (١) عدم ادعائه زيادة محبته للمسيح على محبة غيره من الرسل له. (٢) نوع المحبة التي صرح بها، لأن سؤال المسيح «أتحبني؟» في اليونانية غير جواب بطرس «أحبك» فيها. فالكلمة الأولى تتضمن أعظم المحبة، كمحبة الملائكة والقديسين في السماء لله، فلم يدّع بطرس أن محبته تستحق أن تُحسب كتلك المحبة، وبيّن أنها كمحبة الصديق للصديق.
ويحسن بكل مسيحي أن يحسب سؤال المسيح لبطرس سؤالاً له، ويتأمل في قلبه ليرى هل يستطيع أن يطلب شهادة علم المسيح بمحبته؟ ويتبيّن مما قيل هنا ثلاثة أشياء: (١) إن أول ما يطلبه المسيح من تلاميذه هو محبة قلوبهم. (٢) إنه يريد إقرارهم علناً بمحبتهم له، ولا يكتفي بمجرد الشعور القلبي. (٣) إن كل إنسان يقدر أن يتحقق: هل يحب المسيح أو لا.
ارْعَ خِرَافِي أشار بذلك أنه أوكل إليه ثانية الخدمة الرسولية. وحين دعاه أولاً لأن يكون رسولاً شبَّه خدمته بالصيد إذ قال له «مِنَ الآنَ تَكُونُ تَصْطَادُ النَّاس» (لوقا ٥: ١٠). وشبهها هنا بالرعاية. والتشبيه الأول يشير إلى إدخال الناس في الكنيسة، والثاني يشير إلى تعليمهم كلمة الله لتقويتهم ونموهم. وخراف المسيح التي أمر بطرس برعايتها هم تلاميذه أي المؤمنون به. ولا نعرف بالضبط ما أراده المسيح بتسميته بعض التلاميذ «خرافاً» وبعضهم «غنماً» (ع ١٦)، فقال البعض أنه قصد «بالخراف» الأحداث والضعفاء و «بالغنم» البالغين والأقوياء. وما أمره به هنا يوافق ما أمره به قبل سقوطه بقوله «وَأَنْتَ مَتَى رَجَعْتَ ثَبِّتْ إِخْوَتَكَ» (لوقا ٢٢: ٣٢).
وعلينا أن نلاحظ هنا أن المسيح لم يسمِّ كنيسته الخراف، ولا خراف بطرس بل «خرافي» (خراف المسيح) لأنها له، وهو الراعي الحقيقي العظيم، وغيره من خدام الدين وكلاؤه. وأن في قوله «ارع» بيان لمسؤولية الرعاة، فهُم لا يترأسون على الكنيسة، ولا يقصدون الربح من رعايتها، بل أن يغذوها بكلمة الحياة. وأن المسيح لم يوكل إلى بطرس رعاية شعبه إلا بعد ما فحص عن محبته، كأن تلك الفضيلة صفة ضرورية للراعي. وأن المسيح يحب خرافه، ولا يكلف أحداً برعايتها إلا إن كان يحبه فيعتني بخراف المسيح بالأمانة. وأن المسيح جعل خدمة بطرس للخراف برهاناً على محبته له، ويتوقع منه تلك العلامة في المستقبل. فالمحبة بالكلام دون العمل لا تستحق أن تُسمى محبة. رغب بطرس في الماضي أن يُظهر محبته للمسيح بأعمال غريبة كمشيه على الماء ليلاقيه، وبما يشبه التواضع مثل رفضه أن يغسل يسوع رجليه، وبافتخاره بثبوته وقت الخطر، وبسلِّ سيفه للمحاماة عن المسيح. ولم يسأله المسيح عن ذلك، بل سأله أن يُظهر محبته له بخدمته لشعبه.
١٦ «قَالَ لَهُ أَيْضاً ثَانِيَةً: يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا، أَتُحِبُّنِي؟ قَالَ لَهُ: نَعَمْ يَا رَبُّ، أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ. قَالَ لَهُ: ارْعَ غَنَمِي».
أعمال ٢٠: ٢٨ وعبرانيين ١٣: ٢٠ و١بطرس ٢: ٢٥ و٥: ٢، ٤
ثَانِيَةً كرر المسيح سؤاله الأول ليجعل بطرس يمتحن نفسه، وليوضح أهمية ذلك السؤال وما يُبنى على الجواب. فنوع المحبة الذي سأل عنه هنا كالنوع الذي سأل عنه أولاً. والفرق بين ما ذُكر في ع ١٥ وما ذُكر هنا ثلاثة أشياء: (١) ترك يسوع ما زاده على السؤال الأول من قوله «أكثر من هؤلاء» فقد اقتنع بجواب بطرس أنه تعلم التواضع بسقوطه. (٢) أن المسيح بقوله «ارع غنمي» عبَّر عن الرعاية ثانيةً بغير ما عبر عنه أولاً، فالكلمة الأولى في اليونانية «التغذية فقط» والثانية تفيد فوق ذلك العناية، والإرشاد، والحماية كالسهر على الخراف ووقايتها من الخطر، وطلب الضالة منها ورده إلى الحظيرة. وهذا غير واضح في الترجمة العربية لعدم وجود كلمتين فيها كالكلمتين في اليونانية. (٣) أنه قال في الأول «خرافي» وفي الثاني «غنمي» ولعل هذا التغيير جاء لتشمل هاتان الكلمتان كل صنوف المؤمنين من دونٍ وعالٍ، وضعفاء وأقوياء، وأحداث وبالغين. وكما أنه سأله ثانية عن محبته له، أمره ثانية بخدمة كنيسته، برهاناً على إخلاص تلك المحبة.
١٧ «قَالَ لَهُ ثَالِثَةً: يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا، أَتُحِبُّنِي؟ فَحَزِنَ بُطْرُسُ لأنَّهُ قَالَ لَهُ ثَالِثَةً: أَتُحِبُّنِي؟ فَقَالَ لَهُ: يَا رَبُّ، أَنْتَ تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ. أَنْتَ تَعْرِفُ أَنِّي أُحِبُّكَ. قَالَ لَهُ يَسُوعُ: ارْعَ غَنَمِي».
يوحنا ٢: ٢٤، ٢٥ و١٦: ٣٠
ثَالِثَةً لا شك أن علة سؤال المسيح لبطرس عن محبته إيّاه ثلاثاً تذكيره إيّاه أنه أنكره ثلاثاً، وإعطاؤه فرصة يصرح بمحبته ليسوع بعدد مرات نفيه العلاقة بينه وبين سيده. وإثباته ثالثةً أنه غفر له وردَّه إلى مقامه بين الرسل، وإرادته أنه بواسطة التكرار يتأكد بطرس أنه يجب عليه أن يكون مستيقظاً أميناً في القيام بما يجب عليه باعتبار أنه راعٍ. وما قيل في هذه الآية يوافق ما قيل لسائر الرسل (متّى ١٨: ١٨). ولا دليل على أن المسيح قصد هنا أن يفضل بطرس على سائر رسله في الرتبة والسلطان.
أَتُحِبُّنِي استعمل المسيح هنا الكلمة التي استعملها بطرس، كما يدل عليه الأصل اليوناني، فكأنه سأل: هل حقاً تحبني كما قلت محبة الصديق لصديقه ومحبة الأخ لأخيه؟
فَحَزِنَ بُطْرُسُ لأنَّهُ قَالَ لَهُ ثَالِثَةً فهم بطرس أن المسيح أشار بالسؤال ثلاثاً إلى إنكاره الثلاثي، فحزن جداً لأن سؤال المسيح ثالثةً يظهر شك المسيح في حقيقة محبته. ولكن مهما كان حزن بطرس وقتئذ شديداً فهو ليس شيئاً بالنسبة إلى الحزن الذي سبَّبه للمسيح بإنكاره في دار قيافا.
أَنْتَ تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ شهد بطرس بهذا أن يسوع هو الله، لأن معرفته كل شيء حتى أسرار القلب تثبت بالضرورة أنه الله (يوحنا ١٦: ٣٠ وأعمال ١: ٢٤).
أَنْتَ تَعْرِفُ أَنِّي أُحِبُّكَ أي إن لم يشهد لساني لصدق اعترافي فانظر داخل قلبي لتعلم إخلاص محبتي. ونتعلم من هذا أن مدح الناس أو لومهم لنا ليسا مهمَّين. أما إن شهد المسيح لنا بحقيقة محبتنا له فلا خوف علينا من حساب يوم الدين.
ارْعَ رجع هنا إلى الكلمة التي استعملها في ع ١٥، أي أطعِم.
غَنَمِي كما في ع ١٥. نسب المسيح غنمه إلى نفسه في كل المرات.
أظهر بطرس بما كتبه في رسالته الأولى أنه أدرك قصد المسيح من هذه التوصية (١بطرس ٥: ١ - ٤) وبيّن في مدة حياته كلها إخلاص محبته بخدمته بأمانة.
١٨ «اَلحَقَّ الحَقَّ أَقُولُ لَكَ: لَمَّا كُنْتَ أَكْثَرَ حَدَاثَةً كُنْتَ تُمَنْطِقُ ذَاتَكَ وَتَمْشِي حَيْثُ تَشَاءُ. وَلَكِنْ مَتَى شِخْتَ فَإِنَّكَ تَمُدُّ يَدَيْكَ وَآخَرُ يُمَنْطِقُكَ، وَيَحْمِلُكَ حَيْثُ لا تَشَاءُ».
يوحنا ١٣: ٣٦ وأعمال ٢: ٣، ٤
أعلن يسوع في هذه الآية أنه يجب على بطرس أن يقتدي به في احتمال الآلام، كما يقتدي به في الخدمة. وفي هذا إنباء بكيفية موت بطرس. فلم يعده المسيح بالراحة والإكرام والرياسة، بل بالمصائب. وكذا أعلن الله لحزقيال أنه عُيّن لاحتمال المشقات (حزقيال ٣: ٢٥) وكذلك بولس (أعمال ٩: ١٦ و٢١: ١١). قال بطرس ليسوع «أنت تعلم كل شيء». فصدق يسوع قوله ببرهان علمه ما في المستقبل.
اَلحَقَّ الحَقَّ أَقُولُ لَكَ التكرار للتوكيد.
لَمَّا كُنْتَ أَكْثَرَ حَدَاثَةً لا يلزم من هذا أن بطرس كان يومئذ شيخاً، لكن المسيح أشار إلى أيام حداثة بطرس حين كان صياد سمك قبل أن دعاه رسولاً. والمرجح أنه كان حينئذ بالغاً لأنه كان متزوجاً زمن دعوته (لوقا ٤: ٣٨).
كُنْتَ تُمَنْطِقُ ذَاتَكَ وَتَمْشِي حَيْثُ تَشَاءُ يشير هذا إلى الحرية والاستقلال، فكأن المسيح قال له «كنت وقتئذ تلبس كما تريد وتذهب وتجيء كما تشاء».
وَلَكِنْ مَتَى شِخْتَ لم يرد المسيح بذلك أن بطرس يعيش طويلاً إلى سن الهرم، بل أن يبقى سنين بعد وقت ذلك الخطاب.
تَمُدُّ يَدَيْكَ قال أكثر المفسرين إن المسيح قصد بذلك أن بطرس سيُصلب، لأن مد اليدين من لوازم الصلب.
وَآخَرُ يُمَنْطِقُكَ أي الصالب يربطك على خشبة الصليب، فإنهم كثيراً ما كانوا يربطون المصلوب من وسطه فوق تسميره لئلا تتمزق الأيدي بالمسامير ويسقط الجسد من ثقله.
يَحْمِلُكَ حَيْثُ لا تَشَاءُ أي يجبرك على الذهاب إلى محل الصلب. ولا يلزم من قوله «لا تشاء» أن بطرس يقاوم صالبيه ويرفض أن يموت شهيداً، إذ المعنى أنه يقاسي ما لا يحتمله الجسد. وهذا ما حدث، فقد كتب القديس أوريجانس المؤرخ المسيحي أن بطرس صُلب منكوساً (أي ورأسه إلى أسفل). ولا نعلم إن كان المسيح قصد بذلك الكلام صلب بطرس، إنما نعلم أنه قصد أن بطرس سيموت شهيداً.
١٩ «قَالَ هَذَا مُشِيراً إِلَى أَيَّةِ مِيتَةٍ كَانَ مُزْمِعاً أَنْ يُمَجِّدَ اللَّهَ بِهَا. وَلَمَّا قَالَ هَذَا قَالَ لَهُ: اتْبَعْنِي».
٢بطرس ١: ١٤
هذا تفسير يوحنا لنبوة المسيح لبطرس.
أَيَّةِ مِيتَةٍ من الميتات الإجبارية والأرجح أنها ميتة الصلب. وأشار بطرس نفسه إلى ما قصده المسيح هنا بقوله «عَالِماً أَنَّ خَلعَ مَسْكَنِي قَرِيبٌ كَمَا أَعْلَنَ لِي رَبُّنَا يَسُوعُ المَسِيحُ أَيْضاً» (٢بطرس ١: ١٤). ولا شك أن يوحنا علم ما قصده المسيح هنا علم اليقين، لأن بطرس كان قد مات قبل أن يكتب يوحنا بشارته بسنين.
يُمَجِّدَ اللَّهَ بِهَا هذا دليل على أن المسيحي يمكنه أن يمجد الله بموته (يوحنا ١٣: ٣١ وفيلبي ١: ٢٠ و١بطرس ٤: ١٦). والذي يمجد الله بموته أكثر من غيره هو من يموت شهيداً للحق لأنه بذلك يقدم أحسن شهادة له. ويمكن المسيحي أن يمجد الله باستعداده للموت دائماً طاعةً لقوله «لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسرجكم موقدة» ويمجده أيضاً في وقت النزع إذا احتمله بصبر وشجاعة وإيمان ورجاء، لأنه بذلك يشهد بقوة ديانة المسيح للانتصار على أهوال الموت والقبر.
اتْبَعْنِي استعمال هذه الكلمة بمعنى حرفي في الآية الآتية يجعلنا نفهمها هنا بحرفية معناها، ونفهم منها أن يسوع ذهب من المكان الذي كان فيه، وأمر بطرس بالذهاب وراءه. لكن ذلك لا يمنع أن المسيح قصد أن يتخذها بطرس بالمعنى الروحي أيضاً، أي أن يقتدي به ويطيعه، كما في قوله «هلمّ ورائي» (متّى ٤: ١٩) حين دعاه أولاً ليكون تلميذاً. وكما فسر ذلك بقوله «إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي فَليُنْكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِل صَلِيبَهُ وَيَتْبَعْنِي» (متّى ١٠: ٣٨ و١٦: ٢٤). وأنه قصد الإشارة إلى موته ميتة كميتته كما أشار إليه سابقاً بقوله «حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستتبعني أخيراً». ولا يبعد عن الظن أن مشي المسيح وقتئذ كان رمزياً ليعلم بطرس أنه يجب عليه ما دام حياً أن يتبع سيده في طريق الطاعة والقداسة وخدمة الكنيسة والآلام، متمماً إرادة الآب كما تممها المسيح، وأن يتبعه بعد ذلك إلى السماء والمجد ببذل حياته لأجل اسمه مائتاً شهيداً على الصليب.
٢٠ «فَالتَفَتَ بُطْرُسُ وَنَظَرَ التِّلمِيذَ الَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ يَتْبَعُهُ، وَهُوَ أَيْضاً الَّذِي اتَّكَأَ عَلَى صَدْرِهِ وَقْتَ العَشَاءِ، وَقَالَ: يَا سَيِّدُ، مَنْ هُوَ الَّذِي يُسَلِّمُكَ؟».
يوحنا ١٣: ٢٤، ٢٥ و٢٠: ٢
فَالتَفَتَ بُطْرُسُ وَنَظَرَ هذا يدل على أن المسيح كان يمشي فعلاً، وبطرس يمشي وراءه.
التِّلمِيذَ الَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ أي يوحنا. (انظر شرح يوحنا ٢٠: ٢).
الَّذِي اتَّكَأَ عَلَى صَدْرِهِ وَقْتَ العَشَاءِ (يوحنا ١٣: ٢٤، ٢٥) وليست الغاية من وصف يوحنا نفسه بهذا وما قبله مجرد تمييز التلميذ الذي تبع المسيح عن سائر التلاميذ، بل إظهار سبب رغبته في أن يبقى قريباً من المسيح، وعلى جسارته أن يفعل ذلك بدون أمره. واتباع يوحنا للمسيح دليل على أن المسيح لم يرد بأمره لبطرس أن يأتي وراءه لينفرد به لأمر سري، ودليل أيضاً على أن يوحنا مستعد أن يتبع سيده حيث يشاء في سبيل الخدمة والألم.
٢١ «فَلَمَّا رَأَى بُطْرُسُ هَذَا، قَالَ لِيَسُوعَ: يَا رَبُّ، وَهَذَا مَا لَهُ؟».
هذا استفهام عن مستقبل يوحنا، فكأنه قال «ماذا يصيب يوحنا بعد، وأية ميتة يموت؟» ولا نعرف السبب الذي دعا بطرس ليسأل هذا السؤال. والأرجح أنه نتج عن محبته الخاصة ليوحنا، ومن اهتمامه بكل ما يأتي على يوحنا، وهو اهتمام الأخ الكبير بأخيه الصغير. فرغب في أن يعلم هل سيموت يوحنا مثله ميتة إجبار؟
٢٢ «قَالَ لَهُ يَسُوعُ: إِنْ كُنْتُ أَشَاءُ أَنَّهُ يَبْقَى حَتَّى أَجِيءَ، فَمَاذَا لَكَ؟ اتْبَعْنِي أَنْتَ».
متّى ١٦: ٢٧، ٢٨ و٢٥: ٣١ و١كورنثوس ٤: ٥ و١١: ٢٦ ورؤيا ٢: ٢٥ و٣: ١ و٢٢: ٧، ٢٠
لا بد من أن المسيح قصد بقوله لبطرس «فماذا لك؟» توبيخاً لطيفاً له على أنه سأل عما لا حق له أن يسأل عنه، وأنه لم يقصد أن يجيبه صريحاً عن سؤاله.
أَنَّهُ يَبْقَى أي يحيا (فيلبي ١: ٢٤، ٢٥ و١كورنثوس ١٥: ٦) وقصد المسيح أن بطرس «يتبعه» (أي في سبيل الموت إجباراً) وأن يوحنا «يبقى» (أي يموت ميتة طبيعية).
حَتَّى أَجِيءَ معنى هذه العبارة غير واضح، ولم يفهمها التلاميذ، ولم يدَّع يوحنا فهمها. فقد ورد مجيء المسيح في الإنجيل بأربعة معانٍ: (٢) حلول الروح القدس يوم الخمسين (يوحنا ١٤: ١٨ و١٦: ١٦، ٢٢) وليس هذا هو المعنى المقصود هنا (٢) خراب أورشليم (يوحنا ١٠: ٢٣ ومتّى ١٠: ٢٣ و٢٦: ٦٤). وهذا كان بعد أربعين سنة من زمن هذه المخاطبة، والأرجح أن بطرس لم يعش إلى ذلك الوقت. أما يوحنا فقد كان حيّاً، وقال أكثر المفسرين إن المسيح قصد ذلك المجيء. (٣) إتيان المسيح ثانية للدينونة (١يوحنا ٢: ٢٨ و٣: ٢) وفهم التلاميذ هذا المعنى، أي أن يوحنا يبقى حياً إلى اليوم الأخير ويصعد إلى السماء بغير موت. (٤) حضور المسيح الروحي عند موت المؤمن (يوحنا ١٤: ٣).
ولم يقُل المسيح إن يوحنا يبقى إلى أحد الأزمنة المشار إليها، إنما قال «إن شئت أن يبقى حتى أجيء».
اتْبَعْنِي أَنْتَ هذا مكرر قوله في ع ١٩. فيكتفي الاهتمام بطاعة هذا الأمر دون الاهتمام بما يتعلق بصديقه.
٢٣ «فَذَاعَ هَذَا القَوْلُ بَيْنَ الإِخْوَةِ: إِنَّ ذَلِكَ التِّلمِيذَ لا يَمُوتُ. وَلَكِنْ لَمْ يَقُل لَهُ يَسُوعُ إِنَّهُ لا يَمُوتُ، بَل: إِنْ كُنْتُ أَشَاءُ أَنَّهُ يَبْقَى حَتَّى أَجِيءَ، فَمَاذَا لَكَ؟».
ذَلِكَ التِّلمِيذَ لا يَمُوتُ هذا شرح المؤمنين في أيام يوحنا لإنباء المسيح بأن يوحنا يبقى إلى أن يجيء، لأنهم توقعوا مجيء يسوع للدينونة قريباً جداً، وأن يحدث ليوحنا ما يحدث لغيره من المؤمنين «لا نَرْقُدُ كُلُّنَا، وَلَكِنَّنَا كُلَّنَا نَتَغَيَّرُ، فِي لَحْظَةٍ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ، عِنْدَ البُوقِ الأَخِيرِ. فَإِنَّهُ سَيُبَوَّقُ، فَيُقَامُ الأَمْوَاتُ عَدِيمِي فَسَادٍ، وَنَحْنُ نَتَغَيَّرُ» (١كورنثوس ١٥: ٥١، ٥٢). ولا عجب من أن الإخوة لم يصيبوا بتفسير كلام المسيح، لأنهم لم يفهموا أن أحد معاني مجيئه هو خراب أورشليم. ونعلم من التواريخ القديمة أن يوحنا مات بعد أن مات كل الرسل، وأنه بقي حياً بعد خراب أورشليم، وتوفي وفاة طبيعية في أفسس في نهاية القرن الأول أو بدء القرن الثاني.
لَمْ يَقُل لَهُ يَسُوعُ قال ذلك بياناً لحقيقة ما قاله المسيح، لئلا ينسب أحد إليه آراء الناس وأوهامهم.
٢٤ «هَذَا هُوَ التِّلمِيذُ الَّذِي يَشْهَدُ بِهَذَا وَكَتَبَ هَذَا. وَنَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتَهُ حَقٌّ».
يوحنا ٩: ٣٥ و٣يوحنا ١٢
تكلم يوحنا على نفسه بضمير الغائب بياناً أنه هو كاتب هذه البشارة كشاهد عيان لأعمال المسيح وأنه هو المشار إليه في ع ٢٢، وأن ذلك تواضع منه (يوحنا ١٩: ٢٦).
بِهَذَا أي البشارة كلها.
نَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتَهُ حَقٌّ أي أنا وإخوتي. وهذا بيان أن الإخوة يصادقون على ما كتبه يوحنا، حتى أنه استطاع أن يُشهدهم ويضمهم إليه في ما كتب (راجع ١يوحنا ٥: ١٨ - ٢٠).
٢٥ «وَأَشْيَاءُ أُخَرُ كَثِيرَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ، إِنْ كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَلَسْتُ أَظُنُّ أَنَّ العَالَمَ نَفْسَهُ يَسَعُ الكُتُبَ المَكْتُوبَةَ. آمِينَ».
يوحنا ٢٠: ٣٠ و٧: ١٠
هذا تصريح بأن ما كتبه يوحنا في هذه البشارة عن المسيح وأعماله قليل من كثير. فاللسان لا يستطيع التعبير عن عظمة الرب يسوع، ولا القلم يسطر ما يتعلق بجلاله، وكلاهما قاصر عن بيان الحكمة والرحمة اللتين أظهرهما بأعماله وأقواله، فاختار يوحنا بعضها (يوحنا ٢٠: ٣٠، ٣١) ليؤمن الناس أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولتكون لمن يؤمنون حياة باسمه. وما كُتب في بشارة يوحنا وسائر البشائر ذو قيمة أعظم من كل كتب العالم، وهو سبب تأليف كتب كثيرة وأفكار عظيمة ثاقبة، وإجراء أعمال شريفة نافعة، وفيه إعلان حقائق أرضية وسماوية أساسية في الحياة الزمنية والحياة الأبدية.
ولا يستلزم قوله هذا أنه لم يكتب سوى القليل مما يتعلق بيسوع فترك شيئاً من الحقائق الضرورية للإيمان والقداسة والخلاص، أو شيئاً من عقائد دين المسيح الجوهرية، لأنه كتب بإلهام الروح القدس الذي يرشد إلى كل الحق (يوحنا ١٦: ١٣).
إِنْ كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ما في هذه الآية مبالغة اعتادها الكُتّاب في تلك الأيام. وكان يوحنا يكتب بشارته إلى أناس مثله بعبارات كعباراتهم. وليس في هذه المبالغة شيء من الكذب أو الخداع أو الغش، فالمقصود بيان الكثرة الكاملة، والتعجب من عظمة الموضوع، وإظهار العجز عن تدوينها كلها. ومن أمثلة هذه المبالغة قوله «هُوَذَا أَنْتُمُ اليَوْمَ كَنُجُومِ السَّمَاءِ فِي الكَثْرَةِ» (تثنية ١: ١٠). وقوله «وَكَانَ المِدْيَانِيُّونَ وَالعَمَالِقَةُ وَكُلُّ بَنِي المَشْرِقِ حَالِّينَ فِي الوَادِي كَالجَرَادِ فِي الكَثْرَةِ، وَجِمَالُهُمْ لا عَدَدَ لَهَا كَالرَّمْلِ الَّذِي عَلَى شَاطِئِ البَحْرِ فِي الكَثْرَةِ» (قضاة ٧: ١٢). وقول المسيح «أَنْتِ يَا كَفْرَنَاحُومَ المُرْتَفِعَةَ إِلَى السَّمَاءِ» (متّى ١١: ٢٣). وقول اليهود «هُوَذَا العَالَمُ قَدْ ذَهَبَ وَرَاءه» (يوحنا ١٢: ١٩). ومما يقرب من قول يوحنا في هذه الآية قول الجامعة «لِعَمَلِ كُتُبٍ كَثِيرَةٍ لا نِهَايَةَ» (جامعة ١٢: ١٢).
آمِينَ هذه الكلمة خاتمة كل البشائر، ومعناها «ليكن ذلك» ويصح أن نقولها أجمعين بمعنى: ليكن لنا إيمان بما كُتب هنا، وطاعة لما أُمر به، وتمتُّع بما وُعد به.
Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
D-70007
Stuttgart
Germany
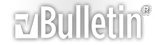




 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس